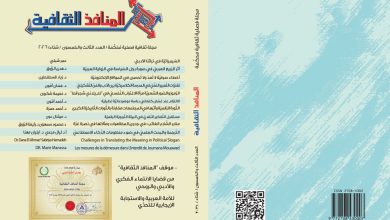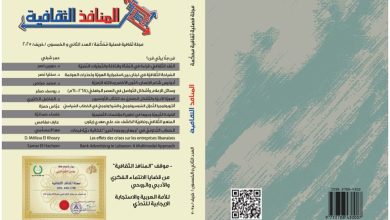تجلّيات الثّورة في الشّعر النّسويّ: نازك الملائكة وفدوى طوقان أنموذجين
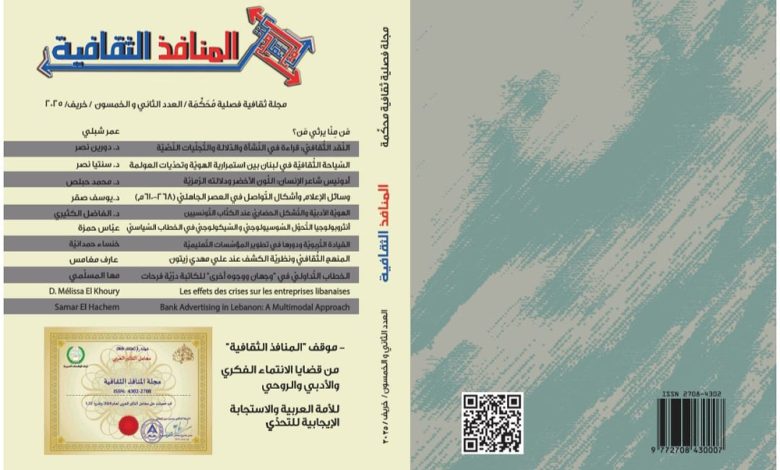
تجلّيات الثّورة في الشّعر النّسويّ: نازك الملائكة وفدوى طوقان أنموذجين
The Manifestations of Revolution in Feminist Poetry: Nazik Al-Malaika and Fadwa Tuqan as Models
الدّكتور محمّد حبلص[1]
Mohammad Hoblos
تاريخ الاستلام 4/ 5/ 2025 تاريخ القبول 30/ 5/2025
ملخّص البحث
يستكشف هذا البحث تجلّيات الرّمز الشّعريّ في نتاج نازك الملائكة وفدوى طوقان، بوصفهما من أبرز الأصوات النّسويّة في الأدب العربيّ الحديث، حيث شكّل شعرهما مرآةً عاكسة للتّحوّلات الاجتماعيّة والسّياسيّة التي عصفت بالعالم العربيّ خلال القرن العشرين. وقد تبيّن من خلال المنهج الوصفيّ التّحليليّ والمقارنة بين التّجربتين أنّ الرّمز الشّعريّ لم يكن مجرّد أداة جماليّة، بل تحوّل إلى وسيلة تعبيريّة فاعلة عن الثّورة والتّحرّر، وعن هموم المرأة والمجتمع على حدّ سواء.
أظهرت الدّراسة أنّ نازك الملائكة وظّفت الرّمز بأسلوب مباشر وتحريضيّ، يجسّد أصداء الثّورات الاجتماعيّة والقوميّة، فيما انطلقت فدوى طوقان من ذاتها وواقعها الفلسطينيّ لتشييد عالم رمزيّ يمتزج فيه الخاصّ بالعامّ، وينفتح على أبعاد إنسانيّة ووطنيّة عميقة. وقد أسهم هذا التّنوّع في إبراز ثراء التّجربة النّسويّة العربيّة، وتعدّد أشكال استجابة الشّعراء للأحداث المفصليّة في تاريخ الأمّة.
إنّ نتائج البحث تؤكّد أنّ الرّمز في شعر الملائكة وطوقان يتجاوز حدود النّصّ ليصبح أداة في صناعة الوعي الجمعيّ والوطنيّ، ودليلًا على الدّور المحوريّ للشّعر النّسويّ في التّعبير عن قضايا الحرّيّة والكرامة والتّمرّد على الاستبداد؛ وبذلك يُسهم هذا البحث في إثراء الدّراسات الأدبيّة والنّسويّة معًا، ويبرز قدرة الشّعر العربيّ الحديث على مواكبة التّحوّلات الكبرى عبر أفق رمزيّ واسع وفاعل.
الكلمات المفاتيح: القوميّة – الشّيوعيّة – فلسطين – الثّورة – الرّمز.
Abstract
This research investigates the manifestations of poetic symbolism in the works of Nazik Al-Malaika and Fadwa Tuqan, two of the most prominent feminist voices in modern Arabic literature. Their poetry reflects the profound social and political transformations that swept across the Arab world during the twentieth century. Adopting a descriptive-analytical approach and a comparative perspective, the study demonstrates that poetic symbolism was not merely an aesthetic feature but a dynamic medium of expression for revolution, liberation, and the collective concerns of both women and society.
The analysis reveals that Nazik Al-Malaika employed symbolism in a direct and provocative manner, embodying the spirit of social and nationalist revolutions. In contrast, Fadwa Tuqan drew on her personal experiences and the Palestinian reality to construct a symbolic universe where the personal intertwines with the collective, opening onto profound human and national dimensions. This diversity highlights the richness of Arab feminist poetry and the multiplicity of responses to the defining events of the Arab nation’s modern history.
The findings affirm that symbolism in the poetry of Al-Malaika and Tuqan transcends textual boundaries to serve as a tool for shaping collective and national consciousness. Moreover, it underscores the pivotal role of feminist poetry in articulating issues of freedom, dignity, and resistance to oppression. In doing so, this research contributes to the enrichment of both literary and feminist studies, while emphasizing the ability of modern Arabic poetry to engage with major historical transformations through a broad and dynamic symbolic horizon.
Keywords: Nationalism – Communism – Palestine – Revolution – Symbolism
المقدّمة
في مسيرة الأدب العربيّ الحديث، كان للشّعر النّسويّ حضور بارز تأثّر بالتّغيّرات الاجتماعيّة والسّياسيّة العميقة التي شهدتها المجتمعات العربيّة خلال القرن العشرين؛ ولعلّ أبرز ما ميّز هذا الشّعر هو تبنّيه لقضايا الثّورة والتّحرّر، خاصّة في إطار الصّراعات القوميّة والوطنيّة التي مثّلت محطّات فارقة في التّاريخ العربيّ الحديث. يتجلّى هذا بوضوح في شعر نازك الملائكة وفدوى طوقان اللّتين شكّلت تجاربهما الشّعريّة منطلقًا خصبًا للتّعبير عن المآسي الوطنيّة والاجتماعيّة، وعكستا بوعيّ رمزيّ عميق تجربة المرأة والشّاعر المناضل في آنٍ معًا.
تكمن أهمّيّة هذا البحث في استكشاف دلالات الرّمز الشّعري وديناميّته في ضوء التّحوّلات الاجتماعيّة، وكيف تجلّت هذه الدّيناميكيّة في خطاب نازك الملائكة وفدوى طوقان اللتين قدّمتا نماذج متميّزة عن الثّورات في شعر المرأة العربيّة؛ ذلك أنّ دراسة البنية الرّمزيّة في شعرهما تتيح فهمًا أعمق لمدى تأثر الشّعر النّسويّ بالأحداث السّياسيّة والاجتماعيّة، وتكشف عن اختلافات في الرّؤى والمواقف التي تتبنّاها كلّ من الشّاعرتين في تعبيرهما عن الثّورة والتّحرر.
يطرح البحث إشكاليّة رئيسة: كيف تجلّى الرّمز الشّعريّ في شعر نازك الملائكة وفدوى طوقان كأداة تعبير عن الثّورات الاجتماعيّة والسّياسيّة؟ وكيف انعكست هذه التّجلّيات في الاختلاف البنيويّ والدّلاليّ بينهما، لا سيّما في سياق الثّورات الشّيوعيّة والقوميّة والفلسطينيّة؟
ولتناول هذه الإشكاليّة، يتبع البحث المنهج الوصفيّ التّحليليّ، وذلك لدراسة الرّمز الشّعريّ في شعر نازك الملائكة وفدوى طوقان من خلال تحليل النّصوص الشّعريّة ودراسة بنيتها اللّغويّة والدّلاليّة، مع التّركيز على السّياق الاجتماعيّ والسّياسيّ الذي أفرز هذه النّصوص. كما يعتمد البحث على منهج المقارنة بين نتاج الشّاعرتين لتسليط الضّوء على الفروقات والتّقاطع في معالجة موضوع الثّورة ورمزيّتها في شعرهما.
المبحث الأوّل: ديناميّة الرّمز الشّعريّ في ضوء التّحوّلات الاجتماعيّة للشّعر العربيّ الحديث
إنّ المجتمع العربيّ في الجاهليّة، وفي عصور الخلافة الإسلاميّة المتنوّعة، وصولاً إلى زماننا الحاضر، مليءٌ بمشاهد الحروب بين العرب، وهي حروبٌ قبليّة، وحزبيّة سياسيّة ومذهبيّة، وبين العرب والعدوّ الأجنبيّ الذي كان يغزو بلادهم لأهداف استعماريّة وطمعًا بثرواتهم، وقد سجّل الشّعر العربيّ هذه الحروب في كلّ مراحلها، فهو يعدّ “ضربًا من السّحر”[2]؛ فلا نكاد نجد حقبة من تاريخ العرب لم يواكب الشّعر أحداثها، ويصوّر بعضًا من مشاهد حروبها، ومن البداهة إذن أن يحفل الشّعر العربيّ في كلّ العصور بمشاهد الدّم والقتال في المعركة، وهذه البداهة المفترضة نجدها حقيقة ماثلةً في الشّعر الجاهليّ المصبوغ بصبغة الفروسيّة والحرب والطّعن والثّأر والدّم.
ومع تعاقب العصور، تغيّر الأسلوب الشّعريّ في تصوير هذه المشاهد، تبعًا لاختلاف البيئة التّاريخية والاجتماعيّة والفكريّة، حتّى جاء العصر الحديث الذي ينتمي إليه موضوع بحثنا، فحمل معه روح الحداثة وأساليبها في التّعبير. وقد استطاع الشّعراء المحدثون أن ينقلوا وقائع الحروب والثّورات بأسلوب فنّيّ مبتكر ينسجم مع روح الحداثة، يجمع بين التّصوير الخارجيّ للمعركة، وما يعتمل في أعماق الشّاعر من مشاعر الأسى والألم تجاه المآسي الإنسانيّة التي ترافقها…
ولم يكن هذا التّطوّر في التّعبير ليتحقّق لولا لجوء الشّعراء إلى لغة الرّمز، بوصفها أداة إيحائيّة قادرة على احتواء المعنى العميق وتجسيده في صورة شعريّة مكثّفة، إذ يشكّل الرّمز في التّجربة الشّعريّة المعاصرة أداةً فنّيّة يتجاوز بها الشّاعر حدود المعنى المباشر إلى فضاءات أرحب من التّأويل، مستعينًا بالسّياق الاجتماعيّ والسّياسيّ والثّقافيّ لتكثيف دلالاته، وليربطه في الوقت نفسه بقضايا العصر وهموم الإنسان.
فالرّموز الثّوريّة في الشّعر الحديث لم تنشأ من فراغ، بل تكاد دلالتها تكون عالميّة منتشرة بين الشّعوب كافّة، فقد وظّف الشّعراء العرب هذه الرّمزيّة في شعرهم للدّلالة على رمزيّة الجهاد والكفاح، ورمزيّة الدّم الذي يسيل مسفوكًا في سبيل الأرض والوطن والكرامة.
ولم يكن أهل الحداثة المبتكرين الأوائل للرّمزيّة الثّوريّة، إذ ثمّة من سبقهم إلى هذه الرّمزيّة الثّورية من شعراء النّهضة، حيث اندلعت الثّورات في تلك الحقبة ضدّ الغزاة الأوروبيّين، الإنكليز والفرنسيّين، فثار العرب على الاحتلال الذي اغتصب الأرض والسّلطة العربيتين مقنَّعًا بقناع الانتداب والرّعاية هادفًا إلى تمزيق جسد العروبة وجَعْلِهِ أقطاراً ضعيفة متناحرة غير متضافرة، وقد وصل الاحتلال إلى هدفه بمكره وقوّة آلته الحربيّة التي اخترعتها الثّورة العلميّة في أوروبا، في حين كان العرب قد خرجوا ضعفاء من تحت سلطة الاحتلال العثمانيّ، لا يملكون حولاً ولا قوّة، ولكنّهم على الرّغم من ضعفهم ثاروا على الإحتلال الإنكليزيّ والإحتلال الفرنسيّ في الأقطار العربيّة كلّها، وقدّموا قوافل الشّهداء فداءً للوطن والحرّيّة.
لقد واكب الشّعر العربيّ النّهضويّ هذه الثّورات فمجّدها، وصوّر كرم الثوّار وبسالتهم، وفي طليعة الشّعراء النّهضويّين الذين كتبوا الشّعر الثّوريّ الجهاديّ، هو أميرهم أحمد شوقي، حيث حفلت قصيدته الشّهيرة (نكبة دمشق) بالمعاني الثّوريّة الجهاديّة، وفيها جعل اللّون الأحمر رمزًا للثّورة والشّهادة والحرّيّة:
دم الثوّار تَعرفُهُ فرنسا وتعلمُ أنّه نورٌ وحقُّ
وللحريّة الحمراءِ بابٌ بكلِّ يدٍ مضرّجةٍ يُدَقُّ([3])
تظهرُ واضحةً العلاقة القويّة، في هذين البيتين، بين اللّون الأحمر والدم والثّورة والحريّة، إنّ الثّورة الحقيقيّة المنتجة هي الثّورة التي تبذل الدّماء في ميدان البطولة؛ لأنّ الدّماء هي التي تحرّر الأرض وتصون العِرْض وتصنع الحرّيّة، لهذا تبدو الحرّيّة- كما وصفها شوقي- مصبوغةً بدم الشّهداء، فنراه في هذين البيتين من قصيدته (نكبة دمشق) يضع المبادئ التي ينبغي أن يلتزم بها الشّعب، في أيّ مكان أو زمان، إذ ما أراد صناعة الحرّيّة.
إنّ الحرّيّة التي يؤمن بها شوقي هي حرّيّة موصوفة لا تشوبها شائبةٌ، وغير خاضعة للتّأويل، وإلّا فتكون مزيّفة، هي لا تفتح بابها إلاّ إذا طرقته يد مضرَّجةٌ بالدماء، وإلّا فهي تُفضّل أن تظلّ غائبة عن الأعين؛ إنّها لا تعرض جمالها إلا إذا دُفِعَ ثمن إطلالتها غالبًا، إلاّ إذا دُفِعَ دماءً ومُهجًا.
وهكذا، يُحكمُ شوقي الرّبط بين الحرّيّة من جهة والثّورة والدّم من جهة أخرى، فكلّ ثورة غير حمراء لا تصنع حرّيّةً حمراء، وقد وفِّق شوقي في توظيف اللّون الأحمر، فيما سبق، ونشهد له بأنّه قد لفت انتباه جماعة الحداثة إلى الدّلالة الثّوريّة الكامنة فيه، فاستثمروا هذه الدّلالة في قصائد كثيرة لمآرب ثوريّة وتحرّريّة ذات مضامين وطنيّة وقوميّة وإنسانيّة، مختلفين عن شوقي في أسلوب الكتابة وصولاً إلى الغاية نفسها، وهذا الاختلاف أمرٌ بَدَهيّ؛ إذْ إنّ كلَّ شاعر يُظهر في شعره سمات عصره، فلا يمكن للشّاعر أن يخرج من مجتمعه، ويتجاوز حدود عصره، فاللّغة “تكون كلًّا واحدًا، إنّها نظام، وقيمة كلّ عنصر لا تتعلّق به بسبب طبيعته أو شكله الخاصّ ولكن بسبب مكانه وعلاقاته ضمن المجموع”([4]).
فشعراء النّهضة يشتركون جميعًا في لغة نهضويّة مع اختلاف في السّياق الشّعريّ الذي به يُعرف الشّاعر ويميَّز عن أقرانه؛ وكذلك جماعة الحداثة يشتركون جميعًا في لغة الحداثة، لغة الرّمز، ويختلفون في السّياق الشّعريّ؛ والدّليل أنّ شعراء الحداثة جميعًا وظّفوا الرّموز في شعرهم بيد أنّ هذه الرّموز أدّت وظائف مختلفة وفاقًا لاختلاف سياقاتها، فكثيرون، على سبيل المثال، قد وظّفوا في شعرهم رمزيّة الفينيق، وعشتار، وتمّوز، ولكنَّ رمزيّة هذه الأساطير لم تأتِ نفسَها، بل تغيّرت دلالتها وفاقًا لاختلاف الموضوع والسّياق والغاية التي رمى إليها الشّاعر، وكذلك رمزيّة الألوان تختلف من شاعر إلى آخر، فالّلون الأحمر قد يرمز عند شاعر إلى الحبِّ وعند آخر إلى الثّورة؛ فالكلمة “هي وجود وحضور له كيان وجسم، وهي قطعة من الوجود أو وجه من وجوه التّجربة الإنسانيّة، ومن ثمّ فإنّ لكلّ كلمة طعمًا ومذاقًا خاصًّا”([5]).
والثّورة ليست هي هي عند الشّعراء جميعًا فثمّة ثورة وطنيّة، وأخرى قوميّة، أو ثورة مصبوغة بصبغة أيديولوجيّة، ثمّ إنّ الشاعر يوظّف رموزه الشّعريّة فيما يخدم أفكاره ومبادئه، ولا يمكن أن يكتب أحدٌ ما يخالف عقيدته، وإن حصل، فهو حينئذ يصير دجّالاً، منافقًا وتنتفي عنه صفة الشّاعر والأديب.
إنّ الاختلاف في دلالة الرّمز الواحد، مردُّهُ إلى اختلاف المبادئ والعقائد عند الشّعراء، وهذا الاختلاف الدّلاليّ في وظيفة الرّمز نفسه، هو دليل ساطع على الطّاقة الدّلاليّة الكامنة في الرّموز، وهذه الطّاقة هي التي بعثت لغة الشّعر من بلادتها، وأعطتها قدرة على الإحاطة بالأحداث؛ فالرّمز، مهما كان نوعه، يولّد طاقات إيحائيّة لما يرمز إليه ويحمله من رؤى، سواء أكانت تتطلّع إلى مفاهيم فكريّة أم جماليّة؛ ولكي يُشحن بدلالات خصبة يحتاج الرّمز إلى تأسيس في إطار لغة النّصّ الشّعريّ، وبصورة أدقّ إلى تركيبه في سياق ينتظم فيه زمانيًّا ومكانيًّا، ويكون منه مركز الإشعاع في الصّورة”[6].
المبحث الثّاني: البنية الرّمزيّة في خطاب نازك الملائكة الشّعري بين التّحريض والتّمرّد
أوّلًا: المعاناة والثّورة في الرّمز الشّعريّ عند نازك الملائكة
إنّ الشّاعر حين يعيش من دون معاناة يعيش من دون قضيّة؛ فأيّ قضيّة هي انبثاق من واقع اجتماعيّ بيئيّ يعيش فيه الشّاعر، مدركًا ما يجري حوله من أحداث متألَّمًا ومتحسّرًا؛ فإنّ الشّعر الهادف ينبثق من الألم، من المعاناة، ولا ينبثق من الفرح والتّرف؛ والأمثلة على أنّ الشّعر يولد من رحم المعاناة كثيرة في الأعمال العربيّة والأجنبيّة، وليس الشّعر وحده يولد هذه الولادة، بل الإبداع في كلّ شيء لا يتكوّن إلاّ في بيئة الألم والعذاب، ولهذا نجد أنّ الكثير من المبدعين العرب وغيرهم التصقوا بالقضيّة الفلسطينيّة، وعبّروا عنها في مجالات مختلفة، فهم وجدوا في معاناة الشّعب الفلسطينيّ ما يلامس أفئدتهم ويثير شعورهم الإنسانيّ، ويحفّز ملكة الإبداع فيهم على العطاء.
مثلما التصق المبدعون بمعاناة الشّعب الفلسطينيّ، التصقوا كذلك بمعاناة الشّعوب الأخرى غير مهتمّين بالقوميّات والأديان، بل اهتمّوا فقط بما يحرّك فيهم إنسانيّتهم، ويُدمي قلوبهم، ويُبكي أعينهم، وبما أنّ الثّورة في جوهر معناها هي جهاد وشقاء ومعاناة، فقد التصق المبدعون بكلّ ثورة من ثورات الشّعوب؛ فهي “ظاهرة اجتماعيّة ذات هدف سياسيّ، وظاهرة إيديولوجيّة (سياسيّة) ذات هدف اجتماعيّ يتمثّل بتغيير المجتمع (…) ومن الثّورات ما حدث ببطء وسلام تحت تأثير التّقدّم العلميّ والخلقيّ، ومنها ما حدث فجأة عقب اضطرابات وسفك دماء مقودة إمّا بمغتصب أغرى فئة من النّاس على تحقيق مطامعهم، وإمّا محرّكة بإرادة الأمّة كلّها”[7]، ويمكن “أن ننظر إلى التّمرّد كحلقة أولى في العمليّة الثّوريّة، بالنّبة إلى الفرد أو المجتمع، ولكنّ التّمرّد لا يكون منطقيًّا ولا يكون إنسانيًّا إن لم تكمله الثّورة”[8]؛ ولأنّ هذه الثّورات، كالثّورة الفلسطينيّة، تسعى إلى الحقّ والحريّة والعدالة، تسعى إلى هذه القيم الحياتيّة التي لا يمكن أن يحيا الإنسان من دونها حرّاً وكريمًا. وتدوم الثّورات ما دامت الحياة؛ لأنّ الحياة لا يمكن أن تخلو من الظّلم والظّالمين؛ لهذا يلجأ المستضعفون في أصقاع الأرض وأقطارها إلى الثّورة على الظّالم والطّاغية.
وفي القرن العشرين، قرن الثّورات العربيّة في العراق ومصر وسوريّا، وقرن الثّورات العالميّة، تحمل نازك الملائكة رمزيّة الثّورة الشّيوعيّة، ويتجلّى احمرار هذه الثّورة في قصيدتها (ثلاث أغنيات شيوعيّة)، إذ حملت رموزها بعدًا تحريضيًّا يوقظ الوعي الجمعيّ، وتمرّدًا على أنماط القول الموروثة؛ لتُعيد صياغة العلاقة بين الشّاعر والواقع في بنية لغويّة مشحونة بالإيحاءات؛ تقول:
تحيّةً شقائقَ النعمانْ
يا أختنا الحمراءْ
يا شفةً ساخنة الألوانْ
مترعةً دماءْ
أختاهُ أنتِ أشرف الورودْ
رمز الدّمِ المراقْ
يا لون ما تضمر من حقودْ
محرقة الأشواق([9]).
إنّ رمزيّة شقائق النّعمان إلى الدّماء لم تولد عند الملائكة من العدم، بل ترجع جذورها التّاريخيّة إلى الميثولوجيا البابليّة، فهي ترمز إلى دماء تمّوز القتيل الذي افترسه الخنزير البرّيّ، فسقت دماؤه الأرض فأنبتت شقائق حمراء، وقد وظّفت الملائكة شقائق النّعمان في سياق شعريّ رمزيّ جديد، وجعلت حُمْرة الشّقائق رمزًا إلى راية الثّورة الشّيوعيّة وإلى دماء الثّوّار الشّيوعيّين، معلنة حبّها للثّورة وللرّفاق الذين تجمعها بهم أخوّة النّضال وأخوّة الدّماء بالمعنى الثّوريّ وليس بالمعنى العرقيّ.
إنّ الثّورة الشّيوعيّة هي أخت الشّاعرة وكذلك الثّوّار الشّيوعيّون هم إخوتها، وشقائق النّعمان هي عندها أشرف الورود: (أختاهُ أنتِ أشرف الورودْ)، وهذا الشّرف العظيم الذي تفوز به الشّقائق على الورود كلّها في تعبير الملائكة ليس لأنّها الأجمل، وليس لأنّها حمراء متجرّدة، بل لأنّها تحمل رمزيّة الدّماء، لأنّها مترعة دماء: (يا شفةً ساخنة الألوانْ/ مترعةً دماءْ).
وبدهيُّ أن تكون الشّقائق مترعةً دماءً؛ لأنّ رمزيّتها الدّمويّة في ذاكرة الشّاعرة وثقافتها متّصلةٌ بالتّاريخ البابليّ الميثولوجيّ، وبدهيٌّ كذلك وجود الميتولوجيا Mitologique في شعر الملائكة، فهي من الشّعراء الأوائل الذي وضعوا المداميك الأولى للحداثة في الشّعر العربيّ، فكان الاتّجاه إلى الرّموز في الأساطير والتّاريخ الواقعيّ من أجل تخصيب لغة الشّعر وبَعْثِها خضراء مثمرة بعد مدّة طويلة من اليباس والعقم، وكان الاتّجاه كذلك إلى تجاوز النّظام العروضيّ الخليليّ، وابتكار نظام التّفعيلة وجَعْلِهِ نظامًا جديداً لكتابة الشّعر.
وقد كتبت نازك الملائكة قصيدتها (ثلاث أغنيات شيوعيّة) تطبيقًا لهذا النّظام؛ فلا نلحظ في قصيدتها المذكورة التي ندرسها ههنا حضوراً للنّظام القديم، إذْ لا توجد فيها وحدة البيت والرويّ، بل ثمّة جملٌ شعريّة حلّت محل الأبيات وهذه الجمل تؤلّف المقاطع، وفي كلّ مقطع نلحظ الرّويّ المتنوّع، والمقطع الشّعريّ السّابق هو مثال هذا التّنوّع:
النّعمانْ/ الحمراءْ/ الألوانْ/ دماءْ/ الورودْ/ المراقْ/ حقودْ/ الأشواق.
ونلحظ كذلك كيف تحطّم البناء القديم في كتابة الشّعر، إذ نسفت الشّاعرة البيت ذا الشّطرين، والتزمت الجملة الشّعريّة، فلم تساو في عدد التّفعيلات:
تحيّةً شقائقَ النّعمانْ
//O// O //O//O / O/ O O
يا أختنا الحمراءْ
/ O / O // O / O/O O
الجملة الأولى تتألّف من تفعيلتين وجزء من الثّالثة، والجملة الثّانية تتألّف من تفعيلة وجزء من الثّانية؛ وكما التّنوّع في الرّويّ، كذلك نلحظ التّنوّع في التّفعيلات، فلم تلتزم الشّاعرة تفعيلة واحدة، بل استعملت في القصيدة نفسها تفعيلة المتقارب والرّجز والسّريع والرّمل.
ثانيًا: الثّورة الشّيوعيّة في البنية الرّمزيّة لشعر نازك الملائكة
إضافة إلى التّحديث في اللّغة والعروض ثمّة التّحديث الأفعل، وهو التّحديث في المضمون؛ حيث طرقت نازك الملائكة موضوعًا حديثًا في ذاك الزّمان وهو الثّورة الشّيوعيّة التي كان لها صداها في أقطار العالم، ومن بينها العراق الذي انتشر الفكر الشّيوعيّ بين مثقّفيه، وفي طليعتهم الملائكة والسّيّاب والبياتيّ؛ ونحن “لو أمعنّا النّظر في حقيقة الفنّ من حيث هو تعبير إنسانيّ وجدناه من البداية شديد الارتباط بالعقيدة”[10].
إنّ هذه القصيدة التي ندرسها ههنا ما هي إلّا تأكيد على دويّ الشّيوعيّة، في نفوس المثقّفين العراقيّين، وتنحو الملائكة في هذه القصيدة منحىً تعبيريًّا مفعمًا عنفًا وقسوةً وتطرّفاً دفاعًا منها عن الثّورة والتزامًا بمبادئها:
يا حمرةً القتل لك الدّماء
فاغرةً الجراحْ
إن تظمأي فبالدّم المنعش أختاهُ لا نبخلْ
هيهات يا حمراءُ أن تعطشي وثمّ من نقتلْ
من أجل هذا اللّون نجزي النجيعْ
جداولاً تنثالْ
وباسمه نقتل حتّى الرّبيع.
ونذبح الأطفال([11]).
تغلو الملائكة في هذا المقطع الشّعريّ، وهي تعبّر عن التزامها بالثّورة الحمراء، إنّها ورفاقها الشّيوعيّين عازمون على قتل الرّبيع بما يمثّل من جمال وبراعم ترمز إلى الحياة والأمل، فالرّبيع يرمز إلى “التّجدّد والأمل، يرتبط- وخصوصًا النّاضر منه- بالنّماء، ويرمز للحياة والوفرة والخير”([12])، والشّعرة ورفاقها الشّيوعيّون عازمون على ذبح الأطفال الذين يمثّلون البراءة والحبّ والسّلام دفاعًا عن الثّورة الحمراء التي كانت في أيّامها أمل الكادحين والفقراء، وأمل المثقّفين الثّوريّين بحياة كريمة.
إنّ نازك الملائكة تعلن التزامها بالمبادئ الشّيوعيّة، واستعدادها لبذل الدّماء في سبيل تحقيقها، و”مهما استخفى الشّاعر وراء الرّمز والاستعارة والعلاقات اللّغويّة المتكرّرة التي تنتمي إلى العالم الشّعريّ فإنّه يظلّ حاضرًا، ويظلّ لحضوره فعّالية خاصّة، واستبعاده من إطار رؤيتنا يفوّت علينا بُعدًا من أهمّ أبعاد القصيدة”[13].
وتخاطب الشّاعرة الثّورة داعيةً إيّاها إلى عدم الخوف من الأيّام القادمة على مصيرها واستمرار اشتعالها؛ لأنّ الشّيوعيين حاضرون لإنعاشها حين تحتاج الإنعاش- بالدّم الذي يجري في عروقهم، ثمّ ينسفح على أرض الفداء؛ لتبقى الثّورة حيّةً في النّفوس، وحاضرون، كذلك، لإزالة عطشها بدماء الأعداء، وفي هذه الصّورة الدّمويّة إشارة من نازك الملائكة إلى أنّ الشّيوعيّين سيُسرفون في سفك دماء أعدائهم بغير رأفةٍ ولا رحمة، وإشارة إلى قوّة التزامها بالثّورة ومبادئها. والحقّ، أنّ “الفنّ سيظلّ – كما كان دائمًا – عمل الفرد المبدع، ولكنّ هذه الخاصّة الفرديّة لا تتعارض -كمت لم تتعارض من قبل- مع العقيدة الجماعيّة”[14].
إنّ الشاعرة تشارك رفاقها ثورتهم، وتخوض معهم معركة النّضال بصلابة شديدة وإيمان ثابت بمبادئ الثّورة الشّيوعيّة، ولا يمكن التّمييز والإيثار بين الثّوّار، وإن اختلفت لديهم أسلحة الكفاح الثّوريّ، فليس ثمّة فرق بين مَن يقاتل بفكره وفنّه، ومن يقاتل ببندقيّته؛ لأنّ الثّورة النّاجحة هي كلٌّ متماسك لا يتجزأ في الميدان، وإذا دخلنا في التّجزئة والتّمييز بين الأجزاء، فإنّنا حينئذٍ نجعل الثّورة ترتبك وتتعثّر؛ فإنّ كلّ عضوٍ من أعضاء الثّورة هو بحاجة وظيفيّة وفعليّة إلى العضو الآخر، وتتشارك الأعضاء جميعًا في الأداء فيكون العمل النّاجح ويتحتّم النّصر؛ وكما لا يمكننا التّمييز بين الأعضاء في الوظيفة؛ كذلك لا يمكننا أن نعدّ الوظيفة التي يؤدّيها هذا العضو هي أكثر خطرًا وشقاءً من تلك التي يؤدّيها عضوٌ آخر.
إنّ الشّاعرة شريكة في الثّورة كما سائر أبناء أمّتها؛ فالعامل بثورته ينتج أعمالًا، والشّاعر بثورته يخلق شعرًا، والعالِم يثور بفكره وعلمه… لكلٍّ مجاله الذي يجسّد فيه صوته الثوريّ، غير أنّهم جميعًا يلتقون في نهرٍ واحد هو حركة الثّورة الكبرى. يمارس الشّاعر ثورته بالكلمة، وإن أمكن له أن يجسّدها بالفعل، كما يمارس العامل ثورته بالكدح، وإن استطاع أن يترجمها شعرًا.
هذه الوحدة الثّوريّة المتكاملة التي لا تقبل التّجزيء، في رأي أدونيس، شبيهة بالسّيمفونيّة التي تقدّم للجمهور وحدة موسيقيّة متكاملة لا تقبل التّفكيك، ويشترك في أدائها أعضاء مختلفون في الوظائف، ولكن لكل عضو تميّزه في الإبداع. وعلى الرّغم من عدم التّفضيل بين أعضاء الثّورة في القيمة الثوريّة، بيد أنّ للشاعر ما يميّزه في الأدب، إذ إن أدواته في كتابة الشعر هي التي تحدّد ثوريّته.
لكنّما “الأدوات التي ينتجها العامل في المصنع، تلبّي حاجات نفعيّة يوميّة في الحياة العمليّة، من ضمن علاقات إنتاج معيّنة؛ فهي لا توجّه إلى وعي الجماهير، بل تدخل في نظام علاقات الإنتاج والاستثمار. أمّا الأدوات التي ينتجها الشّاعر باللّغة، فمن المفروض أنّها تتوجّه إلى الوعي لتغييره فهي تؤدّي دورًا مزدوجًا، داخل وعي الجماهير من ناحية، وداخل حركة الشّعر في الوقت نفسه”([15])، وبقدْر ما يُبدع الشّاعر في صناعة الأدوات يُبدع في كتابة القصيدة؛ وتختلف الأدوات المنتجة في كتابة الشّعر عند الشّعراء فلكلّ شاعر أدواته التي يعبّر بها عن موضوعاته التي يختارها، ومثالُ هذا الرّأي موضوع الثّورة في الشّعر العربيّ الحديث، حيث نجد أنّ هذا الموضوع عُبّر عنه بأدوات مختلفة؛ فمن الشعراء مَنْ عبّر عنه تعبيرًا رمزيًّا، ومنهم مَنْ عبّر عنه تعبيرًا ليس فيه للرّمز وظيفة. والواقع، أنّ “اللّغة أشبه بحقل فارغ خصب، والشّاعر هو الفلّاح الموهوب الذي يستنبت منه أشجار الرّمّان والمشمش واللّيمون”[16].
وكذلك تختلف الرّموز عند الشّعراء في التّعبير عن موضوع الثّورة، فنازك الملائكة وظّفت اللّون الأحمر في التّعبير عن الثّورة الشّيوعيّة وثمّة من يشاركها هذا التّوظيف الرّمزيّ، وثمّة من يخالفها، وقد وُفّقت نازك الملائكة في اختيارها اللّون الأحمر رمزًا للتّعبير عن الثّورة الشّيوعيّة، فهذا الرمز يدلّ على الرّاية الشّيوعيّة (الرّاية الحمراء)، ويدلّ كذلك على دماء الشهداء الذين يموتون على أرض معركة الثّورة فداءً للأهداف التي يناضلون في سبيلها، و”يتميّز اللّون الأحمر عن بقيّة الألوان بأنّه يُستخدم بكثرة في إشارات التّحذير والإنذار؛ والسّبب في ذلك أنّه لونٌ ملفت للانتباه، حيث يكوّن استجابة للإنذارت أكثر من أي لون آخر لدى العقل البشريّ، فإنّ اللّون الأحمر يُشعر الشّخص بأنّه في وضع يحتّمُ عليه الحذر أو التّأهّب([17]).
إنّ اللّون الأحمر في قصيدة نازك (ثلاث أغنيات شيوعيّة) يحمل رمزيّةً مزدوجة: رمزيّة المبادئ، ورمزيّة الممارسة الثّوريّة على أرض المعركة ضدّ الطّغاة الذين يسخّرون الشّعوب ويضطهدونهم، الذين يسلبونهم تعبهم وحقوقهم، ويقتلون أحلامهم الصّغيرة؛ ليبقوا هم أهل السّلطة والبذخ، يعيشون في القصور منعّمين، ولا يبالون بمن يعيشون في الأكواخ معذّبين متألّمين؛ لهذا نحت نازك في قصيدتها منحىً عنفيًّا في التّعبير عن الثّورة الشّيوعيّة:
“من أجل هذا اللّون نجزي النجيعْ
جداولًا تنثالْ
وباسمه نقتل حتّى الربيع
ونذبح الأطفال([18])
إنّ هذا المنحى يعبّر عن رغبة الشّاعرة الجامحة بالقتل وسفك الدّماء، رغبة لا تستثني الأطفال، ويؤكّد حقدها على أعداء الثّورة؛ ثمّ إنّ هذه الرّغبة الدّمويّة عند نازك الملائكة ترتقي بغلوّها إلى مستوى الرّغبة الدّمويّة الكامنة في نفوس الصّهاينة الذين عبّروا عنها قولًا وعملًا.
ونقول: لا تستطيع الملائكة أن تسوّغ رغبتها بقتل الأطفال دفاعًا عن الثّورة مهما تكن أهدافها عظيمة ونافعة؛ لأنّ قتل الطّفولة البريئة جريمةٌ تُلغي كلّ أعذار القاتل وتُبطل حججه، فقتل الأطفال أو الدّعوة إلى قتلهم عارٌ على رجال الحرب، فكيف إذا عبّرت شاعرةٌ، وهي الّتي ينبغي أن تتّصف بالرّقة والرّأفة أكثر من الرّجل، عن رغبتها بسفك دماء الأطفال.
ولا شكّ أنّ هذا التّعبير سيحدث صدمة صاعقة في النّفس الإنسانيّة، وإنّ الشّاعرة نازك الملائكة كان عليها ألّا تصل إلى هذا المستوى من الغلّو الثّوريّ الذي صبغها بصبغة الإجرام والانحراف وتجاوز المألوف والأعراف؛ وجعلها تصبّ لعناتها على العرب جميعًا حينما رأت حلمها الأحمر يتهاوى أمام عينيها:
“وتهاوى حلمي الأحمرُ للأرض ترابًا لاعنًا تسعين مليون محيّا
عربيًّا عربيًّا عربيّا”([19]).
إنّ شاعرتنا الملائكة تصبّ نار ثورتها الشّيوعيّة الحمراء غاضبة لاعنة على كلّ العرب لم تستثن أحدًا منهم، وهذا غلوٌّ منها غير مبرّر، إذ لا يجوز أن يحمل العرب كلّهم أوزار فشل الثّورة على الأنظمة الرّجعيّة المتخلّفة- كما كانت تلك الأنظمة توصف بلغة ذاك العصر- بل في كلّ أمّة هناك مناضلون مخلصون متفانون في سبيل قضاياهم الوطنيّة القوميّة، وهناك متخاذلون ومأجورون لا همّ لهم سوى أن يعيشوا الحياة ولو كانت حياة ذلّ وصغار، ثمّ إنّ نازك الملائكة كان عليها ألّا تعظّم المبادئ الشّيوعيّة الماركسيّة وتحفّز العنف؛ إنّ هذا السلوك سلوكٌ ملتوٍ، إذ لا يمكن لفكر مهما عظم شأنه أن يلغي الرّوح القوميّة عند الأمم، والرّسالات السّماويّة لم تقم بهذا الفعل الإلغائيّ؛ لهذا كان من الواجب “أن يتعلّم الماركسيّون العرب من ماركسيي الأمم الأخرى أنّ المعارك الكبرى هي دائمًا معارك قوميّة: معارك بين أمم وجماعات، وأنّ الوطن أهمّ من النّظام، وأنّ الأمة أعظم من العقائد والإيديولوجيّات”([20]).
المبحث الثّالث: التّحوّلات الدّلاليّة للرّمز الثّوريّ في نِتاج فدوى طوقان
أوّلًا: الحرّيّة والرّمز الوطنيّ في شعر فدوى طوقان
إذا كانت نازك الملائكة قد قدّمت في شعرها خطابًا رمزيًّا مشحونًا بروح التّمرّد والتّحريض، فإنّ التّجربة الشّعريّة لفدوى طوقان تبرز هي الأخرى كصوتٍ أنثويّ متمرّد، لكنّ تمرّدها لا ينطلق من رؤية فلسفيّة مجرّدة أو من موقف أيديولوجيّ أمميّ، بل يتّخذ بعدًا وطنيًّا وجوديًّا، يستمدّ قوّته من صميم المعاناة الفلسطينيّة الفرديّة والجماعيّة على حدّ سواء. هذا البعد الوجوديّ لا ينفصل عند طوقان عن بعدها الوطنيّ، إذ تتشابك تجربة الذّات مع تجربة الأرض والشّعب، حتّى تصبح الحرّيّة التي تنشدها هي ذاتها حرّيّة فلسطين بأكملها.
ومثال ذلك نجده جليًّا في قصيدتها “حرّيّة الشعب“، حيث تصف علاقتها بحرّيّتها المتوهّجة في أعماق نفسها، فتجعلها هدفًا نضاليًّا محفورًا في كلّ زاوية من الوطن، على الجدران، في الأبواب، في شرف المنازل، بل في أماكن العبادة والمزارع والطرقات، وفي السّجون والمشانق. هذا الانتشار المكانيّ للحرّيّة في النّصّ يشي بأنّها ليست فكرةً معنويّة مجرّدة، إنّها كيان حيّ مغروس في التّراب والحجارة وأروقة البيوت، يتنفّس مع أنفاس النّاس ويشاركهم آلامهم وآمالهم؛ تقول:
سأظلُّ أحفر اسمها، وأنا أناضلْ
في الأرض في الجدران في الأبواب
في شُرَف المنازلْ
في هيكل العذراء في المحراب في طرق المزارعْ
في كلّ مرتفعٍ ومنحدرٍ ومنعطفٍ وشارعْ
في السّجن في زنزانة التّعذيب.
في عود المشانقْ
رغم السّلاسل رغم نسف الدّور
رغم لظى الحرائق
سأظلُّ أحفر اسمها حتى أراهْ
يمتدّ في وطني ويكبر
ويظلُّ يكبرْ
حتى يغطّي كلّ شبرٍ في ثراهْ
حتى أرى الحرّيّة الحمراءَ
تفتح كلَّ بابْ
والليلُ يهربُ والضّياءُ
يدكُّ أعمدة الضّبابْ([21])
لا ريب في أنّ الشّاعرة فدوى طوقان تحاكي شوقي في وصفها حرّيّتها، إذ صبغتها بصبغة اللّون الأحمر واستحضرت الباب الذي جعله شوقي مدخلاً للحرّيّة الحمراء، وهو- كما وصفه- بابٌ موصد لا يَدقّه إلّا اليد المضرّجة بالدّماء الثّوريّة، بيد أنّ طوقان لم تجعل محاكاتها شوقي نقلاً وتقليدًا، بل أخذت من أمير الشّعراء (الحرّيّة الحمراء والباب) ووضعتهما في سياق نصّيّ جديد وولّدت منهما معنىً جديدًا لا نلحظه عند سابقها، إذ إنّ الحرّيّة الحمراء عند شاعرتنا طوقان هي الحلم الفلسطينيّ العامّ الذي يتمنّى تحقيقه كلّ فلسطينيّ، هي الحرّيّة التي تحلم الشّاعرة أن تراها تفتح كلّ باب لبيت على أرض وطنها، و”الحرّيّة الحمراء عند طوقان، تلدها الثّورة التي لا تتجاوز رفض الواقع إلى محاولة تقويضه وبناء واقع جديد”[22]؛ وهنا، نلحظ اختلاف الغاية الشّعريّة بين شوقي وطوقان إذ تبدو الحرّيّة عند شوقي ذات باب مغلق أمّا عند فدوى طوقان، فهي تفتح أبواب المضطهدين والمستعبدين.
فالحرّيّة الحمراء عند شوقي رمزٌ عامّ، مفتوح على كلّ قضيّة إنسانيّة، غير محصور بحدود ولا مصبوغ بصبغة، بيد أنّها عند طوقان الحلم الفلسطينيّ المشترك، محدودة بحدود الوطن ومصبوغة بصبغة فلسطين الجريحة، الأسيرة، المتألّمة، وهي الخلاص الذي تنشده الجماعة من الاحتلال، وهي النّور الذي يفتح الأبواب المغلقة في وجه المضطهدين والمستعبدين. هذا التّحديد المكانيّ والوجدانيّ يجعل من الحرّيّة في شعرها قيمة مرتبطة بالأرض والبيت والذّاكرة، لا بفكرة مجرّدة عابرة للحدود.
وعلى خلاف شوقي الذي جعل الحرّيّة بابًا مغلقًا ينتظر من يسعى لفتحه، فإنّ طوقان ترى أنّ هذه الحرّيّة هي التي تسعى إلى عشّاقها في وطنها فلسطين، تفتح أبوابهم في ثورة فلسطينيّة مشتعلة، معلنةً تحرير الأرض المغتصبة من قيود الغزاة؛ لتعلن بداية التّحرير وزوال القيود. هنا، تتحوّل صورة الباب من رمز للعقبة إلى رمز للانفتاح، ويتحوّل اللّون الأحمر من مجرّد دلالة على التّضحية إلى هويّةٍ كاملة للثّورة الفلسطينيّة.
إنّ الفرق بين الرّؤيتين يكمن في أنّ شوقي يقدّم خطابًا إنسانيًّا عامًّا، في حين تقدّم طوقان خطابًا وطنيًّا ذا خصوصيّة، ممهورًا بدماء الجرح الفلسطينيّ، ومرهونًا بذاكرة الاحتلال والمقاومة، وكأنّها تقول إنّ الحرّيّة الحمراء لا يمكن أن تكون حياديّة أو مجرّدة حين تكون فلسطين هي الميدان.
ثانيًا: رموز الثّورة والمقاومة في شعر فدوى طوقان
إذا كانت الحرّيّة الحمراء قد شكّلت في شعر فدوى طوقان الرّمز الأبرز لتطلّعات الشّعب الفلسطينيّ في الخلاص والتّحرّر؛ لأنّها تتّصل بالقضيّة الفلسطينيّة وتعبّر عن حلم الفلسطينيّين بالحرّيّة والعودة، وتزرع البشرى في نفوس المعتقلين واللّاجئين من أبناء الشّعب الفلسطينيّ المستضعف والمعذّب، فإنّ نصوصها تزخر برموز أخرى لا تقلّ قوّة في التّعبير عن روح الثّورة والمقاومة. وهذه الرّموز، التي تستمدّ جذوتها من الطّبيعة والتّاريخ والذّاكرة الشّعبيّة، تمثّل ملامح الخطاب النّضاليّ في شعرها، وتكشف عن رؤيتها لدور الكلمة في معركة التّحرير؛ ها هي تقول:
حرّيّتي:
حرّيّتي!
حرّيّتي!
صوتٌ أردّده بملء فم الغضب
تحت الرّصاص وفي اللّهب
وأظلّ رغم القيد أعدو خلفها
وأظلّ رغم اللّيل أقفو خطوها
وأظلُّ محمولاً على مدّ الغضب
وأنا أناضل داعيًا حرّيّتي!
حرّيّتي! حرّيّتي!
ويردّد النّهر المقدّس والجسورْ
حرّيّتي!
والضّفتّان تردّدان: حرّيتي!
ومعابر الرّيح الغضوب
والرّعد والإعصار والأمطار في وطني
تردّدها معي:
حرّيّتي! حرّيّتي! حرّيّتي!([23])
إنّ فلسطين طبيعةً وإنسانًا تغنّي مع الشّاعرة نشيد الحرّيّة، فحرّيّة الشّاعرة حرّيّة فلسطينيّة، قد اكتسبت هويّتها من ألم الأرض ومعاناة اللّاجئين والمعتقلين القابعين في سجون الغزاة الظّالمين، اكتسبت هويّتها من الحالمين بتحرير فلسطين والعودة إلى البستان والدّار.
إنّ فدوى طوقان في هذه القصيدة هي الشّاعرة الصّادقة المرتبطة بالوطن ترابًا وإنسانًا تصوّر معاناته ووجعه، ولا قيمة للشّعر أو لأيّ نوع من أنواع الأدب، إن لم يرتبط بالإنسان والحياة. إنّ وظيفة الأدب هي أن يصوّر الحياة، و”ربّما كانت أوّل عبارة في تاريخ النّظر النّقديّ قد أحكمت الرّبط بين الأدب والحياة هي العبارة المأثورة عن النّاقد والشّاعر الإنكليزيّ كولردج التي يقرّر فيها أنّ الأدب نقد للحياة”[24].
وتُغنّي طوقان نشيد الحرّيّة الفلسطينيّة في سياق نصّيّ حافل بمعاني الثّورة ودلالاتها؛ فالنّهر المقدّس بضفّتيه الشّرقيّة والغربيّة يغنّي معها نشيد الحرّيّة ويشاركها الثّورة، والنّهر المقدّس في هذا السّياق يحمل دلالة دينيّة وتاريخيّة تدحض مزاعم اليهود أنّ أرض فلسطين هي أرضهم التّاريخيّة، فالنّهر المقدّس الذي تعمّد بمائه السّيّد المسيح عليه السلام هو شاهدٌ دينيٌّ وتاريخيّ على كذب اليهود وادعاءاتهم الباطلة، ولم توظّف الشّاعرة النّهر المقدّس صدفةً في قصيدتها، بل هي أرادت أن تؤكّد أنّ فلسطين ليست إسرائيليّة، فاعتمدت البرهان التّاريخيّ في لغة شعريّة.
ثمّ إنّ الشاعرة قدّمت برهانها في سياق ثوريّ- كما بيّنّا آنفًا- لتوضّح أنّ الحقيقة التاريخيّة تحتاج فعلاً ثوريًّا لإظهارها وحمايتها حين أوردت في السّياق النّصّيّ بعض عناصر الطّبيعة التي تحمل دلالة الثّورة والغضب:
“والضّفّتان تردّدان: حرّيتي! ومعابر الرّيح الغضوب/ والرّعد والإعصار والأمطار في وطني تردّدها معي”([25])
تستعين الشّاعرة بعناصر الطّبيعة الدّالّة على الثّورة؛ لتعبّر بواسطتها عن شعورها الثّوريّ المتفاعل في وجدانها، فوظيفة الرّيح الغضوب والرّعد دلاليًّا تبشيرٌ بهبوب الثّورة ضدّ الوجود الصّهيونيّ على أرض فلسطين العربيّة، ووظيفة الإعصار والأمطار دلاليًّا تأكيدٌ على اقتلاع جذور الغزاة وإزالة دولتهم المزيّفة.
ولعلَّ الشاعرة استنبطت دلالة المطر على الدّمار والخراب من القرآن الكريم، حيث ورد المطر في آيات كثيرة حاملاً الدّلالة على العقاب الشّديد وخراب حياة المجرمين، وهذه الدّلالة نلحظها في قول الله تعالى: ﭐﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ (الأعراف: 84)، وكذلك نلحظ المطر يحمل الدلالة ذاتها في قوله تعالى: ﭐﱡﭐﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟﱠ (الشّعراء: 173)
إنّ هذا الدّمار الشّامل الذي تصفه الشّاعرة في قصيدتها الذي تعد به المجرمين الصّهاينة، هو نتيجة حتميّة لثورتها المشتعلة؛ ثورة تحلم بأن تحقّق لها الحرّيّة الحمراء المضرّجة بدماء الشّهداء الأبطال، وترسم لنفسها مستقبلًا يُزال فيه الظّلم والعدوان؛ وهكذا يتّخذ اللّون الأحمر عند شاعرتنا طوقان رمزًا للثّورة الوطنيّة الفلسطينيّة التي تختلف في جوهرها ومضمونها عن ثورة نازك الملائكة ذات المبادئ الشيوعيّة التي تهدف إلى تحقيق الاشتراكيّة في المجتمع، وجعلها نظامًا سياسيًّا يقود الدّولة.
إنّ هدف نازك الملائكة المروم- كما بدا في قصيدتها السّابقة- هدفٌ أمميٌّ، لا يعير اهتمامًا للقضايا الوطنيّة والقوميّة؛ أمّا هدف طوقان فهو هدفٌ وطنيّ هويّته فلسطينيّة، وفي الحقيقة أنّ الهدف الوطنيّ في كلّ زمان وفي كلّ حال يسمو على كلّ الأهداف والغايات، فهو الأجلُّ والمتقدّم دائمًا؛ لأنّه مرتبطٌ بوجدان الإنسان وعاطفته وذاكرته، بل بكينونته ووجوده؛ لهذا أخفق الشّعراء العرب الذين آمنوا بالفكر الشّيوعيّ حين شغلوا شعرهم بالتّعبير عن القضايا الأمميّة ونسوا القضايا الوطنيّة التي ينبغي أن تبقى الأصل الثّابت عند كل إنسان مهما كانت عقيدته، فها هو وهج الشّيوعيّة الذي بلغ ذروته في النّصف الأوّل وبداية النّصف الثّاني من القرن العشرين قد خفت وتضاءل كنور قنديل نضب زيته بيد أنّ الوهج الوطنيّ استعاد قوّته، وهو اليوم متوهّج في كلّ أقطار العالم، حيث تتسابق الأمم وتتنازع من أجل تحقيق مصالحها الوطنيّة والقوميّة.
إنّنا في السّياق الشعريّ عند طوقان، نلحظ دعوة إلى محاربة الأعداء الصّهاينة الذين يريدون طمس تاريخ القدس العربيّة بغية الاستيلاء عليها، وهذا التّوجّس ليس توجّسًا خياليًّا، بل هو نبوءة شعريّة ورؤيةٌ ثاقبةٌ كاشفة صادقة، وها هي القدس اليوم قد وصلت إليها النّار ويشتدّ خطر لهيبها، والحكومات العربيّة صامتة خاضعة منهزمة، وبعضها أقام مع الصّهاينة علاقات طبيعيّة متناسيًا قَدْر القدس في وجدان الأمّة وعقلها.
ها هي القدس اليوم تتعرّض للاعتداء من قبل اليهود الصّهاينة الذين ينتهكون حرمتها ويقتحمون بين حين وآخر ساحات المسجد الأقصى المبارك. وليس هذا فحسب، بل جعلوا المدينة العربيّة المقدّسة عاصمة لكيانهم الغاصب. وكأنّ القصيدة السّياسية “في يوم فلسطين” تعكس واقع العرب اليوم، وتدلّ على أن العرب قد خانوا رسالة الأمّة العربيّة الدّينيّة والحضاريّة؛ لأنّهم لم يبذلوا جهدًا حقيقيًّا من أجل التّغيير؛ وقد فاتهم تنبيه الله لهم وللنّاس جميعًا في قوله: ﭐﱡ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲶﱠ (الرعد: 11).
إنّ الشّاعرة تفخر بالجهاد والتّضحية بالدّماء إيمانًا منها بأنّ الحريّة لا تصل إليها أمّةٌ إلّا إذا بذل أبناؤها دماءَهم مهراقةً على أرض الأجداد، أرض التّاريخ والعزّة؛ وبهذه الرّمزيّة الشّعريّة تحضّ المجاهدين على الاستبسال والإقدام في معركة الكرامة معزّزةً ثقافة الجهاد بين أبناء عصرها آنذاك.
إنّ قصيدة طوقان يوافق مضمونها واقع الأمّة العربيّة؛ لأنّ العرب تكاسلوا ووهنوا ورضوا الذّلّ والهوان؛ وبما أنّ لكلّ سببٍ نتيجة، يمكن القول: إنّ العرب هم صنعوا سبب ذلّهم وانهزامهم، وقد ثبت ذلك من خلال تجارب العرب في اعتماد مفاوضات السّلام مع الاحتلال الصّهيونيّ، وقد أبرموا معه معاهدات سلام حسب زعهم؛ ولكنّها لم تُفضِ سوى إلى الذّلّ والهوان والتّخلّي عن الحقوق القوميّة في الأرض المقدّسة والتّاريخ والحضارة؛ وفي مقابل تجارب العرب الاستسلاميّة هناك تجارب المقاومة والثّورة وقد أثبتت نجاحها الباهر في لبنان، فأدّت إلى التّحرير، وفي غزّة أدّت إلى كسر جبروت العدوان وجعل الصّهاينة يدركون أن ثمّة ثورة جبّارة تقارعهم، وعليهم أن يحسبوا لها ألف حساب وما عادوا كما الماضي يقتلعون جذور العربيّ الفلسطينيّ من ترابه وتاريخه.
لقد أثبت العربيّ الفلسطينيّ أنّه إنسانٌ حيٌّ على أرض أجداده وليس إنسانًا ميتًا وِفاقًا لعقيدة الصّهاينة وأفكارهم السّوداء؛ إذ يرون أنّ العربيّ الصّحيح الجيّد هو العربيّ الميت؛ لأنّه يريحهم من وجوده ودلالته الوطنيّة والقوميّة والتّاريخيّة، ويُفسح أمامهم المجال للتّوسّع في الاحتلال والاستيطان وتغيير معالم التّاريخ وملامح الأرض.
لقد أثبتت تجارب العرب مع الصّهاينة في الصّراع والمفاوضات أنّ اليهود الصّهاينة لا يعترفون بوجود أحد من العرب إلّا العربيّ القويّ؛ إنّهم لا يعترفون بوجود أمّة من بين الأمم إلّا بالأمّة القويّة ولا غرابة، فهذه هي طبيعة الإنسان عامّة والصّهيونيّ خاصّة.
إنّ الخوف في طبع الصّهاينة لا يملكون جرأة المواجهة، ولا يُغيرون إلّا إذا كانوا معزّزين بالسّلاح الفتّاك المتطوّر الذي لا يملكه عدوّهم، وصفة الخوف هذه قد ألصقها الله تعالى بهم في قوله: ﱡﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﱠ (الحشر: 14).
إنّ اليهود الصّهاينة عظمت قوّتهم وعظم بطشهم بسبب تقهقر العرب وفرقتهم وتخلّيهم عن الرّسالة السّماويّة التي أمرتهم بالوحدة، وبأن يقاتلوا العدوّ معتصمين بحبل الله جميعًأ غير متفرّقين. وإنّ العرب- وأعني قادتهم وأولي الأمر منهم- قد خانوا الرّسالة وضيّعوا الأمانة وسعوا وراء زخرف الحياة الدّنيا، وهذا الفساد في الحاكمين العرب هو الذي أدّى إلى ضعف الأمّة العربيّة وقوّة أعدائها، ولكنّ الشّعب العربيّ يبقى المسؤول الأوّل عمّا وصلت إليه حال الأمّة من ضعف وهوان وتقهقر؛ لأنّه يمثّل القوّة العاتية، وهو السّيل الجارف الذي يستطيع أن يُزيل سلطان الظّالمين والفاسدين، إن هو أراد التّغيير وأراد العزّة، بيد أنّ الشعب العربيّ استسلم لسلطة حاكميه الخائنين إلّا فئةً منه أبت الذّلّ ومشت على طريق الكفاح والبسالة والشهادة، هي فئة المجاهدين الذين يسقون تراب فلسطين العطشان من دمائهم الزّكيّة، وهم على الرّغم من قلّتهم يُقلقون العدوّ ويجعلونه في خوف دائم من الزمن القادم.
ورؤية طوقان رؤية واعية صادقة حين رأت في المجاهدين آنذاك القوّة الحقيقيّة التي يجب أن يُقاتل العدوُّ بها، وأنّ اليد الحمراء التي ضرّجها دم الشّهداء هي التي سيفرّ البغي من هزّاتها، هي التي ستصفع الاحتلال صفعةً مدويّة تجعله يدرك أنّ اليقظة العربيّة حصلت وأنّ زمن النّوم والرّضا بالهزيمة قد ولّى، ورؤية طوقان الشّعريّة هي رؤية الشّاعر الأصيل ذي التّجربة السّياسيّة والاجتماعيّة المتنوّعة والغنيّة، هي رؤية الشّاعر المثقّف البصير الذي التصق بالجماهير ونبت في البيئة الشّعبيّة، وأدرك أنّ ما يؤخذُ غصبًا لا يرجع لينًأ وما، يؤخذ في الحرب لا يرجع في السّلْم.
إنّ الثّقافة العامّة التي تمتاز بها طوقان هي ثقافة التّضحية والمقاومة بالدّم والنّار، فالشّاعر الأصيل هو رهين تجربته العامّة في الحياة، ولا يمكنه أن يكتب بمعزلٍ عنها، إنّه يظلّ لصيقًا بها متأثّراً بأحداثها، وقد يحدث له أن يكتب قصيدة خارج إطار تجربته العامّة- كقصيدة المناسبة- ولكنّه يعود سريعًا إلى جذوره والبيئة التي نبت فيها.
الخاتمة
لقد أسهم هذا البحث في الكشف عن ثراء الرّمز الشّعريّ وديناميّته في شعر المرأة العربيّة المعاصرة، من خلال دراسة تجلّيات الثّورة في نتاج نازك الملائكة وفدوى طوقان، كنموذجين مميّزين يمثّلان مشهداً شعريّاً متفاعلاً مع التّحوّلات الاجتماعيّة والسّياسيّة في العصر الحديث؛ فالرّمز لم يكن مجرّد صورة جماليّة جامدة، بل صار وعاءً حيويّاً ينبض بأصوات الثّورة والتّمرّد، ويتجلّى في نصوصهما كصرخة واضحة ضد الظّلم والاستبداد، وكتعبير عن الوجدان الجمعي للمرأة والشّعب معًا.
لقد تبيّن أنّ نازك الملائكة وظّفت الرمز بأسلوب تحريضيّ مباشر يعكس حالة الثّورة الاجتماعيّة والمادّيّة، في حين اتّخذت فدوى طوقان رموزها من عالمها الخاصّ متداخلة مع الوجدان الوطنيّ الفلسطينيّ، فأضفى على شعرها عمقًا إنسانيًّا وانتماءً تاريخيًّا مميّزًا. وهذه الاختلافات تعكس تنوّع التّجربة النّسويّة في مواجهة الواقع السّياسيّ والاجتماعيّ، وتكشف عن تعدّد أدوات التّعبير الشّعريّ وأفقه الرّحب.
إنّ فهم هذه التّجلّيات الرّمزيّة في شعر نازك الملائكة وفدوى طوقان لا يثري المكتبة الأدبيّة فقط، بل يفتح أفقًا معرفيًّا لفهم الدّور الحيويّ للشّعر النّسويّ في صناعة الوعي الوطنيّ والثّوريّ، ويؤكّد على قدرة الرّمز الشّعريّ على استيعاب التّحوّلات المجتمعيّة وتجاوز حدود النّصّ إلى فعل اجتماعي فاعل.
ختامًا، يبقى الرّمز الشّعريّ عند نازك الملائكة وفدوى طوقان مرآة تعكس أحلام الثّورة وآلامها، ورسالة تثبت أنّ الشّعر النّسويّ هو صوت مقاومة متواصل، يتحدّى الزّمان والمكان، ويحتفي بالحرّيّة والكرامة.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- إسماعيل، عزّ الدّين: الشّعر العربيّ المعاصر قضاياه وظواهره الفنّيّة والمعنويّة. دار الفكر العربي، ط 3، 2013م.
- البياتي، عبد الوهّاب: مجلّة الآداب البيروتيّة، عدد 1، مارس 1966م.
- جيرو، بيير: علم الدّلالة؛ ترجمة منذر عياشي. دار طلاس، دمشق، 1992م.
- دكروب، محمّد: الأدب الجديد والثّورة– كتابات نقدية. دار الفارابي، بيروت، ط3، 1990م.
- ذبيان، سامي وآخرون: . قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. رياض الريس للنشر، لندن، ط1، 1990م.
- رد، هربرت (Herbert Red): الفنّ والمجتمع؛ ترجمة فارس متري ضاهر. دار القلم، بيروت، ط 1، 1975م، ص 19.
- شوقي، أحمد: الشّوقيّات. دار الصّفا للنّشر والتّوزيع، دمشق، لا ط، لا تا.
- طوقان، فدوى: ديوان فدوى طوقان. دار العودة، بيروت، ط1، 1978.
- مجناح، جمال: “الرّمز في شعر محمود درويش”. من أحد فصوله المنشورة في مجلّة الطّريق، العدد الثّالث، أيار- حزيران، 2002م.
- محمد علي، إبراهيم، اللّون في الشّعر العربيّ قبل الإسلام، قراءة ميثولوجيّة: جروس برس، بيروت، ط 1، 2001م.
- الملائكة، نازك: ديوان نازك الملائكة. دار العودة، بيروت، ط2، 1970م، المجلّد الثاني.
- نازك الملائكة، الأعمال النّثريّة الكاملة- قضايا الشّعر المعاصر، سايكولوجيّة الشّعر. المجلس الأعلى للثّقافة، الجزء الأوّل.
- يازجي، رجا: “حركة المقاومة ومشكلة التنظير العقائديّ”. مجلة (مواقف) العدد 8، السّنة الثّانية، آذار- نيسان، 1970م.
المراجع الإلكترونيّة
- Red Color psychology and Meaning. colorpsychology.erg, Retrieved 17-10-2018 Edited.
[1] شاعر لبنانيّ وأستاذ مساعد في الجامعة اللّبنانيّة، كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة – الفرع الثّالث: mouhamadhoblos1964@gmail.com
[2] رد، هربرت (Herbert Red): الفنّ والمجتمع؛ ترجمة فارس متري ضاهر، ص 19.
[3] شوقي، أحمد: ديوان شوقي؛ قصيدة (نكبة دمشق).
[4] جيرو، بيير: علم الدّلالة؛ ترجمة منذر عياشي، ص 129.
[5] إسماعيل، عزّ الدّين: الشّعر العربيّ المعاصر قضاياه وظواهره الفنّيّة والمعنويّة، ص 182.
[6] مجناح، جمال: الرّمز في شعر محمود درويش، ص 42.
[7] ذبيان، سامي وآخرون: قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ص 177- 776.
[8] البياتي، عبد الوهّاب: مجلّة الآداب البيروتيّة، ص 198.
[9] الملائكة، نازك: ديوان نازك الملائكة؛ قصيدة (ثلاث أغنيات شيوعيّة)، 2/ 568.
[10] إسماعيل، عزّ الدّين: الشّعر العربيّ المعاصر، قضاياه وظواهره الفنّيّة والمعنويّة، ص 377.
[11] الملائكة، نازك: ديوان نازك الملائكة؛ قصيدة (ثلاث أغنيات شيوعيّة)، 2/ 569.
[12] محمد علي، إبراهيم، اللّون في الشّعر العربيّ قبل الإسلام- قراءة ميثولوجيّة، ص 112.
[13] إسماعيل، عزّ الدّين: الشّعر العربيّ المعاصر قضاياه وظواهره الفنّيّة والمعنويّة، ص 392.
[14] م. ن.، ص 379 -380.
[15] دكروب، محمّد: الأدب الجديد والثورة– كتابات نقدية، ص 151.
[16] نازك الملائكة، الأعمال النّثريّة الكاملة، 1/ 323.
[17] Red Color psychology and Meaning. www.colorpsychology.erg, Retrieved 17-10-2018 Edited.
[18] الملائكة، نازك: ديوان نازك الملائكة؛ قصيدة (ثلاث أغنيات شيوعيّة)، 2/ 569.
[19] م. ن.، 2/ 572.
[20] يازجي، رجا: “حركة المقاومة ومشكلة التنظير العقائديّ”، ص 58.
[21] طوقان، فدوى: ديوان فدوى طوقان؛ قصيدة (حريّة الشعب)، 1978.
[22] البيّاتي، عبد الوهّاب، مجلّة الآداب البيروتيّة، ص 198.
[23] طوقان، فدوى: ديوان فدوى طوقان؛ قصيدة (حريّة الشعب)، ص 554- 555.
[24] إسماعيل، عزّ الدّين: الشّعر العربيّ المعاصر قضاياه وظواهره الفنّيّة والمعنويّة، ص 373.
[25] طوقان، فدوى: ديوان فدوى طوقان؛ قصيدة (حريّة الشعب)، ص 555.