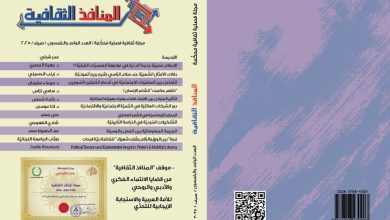المجتمع العربيّ في صدر الإسلام بين الرّفاه وخطر اليهود
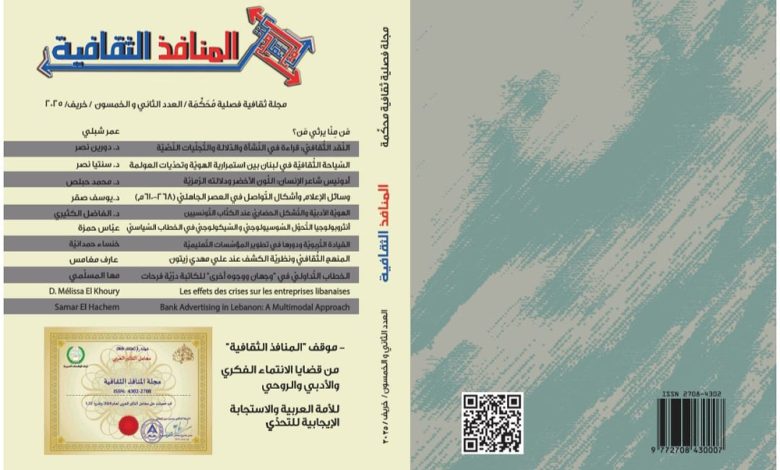
المجتمع العربيّ في صدر الإسلام بين الرّفاه وخطر اليهود
The Arab Society in the Early Islam Era: Between Prosperity and the Threat of the Jews
د. جهينا محمود المصري ([1])
Dr.Jouhayna Mahmoud Al Masri
تاريخ الاستلام 2/ 7/ 2025 تاريخ القبول 30/ 7/2025
الملخّص
لم تكن الحياة الاقتصاديّة والسّياسيّة منتظمةً في جاهليّة العرب، مثلما آلتْ إليه في صدر الإسلام، بعد أن أرْسى قواعدَها الرّسول الكريم (ﷺ(، وبتوسّع الفتوحات، وتدفّق أموال البلاد التي عمّها الإسلام بنوره.
وباعتماد المنهج التّاريخيّ الذي يسلّط الضّوء على معطيات البيئة وعامل الزّمن؛ تكشّف هذا البحث بالملاحظة والتّحليل عن أنّ هذه الوفّرة الاقتصاديّة التي نعمِ بها العربُ جميعًا، لم تكن بمنأى عن كيد الكائدين من المشركين واليهود الذين ناصبوا الإسلام العداءَ منذ أن هلّتْ بشائرُه، وقد حقّقت عدالةً نسبيّة بين النّاس على اختلاف طبقاتهم الاجتماعيّة وانتماءاتهم القبليّة التي ألّف بينها الإسلام.
الكلمات المفتاحيّة: الأسس الاقتصاديّة، الإسلام، الرّسول والصّحابة، الفتوحات، اليهود، نكث العهود، الوفرة الماليّة، المهاجرون والأنصار، المصاعب والمساواة.
Abstract
Economic and political life was not as regular in pre-Islamic Arab times as it became at the beginning of Islam, after its foundations were laid by the Noble Messenger (peace be upon him), and with the expansion of conquests and the flow of money from the countries that Islam spread with its light…
By adopting the historical approach that sheds light on environmental data and the factor of time; Through observation and analysis, this research reveals that this economic abundance that all Arabs were blessed with was not immune from the machinations of the polytheists and Jews who were hostile to Islam ever since its tidings came, and that it achieved relative justice among people regardless of their social classes and tribal affiliations. He united Islam among them. key words Economic foundations, Islam, the Messenger and the Companions, conquests, the Jews, breaking covenants, financial abundance, the immigrants and the Ansar, hardships and equality.
Keywords: Economic foundations, Islam, the Prophet and his companions, conquests, Jews, broken covenants, financial abundance, immigrants and helpers, hardships and equality.
المقدّمة
يشكّل صدر الإسلام مرحلة تأسيسيّة في التّاريخ العربيّ والإسلاميّ، اتّسمت بتحوّلات كبرى في البنية الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة للجزيرة العربيّة. فقد انتقل العرب من واقع الجاهليّة الذي غلبت عليه القبليّة وتباين أنماط المعيشة، إلى كيان موحّد تحكمه مبادئ العدل والمساواة، وقد أرسى دعائمها الرّسول الكريم ﷺ، مدعومًا بحركة الفتوحات التي فتحت أمام المسلمين آفاقًا واسعة من الرّفاه والاستقرار؛ غير أنّ هذا الازدهار لم يكن بمنأى عن التّحدّيات، إذ واجهت الدّولة الإسلاميّة النّاشئة محاولات معارضة متعدّدة، كان أبرزها موقف اليهود في المدينة وما حولها، فقد رأوا في الرّسالة المحمّديّة تهديدًا لمكانتهم الدّينيّة ونفوذهم الاقتصاديّ والاجتماعيّ.
ويأتي هذا البحث ليتناول، في ضوء المنهج التّاريخيّ القائم على التّحليل والاستقراء، ملامح الحياة العربيّة في صدر الإسلام بين الوفرة الاقتصاديّة وخطر اليهود، مبرزًا أبعاد التّفاعل بين الاستقرار الدّاخليّ والتّحديّات الخارجيّة، ومسلّطًا الضّوء على طبيعة العلاقات التي نشأت بين المسلمين واليهود، وما شابها من معاهدات ونقض للعهد وصدامات، كان لها أثر بارز في مسار التّجربة الإسلاميّة الأولى.
المجتمع العربيّ في صدر الإسلام بين الرفّاه وخطر اليهود
كان العرب قبل الإسلام بدوًا وحضرًا، ومن البديهيّ أن يختلف أسلوب معيشتهما في الحياة الاقتصاديّة والسّياسيّة، ولكنّ الحياة الاجتماعيّة كانت ذات نظام واحد، هو نظام القبيلة بروابطها وعُرفها وقيمها الخلقيّة.
وجاء الإسلام بمُثل جديدة واتّجاه جديد، وأحدث ثورة دينيّة فكريّة، رافقتها تطوّرات أدّت إلى ثورة في حياة العرب الاقتصاديّة، وفي وضعهم المعيشيّ؛ فقد تجاوز الإسلام الحدود القبليّة إلى أفق جديد حين نادى بفكرة الأمّة، ثم وحّد العرب بعد الرّدّة في نطاق أمّة واحدة، ووجّههم إلى الجهاد، فأخرجهم من مواطنهم إلى آفاق جغرافيّة جديدة، وصحب ذلك تنظيم بشكل يحقّق فكرة الجهاد والتّوسّع.
وأدّت الفتوحات إلى انتشار العرب وتوسّعهم في الأرض والرّزق، وقد خرجوا في موجة ازدادت تدفّقًا بازدياد الانتصارات ثمّ بتوسّع الفتوح، ولقيت حركة الهجرة حماسًا بسبب جفاف الجزيرة وتوقّف الغزو وتوفّر الثروة في البلاد الجديدة، وشملت هذه الهجرة البادية والحاضرة على ما بينهما من تفاوت في القبليّات والمستويات، وكان لذلك نتائجه في الحياة العامّة([2]).
وتلا الفتوح بصورة تدريجيّة انتشار الدِّين الإسلاميّ، فدخله مَن آمن ومَن تستّر، وقوي هذا الاتّجاه على مرّ الأيّام حتى أدّى إلى ظهور تيّار الموالي، وكان لهذه التّيارات –القبليّ والحضريّ ثمّ تيّار الموالي– دور في التّطوّرات الاجتماعيّة فيما بعد([3]).
وخرج العرب إلى الفتوحات في هيئة قبائل، واستمرّوا في تكوين الجيش العربيّ الذي نُظّم في تقسيمات قائمة على الوحدات القبليّة، من قبيلة إلى عشيرة، وسجّل العرب في الدّواوين المحلّيّة في الأمصار (وادي الجند) على أساس النّسب القبليّ، وانتظموا في السّكن على سكك ودروب وفق العشائر والأفخاذ؛ واستمرّت التّقاليد والعادات القبليّة سائدة بينهم في البادية، وبقي التّأكيد على رابطة النّسب قويًّا؛ وهذا التّنظيم القبليّ المنسجم في الظّاهر كان يخفي وراءه التّباين بين عناصر البادية والعناصر الحضريّة التّجارية عن المدن وخاصّة مكّة.
وفي مرحلة الفتوحات وبعدها، تمكّن المكّيّون من التّجّار وبعض عرب المدن من تنمية الثّروات التي حصلوا عليها؛ في المقابل، كان جهل البلاد بالأمور الماليّة واضحًا، إذ أسرفوا في الإنفاق، وطمع أنصار بعض الخلفاء في الثّراء. ومع تدّفق الأموال عليهم، أصبحوا معتادين على العطاء والرّزق الكبير، لكن عندما توقّفت الفتوحات، أفلسوا سريعًا، ووجدوا مواردهم ضئيلة مقارنة بما اعتادوه، فتزعزع نمط معيشتهم.
وهذه التطورات زادت من حدة التباين بين رجال القبائل وأهل المدن القدماء، وأكسبته أبعادًا ظهرت آثارها جليّة في المرحلة الأولى؛ كما أكّد هذا الوضع المقلق تداخل الجانب الاقتصاديّ بالمشكلة السّياسيّة؛ لكن السّؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل انتشر الإسلام بالدّعوة السّلميّة أو بالقوّة؟
يعتقد بعض المستشرقين، وبعض من لم تتح لهم الفرصة للتّعمّق في الإسلام أو الدّراسات الإسلاميّة، أنّ القوّة كانت عاملًا رئيسًا في انتشار الإسلام، مستندين في ذلك إلى الحروب التي وقعت في حياة الرسول (ﷺ) وبعد وفاته؛ وللرّدّ على هذا الرّأي والسّؤال، نؤكد بقوّة وإصرار أنّ الإسلام لم ينتشر بالسّيف، على الرّغم من وقوع بعض الهفوات مع بعض القبائل، بل انتشر بالدّعوة والبراهين؛ ولنقرأ آية تلو الأخرى في سلسلة من آيات القرآن، ومن ثمّ في سلسلة من الأحداث التاريخية بحيث لا يبقى للشّكّ مجال.
فأمّا عن القرآن، فهناك قوله تعالى:
- ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ﴾ ( البقرة : 256 ).
- ﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ ﴾ (النّحل : 125 ).
- ﴿لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ﴾( الكافرون : 6 ).
- ﴿فَإِنَّمَا عَلَيۡكَ ٱلۡبَلَٰغُ وَعَلَيۡنَا ٱلۡحِسَابُ﴾ ( الرعد : 40 ).
- ﴿فَذَكِّرۡ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٞ٢١ لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بِمُصَيۡطِرٍ﴾ (الغاشية: 21 و22)
كان محمّد في مكّة هو وأصحابه مستضعفين، لا قوّة لهم على خصومهم من كفّار قريش؛ لذا كان يدعو النّاس بالوعظ والإنذار من طريق المسالمة؛ كما جاء في القرآن: ﴿ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ (النّحل: 125)؛ فهذه الآية كانت شعارًا للدّعوة في مكّة، فدخلها مجموعة من عظماء الرّجال الّذين احتكموا إلى العقل والفكر معًا، من أمثال: عليّ بن أبي طالب وأبي بكر الصّدّيق وعثمان بن عفّان وسعد بن أبي وقّاص وطلحة والزّبير، ثمّ عمر؛ فهل يمكن القول إنّ هؤلاء دخلوا بالقوّة، وأين القوّة في ذلك الدّعم؟
لقد اضطهدت قريش المسلمين في مكّة اضطهادًا قاسيًا، وأنزلت بمحمَّد وأتباعه ألوانًا من العذاب، وكانوا مغلوبين على أمرهم، مستضعفين، وكان أهل المدينة يسعون إلى الإسلام فيعتنقونه، ويصير لهم ذووهم وأهلهم؛ فهل يمكن أن نقول إنّ الإسلام انتشر بالقوّة بين سكّان المدينة؟!
ولكن عندما هاجر المكِّيون إلى المدينة بعد بيعة العقبة الأولى والعقبة الثّانية، قويَتْ شوكتهم، واشتدّ جناحهم بالأنصار الذين بايعوا رسول الله (ﷺ( والمهاجرين الذين تبعوه، وبعد أن ذاقوا مصاعب كثيرة من سفك الدّماء وقتل الأنفس وحرمانهم من أبسط مقوّمات الحياة قرن الرّسول (ﷺ( دعوته بالسّيف؛ ليدافع عن نفسه، وليقاتل خصوم دعوته من الكافرين، جريًا على ديدنه في جميع أمور الدّعوة؛ وقد كان قرار الدّفاع هذا تدريجيًّا ومنطقيًّا، متناسبًا مع حجم القوّة الحربيّة التي كان يواجهها. ومن هنا، كانت الآية القرآنية التي نزلت في القتال في المدينة: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ٣٩ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيۡرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُۗ ٤٠﴾ (الحج :39 – 40)؛ فهذه الآية تضمَّنت أمرين: أحدهما الإذن بالقتال، أي جعله مباحًا لهم من غير أن يفرض عليهم فرضًا، والثّاني أنّ الإذن لهم بالقتال إنّما هو بسبب أنّهم ظُلموا، وأُخرجوا من ديارهم بغير حقّ، فسياق الآية يدلّ على أنّ المأذون لهم بالقتال هم المهاجرون لا الأنصار؛ لأنّهم لم يُظلموا ولم يخرجوا من ديارهم، وإنّما هم يقاتلون بحكم البيعة التي بايعوا بها محمّدًا (ﷺ( على أن يحموه وينصروه، ويجوز أن يكون الإذن عامًّا للمهاجرين والأنصار؛ وهذه أوّل خطوة خطاها رسول الله (ﷺ( في أمر القتال، ثمّ جعله فرضًا على المسلمين، ولكن لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، إذ قال عزّ وجل: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ﴾ (البقرة: 190)؛ وهذه هي الحروب الدّفاعيّة.
تُظهر المصادر التّاريخية بوضوح أنّ المرحلة التي شهدت أوسع انتشارٍ للإسلام كانت فترة السِّلم التي أعقبت صلح الحديبية بين المسلمين وقريش، وامتدّت قرابة سنتين. ويؤكّد المؤرّخون أنّ عدد الداخلين في الإسلام خلال هاتين السّنتين فاق بكثير عدد من أسلموا في نحو عشرين عامًا منذ بدء الدّعوة حتى توقيع الصّلح. ويكشف هذا المعطى التّاريخي أنّ الانتشار الواسع للإسلام ارتبط بالسِّلم وأجواء الأمن، لا بالحرب أو الإكراه.
وانتشر الإسلام على نطاق واسع في مناطق شاسعة من العالم، مثل إندونيسيا وأفريقيا، فنتساءل: ما القوّة التي مكّنته من بلوغ تلك البلاد البعيدة وجذب قلوب الملايين؟
ولكن سرعان ما بدأ الإسلام ينتصر وينتشر، وسرعان ما تكوَّنت في الجزيرة العربيّة دولة قويّة متّحدة، فإضافة إلى قوّتها واتّحادها كان لها مبادئ الدّين الجديد الذي اجتمع العرب حوله، وهذه المبادئ جعلت العرب يعشقون الجهاد في سبيل الله؛ لملاقاة إحدى الحُسنيين: أن يموت المجاهد شهيدًا، أو أن ينتصر مدافعًا عن الإسلام، وهذه المبادئ وحّدت العرب، وألزمتهم الطّاعة لله وللرّسول وأولي الأمر، وأن يتركوا لهم الرّأي عند النّزاع؛ حيث قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ (النساء: 59)
ومبادئ الإسلام واضحة في أنّ أيّ قتال إنما هو لردّ العدوان، كما سبق، وينص القرآن الكريم على أن المسلمين أن يلجأوا إلى السِّلم إذا لجأ إليه أعداؤهم، قال تعالى: ﴿۞ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ ٦١﴾ (الأنفال: 61)، وقال: ﴿فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمۡ فَلَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ وَأَلۡقَوۡاْ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ عَلَيۡهِمۡ سَبِيلٗا ٩٠﴾ (النساء: 90)؛ وهذه الآيات البيّنات، والأحداث التي مرَّت على الإسلام، تؤكّدان بوضوح أنّ الإسلام سلك طريقه بالدّعوة لا بالقوّة.
اليهود في المدينة والجزيرة العربيّة
لم يكن لليهود حماسة حقيقية لنشر دينهم، إذ انحصرت أدواتهم في القتال والسّحر، والنفث، والرّقية. وكانوا يعدّون أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة روحانيّة، ويتقنون أساليب الكسب والمعيشة؛ غير أنّهم في الواقع كانوا أهل دسائس ومؤامرات، يمارسون العنف والفساد، ويلقون العداوة والبغضاء بين القبائل العربية المجاورة التي كانت غارقة في حروب دامية متواصلة. قال الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقٗا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ كَٰفِرِينَ﴾ (آل عمران: 100)؛ والخطاب للأوس والخزرج، إذ كان اليهود يريدون فتنتهم، واللفظ في الآية عامّ.
وكان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع، كانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل المدينة، وبنو النّضير وبنو قريظة من حلفاء الأوس، وتقيم ديارهما في ضواحي المدينة
هذه القبائل عُرفت بإذكاء نار الصراع بين الأوس والخزرج منذ زمن بعيد، وشاركت في حرب بُعاث([4]) إلى جانب حلفائهم، وهي الحرب التي استمرّت لسنين طويلة. وهي تمثّل نموذجًا للموقف العام لليهود في تلك الحقبة؛ فاليهود أهل الفساد والجريمة، قاتِلو الأنبياء وسفّاكو الدماء، واشتهروا بالغدر والخيانة، ؛ قال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ يَكۡفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقۡتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ (البقرة: 61).
وكان اليهود في الجزيرة العربيّة، ولا سيّما يهود يثرب، يردّدون على أسماع العرب: “قد آن أوان بعثة نبيّ، وسنتّبعه ونقوى به عليكم”… هكذا كان اليهود يخطّطون ويُمنّون أنفسهم، ظانّين أنّه إذا جاء النّبيّ سيكون في صفّهم؛ غير أنّ مشيئة الله قضت أن يُبعث النّبيّ محمّد ﷺ، فما إن وصلت دعوته إلى يثرب، حتى سارعت الأوس والخزرج إلى مبايعته في بيعة العقبة الأولى والثانية، خشية أن يسبقهم اليهود إلى نصرته.
العقبة الأولى
في موسم الحجّ من العام الثّاني في المدينة، وافى من الأنصار اثنا عشر رجلًا، فلقوا النّبيّ بالعقبة، وهي العقبة الأولى، فبايعوا الله ورسوله (ﷺ(، وذلك قبل أن تُفرض عليهم الحرب([5]).
العقبة الثّانية
رجع مصعب بن عمير إلى مكّة، وخرج مع الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجّاج قومهم، من أهل الشّرك حتى قدموا إلى مكّة، فواعدوا رسول الله (ﷺ( العقبة من أوسط أيام التّشريق، وأراد الله به ما أراد من كرامته والنّصر لدينه وإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله([6]).
ولم يدخل في الإسلام من اليهود إلّا عددٌ قليل جدًّا، مثل عبد الله بن سلام بن الحارث([7])؛ فغالبيتهم العظمى قابلت دعوة النبي ﷺ بالرفض. وقد سجّل القرآن الكريم هذا الموقف في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦۚ﴾ (البقرة: 89)؛ وهنا لا بدّ لنا من التّساؤل: لماذا كفروا بنبيّ الإسلام مع أنّهم كانوا ينتظرونه؟ وربّما يكون الجواب: أنّهم أرادوه أن يكون منهم ولهم؛ ليظلّ سلطانهم على النّاس، ويعلي مكانتهم، ولكنّ الإسلام جاء على يد رجل من العرب وليس من اليهود، والإسلام سوّى بين النّاس، فلم يبقهم شعبًا مختارًا، كما كانوا يأملون، ولهذا السّبب أسرع عرب يثرب ودخلوا الدِّين قبلهم، إذ أصبح لا فائدة فيه لهم، بناءً على تفكيرهم.
ومع كلّ ما حصل وحدث، أحسن المسلمون معاملتهم، وعقدوا معهم معاهدة، وتركوا لهم حرّيّة العبادة، وأعطوهم الحقوق نفسها التي للمسلمين، ومقابل ذلك التزم اليهود بالتّعاون مع المسلمين عسكريًّا لحماية وطنهم المشترك إذا تعرِّض لعدوان، والتزموا كذلك بالتّعاون مادّيًا إذا حدث ما يحتاج إلى التّعاون المادّيّ، وكان روح المعاهدة هو العمل المشترك لهدف مشترك؛ غير أنّ اليهود، كما أشرنا سابقًا وأثبتت شواهد التاريخ، لم يكونوا مخلصين في عهودهم، ولم ينخرطوا في هذا العهد إلا مؤقّتًا ريثما تتاح لهم فرصةٌ أخرى تخدم مصالحهم. وقد بدا ذلك جليًّا منذ اللحظة الأولى، إذ أدركوا أنّ دين محمد ﷺ جاء لينزع منهم ما القيادة الروحية القائمة على الصلة بالله عن طريق الوحي، وما ارتبط بها من فخرهم بكتابٍ مقدّس منزّلٍ من عند الله.
وزاد حقدُ اليهودِ حينما رأوا دينَ محمَّدٍ (ﷺ) ينتشر انتشارًا واسعًا في أقصرِ مدّةٍ عرفها التّاريخ، فاليهودُ يعرفون كيف تعثَّرت اليهوديّة، وكيف حوربت المسيحيّة قرونًا عدّة، ولكنَّ انتصارَ محمَّدٍ (ﷺ) بدأ يتحقّق في حياتِه، وبعد سنين قليلة من بدء دعوتِه، وبخاصّةٍ عندما حدثت الهجرةُ، وظهر الطّريقُ ممهَّدًا للنّجاح الكامل؛ فعقدوا العزم على المقاومة، واتّخذت مقاومتهم طرقًا متعدّدة، كان من أوّلها الجدل الذي اصطنعوه؛ ليشكّكوا النّاس، ويردّوا المسلمين عن الإسلام، وقد ذكر القرآن ذلك الموقف بقوله: ﴿وَدَّ كَثِيرٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَوۡ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِكُمۡ كُفَّارًا ١٠٩﴾ (البقرة: 109).
وأدرك اليهود أنّ هذا الطّريق لم يأتِ بفائدة، ولم يستطيعوا أن يفتِنوا مسلمًا عن دينه، ولم يستطيعوا أن يصدّوا النّاس عن دخول الإسلام، فتأكّدوا أنّ السّبيل الوحيد للقضاء على الإسلام هو قوّة الحسام وليس قوّة اللّسان، بعد أن اتّجهوا إلى قوّة السّيف إلى قريش؛ ليقضي العرب على العرب، وليتولّى العرب إخماد هذا الصّوت الجديد -وهو ما نعيشه الآن- فالعرب يقاتلون العرب، واليهود هم المتفرّجون والمستفيدون، وتأكد لهم أنّ قريشًا اضمحلّت، وأنّ محمَّدًا (ﷺ( هاجر، وأصبح ذا قوّة وعصبيّة، وبات يستطيع أن يقاوم وأن يحمي دينه وأتباعه، والشّاهد على ذلك انتصار المسلمين في غزوة بدر، فأصبح لا مناص لليهود من أن يدخلوا ميدان النّضال بأنفسهم؛ ليرجّحوا كفّة قريش عند اللّزوم، وليحملوا هم عبء هذا الكفاح والصّراع بينهم وبين المسلمين.
وابتدأ الصِّراعُ بين المسلمين وبين بني قينقاع، أقوى جماعاتِ اليهودِ الذين شملتهم المعاهدةُ مع المسلمين، وكانوا أوَّلَ مَن نكث العهودَ، ويرون في ذلك أنّه بعد غزوةِ بدرٍ وانتصارِ المسلمين أبدى اليهودُ غضبَهم وسخطَهم على المسلمين، وكان بنو قينقاع أكثرَ اليهودِ سخطًا وغضبًا واستهانةً بهذا النصرِ وتهوينًا من شأنه.
وحدث أن ذهبت امرأة من الأنصار إلى سوق الصّاغة، حيث يكثر اليهود، فتسلّل خلفها رجل يهوديٌّ وهي جالسة، وعقد طرف ثوبها إلى أعلاه، فلمّا وقفت المرأة انكشف ظهرها، فتضاحك اليهود وصرخت المرأة الشّاكية، فوثب رجل من المسلمين على اليهوديّ فقتله، وشدّ اليهود على المسلم فصرعوه، وأعلنوا نبذهم العهد واستعدوا للحرب([8])؛ ولمّا كلّمهم الرّسول في ذلك، وأنذرهم قالوا له: “يا محمّد إنّك تحسب أنّا كقومك، لا يغرنَّك أنّك لقيت قومًا لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة، وإنّنا والله لئن حاربتنا لتعلمنَّ أنَّا نحن النّاس”، وكان ذلك تهديدًا وإنذارًا بخيانة جسيمة، ونزل بعد ذلك قول الله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوۡمٍ خِيَانَةٗ فَٱنۢبِذۡ إِلَيۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَآءٍۚ﴾ (الأنفال: 58)؛ ويروى أنّ الرّسول قال عندما نزلت هذه الآية: (إنّي أخاف خيانة بني قينقاع).
وخرج الرّسول في جمع من أصحابه، وحاصر دُورهم، فقذف الله في قلوبهم الرّعب، فما استطاعوا الظّهور، ونزلوا على حكم الرّسول (ﷺ،( وحينئذٍ تقدم عبد الله بن أُبيّ وكان حليفهم قبل الإسلام، فقال للرسول: أنَّي فيَّ مواليّ، فتركهم الرّسول له، واكتفى بإبعادهم عن المدينة، فخرجوا حتى نزلوا أذرعات الشّام، ولم يلبثوا حتى هلك أكثرهم، وكانوا حوالي ستمائة، وكانوا يشتغلون بالصّاغة والتّجارة([9]).
أمّا يهود بني النّضير فكان بينهم وبين المسلمين حلف يقضي بالتّعاون بين الفريقين مادّيًّا عند الحاجة؛ وحدث أن قتل أحد المسلمين رجلين بالخطأ، فوجب على المسلمين أن يدفعوا الدّيّة عنهما، وكان الذي قتلهما عمرو بن أُميّة الضّمريّ، وهو الوحيد الذي نجا من عامر بن الطّفيل وأهل نجد، وكانوا قد قتلوا جميع المسلمين الذين أرسلهم الرّسول (ﷺ( لدعوة أهل نجد إلى الإسلام، وكانت الموقعة عند بئر معونة، وعندما كان عمرو بن أمية عائدًا قابل رجلين من بني كلاب ابن ربيعة وبين الرّسول عهد لهم لم يعلمه عمرو، وقد خافهما هذا على نفسه فاغتالهما، فالتزم الرّسول بديتهما([10]). وأثقلت الدّيّة المسلمين؛ لأنّهم كانوا لم يستقرّوا بعد من الناحية الماليّة، بسبب كثرة المهاجرين الذين فرّوا من بيوتهم تاركين أموالهم وثرواتهم بمكّة، ورأى الرّسول أن يسأل بني النّضير أن يُسهموا في دفع هذه الدّيّة، عملًا بالحلف السّابق، فذهب بنفسه إلى الحيّ الذي يسكنون فيه، وذكر لهم الخبر، فقالوا له: “نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت ممّا استعنت بنا عليه”، وطلبوا منه الجلوس ريثما يدبّرون له المال الذي طلبه، فجلس الرّسول (ﷺ( بجانب جدار، ومعه أصحابه أبو بكر وعمر وعليّ.
وذهب اليهود؛ ليفكّروا فيما يدفعون من المال، ولكن سرعان ما هتف واحد منهم: إنكم لن تجدوا الرّجل على مثل حاله هذه. وقال آخر: من منّا يعلو هذا الجدار فيلقي عليه حجرًا فيريحنا منه؟ قال عمرو بن جحاش: أنا لذلك. وصعد عمرو، ولكن سرعان ما أوحى الله لمحمَّد أنّ اليهود يأتمرون به؛ ليقتلوه، وطلب منه الانسحاب في صمت([11])؛ وانسحب الرّسول وانتظر أصحابه، وانتظر عمرو بن جحاش عودته؛ ولكن هيهات. فلحق أبو بكر وعمر وعلي بالرّسول، وسألوه عن السّبب في أنّه تركهم، فذكره لهم، وأشيع خبر المؤامرة.
فراح بعض اليهود يلوم بعضهم الآخر على هذه الجريمة الشّنعاء؛ وفي هذه الحادثة نزل قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ هَمَّ قَوۡمٌ أَن يَبۡسُطُوٓاْ إِلَيۡكُمۡ أَيۡدِيَهُمۡ فَكَفَّ أَيۡدِيَهُمۡ عَنكُمۡۖ﴾ (المائدة: 11).
وكان طبيعيًّا أن يعمل المسلمون على إخراج بني النّضير من المدينة حتى يأمنوا في عقر دارهم من العدوّ الدّاخليّ الذي يشكّل خطرًا مع العدوّ الخارجيّ، وحتّى يفرغوا لعدوّهم الأكبر الذي أخذ يعدّ جموعه في مكّة بعد غزوة أُحد؛ ليقضي على المسلمين قضاء مبرمًا، وفي النّهاية حاصرهم المسلمون مدّة ستّة أيّام، ثمّ ألقى الله في قلوبهم الرّعب، فطلبوا من الرّسول أن يسمح لهم بالخروج من المدينة ومعهم ما تحمل الإبل إلا الدّروع([12])؛ فقبل الرّسول منهم ذلك، وخرجوا، حيث نزل بعضهم خيبر، ونزل آخرون الشّام، وكان من أشرفهم الذين نزلوا خيبر حُيي بن أخطب وسلّام بن أبي الحقيق وكنانة بن الرّبيع([13])؛ وكانت هذه الحادثة في السّنة الرّابعة من الهجرة.
وإنّ الاكتفاء من بني النّضير بالخروج من المدينة، ومعهم ثراؤهم الواسع، كان عملًا في منتهي التّسامح، وقد تغلَّب الباعث الإنسانيّ الذي قضى بهذا الحكم على الحق القانونيّ، وعلى الحرص اللّازم لحراسة أمّة ناشئة ودين جديد؛ على الرّغم من أنّ بني النّضير لم يبرهنوا على أنّهم جديرون بالعطف الذي عاملهم به الرّسول، إذ إنّهم سرعان ما غدروا وأخذوا يجمعون الجموع، ويثيرون النّاس لمهاجمة المسلمين والقضاء عليهم، وقد استجابت لهم جماعات كثيرة، كان يربط بينها كراهيّة للإسلام والكيد له، ومن أهمّ هؤلاء قريش وغطفان وبنو مرّة وغيرهم، وزحفت هذه الجماعات أو هؤلاء الأحزاب على المدينة في الغزوة التي سُمّيت بغزوة الأحزاب.
إنّ غزوة االأحزاب كانت من أشدّ ما عاناه المسلمون من ويلات، إذ جاعوا فيها حتّى ربطوا الحجارة على بطونهم، وعاشوا في سجن ضيّق يحيط بهم الأعداء من كلّ جانب، ثمّ في هذه الحالة الرّهيبة يتّصل حيي بن أخطب، أحد سادة بني النّضير الذين هاجروا إلى خيبر بـ “كعب بن أسد” سيّد بني قريظة، ويدعوه أن ينقض عهده مع المسلمين، وأن ينضمّ هو وجماعته بني قريظة إلى الأحزاب، فاستجاب كعب إلى هتاف حيي، والأمل يراود الاثنين أنّ في ذلك قضاءً نهائيًا على المسلمين([14])؛ فقد أصبح جناحهم مهيضًا بالهجوم الشّامل عليهم من الخارج، ولم يبقَ إلّا ضربة من داخل المدينة تنضمّ إلى هذه الضّربات التي تنزل من الخارج؛ لتقضي على هذا الدِّين النّاشئ. وقد صوَّر القرآن الكريم حالة المسلمين أدقَّ تصوير، فقال: ﴿إِذۡ جَآءُوكُم مِّن فَوۡقِكُمۡ وَمِنۡ أَسۡفَلَ مِنكُمۡ وَإِذۡ زَاغَتِ ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلۡقُلُوبُ ٱلۡحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠ هُنَالِكَ ٱبۡتُلِيَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَزُلۡزِلُواْ زِلۡزَالٗا شَدِيدٗا﴾ (الأحزاب: 10 و11).
وهكذا غدر بنو قريظة في أحرج الأوقات، ووجد المسلمون أنفسهم بين عدوٍّ من الأمام، وعدوٍّ من الخلف، ولما سمع الرّسول بغدر بني قريظة أرسل لهم سعد بن معاذ سيّد الأوس، وسعد بن عبادة سيّد الخزرج، وقابلا كعب بن أسيد، وسألاه وحذّراه، فسخر منهما وأظهر لهما الخشونة والبغي، ولم يسمع لرجاء منهما أو تحذير([15])؛ فيمكن أن نرى:
- كان ذنب بني قريظة عظيمًا، ولولا عون االله لهلك المسلمون.
- رأى سعد بنفسه سخريّة بني قريظة منه ومن صاحبه عندما ذهبا إليهم راجين محذّرين.
- العفو من بني قريظة وإخراجهم من المدينة سيعني بلا شكّ انضمامهم إلى بني النّضير حيث يتضاعف الخطر اليهوديّ على المسلمين.
ولهذه الأسباب كان حكم سعد بديهيًّا، إذ حكم على الخونة الغادرين بالقتل، قتل الرّجال وسبي النّساء والأطفال، وكان ذلك في العام الخامس للهجرة إثر غزوة الأحزاب؛ قال تعالى﴿۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةٗ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْۖ﴾ (المائدة: 82).
وقد برهنت الأحداث طوال القرون على شدّة عداوة اليهود للمسلمين، لقد أساءوا حتّى عندما أحسن المسلمون إليهم؛ ووجد الرّسول أنّ جانبهم لم يعد مأمونًا، فلم يكن بدٌّ من القضاء على هذا الخطر الدّاهم، هؤلاء الذين سبّبوا غزوة الأحزاب، فبدأوا يدبّرون المؤامرات الأخرى للهجوم على المدينة، بعد أن فشلوا في غزوة الأحزاب؛ ولذلك نجدُ الرَّسولَ يعدُّ العُدَّةَ للزَّحف على يهود وادي القُرى وفَدَك وتَيْماء وخَيْبَر، وكانت خَيْبَرُ أقوى حصونِ اليهودِ وأخطرَها. ولذلك بدأ الرَّسولُ زَحْفَه على مناطقِ اليهود، وكان ذلك سنةَ 7هـ، بعد أن هدأت العداوةُ بين المسلمين وبين قريش، وعُقِد بينهما صُلْحُ الحُديبية، وحاصرَ المسلمون خَيْبَر، وامتدَّ الحصارُ وطال، وأخذت حصونُ اليهودِ بها تتساقط بسهولةٍ أو بصعوبةٍ في يدِ المسلمين. ([16]) ولم يجد اليهود بدًّا من أن يستسلموا، واتّفق معهم المسلمون اتّفاقًا سمحًا، مرّة أخرى فقد اكتفى رسول الله (ﷺ( بمقاسمتهم الزّرع و الثمار([17])؛ وكان يقصد من ذلك أن يكون له الإشراف عليهم حتّى لا يعودوا إلى ألوان الغدر مرّة أخرى.
ولمّا تهاوت حصون خيبر اتّفق يهود فدك على الشّروط التي نزل عليها يهود خيبر([18])؛ أمّا يهود وادي القرى وتيماء فقد امتنعوا وقاتلوا فهزمهم المسلمون، ثمّ تركوهم على النّخل والأرض على نظام خيبر([19])؛ وتكسّرت بذلك شوكة اليهود، وإن كانت الشّوكة لم تُزَل نهائيًا وبقيت حينًا، ومدميّة كلّما وجدت سبيلًا إلى الإيذاء.
وبما يتّصل بخيبر أنّه بعد الانتهاء منها، قدّمت امرأة يهوديّة اسمها زينب بنت الحارث بن سلام شاة مشوية للرّسول، دسّت فيها السّمّ، وأكثرت منه في ذراعي الشّاة، حيث عرفت أنّ رسول الله (ﷺ (يحبّ من الشاة ذراعها، فلمّا وضعت الشّاة بين يدي الرّسول (ﷺ( تنازل الذّراع، فلاك منها مضغة فلم يستسغها ولفظها، وكان يأكل معه بشر بن البراء، ولكنه تعجّل فابتلع ما وضعه في فمه، وقال الرّسول: “إنً هذه الذّراع لتخبرني أنّ الشّاة مسمومة”، ودعا المرأة فاعترفت، فسألها الرّسول:
- ما حملك على ذلك ؟ فقالت:
- بلغت من قولي ما لم يخف عليك: إن كان ملكًا استرحنا منه، وإن كان نبيًّا فسينجو. وقيل إنّها دخلت الإسلام، فعفا عنها الرّسول، وقيل قتلها الرّسول بالبراء الذي مات من هذا الطّعام([20]).
وامتدّ الإسلام في عهد الخلفاء الرّاشدين، وتجاوز أرض خيبر في طريقه إلى فارس والرّوم، وأصبح يهود خيبر في ظهر المسلمين، فخاف عمر خطرهم، وخشي أن يضربوا المسلمين من الخلف، كما فعلوا من قبل، ورأى ضرورة ضمان السّلامة والوحدة في الجزيرة العربيّة، قبل أن تتعمّق جيوشه خارج المدينة، وأنّ الأوان قد آن لتنفيذ وصيّة رسول الله (ﷺ(: ألّا يجتمع بجزيرة العرب دِينان([21]) وزيادة على ذلك يروي البلاذري([22]): “أنّ يهود خيبر عاثوا في الإسلام وغشوهم، فألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه”؛ لذلك استقرَّ رأي عمر على إجلاء مَن لم يكن لديهم عهد من رسول الله (ﷺ(، فقحّم أرضهم ومساكنهم ونخلهم ودفع لهم قيمتها وأجلاهم إلى الشّام. أمّا مَن كان له عهد من رسول الله (ﷺ( فقد بقي في موطنه وعلى دينه بالشّروط التي ذكرت في هذه العهود([23]). وقال ابن إسحاق([24]):
وكان ممّن تعوَّذ بالإسلام ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو منافق من أحبار يهود من بني قيْنَقاع: سعد بنُ حُنيف وزيد بن اللّصَيْت الذي قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسوق بني قينقاع، وهو الذي قال حين ضلّت ناقة رسول الله (ﷺ(: يزعم محمّدٌ أنّه يأتيه خبرُ السّماء وهو لا يدري أين ناقته! فقال رسول الله (ﷺ( وجاءه الخبر بما قال عدو الله في رَحْله، ودلَّ الله تبارك وتعالى رسوله (ﷺ( على ناقته: إنّ قائلًا قال: يزعمُ محمّدٌ أنّه يأتيه خبرُ السّماء ولا يدري أين ناقته؟ وإني والله ما أعلم إلّا ما علَّمني الله، وقد دلَّني الله عليها، فهي في هذا الشّعب، قد حبستها شجرة بزمامها، فذهب رجال من المسلمين، فوجدوها حيث قال رسول الله (ﷺ( وكما وصف.
ورافع بن حُرَيملة، وهو الذي قال له رسول الله (ﷺ( – فيما بلغنا – حيث مات: قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين. ورفاعة بن زيد بن التابوت، وهو الذي قال له رسول الله (ﷺ( حين هبّت عليه الريح وهو قافلٌ من غزوة بني المصطلق([25])، فاشتدّت عليه حتّى أشفق المسلمون منها، فقال لهم رسول الله (ﷺ(: لا تخافوا، فإنّما هبّت لموتِ عظيمٍ من عظماء الكفّار. فلما قدِم رسول الله (ﷺ( المدينة وجد رفاعة بن زيد بن التّابوت مات ذلك اليوم الذي هبّت فيه الريح، وسِلْسلة من بَرْهام، وكِنانة بن صُوريا.
وكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد فيستمعون أحاديث المسلمين، ويسخرون ويستهزئون بدينهم، فاجتمع يومًا في المسجد منهم ناسٌ، فرآهم رسول الله (ﷺ( يتحدثون بينهم، خافضي أصواتهم قد لَصِق بعضهم ببعض، فأمر بهم رسول الله (ﷺ( فأُخرجوا من المسجد إخراجًا عنيفًا، فقام أبو أيّوب، خالد بن زيد بن كُلَيب، إلى عمرو بن قيس، أحد بني غَنْم بن مالك بن النّجار – كان صاحب آلهتهم في الجاهليّة – فأخذ برجْله فسحبه، حتّى أخرجه من المسجد وهو يقول : أتُخرجني يا أبا أيّوب من مِرْبد بني ثعلبة! ثمّ أقبل أبو أيّوب أيضًا إلى رافع بن وديعة، أحد بني النّجار، فلبَّبه بردائه ثم نَتَره([26]) نترًا شديدًا، ولطم وجهه، ثمّ أخرجه من المسجد وأبو أيّوب يقول له: أُفٍّ لك منافقًا خبيثًا! أدراجَك يا منافق من مسجد رسول الله (ﷺ(. قال ابن هشام: أي ارجع من الطّريق التي جئت منها.
وقام عمارة بن حَزم إلى زيد بن عمرو، وكان رجلاّ طويل اللّحية، فأخذ بلحيته فقاده بها قَوْدًا عنيفًا حتّى أخرجه من المسجد، ثمّ جمع عُمارة يديه فلطمه بهما في صدره لطْمة خَرَّ منها. قال: يقول خَدَشتني يا عمارة، قال: أبعدك الله يا منافق، فما أعدّ الله لك من العذاب أشدّ من ذلك فلا تقربنَّ مسجد رسول الله (ﷺ(. قال ابن إسحاق:
وقام أبو محمّد، رجل من بني النجار، كان بدريًّا، وأبو محمّد مَسعود بن أوْس بن زَيْد بن أصرم بن زيد بن شعلبة بن غنم بن مالك بن النّجار، إلى قيس بن عمرو بن سها، وكان قيس غلامًا شابًّا، وكان لا يعلم في المنافقين شاب غيره، فجعل يدفع في قفاه حتّى أخرجه من المسجد.
وقام رجل من بَلْخُدرة([27]) بن الخزرج، رهط أبي سعيد الخُدري، يقال له عبد الله بن الحارث، حين أمر رسول الله (ﷺ( بإخراج المنافقين من المسجد إلى رجل يقال له: الحارث بن عمرو، وكان ذا جُمّة فأخذ بجمته فسحبه بها سحبًا عنيفًا، على ما مرّ به من الأرض حتّى أخرجه من المسجد. قال: يقول المنافق: لقد أغلظت يا ابن الحارث، فقال له: إنك أهلٌ لذلك، أي عدوّ الله، لما أنزل الله فيك، فلا تقربنّ مسجد رسول الله (ﷺ( فإنّك نَجس.
وقام رجل من بني عَمرو بن عوف إلى أخيه زُوَي بن الحارث، فأخرجه من المسجد إخراجًا عنيفًا، وأنف منه([28])، وقال: غلب عليك الشيطان وأَمْره.
فهؤلاء من حضر المسجد يومئذٍ من المنافقين وأمر رسول الله (ﷺ( بإخراجهم([29]) .
صلح الحديبية
لم تخمد مشاعر المسلمين في المدينة شوقًا إلى مكّة التي حيل بينهم وبينها ظلمًا وعدوانًا، وما برحوا ينتظرون اليوم الذي تُتاح لهم فيه فرصة العودة إليها والطّواف ببيتها العتيق، إلى أن جاء ذلك اليوم الذي برز فيه النّبيّ (ﷺ( على أصحابه؛ ليخبرهم برؤياه التي رأى فيها دخوله لمكّة وطوافه بالبيت، فاستبشر المسلمون بهذه الرّؤيا؛ لعلمهم أنّ رؤيا الأنبياء حقّ، وتهيّؤوا لهذه الرّحلة العظيمة.
فلما نزل الرّسول بالحديبية أرسل عثمان رضي الله عنه إلى قريش وقال له: أخبرهم أنّا لم نأت لقتال، وإنّما جئنا عُمَّارًا، وادْعُهم إلى الإسلام.
ولكنّ عثمان احتبسته قريش، فتأخّر في الرّجوع إلى المسلمين، فخاف الرّسول (ﷺ( عليه، وخاصّة بعد أن شاع أنّه قد قتل، فدعا إلى البيعة، فتبادروا إليه وهو تحت الشجرة، فبايعوه على أن لا يفرُّوا، وهذه هي بيعة الرّضوان التي أنزل الله فيها قوله: ﴿لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ ١٨﴾ (الفتح: 18).
وأرسلت قريش عروة بن مسعود إلى المسلمين فرجع إلى أصحابه، فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك – كسرى، وقيصر، والنّجاشي – والله ما رأيت ملكًا يعظّمه أصحابه كما يعظّم أصحاب محمّد محمّدًا. والله ما انتخم نخامة إلّا وقعت في كفّ رجل منهم، فدلّك بها وجهه وجلده، وإذا أمر ابتدروا أمره، وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النّظر تعظيمًا له، ثمّ قال: وقد عرض عليكم خطّة رشد فاقبلوها.
ثمّ أسرعت قريش في إرسال سهيل بن عمرو لعقد الصّلح، فلمّا رآه النّبيّ (ﷺ( قال: قد سهل لكم أمركم، أراد القوم الصّلح حين بعثوا هذا الرّجل، فتكلم سهيل طويلًا ثمّ اتّفقا على قواعد الصّلح، وهي:
- الأولى: رجوع الرّسول (ﷺ( وأصحابه من عامه وعدم دخول مكّة، وإذا كان العام القادم دخلها المسلمون بسلاح الراكب، فأقاموا بها ثلاثًا.
- الثّانية : وضع الحرب بين الطّرفين عشر سنين، يأمن فيها النّاس.
- الثّالثة: من أحبّ أن يدخل في عقد مع محمد وعهده دخل فيه، ومن أحبّ أن يدخل في عقد مع قريش وعهدهم دخل فيه.
- الرّابعة: من أتى محمّدًا من قريش من غير إذن وليّه ردّه إليهم، ومن جاء قريشًا ممّن مع محمد لم يردّ إليه.
ثمّ قال الرّسول (ﷺ(: هات اكتب بيننا وبينك كتابًا، فدعا الكاتب – وهو عليّ بن أبي طالب – فقال:
اكتب: بسم الله الرّحمن الرّحيم، فقال سهيل: أمّا الرحمن فما أدري ما هو؟ ولكن اكتب: باسمك اللّهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلّا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال (ﷺ(: اكتب باسمك اللّهم، ثمّ قال: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمّد رسول الله، فقال سهيل: والله لو نعلم أنّك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولكن اكتب محمّد بن عبد الله، فقال: إنّي رسول الله، وإن كذّبتموني، اكتب محمّد بن عبد الله، ثم كُتبت الصّحيفة، ودخلت قبيلة خزاعة في عهد رسول الله (ﷺ(، ودخلت بنو بكر في عهد قريش.
فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل، وقد خرج من أسفل مكّة يرسف – يمشي مقيّدًا – في قيوده، حتّى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل : هذا يا محمّد! أوّل ما أقاضيك عليه أن تردّه إليّ، فقال النّبيّ (ﷺ(: إنّا لم نقض الكتاب بعد، فقال: إذن، والله، لا أصالحك على شيء أبدًا. فقال النّبيّ: فأجزه لي، قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى، فافعل، قال: ما أنا بفاعل. قال أبو جندل: يا معشر المسلمين كيف أردّ إلى المشركين وقد جئت مسلمًا؟ ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابًا شديدًا.
فلمّا فرغ من قضيّة الكتاب، قال رسول الله (ﷺ( لأصحابه: قوموا فانحروا، ثم احلقوا، وما قام منهم رجل، حتّى قالها ثلاث مرات. فلمّا لم يقم منهم أحد، قام ولم يكلّم أحدًا منهم حتّى نحر بدنه ودعا حالقه، فلمّا رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتّى كاد بعضهم يقتل بعضًا. ثم جاء نسوة مؤمنات، فأنزل الله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ﴾ (الممتحنة: 10)؛ وفي مرجعه (ﷺ(: أنزل الله سورة الفتح: ﴿إِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحٗا مُّبِينٗا لِّيَغۡفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ (الفتح: 1و2)، فقال عمر: أَو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم، قال الصّحابة: هذا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (الفتح: 4 و5)
ولمّا رجع إلى المدينة جاءه أبو بصير – رجل من قريش – مسلمًا، فأرسلوا في طلبه رجلين، وقالوا: العهد الذي بيننا وبينك، فدفعه إلى الرّجلين، فخرجا به، حتى بلغا ذا الحليفة. فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحدهما: إنّي أرى سيفك هذا جيّدًا. فقال: أجل والله إنّه لجيّد، لقد جربت به ثم جربت، فقال: أرني أنظر إليه. فقتله بسيفه ورجع أبو بصير إلى المدينة، فقال : يا نبيّ الله ! قد أوفى الله ذمّتك، قد رددتني إليهم، فأنجاني الله منهم، فقال (ﷺ(: ويل أمّه مسعّر حرب، لو كان له أحد. فلمّا سمع ذلك عرف أنّه سيردّه إليهم، فخرج حتّى أتى سيف البحر، وتفلت منهم أبو جندل فلحق بأبي بصير، فلا يخرج من قريش رجل – قد أسلم – إلّا لحقه، حتّى اجتمعت منهم عصابة. فما سمعوا ببعير لقريش خرجت إلى الشّام إلّا اعترضوا لها، فقاتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النّبيّ (ﷺ( تناشده الله والرّحم أنّ من أتاه منهم فهو آمن.
وكان هذا الصّلح فتحًا عظيمًا ونصرًا مبينًا للمسلمين، وذلك لما ترتّب عليه من منافع عظيمة، حيث اعترفت قريش بالمسلمين وقوتهم، وتنازلت عن صدارتها الدّنيويّة وزعامتها الدّينيّة، فلا عجب إذًا أن يسمّيه الله تعالى فتحًا مبينًا([30]).
معاهدات مع الأعداء من يهود
قال ابن إسحاق: “ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله (ﷺ( العداوة بغيًا وحسدًا، وضغنًا لما خصّ الله تعالى به العرب من أخذه رسوله منهم، وانضاف إليهم رجال من الأوس والخزرج، ممّن بقي على جاهليّته، فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشِّرك والتّكذيب بالبعث، إلّا أنّ الإسلام قبرهم بظهوره، واجتماع قومهم عليه، فأظهروا الإسلام، ونافقوا في السّرّ، وكان هواهم مع يهود لتكذيبهم النّبيّ (ﷺ( وجحودهم الإسلام، وكانت أحبار يهودهم الذين يسألون رسول الله (ﷺ( ويتعنّتونه ( يشقون عليه) ويأتون باللَّبس ليلبسوا الحقّ بالباطل، فكان القرآن يُنزّل فيهم يسألون عنه إلّا قليلًا من المسائل في الحلال والحرام، وكان المسلمون يسألون عنها”([31]). ومنهم: حُيَيّ بن أخطب، وأخواه أبو ياسر بن أخطب، وجُدَيِّ بن أخطب، وسلام بن مِشْكم، وكنانة بن الرّبيع بن أبي الحقيق، وسلام بن أبي الحُقَيق، وأبو رافع الأعور، وهو الذي قتله أصحاب رسول الله (ﷺ( بخيبر، والرّبيع بن الرّبيع بن أبي الحُقَيق، وعمرو بن جَحَّاش بن عمرو، حليف كعب بن الأشرف، وكرْدم بن قيس، حليف كعب ابن الأشرف، هؤلاء من بني النّضير.
ومن بني ثعلبة بن النِطْيَون([32]): عبد الله بن صُوريا([33]) الأعور، ولم يكن من بني ثعلبة بالحجاز في زمانه أحد أعلم بالتواره منه، وابن صَلُوبا ومُخَيريق، وكان حَبْرَهم فأسلم.
ومن بني قيْنُقاع: زيد بن اللَّصيت، ويقال: ابن اللُّصَيت، فيما قال ابن هشام، وسعد بن حُنيف، ومحمود بن مَسْيحاه، وعُزير بن أبي عنبر، وعبد الله بن صَيْف. قال ابن هشام: ويقال: ابن ضيْف.
وقال ابن إسحاق: وسُويد بن الحارث، ورفاعة بن قيس، وفِنحاص، وأشْيع، ونُعمان بن أضا، وتَجريّ بن عمرو، شاس بن عدي، وشأس بن قيس، وزيد بن الحارث، ونعمان بن عمرو، وسُكين بن أبي سُكين، وعدي بن زيد، ونعمان بن أبي أوْفى، وأبو أنس، ومحمود بن دَحْين، ومالك بن صيف. قال ابن هشام: ويقال ابن ضيف.
قال ابن إسحاق: ورافع بن حارثة، ورافع بن حُويملة، ورافع بن خارجة، ومالك بن عوف، ورفاعة بن زيد، بن التّابوت، وعبد الله بن سلام بن الحارث، وكان حَبرهم، وأعلمهم، وكان اسمه الحصين، فلما أسلم سمّاه رسول الله (ﷺ( عبد الله، فهؤلاء من بني قينقاع.
ومن بني قريظة: الزّبير بن باطا بن وهب، وغزّال بن شمدين، وكعب بن أسد، وهو صاحب عقد بني قُريظة الذي نُقض عام الأحزاب، وشمدين بن زيد، وجبل بن عمرو بن سُكينة، والنحّام بن زيد، وكردم بن كعب، ووهب بن زيد، ونافع بن أبي نافع، وعدي بن زيد، والحارث بن عَوْف، وكردم بن زيد، وأسامة بن حبيب، ورافع بن رُحَيلة، وجبل بن أبي قشير، ووهب بن يهودا. فهؤلاء من بني قريظة.
ومن يهود بني زُرَيق: لبيد بن أعْصم، وهو الذي أخذ رسول الله (ﷺ( عن نسائه.
ومن يهود بني حارثة: كنانة بن صُورِيا.
ومن يهود بني عمرو بن عَوْف: مَرْدم بن عمر.
ومن يهود بني النجار: سلسلة بن بَرْهام.
فهؤلاء أحبار يهود، وأهل الشّرور والعداوة لرسول الله (ﷺ(.
ولم يتّجه الرّسول (ﷺ( في بداية الأمر إلى سياسة إبعاد اليهود أو مصادرة أموالهم أو الخصومة معهم؛ وكان رسول الله (ﷺ( قد عاهد بني قريظة ألّا يحاربوه ولا يعاونوا عليه المشركين فنقضوا العهد، وأعانوا عليه كفّار مكّة بالسّلاح يوم بدر، ثمّ قالوا: نسينا، وأخطأنا مرّة أخرى، فنقضوا ومالؤوا الكفّار يوم الخندق.
ومن أهمّ بنود هذه المعاهدة:
- أنّ يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وإليهم وأنفسهم، كذلك لعمر بن عوف من اليهود.
- وأنّ على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم.
- وأنّ بينهم النّصر على مَن حارب أهل هذه الصّحيفة.
- وأنّ بينهم النّصح والنّصيحة، والبرّ دون الإثم.
- وأنّ النّصر للمظلوم.
- وأنّ ما كان بين أهل هذه الصّحيفة من حدث، أو اشتجار يخاف فساده، فإنّ مردّه إلى الله عزّ وجلّ وإلى محمَّد رسول الله (ﷺ(.
- وإنّه لا تُجار قريش ولا مَن نصرها.
- وإنّ بينهم النّصر على من دهم يثرب، على كلّ أناس حصّتهم من جانبهم الذي قبلهم.
- وإنّه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم([34]).
وبهذه الاتّفاقية أصبح رئيس المدينة – إنّ صحَّ التّعبير – رسول الله (ﷺ( والكلمة النّافذة، والسّلطان الغالب فيها المسلمين، وبذلك أصبحت المدينة عاصمة حقيقيّة للإسلام.
وإلى جانب هذه الفئات العربيّة التي واجهت الرّسول بمعارضتها ودمائها حين قدم إلى المدينة، وظهر بعض من آثاره في اجتماع السّقيفة بعد وفاته، كانت الجماعات اليهوديّة التي أدركت أنّ قدوم الرّسول إلى يثرب هو فاتحة عهد جديد، لن تكون لهم فيه الكلمة الأولى، ولا المكان القياديّ، فعملوا ما في وسعهم للتّخلّص منه، والإيذاء بحياته، ولكنّ نصر الله كان لكيدهم بالمرصاد.
ونزل أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه على خُبيب بن إساف، أحد بني الحارث من الخزرج بالسّنح، ويقول قائل: كان منزله على خارجة بن زيد، بن أبي زهير، أخي بني الحارث من الخزرج.
وأقام عليّ بن أبي طالب عليه السّلام بمكّة ثلاث ليال وأيّامها حتّى أدى عن رسول الله (ﷺ( الودائع التي كانت عنده للنّاس، حتّى إذا خرج منها لحق برسول الله (ﷺ( فنزل معه على كلثوم بن هدم([35]).
وعلى الرّغم من أهمّيّة المعارضة التي واجهها الرّسول من بعض العناصر السّكّانيّة في يثرب إبّان وصوله إليها، فقد ظلّت المشكلة الاقتصاديّة هي المشكلة الأهمّ والأكثر إلحاحًا، إذ نبعت من واقع أصحابه المهاجرين الذين تركوا أموالهم في مكّة، وغادروها مملقين، لا أمل لهم في العودة، أو استرداد ما يملكون. واضطرّ النّبيّ (ﷺ( في سبيل حلّ هذه المعضلة أن يعمل بنظام المؤاخاة الذي هدف إلى جانب حلّ المشكلة الاقتصاديّة إلى تحسين الرابطة بين المهاجرين والأنصار، وتوكيد وحدة المجتمع الإسلامي في المدينة، بشقَّيه: الأنصار والمهاجرين، حتّى نظام المؤاخاة، على ما تذكر المصادر، نصّ على حقّ التّوارث بين المتآخين دون الأرحام.
آخى بينهم على الحقّ والمواساة، ويتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام، وكانوا تسعين رجلًا، خمسة وأربعين من المهاجرين وخمسة وأربعين من الأنصار، وكان ذلك قبل بدر، فلمّا كانت وقعة بدر، وأنزل الله تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ﴾ (الأنفال: 75) فنسخت هذه الآية ما كان قبلها، وانقطعت المؤاخاه في الميراث، ورجع كلُّ إنسان إلى نسبه وورثه ذوو رحمه([36]). وعلى الرّغم من أنّ العمل بهذا النّظام قد أوقف بعد غنائم بدر، وما أفاء الله على المسلمين من غنائم وأموال سدَّت عوز المحتاجين، فإنّه يبدو واضحًا، أنّه لهدف آخر، وهو هدف تحسين الصّلة بين شقّي الجماعة الإسلاميّة، ظلَّ دون المستوى الذي كان يريده له صاحب الرّسالة، وسيِّد الجماعة، وأطلّ برأسه واضحًا قويًّا حين انتقل إلى جوار ربّه.
وإذا تجاوزنا ما لقيه الرّسول (ﷺ( من معارضة بعض الفئات في المدينة، والمصاعب الاقتصاديّة التي عايشها بعض من صحابته، لوجدنا أنه، بعد أن وطّد الأمور، وذلَّل هذه الصّعاب، كانت تنتظره مهمّة أصعب، وهي: وضع الأسس التي لا بدّ منها لتنظيم العلاقات بين هذه العناصر السّكّانية التي لا تجمعها وحدة عصبيّة، أو وحدة عقائديّة أو وحدة المصلحة.
الخاتمة
يتّضح من خلال مجمل ما سبق أنّ المجتمع العربيّ في صدر الإسلام شهد تحوّلًا عميقًا شمل البنيّة الدّينيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة، وذلك بفضل ما رسّخه الإسلام من مبادئ العدل والمساواة، وما وفّرته الفتوحات من موارد مكّنت الدّولة النّاشئة من تثبيت أركانها. ومع ذلك، لم تكن هذه الوفرة الاقتصاديّة وهذا الاستقرار الاجتماعيّ بمنأى عن التّهديدات، وفي مقدمتها الخطر اليهوديّ المتمثّل في نقض العهود وإثارة الفتن والتّحالف مع أعداء المسلمين، الأمر الذي فرض مواجهة متدرّجة وحازمة بدأت بالمعاهدات والمسالمة، ثم انتقلت إلى الدّفاع المشروع، وصولًا إلى تحييد هذا الخطر سياسيًّا وعسكريًّا.
كما بينت الدّراسة أنّ الإسلام لم يجعل القوة الماديّة وسيلة أساسيّة لنشر دعوته، بل اعتمد على الإقناع بالحجة والموعظة الحسنة، وكان السّلم والصّلح – كما في صلح الحديبية – من أبرز المحطّات التي شهدت اتّساعًا ملحوظًا في دخول النّاس إلى الإسلام. وبالموازاة، أسهمت سياسات المؤاخاة وتنظيم العلاقات بين المهاجرين والأنصار وإدارة شؤون المدينة في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التّحديّات الدّاخليّة والخارجيّة.
إنّ قراءة هذه المرحلة التّاريخيّة تكشف عن وعي القيادة النّبويّة بأهمية الجمع بين القيم الرّوحيّة والمرونة السّياسيّة والحزم العسكريّ، بما يحقّق حماية الدّعوة واستمرار الدّولة. وتظلّ تجربة صدر الإسلام مثالًا بارزًا على أنّ نهضة الأمم لا تُبنى على الانتصارات العسكريّة أو الوفرة الاقتصاديّة وحدها، بل على منظومة قيميّة وأخلاقيّة تحفظ وحدة الصّف وتصوغ هويّة الأمّة.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن الأثير، 1979م، الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري، دار صادر، بيروت، لبنان، ط 1 ، ج 1.
- ابن سعد، ١٩٩٠م، الطبقات الكبرى ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط ١، ج ١
- ابن هشام، عبدالملك،( 1955م )، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفي السقا، وإبراهيم الإبياري، وعبدالحفيظ الشلبي، شركة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط 2.
- محمد بكار زكريا، السيرة النبوية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان 1417هـ / 1997م.
- الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير ( 1387هـ )، تاريخ الطبري – تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ذخائر العرب، القاهرة، دار المعارف 1962 م.
- علي، جواد، ( 2001م )، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، بيروت، ط 4.
- الدوري، عبد العزيز، ٢٠٠٧م، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، ط ٢.
- النووي ، يحيي بن شرف، ١٩٩٦م، تهذيب الأسماء واللغات، دار الفكر، بيروت، لبنان ، ج ١.
([1]) جامعة الجنان/ مكتب التّدقيق اللّغويّ Email: jouhayna.masri1234@gmail.com
([2]) مقدّمة في صدر الإسلام، ص 87 – 88.
([5]) السيرة النبوية لابن هشام، 2/ 73 – 76.
([6]) المصدر السابق، 2/ 81 – 84. وراجع الطّبقات لابن سعد، 1/ 219 – 229.
([7]) تهذيب الأسماء للنّووي، 1/271.
([8]) الكامل في التّاريخ لابن الأثير، 2/ 56.
([9]) السيرة النبوية لابن هشام، 2/ 120، وراجع تاريخ الطبري – تاريخ الرسل والملوك، 2/ 172، وفتوح البلدان للبلاذري، ص 23.
([10]) فتوح البلدان للبلاذري، ص 23 – 24.
([11]) السيرة النبوية لابن هشام، 2/ 176.
([12]) فتوح البلدان للبلاذري، ص 24.
([13]) السّيرة النّبويّة لابن هشام، 2/ 178.
([17]) فتوح البلدان للبلاذري، ص 37.
([20]) السّيرة النّبويّة لابن هشام، 2/ 240 -242.
([21]) المصدر السابق، ج2 ، ص 249.
([22]) فتوح البلدان للبلاذري، ص 36 – 42.
([23]) تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي، 6/ 172.
([24]) بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أبو محمد عبدالله بن هشام، قال حدثنا زياد بن عبدالله البكائي، قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبيّ قال؛ السّيرة النّبويّة لابن هشام، 2/ 174 – 176.
([25]) وتسمّى أيضاً غزوة المريسيع، سمع النبي باجتماع قبيلة بني المصطلق استعداداً للإغارة على المدينة، فما كان منه (ﷺ( إلا أن جمع المسلمين وانطلق إليهم لرد شرهم، وكان خروجه من المدينة في 2 شعبان سنة 6 هـ حيث باغتهم عند منطقة تعرف بماء المريسيع، وعندها نصر الله نبيّه وردّ كيدهم وانتصر المسلمون انتصاراً كبيرًا.
([27]) بلخدرة، زيد بني الخدرة: وقد ذكره أبو ذر في رواية أخري على أنها في الأصل، فقال: (وقام رجل من بلخدرة صوابه: من الأبجر، يريد بني الأبجر، فحذف كما بثاً – في بني الحارث: بلحارث. وقد يخرج ما ذكر علي نقل الحركة، ورواه بعضهم بلخدرة، يريد بني الخدرة.
([29]) السيرة النبوية لابن هشام، ج2 ، ص 176 – 177.
([30]) السّيرة النّبويّة لابن هشام، 3/ 331 – 337. وراجع تاريخ الطبري، 2/ 425 – 427.
([31]) السّيرة النّبويّة لابن هشام، 2/ 160. وراجع كتاب السّيرة النّبويّة لمحمّد بكّار زكريّا، ص 102 – 104.
([32]) النّطيّون: كلمة عبرانيّة، وهي تطلق على كل مَن وُليّ أمر اليهود وملكهم.
([34]) السّيرة النّبويّة لسيّد المرسلين وخاتم النبيين لمحمَّد بن بكّار زكريّا، ص 102 – 104.