جوانب من نظريّة الخطاب: تعريفه وفصاحته
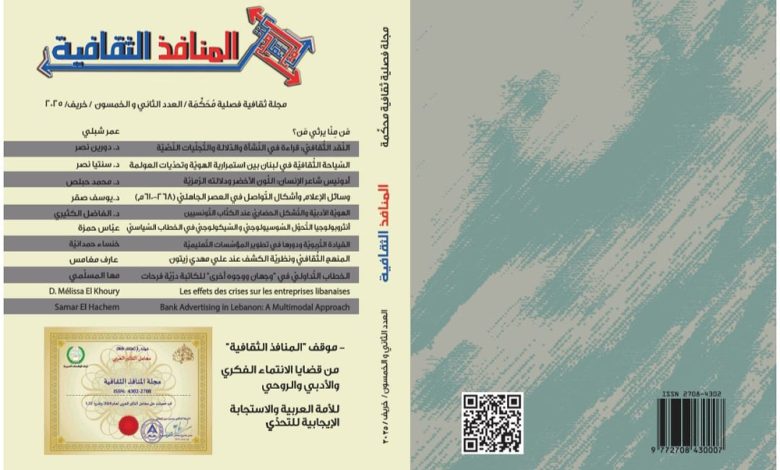
جوانب من نظريّة الخطاب: تعريفه وفصاحته
Aspects of Discourse Theory: Definition and Eloquence
د. كميل أ. مخايل([1])
Dr. Kamil A. Mikhael
تاريخ الاستلام 4/ 7/ 2025 تاريخ القبول 30/ 7/2025
ملخّص
يتحرّى هذا البحث جوانب محدّدة من نظريّة الخطاب في ضوء التبصّرات التي نتجت عن حركة ما بعد البنيويّة. يبدأ البحث بتقصّي فلسفة حركة ما بعد البنيويّة وأفكارها النّقديّة التي طالت البنيويّة. وفي المبحث الثّاني يدرس البحث موضوع الخطاب ودوره الرّئيس في أدبيات مفكري حركة ما بعد البنيويّة، ثم يتتبع البحث تطور تعريف الخطاب وتنوعه وعلاقته بالعالم الواقعي. وفي المبحث الرّابع يتقصّى البحث موضوع فصاحة الخطاب وأساليبه الدّلاليّة واستراتيجياته التّداوليّة مثل استخدام الاستلزام التّخاطبيّ. يعرض المبحث الأخير نتائج الدّراسة ويبحث موضوع التّنظير في الخطاب باللجوء إلى إطار جديد، وهو الجمع بين الإبداع ودور الإدراك، أي دراسة ما هو خاصّ وعامّ في دراسات الخطاب.
الكلمات المفتاحيّة: ما بعد البنيويّة، نظريّة الخطاب، الدّال الفارغ، فصاحة، نظريّة التّركيب الاجتماعيّ.
Abstract
This research explores various aspects of discourse theory through the lens of insights gained from poststructuralism. This research first investigates the philosophy of poststructuralism and its critical ideas that address structuralism. The second section of the research examines discourse and its fundamental role in the literature of poststructuralist thinkers, and then it traces the evolution of discourse definitions, their variety, and their relationship to the real world. The third section investigates discourse eloquence, semantics, and pragmatic strategies, including implicature. The final section presents the research findings and examines the theorization of discourse through a new framework that combines creativity and cognition. This approach focuses on analyzing what is unique (particular) and shared (public) within discourse studies.
Keywords: poststructuralism, discourse theory, empty signifier, eloquence, social constructionism.
مقدمة
أسهمت الإنجازات العلميّة التي شهدها منتصف القرن العشرين في انتشار المعرفة وتعزيز الثّقافة عند الشّعوب، ما أدّى إلى مضاعفة النّتاج الأدبيّ والفكريّ، وترافق ذلك وظهور النّظريات الأدبيّة واللّسانيّة المتنوّعة، ومنها نظريّة الخطاب التي تأثّرت بعلوم كثيرة، أهمها: فلسفة اللّغة وعلم الاجتماع وعلم النّفس والسّيميائيّة والنظريّة النّقديّة. ازدهرت هذه العلوم في مرحلة زمنيّة متقاربة متأثرة ببوتقة من التّغيّرات الاجتماعيّة والأحداث السّياسيّة التي جرت في المرحلة المذكورة؛ أضف إلى ذلك الدّور التّنظيريّ الذي تولّاه عدد من الفلاسفة، منهم على سبيل المثال ميشال بيشو (Michel Pêcheux) ويورغن هابرمس (Jürgen Habermas)، فأدّى ذلك كلّه بدوره إلى انفجار معرفيّ استفادت منه نظريّة الخطاب لاحقًا، حيث عرفت أفكارًا جديدة، وازداد منهجها النقديّ غنىً، إذ ضمَّ آفاقًا تحليليّة علمية لم تكن لتوجد سابقًا.
يتناول هذا البحث جزءًا رئيسًا من هذه التّطوّرات، ويدرس أيضًا تطوّر تعريف الخطاب وعلاقة ذلك بالآفاق التّحليليّة المتنوّعة من جهة، والكفاءة المنهجيّة لتحليل الخطاب من جهة أخرى. والجدير ذكره هنا أنّ هذه المنهجيّة التّحليليّة قسّمت الخطاب من حيث علاقته بالواقع الماديّ إلى مكوِّن ومكوَّن، وهو أيضّا موضوع سيتطرَّق البحث إليه.
- ما بعد البنيويّة والخطاب
بادئ ذي بدء، رفضت حركة ما بعد البنيويّة (Poststructuralism) بعض المفهومات البنيويّة مثل عقلنة المفهومات وعولمتها، ويعدُّ الفيلسوف الفرنسيّ جاك دريدا (Jacques Derrida) أوّل من استهلّ هذه المواقف النّقديّة في ورقة بحثية قدمها عام 1966 في مؤتمر عقد في الولايات المتحدة الأميركية. يمكن تعريف ما بعد البنيويّة على النّحو الآتي: هي مجموعة من المواقف يتخذها المرء تجاه عملية التّواصل وتاريخها المديد، ويتبنّى النّاقد أو المفكر هذه المواقف في خضم فهم الأحداث وتأويلها([2]).
ويشرح تيري إيغلتون (Terry Eagleton) أحد أبرز النقاد الأدبيين فكرة ما بعد البنيويّة بنصٍّ معبّر، يقول: إذا البنيويّة فرّقت بين العلامة اللّغويّة ومرجعها، فإنّ حركة ما بعد البنيويّة ذهبت أبعد من ذلك وفرقت بين الدّال والمدلول. ]يتابع إيغلتون شارحا[: بعبارات أخرى ما قلناه للتو هو أنّ المعنى غير موجود بشكل مباشر في العلامة اللّغويّة. وبما أن معنى أيّ علامة يعتمد على ما ليست عليه العلامة، فإنّ معنى العلامة اللّغويّة غائب عنها أيضا. المعنى إذا أردت مبعثر أو منتشر على امتداد سلسلة الدوالّ كلّها، لذلك لا يمكن أن نحدّده بدقة، أي المعنى، فهو غير موجود في أية علامة منفردة، إنما هو نوع دائم من الحضور المتذبذب والغياب في الوقت نفسه([3]).
أريد أن أتوقّف هنا شارحا ما ورد أعلاه، فقد حاول إيغلتون شرح العلاقة بين المعنى والعلامة اللّغويّة والتواصل في ضوء مفهومات حركة ما بعد البنيويّة. وأساس ذلك هو نقد أفكار منظري البنيويّة الذين كانوا قد انطلقوا من فكرة النظام اللّغويّ ودراسته دراسة آنيّة، أي أنّ النظام المذكور هو نظام مستقل عن الواقع السّياسيّ والاجتماعيّ، وهو ما تجسّد بفكرة ابتعادهم عن دراسة أثر التّاريخ في النظام اللّغويّ. وفي الواقع يذكر أكثر من باحت أن عناصر القوة في البنيويّة هي أيضا عناصر ضعفها، وهذا ما حثّ حركة ما بعد البنيويّة على إعادة صياغة أفكارهم النّقديّة صياغة تضمن الاتساق فيما بينها من جهة، وتضمن إعادة تحديد العلاقة بين اللّغة والواقع الاجتماعيّ من جهة أخرى.
ويضاف إلى ذلك أنّ حركة ما بعد البنيويّة ابتعدت عن التّنظير الأحادي الذي طبع مرحلة البنيويّة آنذاك، واقتربت أكثر من التّنظير المتنوّع بسبب تعدد منظّريها والحاجة الفلسفية إلى ذلك. وحاولت أيضا الحركة المذكورة صياغة دور المعرفة، فرفضت مقولات البنيويّة التي حصرت المعرفة ببنية مسيطرة، فالمعرفة في مرحلة ما بعد البنيويّة تتخطّى الجوهر. لذلك تُعدّ حركة ما بعد البنيويّة في هذا السّياق نوعا من الممارسات التي تتّصف بأنّها أفعال إبداعية وذات طبيعة نقدية وعملية. وقد طوّرت حركة ما بعد البنيويّة فلسفتها، وبرز دور المعرفة وحدودها وعلاقتها بالخطاب، حيث ترسّبت آثار الممارسة اللّغويّة، ممّا أدى إلى التركيز على المسائل الهامشية والمبعثرة، وتجلّى ذلك بأفكار عديدة([4])، وهذا ما سأعرضه باقتضاب:
- أوّلية النظريّة (primacy of theory The): في مرحلة ما بعد البنيويّة أصبحت النظريّة عنصرا أكثر أهمية وأكثر بروزا في ممارسة النّقد وفي كل موضوعات المعرفة، وكل ما لا يتسق والنظريّة
يرفض ويعدّ غير مبرَّر ووهمي.
- إزاحة الفاعل (The decentering of the subject): تنطلق هذه الفكرة من أنّ الإنتاج الأدبي ليس حصرا وليدة المؤلف، وهي تتسق وفكرة إلغاء البنية المركزيّة المسيطرة التي نادى بها جاك دريدا، وقد صاغها رولان بارت (Roland Barthes) بأسلوب آخر، وهو موت المؤلّف. وجوهر هذه الأفكار أنّ مصدر المعرفة متنوّع ومتعدّد.
- القراءة والنّصوص والكتابة (Reading, texts, and writing): ترتبط هذه الفكــرة بمــا ورد أعلاه ارتباطاً مباشرًا، وتعنى هنا بتحرير النص من أدبيته، لأنّ الأخيرة التي كانت ترتبط بالمؤلف في مرحلة البنيويّة لم تعد كذلك. فالنصّ تحرّر من سلطة المؤلف هنا، وتحوّل القارئ إلى المسؤول الرّئيس عن تأويل النّصوص، أي أنه قارئ حرّ يقابله نصٌّ حرّ يتميز بنصّيته. وجوهر هذه الفكرة هو تحرير النّصوص من فكرة تصنيفها المسبّق.
- مفهوم الخطاب (The concept of discourse) :انطلاقا من سبعينيّات القرن الماضي، وبتأثير من تطوّر مناهج النّقد، وبخاصة النّقد الحواري الذي أسَّسه ميخائيل باختين (Mikhail Bakhtin)، تحوّل الخطاب إلى واحة من التّبادل الدينامي للمعتقدات والسّلوكيّات، والمشاعر، ومظاهر الوعي الإنسانيّ. تسهم هذه العناصر مجتمعة في إثراء المعاني المباشرة بدلالات جديدة.
- هيرمينوطيقا الشّك (Hermeneutics of suspicion): أو التّأويليّة القائمة على الشّك بحسب بول ريكور (Paul Ricoeur). يقصد بهذه الفكرة دراسة المعاني المحتملة في النّصوص، أي أن المعاني المقصودة من النّصوص لا تظهر في البنيّة السّطحيّة، بل يُعَّبر عنها بأسلوب غير مباشر ومضمر، ويعود ذلك إلى قوى نفسيّة وأيديولوجيّة وضرورات خطابيّة. أمّا المعاني الظّاهرة في البنية السّطحيّة للنصّ فهي أشبه بتشويه أو إزاحة أو حتّى إعاقة للمعاني الحقيقية التي تحتاج إلى تحليل لمقاصدها.
- النّسبيّة (Relativism): أو مذهب النّسبيّة، ينصّ هذا المذهب على أنّ غياب البنية المركزية، أو القاعدة الأساس، يقتضي أنّ علاقة الحقائق والقيم والمبادئ الحضارية بثقافة مسيطرة أو أيديولوجيا ما أو نمط معين من الأشخاص، هي علاقة نسبية في مكان ما وزمان ما، ما يستدعي المطالبة بتعميم المساواة ومنحها لأطياف المجتمع، وبخاصة للأقليات منهم([5]).
هذه كانت أهم الموضوعات التي أثارها منظرو حركة ما بعد البنيويّة، ولا يزال لغاية الآن كثير منها موضع بحث وبخاصة علاقة المعرفة بالخطاب، أو اللّغة في الاستعمال، وكيف تنتج السّلطة من جرّاء العلاقة المذكورة، وأثر ذلك في عملية التّواصل. يذكر أحد الباحثين على سبيل المثال أنّ دور حركة ما بعد البنيويّة في العلاقات الدّوليّة هو كشف دور العنف، وإبراز دور الهوية والكفاءة السّياسيّة وغيرها في تكوين الحياة السّياسيّة والاجتماعيّة المعاصرة([6])، أي بيان كيفية استغلال السّياسيّين والمفكرين وغيرهم لقواعد الاستدلال للتّحكم في العملية التواصليّة، وبخاصة في مقاربة القضايا السّياسيّة والاجتماعيّة المستجدة.
هذه التّحوّلات في مقاربة القضايا المذكورة لم تكن لتبرز لو لم تتطور المناهج النّقديّة وأسسها الفلسفية، بدءًا بالشّكلية الروسية (Russian Formalism)، ومرورا بالبنيويّة، وصولًا إلى حركة ما بعد الحداثة (Postmodernism)، ولم تكن لتنجح أيضا لو لم يتمّ النظر إلى الخطاب في فكر ما بعد البنيويّة كمكوِّن للواقع الاجتماعيّ([7])، حيث باستطاعتنا أن نمثل لأنفسنا صلة الوصل بين علاقاتنا المختبرة وشروط وجودنا المادي([8]). وكان الدّافع الرّئيس وراء ذلك هو النّقد ما بعد البنيوي، وبخاصة فكرة الذّاتيّة (Subjectivity) المتحوّلة باستمرار وفكرة عدم وجود معنى محدّد (Indeterminacy)، وفكرة التغيّر المستمر والمرونة (Change and Fluidity)([9]).
فمهمّة الخطاب إذا، مثلما تبين أعلاه، تحويل تجاربنا المستقاة من التّاريخ إلى تجربة مادّية يمكن اختبارها والحكم عليها. لذلك كنت قد تطرّقت إلى الفكر النّقديّ الذي طوَّرته مقاربة ما بعد البنيويّة، حيث تحوّل الخطاب إلى ممارسة تواصليّة بدلًا من اللّغة كبنية، لأنّ الخطاب يستبعد المتكلّم أو المتكلّم الأُحاديّ المستقل والمكوّن لنفسه، أي أنّ الذّات في الخطاب ذات اجتماعيّة كوَّنها المجتمع وليست ذات فرديّة([10])، وهو ما يتّسق ومفهوم إزاحة الفاعل الذي ذكرته أعلاه من جهة، والنّقد الذي يرفض أنّه بالإمكان فهم المجتمعات بناء على قواعد عالميّة وبنى نصية غير مرنة تتردّد في النّصوص والفنون والشعائر الدينية أو حتى في أساليب التعبير([11]) من جهة أخرى.
والممارسة الخطابيّة فيما بعد البنيويّة تعني أيضا أنّ مسؤولية إنتاج المعنى لا تقع على عاتق المستوى الدلالي في اللّغة، بل تتخطّاه إلى رحاب متجدّدة لا تنضب؛ منها ما هو تاريخي وأنثروبولوجي، ومنها ما هو معاصر وأيديولوجي. فنحن هنا أمام اكتشاف التجربة الإنسانية وربطها بتجربة أخرى، ولسنا أمام اكتشاف التجربة الدّلاليّة وتسيّقها على الرغم من أهميتها. لذلك برزت نظريّة أفعال الكلام (Speech act theory) متأثرة بحركة ما بعد البنيويّة لأنّها تناولت تحليل الكلام وليس النظام اللّغويّ. ولقد أشار اللّسانيّ الألمانيّ يوهانس أنغرمولر (Johannes Angermuller) إلى أنّ حركة ما بعد البنيويّة هي وليدة تقاطع جمع بين الإنسانيّات والعلوم الاجتماعيّة والحيز اللّغويّ والاجتماعيّ المتعدّد الاختصاصات([12]).
هذا الربط لا بدَّ أن يتجسّد في البنية السّطحيّة للغة، أو أن يُعبّر عنه، وعندما يتحقّق ذلك وفق ميشال فوكو (Michel Foucault)، يجري خلق الذّات المتكلّمة في الخطاب، سواء أنتج ذلك عن بوتقة
من الأحداث التّاريخية أم عن بنى خطابية معاصرة… وهذا يستتبع أنّ العلامة اللّغويّة، وبحسب جاك دريدا، هي جاهزة للاستخدام في أحداث تواصليّة دائمة، ما يعني أنّ العلامة اللّغويّة، أي الدّال والمدلول، لا يمكن الركون إليها لتحليل البنى اللّغويّة مثلما افترضت البنيويّة([13])، بل ما يمكن الركون إليه لملاحظة البنى وتحليلها وجعل ذلك ممكنا وفق تبصّرات ما بعد البنيويّة هو مفهوم جديد، مفهوم لا يستبعد المصادر الاجتماعيّة من الاجتماعيّ نفسه وهو الخطاب([14])، وهذا هو موضوع المبحث الآتي.
- نظريّة الخطاب
تبيَّن في المبحث السّابق أنّ تطور المناهج النّقديّة ساهم في تطوير مناهج تحليل الخطاب، ووضع الأطر الملائمة لبناء نظريّة الخطاب التي تتناول بنحو واسع دراسة جوانب اللّغة والتواصل المختلفة عن البنى اللّغويّة([15]). لذلك رأى الباحثون، وبخاصة باحثو حركة ما بعد البنيويّة، أنّ تحليل التواصل والمعرفة يجب أن يمرَّ بالخطاب، ليس لأنّه لا يوجد شيء خارج الخطاب، بل لأنّ الخطاب هنا أشبه بمصفاة (Filter)، إذ تسمح طبيعة الخطاب بالعمل كمصفاة للتمثيلات (Representations) والممارسات (Practices).
بالنّسبة إلى التّمثيلات هي إبداعات أساسها اللّغة، أي أساسها اختيار المدلولات، ولكنّها مدلولات منحازة وموثوقة معا؛ ولأنّها تمكّن الممثلين الاجتماعيّين من معرفة غاياتهم والتصرف بناء على ما يعلمون، فإنّ التمثيلات تمتلك تداعيات سياسية. ومهمة محلل الخطاب هنا هو تحديد كيفية تكوّن هذه التمثيلات وبروزها من بين غيرها في خطاب كوّنته التمثيلات نفسها([16]). أمّا الممارسات فترتبط مباشرة بالخطاب، وإذا كان الأخير هو الكينونة، فإنّ الممارسة هي عملية التحوّل التي ينتج عنها الخطاب، ومن ثَمَّ يخضع الخطاب لنمط الممارسات، وأخيرا يعيد خلق ممارسات جديدة([17]).
وهنا أريد الإشارة إلى أنّه ولما كان الخطاب يتّصف بعمليات اختيار، فإنّ هذا الاختيار بدوره يتمُّ على مستوى الكلام أكثر مما يتمّ على مستوى النّظام اللّغويّ، ممّا يعني أنّ الإجراءات المرتبطة بالتّداوليّة تسهم مباشرة في إنتاج الخطاب وإعادة فهمه، زد على ذلك أنّها تضفي غنى على عمليات الاختيار وبخاصة إذا ترافقت الأخيرة والأيديولوجيا. ولكن، ما تداعيات ما ورد أعلاه على إنتاج المعرفة في الخطاب؟ وكيف يمكن تعريف الخطاب في ضوء تطور قواعد الاستدلال وغناها؟ سأحاول الإجابة عن هذين السّؤالين، وسأبدأ أوّلا بتعريف الخطاب مراعيا مفهومات عديدة، ومنها ما ذكره ميشال فوكو في كتابه “حفريات في المعرفة” عن أنّ الخطاب ليس فقط مجرّد اختزال دور العلامات اللّغويّة بالإحالة إلى النظام اللّغويّ أو الكلام، إنّه ذاك الشيء أو القيمة الإضافية وهو ما يجب تبيانه([18]):
1.2 الخطاب هو ممارسات تنظم الموضوعات وتتحدّث عنها بأسلوب منتظم.
يبيّن فوكو في هذا التعريف أنّ الخطاب ليس فقط طريقة للتكلّم عن الأشيـاء، ولكنه طريقــة لصياغــة الواقع الموصوف وبنائه. لذلك اقترح فوكو مفهومات عديدة لبناء نظريته، وهي: بناء الواقع (Constructing reality) والممارسات النسقية (Systematic practices) والسّلطة والمعرفة (Power and knowledge) والمصادفة التّاريخية (Historical contingency). هذه المسائل تشرح كيف يقوم الخطاب بخلق الأشياء التي يحيل إليها، وكيف يؤثر في فهمنا للعالم، وكيف يمارس السّلطة على أحكامنا التّأويليّة. لذلك فإنّ اللّغة في رأي فوكو ليست حيادية، وهي تساهم مباشرة في صياغة المعايير المجتمعية وقيمه وتراكيبه([19]).
2.2 الخطاب طريقة من طرق الوجود في العالم، إنّه ]أي الخطاب[ شكل من أشكال الحياة، إنّه هوية اجتماعيّة.
يجسد هذا التعريف تأثير المنظور الاجتماعيّ الثّقافيّ (Sociocultural) في اللّغة والهوية، ويربط اللّسانيّ الأميركي جايمس بول غي (James Paul Gee) في تعريفه للخطاب بين المستوى الفلسفي والمستوى الاجتماعيّ، إذ عدّ الخطاب ممارسة اجتماعيّة (Social practice)، أي عدَّه وسيلة للتصرف والتفكير، ووسيلة تجسّد معايير المجموعة المجتمعية؛ وجمع أيضا في تعريفه بين الخطاب والهوية. فعلى سبيل المثال تحاول بعض فئات المجتمع، مثل الأطباء، التكلّم بلغة اصطلحوا عليها (Jargon) وممارسات خلقوها في مجال أعمالهم، حيث تساهم كلّها في تحديد هوية المتكلّم، ما يساهم في الانتماء إلى المجتمع الثّقافيّ والاجتماعيّ، لأنّه يوجد في المجتمعات علاقة بين ما يسمى (Big D Discourse) و(Little d discourse)([20]).
3.2 الخطاب مجموعة من الوسائل اللّسانيّة التي يتصف تنظيمها ومحتواها بأنّهما متّسقان، وهذه الوسائل تجيز أيضا للناس بناء المعاني في سياقات اجتماعيّة.
يصف هذا التعريف الخطاب بأنّه وسيلة مقصودة لاختيار المادة اللّسانيّة بغية إنشاء المعاني، ولكي يتمّ ذلك يجب أن تتصف المادة اللّسانيّة بالسبك والحبك. والخطاب في هذا التعريف لا يرتبط فقط باللّغة، بل يبين كيف يقوم الناس ببناء المعاني في سياقات التفاعلات الاجتماعيّة أيًّا كانت أنواعها. لذلك فإنّ هذا التعريف يبيّن أنّ الخطاب لا يقتصر على استعمال النّحو بأسلوب صحيح، بل يتخطّى ذلك لاستخدام اللّغة في أساليب اجتماعيّة وذات فائدة([21]).
- الخطاب هو ذاك الشيء الحاضر مثل ذاك الشيء الغائب، ويصبح دالا فارغا (Empty signifier)
كدال وظيفته الإشارة إلى هذا الغياب.
ذكر هذا التعريف الفيلسوف الأرجنتيني والمنظر السّياسيّ إرنستو لاكلو (Ernesto Laclau)، فقد استفاد في تعريفه الشهير من مقولة عدم وضوح المعاني في مرحلة ما بعد البنيويّة ونظريّة التفكيكية، وقدّم مفهوم الدّال الفارغ وجمع بينه والخطاب السّياسيّ متيحا للسّياسيّ استغلاله لتعزيز الهيمنة (Hegemony). يقصد لاكلو في الجزء الأول من تعريفه (الخطاب… الغائب) أنّ الخطاب لا يمثّل واقعا معينا أو جوهرا جامدا، إنّما يدل أنّ هناك شيئا ناقصا أو غير مكتمل بطبيعته؛ وفي الجزء الثاني ورد ذكر (ويصبح دالا فارغا)، والمقصود بالدّال الفارغ هو ذاك الرمز أو تلك الكلمة التي لا تمتاز بمعنى محدّد، ولكنّها أشبه بوعاء لكثير من التفسيرات؛ فعلى سبيل المثال، تعني كلمة (ديموقراطية) أشياء عديدة لمجموعات بشرية عديدة، وذلك وفق السّياق التي ترد فيه والأهداف والأيديولوجيات. أمّا الجزء الأخير (كدال… الغياب) فالمقصود به أنّ الدّال الفارغ يعمل ككلمة مفهومها يوحّد ولا يفرّق، وذلك لأنّ مفهوم الكلمة يمثل غياب المعنى المحدّد أو المعنى المصطلح عليه عالميا؛ فعلى سبيل المثال، وفي الخطاب السّياسيّ، توحّد كلمة (الحرّية) بين النّاس ولو كانت معانيها المحدّدة تتنوّع في السّياقات العديدة التي وردت فيها)[22](.
يتبيّن مما ورد أعلاه أنّ حركة ما بعد البنيويّة أتاحت لمنظري الخطاب الاستفادة من المقولات الغنية التي درستها، إذ يلاحظ أنّ تعريف الخطاب تضمّن مسائل اقترنت باللّسانيّات الاجتماعيّة والتّداوليّة والتطورات الحضارية والسّياسيّة والمعرفية، ما يعني تنوع أبعاده. فمنهم من حاول ربط إنتاجه بالذّات الإنسانية الاجتماعيّة المعاصرة، ومنهم من حاول ربطه بتاريخ المعرفة وفلسفتها، وبخاصة مذهب الإعلائية (Transcendentalism)([23]) الذي ينصُّ على وجود عناصر معرفية فطرية في الذّهن سابقة على الخبرات الحسية، أو شبه الإعلائية (Quasi-Transcendentalism)، ومنهم أيضا من ربطه بالآخر. ولكن هل يمكن الإقرار ببعد معين من دون آخر؟ وما هو دور الخطاب في الكشف عن المعاني؟
تقتضي الإجابة الموضوعية الإقرار بصعوبة الاكتفاء بأيّ تعريف على حدة، ولو كان الأمر ممكنا، لما اجتهد الباحثون في دراسات تحليل الخطاب اجتهادا حثيثا في سبر أغوار الخطاب، وبخاصة أنّ كثيراً منهم يعملون في مجال علم المعرفة (Epistemology)، حيث الاهتمام بكيفية اكتساب المعرفة عن العالم، وهذه مسألة مهمة جدّا لمحلل الخطاب([24])، وفقط لمحلل الخطاب، لأنّ مفهوم اللّغة عجز عن تفسير بعض المعاني المترسِّخة في التّاريخ والسياسة والثقافة، وكيفية إعادة إنتاجهم المستمرة في أنواع الكلام وأشكال التّمثيل وفي بعض الأطر المؤسّساتيّة، في حين أنّ مفهوم الخطاب نجح في هذه المهمّة([25]).
أمّا بالنّسبة إلى السّؤال الثّاني فإنّ المسألة أكثر تشعّبا، لأنّ تحليل المعاني يرتبط بنظريّة الخطاب وفلسفته، وهي بدورها ترتبط أيضًا بالمسألة الأولى. كتب ستيوارت هال (Stuart Hall) موضحًا أنّ الخطاب يضبط الطّريقة التي يمكن التكلّم بها عن موضوع ما وفهمه؛ والخطاب يؤثّر في طريقة تركيب الأفكار واستخدامها لتنظيم سلوك الآخرين. ولأنّ الخطاب يتيح استخدام بعض أساليب الكلام حول موضوع ما، وتحديد طريقة مقبولة ومفهومة للكلام والكتابة، أو تحديد كيفية التّصرّف في المجتمع، وهكذا أيضا بحكم التّعريف، فإنّ الخطاب يبطل أساليب تكلّم الآخرين ويقيدها، ويحصر كيفية استجابتنا للأفكار المطروحة أو كيفية توسيع معرفتنا عنها([26]).
ولكنّ هذا الدور يثير إشكالية العودة إلى البنية المركزية التي نادت بها البنيويّة، أي أنّ الخطاب أشبه ببنية تضبط المعاني داخله؛ فإذا كان هذا الأمر صحيحًا فإنّ حركة ما بعد البنيويّة ليست بالضّرورة على جهة معاكسة للبنيويّة؛ وفي الواقع تبّنى كثير من منظري ما بعد البنيويّة المنهجية العلائقيّة التي عرفت بها البنيويّة، لكنّهم رفضوا المنهجيّة المركزيّة للمعاني التي أتت بها في الوقت نفسه([27]). توضح نظريّة الخطاب هذا الأمر بقولها إنّ ظهور الكيانات أو مجموعة منها لا يتمّ في العقل البشري، بل يتمّ ذلك في بنية خطابيّة غير مكتملة، حيث تسهم الوقائع الحسية والصراعات السّياسيّة بتقويض استقرارها([28]).
سأتوقف قليلًا شارحًا، واخترت بعض الأمثلة التي تتكلّم عن موضوع واحد، وهو خروج المدعو (سهيل الحموي) من السّجون السّوريّة إلى الحرّية بُعيد سقوط النظام السوري في 8/12/2024، وتقصّدت ثلاثة معايير لأستقي المعلومات، أوّلا: اخترت موضوعًا واحدًا. وثانيًا: اخترت التّاريخ نفسه. وثالثًا: اخترت الأمثلة من وسائل التّواصل الاجتماعيّ، والأمثلة هي:
- من سراديب الأسد إلى الحرّية.. سهيل الحموي يروي لـ “هنا لبنان” يوميات الجحيم التي استمرت 33 عاما!([29])
- بعد 33 عاما في سجون النّظام السّوريّ شكّا تستقبل ابنها سهيل الحموي (الاثنين 9/12/2024 الساعة 16:14)([30]).
- الأنباء الكويتية: سهيل حموي عاد إلى “شكا” اللّبنانيّة بعد 32 سنة و2 أيام في سجون بلده سورية([31]).
يلاحظ في الأمثلة أعلاه ما يأتي:
- يمكن تمثيل الكيان الطّارئ في بنية خطابيّة على النحّو الآتي: خروج لبنانيّ من سجن سوريّ إلى الحريّة.
- المثال الأول منحاز ولا يتضمّن أيّة إشارة إلى مصطلح (السّجن)، بل اختار تركيبا (سراديب الأسد) كنّى به عن السّجن في دولة سوريا، لأنّ موقع (هنا لبنان) يتبع لأشخاص يتعاطفون وحزب القوات اللبنانية الذي اختلف معه نظام حكم الأسد، ولأنّ المدعو سهيل الحمويّ كان ينتمي إلى الحزب المذكور مثلما ذُكر. أمّا المثال الثّاني فهو أقلّ انحيازًا من الأوّل، ولكنّه استخدم التّقديم والتّأخير، أي قدّم ذكر الظّرف (بعد 33) لإثارة العطف، لكنّه بدوره أكثر انحيازًا من المثال الأخير. والمثال الثّالث أكثرهم حيادًا، حيث ذكرت الجريدة المذكورة فعل (عاد) وليس فعل (خرج)، ربما لأنّها جريدة غير لبنانيّة نشرت الخبر في صفحاتها وشعرت بالتزام أيديولوجيّ أقل.
- هذه الأمثلة تفسر ما ذكرْته أعلاه عن مساهمة الوقائع الحسيّة والصّراعات السّياسيّة، أو السّعي إلى الاستئثار بممارسة السّلطة، بتقويض استقرار البنى الخطابيّة وتنوّعها. وتفسّر الأمثلة المذكورة أيضًا دور الدّال الفارغ (الحريّة)، ولو ورد مضمرًا، في كيفية استقطاب الأطراف السّياسيّة وإنتاج تأويلات متنوّعة للخبر السّياسيّ، وذلك بحسب انتمائهم الأيديولوجيّ، ما يبرز دور الموقف السّياسيّ والنّقديّ في تحليل الخطاب.
والجدير ذكره هنا، أنّه كلما ازدادت حرّية الاختيار والتّفكير من قبل الذّات الخطابيّة ازداد الإبداع في استغلال التّراكيب الخطابيّة. كتب اثنين من أهمّ الباحثين في علم النّص أنّه كلّما ابتعدنا عن نحو الجملة واقتربنا من نحو الخطاب ندخل مجالًا يتميّز بحرّية كبيرة للاختيار والتّنوع وتطابق أقل والقواعد المتبعة([32])، وهو ما يلاحظ من مقارنة الأمثلة أعلاه. ولكنّ هذه الحريّة قد تقود إلى الإبداع والنّجاح في صياغة خطاب يحقّق أهدافه، إنّما بدرجات متفاوتة، لأنّ ذلك يشترط إدراك الذّات الخطابيّة لكيفية قيام البنى الصّغرى للّغة في صياغة البنى الكبرى للمجتمع، أي إذا أدركت دور الخطاب في تعزيز السّلطة([33]).
لذلك، يقتضي تحليل الخطاب فهم الأهداف المرتجاة منه وسياقه الثّقافيّ والإجراءات الممكنة التي تترافق وصياغة الخطاب، أي فهم دور الخطاب في السّياق الاجتماعيّ والسّياسيّ وكيفية تحقيق غايات معينة، مثلما حصل في الأمثلة الثلاثة الواردة أعلاه؛ وهذا ما مهّد لبروز دور التّحليل النّقديّ للخطاب في مرحلة ما بعد البنيويّة، حيث بات أكثر وضوحا([34])، وهو أمر ميّز الجيل الثاني من مراحل تطور نظريّة الخطاب، في حين أنّ الجيل الأوّل من نظريّة الخطاب اكتفى بتعريفه تعريفا لسانيا ضيقا كوحدة نصّية أكبر من الجملة([35]).
استهل الجيل الثاني المذكور أعلاه اللّسانيّ نورمان فاركلوف (Norman Fairclough) في كتابه الشّهير (اللّغة والسّلطة) الذي ترجم إلى العربيّة لأهميته، وقد أسهم كثير من اللّسانيّين المهتمين بتحليل الخطاب تحليلًا نقديًّا في تطوير مفهوم الخطاب تطويرًا ملحوظًا، وفيما يلي أهم ما ورد في هذا المجال:
5.2 الخطاب هو ممارسة اجتماعيّة، وهذا يفترض أنّ علاقات السّلطة هي خطابيّة؛ الخطاب يكوّن المجتمع والثّقافة وهما بدورهما يكوّنان الخطاب؛ الخطاب يؤدّي وظيفة أيديولوجيّة؛ الخطاب ذو أبعاد تاريخيّة؛ الخطاب يؤدّي وظيفة تأويليّة وتفسيريّة؛ الخطاب يؤدّي وظيفة توسّطيّة في المجتمع؛ الخطاب شكل من أشكال الأفعال الاجتماعيّة([36]).
يشرح كلّ من نورمان فاركلوف وروث وداك (Ruth Wodak) أنّ الخطاب ليس عن اللّغة فحسب، بل عن كيفية ترابط اللّغة والسّياق الاجتماعيّ وبنى السّلطة، وما ورد أعلاه أشبه بتعداد الخصائص العامة للخطاب. فمدرسة التّحليل النّقديّ للخطاب تنظر للخطاب كمرآة من جهة، وكطريقة لتكوين الوقائع الاجتماعيّة من جهة أخرى، أي أنّها تتبنّى مقاربة مرنة، وبذلك تجعل من الخطاب وسيلة لتحليل ديناميات استعمال السّلطة في التواصل بأنواعه([37]).
6.2 الخطاب هو تدفق للمعرفة- و/أو تدفّق لكلّ نوع من أنواع المعرفة المجتمعية- عبر كلّ الأزمنة.
يركز هذا التّعريف على الجوانب التّاريخية والمادية للخطاب، ويبيّن التعريف المذكور كيف تتراكم المعرفة وتتجسّد في نماذج أخرى مع مرور الزمن. ويشدّد هذا التّعريف على أهمية تحليل الخطاب كقوة دينامية تتطوّر باستمرار وتستهدف صياغة المجتمع([38]).
يتبيّن مما ورد أعلاه أنّ نظريّة التّحليل النّقديّ للخطاب أدخلت إلى نظريّة الخطاب إجراءات تحليليّة ومفهومات عديدة تتناول منهجيّة تحليل الخطاب في المقاربة المذكورة. أوّل هذه المفهومات هو ترابط اللّغة والسّلطة، لذلك فالخطاب هنا ليس حياديًّا، بل هو متجذّر في العلاقات الاجتماعيّة لذوي السّلطة. وثانيها لا يمكن تحليل الخطاب إلا في سياقه الاجتماعيّ والسّياسيّ والتّاريخيّ، وثالثها يفسر دور الخطاب في صياغة الواقع، إذ إنّ الخطاب يصوغ المعايير الاجتماعيّة والأيدولوجيّات والحقائق ويصرّ عليها أحيانا ويتحدّاها أحيانا أخرى. أمّا آخرها، فهو الطّبيعة المتداخلة الاختصاصات لتحليل الخطاب.
وهكذا تبنّت نظريّة الخطاب منهجية يمكن تطبيقها لتحليل معاني الخطاب، وإن كانت هنا ذات طابع نقدي وسياسي؛ وعلى الرغم من أنّ الافتراض الفلسفي يركّز على أنّ جميع البنى المستخدمة لبناء المعاني هي بنى طارئة، إلا أنّه وفي الوقت نفسه لا يمكن التعالي على هذه البنى المستخدمة، حيث ولدى الإشارة إلى معنى ما نستخدم بنية ما من بنى موجودة([39]). فالمعاني هنا ليست دائمة ثابتة ومحدّدة، ولكنها
في الوقت نفسه ليست دائما مرنة ومتاحة للاستخدام([40]).
لذلك فإنّ نظريّة الخطاب، أو أيّة نظريّة، لا بدّ وأن تترافق وكثير من الملاحظات المرتبطة بزيادة كفاءة المنهجيّة التّحليليّة وتوضيحها، إذ لا نظريّة من دون منهجية تطبيقيّة واضحة وفعّالة، وهذا ما لفت النّظر إليه أكثر من باحث، ومنهم جايكوب تورفينغ (Jacob Torfing)، يقول:
- يجب على نظريّة الخطاب أن تبرهن الأهمية التّحليليّة لمنهجيتها في دراسات تجريبيّة تأخذنا إلى ما هو أبعد من مجرد عرض الحجج والمبادئ.
- يجب على نظريّة الخطاب أن تفكّر تفكيرًا مليًّا في مسائل المنهجيّة واستراتيجيّات البحث وأن يترافق ذلك واستنتاجات جدّية([41]).
أمّا تون فان دايك (Teun van Dijk) فقد أدلى بدلوه في هذا الموضوع، إذ لجأ إلى بلورة منهجيته للتّحليل النّقديّ للخطاب في أكثر من دراسة، ومن ثمَّ ضمّنها البعد الإدراكيّ. ولكنّه كتب أيضا محدّدًا الخصائص التي يتميز بها الخطاب: إنّه شكل من أشكال التّفاعل الاجتماعيّ، وهو يتضمّن استخدام إشارات سيميائيّة في سياق اجتماعيّ، ويتألّف من بنى معقّدة ومتعدّدة، ومتتاليات وهرمية معينة، زد على ذلك البنى المجردة والاستراتيجيّات الدّيناميّة، وأخيرا ربط بين الخطاب والأنماط والأنواع([42]).
يمكن الاستنتاج مما ورد أعلاه أنّ هذه الخصائص أو الجوانب المتنوّعة للخطاب جعلت الحديث عن نظريّته ودراساته إقرارًا بأهميته من جهة، وإقرارًا بأنّ النظريّة أكثر تعقيدًا مما يبدو للوهلة الأولى من جهة أخرى. هذه الفكرة الأخيرة تتجلّى أيضًا في الرّسم البياني أدناه، وهو رسم وضع لبيان الجوانب المتنوّعة التي ترتبط بنظريّة الخطاب وعلاقة الخطاب بالعالم الواقعي([43]):
| الخطاب مكوِّن العلاقة الجدليّة الخطاب مكوَّن
(Discourse is constitutive) (Dialectical relationship) (Discourse is constituted) التّحليل النّقديّ للخطاب (نظرية لاكلو وموف الخطابية) (علم النفس الخطابي) (فوكو) (ألتوسر) (غرامشي) (المادية التاريخية) الرّسم البيانيّ رقم (1): دور الخطاب في تكوين العالم.
|
يوضح الرّسم البيانيّ العلاقة بين الخطاب والواقع الاجتماعيّ عبر ثلاثة مستويات: البنية اللّغويّة، والسّياق الثّقافيّ، والممارسات السّلطويّة. ويلاحظ أيضا أنّ نظريّة لاكلو وموف والتّحليل النّقديّ للخطاب وعلم النّفس الخطابيّ ترتبط إما جزئيًا وإما كليًّا بنظريّة التّركيب الاجتماعيّ (Social constructionism) التي يستخدمها بعضهم مرادفًا لنظريّة التّركيبيّة الاجتماعيّة (Social constructivism)، أي النّظريّة التي تنصّ على أنّ النّاس يبنون المعاني اعتمادًا على معرفتهم الماضية والحالية، وهي تتميز ببعدين: البعد الإدراكيّ والتّفاعل الاجتماعيّ، وهذا الأخير يركّز على أهمية اللّغة([44]). بعبارات أخرى، يستخدم الخطاب في البعد الأخير لصنع المعرفة والفهم، أي أنّ المعرفة ليست مجموعة من الحقائق وإنّما عملية بناء مشتركة، فاستعمال اللّغة هنا ليس مجرد مرآة للواقع، وهذا يفترض أنّ للنّاس حرية الاختيار والإبداع اللّغويّ.
لكن ما ورد للتوّ لا يقف عند حدود حرّية الاختيار والإبداع، بل يتخطّاه إلى دراسة كنه النّفس البشريّة التي تميل أحيانا إلى استخدام حرّيتها واستغلالها، أو ممارسة ذاتيتها الخطابيّة المتغيرة لتحقيق مصالحها المتنوّعة وللهيمنة. يقول لاكلو وموف في كتابهما الشّهير الذي تضمّن نظريتهما في الخطاب والهيمنة، أنّ الأخير هو الكلية المنظمة النّاجمة عن ممارسة تلفظيّة؛ هذا التّعريف للخطاب قد يبدو مقتضبًا، ولكنّه يوحي بأنّ الخطاب ليس فقط عن استعمال اللّغة، بل عن كيفية بناء المعاني في إطار العلاقات، ويظهر التّعريف المذكور نظرتهما إلى أنّ الخطاب طارئ ويخضع دائما للتّغيير([45])، وهو يجسّد تأثّرهما بحركة ما بعد البنيويّة، زد على ذلك أنّهما أوّل من تطرّق إلى مصطلح (نظريّة الخطاب)([46]).
وفي الواقع كثيرا ما ترتبط الذّاتية الخطابيّة بقيود الأيديولوجيا السائدة في مجتمع ما وبمتغيرات عديدة، لذلك عدّ لاكلو وموف نظريّة الخطاب نظريّة لنقد الأيديولوجيا السائدة، وبخاصة إذا كانت تساهم في تشويه الواقع([47])، واقع مخفيّ أو مشوّه ويرتبط بمنظور ما، مثلما ورد في المثال رقم (5). بعبارات أخرى، نظريّة الخطاب هي أشبه بإطار متعدّد الاختصاصات مهمته اكتشاف الأساليب التي تستخدمها أنظمة اللّغة، أو التواصل اللّغويّ، بغية صياغة المعرفة والمجتمع وتحديد الهوية. لذلك تتناول نظريّة الخطاب كيفية قيام الخطاب، أو أنظمة صياغة المعنى، ببناء علاقات السّلطة والقيم المجتمعية والأيديولوجيات، والتأثير فيها في الوقت نفسه.
من هنا تحتمل نظريّة الخطاب اجتهادات متنوّعة أحيانا، لأنّها ترتبط بكثير من الافتراضات الفلسفية، بدءًا بالمادية التّاريخيّة والماركسيّة، وصولا إلى نظريّة التّركيب الاجتماعيّ. أمّا الآن سأتناول الوجه الآخر لنظريّة الخطاب، الوجه الذي يستغلّه منتجو الخطاب، وهو أساليب الخطاب واستراتيجياته.
- فصاحة الخطاب
يتناول هذا المبحث الأساليب الدّلاليّة والاستراتيجيّات التّداوليّة المستخدمة في الخطاب، سواء أكانت مضمرة أم لا. ولقد أطلقت عليه اسم (فصاحة الخطاب)، لأنّ الأساليب والاستراتيجيات المذكورة عديدة ومتنوّعة، وكثير منها لم يكن ليحقّق غاياته لو لم يرد ظاهرًا أو مضمرًا في سياق الخطاب نتيجة لصراعات سياسيّة ووقائع حسيّة. فللخطاب إذا دور رئيس في بلورة هذه الاستراتيجيّات الخطابيّة، وهو يسهم مساهمة فعّالة في بروزها؛ ولم أسمه (خبث الخطاب)، حتى ولو كان يصحّ أحيانًا إطلاق هذه التّسمية، لأنّ الخبث إجراء مؤقّت يستعين به منتج الخطاب عن قصد وببراعة، أمّا مصطلح (الفصاحة) فهو أوسع دلالة على غنى استراتيجيات الخطاب، وينسجم مع كثير من نظريات الخطاب المعاصرة.
سيتضمن هذا المبحث أهمّ المسائل المنهجيّة التي وردت في نظريّات تحليل الخطاب، سواء أكانت النّظريّات التي تأثّرت بحركة ما بعد البنيويّة أم لا، إذ إنّ هذا البحث يستهدف دراسة أساليب الخطاب الدّلاليّة واستراتيجياته التّداوليّة التي تساهم مساهمة مباشرة في تحقيق منتج الخطاب لغاياته:
1.3 المربّع الأيديولوجي (Ideological square): يركز المربّع الأيديولوجي، وشبيه به المربّع السيميائي (Semiotic square) في دراسات الأدب، على استخدام أربع أفكار رئيسة، وهي ترد متناثرة في الخطاب: الأولى هي التّعبير أو التشديد على حسنات الجهة المتكلّمة؛ ويقابلها التعّبير أو التّشديد على ما هو سيّئ بالنّسبة إلى الطّرف الآخر. والفكرة الثّالثة هي إلغاء أو تسخيف المعلومات المرتبطة بكلّ ما هو جيّد بالنسبة إلى الطرف الآخر؛ ويقابلها إلغاء أو تسخيف المعلومات المرتبطة بكلّ ما هو سيّئ بالنسبة إلى المتكلّم([48])؛ وهذا ما يجعل العلاقة وثيقة بين الخطاب والمربع الأيديولوجيّ، ما يبرز أهمية تحليل هذه العلاقة، لأنّ المعلومات المذكورة كثيرًا ما ترد متناثرة فيه.
2.3 الدّال الفارغ: سبق وعرضت مفهوم الدّال الفارغ في المبحث الأخير، وتعود أهميته إلى أنّه يستخدم في أساليب عاطفية تسمح باستغلاله، وبخاصة في الخطابات السّياسيّة([49])، فكيف بالأحرى إذا كان الخطاب كلّه دالا فارغا!؟
3.3 الاستلزام التّخاطبيّ (Conversational implicature): يقصد به إضافة معان سياقيّة موازية للمعاني الظّاهريّة ومتباينة عنها، ولقد سمّاها بول غرايس (Paul Grice) الاستلزام التّخاطبيّ، لأنّ ذلك يحدث عبر خرق المبادئ الأربعة المتفرعة عن مبدأ التّعاون في الحوار، وهي مبدأ الكميّة والنّوعيّة والملاءمة والكيفية([50]). والاستلزام التّخاطبيّ، وإن كان يتناول تحليل المقولة (Utterance)، فإنّ الخطاب ضروري لمعرفة ما المقصود بالاستتباع نفسه، لأنّ المتكلّم هو من يضمّن كلامه معنى متمايزًا عمّا قاله حرفيًّا في السّياق([51])، وهو أشبه باستراتيجيّة تداوليّة يستخدمها منتج الخطاب ويستغلّها، وقد استعان به أكثر من باحث لتحليل الخطاب، وبخاصة تحليل معاداة السّاميّة والتّمييز العنصريّ([52])، مثل روث وداك وغيرهم.
4.3 أفعال الكلام (Speech acts): جوهر هذه الفكرة هو أنّ الكلام يقال ليس فقط للتّعبير عن أشياء بل لفعلها، لذلك تركّز نظريّة أفعال الكلام على وظيفة الخطاب([53]). تتضمّن النظريّة المذكورة ثلاثـة أنواع من الأفعال في داخل كلّ ملفوظ، وهي الفعل الكلاميّ (Locutionary act) لإنتاج الملفوظ؛ والفعل الإنجازيّ (Illocutionary act)، ويقصد به المعنى المقصديّ لملفوظ ما، كالوعد والتّهديد وغيره؛ ويعدُّ الفعل الإنجازيّ ركيزة نظريّة أفعال الكلام. والفعل التّأثيريّ (Perlocutionary act)، ويقصد به إنتاج الفعل التّأثيريّ عبر الفعل الإنجازيّ، فالمتلقي ينجز حدثا أيضا، أي أنّه يقتنع([54]). وفي هذا السّياق، يتيح الفعل الإنجازي التّأثير في مشاعر المرء وأفكاره وأفعاله([55]). وأضاف فان دايك إليها أنّ النّصّ يستخدم أيضا كفعل من أفعال الكلام([56]). وهذا ما يجعل من تحليل دلالات أفعال الكلام في الخطاب أمرًا رئيسًا.
5.3 نظريّة الإطار (Frame theory): الإطار شكل معيّن لتنظيم المعرفة المحدّدة عرضيًّا، والتي نمتلكها عن العالم([57])، كالسّفر، والتسوّق، والذّهاب إلى الطّبيب أو السّينما. فعلى سبيل المثال عندما يسافر المرء يفترض عليه شراء تذكرة سفر، والذّهاب إلى المطار، وإجراء المعاملات الإداريّة فيه، والصّعود إلى الطّائرة، ومن ثمّ النّزول منها. لذلك فإنّ المعرفة الواردة في الخطاب يمكن استخدامها في إطار، وهذا الأخير بدوره يسهم في فهم الخطاب وإنتاجه، لأنّ المسألة هنا ترتبط بتمثيل المعرفة في الذّهن([58]). ولكنّ الإطار ككلّ شيء يستخدم يمكن أن يستغلّ لتحقيق غايات عديدة، ويشرح والتر كينتش (Walter Kintsch) وفان دايك أسس هذه المسألة بشكل مبسّط: يعدّ (دفع المال) القضية المشتركة بين إطار التسوّق وإطار الذهاب إلى المطعم، وهذه القضية يمكن تعميمها أو دمجها مع معلومات أخرى مخزّنة في الذاكرة الموسوعية بهدف فهم النص([59])، لأنّ العناصر المفردة لا تعلق بالوعي من دون روابط بل ترد على شكل قطع مدمجة ومترابطة بشكل تام([60])؛ وهكذا يمكن استغلال العوامل المشتركة بين الأطر لتوجيه فهم المتلقي، مثل إبراز الوجه الشرّير للسجون السورية في المثال رقم (1) إبّان حكم نظام الأسد عبر استخدام الإطار (سراديب) الذي يفيد الدلالات الآتية: مكان ضيق، ظلمة، وحدة، تغذية سيئة إلخ؛ في حين أنّ دلالات الإطار (السجون)، ووفق ذاكرتنا الموسوعية، لا تتماثل ودلالات كلمة (سراديب) التي وردت أيضا مضافة إلى كلمة أخرى، أي ضمن تركيب إضافي (سراديب الأسد)، ما أغنى مروحة دلالاته.
6.3 الاستعارة المفهومية (Conceptual metaphor): هي استخدام لغوي يتيح إنشاء تطابقات بين مجال مصدر ومجال هدف([61])، وجوهرها استخدام المحسوسات للتعبير عن المجرّدات. وهي تعدّ من نتائج الإبداع الفكري في اللّغة، وتعود أهميتها إلى أنّها تؤثّر أيضا في الفكر، وهي إحدى تجلّيات العلاقة المتبادلة بين اللّغة والقدرات الإدراكية في العقل؛ لذلك عدّها بعض الباحثين نافذة إلى العقل([62]). وتتميز أيضا بأنّ استعمال اللّغة فيها استعمال غير محكم (Loose use)([63])، حيث يفسح المجال لتأويلات مختلفة، لأنّ الاستعارة المفهومية نوع من أنواع استخدام المعرفة الموسوعية([64])، زد على ذلك دورها في تعزيز السبك (Cohesion) في الخطاب([65])، وهذا ما يبرز أهمية دورها في تحليل الخطاب.
7.3 التناصّ (Intertextuality) والتفاعل الخطابيّ (Interdiscursivity): تحدّد جوليا كريسـتـيـﭬـا (Julia Kristeva) التناصّ قائلة: يمثل النص عملية استبدال من نصوص أخرى، أي عملية تناص، ففي فضاء النصّ تتقاطع أقوال عديدة مأخوذة من نصوص أخرى، ممّا يجعل بعضها يقوم بتحييد بعضها الآخر ونقضه([66]). أمّا مرحلة ما بعد البنيويّة فشهدت ظهور مصطلح التفاعل الخطابيّ، وقد ترافق أيضا هذا المصطلح ونظريّة التّحليل النّقديّ للخطاب؛ يقول فاركلوف: يركّز التفاعل الخطابيّ الانتباه على تغاير النّصوص الطبيعي، وعلى تكوينها من مجموعة مؤتلفة من أصناف متنوعة وضروب الخطاب؛ ويفترض هذا المصطلح مجالات لا حصر لها تقريبا من الإبداع في الممارسة الخطابيّة([67]). ويجمع هذا المستوى من التّحليل بين التّحليل اللّسانيّ للنصّ وأشكال عديدة من التّحليل الاجتماعيّ للأحداث الاجتماعيّة والممارسات الاجتماعيّة([68]). وما يهمّ البحث هنا هو الإبداع في الممارسة الخطابيّة وما ينتج عنه من دلالات لا حصر لها أيضا في الخطاب، وبخاصة أنّ تعزيز الهيمنة قد يتأثر إمّا سلبا وإمّا إيجابا بالإبداع المذكور([69]).
8.3 التلطيف الحواري (Conversational mitigation): التلطيف وسيلة يمارسها المتكلّم لتخفيف قوّة الفعل الكلامي أو إضعافها، وهو يستهدف تحاشي التأثيرات غير المرحب بها عند المستمع([70]). والتلطيف وسيلة تستهدف إبلاغ المرسَل إليه الطريقة التي قيلت بها بعض الأفعال، أو موقف المتكلّم النفسيّ من موضوع كلامه وإظهار التعاطف أو الموقف النفسي للمتكلم المتضامن مع المرسَل إليه في سياق ما([71])، وهو ينسجم ونظريّة التّركيب الاجتماعيّ لأنّه يحاول خلق عالم خطابي جديد؛ وهو نوعان، داخلي وخارجي كاستخدام الأسئلة والتراكيب الشرطية وعلامات التأدب([72]). والتلطيف الحواري ذو طبيعة تداولية، ويرتبط بموضوعي الغموض (Ambiguity) واللبس الدلالي (Vagueness)([73]). فعلى سبيل المثال، يستغلّ الطبيب النفسي هاتين الخصيصتين لكي يطبّب المريض بفعالية. ومن أمثلته في الثقافة اللبنانية السّياسيّة: استخدام مصطلح (الهدر) بدلا من (السرقة).
والكلام، أو الخطاب، يتضمّن أيضا استخدام أسلوب آخر لا يقلّ أهمية عن التلطيف، وهو سوء التعبير أو فحش التعبير (Dysphemism)، وقد تناولته دراسات عديدة بالبحث، ولقد كتب جان جاك لوسركل (Jean-Jacques Lecercle) كتابا مهمّا عن الموضوع المذكور، ونقل إلى اللّغة العربية بعنوان (عنف اللّغة). ومن أمثلته في الثقافة اللبنانية: استخدام مصطلح (عميل) بدلا من (معارض). وقد يستخدم أيضا الخطاب كلّه لممارسة عنف اللّغة.
9.3 الافتراض المسبق (Presupposition): هو ما تقتضيه دلالة الكلام من سياق الحال المصاحب([74]). وكثيرا ما ترد الافتراضات المسبقة في سياق الخطاب لغايات بريئة أو غير بريئة، ففي قول مثل:
(4) افتح النافذة.
افتراض مسبق بوجود النافذة وبأنّها غير مفتوحة.
10.3 الدلالة التعيينية (Denotation) والدلالة التضمينية (Connotation): الدلالة التعيينية هي دلالة الكلمات الحرفية، أمّا الدلالة التضمينية فهي ما تثيره دلالة الكلمات من عواطف وأفكار في ذهن الفرد أو المجموعة([75])، مثل استخدام كلمة فاشي (Fascist) في أوروبا.
11.3 الحذف (Omission) والتكرار (Repetition) والتحوّل إلى الاسمية (Nominalization): حذف المعلومات في الخطاب يؤثر في بناء نماذج المتلقّين عن العالم وتعديل استنتاجاتهم وتوجيهها إلى وجهات قد تكون معدّة مسبقا([76]). أمّا التكرار فهو يسمح للمتكلم بأن يقول شيئا مرّة أخرى بغية إضافة شيء جديد إلى هذا الشيء المتكرر([77]). هذا الشيء قد تعزّزه فكرة ما أو إظهارها في الخطاب كأنّها طبيعيـة. وأخيرا التحوّل إلى الاسمية بدلا من الجمل الفعلية يساهم في تجهيل الفاعل وضياع المسؤولية، نحو:
- انفجار مرفأ بيروت.
ففي المثال أعلاه لم يذكر الفاعل في البنية السّطحيّة، حيث استخدم المصدر (انفجار) المشتقّ من فعل (انفجر) على وزن (انفعل)، وهو وزن بُني للمطاوعة؛ واستبعد أيضا المصدر (تفجير) الذي يفيد وجود فاعل ما، لأنّه مصدر فعل (فجّر). والتّركيب رقم (5) يستخدم بكثرة في نشرات الأخبار اللبنانية الموجهة توجيها سياسيا.
هذه كانت أهم المسائل التي قد يتضمّنها الكلام أو الخطاب بغية استخدامها أو استغلالها لتحقيق مقاصد معينة. ويلاحظ هنا أنّ مصدرها متنوّع، منها ما يفترض أنّ الخطاب ممارسة اجتماعيّة، ومنها ما يفترض أنّ الخطاب يستخدم لتعزيز الهيمنة، ومنها أيضا ما يفترض أنّ الخطاب فعل من أفعال الكلام، وقد تكلمت عن الافتراضات الأخرى سابقا. بعبارات أخرى، يستخدم الخطاب في الموضوعات السّياسيّة والتفاعل الاجتماعيّ، كالخطاب الإعلامي والتربوي والقضائي وغيره، ما يبرر السّؤال الآتي:
كيف يستطيع الخطاب فعل كل ذلك؟([78])
ما من شكّ أنّ هذا السّؤال هو في صلب نظريّة الخطاب، وهي معنيّة بالإجابة عليه، وقد حاول أكثر من باحث الاجتهاد في الإجابة؛ كتب أحد الباحثين المتخصّصين بثورة التواصل أنّ الخطاب هو تواصل وجهته جمهور غير محدّد وهو امتداد للتفاعل المباشر، وأصبح بالإمكان تحقيق التواصل المذكور عبر وسائل الكتابة التكنولوجية ووسائل الإعلام العامة أو أجهزة التواصل المرتكزة على الحاسوب([79]). والخطاب يتّصف أيضا بأنّه خطاب عام، أي خطاب موجّه إلى جمهور، وخطاب انعكاسي، أو تواصل من الدرجة الثانية، ما يعني أنّ الخطاب يتيح التأمّل بشكل التواصل وفرضياته([80]).
فالخطاب إذا تطور كثيرا لأنّ وسائل نشره بدورها تطورت، وقد بدأ تطوّره الحديث منذ منتصف القرن التاسع عشر، وترافق ذلك وتطور دراسات الخطاب أيضا، إذ إنَّ الإبداع في الخطاب لا يكمن في اللّغة نفسها فحسب، بل في الإجراءات اللّغويّة التي يتّخذها الناس للتعامل مع مشاكلهم([81])، أي الإجراءات اللّغويّة التي يختارها الناس بحرّية، ما يتيح ملاحظة المتغيرات بسهولة أكثر ودراستها دراسة علمية، سواء أوردت الإجراءات المذكورة في خطاب مكتوب أو مقروء أو حتى في خطب سياسية أو أي نوع من أنواع التفاعل الخطابيّ. زد على ذلك أنّ الإبداع متعدّد الوجوه([82])، وهو ما يتيح أيضا توظيف المنهجية اللازمة لتحليله وإجراء المقارنات العلمية، ما يؤدّي في نهاية المطاف إلى تطور التّنظير في الإبداع الخطابيّ.
خاتمة
دراسة الإبداع في الخطاب ودور التنوّع الثّقافيّ
تبيّن أعلاه أنّ دراسات الخطاب ارتبطت بتداخل الاختصاصات المعرفية بغية تحليل الخطاب، ولكن
هذا جانب واحد من جوانب التّنظير في دراسات الخطاب. فتداخل الاختصاصات هنا يفترض أنّ استراتيجيات الخطاب الدّلاليّة والتّداوليّة أكثر اتساعا مما قد نظنّ، وإنّ مساهمة العلوم الإنسانية بأنواعها لم يعقّد نظريّة الخطاب مثلما يبدو للوهلة الأولى، إنّما جعلها أكثر علمية وأكثر منهجية، وجعل تحليل الخطاب نفسه ميدانا لإبداعات غنية ومتنوعة يجب تحليلها والاستفادة منها.
ولئن كنتُ ذكرت للتوّ كلمات مثل إبداعات غنية ومتنوّعة، فإنّي حاولت الإضاءة على موضوع الإبداعات الغنية في متن البحث، وعرضت المسائل المرتبطة بذلك. أما بالنسبة إلى موضوع (التنوّع) فكنت قد بدأت أيضا برصد بعض دراسات الخطاب في دول غير غربية منذ بدء الألفية الثالثة، أي دول مثل الصين واليابان وجنوب أفريقيا والدول العربية. والجدير ذكره هنا أنّ كثيرا من دراسات الخطاب هذه نُشر أو يُنشر في دور نشر أوروبية وأميركية باللّغة الإنكليزية، ما يعني أنّ العولمة الثّقافيّة بدأت تؤتي ثمارها في مجالات نظريّة الخطاب وتحليله. فعلى سبيل المثال، تعدّ مساهمة الفيلسوف الأرجنتيني إرنستو لاكلو في نظريّة الخطاب مساهمة لا يستهان بها، وكنت قد أضأت باقتضاب على أفكاره.
توصّل البحث أيضا إلى أنّ الخطاب ليس مجرد أداة تواصل، بل هو أداة فعّالة في تشكيل الواقع الاجتماعيّ عبر استخدام نظريّة التّركيب الاجتماعيّ واستراتيجيات أخرى. هذا كلّه إن دلّ على شيء دلَّ على أنّ التّنظير في موضوع الخطاب وتحليله يحتاج إلى منهجية بحثية تشجع تعّدد الاختصاصات والتنوع الثّقافيّ معا، وأشدّد على كلمة (معا)، لأنّ الخطاب ذو بعد لغوي، وثقافي، وإدراكي، واجتماعيّ، وسياسي، وجغرافي. فإذا كان لكلّ بعد من أبعاد اللّغة أهمية معينة، فللبعد الثّقافيّ والإدراكي أهمية رئيسة، لأنّ البعد الثّقافيّ أشبه بالبعد الخاص بكلّ شعب على حدة، إذ إنّ لكلّ لغة عبقريتها (Genius) الفريدة، زد على ذلك تاريخها وغيره. في حين أنّ البعد الإدراكي أشبه بالبعد العام، لأنّ البشر يتماثلون نوعا ما في الخصائص الإدراكية.
انطلاقا ممّا ورد أعلاه، أظنّ أنّ البحث في نظريّة الخطاب يحتاج إلى دراسة ما هو خاصّ وأثره في الخطاب، ودراسة ما هو عام أو مشترك وأثره أيضا في الخطاب، وبخاصة الخطاب الموجّه إلى جمهور كبير، سواء أكان هذا الخطاب سياسيا أم إعلاميا، لأنّ الخطاب مثلما ذكرت أعلاه أشبه بمصفاة. وفي هذا السّياق، يمكن للدراسات المستقبلية أن تكشف خصائص الخطاب الرقمي ودوره في تعزيز الهيمنة الثّقافيّة في عصر وسائل التواصل الاجتماعيّ، لا سيما أنّه موجه إلى جمهور كبير.
المصادر والمراجع
المصادر والمراجع العربية
- فان دايك، تون أ. (1996). النص بنياته ووظائفه مدخل أولي إلى علم النص. في العمري، محمد (تحرير) نظريّة الأدب في القرن العشرين، أفريقيا الشرق.
- فان دايك، تون أ. (2005). علم النص: مدخل متداخل الاختصاصات. ترجمة سعيد البحيري،
القاهرة: دار القاهرة.
المصادر والمراجع الأجنبية
- Abrams, M. H. & Harpham, G. G. (2012). A glossary of literary terms. Boston: Wadsworth.
- Althusser, L. (1972). Lenin and philosophy. New York: Monthly review press.
- Angermuller, J. (2020). Poststructuralist discourse studies: From structure to practice. In A. De Fina & A. Georgakopoulou (eds.), The Cambridge handbook of discourse studies, 235-254. Cambridge: Cambridge university press.
- Austin, J. L. (1978). Quand dire c’est faire. Paris: Seuil.
- Baalbaki, R. M. (1990). Dictionary of linguistic terms. Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayin.
- Bach, K. (2011). Grice. In B. Lee (ed.), Philosophy of language: The key thinkers, 179-198. London: Continuum.
- Bohman, J. (2004). Discourse theory. In G. F. Gaus & C. Kukathas (eds.), Handbook of political theory, 155-166. London: Sage.
- Broadfoot, K., Deetz, , & Anderson, D. (2004). Multi-levelled, multi-method approaches to organizational discourse. In D. Grant et al. (eds.), The Sage handbook of organizational discourse, 193-211. London: Sage.
- Brown, G. & Yule, G. (1983). Discourse analysis. Cambridge: Cambridge university press.
- Carston, R. (2016). Contextual adjustment of meaning. In N. Riemer (ed.), The Routledge handbook of semantics, 195-210. London: Routledge.
- Castle, G. (2013). The literary theory handbook. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Chaminzo-Domínguez, P. J. (2018). Ambiguity and vagueness as cognitive tools for euphemistic and politically correct speech. In A. P. Pedraza (ed.), Linguistic taboo revisited, 79-96. Berlin: De Gruyter Mouton.
- Cohen, L., Manion, , & Morrison, K. (2008). Research methods in education. London: Routledge.
- Crick, N. A. (2019). Poststructuralism. In D. L. Cloud (ed.), The Oxford encyclopedia of communication and critical cultural studies (3), 1306-1320. Oxford: Oxford university press.
- De Beaugrande, R. & Dressler, W. (1981). Introduction to text linguistics. London: Longman.
- Devetak, R. (2013). Poststructuralism. In S. Burchill et al. (eds.), Theories of international relations, 187-216. Houndmills: Palgrave Macmillan.
- Dunn, K. C., & Neumann, I. B. (2019). Undertaking discourse analysis for social research. Ann Arbor: University of Michigan press.
- Eagleton, T. (1983). Literary theory: An introduction. Oxford: Blackwell.
- Fairclough, N. (2003). Discourse analysis: textual analysis for social research. London: Routledge.
- Fairclough, N. & Wodak, R. (1997/2000). Critical discourse analysis. In T. A. van Dijk (ed.), Discourse as social interaction, 258-284. London: Sage.
- Fairclough, N. (1995/2013). Critical discourse analysis: The critical study of language. London: Routledge.
- Fairclough, N., Mulderrig, J., & Wodak, R. (2011). Critical discourse analysis. In T. A. Van Dijk (ed.), Discourse studies: A multidisciplinary introduction, 357-378. London: Sage.
- Foucault, M. (1972) [1969]. The archaeology of knowledge: And the discourse on language. Translated by Sheridan Smith. London: Tavistock.
- Fraser, B. (1980). Conversational mitigation. Journal of pragmatics 4, 341-350.
- Gee, J. P. (2008). Social linguistics and literacies: Ideology in discours London: Routledge.
- Grice, H. P. (2006). Logic and conversation. In A. Jaworski & N. Coupland (eds.), The discourse reader, 66-77. London: Routledge.
- Hall, S. (2001). Foucault: Power, knowledge, and discourse. In M. Wetherell, S. Taylor, & S. J. Yates (eds.), Discourse theory and practice: A reader, 72-81. London: Sage.
- Handl, S. & Schmid, H.-J. (2011). Introduction. In S. Handl & H.-J. Schmid (eds.), Windows to the mind: Metaphor, metonymy, and conceptual blending, 1-20. Berlin: De Gruyter Mouton.
- Hartley, J. (2002). Communication, cultural, and media studies: The key concepts. London: Routledge.
- Hoey, M. (1995). Pattern of lexis in text. London: Oxford university press.
- Holmes, J. (1984). Modifying illocutionary force. Journal of pragmatics 8, 345-365.
- Jager, S. (2001). Discourse and knowledge: Theoretical and methodological aspects of a critical discourse and dispositive analysis. In R. Wodak & M. Meyer (eds.). Methods of critical discourse analysis, 32-62. London: Sage.
- Jones, R. H. (2012). Discourse and creativity. London: Routledge.
- Jørgensen, M. & Phillips, L. (2002). Discourse analysis as theory and method. London: Sage.
- Kaufman, J. C., Glăveanu, P., & Baer, J. (2017). The Cambridge handbook of creativity across domains. Cambridge: Cambridge university press.
- Kintsch, W. & van Dijk, T. A. (1978). Towards a model of text comprehension and production. Psychological review (85): 5, 363-394.
- Kølvraa, C. (2018). The discourse theory of Ernesto Laclau. In R. Wodak & B. Forchtner (eds.). The Routledge handbook of language and politics, 96-108. London: Routledge.
- Kristeva, J. (1979). Le texte du romam. Paris: Mouton.
- Laclau, E. (1996) Emancipation(s). London: Verso.
- Laclau, E. & Mouffe, C. (1985/2001). Hegemony and socialist strategy. London: Verso.
- Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. In A. Ortony (ed.), Metaphor and thought, 202-251. Cambridge: Cambridge university press.
- Mayr, A. (2008). Language and power: An introduction to institutional discourse. London: Continuum.
- Paz, A. I. (2013). Discourse theory. In R. J. McGee & R. L. Warms (eds.), Theory in social and cultural anthropology: An encyclopedia (1), 191-196. London: Sage.
- Ponterotto, D. (2003). The cohesive role of cognitive metaphor in discourse and conversation. in A. Barcelona (ed.), Metaphor and metonymy at the crossroads: A cognitive perspective, 283-298. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Renkema, J. (2004). Introduction to discourse studies. Amsterdam: John Benjamins.
- Sadock, J. (2006). Speech acts. In L. R. Horn & G. Ward (eds.), The handbook of pragmatics, 53-73. Oxford: Blackwell.
- Schatzki, T. R. (2001). Practice mind-ed orders. In T. R. Schatzki, K. Cetina, & E. von Savigny (eds.), The practice turn in contemporary theory, 50-63. London: Routledge.
- Swann, J. et al. (2004). Dictionary of sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh university press.
- Tendhal, M. & Gibbs, R. W. (2008). Complementary perspectives on metaphor: Cognitive linguistics and relevance theory. Journal of pragmatics 40, 1823-1864.
- Thompson, J. B. (1995). The media and modernity. Cambridge: Polity.
- Threadgold [Cardiff], T. (2003). Cultural studies, critical theory, and critical discourse analysis: Histories, remembering, and futures. Linguistik Online (14): 2, 5-37.
- Torfing, J. (2011). Discourse. In K. Dowding (ed.), Encyclopedia of power, 191-196. London: Sage.
- Torfing, J. (2005). Discourse theory: Achievements, arguments, and challenges. In D. Howarth & J. Torfing (eds.), Discourse theory in European politics: Identity policy and governance, 1-32. Houndmills: Palgrave Macmillan.
- van Dijk, T. A. (2011). Discourse studies: A multidisciplinary introduction. London: Sage.
- van Dijk, T. A. (1998). Ideology: A multidisciplinary approach. London: Sage.
- van Dijk, T. A. (1993). Principles of critical discourse analysis. Discourse and society (4): 2, 249-283.
- Weizman, E. (1993). Interlanguage requestive hints. In G. Kasper & S. Blum-Kulka (eds.), Interlanguage pragmatics, 123-137. Oxford: Oxford university press.
- Williams, J. (2005). Understanding poststructuralism. Chesham: Acumen.
- Wodak, R. (2007). Pragmatics and critical discourse analysis: A cross-disciplinary inquiry. Pragmatics and cognition (15): 1, 203-225.
المواقع الإلكترونية
- موقع التحري نيوز (3):
https://chat.whatsapp.com/Jd1vwBctxwoGoTD3a6S72H (Accessed on December 13,2024)
- موقع ثورة وجع الإنسان (64):
https://chat.whatsapp.com/JabBUkVUWB612SxsyBYoHR (Accessed on December 13,2024)
- موقع هنا لبنان (27):
https://www.instagram.com/reel/DDXS_SuR0Ex/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== (Accessed on December 13,2024)
([1]) د. كميل أ. مخايل حائز على شهادة دكتوراه في اللغات والترجمة من الجامعة اللبنانية، باحث ولساني يهتم بدراسات الخطاب والتداولية.
([2]) Crick, N. A. (2019). Poststructuralism. In D. L. Cloud (ed.), The Oxford encyclopedia of communication and critical cultural Studies (3), Oxford: Oxford university press, pp. 1307-1309.
([3]) Eagleton, T. (1983). Literary theory: An introduction. Oxford: Blackwell. p. 128.
([4]( Williams, J. (2005). Understanding poststructuralism. Chesham: Acumen. pp. 5-6.
([5]) Abrams, M. H. & Harpham, G. G. (2012). A glossary of literary terms. Boston: Wadsworth. pp. 308-313.
([6]) Devetak, R. (2013). Poststructuralism. In S. Burchill et al. (eds.), Theories of international relations, Houndmills: Palgrave Macmillan, pp. 200-207.
([7]) Broadfoot, K., Deetz, S., & Anderson, D. (2004). Multi-levelled, multi-method approaches to organizational discourse. In D. Grant et al. (eds.), The Sage handbook of organizational discourse, London: Sage, p. 195.
([8]) Althusser, L. (1972). Lenin and philosophy. New York: Monthly review press. pp. 163-164.
([9]) Swann, J. et al. (2004). Dictionary of sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh university press. p. 247.
([10]) Paz, A. I. (2013). Discourse theory. In R. J. McGee & R. L. Warms (eds.), Theory in social and cultural anthropology: An encyclopedia (1), London: Sage, p. 193.
([11]) Castle, G. (2013). The literary theory handbook. Oxford: Wiley-Blackwell. p. 167.
([12]( Angermuller, J. (2020). Poststructuralist discourse studies: From structure to practice. In A. De Fina & A. Georgakopoulou (eds.), The Cambridge handbook of discourse studies, Cambridge: Cambridge university press, p. 236.
([13]) Paz (2013). Discourse theory. In McGee & Warms (eds.), Theory in social and cultural anthropology: An encyclopedia (1), p. 193.
([14]) Dunn, K. C. & Neumann, I. B. (2019). Undertaking discourse analysis for social research. Ann Arbor: University of Michigan press. pp. 33-34.
([15]) Paz (2013). Discourse theory. In McGee & Warms (eds.), Theory in social and cultural anthropology: An encyclopedia (1), p. 191.
([16]) Dunn & Neumann (2019). Undertaking discourse analysis for social research. p. 62.
([17]) Schatzki, T. R. (2001). Practice mind-ed orders. In T. R. Schatzki, K. K. Cetina, & E. von Savigny (eds.), The practice turn in contemporary theory, London: Routledge, p. 53.
([18]) Foucault, M. (1972) [1969]. The archaeology of knowledge: And the discourse on language. Translated by Sheridan Smith. London: Tavistock. p. 49.
([19]) Foucault (1972) [1969]. Archaeology of knowledge: And the discourse on language. pp. 49-55.
([20]) Gee, J. P. (2008). Social linguistics and literacies: Ideology in discourse. London: Routledge. p. 3.
([21]) Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Research methods in education. London: Routledge. p. 389.
([22]) Laclau, E. (1996). Emancipation(s). London: Verso. pp. 44-45.
([23]) Torfing, J. (2011). Discourse. In K. Dowding (ed.), Encyclopedia of power, London: Sage. p. 193.
([24]) Dunn & Neumann (2019). Undertaking discourse analysis for social research. p. 19.
([25]) Hartley, J. (2002). Communication, cultural, and media studies: The key concepts. London: Routledge. p. 73.
([26]) Hall, S. (2001). Foucault: Power, knowledge, and discourse. In M. Wetherell, S. Taylor, & S. J. Yates (eds.), Discourse theory and practice: A reader, London: Sage, p. 72.
([27]) Angermuller (2020). Poststructuralist discourse studies: From structure to practice. In De Fina & Georgakopoulou (eds.), The Cambridge handbook of discourse studies, p. 236.
([28]) Torfing (2011) Discourse. In Dowding (ed.), Encyclopedia of power. p. 193.
https://www.instagram.com/reel/DDXS_SuR0Ex/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== (Accessed on December 13,2024)
([30]) موقع ثورة وجع الإنسان (64):
https://chat.whatsapp.com/JabBUkVUWB612SxsyBYoHR (Accessed on December 13,2024(
https://chat.whatsapp.com/Jd1vwBctxwoGoTD3a6S72H (Accessed on December 13,2024)
([32]) De Beaugrande, R. & Dressler W. (1981). Introduction to text linguistics. London: Longman. p. 17.
([33]( Mayr, A. (2008). Language and power: An introduction to institutional discourse. London: Continuum. p. 9.
([34]) Threadgold [Cardiff], T. (2003). Cultural studies, critical theory, and critical discourse analysis: Histories, remembering, and futures. Linguistik Online (14): 2, p. 7.
([35]) Torfing, J. (2005). Discourse theory: Achievements, arguments, and challenges. In D. Howarth & J. Torfing (eds.), Discourse theory in European politics: Identity policy and governance, Houndmills: Palgrave Macmillan, pp. 6-9.
([36]) Fairclough, N. & Wodak, R. (1997/2000). Critical discourse analysis. In T. A. van Dijk (ed.), Discourse as social interaction. London: Sage, pp. 358-363.
([37]) Fairclough, N., Mulderrig, J., & Wodak, R. (2011). Critical discourse analysis. In T. A. Van Dijk (ed.), Discourse studies: A multidisciplinary introduction, London: Sage, pp. 357-378.
([38]) Jager, S. (2001). Discourse and knowledge: Theoretical and methodological aspects of a critical discourse and dispositive analysis. In R. Wodak & M. Meyer (eds.), Methods of critical discourse analysis, London: Sage, p.33.
([39]) Laclau, E. & Mouffe, C. (1985/2001). Hegemony and socialist strategy. London: Verso. pp. 112-113.
([40]) Jørgensen, M. & Phillips, L. (2002). Discourse analysis as theory and Method. London: Sage. p. 38.
([41]) Torfing (2005). Discourse theory: Achievements, arguments, and challenges. In Howarth & Torfing (eds.), Discourse theory in European politics: Identity policy and governance, p. 25.
([42]) van Dijk, T. A. (2011). Discourse studies: A multidisciplinary introduction. London: Sage, pp. 3-5.
([43]) Jørgensen & Phillips (2002). Discourse analysis as theory and method. p. 20.
([44]) Swann (2004). A dictionary of sociolinguistics. p. 282.
([45]) Laclau & Mouffe (1985/2001). Hegemony and socialist strategy. pp. 105-106
([46]) Kølvraa, C. (2018). The discourse theory of Ernesto Laclau. In R. Wodak & B. Forchtner (eds.), The Routledge handbook of language and politics, London: Routledge, p. 96.
([47]) Jørgensen & Phillips (2002). Discourse analysis as theory and method. p. 186.
([48]) Van Dijk, T. A. (1998). Ideology: A multidisciplinary approach. London: Sage. p. 267.
([49]) Kølvraa (2018). The discourse theory of Ernesto Laclau. In Wodak & Forchtner (eds.), The Routledge handbook of language and politics, p. 105.
([50]) Grice, H. P. (2006). Logic and conversation. In A. Jaworski & N. Coupland (eds.), The discourse reader, London: Routledge, pp. 68-69.
([51]) Bach, K. (2011). Grice. In B. Lee (ed.), Philosophy of language: The key thinkers. London: Continuum. p. 186.
([52]) Wodak, R. (2007). Pragmatics and critical discourse analysis: A cross-disciplinary inquiry. Pragmatics and cognition (15): 1, p. 217.
([53]) Renkema, J. (2004). Introduction to discourse studies. Amsterdam: John Benjamins. p. 16.
([54] (Austin, J. L. (1978). Quand dire c’est faire. Paris: Seuil. pp. 109-114.
([55]) Sadock, J. (2006). Speech acts. In L. R. Horn & G. Ward (eds.), The handbook of pragmatics, Oxford: Blackwell, p. 55.
([56])فان دايك، تون أ. (1996). النص بنياته ووظائفه مدخل أولي إلى علم النص. في العمري، محمد (تحرير)، نظرية الأدب في القرن العشرين، أفريقيا الشرق، ص 67.
([57]) فان دايك، تون أ. (2005). علم النص: مدخل متداخل الاختصاصات. ترجمة سعيد البحيري، القاهرة: دار القاهرة. ص 270.
([58]) Brown, G. & Yule, G. (1983). Discourse analysis. Cambridge: Cambridge university press. p. 238.
([59]) Kintsch, W. & van Dijk, T. A. (1978). Towards a model of text comprehension and production. Psychological Review (85): 5, p. 366.
([60]( De Deaugrande & Dressler (1981). Introduction to text linguistics. p. 91.
([61]) Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. In A. Ortony (ed.), Metaphor and thought, Cambridge: Cambridge university press, pp. 203-206.
([62]) Handl, S. & Schmid, H.-J. (2011). Introduction. in S. Handl & H.-J. Schmid (eds.), Windows to the mind: Metaphor, metonymy, and conceptual blending. Berlin: De Gruyter Mouton, p. 1.
([63]) Carston, R. (2016). Contextual adjustment of meaning. In N. Riemer (ed.), The Routledge handbook of semantics, London: Routledge. p. 203.
([64]) Tendhal, M. & Gibbs, R. W. (2008). Complementary perspectives on metaphor: Cognitive linguistics and relevance theory. Journal of Pragmatics 40, p. 1836.
([65]) Ponterotto, D. (2003). The cohesive role of cognitive metaphor in discourse and conversation. In A. Barcelona (ed.), Metaphor and metonymy at the crossroads: A cognitive perspective, Berlin: Mouton de Gruyter, p. 292.
([66]) Kristeva, J. (1979). Le texte du romam. Paris: Mouton. p. 12.
([67]) Fairclough, N. (1995/2013). Critical discourse analysis: The critical study of language. London: Routledge. p. 95.
([68]) Fairclough, N. (2003). Discourse analysis: Textual analysis for social research. London: Routledge. p. 218.
([69]) Fairclough (1995/2013). Critical discourse analysis: The critical study of language. p. 95.
([70]) Fraser, B. (1980). Conversational mitigation. Journal of pragmatics 4, p. 342.
([71]) Holmes, J. (1984). Modifying illocutionary force. Journal of pragmatics 8, p. 348.
([72]) Weizman, E. (1993). Interlanguage requestive hints. In G. Kasper & S. Blum-Kulka (eds.), Interlanguage pragmatics, Oxford: Oxford university press, p. 129.
([73]) Chaminzo-Domínguez, P. J. (2018). Ambiguity and vagueness as cognitive tools for euphemistic and politically correct speech. In A. P. Pedraza (ed.), Linguistic taboo revisited, Berlin: De Gruyter Mouton, p. 79.
([74]) Baalbaki, R. M. (1990). Dictionary of linguistic terms. Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayin. p. 396.
([75]) Baalbaki (1990). Dictionary of linguistic terms. pp. 115-141.
([76]) van Dijk, T. A. (1993). Principles of critical discourse analysis. Discourse and Society (4): 2, p. 258.
([77]) Hoey, M. (1995). Pattern of lexis in text. London: Oxford university press. p. 57.
([78]) Bohman, J. (2004). Discourse theory. In G. F. Gaus & C. Kukathas (eds.), Handbook of political theory, London: Sage, p. 155.
([79]) Thompson, J. B. (1995). The media and modernity. Cambridge: Polity. pp. 85-86.
([80]) Bohman (2004). Discourse theory. In Gaus & Kukathas (eds.), Handbook of political theory, pp. 155-156.
([81]) Jones, R. H. (2012). Discourse and creativity. London: Routledge. p. 7.
([82]) Kaufman, J. C., Glăveanu, V. P., & Baer, J. (2017). The Cambridge handbook of creativity across domains. Cambridge: Cambridge university press. p. 5.



