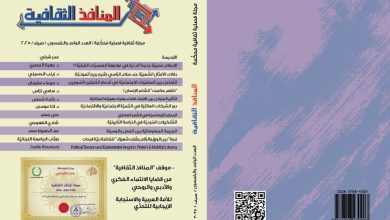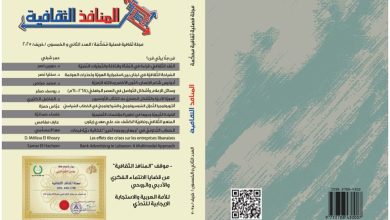القيادة التّربويّة ودورها في تطوير المؤسّسات التّعليميّة: المفاهيم، الأنماط والتّحديّات
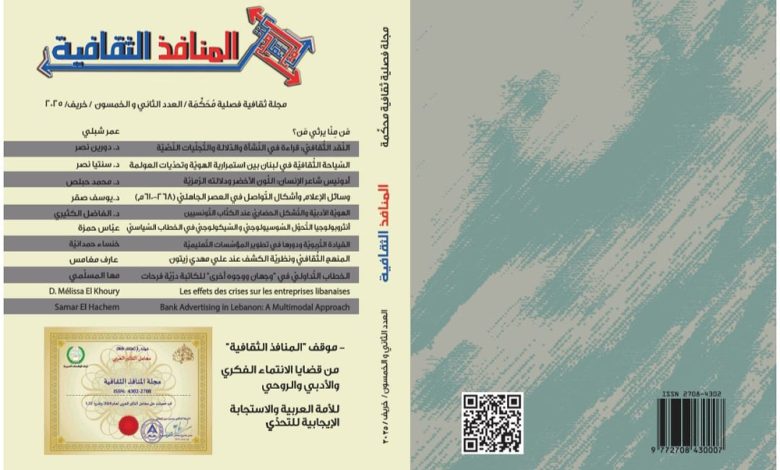
القيادة التّربويّة ودورها في تطوير المؤسّسات التّعليميّة: المفاهيم، الأنماط والتّحديّات
Educational leadership and its role in the development of educational institutions: Concepts, patterns, and challenges
خنساء أحمد حمدانيّة
Khansa Ahmad Hemdanieh
تاريخ الاستلام: 30/4/2025 تاريخ القبول 13/ 5/ 2025
ملخّص
في ظلّ المتغيّرات السّريعة التي يشهدها قطاع التّعليم، تبرز القيادة التّربويّة كعنصر حيويّ في تطوير المؤسّسات التّعليميّة وتعزيز فعاليّتها، فلم تعد تقتصر مهمّة القائد التّربويّ على الجوانب الإداريّة والتّنظيميّة فحسب، بل أصبحت تشملُ بناء بيئة تعليميّة محفّزة تدعم الإبداع، وتلبّي احتياجات المتعلّمين، وتسهم في تحقيق نتائج نوعيّة.
يتناول هذا البحث بالدّراسة والتّحليل دور القيادة التّربويّة في بناء بيئة تعليميّة إيجابيّة، وانعكاسات هذا الدّور على تحقيق الكفاية الإنتاجيّة التّعليميّة في المؤسّسات التّربويّة. كما يستعرض البحث مفاهيم القيادة التّربويّة، وتطوّرها وأنماطها المختلفة، إلى جانب التّحديّات التي تواجه القادة في الميدان، كما يُسهم في تسليط الضّوء على نماذج واقعيّة ناجحة من البيئة اللّبنانيّة، فيتعزّز الطّابع التّطبيقيّ للبحث ويقدّم مقترحات عمليّة قابلة للتّنفيذ. ذلك، إضافة إلى دور القيادة التّربويّة في تطوير الأداء التّعليميّ ضمن المدارس الرّسميّة اللّبنانيّة، من خلال تحليل نماذج ناجحة؛ فأظهرت النّتائج أنَّ أنماط القيادة التّشاركيّة والتّحليليّة تعزّز بيئة إيجابيّة وتحفّز الكوادر التّعليميّة. كما بيّنت أهمّيّة الذّكاء العاطفيّ والمهارات القياديّة في مواجهة التّحدّيات المؤسّسيّة والثّقافيّة.
توصي الدّراسة بتعزيز التّدريب المهنيّ ودعم استقلاليّة القادة التّربويّين، وتؤكّد أنَّ القيادة الفعّالة هي حجر الأساس لأيّ إصلاح تعليميّ مستدام.
الكلمات المفتاحيّة: القيادة التّربويّة- بيئة تعليميّة- التّشاركيّة- كفاءة- الذّكاء العاطفيّ- البيئة الإيجابيّة- الأنماط- التحديات.
Abstract
Amid the rapid changes in the education sector, educational leadership emerges as a vital element in developing educational institutions and enhancing their effectiveness. The role of an educational leader is no longer limited to administrative and organizational aspects; it now encompasses building a stimulating learning environment that fosters creativity, meets learners’ needs, and contributes to achieving qualitative outcomes.
This research analyzes the role of educational leadership in creating a positive learning environment and its impact on achieving educational productivity in academic institutions. It explores the concepts, development, and various models of educational leadership while highlighting the challenges faced by leaders in the field. Additionally, the study sheds light on successful real-life models from the Lebanese context, enhancing the practical aspect of the research and presenting actionable recommendations.
Furthermore, the study examines the role of educational leadership in improving academic performance within Lebanese public schools by analyzing successful models. The results indicate that participatory and transformative leadership styles foster a positive environment and motivate educational staff. The study also highlights the importance of emotional intelligence and leadership skills in addressing institutional and cultural challenges.
The research recommends strengthening professional training and supporting the autonomy of educational leaders, emphasizing that effective leadership is the cornerstone of any sustainable educational reform.
Keywords :Eucational leadership – Participative- Educational Environment – Efficiency – Emotional Intelligence– Positive Environment– Patterns- Challenges.
أوّلًا: المقدّمة
تُعدُّ القيادة من المفاهيم الأساسيّة في حقل الإدارة والعلوم السّلوكيّة، وهي تشكّلُ ركيزة أساسيّة في توجيه الأفراد والمؤسّسات نحو تحقيق الأهداف المرجوَّة، خصوصًا في المؤسّسات التّربويّة التي تتعامل مع الإنسان كقيمة وهدف في آن معًا. كما تحتلُّ القيادة التّربويّة مكانة بالغة الأهمّيّة في البنية الإداريّة للمدرسة، حيث يُناط بها دور فاعل في ضبط الإيقاع التّربويّ، وتنظيم الموارد، وتوجيه الجهود نحو تحقيق نتائج تعليميّة ذات جودة عالية.
في خضمّ التّحوُّلات المُتسارعة التي يشهدها القطاع التّربويّ بفعل التّطوُّر التّكنولوجيّ، والضّغوط المجتمعيّة المتزايدة، وتنوُّع احتياجات المتعلّمين، تزداد الحاجة إلى قيادة تربويّة فاعلة قادرة على صناعة بيئة تعليميّة إيجابيّة تحفّز المعلّمين، وتدعم المتعلّمين، وتوفّر مناخًا ملائمًا للإبداع والإنتاجيّة.
إنَّ الكفاية الإنتاجيّة التّعليميّة لم تعد تُقاس فقط بكمّ المعارف المقدّمة، بل بمدى قدرة المؤسّسة التّربويّة على تفعيل مواردها البشريّة والمادّيّة، وتحقيق نتائج نوعيّة مستدامة، وتأتي القيادة التّربويّة هنا كعامل مفصليّ في بناء بيئة محفّزة، قائمة على الثّقة والتّعاون والانفتاح، وهي عوامل تؤثّر مباشرة في رفع الكفاية والإنتاجيّة على مستوى الأداء الفرديّ والمؤسّساتيّ.
انطلاقًا من هذه الرّؤية، يسعى هذا البحث إلى دراسة أدوار القيادة التّربويّة، وتحليل أثرها في خلق بيئة تعليميّة إيجابية تُمكّن من الوصول إلى كفاية إنتاجيّة تعليميّة متقدّمة، تُلبّي تطلّعات الطلّاب والمجتمع على حدّ سواء.
- أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضّوء على أهمّيّة ودور القيادة التّربويّة في تعزيز البيئة التّعليميّة الإيجابيّة وتحقيق الكفاية الإنتاجيّة التّعليميّة في المؤسّسات التّربويّة، ومن خلال هذا الهدف العام، يسعى البحث إلى تحقيق الاهداف الفرعيّة الآتية:
- تحديد مفهوم القيادة التّربويّة، وبيان خصائصها وأهمّ وظائفها داخل المؤسّسة التّعليميّة.
- تحليل العوامل التي تؤثّر في فاعليّة القيادة التّربويّة، سواء على مستوى الشّخصيّة القياديّة أم البيئة التّنظيميّة.
- توضيح مفهوم الكفاية الإنتاجيّة التّعليميّة، ومكوّناتها التّفاوتيّة الأساسيّة التي تُسهم في جودة التّعليم.
- اكتشاف العلاقة التّفاعليّة بين القيادة التّربويّة وبناء بيئة تعليميّة محفّزة للإنتاجية.
- رصد التّحدّيات والصّعوبات التي تواجه القادة التّربويّين في سعيهم إلى خلق مناخ تعليميّ إيجابيّ.
- تقديم مقترحات عمليّة لتعزيز فاعليّة القيادة التّربويّة بما يحقّق بيئة تعليميّة منتجة ومتطوّرة.
- الإشكاليّة
من هنا، تنبع إشكاليّة هذا البحث من الحاجة إلى فهم العلاقة بين نمط القيادة التّربويّة في المدرسة وبين تحقيق الكفاية الإنتاجيّة التّعليميّة، مع الأخذ في الحسبان الأبعاد النّفسيّة والاجتماعيّة والتّنظيميّة لهذه العلاقة؛ إذ إنَّ فعاليّة القيادة لا تقتصر على المهام الإداريّة البحتة، بل تتجاوزها إلى القدرة على التّأثير والإلهام وبناء ثقافة مؤسّسيّة إيجابيّة قادرة على التّكيُّف والتّطوير وتحقيق الأهداف بكفاءة عالية.
ما دور القيادة التّربويّة في بناء البيئة الإيجابيّة لتحقيق الكفاية الإنتاجيّة التّعليميّة في المؤسّسات التّربويّة؟
- الفرضيّات
- الفرضيّة الرّئيسة
توجد علاقة ذات دلالة بين فاعليّة القيادة التّربويّة وبناء بيئة تعليميّة إيجابيّة تُسهم في تحقيق الكفاية الإنتاجيّة التّعليميّة في المؤسّسات التّربويّة.
ب. الفرضيّات الفرعيّة
- توجد علاقة إيجابيّة بين ممارسة أنماط القيادة التّربويّة التّحفيزيّة وبين مستوى التّحفيز لدى المعلّمين داخل البيئة المدرسيّة.
- تؤثّر القيادة التّربويّة ذات الطّابع التّشاركي في رفع كفاءة استخدام الموارد البشريّة والمادّيّة في المؤسّسات التّربويّة.
- تُسهم القيادة التّربويّة في تقليل مستوى التّوتر والصّراعات داخل المدرسة، فتنعكس إيجابًا على جودة التّعليم.
- يؤدّي وجود بيئة تعليميّة إيجابيّة يقودها مدير تربويّ فعَّال إلى تحسين أداء الطّلّاب والمعلّمين على حدّ سواء.
- ترتبط درجة الكفاية الإنتاجيّة التّعليميّة في المدرسة بدرجة التّفاعل الإيجابيّ بين القيادة والهيئة التّدريسيّة.
- تؤثّر قدرة القائد التّربويّ على بناء ثقافة مدرسيّة قائمة على الثّقة والانفتاح في تفعيل الإبداع والابتكار داخل المؤسّسة التّعليميّة.
- حدود البحث
يتناول هذا البحث القيادة التّربويّة في المدارس (المرحلة الأساسيّة والثانويّة) ضمن السّياق اللّبنانيّ والعربيّ بوجه عام، مع التّركيز على علاقتها بخلق بيئة تعليميّة إيجابيّة تُفضي إلى كفاية إنتاجيّة تعليميّة.
- الحدّ المكانيّ: يركّز البحث على المؤسّسات التّربويّة الرّسميّة والخاصّة في البيئة العربيّة، مع الإشارة إلى نماذج دوليّة داعمة عند الحاجة.
- الحدّ الزّمنيّ: يعتمد البحث على أدبيّات تمتدُّ من 2015 إلى 2025، للاستفادة من أحدث الدّراسات المتعلّقة بالقيادة والإنتاجيّة التّعليميّة.
- الحدّ البشريّ: يتوجّه البحث إلى المديرين التّربويّين والمعلّمين والقيادات التّعليميّة في المدارس.
- المصطلحات الأساسية
- القيادة التّربويّة: يُقصدُ بها مجموعة من المهارات والعمليّات الإداريّة والتّربويّة التي يمارسها المدير أو القائد، داخل المؤسّسة التّعليميّة لتوجيه وتحفيز العاملين وتحقيق الأهداف التّربويّة بكفاءة.
- البيئة الإيجابيّة: هي المناخ التّربويّ والاجتماعيّ الذي يتَّسم بالدّعم والانفتاح والتّحفيز والتّعاون داخل المؤسّسة التّعليميّة.
- الكفاية الإنتاجيّة التّعليميّة: تشير إلى قدرة المؤسّسة التّربويّة على تحقيق نتائج تعليميّة فعَّالة، مع توظيف الموارد بكفاءة وتحفيز العاملين وتحقيق أهداف التّعليم النّوعيّ.
- الأنماط القياديّة: القيادة التّحويليّة، القيادة التّشاركيّة، القيادة الأوتوقراطيّة، القيادة الموقفيّة، القيادة الخادمة والقيادة الموزّعة. كلّ نمط من هذه الأنماط يناسب بيئة تعليميّة أو مرحلة معيّنة، وغالبًا ما يُدمَج القادة التّربويّون بين أكثر من نمط بحسب الحاجة.
- منهجيّة البحث:
يعتمد البحث على المنهج الوصفيّ التّحليليّ، من خلال تحليل الأدبيّات التّربويّة الحديثة المتعلّقة بالقيادة والكفاية الإنتاجيّة، إلى جانب استقراء نماذج وتجارب واقعيّة لتطبيقات القيادة التّربويّة الفعَّالة، ويعتمد كذلك على تحليل دراسات سابقة تسهم في دعم فرضيّات البحث وتفسير علاقات التّأثير المتبادلة بين المتغيّرات.
ثانيًا: الإطار النّظريّ
- تعريف القيادة التّربويّة
القيادة التّربويّة هي عمليّة توجيه وإدارة الجهود داخل المؤسّسات التّعليميّة من أجل تحقيق أهداف تربويّة محدَّدة، تعتمد على الرّؤية الواضحة والتّخطيط الاستراتيجيّ، مع التّركيز على تطوير كلّ من البيئة التّعليميّة والعناصر البشريّة العاملة فيها؛ كما أنَّها تُعدّ عنصرًا محوريًا في تحسين جودة التّعليم، إذ تسهم في رفع كفاءة المعلّمين وتحفيز الطّلبة وتطوير المناهج والبرامج التّعليميّة؛ كما ترتكز على مبادئ المشاركة والعدالة والتّمكين، مما يجعلُ الفاقد التّربويّ ليس مجرّد مدير، بل محفّز وموجّه وميسّر للتّغيير الإيجابيّ. يُنظرُ إلى القيادة التّربويّة على أنَّها أداة لإحداث التّغيير المستدام داخل المدارس والجامعات، وذلك من خلال بناء ثقافة تنظيميّة داعمة للتّعلّم والتّطوير المستمرّ.
تتطلّب القيادة التّربويّة قُدرات خاصّة تشمل مهارات التّواصل واتّخاذ القرار والذّكاء العاطفيّ والقدرة على حلّ المشكلات؛ كما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتّحسين المدرسيّ ونجاح الطّلبة، حيث تشير البحوث إلى أنَّ القادة الفاعلين يسهمون في خلق بيئات تعليميّة محفّزة وآمنة، ويمكن أنْ تأخذ القيادة التّربويّة أشكالًا متعدّدة مثل القيادة التّحويليّة أو التّشاركيّة أو الموزّعة، بحسب السّياق والثّقافة المؤسّسيّة.
في الوقت الرّاهن، ازدادت الحاجة إلى قادة تربويّين يمتلكون رؤية مرنة قادرة على التّكيّف مع التّغيّرات التّكنولوجيّة والاجتماعيّة؛ ولا تقتصر القيادة التّربويّة على مديري المدارس فحسب، بل تشمل كلّ من يؤدّي دورًا في اتّخاذ القرار التّربوي وتوجيه المسارات التّعليميّة.
من هنا، فإنَّ القيادة التّربويّة تُعدّ فنًّا ومهارة تحتاج إلى تدريب وتأهيل مستمرّ لضمان فعاليّتها؛ كما تمثّل حلقة وصل بين السّياسات التّعليميّة وواقع التّطبيق داخل الفصول الدّراسيّة.
في المُجمل، تعدّ القيادة التّربويّة عاملًا حاسمًا في نجاح المؤسّسات التّعليميّة وتطوير المجتمعات بشكل عام([1]).
- الفرق بين الإدارة والقيادة في السّياق التّربويّ
يُصنَّفُ التّمييز بين الإدارة والقيادة ضمن الأمور البالغة الأهمّيّة في السّياق التّربويّ، حيث ينعكسُ كلّ منهما بشكل مباشر على جودة التّعليم وفعاليّة المؤسّسات التّعليميّة؛ فالإدارةُ التّربويّة تُعنى بتنظيم العمليّات، وتطبيق القوانين، وضمان سير العمل ضمن الأُطر المؤسّسيّة المحدَّدة. أمَّا القيادة التّربويّة، فتركّز على إلهام المعلمين والطّلّاب، وتشكيل الرّؤية المستقبليّة، وتحفيز الجميع نحو تحقيق أهداف مشتركة.
يعملُ المدير التّربويّ على التّخطيط، والتّنظيم والتّقويم، وهو مسؤول عن الجوانب الإداريّة اليوميّة. في المقابل، يتجاوز القائد التّربويّ تلك المهام؛ ليؤثّر في ثقافة المدرسة ويقود التّغيير الإيجابيّ، كما تتطلّب القيادة مهارات في التّواصل وبناء العلاقات واتّخاذ القرارات الاستراتيجيّة بناء على رؤية واضحة.
تسعى القيادة إلى الابتكار والتّطوير، وتضمن الإدارة الاستقرار؛ من هنا، تبرز أهمّيّة التّكامل بين الدّورَين لتحقيق بيئة تعليمية فعَّالة، حيث يُحدث القائد التّربويّ فرقًا حقيقيًّا حين يجمع بين كفاءة الإدارة روح القيادة المُلهمة([2]).
- تطوّر مفهوم القيادة التّربويّة عبر الزّمن
شهدَ مفهوم القيادة التّربويّة تطوّرًا ملحوظًا عبر العصور، حيث بدأ يتمحور حول السّلطة الإداريّة والتّنظيميّة التي يمارسها المدير داخل المدرسة، حيث كان يُنظر إلى القائد التّربويّ كمنفّذ للسّياسات ومراقب للانضباط؛ مع مرور الوقت، تغيّر هذا المفهوم ليأخذ أبعادًا أعمق، حيث أصبح القائد التّربويّ شريكًا في العمليّة التّعليميّة، يركّز على دعم المعلّمين وتحفيز الطّلّاب، ويقود التّغيير والتّطوير داخل البيئة التّعليميّة من خلال الرّؤية والابتكار والتّواصل الفعّال([3])؛ لقد تطوّر هذا المفهوم على مراحل عدّة:
- المرحلة الأولى (حتّى منتصف القرن العشرين)
- كان يُنظر إلى القيادة التّربويّة من منظور إداريّ بحت.
- ركّزت على الجوانب التّنظيميّة مثل تنفيذ القوانين، الحفاظ على الانضباط، ومتابعة التّعليمات.
- القائد التّربوي كان يُعدّ مديرًا أكثر من كونه قائدًا.
- الأسلوب كان سلطويًّا أو أوتوقراطيًّا في الغالب.
- مرحلة التّركيز على الكفاءة والفعاليّة (1950-1970)
- ظهرت الحاجة إلى تحقيق أهداف تعليميّة محدَّدة بفعاليّة.
- برزت مفاهيم مثل الإدارة بالأهداف والكفاءة الإداريّة.
- القيادة بدأتْ تأخذ شكلًا أكثر تخطيطًا وتنظيمًا.
- ظهر الاهتمام بتحسين الأداء الأكاديميّ للطّلّاب عن طريق تحسين أداء المعلّمين.
- القيادة التّحويليّة والإنسانيّة (1980-1990)
- تطوّر المفهوم نحو القيادة التّحويليّة (Transformational Leadership).
- ركّزت على تحفيز العاملين، خلق رؤية، وتطوير ثقافة مدرسيّة إيجابيّة.
- القائد أصبح ملهمًا، لا يكتفي بالإدارة بل يقود نحو التّعبير.
- ظهرت أهمّيّة العلاقات الإنسانيّة والاتّصال الفعّال بالبيئة التّربويّة.
- القيادة الموزّعة والتّشاركيّة (2000- حتى وقتنا الحاضر).
- تمّ الاعتراف بأهمّيّة المشاركة الجَماعيّة في اتّخاذ القرار.
- ظهرت نماذج مثل:
- القيادة الموزّعة (Distributed Leadership).
- القيادة الأخلاقيّة (Ethical Leadership).
- القيادة الخادمة (Servant Leadership).
- القائد الآن يعمل ضمن فريق ويشجّع تمكين المعلّمين والطلّاب.
- التّأكيد على الابتكار والمرونة واستخدام التّكنولوجيا.
- القيادة التّربويّة في عصر التّحوّل الرّقميّ (العقد الأخير)
- مع التّطوّر التّكنولوجيّ والتّحوّل الرّقميّ في التّعليم، تغيّرت متطلّبات القيادة.
- أصبح القائد التّربوي بحاجة إلى:
- فهم التّقنيات الحديثة وتوظيفها.
- إدارة التّعلّم عن بُعد.
- التّعامل مع الأزمات مثل جائحة كورونا.
- القيادة الآن أكثر تعقيدًا وتتطلّبُ مرونة وقدرة على التّكيُّف([4]).
- العوامل الشّخصيّة للقائد التّربويّ
تُعدُّ الصّفات الشّخصيّة للقائد التّربويّ من أهمّ المحدّدات التي تؤثّر في فاعليّته؛ وفاعليّته تشمل هذه العوامل:
- الذّكاء العاطفيّ: يُمكّن القائد من فهم مشاعر الآخرين وتنظيم عواطفه، ممّا يخلق بيئة يسودها الاحترام والتّفاهم؛ فالقائد الذي يتحلّى بالتّعاطُف والقدرة على الإصغاء يتمكّن من تعزيز الولاء والانتماء في فريقه.
- الكفاءة المهنيّة: تشملُ المؤهّلات العلميّة والخبرات التّربويّة والمعرفة بالسّياسات التّعليميّة. يُنظر إلى القائد المتمكّن كمرجع موثوق.
- القدرة على اتّخاذ القرار: تشمل تحليل المشكلات، تقييم البدائل، واتّخاذ قرارات مبنيّة على بيانات واقعيّة.
- الرّؤية المستقبليّة والمرونة: القدرة على التّكيّف مع التّغيّرات السّريعة في المجال التّعليميّ، وتوجيه المؤسّسة نحو التّميّز والابتكار.
- أسلوب القيادة: سواء كانت القيادة سلطويّة، ديمقراطيّة، أم تحويليّة، فإنّ الأسلوب المتَّبع يؤثّر بشكل مباشر في مدى تفاعل العاملين ورضاهم.
- أنماط القيادة التّربويّة
تتنوّع القيادة التّربويّة وفقًا لأسلوب القائد، وطبيعة البيئة التّعليميّة، وطريقة التّفاعل مع المعلّمين والطّلّاب، ومن خلال الدّراسات التّربويّة، أمكن تصنيف أنماط القيادة التّربويّة إلى أنواع عدّة رئيسة:
- القيادة الأوتوقراطيّة (السّلطويّة)
- تعريف
يقوم القائد في هذا النمط باتّخاذ جميع القرارات من دون الرّجوع إلى الآخرين، ويركّز على فرض النّظام والانضباط الصّارم.
- السّمات
- مركزيّة في السّلطة.
- ضعف في التّواصل الأفقيّ.
- التّركيز على الإنجاز والانضباط.
- الإيجابيّات
- سرعة في اتّخاذ القرار.
- وضوح في الأوامر والتّعليمات.
- السّلبيّات
- يحدّ من الإبداع والمبادرة.
- يقلّل من الحافز الدّاخليّ لدى المعلّمين.
- مثال:
يرفض مدير المدرسة النّقاش أو إشراك المعلّمين في اتّخاذ القرار، ويُطبّق اللّوائح بحذافيرها. في هذا النّمط، قد يحقّق هذا المدير نتائج سريعة في حالات الطّوارئ والانضباط، لكنّه يقلّل من دافعيّة المعلّمين ومن حريّة الإبداع، فيخلق بيئة من التّوتر والخضوع، مما يؤثّر سلبًا على العلاقات داخل المدرسة.
- القيادة الدّيمقراطيّة (التّشاركيّة)
- تعريف
يُشرك القائد المعلمين والطلاب فب عملية اتخاذ القرار، ويشجع على الحوار والمشاركة.
- السّمات
- تشجيع التّعاون.
- احترام الآراء المختلفة.
- تواصل فعّال وثقة متبادلة.
- الإيجابيّات
- يحفّز المعلّمين ويعزّز انتماءهم.
- يرفع من جودة القرارات بفضل تنوّع الآراء.
- السّلبيّات
- بطء في اتّخاذ القرار أحيانًا.
- قد يؤدّي إلى تشتُّت في الآراء إذا لم يُحسن تنظيم النّقاش.
- مثال:
يُنظّم القائد التّربويّ اجتماعات دوريّة مع المعلّمين لمناقشة التّحدّيات ووضع حلول جَماعيّة؛ فيتحفّز المعلّمين على العمل بروح الفريق، ويتعزّز الشّعور بالانتماء والمسؤوليّة، ويرفع من معنويّات الطاقم التّدريسيّ ويشجّع على الابتكار.
- القيادة التّحويليّة
- تعريف
يعملُ القائد على إلهام العاملين وتحفيزهم لتحقيق تغيير إيجابي، ويركّز على تطوير القدرات وتعزيز الإبداع.
- السّمات
- رؤية واضحة للمستقبل.
- تركيز على التّغيير والتّطوير.
- إلهام وتحفيز داخليّ للفريق.
- الإيجابيّات
- يعزّز روح المبادرة والابتكار.
- ينمّي ثقافة مدرسيّة إيجابيّة.
- السّلبيّات
- يتطلّب وقتًا وجهدًا طويلين لتطبيق الرّؤية.
- قد لا يحقّق نتائج ملموسة على المدى القصير.
- يطوّر القائد مشروعًا مدرسيًّا لتحويل البيئة التّعليميّة إلى بيئة رقميّة تفاعليّة، فيحفّز المعلّمين للمشاركة؛ فيحفّز على تحسين الأداء المستمرّ والتّطوير الذّاتيّ، ويخلق بيئة تعليميّة ملهمة ومرنة تشجّعُ على تبنّي استراتيجيّات تعليميّة حديثة تواكب التّغيّرات.
- القيادة الموقفيّة
- تعريف
يقوم القائد بتغيير أسلوبه في القيادة وفقًا للموقف أو الظّرف الذي يواجهه.
- السّمات
- مرونة عالية.
- قدرة على التّكيّف مع التّغيّرات.
- فهم عميق للسّياق والنّاس.
- الإيجابيّات
- يُتيح الاستجابة المناسبة في كلّ حالة.
- يُناسب الفرق المتنوّعة.
- السّلبيّات
- قد يُنظر إليه على أنّه غير ثابت أو متردّد.
- يتطلّب وعيًا نفسيًّا واجتماعيًّا عاليًا.
- مثال:
يستخدم القائد أسلوبًا ديمقراطيًّا مع فريق قويّ ومتحفّز، ويستخدم أسلوبًا مباشرًا مع فريق قليل.
- القيادة التّشاركيّة (اللّامركزيّة)
- تعريف
تُوزَّع القيادة على أفراد عدّة في المدرسة (مثل قادة الفرق، المعلمين المتميّزين)، مما يشجّع على المشاركة الجَماعيّة.
- السّمات
- تعزيز الاستقلاليّة
- تنمية القيادات المستقبليّة
- مشاركة المسؤوليّات
- الإيجابيّات
- تقوية ثقافة التّعاون
- تعزيز الإبداع وتنوّع الحلول
- السّلبيات
- قد يؤدّي إلى عدم وضوح المسؤوليّات
- صعوبة في التّنسيق إذا غابت الرّؤية المشتركة.
- مثال
يُشرِك مدير المدرسة المعلّمين في وضع السّياسات التّعليميّة، ويُفوّض قادة الفرق بمهام محدَّدة، فيعزّز ثقافة العمل الجَماعي والمبادرة، ويطوّر مهارات القيادة لدى المعلمين، ويزيد من التزام الفريق وتحمّلهم للمسؤوليّة.
في المحصّلة، تختلف أنماطُ القيادة التّربويّة باختلاف السّياقات، ولا يوجد نمط مثاليّ واحد يمكن اعتماده في جميع الحالات، فالقائد الفعَّال هو من يحسن اختيار النّمط المناسب حسب الظّروف والموارد المُتاحة، ويوازن بين الحزم والتّحفيز، وبين السّلطة والتّشاركيّة.
- التّحدّيات التي تواجه القيادة التّربويّة
تُعدّ القيادة التّربويّة حجر الزّاوية في تطوير وتحسين النّظام التّعليميّ؛ لكن، على الرّغم من أهمّيّة الدّور الذي تؤدّيه القيادة في نجاح المؤسّسات التّعليميّة، فإنَّها تواجه العديد من التّحدّيات التي قد تُعيق سير العمل وتحقيق الأهداف التّعليميّة.
- التّحدّيات الإداريّة والتّنظيميّة
الخصائص: تُعدُّ التّحدّيات الإداريّة والتّنظيميّة من أبرز العوائق التي تواجه القادة التّربويّين في العديد من المؤسّسات التّعليميّة. وتتراوحُ هذه التّحدّيات بين صعوبة تنظيم الوقت وإدارة الموارد إلى ضرورة التّنسيق بين مختلف الأقسام والأنشطة المدرسيّة.
- التّأثير على القيادة
- القيادة الفعّالة: تواجه القيادة التّربويّة تحدّيًا كبيرًا في تنظيم العمل بين المعلّمين والطّلّاب، ووضع استراتيجيّات تضمن سير العمل بسلاسة. في العديد من المؤسّسات التّعليميّة، حيث توجد تعدُّدية في الأقسام والمرافق (مثل الأنشطة اللّامنهجيّة، الدّعم النّفسيّ، والإشراف الأكاديميّ)، ممّا يخلق صعوبة في التّنسيق بين هذه الأطراف المختلفة.
- القرارات التّنظيميّة: القائد التّربويّ مضطرٌّ لاتّخاذ قرارات تنظيميّة تحتاج إلى توازن بين تحقيق أهداف المدرسة والإلمام بكافّة التّفاصيل اليوميّة، وعليه، فإنَّ الإدارة الذّاتيّة والقدرة على ترتيب الأولويّات تعدّدث من المهارات الأساسيّة التي يجب أنْ يمتلكها القائد.
- كيفيّة التّعامل مع التّحدّي
- التّخطيط الفعَّال: ينبغي على القائد التّربويّ وضع خطط استراتيجيّة تأخذ بعين الحسبان الاحتياجات المختلفة للمدرسة والمشكلات التي قد تواجهها.
- التّحسين المستمرّ في الإدارة: يحتاج القائد إلى تطوير أساليب إدارة الوقت وتنظيم الأنشطة المدرسيّة بشكل دوريّ، بما يساعد على تحسين الأداء التّنظيميّ للمؤسّسة التّعليميّة.
- مقاومة التّغيير
الخصائص: تُعدُّ مقاومة التّغيير أحد التحدّيات الرئيسة التي تواجه القيادة التّربويّة، ففي العديد من المدارس، يواجه القائد التّربويّ صعوبة في إدخال التّغييرات سواء كانت تتعلّق بالمنهج، طرق التّدريس، أم أساليب الإدارة.
- التّأثير على القيادة
- مقاومة المعلّمين والموظّفين: الكثير من المعلّمين قد يقاومون التّغييرات بسبب القلق من التّأثيرات المحتملة على أساليبهم التّعليميّة أو بسبب عدم رغبتهم في الخروج من منطقة الراحة. كما أنّ بعض الموظّفين قد يشعرون بعدم الرّاحة تجاه أساليب القيادة الجديدة أو السّياسات.
- مقاومة الطّلّاب: التّغييرات التي قد تطرأ على أساليب التّعلّم أو المناهج الدّراسيّة قد تواجه مقاومة من الطّلّاب الذين تعوّدوا على طُرُق تعلُّم معيَّنة.
- كيفيّة التّعامل مع التّحدّي
- إشراك المعنيّين: يجب على القائد التّربويّ إشراك المعلّمين، الطّلّاب، وأولياء الأمور في عمليّة التّغيير منذ البداية؛ فعندما يكون الجميع جزءًا من العمليّة، فإنّهم يصبحون أكثر استعدادًا للتّكيُّف مع التّغييرات.
- التّواصل الفعّال: يجب على القائد أن يوضّح فوائد التّغيير، وأسباب تنفيذه، مع التّركيز على كيفيّة تحسين العمليّة التّعليميّة وجودة الأداء. هذا الأمر يساعد على تقليل مقاومة التّغيير.
- نقص الموارد
- الخصائص
من أكبر التّحدّيات التي تواجه القيادة التّربويّة هو نقص الموارد الماليّة والبشريّة. ففي الكثير من الحالات، تواجه المدارس صعوبة في الحصول على التّمويل الكافي لتوفير البنية التّحتيّة الحديثة أو لتوظيف الكوادر الأكاديميّة المدرّبة.
- التّأثير على القيادة
- التّأثير على جودة التعليم: نقص الموارد قد يؤدّي إلى تقليل جودة التّعليم والتّدريب. على سبيل المثال، نقص الموارد الدّراسيّة مثل الكتب والمعدّات التّكنولوجيّة قد يعيقُ قدرة المعلّمين على تقديم المحتوى بشكل فعّال.
- الضّغط على المعلّمين: في حالة نقص الموظّفين، قد يتعيّن على المعلّمين تحمّل عبء العمل الإضافيّ لكلّ طالب، فيؤثّر على قدرتهم على تخصيص وقت كافٍ لكلّ طالب.
- كيفيّة التّعامل مع التّحدّي
- البحث عن مصادر تمويل بديلة: يمكن للقيادة التّربويّة البحث عن شراكات مع مؤسّسات المجتمع المحلّيّ أو المنظّمات غير الحكوميّة للحصول على دعم ماديّ، كما يمكن تنفيذ برامج جمع تبرّعات أو تطوير مشاريع تعليميّة تعاونيّة.
- إعادة تخصيص الموارد: تحسين استخدام الموارد المتاحة، مثل تعزيز دور التّكنولوجيا في التّعليم لتقليل الاعتماد على الأدوات التّقليديّة، يمكن أنْ يكون حلًّا مجديًا في حال نقص الموارد.
- الثّقافة المؤسّسيّة
- الخصائص
الّثقافة المؤسّسيّة تشكّل جزءًا كبيرًا من بيئة العمل في أيّ مؤسّسة تعليميّة؛ فالقيادة التّربويّة قد تواجه تحدّيات كبيرة في محاولة تغيير أو تعديل ثقافة المدرسة، خصوصًا إذا كانتْ الثّقافة سلبيّة أو لا تدعم التّطوير المستمرّ.
- التّأثير على القيادة
- التّأثير على الانتماء: ثقافة العمل السّلبيّة قد تؤدّي إلى انخفاض الحوافز والانتماء لدى المعلّمين والطّلّاب، ممّا ينعكس سلبًا على الأداء الأكاديمي.
- التّطوير المهنيّ: قد تكون مقاومة للابتكار والتّطوير المهنيّ، ممّا يعوق القدرة على تنفيذ أفكار جديدة.
- كيفيّة التّعامل مع التّحدّي
- التّوجيه وبناء الثّقة: القائد التّربويّ يجب أن يعمل على تحسين ثقافة المؤسّسة من خلال بناء الثّقة بين المعلّمين والطّلّاب وأولياء الأمور، ويجب أيضًا تعزيز التّفاعل الإيجابيّ بين جميع أفراد المجتمع المدرسيّ.
- تشجيع المبادرات الإيجابيّة: تشجيع المعلّمين والطّلّاب على تبنّي ثقافة التّعليم المستمرّ والابتكار يمكن أن يساعد في تغيير الثّقافة المؤسّسيّة نحو الأفضل.
- تعدّد أصحاب المصلحة
- الخصائص: في المؤسّسات التّعليميّة، هناك العديد من أصحاب المصالح مثل المعلّمين والطّلّاب وأولياء الأمور والجهات الحكوميّة. وتعدّد هذه الأطراف يخلق تحدّيات في التّنسيق والتّفاهم بين الجميع.
- التّأثير على القيادة
- تباين الأهداف والتّوقّعات: قد يكون لكلّ طرف من أصحاب المصلحة أهداف وتوقّعات مختلفة، ممّا قد يؤدّي إلى صعوبة في اتّخاذ قرارات جماعيّة.
- التّوتّرات بين الأطراف: قد يحدث تعارض بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة حول المناهج أو أساليب التّدريس، فتتعقّد عمليّة اتّخاذ القرار.
- كيفيّة التّعامل مع التّحدّي
- التّواصل المستمرّ: يجب على القيادة التّربويّة ضمان التّواصل المستمرّ والمفتوح مع جميع أصحاب المصلحة أثناء جلسات الاستماع والاجتماعات المنتظمة، واستخدام وسائل الاتّصال المختلفة يمكن أن يساعد في تعزيز التّعاون.
- التّفاوض والتّفاهم: يجب أن يكون القائد التّربويّ على دراية بمختلف احتياجات وتوقّعات أصحاب المصلحة وتطوير آليّة للتّفاوض والتّوصّل إلى حلول مشتركة.
في المحصّلة، تواجه القيادة التّربويّة العديد من التّحدّيات التي تتراوح بين التّحدّيات الإداريّة والتّنظيميّة ومقاومة التّغيير ونقص الموارد. إضافة إلى ذلك، تتطلّب الثّقافة المؤسّسيّة وتعدّد أصحاب المصلحة تفاعلًا مستمرًّا من القيادة لضمان تحقيق بيئة تعليميّة فعَّالة. بالتالي، فإنّ القائد التّربويّ النّاجح يحتاج إلى مهارات قويّة في الإدارة والتّواصل، وحلّ المشكلات للتّغلّب على هذه التّحدّيات وتحقيق النّجاح المؤسّسيّ.
- دراسات حالة أو نماذج ناجحة
- مدرسة صيدا المتوسّطة الرّسميّة
تُعدّ مدرسة صيدا المتوسّطة الرّسميّة نموذجًا بارزًا للقيادة الفعَّالة في القطاع العام، تحت إشراف المديرة السّابقة: “السّيّدة عبد الملك” التي تولّت الإدارة في مرحلة كانت المدرسة بحاجة ماسّة إلى التّجديد والتّطوير، فعملتْ على تحسين البنية التّحتيّة للمدرسة من خلال ترميم المبنى وتجهيز قاعات المعلوماتيّة وتحديث الصّفوف، كما ركّزت على بناء شخصيّة الطّلّاب من خلال تعزيز القيم الوطنيّة والأخلاقيّة، مما أسهم في زيادة ثقة الأهالي في المدرسة وتسجيل المزيد من الطّلّاب. وأثمر هذا النّموذج القياديّ عن نجاح المدرسة في امتحانات الشّهادة المتوسّطة بنسبة 100% مع تفوّق العديد من الطّلّاب([5]).
- موقع وبيانات متوسّطة صيدا الرّسميّة
تُعدُّ مدرسة صيدا المتوسّطة الرّسميّة من أبرز المؤسّسات التّعليميّة في مدينة صيدا، لبنان، وهي مثال حيّ على القيادة التّربويّة الفعَّالة التي تسهم في تطوير التّعليم العامّ.
- الاسم: مدرسة صيدا المتوسّطة الرّسميّة.
- العنوان: حارة صيدا، شارع طريق جباع، صيدا.
- الدّوام: قبل الظّهر.
- اللّغة الأجنبيّة الأولى: الإنكليزيّة.
- عدد الشُعب: 24 شعبة، تشمل الرّوضة والحلقة الأولى والثّانية والحلقة الثّالثة.
- عدد التّلامذة: 644.
- القيادة الفعَّالة والتّطوير المستدام
تحت إشراف المديرة ميرفت السّنّ، عملتْ المدرسة على تعزيز بيئة تعليميّة محفّزة من خلال:
- تطوير البنية التّحتيّة: إجراء صيانة شاملة للمرافق المدرسيّة وتوفير قاعات مجهّزة بأحدث التّقنيّات.
- تنظيم الأنشطة التّربويّة: إقامة فعاليّات ثقافيّة ورياضيّة تسهم في تنمية مهارات الطّلّاب.
- تكريم الكوادر التّعليميّة: في كانون الثّاني 2024، كرَّمت المدرسة ثلاث معلّمات بلغنَ سنّ التّقاعد بعد مسيرة تعليميّة تجاوزت 35 عامًا، فانعكس تقديرها للجهود المبذولة في خدمة التّعليم([6]).
- التّميّز الأكاديمي
أسهمت القيادة الفعَّالة في تحقيق نتائج متميّزة على الصّعيد الأكاديميّ، حيث أظهرت المدرسة تقدّمًا ملحوظًا في امتحانات الشّهادة المتوسّطة، ممّا يعكس جودة التّعليم والاهتمام بتطوير المناهج والأنشطة الصّفيّة.
- مدرسة راشيل إدة الرسمية-زغرتا
تُعدُّ مدرسة “راشيل إدّه الرّسميّة” في بلدة سبعل قضاء زغرتا، مثالًا آخر على القيادة الفعَّالة في التّعليم العامّ، حيث عملت الإدارة على تحسين البنية التّحتيّة للمدرسة من خلال ترميم المبنى وتجهيز قاعات المعلوماتيّة وتحديث الصّفوف؛ كما ركَّزت على بناء شخصيّة الطّلّاب من خلال تعزيز القيم الوطنيّة والأخلاقيّة، فأسهم ذلك في زيادة ثقة الأهالي بالمدرسة، وأثمر هذا النّموذج القياديّ عن نجاح المدرسة في امتحانات الشّهادة المتوسّطة بنسبة 100%، وتسجيل المزيد من الطّلّاب مع تفوّق العديد منهم، وأصبحت هذه المدرسة نموذجًا مميّزًا للمدارس الرّسميّة اللّبنانيّة، حيث حقّقت تقدُّمًا ملحوظًا بفضل جهود مديرة المدرسة السّابقة، السيدة “وداد سمعان الدويهي”([7]).
- أبرز إنجازات المدرسة
- تحقيق علامة CELF الفرنسيّة: في عام 2021، حصلت المدرسة على علامة (CELF) من السفيرة الفرنسيّة “آن غريو”؛ لتكون بذلك أوّل مدرسة رسميّة لبنانيّة تنال هذه الجائزة التي تُمنح للمؤسّسات الفرنكوفونيّة التي تعتمد الثّنائيّة اللّغويّة([8]).
- نسبة نجاح 100% في الشّهادة المتوسّطة: في عام 2022، نجح جميع طلّاب الصّفّ التّاسع الأساسيّ في امتحانات الشّهادة المتوسّطة، مع حصول أكثر من نصفهم على درجات “جيد جدًا”([9]).
- أنشطة تربويّة وثقافيّة متميّزة: أُقيمت فعاليّات مثل “السّيرك التّربويّ الثّقافيّ الرّياضيّ” بالتّعاون مع جمعية “Arc en Ciel”، إضافة إلى ورش عمل ثقافيّة للأطفال والكبار، ممّا يعكس التزام المدرسة بتوفير بيئة تعليميّة شاملة.
- تطوير بنية مدرسيّة نموذجيّة: افتتحت المدرسة في عام 2015 بدعم من السّفارة الإيطاليّة؛ لتكون الوحيدة في جرد زغرتا، وتسهم في توفير التّعليم الرّسميّ لأنباء المنطقة([10]).
تُعدّ مدرسة راشيل إدّه الرّسميّة مثالًا يُحتذى به في تطوير التّعليم الرّسميّ في لبنان، بفضل القيادة التّربويّة الفعَّالة والبيئة التّعليميّة المبتكرة.
ثالثًا: عرض النّتائج وتحليلها
اعتمادًا على تحليل الأدبيّات والنّماذج الواقعيّة لدور القيادة التّربويّة في تطوير المؤسّسات التّعليميّة، توصّل البحث إلى مجموعة من النّتائج المهمّة:
- فاعليّة القيادة التّربويّة ترتبط بأنماط القيادة الممارَسة: يتبيَّن من النماذج المدروسة (مثل مدرستَي صيدا المتوسّطة وراشيل إدّه الرّسميّة)، أنَّ نمط القيادة التّحويليّة والتّشاركيّة يُحقّق نتائج تعليميّة عالية، من خلال إشراك العاملين، وتحفيز المعلّمين، وتوفير بيئة تعليميّة إيجابيّة. بالمقابل، أظهرت الأدبيّات أنَّ النمط الأوتوقراطيّ يؤدّي غالبًا إلى انخفاض في دافعيّة الفريق التّعليميّ، ويقلّل من فرص الإبداع.
- القيادة التّربويّة تؤثّر بشكل مباشر في بناء البيئة التّعليميّة الإيجابيّة: تُظهر النّماذج القياديّة النّاجحة أنَّ بناء الثّقة والانفتاح والتّعاون، تشكّل عوامل محوريّة في خلق مناخ مدرسيّ محفّز ومنتج. فالمدير الذي يعزز العلاقة التّشاركيّة يُسهم في تحسين العلاقات المهنيّة والانتماء الوظيفيّ لدى المعلّمين.
- تأثير القيادة على الكفاية الإنتاجيّة التّعليميّة يتوسَّط بين التّنظيم والتّحفّيز: تشير التّحليلات إلى أنَّ القيادة النّاجحة لا تكتفي بإدارة الموارد بل تُحوّلها إلى طاقة فعّالة عبر التّحفيز، وتوزيع المسؤوليّات، وبناء القُدُرات، فتُسهم في تحسين النّتائج التّعليميّة كما في حالة نسبة النّجاح المرتفعة في المدرستين النّموذجيتين.
- النّجاح القياديّ يتطلّب مواجهة تحدّيات تنظيميّة وثقافيّة معقّدة: أظهرت الدّراسة أنَّ من أبرز التّحدّيات التي تعيق القيادة التّربويّة: مقاومة التّغيير ونقص الموارد والثّقافة المؤسّسيّة السّلبيّة وتعدّد أصحاب المصلحة؛ لكنّ القيادة الواعية، كما في النّموذجين السّابقين، واجهت هذه التّحدّيات من خلال: التّخطيط الاستراتيجيّ وتنمية العلاقات وتعزيز المشاركة المجتمعيّة.
- مقوّمات القائد التّربويّ الفعّال تتجاوز المؤهّلات الأكاديميّة: تؤكّد نتائج التّحليل أنَّ الذّكاء العاطفيّ والرّؤية المستقبليّة والمرونة في التّعامل، هي من العوامل الحاسمة التي تميّز القائد النّاجح؛ فالقائد الذي يمتلك هذه المهارات، إضافة إلى القدرة على اتّخاذ القرار السّريع، يكون أكثر قدرة على الاستجابة للأزمات والتّطوّرات.
- النّموذج اللّبنانيّ يُقدّم فرصًا قابلة للتّطوير والتّعميم: من خلال استعراض التّجارب المحلّيّة، يتضّح أنّ المدارس الرّسميّة اللّبنانيّة قادرة على تقديم نماذج تعليميّة ناجحة على الرّغم من محدوديّة الموارد، شرط توافر قيادة تربويّة ذات كفاءة، ويمكن اعتماد هذه التّجارب كنموذج للتّطوير المستدام في مؤسّسات أخرى.
رابعًا: تفسير النّتائج وعلاقتها بالدّراسات السّابقة
- فاعليّة القيادة التّربويّة ترتبط بأنماط القيادة الممارَسة
التّحليل
يعكس هذا الاستنتاج ما أكَّدته نظريّة القيادة التّحويليّة (Bass& Avolio, 1994)،([11]) حيث تبيّن أنَّ القادة الذي يلهمون المعلّمين، ويشاركونهم في اتّخاذ القرار يعزّزون الأداء التّعليميّ.
الرّبط بالدّراسات السّابقة
- تشير دراسة (Leithwood et al. (2006))([12]) إلى أنَّ القيادة التّحويليّة ترتبط بتحسين تحصيل الطّلّاب ورفع معنويّات المعلّمين.
- على العكس، أثبتت أبحاث (Owens & Valesky (2011))([13]) أنَّ النّمط الأوتوقراطيّ يخلق بيئة غير محفّزة تقلّل من الابتكار والدّافعيّة.
- القيادة التّربويّة تؤثّر مباشرة في بناء بيئة تعليميّة إيجابيّة
التّحليل
إنَّ البيئة الإيجابيّة التي تبنيها القيادة ترتكز على الثّقة والانفتاح، وهو ما يؤسّس لعلاقات مهنيّة مستقرّة ويشجّع على الانتماء المهنيّ.
الرّبط بالدّراسات السّابقة:
- يتّفق هذا مع نموذج (Fullan (2001))([14]) الذي يُبرز أهمّيّة “الثّقافة المدرسيّة” الإيجابيّة كعامل حاسم في النّجاح المدرسيّ.
- كما تدعم دراسة (Tschannen-Moran (2004))([15]) أهمّيّة الثّقة في تعزيز فعاليّة المعلّمين وتعاونهم.
- القيادة تؤثّر على الكفايّة الإنتاجيّة عبر التّنظيم والتّحفيز
التّحليل
تشير النّتيجة إلى أنَّ القيادة الفعَّالة لا تقتصر على التّخطيط والتّنظيم بل تسعى لبناء طاقة إنتاجيّة بشريّة قائمة على التّحفيز وتوزيع الأدوار.
الرّبط بالدّراسات السّابقة
- تؤكّد نظريّة (McGregor’s Theory Y)([16]) أنَّ الموظفينّ (المعلّمين هنا) إذا تحفّزوا وتشاركوا، يصبحون أكثر إنتاجيّة.
- دراسة (Bush & Glover (2003))([17]) تشير إلى أنّ القيادة التّربويّة القادرة على بناء القدرات ترفع الكفاءة المؤسّسيّة.
- النّجاح القياديّ يتطلّب مواجهة تحدّيات تنظيميّة وثقافيّة معقّدة
التّحليل
القيادة الواعية تستطيع التّعامل مع التّحدّيات عبر التّخطيط وتنمية العلاقات، فتتطلّب فهمًا عميقًا للسّياق المحلّيّ ومهارات عالية في إدارة التّغيير.
الرّبط بالدّراسات السّابقة:
- يتوافق ذلك مع نموذج (Kotter (1996))([18]) في إدارة التّغيير، حيث يعدّ بناء التّحالفات وتوضيح الرّؤية من مفاتيح تجاوز المقاومة.
- دراسات في السّياق العربيّ، مثل دراسة (عبد الجواد2020)([19])، تؤكّد أنّ مقاومة التّغيير ونقص الإمكانيّات أبرز التّحدّيات أمام القادة التّربويّين.
- مقوّمات القائد التّربويّ الفعَّال تتجاوز المؤهّلات الأكاديميّة
التّحليل
التّركيز على الذّكاء العاطفيّ والمرونة يشير إلى الاتّجاه الحديث في القيادة الذي يرى أنَّ السّمات الشّخصيّة والاجتماعيّة لا تقلّ أهمّيّة عن المعرفة الأكاديميّة.
الرّبط بالدّراسات السّابقة
- وفقًا لـ (Goleman (1998))([20])، الذّكاء العاطفيّ عنصر أساسيّ في القيادة النّاجحة، خاصّة في البيئات التّربويّة.
- كذلك، أشارت دراسة (Day et al. (2011))([21]) إلى أنَّ القيادة المؤثّرة تقوم على المهارات الشّخصيّة بقدر ما تقوم على المؤهّلات الأكاديميّة.
- النّموذج اللّبناني يُقدّم فرصًا قابلة للتّطوير والتّعميم
التّحليل
على الرّغم من الظّروف الصّعبة، فإنَّ بعض المدارس الرّسميّة اللّبنانيّة أظهرت نماذج قياديّة ناجحة، مما يفتح الباب لتعميم التّجربة.
الرّبط بالدّراسات السّابقة
- دراسة (UNESCO (2017))([22]) حول القيادة التّربويّة في البلدان النّامية تؤكّد أنّ القيادة الفعّالة يمكن أنْ تُحدث فرقًا كبيرًا حتّى في بيئات تعاني من نقص الموارد.
- هنا يتماشى مع نموذج “التّحسين في السّياقات منخفضة الموارد” الذي طوَّره Barber et al.) (2010))([23]).
في المحصّلة إنَّ النّتائج تتّسق بشكل كبير مع الأُطُر النّظريّة المعروفة في القيادة التّربويّة، وتؤكّد على أهمّيّة التّحوُّل من الإدارة التّقليديّة إلى القيادة التّشارُكيّة والمرنة، خصوصًا في السّياقات الصّعبة. وتُسهم الدّراسة الحاليّة في إثراء الأدبيّات المحلّيّة وتقدّم تطبيقات واقعيّة من السّياق اللّبنانيّ يمكن الاستفادة منها عربيًّا ودوليًّا.
خامسًا: التّوصيات
استنادًا إلى نتائج البحث، يمكن اقتراح التّوصيات التّالية لتعزيز فاعليّة القيادة التّربويّة وتحقيق بيئة تعليميّة إيجابيّة تسهم في رفع الكفاية الإنتاجيّة التّعليميّة.
أوّلًا: على مستوى القادة التّربويّين
- التّطوير المهنيّ المستمرّ: ينبغي تنظيم ورش عمل ودورات تدريبيّة دوريّة للقادة التّربويّين؛ لتأهيلهم على أساليب القيادة الحديثة، مثل القيادة التّحويليّة والموزّعة والمهارات اللّازمة للتّعامل مع التحدّيات المعاصرة.
- تنمية الذّكاء العاطفيّ والمهارات التّواصليّة: تشجيع القادة التّربويّين على تنمية قدراتهم في التّواصل وإدارة الأزمات، وحلّ النّزاعات لبناء علاقات إيجابيّة ومستقرّة مع العاملين والطلّاب.
- تعزيز ثقافة القيادة التّشاركيّة: اعتماد نمط القيادة التّشاركيّة بشكل أوسع، إذ له أثر إيجابيّ في رفع معنويّات المعلّمين وتحفيزهم على الإبداع وتحمُّل المسؤوليّة.
- تحفيز الابتكار والمرونة القياديّة: توجيه القادة لتبنّي حلول إبداعيّة للتّعامل مع مشكلات مثل نقص الموارد أو مقاومة التّغيير، مع التّركيز على الاستفادة من التّقنيات الحديثة.
ثانيًا: توصيات للمؤسّسات التّعليميّة
- إنشاء بيئة تعليميّة محفزة: تهيئة مناخ مدرسيّ قائم على الثّقة والدعم والانفتاح، بما يعزّز من ولاء العاملين وانتمائهم للمؤسّسة التّعليميّة.
- توفير الدّعم الإداريّ والتّقنيّ: ضمان توافر بنية تحتيّة مناسبة، وتكنولوجيا تعليميّة حديثة، ودعم إداريّ يُمكّن القادة من تنفيذ رؤاهم بفعاليّة.
- اعتماد نظام تقييم للقيادة التّربويّة: تطوير أدوات تقييم دورية ومتكاملة تقيس أثر القيادة على الأداء الأكاديميّ، والتّحفيز المهنيّ، ونمو البيئة التّعليميّة.
ثالثًا: توصيات لصانعي السّياسات التّعليميّة
- صياغة سياسات داعمة للقيادة: وضع أطُر قانونيّة وتنظيميّة تعزّز استقلاليّة القادة التّربويّين وتدعمهم في تنفيذ خطط التّطوير التّربويّ.
- دعم الشّراكة المجتمعيّة: تشجيع القادة والمؤسّسات على بناء علاقات مع المجتمع المحليّ لتوفير موارد إضافيّة ودعم بيئة التّعلّم.
- تشجيع النّماذج القياديّة النّاجحة: إبراز تجارب قياديّة متميّزة كنماذج يُحتذى بها، مثل مدارس صيدا وراشيل إده الرّسميّة، وإدراجها في برامج إعداد القادة الجُدُد.
رابعًا: توصيات بحثيّة
- إجراء دراسات مقارنة بين أنماط القيادة المختلفة وأثرها على الكفاية الإنتاجيّة في السّياقات العربيّة والدّوليّة.
- التّوسّع في دراسات الحالة لتوثيق التّجارب النّاجحة للقيادة التّربويّة في مختلف البيئات، وتحديد عناصر التّميّز فيها.
- التّركيز على القيادة في الأزمات: دراسة فاعليّة القادة التّربويّين في إدارة الأزمات مثل الأوبئة أو النّزاعات، واستخلاص دروس تطبيقيّة منها.
سادسًا: الخاتمة
في ضوء ما تمَّ عرضه وتحليله في هذه الورقة البحثيّة، يتّضح أنّ القيادة التّربويّة تُعدُّ عاملًا محوريًّا في نجاح المؤسّسات التّعليميّة، ليس فقط من خلال دورها الإداري والتّنظيميّ، بل بوصفها قوّة دافعة نحو التّغيير وبناء ثقافة مدرسيّة إيجابيّة تُعزّز الكفاية الإنتاجيّة.
بيَّن البحث أنّ القيادة الفعّالة، سواء كانت تحويليّة، تشاركيّة أم موقفيّة، فهي قادرة على تجاوز التّحدّيات البنيويّة والثّقافيّة والتّنظيميّة التي تعيق تحقيق بيئة تعليميّة محفّزة وفعّالة.
من خلال دراسة النّماذج الميدانيّة لمدارس لبنانيّة رسميّة مثل “صيدا المتوسّطة الرّسميّة” و”راشيل إدّه الرّسميّة”، يتضّح أنَّ القيادة الواعية والمرنة التي تتبنّى رؤية مستقبليّة وتوظّف الإمكانيّات المُتاحة بحكمة، قادرة على إحداث تحوّلات ملموسة في الأداء التّعليميّ وتحقيق تميّز على المستويين الأكاديميّ والإداريّ، كما أنّ مواجهة التّحدّيات تتطلَّب من القائد التّربويّ مهارات قياديّة متجدّدة، وشراكات فاعلة، وقدرة على التّكيّف مع متطلّبات العصر.
بناءً عليه، يمكن القول: إنَّ الاستثمار في تطوير القيادات التّربويّة من خلال التّدريب المستمرّ، وتمكينهم من اتّخاذ القرار، ودعمهم بموارد كافية، هو مدخل أساس لإصلاح المنظومة التّعليميّة وتحقيق أهداف التّنمية التّربويّة المستدامة؛ وعليه، فإنّ مستقبل التّعليم العربيّ يرتكز بشكل جوهريّ على نوع القيادة التي تُمارس داخل مؤسّساته، ومدى قدرتها على تحويل الرّؤية التّربويّة إلى واقع فعَّال ملموس.
- قائمة المراجع
- رائد الأعمال العربي. (2025، 9 أبريل). القيادة التّربويّة: ما هي؟ ولماذا مهمة؟ وما هي أنواعها؟ استرجع في 23 أبريل 2025، من https://ar-entrepreneur.com/مهارات-قيادية-القيادة-التربوية
- كاتب غير محدد. (2018، 25 فبراير). مهارات القيادة التّربويّة في اتخاذ القرارات الإدارية ص. 24 [PDF]. استرجع في 23 أبريل 2025، من https://www.noor-book.com/ كتاب-مهارات-القيادة-التربوية
- عزازي، سلوى محمد أمد. (2011، 30 سبتمبر). مفاهيم القيادة التّربويّة الحديثة. استرجع في 27 أبريل 2025، من https://almualem.net/saboora/showthread.php?t=28835
- طعيمة، رشدي أحمد. (2006، 22 يناير). الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز والاعتماد: الأسس والتطبيقات (ص. 254). عمان، الأردن: دار المسيرة.
- زعيتر، هيثم. (2018، 22 أكتوبر). النائب الحريري خلال تكريم مديرة مدرسة صيدا المتوسطة: لبنان صمد بفضل شبابه الذين اختاروا العلم والنجاح. استرجع في 28 أبريل 2025، من https://www.janobiyat.com/news34793/
- أسرة التحرير. (2024، 4 يناير). متوسطة صيدا المختلطة كرمت ثلاث معلمات بلغن سن التقاعد. استرجع في 29 أبريل 2025، من https://www.nna-leb.gov.lb/ar/education/667296/
- أسرة التحرير. (2025، 1 أكتوبر). سيرك تربوي في مدرسة راشيل إده الرسمية في سبعل. استرجع في 29 أبريل 2025، من https://www.imlebanon.org/2015/10/01/circus-educational-school-rachel-eddde-sebhel/?utm
- أسرة التحرير. (2021، 4 مارس). مدرسة راشيل إده الرسمية إلى العالمية. استرجع في 29 أبريل 2025، من https://elmarada.org/مدرسة-راشيل-اده-الرسمية-الى-العالمية
- أسرة التحرير. (2022، 15 يوليو). مدرسة رسمية تحتفل بنجاح وتفوق كل طلابها.. من هي؟ استرجع في 29 أبريل 2025، من https://www.lebanon24.com/news/lebanon/971576/
- أسرة التحرير. (2015، 25 أغسطس). افتتاح مدرسة راشيل إده في سبعل الوحيدة في جرد زغرتا لاستيعاب التلامذة. استرجع في 29 أبريل 2025، من https://lkdg.org/ode/13788?utm_source
- عبد الجواد، سماح عبد الفتاح. (ب.ت.). تقييم إستراتيجيات إدارة الجدارة لتوظيف قدرات الشباب وعلاقته بالرضا عن الحياة. المجلة العلمية المحكمة لدراسات وبحوث التربية النوعية، 6(1)، 742.
- Barber, M., Whelan, F., & Clark, M. (2010). Capturing the leadership premium: How the world’s best-performing school systems come out on top. McKinsey & Company.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1993). Improving organizational effectiveness through transformational leadership. SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/improving-organizational-effectiveness-through-transformational-leadership/book4228
- Bush, T., & Glover, D. (2003). School leadership: Concepts and evidence. National College for School Leadership.
- Day, C., Sammons, P., Leithwood, K., Hopkins, D., Gu, Q., Brown, E. J., & Ahtaridou, E. (2011). Successful school leadership: Linking with learning and achievement. McGraw-Hill Education.
- Fullan, M. (2001). The new meaning of educational change (3rd ed.). Teachers College Press.
- Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. Bantam Books.
- Kotter, J. P. (1996). Leading change. Harvard Business School Press.
- Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A., & Hopkins, D. (2006). Successful school leadership: What it is and how it influences pupil learning. Department for Education and Skills.
- McGregor, D. (1960). The human side of enterprise. McGraw-Hill.
- Owens, R. G., & Valesky, T. C. (2011). Organizational behavior in education: Leadership and school reform (10th ed.). Pearson.
- Tschannen-Moran, M. (2004). Trust matters: Leadership for successful schools. Jossey-Bass.
- UNESCO. (2017). Leading better learning: School leadership and quality in the education, 2030 agenda: Regional reviews of policies and practices. Paris: UNESCO.
[1] – رائد الأعمال العربي. (2025، أبريل 9). القيادة التّربويّة: ما هي؟ ولماذا مهمة؟ وما هي أنواعها؟ رائد الأعمال العربي https://ar-entrepreneur.com/مهارات-قيادية-القيادة-التربوية
[2]– كاتب غير محدد. (2018، فبراير 25) مهارات القيادة التّربويّة في اتخاذ القرارات الإدارية (ص. 24) (ملف PDF). Book.https://www.noor-book. Noor / كتاب-مهارات-القيادة-التربوية
[3]-عزازي.س.م.أ.(2011، سبتمبر 30).مفاهيم القيادة التّربويّة الحديثة. المعلم نت. https://almualem.net/saboora/showthread.php?t=28835
[4] – طعيمة. ر.أ. (2006) الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز والاعتماد: الأسس والتطبيقات (ص. 254). دار المسيرة
[5] – زعيتر، ه. (2018، اكتوبر 22) النائب الحريري خلال تكريم مديرة مدرسة صيدا المتوسطة: لبنان صمد بفضل شبابه، الذين اختاروا العلم والنجاح. جنوبية. استرجع، في 28 أبريل، 2025، من https://www.anoubiyat.com/news 34793j /
[6] – أسرة التحرير، (2024، يناير 4) متوسطة صيدا المختلطة كرمت ثلاث معلمات بلغن سن التقاعد، الوكالة الوطنية للإعلام، استرجع في 29 أبريل، 2025، من https:www.nna-leb.gov.lb/ar/education/667296
[7]– إدَه، ر.، مدرسة سيرك التّعليميّة في إده: تجربة فريدة في التعليم الترفيهي.، (2015، أكتوبر، 1) أhttps://www.imlebanon.org/2015/10/01/circus-educational-school-rachel-eddde-sebhel
[8]– أسرة التحرير، (2021، مارس 4). مدرسة راشيل إده الرسمية إلى العالمية. موقع المردة. استرجع في 29 أبريل، 2025، من /https://elmarada.org مدرسة- راشيل- اده- الرسمية- إلى- العالمية
[9] – أسرة التحرير، (2022، يوليو 15) مدرسة رسميّة تحتفل بنجاح وتفوّق كلّ طلّابها.. من هي؟ لبنان 24. استرجع في 29 أبريل، 2025، من https://www.lebanon24.com/news/lebanon/971576//
[10]– أسرة التحرير، (2015، اغسطس 25). إفتتاح مدرسة راشيل اده في سبعل الوحيدة في جرد زغرتا لاستيعاب التلامذة،قاعدة معلومات لبنان. استرجع في 29 أبريل 2025، من https://lkdg.org/ode/13788?utm_source
[11]-Bass, B.M,& Avolio, B. J. (1993, October). Improving orgsnizational effectiveness through Transformational Leadership. SAGE Publicayions. Consulté le 30 avril 2025,à partir de https://us.sagepub.com/en-us/nam/improving-organizational-effectiveness-through-transformational-leadership/book4228
[12] – Leithwood, K.,Day, C. Sammons, P., Harris, A., & Hopkins, D. (2006). Successful school leadership: What it is and how it influences pupil learning. Department for Education and Skills.
[13] – Owens, R. G., & Valesky, T. C. (2011). Organizational behavior in education: Leadership and school reform (10 th ed.). Pearson.
[14]– Fullan, M. (2001). The new meaning of educational change (3rd ed.) Teachers College Press.
[15]– Tschannen-Moran, M.(2004). Trust matters: Leadership for successful schools. Jossey-Bass.
[16]– McGregor, D. (1960). The human side of entreprise, McGraw-Hill
[17]– Bush, T., & Glover, D. (2003). School leadership: Concepts and evidence. National College for School Leadership.
[18]– Kotter, J. P. (1996). Leadig change. Harvard Business School Press.
[19]– سماح عبد الفتاح عبد الجواد، تقييم إستراتيجيات إدارة الجدارة لتوظيف قدرات الشباب وعلاقته بالرضا عن الحياة، المجلة العلمية المحكمة لدراسات وبحوث التربية النوعية، المجلد السادس- العدد الأول- مسلسل العدد (11). صفحة 742.
[20]– Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence, Bantam Books.
[21]– Day, C., Sammons, P., Leithwood, K., Hopkins, D., Gu, Q., Brown, E. J., & Ahtaridou, E. (2011). Successful school leaderships: Linking with learning and achievement. Mc Graw-Hill Education.
[22]– UNESCO. (2017) . Leading better learning: School leadership and and quality in the education, 2030 agenda: Regional reviews of policies and practices, Paris: UNESCO.
[23]– Barber, M., Whelan, F., & Clark, M. (2010). Capturing the leadership premium: How the world ‘s best- performing school systems come out on top. McKinsey & Company.