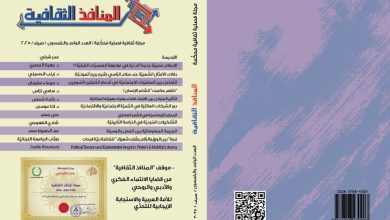المواطنيّة في لبنان بين المفهوم والمرجوّ
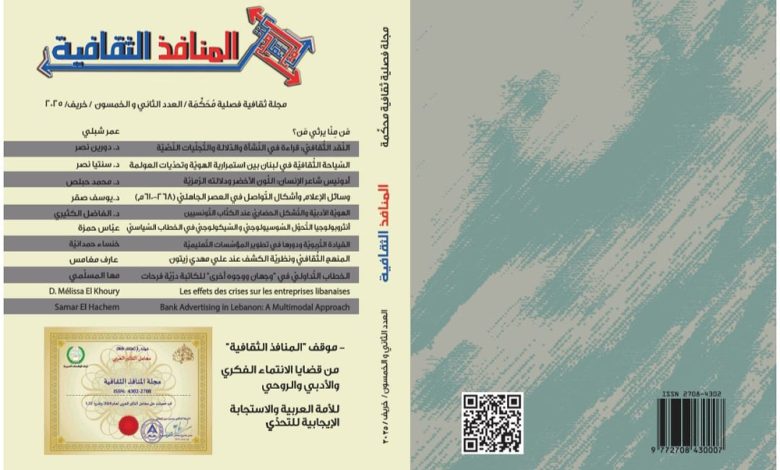
المواطنيّة في لبنان بين المفهوم والمرجوّ
La citoyenneté au Liban: entre concept et aspirations
د.جورج عيد حرب[1]
Dr. Georges Eid Harb
تاريخ الاستلام 15/ 6/ 2025 تاريخ القبول 19/ 7/2025
ملخص
يتناول البحث تطوّر مفهوم المواطنة منذ نشأته في أثينا وروما مرورًا بأوروبا الحديثة، وصولًا إلى الواقع اللّبنانيّ المعقّد. يربط بين مفهوم المواطنة وظهور الدّولة الحديثة، مبرزًا العوائق التّاريخيّة والسّياسيّة التي حالت دون ترسيخها في لبنان، كالإقطاع والطّائفيّة. يعرض البحث محطّات تطوّر النّظام اللّبنانيّ منذ الإمارة وصولًا إلى ما بعد اتفاق الدّوحة، متوقفًا عند مأزق العلاقة بين الدولة والمجتمع. يشدّد على أهمّية التّربية المدنيّة، وإعادة بناء هويّة وطنيّة جامعة، ويقترح مقوّمات الدّولة المرجوّة التي تحترم التّنوع وتعزّز الانتماء. يخلص إلى أنّ تحقيق المواطنة الحقيقيّة يستلزم ثورة ثقافيّة تبدأ من الإنسان.
الكلمات المفتاحيّة: المواطنيّة – لبنان – الدّولة – الانتماء- التّعدديّة- الهويّة – الثّقافة السّياسيّة- الأزمات -التّطبيق -الولاء -الدّولة المدنيّة -المشاركة- بناء الوطن
Résumée
Cette recherche retrace l’évolution du concept de citoyenneté depuis Athènes et Rome jusqu’à l’Europe moderne, et examine sa problématique au Liban. Elle souligne les obstacles historiques et politiques comme le féodalisme et le confessionnalisme. L’étude retrace les étapes du système politique libanais, de l’émirat jusqu’à l’après-Doha, révélant la crise entre l’État et la société. L’auteur insiste sur l’importance d’une éducation civique et d’une identité nationale inclusive. Il propose les piliers d’un État souhaité basé sur la diversité, la justice et la dignité humaine. La citoyenneté réelle ne peut émerger que par une révolution culturelle centrée sur l’humain.
Mots clés : Citoyenneté- Liban- État- Appartenance – Pluralisme- Identité- Culture politique- Crises- Application- Loyauté- État civil- Participation- Construction nationale
مقدّمة
إنّ المواطنيّة في لبنان بقيت فكرة عصيّة على التّحقّق منذ تأسيس هذا البلد، وغالبًا ما راودت المفكّرين اللّبنانيّين تساؤلات مشروعة عن سبب التخلّف المواطنيّ في بلد عرف التّقدّم، لا بل التّفوّق، في مجالات كثيرة علميّة وفنيّة وصناعيّة وغيرها. إلاّ أنّ المواطنيّة، لم يستطع اللّبنانيّون حتّى السّاعة الانخراط في ركبها، سواء محلّيًا أو إقليميًّا أو عالميًّا، وبقيت هذه التّساؤلات تعود إلى الواجهة عند كلّ أزمة عصفت بلبنان.
وعلى الرّغم من الكتب الكثيرة الّتي صيغت في هذا الإطار، إلّا أنّ ما كُتب بقي تائهًا داخل الصّفحات الكثيرة، على الرّفوف وداخل المكتبات الورقيّة أو الإلكترونيّة، دون أن يعرف طريقه إلى التّطبيق، وبالتّالي من دون أن يعرف لبنان اللّحاق بركب الدّول الّتي عرفت كيف تدمج تعدّد الثّقافات والإثنيّات والأديان والانتماءات تحت قبّة الوطن الموحَّد، لتصنع من هذا التّنوّع غنىً ومصدرًا للقوّة.
ويتبادر إلى الذّهن السّؤال عن الأسباب الّتي منعت اللّبنانيّين حتّى السّاعة من بناء وطن، وطالما تساءلتُ عن الأسباب التي أدّت دورًا سلبيًا في تعزيز الرّوح الوطنيّة على حساب النّفور الأعمى، كما تساءلت مرارًا عن البطء الّذي يلفّ حركة التّقدّم الوطنيّ في لبنان الذي ينعكس تأخيرًا في اللّحاق بركب الدّولة الحضاريّة المتقدّمة، الّتي عرفت كيف تتخطّى لتصل. وربّما هنا تكمن إشكاليّتنا الّتي سنحاول معالجتها في هذا البحث: كيف نتخطّى، دون عوائق، لنصل بلبنان وننجح حيث فشل من سبقنا.
- مفهوم المواطنيّة
لم يأخذ مفهوم المواطنيّة بعدًا واضحًا إلّا بعد أن استقرّت مجموعة من الأفراد ضمن مكان جغرافيّ معيّن سمّته موطنًا، وبعد أن تكرّست السّلطة على هذه الأرض تحت شكلٍ ما، وعلى الّذين عاشوا أو تعايشوا معها، أصبح هناك ما يُسمّى بالوطن. وقد عرفت تلك المجتمعات عدّة أشكالٍ من السّلطة، تمثلت بالسّلطة الإقتصاديّة والعسكريّة والطّبقيّة والدّينيّة والعرقيّة، والّتي مارست على النّاس أشكال متعدّدة من الحكم، فجعلتهم رعايا الملك أو السّلطان أو الأمير أو كبير القبيلة أو المجموعة. يتّفق مفهوم المواطنة مع العديد من المفاهيم التي تتمرّد على المفهمة بتعبير ألان تورين في وصفه لمصطلح الحداثة، فمن الصّعوبة تحديد مجمل الدّلالات والإيحاءات الّتي يشير إليها مصطلح المواطنة تحديدا دقيقًا، ومع ذلك يمكن الوقوف على بعض المعالم الدّالة عليه.
بدأت المواطنة بالبروز لأوّل مرّة في أثينا في القرن السّادس قبل الميلاد عندما أعلن كليستينيس، والّذي أسّس الدّولة السّياسية ل “أتيكا”، بأنّ حقوق المواطنين وواجباتهم تنبع من أتيكا كأرض ذات سيادة، ويكون هنا قد سدّد أول ضربة للانتماءات العائليّة والإقطاعيّة والطّبقيّة الّتي كانت سائدة آنذاك، فبدأ الأثينيون احترام القانون الّذي عبّر عن إرادتهم، وأحبّوا الدّولة الّتي جسّدت قوّتهم، فاصبح رجال أثينا في حالات الحرب، يدافعون عن الأرض التي يملكونها، ويستميتون في سبيل دولة تجسّد إرادتهم وترعاهم، وأكثر من ذلك، كي لا يتحوّلوا من أسياد إلى عبيد[2]. بعد أثينا، خطت روما خطوة مهمّة نحو المواطنيّة في القرن الأوّل قبل الميلاد، فقسّمت المواطنين إلى ثلاث درجات، المواطن الّذي ولد في روما في الدّرجة الأولى، والدّرجة الثّانية كانت تعطى لبعض سكان المدن الّذين كان لهم حقّ التّعاقد مع الرّومان وليس الزّواج منهم، كما أنّ هناك الدّرجة الثّالثة التي كانت تُعطى لكبار الموظفين لدى الرّومان والّذين أتمّوا فترة خدمتهم، مثل القضاة العدليّين والقادة العسكريّين.
الإمتياز الأهم الذي حصل عليه المواطن الرّوماني، هو حقّ الحماية لشخصه وممتلكاته، وعدم إمكانيّة تعرّضه للتّعذيب أو العنف عند محاكمته، فيكون الأب الرّومانيّ قد فقد كبرى امتيازاته السّلطويّة الّتي كانت له، ومنها حقّ قتل أبنائه في حالات عدم الرّضى عنهم، وانحسر ذلك بالسّلطة القضائيّة فقط وفي بعض الحالات القانونيّة العقابيّة الّتي تستوجب ذلك[3].
أما في أوروبا، حيث النّظام السّائد قد منح سلطة مطلقة للبابا والأمبراطور، لكنّ ازدهار التّجارة، وضع الملوك والأمراء في خانة التّحالف الضّروري لما للطّرفين من مصالح مشتركة بوجه البابا والأباطرة، وقد بلغت هذه الصّراعات أوجّها إبان الإصلاح الدّينيّ الأوروبيّ في القرن السّادس عشر، حيث انتهت إلى تغيّرات جوهرية، وأصبح لكلّ حكومة محليّة الحقّ بوضع قوانين لشعبها دون تدخّلات خارجيّة، فبدأت أولى الحقوق المشروعة للمواطن الأوروبيّ بالظّهور على حساب انحسار السّلطة البابويّة وبالتّالي الدّينيّة[4].
الحقيقة، أنّ سؤال المواطنة أصبح سؤالًا ملحًّا ومن الضّروري الإحاطة بحيثيّاته في ظلّ المتغيّرات الحاصلة على المستوى العالميّ، وهي تحوّلات شملت كلّ نواحي الحياة البشريّة، جاعلةّ من مطلع الألفيّة الثّالثة لحظة تاريخيّة على غاية من الأهميّة، لكونها تمثّل بالنّسبة لمجتمعاتنا لحظة مصيريّة، إذ بات من الصّعوبة ضمان مكانة بين أمم القرن الواحد والعشرين دون الاحتكاك والتّفاعل مع الآخرين والاستفادة منهم، فالتّفكير والتّساؤل عن الدّولة ووظيفتها وموقعها ككيان سياسيّ وقانونيّ وكجهاز سلطة وإدارة، وعلاقتها بالمواطنين، يمثّل اليوم جوهر التّفكير في العولمة وتشكّلاتها وتحدّياتها وأخطارها وفرصها أيضًا.
إنّ مفهوم المواطنة كما استقرّ في الفكر السّياسيّ المعاصر هو مفهوم تاريخيّ شامل ومعقّد له أبعاد عديدة ومتنوّعة، منها ما هو مادّيّ– قانونيّ، منها ما هو ثقافيّ– سلوكيّ، ومنها ما هو وسيلة أو هو غاية يمكن بلوغها تدريجيًا، لذلك فإنّ نوعيّة المواطنة في دولة ما تتأثّر بالنّضج السّياسيّ والرّقيّ الحضاريّ، كما يتأثّر مفهوم المواطنة عبر العصور بالتّطوّر السّياسيّ و الاجتماعيّ وبعقائد المجتمعات، وبقيم الحضارات والمتغيّرات العالميّة الكبرى، ومن هنا يصعب إيجاد تعريف جامع مانع ثابت لمبدأ المواطنة[5]. حتى أنّه يمكن القول بوجود عدد من المفاهيم والتّعريفات الممكنة لهذا المصطلح بقدر عدد المجتمعات إن لم يكن بقدر عدد الأفراد أو المواطنين.
رغم هذا التّعقيد الذي يطبع مفهوم المواطنة، فإنّه يشير بصورة مجملة إلى أنّها انتماء مؤمّن للكيان السّياسيّ، تتحقّق فيه معادلة الحقوق والواجبات، فيقول أحد الدّارسين:” المواطنة هي وصف سياسيّ لأفراد المجتمع المنضوين تحت دولة – وطن، تتبنّى الاختيار الدّيمقراطيّ، فهي وضعيّة تسمو على الجنسيّة و تجعل العلاقة مع الدّولة علاقة شراكة في الوطن وعلاقة تشاركيّة غير تبعيّة كما كان الشّأن في الأنظمة الاستبداديّة والإقطاعيّة التّي يعدّ فيها الأفراد رعايا لا مواطنين”[6]، بعبارة أخرى فـــ” المواطنة تدلّ ضمنا على مرتبة من الحرّيّة مع ما يصاحبها من مسؤوليّات[7]، من خلال هذين التّعريفين نستطيع القول إنّ مبدأ المواطنة في جوهره يعبّر عن وضعيّة الفرد في الدّولة من خلال تحديد قيمته ومكانته الّتي تقاس بمدى حصوله على حقوقه من جانب، ودوره الّذي يقاس بأدائه لواجباته من جانب آخر، فالمواطنة مبدأ نسبيّ تختلف درجة تحقّقه من مجتمع لآخر، كما أنّه مبدأ له تاريخ، وتاريخه يكشف عن سعي الإنسان للحصول على حقوقه و تكريس قيمه (حرّيّة، عدالة، مساواة،إنسانيّة). هذا السّعي الّذي انتقل فيه الإنسان من كونه مجرّد تابع لا اعتبار له ، خاضع بصورة كليّة لمختلف السّلطات، إلى اعتباره مواطنًا فاعلًا مشاركًا في تسيير شؤونه ولو بدرجات متفاوتة بين المجتمعات، وقد ارتبط الرّقيّ في الممارسة المواطنيّة بسياق تطوّر الفكر السّياسيّ الغربيّ منذ النّهضة، وتحديدًا مع ظهور الدّولة القوميّة الّتي تقوم على سيادة القانون، ومسايرةً للتّطور السّياسيّ الحاصل في الدّول الغربيّة، فقد أصبح بعض المفكرين ينظرون لمفهوم جديد للمواطنة أسماه هابرماس “مواطنة ما بعد الوطن”، وهي المواطنيّة الكونيّة العابرة للأوطان والّتي نجد مرجعيتها في مبادئ مجردة من تجلّياتها في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان[8].
ب- الدّولة ووظائفها
لمحة عن تاريخية الدّولة في لبنان
إنّ اللحظة التّاريخيّة الّتي نحياها اليوم تحتّم علينا أكثر من أيّ وقت مضى ضرورة طرح الإشكاليّات الحقيقيّة حول الدّولة، وعدم التّمويه أو القفز عليها، وإعادة النّظر في الكثير من المواقف، فالتّحولات الحاصلة على المستوى الكونيّ تقتضي توضيح دقيق لوظائف الدّولة وأدوارها وصلتها بمواطنيها في لبنان.
يوم كانت الدّولة حارسة، كان همّها الأساس أن تصهر الجميع في بوتقة تخدم الحاكم، أما عندما تحوّلت إلى خادمة فقد تركّز سعيها على تهيئة المناخ كي يتمكّن كلّ إنسان من أن يتحوّل إلى مواطن يتمتّع بحقوق وعليه واجبات؛ ممّا يسهّل وصوله إلى اكتمال إنسانيّته في مجتمع متوازن وعادل. إنّ البحث في الأسس الّتي تحقّق هذه النّقلة النّوعيّة لأيّ مجتمع، يتّخذ أهمّية تزداد بمقدار ازدياد الحاجة، خاصّة لمجتمع متحوّل، فما هي مقوّمات هذا التحوّل في مجتمع كالمجتمع اللّبنانيّ؟
سنحصر بحثنا، لإبراز محطّات هذا التّحول، في الأنظمة السّياسيّة – الاجتماعيّة الّتي حضنت شكلًا من أشكال التّعدّديّة، ضمن اصطفاف حول هدف أعلى، قاده أشخاص تمكّنوا من تأمين الإستمراريّة والإستجابة للتّحدّيات المختلفة.
لقد عرف تاريخ لبنان الحديث ستّة أنظمة حتّى الآن، وبانتظار السّابع، بعد جلاء المرحلة الحاليّة وذلك تبعًا لمرتكزها أو مرتكزاتها ، وهي :
- نظام الإمارة الّذي استند إلى الإقطاعية المرتبطة بالعائليّة وإن صحّ القول بالقبليّة وبالتّالي العائليّة.
- وقد استمر هذا النّظام حتى ورثه نظام القائمقاميتين الّذي أعطى الأولويّة للطّائفية مع حفاظه على الإقطاعيّة – العائليّة.
- وفي المرحلة الثّالثة استمرّ هذا الوضع برعاية دوليّة ، حتّى بداية الحرب العالميّة الأولى كي يوضع هذا الكيان في نهايتها تحت سيطرة الانتداب الفرنسيّ.
- النّظام في ظلّ الانتداب الفرنسيّ ونشأة دولة الإستقلال المرتكزة على الشّكل الجمهوريّ التّوافقيّ في العام 1943. تميّز هذا النّظام باحتفاظ فريق بامتيازات أوصلت إلى الأزمة الأولى عام 1958 انقضت بإعادة النّظر فيها والقيام بتأسيس دولة مرتكزة على القانون والمؤسّسات. لكنّ هذه المحاولة فقدت فعاليّتها بسبب التّجاذبات الدّاخليّة، ما أدّى إلى انحلال الدّولة، خاصة بعد حصول الفلسطينيّين على اتّفاقيّة القاهرة العام 1969.
- هذا التّحوّل خلق الظّروف المناسبة للانقسام الاجتماعيّ الّذي أدى إلى اندلاع حرب 1975 الّتي أعيد النّظر بموجبها في الميثاق الوطنيّ وإقرار الميثاق الجديد تطبيقًا لاتّفاق الطّائف.
- ثم بدأت مرحلة اهتمّت بتنفيذ إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد، وعملت جاهدة على تأجيل تنفيذ بنود الميثاق الجديد، بمساعدة لفيف من المنتفعين اللّبنانيّين الّذين ألهتهم عمليّة اقتسام المغانم دون أيّ حساب لما خلّفته هذه الوضعيّة على تجميد الانتقال إلى مرحلة المواطنيّة والإصطفاف خلف الإنتماء الطّوائفيّ[9].
- مرحلة ما بعد اتّفاق الدّوحة الّذي أقرّه الزّعماء اللّبنانيّون ، والّذي نصّ على بعض الأعراف الجديدة في النّظام ، ولم تكن ذات أهمّيّة، ممّا أعاد الوهج الأساسيّ لاتّفاق الطّائف.
ما وَجب اتّباعه الآن تمهيدًا لمواطنيّة لا تزال مفقودة، يتمحور حول الآتي:
1- وعي المشكلة بكلّ أبعادها ، خاصّة أنّ المجتمع الّذي نسعى لتحضير آليّة مساعدته للإنتقال إلى المواطنيّة، هو مجتمع ما زال في مرحلة تحوّل دائم يمنع استعمال قيم موحّدة تصهر الجميع في بوتقة محدّدة المعالم.
2- يجب الإقرار، منذ البدء ، بوجود تعدّديّة ثقافيّة لا يمكن جعلها تظهر موحّدة ومنصهرة ، ولو في حدّها الأدنى.
3- الإصرار، في حقبات تاريخيّة مضت، على إظهار هذا المجتمع أنّه ذو اتجاه موحّد، باء بالفشل، والدّليل على ذلك أنّ ميثاق 1943 قد بني على نفيين: لا للشرق ولا للغرب !
لهذا قيل: “إنّ لبنان ذو وجه عربيّ” وقام الميثاق الأوّل على هذا الشّعار حتّى بروز النّاصريّة الّتي نادت بإحياء التّيار القوميّ الموحّد للجميع تحت راية الرّئيس الرّاحل جمال عبد النّاصر. ثمّ تطوّرت التّسمية تبعًا لاتفاق الطّائف فأصبحت: “لبنان عربيّ الهويّة والإنتماء” (فقرة ب من المقدّمة).
4- ومع اندلاع الحرب الأهليّة لعام 1975 في ظلّ الانقسام العموديّ الّذي طال المجتمع اللّبنانيّ، اجتمع سعاة الخير في الطّائف ورسموا آليّة، أهمّ ما جاء فيها:
– إعادة ترتيب صلاحيّات الرّئاسات الثّلاث.
– العمل على إلغاء الطّائفية السّياسيّة (الفقرة “ح” من المقدّمة).
– لا شرعيّة لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك (الفقرة “ي” من المقدّمة).
– مع انتخاب أوّل مجلس نوّاب على أساس وطنيّ لا طائفيّ يستحدث مجلس للشّيوخ تتمثّل فيه جميع العائلات الرّوحيّة وتنحصر صلاحيّاته في القضايا المصيريّة (المادّة 22 من الدّستور).
– لم يرِد في دستور الطّائف ما يشير إلى اعتماد تنظيم إداريّ مختلف.
لكنّ هذا الميثاق الجديد أيضًا لم يوقِف مسار التّحوّل في المجتمع اللّبنانيّ وكأنّها أسطورة “سيزيف” الّتي يتكرّر فيها تدحرج الصّخرة. لهذا فإنّ رسم تصوّر لتربية مدنيّة تؤدّي إلى تركيز الفكر والسّلوك المواطنيّ يبدو أمرًا عسيرًا جدّا.
خلاصة القول إنّ مهندسي ميثاق الطّائف قد عدّوا التّعديلات الطّفيفة المقترحة كافية لوقف التّحوّل في المجتمع اللّبنانيّ وعليه يمكن الانتقال إلى مرحلة المواطنيّة بعد تطبيقها، علمًا بأنّ عوامل التّحول هذه ما زالت قائمة لأنّها لم تمَسّ لأسباب عديدة لا جدوى من بحثها من جهة ، ومن جهة ثانية لم تتّخذ الإجراءات اللّازمة من أجل آليّة تنفيذ مناسبة تطال المشكلة أثناء وبعد التّنفيذ هذا.
مهما يكن من أمر، لا بدّ لنا من الإسهام في رسم خطّة عمل لاعتماد التّربية المدنيّة كوسيلة للوصول إلى المواطنيّة، رغم سمة التّحوّل في المجتمع اللّبنانيّ.
ج- المجتمع والدّولة
ثمّة أزمة بنيويّة تعانيها دول العالم العربيّ، ولبنان من ضمنها، تتعلّق بالإنفصام المزمن بين المجتمع والدّولة وبين الأمّة والدّولة بسبب الظّروف التّاريخية المؤسّسة للدّولة وجدليّة العلاقة بين الدّاخل والخارج [10] الّذي كان له دور خاصّ في تأسيس الدّولة الحديثة في العالم الثّالث بشكل عامّ، حيث لم تتبلور الدّولة في سياق تاريخيّ مشابه لسياق نشوء الدّولة ـ الأمّة في أوروبا وتحديدًا في النّموذج الفرنسيّ الأكثر دلالة.
يمتاز الوطن العربيّ، إلى ذلك، بسياق اجتماعيّ ، تحديثيّ خاصّ لم يسمح بإنتاج دولة حديثة، فقد فشلت محاولات التحديث في الإنتقال إلى نموذج مجتمعيّ ودولتيّ حديث وفشلت بالتّالي تجربة ما سمّي بالنّهضة العربيّة في بناء دولة حديثة حقيقيّة، وما شهدناه هو نظام أبويّ مستحدث بحسب الدّكتور هشام شرابي[11].
ولأنّ الدّولة الحديثة هي شرط “المواطنة” الكاملة اصطدمت هذه الأخيرة بمشكلات الأولى في مجالات الهويّة والمشاركة والمساواة[12] الّتي لم تحسم في بنية مؤسّساتيّة مستقرّة وأصبح العبء مزدوجًا :
أ ـ بناء دولة متكاملة كمؤسّسة تؤمّن المشاركة والمساواة والسّيادة .
ب ـ بلورة هويّة وطنيّة ، متّفقٌ عليها، لمواطنين أحرار.
ثمّة تناغم مطلوب بين الدّولة الحديثة ومكوّناتها الإجتماعيّة، وبقدر ما تعبر عن مجمل هذه المكوّنات تكون المصالحة هي السّمة الأبرز، والاستقرار هو المدى المتوقّع، وتكون المواطنة هنا حالة تفاعل ذاتيّ حرّ بين المكوّنات الّتي لا تخشى تسلّط الدّولة ولا تهميش السّلطة ولا تضييع الهويّات الفرعيّة.
فالدّولة تشكّل الحيّز العموميّ المشترك وتمثّل كلّ مكوّناتها لكنّها لا تختزل بأيّ منها، هي دولة المواطنة الجامعة التي لا تلغي خصوصيّات المجموعات والأفراد بل تحافظ عليها وتضيف إليها الهويّة المشتركة. هنا يصبح دور الدّولة، في إحدى وظائفها المساهمة في بلورة مواطنة تنبني باستمرار نحو حيّز مشترك يُعَزِّز الإنتماء والهويّة في مواجهة تحدّيات مشتركة وكذلك صناعة أمل بمستقبل مزدهر في سياق تفاعليّ داخليّ غير قسريّ.
ولعلّ الحالة اللّبنانيّة أكثر انسجاما مع مواطنة تغتني بالتّنوّع ولا تلغيه، في دولة تحترم التّعدّديّة الدّينيّة وتحافظ عليها وتحترم حرّيّة الإعتقاد وتداول السّلطة لكنّها أيضا تطوّر هويّتها باستمرار لا على قاعدة إلغاء المسلّمات الوطنيّة الثّابتة والإنتماء الواضح بل في سياق تحقّق الذّات الوطنيّة مع كلّ نجاح في مواجهة أيّ استحقاق وطنيّ.
المواطن في دولة “المواطنة” هذه، هو فرد يفتخر بانتمائه إلى وطنه دون إلغاء لذاتيّات تتداخل مع هويّته الوطنيّة، فهو يحمل أبعادًا متنوعة لهويّات متآلفة غير متضادّة بالضّرورة تصقلها نجاحات الدّولة، فيستطيع أن ينتمي إلى أيّ مجموعة دينيّة أو غير دينيّة وفي الوقت نفسه يكون لبنانيّا لا تُنْتَقَص لبنانيّته ولا تتفاوت درجتها مع غيره، وهو أيضا يحمل انتماءً عربيًّا لا لبس فيه، وفوق كلّ أبعاد الهويّة المركّبة المتآلفة هو فرد ينتمي إلى عصر، فهو إذن يحمل هويّة هذا العصر ويغرف من رموزه، ويتفاعل مع حضاراته المختلفة ، وينهل من كلّ الثّقافات الإنسانيّة، هو إنسان عالميّ دون أن ينتقص ذلك من هويّته الدّينيّة وانتمائه إلى دولة محدّدة.
د- أركان الدّولة المرجوّة
بتعريفنا للدّولة يتّضح أنّ لها ثلاثة أركان هي: الشّعب والأرض والسّلطة السّياسيّة.
- الشّعب
يتكوّن الشّعب من مجموع كبير من النّاس تجمعهم الرّغبة في العيش المشترك، وإن كان لا يمكن تحديد عدد مناسب أو حدّ أدنى وحدّ أقصى لعدد النّاس أو أفراد الشّعب ، إلّا أنّ كثرة عدد السّكان لا شكّ يعدّ عاملًا هامًّا في ازدياد قدر الدّولة وشأنها، وقد يتطابق تعريف الشّعب مع الأمّة وقد يختلف عنها كما هو حال الأمّة العربيّة المقسّمة إلى دول. فشعب الدّولة يتكوّن من أمّة أو جزء منها أو عدّة أمم، فالشّعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضًا معيّنة، أمّا الأمّة فهي إلى جانب ذلك تتميّز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدّة عناصر كاللّغة والدّين والأصل أو الرّغبة المشتركة في العيش معًا. أمّا بالنّسبة للأمّة والدّولة فالاختلاف يكمن في أنّ الأمّة هي جماعة من الأفراد تجمعهم روابط موضوعيّة وذكريات وآمال مشتركة ورغبة في العيش معًا، أمّا الدّولة فهي وحدة سياسيّة قانونيّة وضعيّة…إضافة إلى أنّ الدّولة هي عنصر من عناصر الأمّة، وإذا كانت الدّولة والأمّة تشتركان في عنصر الشّعب والإقليم، فإنّ الدّولة تتميّز عن الأمّة بالحكومة الّتي تعدّ ركنا من أركان الدّولة. ومن وظائف الدّولة إخفاء التّناقضات الدّاخليّة بين أعضائها من صراع سياسيّ وطبقيّ وإضفاء صفة المشروعيّة أو الشّرعيّة على السّلطة .
- الأرض
يستقرّ الشّعب على أرض معيّنة سواء كانت هذه الأرض ذات مساحة كبيرة أو صغيرة، وقد أصبحت الأرض كعنصر من عناصر الدّولة الثّلاث تسمّى بالإقليم الّذي لا يشمل اليابسة فقط وإنّما إلى جانبها المسطّحات المائيّة التّابعة لليابسة ، والفضاء الّذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدّولة وفقًا لقواعد السّلوك الدّوليّ. وإنّ حقّ الدّولة على إقليمها هو عبارة عن حقّ عينيّ نظاميّ يتحدّد مضمونه بممارسة السّيادة العامة بما تفرضه من إجراءات رقابة وإدارة للشّؤون العامّة.
3- السّلطة السّياسيّة
لا يكفي أن يكون هناك شعب يقيم على مساحة من الأرض لقيام الدّولة بل لابدّ من وجود قوّة أو سلطة أو حكومة لفرض السّلطة على الشّعب في إطار الأرض وأن تعمل هذه الحكومة على تنظيم أمور الجماعة وتحقيق مصالحها والدّفاع عن سيادتها، وتستمد حكومة أيّ دولة شرعيّتها من محبّة شعبها لها لا بل قبوله لها، فإذا انتفى هذا القبول فإنّ الحكومة تكون فعليّة وليست شرعيّة مهما فرضت نفوذها على المحكومين. والمبدأ العامّ أنّ السّلطة إمّا أن تكون اجتماعيّة مباشرة وإمّا أن تكون مجسّدة في شخص معيّن أو سلطة مؤسّسة. والسّلطة السّياسيّة ظاهرة قانونيّة لارتباطها بالقانون، تلجأ إليها السّلطة لتنظيم الأفراد وتقييد مطامعهم و اندفاعهم وتغليب مصالحهم على مصلحة الجماعة. كما أنّ تلك السّلطة يمكن أن تتأثّر بعوامل عديدة سواء دينيّة أو نفسيّة أو اقتصاديّة أو اجتماعيّة أو تاريخيّة… المشروعيّة والسّلطة الشّرعيّة مصطلحان كثيرا التّرداد بين الحكّام، فالمشروعيّة هي صفة تطلق على سلطة اعتقادًا أنّها أصلح فكرة من حيث تطابقها مع آمال وآلام المجتمع، والمشروعيّة تمنح للسّلطات صلاحيّة إعطاء الأوامر وفرض الطّاعة، أمّا الشّرعية فهي صفة تتمتّع بها الدّولة في أعمالها إذا تطابقت مع الدّستور والقانون المطبق في البلد.
خاتمة
إنبثقت في لبنان السّلطة السّياسيّة من الإقطاع الّذي على الرغم من أنّ الثّورات في العالم قد توصّلت لحرمان ملوك الممالك الأصيلة من هذا التّسلط، لم تتوصّل – في لبنان خاصّة- من حرمان الإقطاعيّين منه. وإذا ما تساءلنا عن السّبب نجد بأنّه، في لبنان، فقط، كان الإقطاعيّون هم السّبّاقين للثّورة على من يطالب بكسر نظامهم وقطع رؤوس المتمرّدين، وهذا طبعا برضى الدّستور والحكم والمسؤولين حتّى الدّينيّين. وفي مرحلة بناء الجمهوريّة، كان الإقطاعيّون هم السّبّاقين لإنشاء الأحزاب الدّيمقراطيّة والاستئثار بشعارات الحرّيّة والسّيادة والاستقلال على أن لا تخدم سوى ملكيّتهم الخاصّة. وهذا ما لا يستوعب فهمه الغرب. وهو أهمّ ما تسبّب بهجرة اللّبنانيّين تفتيشًا عن حرّيّة وكرامة قرأوا عنها في الكتب. وهنا نثني على دور الثّقافة والعلم ونجدّد الشّكر للكنيسة الرّومانيّة الّتي استدعت الموارنة لتثقيفهم في روما وللمجتمع اللّبنانيّ الذي سبق الثّورة الفرنسيّة وفرض عام 1736 التّعليم الإلزاميّ للفتيان والفتيات كافة. إنّ هذا ما كان نواة الثّورة الحقيقيّة الّتي نجح الإقطاع الطّاغي وأدها بأن طالب الإرساليّات باحترام المعادلة التّالية: “قيراط علم و23 قيراط تهذيب” والتّهذيب معروف بأنّه الخضوع غير المشروط حتّى في الزّواج. وهذا ما ثار عليه جبران في الأجنحة المتكسّرة. ولو صحّت هذه الثّورة لكان لبنان اليوم على غير ما هو عليه.
بعد ما عرضنا، نلاحظ كيف أنّه على الدّولة بكل مؤسّساتها أن تدور في فلك الإنسان والشّعب، وإن ما يحيط مباشرة بهما وبمصالحهما هي المجالس المنبثقة عنهما – النّواب والحكومة الّتي مهمّتها أن تسهر على التّخطيط والتّوجيه والتّشريع للأمور كافة، ومجتمعة تشكل مجلس الشّعب الّذي بيده الحلّ والرّبط في الأزمات الكبرى والتّعقيدات الاستثنائيّة كالّتي نعيشها اليوم، حتى لا تضيع الرّؤية ويموت الشّعب. وضمن الفلك نفسه تقوم مجالس أخرى للتّربية والثّقافة والتّعليم العالي والاختراعات ألخ… الّتي من مهامها التّخطيط للتّثقيف الدّائم على المواطنة.
هذا بايجاز ما نلفت إليه بالنّسبة لأهميّة مِحوريّة الإنسان في الوطن، والمواطنة، كي لا نتعامل مع هذا الموضوع كمن يضرب بالرّمل.
وترتبط الآية القرآنية ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ ١١﴾ بعلم الاجتماع والسّياسة، فماذا لو وجدنا الشّعب الّذي اعتاد الأمر الواقع، راضيًا بنفسه ولا يهمه أن تُحترم إنسانيّته أكثر ممّا هي عليه اليوم. لقد تحوّل منذ زمن طويل إلى قدريّ، ويئس من أيّ تغيير ولا يرى تحوّلّا في حياته إلا بالرّحيل عن البلد أو نهائيًا عن الحياة. أليس هذا الشّعور فعليًّا وواقعيًّا ويترجمه الشّباب بوسائل عدّة على الأرض؟
إنّها المعضلة الأساسيّة والملحّة الّتي يجب أن نركز عليها اليوم لإخراج الإنسان المرجوّ المتمثّل، لا بالشّباب فقط إنّما بالأطفال والرّضّع، من براثن الإعلام السّياسيّ والأمنيّ الّذي لم يعد صالحًا البتّة لبناء الإنسان والوطن فكيف بالمواطنة ! ناهيكم عن الإعلان والإشاعات وما يرافقها من مهرجانات وأحداث يَدمي القلب لها وتُحضّر حقائب الرّحيل.
لائحة المراجع العربيّة
- أبو خليل، يوسف، الدّولة والمجتمع في لبنان، قراءة تاريخيّة، بيروت، دار الفارابي، 2009.
2 . بشّور، معن، العروبة والمواطنة، جدليّة العلاقة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيّة، 2013.
- طرابلسي، فواز، تاريخ لبنان الحديث، من الإمارة إلى الطّائف، بيروت، رياض الريّس للكتب والنشر، 2007.
- عويدات، جهاد، فهم الدّولة والمواطنة في المجتمعات التّعدّديّة. بيروت، المؤسّسة الحديثة للكتاب، 2011.
- منصور، ندى، المواطنة والتربيّة المدنيّة في لبنان، بيروت، دار العلم للملايين، 2015.
- معوض، أسامة، الدّولة والمواطنة في الفكر السّياسيّ العربيّ المعاصر، القاهرة، مركز البحوث السّياسيّة، 2010.
- هاشم، علي، سوسيولوجيا الطّائفيّة في لبنان. بيروت، دار سائر المشرق، 2018.
liste des références françaises
-Touraine, Alain. Qu’est-ce que la démocratie ? Paris : Fayard, 1994 1
2 -Habermas, Jürgen. L’intégration républicaine : Essais de théorie politique. Paris : Fayard, 1998.
3-Balibar, Étienne. Citoyen sujet et autres essais d’anthropologie philosophique. Paris : PUF, 2011.
-Balandier, Georges. Le pouvoir sur scènes. Paris : Balland, 1980.4
. -Lefort, Claude. La démocratie à l’épreuve. Paris : Le Seuil, 19925
.Rosanvallon, Pierre. La société des égaux. Paris : Le Seuil, 2011.- 6
7- Gaspard, Françoise. Citoyenneté et démocratie. Paris : Éditions La Découverte, 2003.
[1] دكتور في الفلسفة- الجامعة اللبنانية – كليّة الآداب – الفرع الرابع ، وفي كليّة التربية -الفرع الثاني
[2] – will Durant (1966), the story of civilization, vol.N.Y., simon and Scruster, p. 126.
[3] – فريحة، نمر، فعاليّة المدرسة في التّربيّة والمواطنيّة، شركة المطبوعات للتوزيع والنّشر، بيروت 2013، ص16.
[4] – المرجع السّابق، ص. 18.
[5] الكؤاريّ ، علي خليفة ، مفهوم المواطنة في الدّولة الدّيمقراطية ( المستقبل العربي، السنة 23 ، العدد 264 ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيّة، فيفري،2001) ص 104.
[6] الدّولة ومواطنوها ،المسؤوليّات الجديدة وإعادة توزيع الأدوار، مرجع سابق، 40.
[7] الكواريّ، علي خليفة ، مرجع سابق، ص 118.
[8] الدّولة ومواطنوها..، مرجع سابق، ص 45.
[9] القاعي ،عبدو ، وخوري جوزيف ، القيم الدّينيّة في لبنان على مفترق قرنين 1989-2003 دراسة ميدانيّة عرضت في مؤتمر “حروب الأديان وسلامها : إشكاليّة صورة الله”. جامعة سيدة اللويزة 2-3/4/2004
Mzawak, Mirna, l’engagement Chrétien entre Conception et Vécu, Thèse de Doctorat en philosophie et Sciences Humaines, USEK, Juillet 2006.
[10] ـ راجع، خلدون حسن النّقيب : الدّولة التّسلطيّة في المشرق العربيّ الحديث، بيروت مركز دراسات الوحدة العربيّة، 1992 خصوصا المقدّمة النّظريّة والفصل الأول.
[11] تعدّ هذه النّظرية أنّ التّحديث في العالم العربيّ تمّ بشكل سطحيّ بحيث لم تتطوّر المجتمعات العربيّة من سياقها الإقطاعيّ إلى سياق حديث، كما أنّها لم تبقَ ضمن آليّات عمل وثقافة المجتمع السّابق لدخول التّحديث الغربيّ إليه فأصبح في حالة جديدة مشوّهة بين نظامين تاريخيّين متداخلين أسماهما النّظام الأبويّ المستحدث . أنظر : هشام شرابي، النّظام الأبويّ المستحدث وإشكاليّة تخلّف المجتمع العربيّ.
[12] راجع، سعد إبراهيم ، أزمة الدّيموقراطيّة في الوطن العربيّ ، بيروت مركز دراسات الوحدة العربيّة، طبعة ثانيّة ـ 1987 صفحة 414 و 415 .