أنثروبولوجيا التّحوّل السّوسيولوجيّ والسّيكولوجيّ في الخطاب السّياسيّ من القبيلة إلى الحزب (شيعة عليّ وشيعة معاوية)
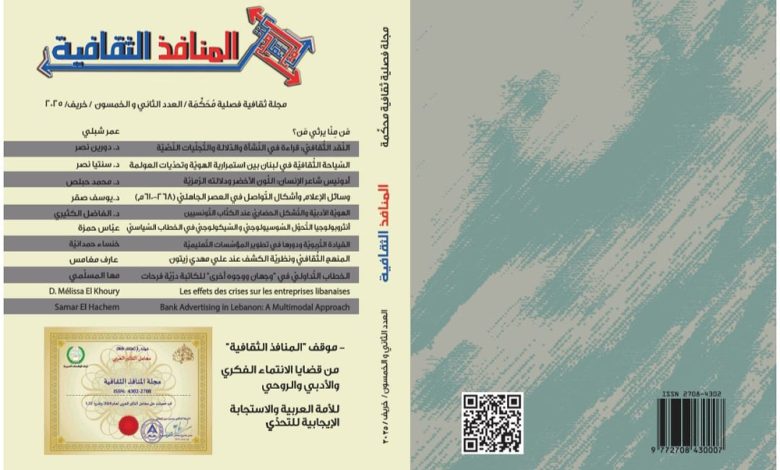
أنثروبولوجيا التّحوّل السّوسيولوجيّ والسّيكولوجيّ في الخطاب السّياسيّ من القبيلة إلى الحزب
(شيعة عليّ وشيعة معاوية)
Anthropology of Sociological and Psychological Change in Political Discourse from Tribe to Party (Shiites of Ali and Shiites of Muawiyah)
عبّاس أنيس حمزة[1]
Abbas Anis Hamza
تاريخ الاستلام 30/ 4/ 2025 تاريخ القبول 30/ 5/ 2025
ملخص
يحلّل هذا البحث التّحوّلات الأنثروبولوجيّة والسوسيولوجيّة والنفسيّة العميقة التي طرأت على المجتمع الإسلاميّ إثر الصراع بين الإمام عليّ ومعاوية (37 هـ)، والذي أفضى إلى تحوّل جذريّ في الولاءات من البنية القبليّة إلى الانتماءات الحزبيّة الأيديولوجيّة. يوضّح البحث كيف استطاع معاوية استقطاب المسلمين عبر الإغراء الماديّ والتأثّر بالنموذج البيزنطيّ الإداريّ، مستخدمًا خطابًا مزدوجًا، دينيًّا وسياسيًّا، لمواجهة الإمام عليّ وبناء نظام سلطويّ مركزيّ يعيد تشكيل الهُويّة الجماعيّة للمسلمين، وذلك بتوظيف الخطابين الإلهيّ والرساليّ في مواجهة الخطاب الإماميّ، لترسيخ دعائم حكمه. في المقابل، مثّل خطاب الإمام عليّ مرجعيّة أخلاقيّة، متمسكًا بالشرعيّة الدينيّة والسّياسيّة كامتداد طبيعيّ للخطاب الإلهي والرساليّ، إلّا أنّه عانى من انقسام أتباعه وظهور الخوارج. وقد شكّلت وثيقة التحكيم نقطة تحوّل انثروبولوجيّة حاسمة، إذ عمّقت الانقسامات وأسّست للإسلام السّياسيّ الذي أعاد توظيف الدين كأيديولوجيا لصياغة الولاءات الحزبيّة، وأفرز تيّارات طائفيّة متجذّرة. ويخلص البحث إلى أنّ الصراع بين الإمام عليّ ومعاوية، الذي بُني في ماهيّته على الثنائيّات الضديّة، شكّل الانزياح المعرفيّ والتّاريخيّ الذي أعاد تشكيل الهُويّة الجماعيّة الإسلاميّة من القبيلة إلى الحزب؛ فبينما سعى الإمام عليّ للحفاظ على سياق النموذج النبويّ الثوريّ القائم على العدل والأخلاق، بما يمثّل من شرعيّة وكرمز للوحدة الإسلاميّة، نجح معاوية في تأسيس نظام سياسيّ براغماتيّ يعتمد على الولاءات الماديّة والأيديولوجيّة، مستغلًا الدين لخدمة السلطة. هذا التّحوّل الأنثروبولوجيّ ما زال يلقي بظلاله على الواقع الإسلاميّ حتى اليوم، ممّا يؤكّد على قوّة الخطاب السّياسيّ في صناعة الهويّات وتغيير مسارات التّاريخ.
الكلمات المفتاحيّة: أنثروبولوجيا، سوسيولوجيا، سيكولوجيا، أيديولوجيا، خطاب، الهُويّة، التشكّل، التّحوّل، البنية، سياق، ثنائيّة، الانزياح، تناقض، دينيّ، ثوريّ، سياسيّ.
Abstract
This research analyzes the profound anthropological, sociological, and psychological transformations that took place in Islamic society following the conflict between Imam Ali and Muawiya (37 AH), which led to a radical shift in loyalties from tribal structure to ideological party affiliations. The research shows how Muawiya was able to polarize Muslims through material temptation and influence by the Byzantine administrative model, using a dual discourse, religious and political, to confront Imam Ali and build a centralized authoritarian system that reconfigured the collective identity by employing the divine and messianic discourses against the Imamite discourse to consolidate his rule. On the other hand, Imam Ali’s discourse represented a moral authority, upholding religious and political legitimacy as a natural extension of the divine and messianic discourse, but he suffered from the division of his followers and the emergence of the Kharijites. The arbitration document was a crucial anthropological turning point, as it deepened divisions and laid the foundation for political Islam, which repurposed religion as an ideology to shape partisan loyalties and spawned deep-rooted sectarian currents. The research concludes that the conflict between Imam Ali and Muawiya, which was built on oppositional binaries, constituted the epistemological and historical shift that reshaped the Islamic collective identity from tribe to party. While Imam Ali sought to preserve the context of the revolutionary prophetic model based on justice and morality, representing legitimacy and a symbol of Islamic unity, Muawiya succeeded in establishing a pragmatic political system based on material and ideological loyalties, exploiting religion to serve power. This anthropological shift still casts a shadow on the Islamic reality today, emphasizing the power of political discourse to shape identities and change the course of history.
Keywords :Anthropology, sociology, psychology, ideology, discourse, identity, formation, transformation, structure, context, binary, dichotomy, contradiction, religious, revolutionary, political.
المقدمة
إنَّ تكوّن كلٍّ من حزب عليّ وحزب معاوية مع حلول سنة 37 للهجرة، أفضى إلى تحوّل جذريّ في بنية الإنسان العربيّ المسلم وإعادة تكوين لماهيّته، وهذا أفضى إلى تغيير أنثروبولوجيّ عميق في طريقة وجوده، نتيجة للتداعيات العنيفة للحرب التي نشبت بين هذين الحزبين. وقد أدّت هذه الحرب إلى انقسام سوسيولوجيّ وسيكولوجيّ بين النّاس، رغم أنَّها لم تكن ذات طابع طائفيّ في جذورها الأولى. ولذلك لا بدّ من الرجوع إلى السبب الرئيس لهذا الانقسام؛ ولا شك أنَّ تناقض خطاب معاوية مع خطاب الإمام عليّ هو الذي أدّى إلى وجود تناقض في الوعيّ الاجتماعيّ للمسلمين.
لم يقتصر هذا التّناقض على السّاحة السّياسيّة، وإنّما انعكس على مختلف جوانب الحياة بين النّاس، فتحوّل المسلمون إلى جماعات متصارعة. ورغم انتهاء الحرب عسكريًّا، إلّا أنّ آثارها الأنثروبولوجيّة ظلّت مُستمرّةً؛ فقد ظهرت في تشكّل كيانات اجتماعيّة مستقلّة تحمل أنماطًا ثقافيّة وقيمًا متباينة، وهذا أفضى إلى تكوين نماذج من الحيوات الإنسانيّة متغايرة إلى أبعد حدّ، أسّست لتناقضاتٍ حضاريّةٍ ما تزال تُلقي بظلالها على واقع الأمّة حتى اليوم.
ينبغي فهم ما نقصده بأنثروبولوجيا التّحوّل السوسيولوجيّ والسيكولوجيّ في الخطاب السّياسيّ من القبيلة إلى الحزب، على أساس أنَّ معاوية أحدث انعطافًا كبيرًا في المجتمع الإسلاميّ الناشئ. لقد نقل المسلمون التابعون له من نمط عيش قبليّ بسيط، إلى نظام حياة مدنيّ معقّد، فأحدث ذلك تغييرًا جوهريًّا في نفوسهم بانفتاحهم على أساليب جديدة للعيش لم يعرفوها من قبل. وقد أدّى بهم ذلك إلى الانتقال من الوعي النابع من مجتمع القبيلة، إلى وعي جديد نابع من مجتمع غريب عنهم، ما أدّى إلى تحوّل سوسيولوجيّ عميق في الحياة الإسلاميّة أفضى إلى تكوين سيكولوجيّ جديد للأفراد.
أوّلًا: التأثير الأنثروبولوجيّ لمعاوية في المجتمع الاسلاميّ
استطاع معاوية استقطاب الكثير من المسلمين الذين كانوا يعيشون في شبه الجزيرة العربيّة بعامّة، وفي مكّة والمدينة بخاصّة، وأحدث تأثيرًا كبيرًا في تكوين الإنسان المسلم بأن نقله من مستوى سوسيولوجيّ وسيكولوجيّ كان موجودًا من قبل إلى مستوى جديد تمامًا. وقد أدّى ذلك إلى تغيير عميق في طبيعة الإنسان في ذلك العصر، فتغيّرت عاداته إذ انتقل من الزهد والتقوى والورع والتضحية والجهاد في سبيل الله، إلى الاهتمام بالدرجة الأولى بمكاسب الحياة، وشغوفًا إلى أقصى حدّ بأعراض الدّنيا، وهذا كلّه يرجع إلى قوّة الإغراء التي استطاع معاوية استخدامها لجذب النّاس إليه، وهذا ما أحدث انقلابًا في أنثروبولوجيا الإنسان المسلم، ليصبح معنيًّا أكثر باللباس والطعام والشراب والحياة في القصور والانغماس في ملذّات الحياة المدنيّة، فكان هذا الأمر بداية لنهاية عصر الفتوحات.
ولا شكّ أنَّ لهذا التّحوّل الأنثروبولوجيّ الذي أحدثه معاوية التأثير الأكبر في تكوين مجتمع جديد غير المجتمع الذي أسّسه الرّسول (ص)، وحاول استعادته أمير المؤمنين عليّ. وقد استطاع خطاب معاوية أن يجذب إليه كثيرًا من النّاس؛ بل وأن ينظروا إليه بصفته أميرًا للمؤمنين بعد رحيل الإمام؛ لكن السؤال الذي يجب البحث عن جواب حاسم عنه هو: كيف استطاع معاوية أن يقود ما اصطلحنا عليه أنثروبولوجيا التّحوّل السوسيولوجيّ والسيكولوجيّ في الخطاب السّياسيّ من القبيلة إلى الحزب؟ أي كيف غيّر خطاب معاوية ولاء الإنسان المسلم ليصبح ولاءً مطلقًا له، محدثًا هذا الانزياح الحضاريّ العميق؟
والحقيقة أنّ هذا الانزياح هو نتاج استراتيجيّةٍ واعيةٍ قادها معاوية؛ إذ استطاع استقطاب شرائح واسعة من المسلمين، لا سيّما من أبناء مكّة والمدينة، ولقد كسر خطابه الحاجز النفسيّ بين القيم الإسلاميّة المثاليّة وإغراءات الحضارة البيزنطيّة. فدمشق، التي اتّخذها عاصمةً لدولته، لم تكن مجرّد حاضرةٍ سياسيّة، وإنّما مثّلت رمزًا ثقافيًّا حوّل الفرد المسلم من “مجاهد” في مشروعٍ دينيّ جماعيّ إلى “فرد” في نظام مركزيّ يقدّس الولاء الفرديّ للحاكم. وقد نقل معاوية الصراع من معركة على الشرعيّة الدينيّة إلى معركةٍ على توزيع الامتيازات، مُستفيدًا من تحوُّل مجتمع الفتوحات – المُثقل بالغنائم – إلى مجتمعٍ يبحث عن الاستقرار الماديّ.
يفسّر هذا التّحوّل سبب عجز الإمام عليّ بعد حرب صفّين، عن إعادة تجميع الجيش مرّة أخرى لاستئناف الحرب[2]، رغم محاولاته المتكرّرة، فلم يجد إلّا جمعًا من المتخاذلين عن الجهاد. فالمجتمع الذي حاول الإمام استعادته كان قد تغيّرت بُنيته النفسيّة والاجتماعيّة بشكلٍ لا عودة عنه. بينما حافظ معاوية وابنه يزيد لاحقًا، على سيطرةٍ مطلقةٍ على جنوده المستعدين لخوض أيّ حرب يأمرهم بها. لذا، لم يكن عجز الإمام عليّ انتكاسة عسكريّة، بالقدر الذي كان بمثابة انهيار لمشروع اصلاحيّ حضاريّ أمام تحوّلٍ أنثروبولوجيٍّ جمّد القيم الروحيّة. وعليه، لا بدّ من الرجوع إلى هذه القضيّة وتحليلها على نحو معمّق من أجل فهمها لإيضاح ما يقف وراء قوّة الاستقطاب في خطاب معاوية، وهذا أمر يبدو محيّرًا إلى أقصى حدّ.
بالعودة إلى سياق الفتوحات الإسلاميّة، يُعدُّ تعيين السفيانيّين، يزيد بن أبي سفيان ثم معاوية على إمارة الشّام في العهدين الراشديّ والأمويّ، قضيّةً محوريّةً لفهم التّحوّلات السّياسيّة في التّاريخ الإسلاميّ. فبعد فتح الشّام من البيزنطيّين في معركة اليرموك (13 أو 15 هـ)، التي بدأت في عهد الخليفة الأوّل أبي بكر الصدّيق وأكملها الخليفة الثاني عمر بن الخطّاب، برزت إشكاليّة تعيين ولاة من عائلة أبي سفيان في مناصب حسّاسة، والتي كانت تُعدّ من أبرز خصوم النّبيّ(ص) قبل إسلامها. ففي عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وُليَّ أخو معاوية، يزيد بن أبي سفيان، إمارة الشّام، رغم كونه من “الطّلقاء” الذين أسلموا بعد فتح مكّة، وابنًا لزعيم قريش السابق أبي سفيان، الذي قاد حروبًا ضد المسلمين.[3]
أصبح معاوية أميرًا على الشّام سنة 21 هجريّة في عهد الخليفة عُمر، ومن هنا استأنف عمليّة نشر الإسلام في بلاد الشّام، لكن تحت مظلّةٍ سياسيّةٍ واجتماعيّةٍ مغايرة لما عُرف في العهد النبويّ. ولا ريب في أنَّ سنة فتح الرّسول (ص) لمكّة كانت السنة الثامنة للهجرة، ومعاوية نفسه أسلم حين فتح مكّة، أي بين إسلامه وتعيينه أميرًا على الشّام ثلاثة عشر عامًا، ويُرجّح أنّ أخاه يزيد قد مهّد له الطريق لكسب ولاء القبائل النصرانيّة التي كانت متحالفة مع البيزنطيّين، ثمّ اتجه أفرادها بسبب الفتح إلى اعتناق الإسلام.
لكنّ الإسلام الذي اعتنقته هذه القبائل لم يكن امتدادًا طبيعيًّا للنموذج النبويّ، بل كان “إسلامًا أمويًّا” – انتقل عبر ولاة من بني أميّة- تمازجت فيه العقيدة مع البراغماتيّة السّياسيّة. فمعاوية، في خطوةٍ استراتيجيّةٍ في تاريخه الشّخصيّ، صاهر قبيلة كلب الشّاميّة، ذات الأصول النّصرانيّة التّابعة للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة، التابعة بدورها للكنيسة البيزنطيّة الأرثوذكسيّة، بزواجه من ميسون بنت بحدل الكلبيّة[4]، التي أنجبت له لاحقًا ابنه يزيد. لم تكن هذه المصاهرة حدثًا شخصيًّا، بل محورًا لبناء تحالفٍ قبليٍّ وسياسيٍّ مكّن معاوية من اختراق النسيج الاجتماعيّ للشام، وأن يكسب ولاء القبائل العربيّة ذوات الأصول النصرانيّة، رابطًا مصالح القبائل المسيحيّة حديثة الإسلام بنظام حكمه.
ومن هنا بحكم علاقة هذه القبائل أنفسها مع البيزنطيّين، قام معاوية نفسه بنسج علاقات وطيدة مع من بقي منهم في الشّام، وانفتح بذلك على نمط جديد من الحياة مختلف اختلافًا تامًّا عن نمط الحياة الذي عاشه في مكّة إلى حين تعيينه أميرًا. ومعنى ذلك أنَّ معاوية استطاع استثمّار مصاهرته لقبيلة كلب في التقرّب من بقايا النخب البيزنطيّة للاستفادة منهم، وهنا بسبب اختلاطه بنمط جديد من الحياة، أمسك بزمام المبادرة لإحداث ما اصطلحنا عليه بالتّحوّل الأنثروبولوجيّ. وقد أصبحت العناصر التي اعتنقت الإسلام حديثًا من القبائل النصرانيّة الركيزة الأساسيّة في جيش معاوية الذي حارب الإمام عليّ، وهذا أمر لا يمكن كشفه بسهولة لقلّة المصادر التّاريخيّة وشحّ المعلومات.
لكن لا بدّ أن يكون معاوية قد أسّس نوعًا من الخطاب متناسبًا مع طبيعة المجتمع الجديد الذي انتسب إليه، ولا شكّ في أنَّ هذا الخطاب يحمل طابعًا مزدوجًا دينيًّا وسياسيًّا، هدف إلى ترويض عقول أهل الشّام لصالحه بصفته كاتب الوحي والصحابيّ الجليل، واستقطاب المسلمين في الجزيرة العربيّة بصفته المطالب بالثأر من قتلة الخليفة عثمان.
وهكذا، مثَّلت ولاية معاوية على الشّام بداية تحوّلٍ أنثروبولوجيٍّ عميق، غيّر هُويّة المجتمع الإسلاميّ الناشئ، من خلال دمج العناصر البيزنطيّة في البُنى السّياسيّة والثقافيّة، وتشكيل نموذجٍ هجينٍ مهَّد لقيام الدولة الأمويّة لاحقًا، بوصفها إمبراطوريّةً تستند إلى الولاءات القبليّة والمصالح الماديّة والقوّة العسكريّة، أكثر من استنادها إلى المثال النبويّ.
إنَّ خطاب معاوية معقّد إلى اقصى حدّ، إذ إنَّ خلفيّته بصفته ابن أبي سفيان العدو الأكبر لرسول الله (ص)، تركت في نفسه تأثيرًا بالغًا متّصلًا، ذلك أنَّ أباه أبا سفيان حارب رسول الله(ص) منذ بداية الدعوة، فضيّق عليه هو والمشركون في مكّة وحاصروه وآذوه وحاولوا اغتياله، وصولًا إلى معركة بدر وأُحد والخندق وصولًا إلى فتح مكّة، وإطلاق أبي سفيان وزوجته هند وأولاده ومن بينهم معاوية.
بناءً على هذه الخلفيّة، تكوّن معاوية سيكولوجيًّا على كراهيّة أمير المؤمنين عليّ، الذي كان سيف رسول الله في معارك قُتل فيها أخو معاوية (حنظلة) وجدّه لأمّه (عتبة) وخاله في معارك بدر وأُحد. ومن ناحية أخرى، نظرًا لوجود معاوية في دمشق البيزنطيّة نحو عشرين عامًا في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر، تشبّع بالفكر البيزنطيّ – المسيحيّ لناحية تأثّره بأنظمة الحكم المركزيّة، والتراتبيّة الاجتماعيّة، والتحالفات القائمة على المصالح الماديّة النفعيّة، بدليل احتكاكه مع بقايا البيزنطيّين في الشّام ومصاهرته لقبيلة كلب النصرانيّة الأصل، وعلاوة على ذلك اتباعه لطرق في نظم الحكم لم تكن معروفة في عهد الخلفاء الراشدين.
وذكر لنا خليفة بن خياط في تاريخه معلومات على درجة عالية من الأهميّة تتعلّق بمعاوية، قال ابن خياط عن حاشية معاوية: “وكان كاتب الرسائل عبيد بن أوس الغسانيّ. وعلى الديوان وأمرهِ كلِّهِ: سرجون بن منصور الروميّ. وحاجبه: أبو أيّوب مولاه. وعلى شرطه: يزيد بن الحرّ مولاه، فمات يزيد فولّى قيس بن حمزة الهمدانيّ، ثمّ عزله وولّى ذهل بن عمرو العذريّ. وكان أوّل من اتخذ صاحب حرس، وأوّل من وضع ديوان الخاتم، وكان على الحرس المختار مولى لحمير، وعلى الخاتم: عبد الله بن عمرو الحميريّ.”[5]
واللّافت فيما نقله ابن خياط أنَّ كاتب الرسائل – كما هو واضح – غسانيّ، أي من أصل نصرانيّ، لأنَّ الغساسنة في الشّام كانوا على الديانة النصرانيّة، هذا إلى أنّهم كانوا حلفاء للروم البيزنطيّين، وبقي أكثر الغساسنة بعد الفتح على الديانة النصرانيّة. زدْ على ذلك أنَّ معاوية سلّم أمر الديوان كلّه لسرجون بن منصور الروميّ، ويبدو من نسبته أنّه روميّ الأصل وليس نصرانيًّا فقط. والحقيقة أنّ مهمّةَ الديوان آنذاك تعادل الآن مهمّة وزارة الخارجيّة ومعها أجهزة الاستخبارات، فأن يسلّم معاوية هذا المنصب الخطير لروميّ أمر يثير تساؤلات. هذا، إلى أنَّ سرجون هو الذي أشار على يزيد فيما بعد بتكليف ابن مرجانة بقتل الحسين بن عليّ، إذ روى البلاذري: “بلغ يزيد بن معاوية أنَّ الحسين عليه السلام يريد الخروج إلى الكوفة فغمّه ذلك وساءه فأرسل إلى سَرْجون مولاهم وكان كاتبه وأنيسه فاستشاره فيمن يوليه الكوفة فأشار بعبيد الله بن زياد.”[6]
ويضاف إلى ما سبق أنَّ معاوية أوّل من اتخذ صاحب حرس، وهو يوازي عند الروم قائد الحرس الإمبراطوريّ، وهذا يوحي أنَّ معاوية تحوّل إلى إمبراطور على الطريقة البيزنطيّة، كما أنَّ اعتماده على ديوان الخاتم كان الهدف منه هو حفظ رسائله بطريقة لا يمكن فتحها حتّى لا يطلع الرسل على مضمون الرسائل التي يحملونها، لأنّها مختومة بخاتم. ومن هنا تحوّلت دولة الإسلام القائمة على الشورى إلى دولة أمنيّة بكلّ معنى الكلمة، ويزيد المشهد وضوحًا أنّ معاوية اعتمد في قيادة الحرس أو ديوان الخاتم على حِميريّين[7]، وقبيلة حِمير كما هو معروف كان معظم أفرادها يدينون باليهوديّة.
إذن، ها هو الإمبراطور الجديد، محاطًا بحرسه الإمبراطوريّ، ومستشاريه من الروم والنصارى واليهود، أي من خلفيّات ثقافيّة دينيّة متنوّعة للإيحاء بالتسامح الدينيّ، ويوجّه خطاباته بمشورة هؤلاء إلى أمير المؤمنين ليهدّده بسبب استقوائه بفلول البيزنطيّين والنصارى واليهود على مستوى التخطيط، وبقبائل كانت متحالفة مع الروم أصلًا من أجل الاستيلاء على السلطة، وقد استطاع معاوية أن يستنفر في خطابه الحالة الإسلاميّة.
بيد أنَّ البنية العميقة لخطاب معاوية تنبع أصلًا من وجوده في واقع جغرافيّ (دمشق البيزنطيّة) مختلف عن واقع المسلمين من المهاجرين والأنصار (مكّة والمدينة)، من هنا أسهم معاوية في هذا الانقلاب الأنثروبولوجيّ، فقد استقطب النّاس بنقلهم من بيئة محدودة إلى بيئة مدنيّة، فأحدث ذلك فيهم تغييرات كبيرة على مستوى العادات في الطعام والسكن والرفاهيّة والاستغراق في متع الحياة المدنيّة، فتولّدت في دخيلاء كلّ واحد منهم شخصيّة جديدة تريد أن تخرج من شرنقتها القديمة، علاوة على الإغراءات الماليّة الهائلة التي كان معاوية يستميل بها النّاس، وكان قد أخذها من بيت مال المسلمين.
ثانيًا: تحليل أثر خطابي عليّ ومعاوية في الوعي الجمعيّ الاسلاميّ
تقف وراء خطاب معاوية بنية ساعدته على تحقيق أهدافه، وما كان له أن يحقّق غاياته إلّا بإقصاء عدوّه الأوّل، أعني الإمام عليّ ومن معه من أنصار. ولذلك، الانقلاب الانثروبولوجيّ الذي أحدثه معاوية في المجتمع الإسلاميّ لم يكن له أن يتم، إلّا إذا اتخذ هذا الخطاب طابع الطعن في عليّ، ودفع النّاس إلى لبس لبوس جديد يتناسب مع التّحوّل الأنثروبولوجيّ الذي هدف معاوية إلى تحقيقه في الشخصيّة الإسلاميّة.
ولقد كتب معاوية إلى امير المؤمنين: “مِنْ عَبْدِ اَللَّهِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ: ﴿وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ اَلْخٰاسِرِينَ ﴾ وَإِنِّي أُحَذِّرُكَ اَللَّهَ أَنْ تُحْبِطَ عَمَلَكَ وَ سَابِقَتَكَ بِشَقِّ عَصَا هَذِهِ اَلْأُمَّةِ وَ تَفْرِيقِ جَمَاعَتِهَا، فَاتَّقِ اَللَّهَ وَ اُذْكُرْ مَوْقِفَ اَلْقِيَامَةِ وَ اِقْلَعْ عَمَّا أَسْرَفْتَ فِيهِ مِنَ اَلْخَوْضِ فِي دِمَاءِ اَلْمُسْلِمِينَ، وَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ لَوْ تَمَالَأَ أَهْلُ صَنْعَاءَ وَ عَدَنٍ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ لَأَكَبَّهُمُ اَللَّهُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي اَلنَّارِ، فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ مَنْ قَتَلَ أَعْلاَمَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ سَادَاتِ اَلْمُهَاجِرِينَ، بَلْهَ مَا طَحَنَتْ رَحَى حَرْبِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُرْآنِ وَ ذَوِي اَلْعِبَادَةِ وَ اَلْإِيمَانِ مِنْ شَيْخٍ كَبِيرٍ وَ شَابٍّ غَرِيرٍ كُلُّهُمْ بِاللَّهِ تَعَالَى مُؤْمِنٌ وَ لَهُ مُخْلِصٌ وَ بِرَسُولِهِ مُقِرٌّ عَارِفٌ، فَإِنْ كُنْتَ أَبَا حَسَنٍ إِنَّمَا تُحَارِبُ عَلَى اَلْإِمْرَةِ وَ اَلْخِلاَفَةِ فَلَعَمْرِي، لَوْ صَحَّتْ خِلاَفَتُكَ لَكُنْتَ قَرِيبًا مِنْ أَنْ تُعْذَرَ فِي حَرْبِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنَّهَا لَمْ تَصِحَّ لَكَ وَ أَنَّى بِصِحَّتِهَا وَ أَهْلُ الشّام لَمْ يَدْخُلُوا فِيهَا وَ لَمْ يَرْتَضُوا بِهَا فَخِفِ اَللَّهَ وَ سَطَوَاتِهِ، وَ اِتَّقِ بَأْسَ اَللَّهِ وَ نَكَالَهُ، وَ اِغْمِدْ سَيْفَكَ عَنِ النّاس فَقَدْ وَ اَللَّهِ أَكَلَتْهُمُ اَلْحَرْبُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ كَالثمّدِ فِي قَرَارَةِ اَلْغَدِيرِ وَ اَللّٰهُ اَلْمُسْتَعٰانُ.”[8]
يجب هنا الوقوف عند هذا الضّرب من الخطاب، لأنّه هو بعينه الضّرب الذي أسّس لإحداث أنثروبولوجيا التّحوّل السّوسيولوجيّ والسّيكولوجيّ في الخطاب السّياسيّ من القبيلة إلى الحزب، أي أنَّ الأحداث قادت بعد سقوط مفهوم الانتماء الإسلاميّ أو الجهاد في الإسلام وظهور مفهوم القبيلة من جديد، إلى سقوط مفهوم القبيلة نفسه وحلول مفهوم الحزب محلّه. وقد ساق التركيز على مغانم الحزب إلى تغيير سوسيولوجيّ عميق، أردفه تغيير سيكولوجيّ جماعيّ قاده خطاب معاوية، بطريقة أفضت إلى انقلاب أو انزياح عميق في الدولة الإسلاميّة.
ويظهر من أسلوب الخطاب الذي وجّهه معاوية إلى أمير المؤمنين، أنّه استند إلى الآية الخامسة والستين من سورة الزّمر. وعليه، أراد معاوية في خطابه استخدام النصّ القرآنيّ ضدّ الإمام، أي استخدام الخطاب الإلهيّ لإضفاء شرعيّة دينيّة على الحزب السفيانيّ الوليد في مواجهة الخطاب الإماميّ.
بالإضافة إلى ذلك، استند معاوية إلى حديث نسبه إلى الرّسول الأكرم(ص)، وهذا يعني أنَّ معاوية يريد العمل بالسُّنَّة وقتل قتلة الخليفة عثمّان.
وعليه، وظّف معاوية الخطاب الإلهيّ والخطاب الرساليّ للتشكيك بشرعيّة إمامة أمير المؤمنين وتأليب الأنصار ضده، مصورًا حركته كردّ فعل دينيّ لتطبيق السنّة النبويّة.
هذا هو الأساس الفكريّ الذي نهض عليه كتاب معاوية؛ لكن يجب الانتباه إلى أنَّ هذا الكتاب هو بحدّ ذاته تعبير عميق عن خطاب معاوية إلى النّاس من مختلف الأطراف، لتحريضهم على أمير المؤمنين، ممّا أسهم في صناعة للهويّة الجمعيّة الجديدة، لأنّ معاوية باتهامه للإمام بتفرقة الأمّة الإسلاميّة قدّم نفسه كرمز للوحدة الإسلاميّة، وحزبه كحامي للدين.
إذّا، نحن هنا بإزاء أسلوب خطابيّ يقوم على ماهيّة عميقة وهي الموعظة*، فنجد في كتاب معاوية نَفَسًا وعظيًّا وإصلاحيًّا واضحًا، واستحضارًا لآيات قرآنيّة وأحاديث نبويّة في سياقاتٍ مخصوصة، مستندًا إلى تعبيرات بلاغيّة قويّة. ولقد حاول معاوية إيصال معنى واحد بطرق مختلفة، سواء بالاستناد إلى آية كريمة أو حديث نبويّ، أو عن طريق زرع دفقة عاطفيّة وجدانيّة في لغته بوساطة تعابير بلاغيّة حزينة عن موت كثير من المسلمين في الحرب، أو بوساطة تعابير بلاغية تهويليّة أو تخويفيّة هدف منها إلى تبيان إيمانه بالله تعالى، وتوجيه نصيحة لأمير المؤمنين حتّى يخاف الله وسطواته من فظاعة ما فعلت الحرب التي أوقدها الإمام بالنّاس.
وإذا أردنا تحليل البُعد الإبداعيّ في كتابات معاوية، لوجدنا أنّه أعاد تجديد الخطاب السفيانيّ بلبوس الخطابين الإلهيّ والرساليّ، أي إنّه وجّه البنية اللفظيّة لهذين الخطابين عن طريق إعادة نظم مفرداتهما وتراكيبهما اللّغويّة، ليؤلّف بذلك خطابًا تضليليًّا للنّاس، ولقد نجح هذا الخطاب فعلًا، ليس بالنسبة إلى كثير من النّاس آنذاك فحسب؛ بل بالنسبةِ إلى كبار المؤرّخين في العالم الذين نظروا إلى معاوية نظرة غير موضوعيّة.
ويُستشهد هنا برأي ول ديورانت[9] الذي قال: “يجب علينا ألّا نظلم معاوية. لقد استحوذ على السّلطة في بادئ الأمر حين عيّنه عمر الخليفة الفاضل النزيه واليًا على الشّام، ثمّ بتزعّمه الثورة التي أوقد نارها مقتلُ عثمّان، ثمّ بما دبّره من الدسائس البارعة التي أغنته عن الالتجاء إلى القوّة إلّا في ظروف جدّ نادرة، ومن أقواله في هذا المعنى (لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي، ولا أضعُ سوطي حيث يكفيني لسانيّ، ولو أنَّ بيني وبين النّاس شعرة ما انقطعت) قيل: وكيف يا أمير المؤمنين؟ قال: (إذا مدّوها خلّيتها وإن خلّوها مددتها).”[10]
يظهر هنا أنَّ ول ديورانت، بصفته فيلسوف الحضارة ومؤرّخ لتاريخ العالم، وجد المبرّرات لأفعال معاوية، فهو صاحب سلطة أعطاه إيّاها خليفة فاضل نزيه، وقائد ثورة هدفها الانتقام من قتلة عثمّان، وسياسيّ بارع استطاع الانتصار بمكره وذرائعيته أكثر من انتصاره في ساحات الوغى. كما أنَّ قوله عن العلاقة بينه وبين الشعرة الموجودة بينه وبين النّاس أعجبت ديورانت، ما يدلّ على نفوذ خطاب معاوية حتّى في عقول كبار المؤرخين!
لكن رغم مكانة المؤرّخ الكبير ديورانت، إلّا أنّه – كما يبدو – قليل البضاعة من التّاريخ الإسلاميّ، فقراءته تبدو سطحيّةً في تعامله مع قضيّة معاوية، إذ إنَّ السلطة التي نالها معاوية في عهد الخليفة عمر فيها مخالفة لقاعدة “لا ولاية لطليق”[11] التي ذكرها أمير المؤمنين في كتابه إلى معاوية “وَاعْلَمْ أَنَّكَ مِنَ الطُّلَقَاءِ الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الْخِلَافَةُ، وَلَا تُعْقَدُ مَعَهُمُ الْإِمَامَةُ”[12] ، كما أنّه يصف حركة معاوية بأنّها “ثورة” في حين أنّها -واقعيًّا- لم تكن سوى ردّة فعلٍ على الثورة الشعبيّة التي اندلعت ضدّ سياسات الخليفة عثمان بن عفان، أي ثورة على الثورة الحقيقيّة. زدْ على ذلك أنَّ دسائس معاوية تقوم على انحطاط في الأخلاق، ولا تدلّ على مواقف سياسيّة نبيلة. ويضاف إلى كل ما سبق أنَّ معيار العلاقة مع النّاس بالنسبة إلى معاوية هو “شعرة”، وليس الشريعة المطهّرة.
لذلك، هذا التحيّز لدى ديورانت إلى معاوية ليس غريبًا، فهو لا ينفصل عن النّظرة الاستشراقيّة التي تنطوي دائمًا على حقد دفين على الإسلام، ولذلك سيسعى المستشرقون، ومنهم ديورانت، إلى تأييد خطاب معاوية، لأنّه خطاب انهيار الدولة الإسلاميّة، وهو ما يخدم السرديّة الاستشراقيّة الرافضة لفكرة قيام دولة إسلاميّة قويّة.
ومن جهة أخرى نجد أنَّ المفكرين العرب أيضًا كانوا مأخوذين بشخصيّة معاوية، فتمثيلًا لا حصرًا، لم يفهم عبّاس محمود العقّاد من كتب معاوية وخطبه سوى ما يمكن على أساسه النظر إلى معاوية بصفته إنسانًا متعلّمًا بليغًا.
ذهب العقّاد إلى أنَّ “معاوية تعلّم القراءة والكتابة والحساب، وإلى أنّه قد اتفقت الأخبار على كتابته للنبيّ -عليه السلام-، وكان معاوية على شغف خاص بالاستماع إلى سير الملوك، ووقائع الأمم وأطوار الدول الغابرة، وربما قرئت له هذه السِّير من كتب يونانيّة أو فارسيّة(…)وبلاغة معاوية في كلامه بلاغة سويّة لا تعلو، ولا تسف عن بلاغة أمثاله ونظرائه: يبيّن عمّا يقصد، ويحتفل بالقول، فينقاد له طبعه الميسر للعربيّ الفصيح من أبناء عصره(…) ومن ردوده المحفوظة ردّه على الإمام عليّ.”[13]
يظهر واضحًا من طريقة فهم العقّاد لشخصيّة معاوية أنّه لم يركِّز على ماهيّة فكر معاوية، أي على تكوين وعيه باتجاه تحقيق انقلاب في الدولة الإسلاميّة الناشئة لصالح مآربه الشخصيّة. ذلك أنَّ العقاد أراد إظهار معاوية بصفته إنسانًا مثقفًا وممتلكًا لقدرات لغويّة لا تقلّ عن نظرائه، دون أن يقدم نقدًا جادًّا لسياساته القمعيّة، أو تحليلٍ لانزياحه عن المشروع الإسلاميّ الأصيل. وهنا يغمز العقّاد من قناة الإمام، بمعنى أنَّ معاوية لا يقلّ بلاغة عن الإمام. ويتّضح من سياق كلام العقّاد أنّ بلاغة معاوية تتجلّى في ردّه على أمير المؤمنين، ولم يقم العقّاد بتحليل هذا الرد وأسبابه وما يقف وراءه من غايات. بل إنَّ تركيزه على “البلاغة السويّة” في خطاب معاوية يكشف عن فهم سطحيٍّ لطبيعة الخطاب السّياسيّ الأمويّ، أي أنّه لم يستقص ما تسبّب به خطاب معاوية في إحداث تغيير عميق في بنية المجتمع الإسلاميّ.
هكذا، يتضح أنَّ كِلا التوجّهين، الاستشراقيّ والعربيّ، أخفقا في قراءة معاوية قراءةً شموليّةً، فالأوّل تعمّد تشويه التّاريخ الإسلاميّ، والثاني وقع في فخّ الانبهار بالشكل على حساب المضمون.
لقد طغى خطاب معاوية، غربًا وشرقًا، على مستوى المثقّفين، وكان له تأثير اجتماعيّ كبير في نفوس الكثير من المسلمين، ما زال مستمرًّا إلى يوم النّاس هذا. ولقد بدأ تأثير معاوية منذ أن استطاع استقطاب الحشود التي وقفت إلى جانبه في حربه ضدّ الإمام عليّ، ومردّ ذلك إلى أنَّ معاوية كان قد صدر في مواقفه عن ثقة تامّة بمن حوله، تحديدًا العناصر البشريّة المكوّنة لجيشه المتماسك، في مقابل تفكك جيش الإمام، ولقد عبّر عن ذلك بوضوح تامّ في خطابه الموجّه الى حزبه قائلًا: “أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ رَأَيْتُمْ كَيْفَ صَنَعَ اللَّهُ بِكُمْ فِي حَرْبِكُمْ عَدُوَّكُمْ، جَاءُوكُمْ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّهُمْ سَيُقَيِّضُونَ بَيْضَتَكُمْ وَيُخَرِّبُونَ بِلَادَكُمْ، وَمَا كَانُوا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّكُمْ فِي أَيْدِيهِمْ، فَرَدَّهُمُ اللَّهُ بِغَيْظِهِمْ، لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا مِمَّا أَحَبُّوا، وَحَاكَمْنَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، فَحَكَمَ لَنَا عَلَيْهِمْ، ثمّ جَمَعَ لَنَا كَلِمَتَنَا وَأَصْلَحَ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَجَعَلَهُمْ أَعْدَاءً مُتَفَرِّقِينَ يَشْهَدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْكُفْرِ، وَيَسْفِكُ بَعْضُهُمْ دَمَ بَعْضٍ. وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَتِمَّ لَنَا هَذَا الْأَمْرُ. وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ تُحَاوِلُوا أَهْلَ مِصْرَ، فَكَيْفَ تَرَوْنَ ارْتِثَاءَنَا لَهَا؟”[14]
وهذا فضلًا عن زرعه لإيديولوجيا خاصّة به تقوم على تأصيل أفكاره، أي إنَّ معاوية استحضر في لغته الحقائق الدينيّة الميتافيزيقيّة الغائبة عن الحسّ المباشر ليوظّفها لصالح موقفه السّياسيّ – الرامي إلى التغيير السوسيولوجيّ للمجتمع الإسلاميّ.
يقول ويب كيني[15] في كتابه اللغة الدينيّة: “اللغة هي إحدى الوسائط التي يمكن بوساطتها جعل وجود ونشاط الكائنات غير المتاحة للحواس أمرًا ممكنًا، بل ومقنعًا، بطرق تكون متاحة بشكل عامّ ولكنّها أيضًا متاحة بشكل شخصيّ للأشخاص كأعضاء في مجموعات اجتماعيّة(…) اللغة الدينيّة متورّطة بعمق مع الافتراضات الأساسيّة حول مطامح الذات البشريّة. وفي الوقت نفسه، تواجه الأديان معضلات مزمنة تطرحها التوترات بين التعالي والطبيعة الواقعيّة والملموسة للممارسات اللفظيّة. ويعتمد الكثير على هذه الافتراضات والتوترات، لدرجة أن الكثير من المناقشات الدينيّة تدور حول الأشكال اللّغويّة. ويتصل الأمر بالشكل اللغويّ والبراغماتية.”[16]
هنا نلاحظ أنَّ معاوية استحضر في خطابه الحقائق الدينيّة العالية التي هي موضوع للإيمان النقي ليحوّلها إلى وسيلة لاستقطاب جمهوره، متوسِّلًا لغة تلبس لبوس الدين وتسعى إلى بلوغ مآرب نفعيّة أو براغماتيّة.
غير أنَّ أمير المؤمنين كان واعيًا وعيًا تامًّا بمرامي معاوية لتوظيف الدين في لغته لصالح أهدافه، فقد ردّ على كتاب معاوية الآنف الذكر الذي يطالب فيه أمير المؤمنين بأن يتّقي الله في دماء النّاس، وجاء ردّه على النحو الآتي:
“مِنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَتَتْنِي مِنْكَ مَوْعِظَةٌ مُوَصَّلَةٌ وَ رِسَالَةٌ مُحَبَّرَةٌ، نَمَّقْتَهَا بِضَلاَلِكَ وَ أَمْضَيْتَهَا بِسُوءِ رَأْيِكَ، وَ كِتَابُ اِمْرِئٍ لَيْسَ لَهُ بَصَرٌ يَهْدِيهِ، وَ لاَ قَائِدٌ يُرْشِدُهُ، دَعَاهُ اَلْهَوَى فَأَجَابَهُ وَ قَادَهُ اَلضَّلاَلُ فَاتَّبَعَهُ، فَهَجَرَ لاَغِطًا وَ ضَلَّ خَابِطًا، فَأَمَّا أَمْرُكَ لِي بِالتَّقْوَى فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، وَ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنْ أَنْ أَكُونَ مِنَ اَلَّذِينَ إِذَا أُمِرُوا بِهَا ﴿َأخَذَتْهُمُ اَلْعِزَّةُ بِالْإِثمّ﴾ وَ أَمَّا تَحْذِيرُكَ إِيَّايَ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلِي وَ سَابِقَتِي فِي اَلْإِسْلاَمِ فَلَعَمْرِي لَوْ كُنْتُ اَلْبَاغِيَ عَلَيْكَ لَكَانَ لَكَ أَنْ تُحَذِّرَنِي ذَلِكَ، وَ لَكِنِّي وَجَدْتُ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ﴿ فَقٰاتِلُوا اَلَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِيءَ إِلىٰ أَمْرِ اَللّٰهِ ﴾ فَنَظَرْنَا إِلَى اَلْفِئَتَيْنِ فَأَمَّا اَلْفِئَةُ اَلْبَاغِيَةُ فَوَجَدْنَاهَا اَلْفِئَةَ اَلَّتِي أَنْتَ فِيهَا، لِأَنَّ بَيْعَتِي بِالْمَدِينَةِ لَزِمَتْكَ وَ أَنْتَ بِالشّام، كَمَا لَزِمَتْكَ بَيْعَةُ عُثمّانَ بِالْمَدِينَةِ وَ أَنْتَ أَمِيرٌ لِعُمَرَ عَلَى الشّام، وَ كَمَا لَزِمَتْ يَزِيدَ أَخَاكَ بَيْعَةُ عُمَرَ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ أَمِيرٌ لِأَبِي بَكْرٍ عَلَى الشّام “[17]
يتّضح تمامًا أنَّ أمير المؤمنين كشف المكر الموجود في كتاب معاوية، فبدأ بتفكيك بنية خطابه حينما ردّ عليه بقوله: “فقد أتتني منك موعظة موصَّلة”، أي موعظة قام بوصلها من عبارات وعناصر مجموعة إلى بعضها بعضًا، دون أن يكون فيها تجانس واضح، وهذا دليل قاطع على أنَّ أمير المؤمنين قبض على ماهيّة تفكير معاوية، الذي انتحل شخصيّة الواعظ، ولكن مادة خطابه الوعظيّ ملفقة غير نابعة من فكر أصيل، بل إنَّ كتاب أو بالأحرى خطاب معاوية في مجمله – في رأي الإمام- قائم على فكر ضالّ مضلِّل. ولقد شخّص أمير المؤمنين القدرة التضليليّة في فكر معاوية. ورغم حدّة خطاب معاوية، واجه الإمام مضمونه بتواضع، فهو لم يبدِ أيّ انزعاج من أن يؤمر بالتّقوى، بمعنى أنّه لن يسمح لعزَّة نفسه أن تحول بينه وبين قبوله لأمرٍ موجَّهٍ له من أيّ إنسان يطلب منه أن يتّقي الله.
ويستأنف أمير المؤمنين كلامه في كتابه إلى معاوية قائلًا: “وَأَمَّا شَقُّ عَصَا هَذِهِ اَلْأُمَّةِ فَأَنَا أَحَقُّ أَنْ أَنْهَاكَ عَنْهُ، فَأَمَّا تَخْوِيفُكَ لِي مِنْ قَتْلِ أَهْلِ اَلْبَغْيِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَنِي بِقِتَالِهِمْ وَ قَتْلِهِمْ وَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّ فِيكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ اَلْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ وَ أَشَارَ إِلَيَّ وَ أَنَا أَوْلَى مَنِ اِتَّبَعَ أَمْرَهُ، وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ بَيْعَتِي لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّ أَهْلَ الشّام لَمْ يَدْخُلُوا فِيهَا، فَإِنَّمَا هِيَ بَيْعَةٌ وَاحِدَةٌ تَلْزَمُ اَلْحَاضِرَ وَ اَلْغَائِبَ لاَ يُسْتَثْنَى فِيهَا اَلنَّظَرُ وَ لاَ يُسْتَأْنَفُ فِيهَا اَلْخِيَارُ، وَ اَلْخَارِجُ مِنْهَا طَاعِنٌ وَ اَلْمُرَوِّي فِيهَا مُدَاهِنٌ، فَارْبَعْ عَلَى ظَلْعِكَ وَ اِنْزِعْ سِرْبَالَ غَيِّكَ وَ اُتْرُكْ مَا لاَ جَدْوَى لَهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ عِنْدِي إِلاَّ اَلسَّيْفُ ﴿حَتَّى تَفِيءَ إِلىٰ أَمْرِ اَللّٰهِ﴾ صَاغِرًا وَ تَدْخُلَ فِي اَلْبَيْعَةِ رَاغِمًا وَ اَلسَّلاَمُ.“[18]
يُستنبط من خطاب أمير المؤمنين أنّه يمتلك قدرة حجاجيّة كبيرة جدًّا، فهو لا يترك أيّ فكرة أو حجّة كان قد استخدمها معاوية، إلّا قام بتفنيدها أو بتقديم حجّة أقوى منها، وهذا دليل على أنَّ فكر معاوية كان واضحًا بالنسبة إلى الإمام من حيث غاياته، وهو واضحٌ في جوهره بالنسبة إليه. لكن ما دفعه إلى تقويض خطاب معاوية هو معرفته على نحو مسبق بأنَّ خطابه سيكون هدفه ليس إقناع أمير المؤمنين بصدقيّته؛ بل إقناع جمهور المسلمين، لذلك مواجهة الإمام الفكريّة لخطاب معاوية كان الهدف منها هو عدم تمكينه من خداع النّاس بما يدّعيه ويزعمه ويلفقه، لذلك كان لا بدّ من مقارعة الحجّة بالحجّة، وتقويض الأساس النظريّ الذي يقوم عليه خطاب معاوية.
وبالتعمّق في تحليل خطاب أمير المؤمنين إلى معاوية، نلاحظ أنّ الثنائيّات الضديّة تُشكِّل أساس الصراع المركزيّ بينهما، وهو صراع بين الحق والباطل. يُقيم أمير المؤمنين حجّته مفكّكًا ادعاءات معاوية باستخدامه لبنية حجاجيّة تعتمد على التضادّ المنطقيّ. فمن جهة، يؤكّد شرعيتّه عبر نسق البيعة الواحدة التي تلزم الحاضر والغائب “لَا يُسْتَثْنَى فِيهَا النَّظَرُ”، معارضًا بشكل حاسم فكرة انفصال الشّام سياسيًّا. ومن جهة أخرى، يُقابل اتهامات معاوية “تَحْذِيرُكَ إِيَّايَ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلِي” بتحويل الاتّهام إلى معاوية نفسه، عبر تصويره كـ “ضالٍّ” تَقوده الأهواء “لَيْسَ لَهُ بَصَرٌ يَهْدِيهِ”. وتعتمد البنية السرديّة في خطاب الإمام على تسلسل تفنيديّ مُحكم، يبدأ برفض خطاب معاوية “مَوْعِظَةٌ مُوَصَّلَةٌ بِضَلَالِكَ”، ثمّ بدعم الموقف بالنصّ القرآنيّ “فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي”، ويختتم بالتهديد الصريح “لَيْسَ لَكَ عِنْدِي إِلَّا السَّيْفُ”، ممّا يُشكِّل تصعيدًا دراميًّا من التجريد الدينيّ إلى التهديد الماديّ.
ولئن كان معاوية قد وظّف في كتابه الموجّه إلى أمير المؤمنين الآية الخامسة والستين من سورة الزمر ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾، من أجل توظيف الخطاب الإلهيّ لصالح مآربه، فإنَّ أمير المؤمنين أظهر في كتابه أسلوب معاوية المخادع، مبيّنًا الموقف الشرعيّ الذي يجب أن يتّخذه إمام المسلمين في مثل الوضع الذي تسبّب به معاوية، إذ استند إلى الآية التاسعة من سورة الحجرات ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حتّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين﴾، فعبارة ” فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي “ تردّ ردًّا واضحًا على دعاوى معاوية في مزاعمه بأنَّ أمير المؤمنين يسفك دم المسلمين.
والواقع أنَّ خطابي أمير المؤمنين ومعاوية كانا السبب في انقسام الوعي الجمعيّ الإسلاميّ فيما يتعلّق بقبول هذين الخطابين عند النّاس، فنجد فئة مؤيّدة لخطاب الإمام وفئة أخرى مؤيّدة لخطاب معاوية.
لكن يجب الانتباه إلى نقطة ذات أهميّة كبيرة هنا، وهي أنَّ خطاب كلّ من الإمام ومعاوية يهدف إلى إقناع النّاس ووقوع التصديق به، وهنا لا يهم -من الناحية الشكليّة- من كان على حقّ ومن كان على ضلال، بل المهم هنا هو الطاقة الموجودة في خطاب كلّ منهما التي تحمل من يصله خطابهما على الاقتناع بواحد منهما، لأنَّ الاقتناع بالخطاب هو أساس لما حدث من تحوّل أنثروبولوجيّ. ولذلك، لا بدّ من تحليل القدرة على الإقناع والتصديق في هذين الخطابين، نظرًا لما احدثاه من انقلاب سوسيولوجيّ وسيكولوجيّ في المجتمع الإسلاميّ. وهذا يمكن أن نجده في الخطب المباشرة أمام النّاس وليس في الرسائل المتبادلة ولهذه الخطب المباشرة دلالة انثربولوجيّة أقوى، لأنّها تقوم على الاتصال مع النّاس مباشرةً وتسهم في تغيير قناعاتهم على نحو يؤدّي إلى تغيير في سلوكهم. ولقد عكست الرسائل بين الإمام ومعاوية تحوّلًا أنثروبولوجيًّا من طقوس القرابة إلى طقوس السلطة والحرب، وتحوّلًا سوسيولوجيًّا من العصبيّة القبليّة إلى الهويّة الحزبيّة المتماهية مع الجماعة، وتحوّلًا سيكولوجيًّا من الولاء القائم على الدم إلى الولاء القائم على الإيمان الأيديولوجيّ، أي التّحوّل من النظام القبليّ القائم على العصبيّة والدم إلى النظام الحزبيّ المُؤسَّس على الانتماء السّياسيّ الدينيّ.
وبناءً عليه، شكّل الصراع بين أمير المؤمنين ومعاوية تحوّلًا جوهريًّا في المجتمع الإسلاميّ، إذ انتقلت الهُوية الجماعيّة من القبلية إلى الأيديولوجيا الحزبيّة. ولكن في العمق، مثّل معاوية استمرارًا للعقليّة القبليّة في إطار دينيّ، معتمدًا على سيكولوجيّة الخوف من التفكّك الاجتماعيّ، وخطاب يستحضر الذنب الجماعيّ والثأر، بينما أسّس الإمام لسيكولوجيّة الإيمان الثوريّ، رابطًا الطاعة بالثواب الآخرويّ. ولقد نجح معاوية في إعادة تشكيل الهويّة الجمعيّة لأهل الشّام وربطهم بدم عثمان، محوّلًا الانتماء القبليّ إلى ولاء أيديولوجيّ للحزب الأمويّ، بينما سعى الإمام لإعادة المجتمع إلى نسق البيعة الواحدة كشكل للعقد الاجتماعيّ، يدمج الدين بالسياسة.
هنا نجد قضيّة ذات أهميّة كبيرة، فيما يتّصل بالكتب المتبادلة بين أمير المؤمنين ومعاوية، وهي أنَّ فكريهما الموجودين في هذه الكتب هو في نهاية المطاف تعبير عن آراء كلّ منهما، وهذا ما تقوم اللغة بنقله، وبما أنَّ خطاب كلّ منهما يقوم على معان ومبان متشابهة بسبب تقمّص معاوية للخطابين الإلهيّ والرساليّ، فإنَّ الأولويّة في خطاب كلّ منهما لا يمكن تحديدها بالنسبة إلى المتلقي لكلا الخطابين، لأنَّ المسألة أصبحت منوطة بوظيفة اللغة.
وهنا يمكن الاستناد إلى ابن رشد، الذي ركّز على ما أسماه “الأخذ بالوجوه” في الخطب، وقد فسّر ابن رشد استخدام هذا الاسم “الأخذ بالوجوه” على أساس أنَّ الألفاظ وحدها غير كافية لتحقيق الغرض من الخطاب؛ بل لا بدّ أن يترافق مع جزالة الألفاظ ومتانة تركيبها وقدرتها على التعبير عن المعاني، البراعة في إفهام المتلقي ودفعه إلى التصديق وبلوغ المرام من الخطاب، وهذا ما يحدث التأثير المطلوب في النّاس من الخطاب.
ويُفصّل ابن رشد “الأخذ بالوجوه” على النحو الآتي: “وهذه الأشياء صنفان: إمّا أشكال، وإمّا أصوات ونغم. والأشكال منها ما هي أشكال للبدن بأسره، ومنها ما هي أشكال لأجزاء البدن كاليدين والوجه والرأس، وهذه هي أكثر استعمالًا عند المخاطبة. والأشكال بالجملة، يقصد بها لأحد أمرين: إمّا تفهيم المعنى وتخييله الموقع للتصديق، كما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-أنّه قال في آخر خطبة: “بُعثت أنا والساعة كهاتين”-وأشار بإصبعيه يقرنهما. وإمّا تخييل لانفعالٍ ما أو خلقٍ ما، وذلك إمّا في المتكلّم …وإمّا في المخبر عنه…”[19]
ويقصد ابن رشد من هذا الكلام أنَّ الخطيب يمكن أن يستند إلى حركات من أجزاء بدنه تعزّز قوّة خطبته بين المستمعين، هذا إذا كان يلقي الخطبة على الجمهور الموجود أمامه، وتدفعهم إلى التصديق كما فعل رسول الله (ص)، وكذلك الأمر في ما يتعلّق بالخطباء حينما يقومون بتخييل الهدف منه إقناع الحاضرين، كان يُظهر الخطيب نفسه حزينًا أو خائفًا أو غاضبًا، إذا كان يخبر عن قصّة معيّنة يصحّ فيها أحد هذه الانفعالات، وكذلك الأمر بالنسبة لمن يتحدّث عنه الخطيب، إذا كان خاضعًا لانفعال فيمكن تصويره من قبل الخطيب على هذا النحو من أجل شدّة التأثير في الحاضرين.
وأمّا فيما يتعلق بالنغم، فإن الخطيب إذا أراد الرحمة رقق صوته، أو إذا قصد الغضب عظّم صوته، ويمكن أن تكون غاية الخطيب تحريك السامعين نحو انفعال ما فيستخدم طبقات صوته لهذه الغاية، أو أنّه يريد إظهار كوامن نفوس المستمعين فيظهر طبقات صوتيّة تساعد على كشف نواياهم عن طريق سوقهم إلى انفعالات معيّنة.[20]
ويظهر هنا كلّ الظهور أنَّ ابن رشد يستعرض ما أسماه “الأخذ بالوجوه” من أجل تبيان كيفية إحداث الخطيب للتأثير في نفوس السامعين، والمهم ها هنا أنَّ الحقّ ليس مطلوب الخطيب، بل تتجلّى براعته في إيقاع التصديق في المقام الأوّل بصفته العامل الأساس الذي يمكن على أساسه استقطاب النّاس، فقد يكون الخطيب بعيدًا عن الحق، ولكن غايته الرئيسة هي جذب النّاس نحو الباطل، وهذا ممكن وموجود، فقد يوجد إنسان غير قادر على جذب النّاس إلى الحقّ، لأنّه لا يمتلك أدوات إقناعهم، وقد يوجد إنسان آخر قادر على جذب النّاس نحو الباطل لأنّه يمتلك أدوات الإقناع.
لكن المهم أنَّ ابن رشد يضع ملاحظة هامّة في هذا الاتجاه بقوله: “وينبغي أن تعلم أنَّ الأخذ بالوجوه ليس له غناء في الخطب المكتوبة، وإنّما غناؤه في المتلوّة. وإنّ عادة العرب في استعمالها قليلة…والأخذ بالوجوه إنّما هو نافع أكثر ذلك في الخطب التي تتلى على جهة المنازعة، لأنّه إنّما يُحتاج إلى الاستعانة بجميع الأشياء المقنعة في موضع المنازعة لتحصل الغلبة. وأمثال هذه الخطب هي الخطب التي كانت بين عليّ ومعاوية.”[21]
وعليه، يميّز ابن رشد بين الخطب المكتوبة والخطب المتلوّة، ويؤكد أنّه لا توجد فائدة من “الأخذ بالوجوه” في الخطب المكتوبة، لأنّه لا يمكن للخطيب عبر الكتابة أن يستخدم أجزاء من جسمه أو صوته للتعبير عن مراده من أجل الوصول إلى بغيته؛ لكن أدرك ابن رشد أنَّ الخطب المكتوبة بين أمير المؤمنين ومعاوية هي في حقيقة الأمر خطب متلوّة على النّاس، وتحوّلت إلى مراسلات بمعنى أنَّ مآخذ معاوية المفتعلة على أمير المؤمنين كان قد صرّح بها علانية أمام النّاس، وكذلك تبيان أمير المؤمنين لمثالب معاوية كان قد صرّح بها بالكلام أمام النّاس، وكتب التّاريخ مليئة بنماذج من هذا النوع.
هذا، ولا بدّ من التركيز على مسألة أساسيّة وهي أنَّ معاوية لم يوظّف الخطاب الإلهيّ والخطاب الرساليّ ضد أمير المؤمنين من أجل استمالة النّاس إلى حزبه فحسب؛ بل اختلق خطابًا رساليًّا نسبه إلى الرّسول (ص)، إذ وظّف بعض الصحابة والتابعين لوضع أحاديث كاذبة عن الرّسول (ص)، وكان الهدف منها استقطاب النّاس إليه وإبعادهم عن أمير المؤمنين.
روى ابن أبي الحديد أنَّ أبا جعفر الإسكافيّ المعتزليّ قال: “إنَّ معاوية وضعَ قومًا من الصحابة وقومًا من التابعين على رواية أخبار قبيحة عن عليّ، تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جُعْلًا يُرغب في مثله، فاختلقوا ما أرضاه، منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين عروة بن الزبير.”[22]
يتّضح هنا تمامًا أنَّ معاوية أراد أن يحارب أمير المؤمنين بأقوال الرّسول (ص)، وذلك من أجل أن يستنفر الشعور الدينيّ، تحديدًا عند أهل الشّام ضد الإمام، وطرحه بصورة عدوّ الإسلام الذي يجب الجهاد للتغلّب عليه.
ولقد نقل ابن أبي الحديد بعض هذه الأحاديث التي وضعها هؤلاء: “روى الزهري أنَّ عروة بن الزبير حدّثه، قال: حدّثتني عائشة، قال: كنتُ عند رسول الله إذ أقبل العبّاس وعليّ، فقال: يا عائشة، إنَّ هذين يموتان على غير ملّتي-أو قال ديني.”[23]
ولقد استطاع معاوية بالفعل أن ينجح في تحقيق هذا التّحوّل الأنثروبولوجيّ سوسيولوجيًّا وسيكولوجيًّا استنادً إلى وعيٍ تامّ بأنَّ خطابه وحده لن يكون كافيًا لإقناع جمهور المسلمين، فكان لا بد من استكمال خطابه الرئيس بخطابات فرعيّة تعد استئنافًا ضروريًّا له. لم يجد معاوية سلاحًا أو وسيلةً لتحقيق هذا الهدف إلّا بتوظيف الحديث النبويّ ضد أمير المؤمنين.
إذن، بدأ خطابٌ جديدٌ بالتشكّل على نحوٍ انبثاقيٍّ من خطاب معاوية، وأدّى هذا الخطاب إلى تكوين صورة سلبيّة عن الإمام عليّ، وبدأت إرهاصات هذا الخطاب في حياة الإمام واستمرّ في التطوّر والاتساع بعد رحيله، فأصبح الحديث النبويّ سلاحًا في يد معاوية ضدّه.
وقد روى ابن أبي الحديد “أن عروة “ابن الزبير” زعم أن عائشة حدثته، فقالت: كنت عند النبيّ(ص) إذ أقبل العبّاس وعليّ، فقال: “يا عائشة إن سرّك أن تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعا”، فنظرت، فإذا العبّاس وعليّ بن أبي طالب.”[24]
ولقد استغلّ معاوية وقعة الجمل، التي قادت فيها السيدة عائشة وطلحة والزبير بن العوام النّاس لمحاربة أمير المؤمنين[25]، وتمكّن من ضم المهزومين في هذه المعركة إلى حلفه السوسيولوجيّ، أي إلى الجماعة التي يعمل على تكوينها.
كما ومثَّل دور عمرو بن العاص في الصراع بين معاوية والإمام عليٍّ امتدادًا لاستراتيجيّةٍ سياسيّةٍ-دينيّةٍ هدفت إلى تفكيك شرعيّة الإمام عليّ عبر توظيف الخطاب الدينيّ نفسه. فإلى جانب دعمه العسكريّ والسّياسيّ لمعاوية، انخرط عمرو في حربٍ خطابيّةٍ مُمنهجةٍ، تمثّلت في تلفيق أحاديث تُناقض النصَّ القرآنيَّ الصريح، وتُشكِّك في ولاية عليٍّ الشرعيّة. ومن أبرز هذه الأحاديث المنسوبة إلى النبيّ(ص) ما رواه البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحيهما عن عمرو بن العاص، فقد قال ابن أبي الحديد: (وأمّا عمرو بن العاص فروى عنه الحديث الذي أخرجه البخاريّ ومسلم في صحيحهما مسندًا متصلًا بعمرو بن العاص، قال: ” سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنّ آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء إنّما ولييّ الله وصالح المؤمنين”).[26] وهو حديثٌ يُعارض بشكلٍ صريحٍ آية الولاية القرآنيّة: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ٥٥﴾(المائدة: 55)، التي نزلت في عليٍّ[27]، أراد معاوية هنا أن يناقض الخطاب الإلهيّ الذي يؤكّد على ولاية أمير المؤمنين بخطاب حديثيّ ملفق.
لم يقتصر هدف معاوية من هذا التوظيف مجرّد التشكيك في أسباب نزول الآيات، بل تخطاه إلى إعادة تشكيل الوعي الدينيّ الجماعيّ بما يخدم مشروعه السّياسيّ. فبدعم من السلطة الأمويّة، تمَّ تسويق هذه الأحاديث الملفّقة على أنها جزء من “السُنّة النبويّة”، لتُصبح أداةً لشرعنة رفض حقّ الإمام في الخلافة الشرعيّة، وتمهيد الطريق لمعاوية كي يُقدّم نفسه “أميرًا للمؤمنين”.
والحقيقة أنّ تأثير هذه العمليّة لم يقتصر على تشويه صورة الإمام عليّ في الوعي الجمعيّ ذي التموضوعات السيسيولوجيّة والسيكولوجيّة، بل أسّس لبنيةٍ اجتماعيّةٍ-دينيّةٍ جديدةٍ، تحوّل فيها الحزب الأمويّ إلى مركز الولاء المطلق. فمن خلال تكرار هذه الأحاديث في خطاب السلطة العامّ، نجح معاوية في غرس مشاعر العداء تجاه الإمام في نفوس المؤيّدين المخدوعين، الذين رأوا في معارضته للخليفة الشرعيّ جهادًا لحماية الإسلام من الفتنة.
وعليه، لا يزال الانزياح الأنثروبولوجيّ الذي أرساه معاوية في البنية الاجتماعيّة الإسلاميّة يُلقي بظلاله على الواقع إلى يوم الناس هذا. فبدعمٍ من صحابةٍ وتابعين استقطبهم، نجح في تشكيل تيّارٍ معقّد جمع بين القوّة العسكريّة والسياسة والثقافة والاقتصاد، بهدف إرساء دعائم مجتمعٍ جديدٍ يخدم ملكه. وقد تمكّن، عبر مراحل تاريخيّةٍ متعاقبةٍ وصولًا إلى يومنا الراهن، من تقديم نفسه كـ “أمير المؤمنين” منافسًا لشرعيّة الإمام، مستغلًّا إغداق الأموال على المؤيّدين، في مقابل تشويه صورة الإمام الذي رفض تحويل بيت المال إلى أداة لشراء الولاءات.
ولقد جسّدت الثنائيّة بين خطابي عليّ ومعاوية تناقضًا جوهريًّا في الرؤى، تحوّل مع الزمن إلى معيارٍ لتحليل شخصيّتيهما في الأدبيّات الإسلاميّة. لكنّ هذه الكتابات – للأسف – ظلّت أسيرة الانقسام المذهبيّ، فاختزلتهما في تصنيفاتٍ ضيّقةٍ ما بين مؤلّفات ناصبيّة أو مؤلفات رافضيّة، دون محاولةٍ جادّةٍ لفكّ التشابك بين البعدين التّاريخيّ والدينيّ. إلّا أنَّ “أبو حيّان التوحيديّ” يُعدّ استثناءً ملحوظًا؛ فقد قدّم، من خلال تأمّله الحياديّ للصّراع، قراءةً مغايرةً كشفت عن أبعادٍ جديدةٍ في شخصيّتيهما وخطابيهما، مُتجاوزًا الانزياحاتِ المذهبيّة ليرصد جذور الصراع في التناقض بين مشروعين: أحدهما يُقدّس الوحدة الإسلاميّة عبر العدالة، والآخر يُؤسّس للسلطة عبر الإغراء الماديّ.
قال أبو حيّان التّوحيديّ: “وكان معاوية جيّد الكلام، عجيب الجواب، عظيم الحلم، صبورًا على الخصم، معتادًا للكظم، ماضي الجنان، مفلق البيان، عارفًا بالدّنيا، متأتيًا لها، مالكًا لزمامها، جاذبًا لخطامها، راكبًا لسنامها؛ وكان عمرو بن العاص باقعة؛ وكان زياد أنكر القوم؛ وكان المغيرة لا يشقّ غباره، ولا تصطلى ناره؛ وليس عليّ كرم الله وجهه يجري في مضمارهم: عليٌ بحر علم، ووعاء دين، وقرين هدى، ومسعر حرب، ومدره خطْب، وفارج كرب، مضاف السبب إلى النسب، معطوف النسب على الأدب، ولكنَّ شيعته شديدة الخلاف عليه، قليلة الانتهاء إلى أمره، وكلهم الله إلى أمرهم، وإلى الله إيابهم، وعليه جزاؤهم وحسابهم.”[28]
لقد صدق التّوحيديّ في قوله أنّ شيعة الإمام كانت “شديدة الخلاف قليلة الانتهاء إلى أمره”، إذ الحقيقة أنّ الإمام عانى معاناة مريرة من تخاذل أتباعه عن تنفيذ أوامره، ورفضهم الانصياع لتوجيهاته ولقد عبر عن ذلك بخطابه الموجّه اليهم قائلًا: (…)واَللَّهِ لَقَدْ أَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْيِي بِالْعِصْيَانِ، ولَقَدْ مَلَأْتُمْ جَوْفِي غَيْظًا حَتَّى قَالَتْ قُرَيْشٌ: إِنَّ اِبْنَ أَبِي طَالِبٍ شُجَاعٌ ولَكِنْ لاَ رَأْيَ لَهُ فِي اَلْحَرْبِ(…)[29]، هذا، لأنّه كان ديمقراطيًّا وعادلًا بكلّ ما في الكلمة من معنى، فهو كان يصغي لآراء الآخرين حتّى لو كانت معارضةً لرأيه.
هذا، وحينما أوشك جيش الإمام على الانتصار في صفّين، لجأ معاوية بعد شعوره بالهزيمة إلى تغيير خطابه من خطابٍ تحريضيٍّ يدعو إلى إزاحة أمير المؤمنين إلى خطابٍ يدعو إلى تهدئة الحرب واخماد نيرانها. فخرج هو وعمرو بن العاص بدعوى التحكيم، ورفعوا المصاحف على الرماح من أجل شقّ صفوف أتباع الإمام من المسلمين تحت ذريعة الاحتكام إلى كتاب الله تعالى[30]. والحقيقة أنّنا نلاحظ هنا انقسامًا في جيش الإمام أفضى إلى انقسام سوسيولوجيّ بين أتباعه، وقاد إلى ظهور فرقة الخوارج بسبب خطاب معاوية التحكيميّ المستند الى مقولة “لا حكم إلّا لله”. وعلى هذا الأساس، انبثق تعين سوسيولوجيّ جديد في الدولة الاسلاميّة، هو تعين فرقة الخوارج جغرافيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، إذ كوّنوا تشكيلة اقتصاديّة اجتماعيّة بكلّ ما تعنيه هذه الكلمة من معنى.
وقد ذكر دونالد ليتل[31] حول الخطوات التي اتخذها معاوية لإحكام سيطرته على السلطة، قائلًا: “لقد أصبح من الواضح في عهد الخلفاء الأوائل أن التقاليد القبليّة وممارسات محمّد في المدينة المنورة لم تكن موارد كافية لإدارة إمبراطوريّة شاسعة. ولحل هذه المشكلة لجأ معاوية إلى الحل الذي كان في متناول يده في سوريا، وهو تقليد الإجراءات الإداريّة التي تطوّرت خلال قرون من الحكم الرومانيّ والبيزنطيّ هناك. على الرغم من أنّ العمليّة التي تمّت بها الاستعارة ليست معروفة تمامًا، فمن الواضح أنّ معاوية بدأ بعض الممارسات التي يبدو أنّها مستوحاة من التّقليد السّابق. في الأساس، كان يهدف إلى زيادة تنظيم ومركزيّة حكومة الخلافة من أجل ممارسة السيطرة على المناطق التي تتوسّع باطراد. وقد حقق ذلك من خلال إنشاء مكاتب-ديوان في دمشق لتسيير شؤون الحكم بكفاءة. تنسب المصادر العربيّة المبكرة ديوانين على وجه الخصوص لمعاوية: ديوان الختم، أو المستشاريّة، والبريد، أو الخدمة البريديّة، وكلاهما كان من الواضح أنّهما كانا يهدفان إلى تحسين الاتصالات داخل الإمبراطوريّة. مناصب بارزة داخل البيروقراطيّة الناشئة، وكان بعضهم ينتمي إلى عائلات خدمت في الحكومات البيزنطيّة. كان توظيف المسيحيّين جزءًا من سياسة أوسع للتسامح الدينيّ، والتي استلزمها وجود أعداد كبيرة من السكان المسيحيّين في المقاطعات المفتوحة، وخاصّة في سوريا نفسها.[32]
يتبيّن أنَّ معاوية استطاع أن يغيّر البنية السّوسيولوجيّة للمجتمع الإسلاميّ، تحديدًا في الشّام، بسبب انفتاحه على طريقة الإدارة والحياة على الطريقة البيزنطيّة، وازداد هذا التغيير في المجتمع الإسلاميّ لأسباب مختلفة.
لقد شهدت الدولة الإسلاميّة تحوّلات سوسيولوجيّة وجغرافيّة هامّة، فالبصرة بعد حرب الجمل أصبحت بيئة حاضنة لعداء أمير المؤمنين، ومركزًا لمجموعة بشرية تكنّ عداء شديدًا له. بالإضافة إلى ذلك، شكّلت الشّام، معقل معاوية، بيئة معادية ضمّت أناسًا مشحونين إيديولوجيًّا ضد الإمام وكانوا بمثابة الخزان البشريّ الذي استخدمه معاوية في جيشه. ومع ظهور فرقة الخوارج وانتشارها لاحقًا في الأمصار تحديدًا في العراق، نشأ تموضع سوسيولوجيّ جغرافيّ جديد يضمّ أناسًا امتلكوا لا وعيًا جمعيًّا ضد الإمام، بسبب التربية والايمان الدينيّ المغلوط.
وهكذا، أخذ خطاب معاوية أبعادًا سوسيولوجيّة مؤثرة في النّاس، على نحو أدّى إلى ظهور كيانات اجتماعيّة جديدة داخل الدولة الإسلاميّة توجّهها الصراعات الإيديولوجيّة.
ثالثًا: وثيقة التّحكيم وأثرها في التّحوّلات الانثروبولوجيّة للمجتمع الاسلاميّ
كان أمير المؤمنين قد عوَّل على الكوفة بصفتها مدينة يسودها اجتماع بشريّ تحكمه معايير دينيّة وثقافيّة ونفسيّة وجد فيها أساسًا لتطوير مجتمع صالح، بصفته ليكون بمثابة عاصمة دولة الخلافة الإسلاميّة في مواجهة دمشق الأمويّة ذات النزعة البيزنطيّة، وهذا ما يفسر انتقال أمير المؤمنين إلى الكوفة.
ولكن الانقسام الاجتماعيّ في جيش أمير المؤمنين بسبب خطاب معاوية التحكيميّ، لم يسمح للإمام بأن يحقّق هذا الأمل، وذلك أن فئة من جيشه طالبت بضرورة إجراء التحكيم، ورغم معارضته إلّا أنّه اضطر في النهاية لمجاراة هذه الفئة ووقعت وثيقة التحكيم، وعرضت على النّاس كافّة من جيش عليّ وجيش معاوية وممّا نصّت عليه:
“بسم الله الرحم الرحيم، هذا ما تقاضى عليه عليّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، قاضى عليّ على أهل الكوفة ومن معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين، وقاضى معاوية على أهل الشّام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين، أنّا ننزل عند حكم الله عز وجل وكتابه ولا يجمع بيننا غيرها وانّ كتاب الله عز وجل بيننا من فاتحته إلى خاتمته نحيي ما أحيا ونميت ما أمات فما وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل وهما أبو موسى الاشعري عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص القرشي عملا به وما لم يجدا في كتاب الله عز وجل فالسُّنة العادلة الجامعة غير المفرقة“.[33]
تعد وثيقة التحكيم بين الإمام عليّ ومعاوية (37 ه/657 م) لحظةً مفصليّةً في تاريخ التشكيل الاجتماعيّ-السّياسيّ الإسلاميّ، وخطابًا جديدًا موجهًا للجيشين، أو بالأحرى للمجتمع الإسلاميّ المنقسم على نفسه. وهذا الخطاب الجديد الذي هو وثيقة التحكيم، أزاح كلًّا من خطاب الإمام عليّ وخطاب معاوية إذ فقد جيش الإمام حماسته للحرب وغاب شعور أفراده بأنّهم على حق. وقد جاء خطاب التحكيم أي الفكر الذي قدّمه هذا الخطاب للناس رديفًا لخطاب معاوية ضد أمير المؤمنين، خصوصًا بعد أن خلع أبو موسى الأشعريّ أمير المؤمنين من الولاية، وثبّت عمرو بن العاص معاوية على ولاية المسلمين.
ولقد شكّلت وثيقة التحكيم نقطة تحوّل أنثروبولوجيّة جذريّة في المجتمع الإسلاميّ، حيث انتقلت الولاءات من الهُويّة القبليّة، إلى تحالفاتٍ جغرافيّة سياسيّة، عكست تبلور كياناتٍ حزبيّة -شيعة عليّ وشيعة معاوية- قائمة على مشاريع أيديولوجيّة.
وعليه، تحوّل القرآن والسنّة إلى حقل صراع رمزيّ، ففي حين قُدّم القرآن كحكم محايد، أصبح تفسيره أداةً لتكريس الانقسام. وبالمثل، كشفت الإشارة إلى السنّة العادلة في نصّ الوثيقة “فالسُّنة العادلة الجامعة غير المفرّقة” عن صراعٍ خفيّ حول تعريفها. وأيضًا مثَّلت الوثيقة لحظة تأسيسيّة في ولادة الإسلام السّياسيّ، حيث أُعيد توظيف الدين كأيديولوجيا لصياغة الولاءات من القبيلة إلى الحزب. وكان أبرز تجليّات هذا التّحوّل هو انتقال أهل الشّام وأهل الكوفة إلى كياناتٍ سياسيّةٍ مُستقلّة، لم تعد القبيلة هي النواة، بل المشروع الأيديولوجيّ القائم على تفاسير دينيّة متباينة.
وفي حين كشف فشل التحكيم عن استحالة التوفيق بين النموذجين التقليديّ والثوريّ، فقد أنتج صراعًا تأويليًّا لا يزال يُشكّل الوعي الإسلاميّ إلى اليوم. فالتحكيم لم يُنه الصراع، بل حوَّله إلى أزمة شرعيّة دائمة، مهَّدت لتحوّل الخلاف السّياسيّ إلى انقسامٍ طائفيّ مُتوارث. كما وتُظهر الوثيقة نافذةً أنثروبولوجيّة لفهم كيف بدأ الإسلام السّياسيّ يُنتج بنىً اجتماعيّة جديدة، تعكس تفاعل الدين مع السياسة في تشكيل الهُويّات والسلطة.
هنا انبثق خطاب الخوارج الرافض للتحكيم، بعد مطالبتهم به وإجبار الامام على قبوله، فطلبوا منه أن يتوب إلى الله وأن يعترف بكفره بقبول تحكيم الرجال، فردّ عليهم الامام قائلًا:
“إِنَّا لَمْ نُحَكِّمِ الرِّجَالَ، وَإِنَّمَا حَكَّمْنَا الْقُرْآنَ. وهذَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْتُورٌ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ لاَ يَنْطِقُ بِلِسَانٍ، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ، وَإِنَّمَا يَنْطِقُ عَنْهُ الرِّجَالُ… أُفٍّ لَكُمْ! لَقَدْ لَقِيتُ مِنْكُمْ بَرْحًا، يومًا أُنَادِيكُمْ وَيومًا أُنَاجِيكُمْ، فَلاَ أحْرارُ صِدْقٍ عِنْدَ النِّدَاء، وَلاَ إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْدَ النَّجَاءِ!”[34]
وهنا لم يجد الإمام عليّ بُدًّا من مواجهة هذه الفئة المنشقة عنه، والتي قد تؤدّي بإثارتها للفتنة إلى خلخلة صفوف جيشه. وحاول منع حدوث انقسام في جيشه يتسبب في صراع اجتماعيّ ومذهبيّ، لكن باءت محاولاته معهم بالفشل. ولذلك، لم يستسلم للأمر الواقع ولم يتركهم ليستمرّوا في غيّهم وضلالهم، أعني الخوارج، ولهذا خاض ضدّهم حرب النهروان التي أُبيد فيها غالبيّتهم.[35]
والحقيقة أنّ الإمام عليّ، عبر تفكيكه العصبيّة القبليّة وتركيزه على القرآن كرمز مركزيّ للشرعيّة “حَكَّمْنَا الْقُرْآنَ”، يؤسّس لبنية جديدة تقوم على ثنائيّة النصّ/التأويل، ليُصبح القرآن مرجعيّة مطلقة، ولكن يحتاج إلى ترجمان بشريّ، هو أمير المؤمنين نفسه. فتتحوّل السلطة من الزعامة القبليّة إلى المرجعيّة الدينيّة-السّياسيّة، في إعادة لتشكيل الولاءات حول هويّة حزبيّة “شيعة عليّ” تُعارض الخوارج وأنصار معاوية. هذه الثنائيّة – النصّ/التأويل – تُنتج بدورها ثنائيّات فرعيّة: الإيمان/الرفض، العدل/الظلم، الوحدة/التمرّد، حيث يُصوّر خطاب الإمام الخوارج كـ “انزياح بنيويّ” عن النظام الجديد بسبب رفضهم الوساطة التأويليّة للإمام، بينما يُقدّم الإمام نفسه كمركز دلاليّ يُوحّد بين النصّ المقدّس والتطبيق السّياسيّ.
وأمّا بعد فتنة الخوارج فنجد تحوُّلًا في خطاب الإمام، إذ بدأت ثقته بأتباعه تضعف إلى أبعد حد، فوضع أسسًا نظريّة لخطاب جديد، الهدف منه هو إعادة أصحابه إلى جادة الصواب، فلم يعد خطابه مقتصرًا على معاوية وحده ولا الخوارج وحدهم بل وجد نفسه مضطرًّا الى ابتكار خطاب جديد لضمان عدم انفضاض أتباعه من حوله.
هنا اكتشف أمير المؤمنين بدء تفكّك معسكره وتراجع أنصاره بعد معركة النهروان، فلم تعد المعاناة التي عاناها من كيد معاوية وحزبه وخروج الخوارج ومروقهم؛ بل أصبحت هذه المعاناة أضعافًا مضاعفة بتخاذل النّاس عن الجهاد، واستسلامه للأمر الواقع.
لقد أدّت فتنة الخوارج الى صدع سوسيولوجيّ وسيكولوجيّ في المجتمع المؤيّد لأمير المؤمنين، وانتشرت دعوة الخوارج واستمرّت في المرحلة الأمويّة، ولم يقتصر الأمر على انشقاق الخوارج وحدهم. لقد ثارت جماعات أخرى على أمير المؤمنين، إذ إنّ الخطاب الخارجيّ الذي دان الإمام عليّ لقبوله التحكيم لاقى صدى في صفوف جيشه عند أناس من غير الخوارج المعروفين بالحروريّين.
وعليه، نستنتج أنَّ هناك حركات تمرّد متعدّدة على الإمام عليّ، كان أكثرها إيلامًا حركة الخذلان الّتي فاشت بين صفوف جيشه، وترجع بوجه عامّ إلى توّلد خطاب جديد بسبب الفتنة. وبدأت نظريّة سياسيّة جديدة بالظهور تحوّلت إلى خطاب سياسيّ كان له تأثيره الفاعل دائمًا، ليس فقط في ظلّ دولة الإمام بل في المرحلتين الأمويّة والعبّاسيّة.
ذلك أنَّ “الخوارج وضعوا نظريّة خلع الإمام الجائر، واستعاضوا عن مبدأ القرشيّة في الإمامة، بمبدأ الجدارة وساووا بين المسلمين في تولّي الإمامة أيّن كان جنسهم ولونهم، وبين الرجل والمرأة. فالإمامة للأحق، وقد يكون هذا الأحق من غير قريش ولهذا الموقف جذور في بعض ما يؤثر عن عليّ…ويؤثر في هذا الصدد أنَّ عليًّا قال مرة لعثمّان في حديث طويل: ضعفت ورققت على أقربائك قال عثمّان: هم أقرباؤك أيضًا. فقال عليّ: لعمري إن رحمهم مني لقريبة، ولكن الفضل في غيرهم. وفي هذا ما يشير إلى أن النسب القرشيّ لم يكن في نظر عليّ موضع فضل بالضرورة، وأن الدين هو هذا الموضع.”[36]
لقد أضاء أدونيس على فكرة مهمّة جدًّا وهي أنّه رغم تمرّد الخوارج على الإمام عليّ إلّا أنّ فكرهم المتصل برفض قرشيّة الخليفة-إمام المسلمين مُستفاد من عليّ أصلًا، لأنّه حارب على امتداد حياته المشركين في الجاهليّة والمستأثرين بالحكم من قريش في الإسلام. علاوة على مواجهته الشديدة للقرشيين إذا اختلسوا مالًا أو طالبوا بما لا يستحقوه من بيت مال المسلمين (الزبير، طلحة، عقيل بن أبي طالب) وهذا يدلّ على أنّ الخطاب الخَارجِيّ في ما يتعلّق بنزع القداسة عن القرشيّين كان نابعًا بطريقة أو بأخرى من عدالة أمير المؤمنين التي استفادها من رسول الله(ص)، إذ إنّ النّاس سواسية كأسنان المشط وهذا يتّسق مع قوله تعالى﴿…إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ…﴾ الحجرات:13.
ويجب أن نفهم هذه المسألة على أساس أنّ امير المؤمنين لم يقبل بإعادة تظهير الطبقة الأرستقراطية القرشيّة التي حاربها مع رسول الله(ص) من بدر إلى فتح مكّة، لأنّ مفهوم القبيلة أصلًا عاود الظهور بعد موت الرّسول (ص)، وتجلّى ذلك في استئثار قبائل قريش بالحكم إلى أن انفرط مفهوم القبيلة وتحوّل إلى مفهوم الحزب أو الشيعة( شيعة عليّ وشيعة معاوية). ولكن تقود نتائج البحث إلى أنّ انفضاض النّاس من حول أمير المؤمنين يدلّ على أنّه لم يكن ساعيًا إلى تكوين حزب بالمعنى الذي سعى إليه معاوية؛ بل كان هدفه إحياء دولة الإسلام، لكن التمزّق الاجتماعيّ حال بينه وبين تحقيق هذا الهدف. فالإمام كان خليفة لكلّ المسلمين ولم يستنسب حزبًا لصالحه وفي المقابل نجح معاوية بخطابه الالتوائيّ بأن يكوّن حزبًا خادمًا لبني أميّة، تجلّى في توظيف إمكانيّات الدولة الإسلاميّة لصالح الملك العضوض الأمويّ. وعلى هذا الأساس ظهرت كيانات اجتماعيّة توزّعت على رقع جغرافيّة متعددة، وحمل سكانها موروثًا ثقافيًّا سيكولوجيًّا أو بالأحرى حملوا موروثًا يجب أن يكون موضوعًا للأنثروبولوجيا الثقافيّة التي يمكن أن تبحث في تكوين الوعيّ الثقافيّ ذي الجذور الدينيّة والمحدد لمسارات الخطابات السّياسيّة. لقد انفض النّاس من حول الإمام عليّ ولم يجد نفعًا خطابه التأديبيّ.
خاتمة
إنّ التّحوّلات الأنثروبولوجيّة السوسيولوجيّة والسيكولوجيّة التي شهدها المجتمع الإسلاميّ خلال مرحلة الصراع بين الإمام عليّ ومعاوية، أفضت إلى انتقال الولاء من القبيلة إلى الحزب الأيديولوجيّ، حيث استثمر معاوية خطابه المعقّد، المدعوم باستمالة النخب وتوظيف الدين، لإحداث انقلاب في وعي المسلمين وعاداتهم، جاذبًا إيّاهم نحو نمط حياة مدنيّ وبيزنطيّ مغاير لقيم الزهد والتقوى التي أرساهما الرسول الأكرم والإمام. في المقابل، واجه الإمام عليّ هذا الخطاب المضاد بحجج قويّة وكشف لمغالطات معاوية، إلّا أنّ خطاب معاوية نجح في إحداث انقسام عميق تجلّى في ظهور كيانات اجتماعيّة وسياسيّة مختلفة وولاءات جديدة في المجتمع الإسلاميّ لم تكن موجودة في الزمن النبويّ.
بنيويًّا، يمكن قراءة هذا الصراع كديناميّة تأسيسيّة لإعادة ترميز الهويّة الجمعيّة الإسلاميّة، حيث يمثّل خطاب الإمام بنية دلاليّة متماسكة تسعى لتثبيت مرجعية النصّ الدينيّ والقيم الأخلاقيّة، بينما يشتغل خطاب معاوية كبنية تفكيكيّة تقوّض هذه المرجعيّة عبر استراتيجيّات تضليليّة وتوظيف براغماتيّ للدين. هذا التنازع الخطابيّ، كثنائيّة ضديّة بين خطاب الحق والباطل، حيث سعى كل طرف إلى فرض نسقه الدلاليّ الخاص على المتلقّي، نجح خطاب معاوية، من خلال استغلاله لثغرات البنية الاجتماعيّة القائمة، وخصوصًا جاذبيّة النمط المدنيّ في الشّام، في إنتاج بنية خطابيّة مهيمنة تعمل على إعادة تشكيل الوعي الجمعيّ وتوجيهه نحو ولاء حزبيّ، أدّى إلى إعادة هيكلة عميقة للبنية الاجتماعيّة والسّياسيّة في صدر الإسلام.
وعليه، يُعدّ الصراع بين الإمام عليّ ومعاوية نقطة تحوّل أنثروبولوجيّ أعادت تشكيل البنى الاجتماعيّة والنفسيّة للمسلمين. فقد سعى أمير المؤمنين للحفاظ على النموذج النبويّ القائم على العدل، بينما نجح معاوية في تأسيس نظام سياسيّ براغماتيّ، موظفًا الدين لخدمة السلطة. هذا التّحوّل لا يزال يشكل الوعي الإسلاميّ حتى اليوم، ممّا يظهر قوّة الخطاب السّياسيّ في صناعة الهويّات وتغيير المسارات التّاريخيّة.
المصادر والمراجع
| 1. القرآن الكريم. |
| 2. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمّد ابو الفضل إبراهيم، دار الكتاب العربيّ-بغداد؛ الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت، 2007م. |
| 3. ابن خياط، أبي عمرو خليفة الشيباني العصفري البصري (ت:240ه)، تاريخ خليفة بن خياط، راجعه وضبطه ووثقه ووضع حواشيه وفهرسه: مصطفى نجيب فواز وحكمت كشلي فواز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1995م. |
| 4. ابن كثير، الحافظ، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، ج7، بيروت، 1985م. |
| 5. ابن رشد، أبو الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ت: 595هـ) تلخيص الخطابة، حققه وقدّم له: عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات-الكويت؛ دار القلم-بيروت، لا.ت. |
| 6. ابن هشام، السيرة النبويّة، علّق عليها، وخرّجَ أحاديثها، وصنع فهارسها: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربيّ، بيروت، ط3، 1990م.
7. البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر، كتاب جمل من أنساب الأشراف، ج5، حققه وقدّم له: سهيل زكار ورياض زركلي، دار الفكر، دمشق، 1996م. |
| 8. التوحيدي، أبو حيّان، البصائر والذخائر، م1، ج2، تحقيق: وداد القاضي، دار صادر، بيروت، ط1، 1988م. |
| 9. الطبري، أبو جعفر محمّد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، ج2، راجعه وصححه وضبطه: نخبة من العلماء الأجلاء، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 1939م. |
| 10. العقاد، عبّاس محمود، معاوية بن أبي سفيان، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2013م. |
| 11. المبرد، أبو العبّاس محمّد بن يزيد، الكامل، ج1، عارضه بأصوله وعلّق عليه: محمّد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، لات. |
| 12. أدونيس، الثابت والمتحول: بحث في الابداع والاتباع عند العرب، ج1، دار الساقي، بيروت، ط11، 2019م. |
| 13. ديورانت، ول، قصة الحضارة، ج2، م4 (عصر الإيمان)، ترجمة: محمّد بدران، اختارته وأنفقت على ترجمته الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربيّة، القاهرة، لا ت. |
| 14. صحيح مسلم بشرح النووي، ج6، دار الكتاب العربيّ، بيروت، 1987م. |
| 15. صفوت، أحمد زكي، جمهرة رسائل العرب في عصور العربيّة الزاهرة، ج1، القاهرة، 1938م. |
فهرس المصادر والمراجع الأجنبية
- Keanep, Webb, RELIGIOUS LANGUAGE, Annu. Rev. Anthropol. 1997. Copyright © 1997 by Annual Reviews Inc.
- Muʿāwiyah I Umayyad caliph, Britannica, https://www-britannica-com.translate.goog/biography/Muawiyah-I.
[1] طالب دكتوراه في اللّغة العربيّة وآدابها، كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة الجامعة الإسلاميّة في بيروت.
[2] راجع: ابن كثير، الحافظ، البداية والنهاية، الحافظ، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، 1985، ج7، ص: 307-308.
[3] راجع: ابن كثير، البداية والنهاية، ج9، ص:586.
[4] راجع: م.ن.، ج11، ص:463.
[5] -ابن خياط، أبي عمر خليفة، تاريخ خليفة بن خياط، راجعه وضبطه ووثقه ووضع حواشيه وفهرسه: مصطفى نجيب فواز وحكمت كشلي فواز، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995، ص: 141.
[6] -البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر، جمل من كتاب أنساب الأشراف، ج5، حققه وقدّم له: سهيل زكار ورياض زركلي، دار الفكر، دمشق، لا ت، ص: 407.
[7] راجع: تاريخ ابن خياط، م.س.، ص: 154.
[8] – جمهرة رسائل العرب، ج1، ص: 416-417. وانظر أيضًا: شرح ابن أبي الحديد، م3، ص: 302.
*هذا ما سيكشفه امير المؤمنين في رده على معاوية.
[9] ويليام جيمس ديورانت (William James Durant) (1885–1981) هو مُؤرِّخ وفيلسوف وكاتب أمريكي، اشتُهر بأعماله الضخمة التي تجمع بين الفلسفة والتاريخ، واعتمد فيها أسلوبًا أدبيًّا سلسًا يجعل المعرفة في متناول الجمهور العام. تعاون مع زوجته أرييل ديورانت (Ariel Durant) في تأليف معظم أعماله البارزة، خصوصًا سلسلة “قصة الحضارة” التي تُعد إنجازه الأبرز
[10] -ديورانت، ول، قصة الحضارة، ج2، مج4 (عصر الإيمان)، ترجمة: محمّد بدران، اختارته وأنفقت على ترجمته الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربيّة، القاهرة، لات، ص:81.
[11] راجع: ابن هشام، السيرة النبويّة، ج 2، ص 412؛ الطبريّ، تاريخ الأمم والملوك، ج 3، ص 61.
[12] جمهرة رسائل العرب، ج1، ص: 340-341. وانظر أيضًا: ابن عبد ربه الأندلسي، العقد الفريد، تحقيق: مفيد محمّد قمحية، بيروت، دار الكتب العلمية، ج2، ص:233. وشرح نهج البلاغة، مج3، ص:300، مج1 ص248. وابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج1، ص:71.
[13] -انظر: العقاد، عبّاس محمود، معاوية بن أبي سفيان، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2013، ص:106.
[14] -الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص: 74.
[15] ويب كيني أستاذ جامعي أميركي – معاصر – في قسم الأنثروبولوجيا بجامعة ميشيغان، حاصل على منحة جورج هربرت ميد. وهو عضو في قسم الأنثروبولوجيا بفرعيه الاجتماعي والثقافي واللغوي، بالإضافة إلى البرنامج متعدد التخصصات في الأنثروبولوجيا والتاريخ ومركز دراسات جنوب شرق آسيا.
[16] – See: Keane, Webb, RELIGIOUS LANGUAGE, Annu. Rev. Anthropol. 1997. 26:47–71. Copyright © 1997 by Annual Reviews Inc.
[17]-جمهرة رسائل العرب، ج1، ص: 417-418.
[18] -م.ن.، ص: 418-419.
[19] -ابن رشد، تلخيص الخطابة، حققه وقدّم له: عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات-الكويت؛ دار القلم-بيروت، لا ت، ص: 250.
[20] -م.ن.، ص: 251.
[21] -م.ن.، ص: 251-252.
[22] – شرح نهج البلاغة، مج2، ص: 263.
[23] -م.س.، ص: 263.
[24] م.ن، ص: 263.
[25] راجع: شرح نهج البلاغة، مج3، ص 5-6، ص: 307.
[26] -م.ن.، ص:263.
[27] انظر: الزمخشريّ في تفسيره، الكشاف، ص: 297. وانظر: السيوطيّ في تفسيره، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ص: 359-363.
[28] -التّوحيديّ، البصائر والذخائر، م1، ج1، ص:172.
[29] المبرد، أبو العبّاس محمّد بن يزيد، الكامل، ج1، عارضه بأصوله وعلّق عليه: محمّد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، لات، ص: 20.
[30] الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص: 37.
[31] أستاذ بمعهد الدراسات الإسلامية، جامعة ماكجيل، مونتريال، مؤلف كتاب “مقدمة في التأريخ المملوكي”.
[32]Muawiyah I Umayyad caliph, Britannica, https://www-britannica-com.translate.goog/biography/Muawiyah-I.
[33] -الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج5، ص53.
[34] شرح نهج البلاغة، مج4، ص:262.
[35] انظر: صحيح مسلم للنيسابوري، ص: 1773.
[36] -ادونيس، الثابت والمتحوّل: بحث في الابداع والاتباع عند العرب، ج1، دار الساقي، بيروت، ط11، 2019م، ص:235.


