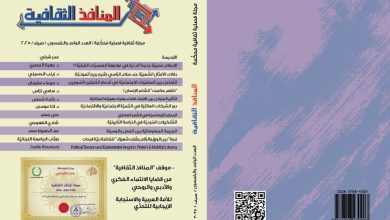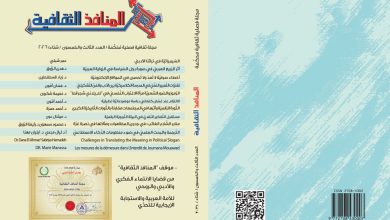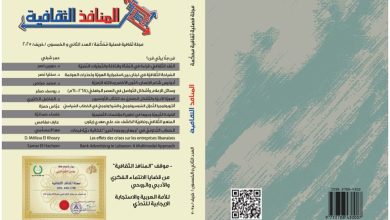استهلاك اللّبنانيّين في الأعياد وانعكاسه على التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة
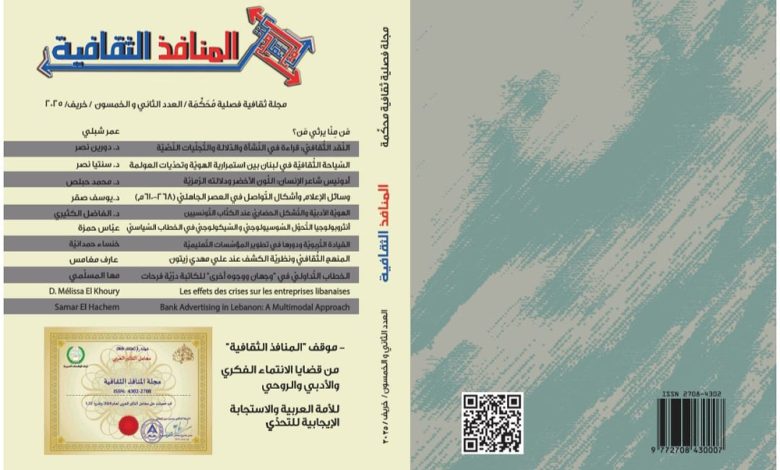
استهلاك اللّبنانيّين في الأعياد وانعكاسه على التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة
Lebanese Consumption Patterns During Holidays and Their Implications for Social and Economic Development
د. لانا جرجي موسى
Dr. Lena Moussa
تاريخ الاستلام 20/ 6/ 2025 تاريخ القبول 20/ 7/2025
الملخّص
يتناول هذا البحث موضوع استهلاك الأسر اللّبنانيّة خلال المناسبات الدّينيّة والاجتماعيّة في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة التي تمرّ بها البلاد منذ عام 2019، مع التّأثيرات المترتّبة في جائحة كورونا. يسلّط البحث الضّوء على العوامل المؤثّرة في نمط استهلاك الأسرة خلال الأعياد، بما في ذلك المكانة الاجتماعيّة والمستوى الاقتصاديّ ودور وسائل التّواصل الاجتماعيّ في توجيه خيارات المستهلك.
اعتمد البحث المنهج النوعيّ لتحليل السّلوك الاستهلاكيّ وتحديد انعكاسه على التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، حيث أظهرت النّتائج أنّ نمط الاستهلاك يسهم في تنشيط الحركة الاقتصاديّة وخلق فرص العمل، لكنّه قد يؤدّي إلى تعميق الفوارق الاجتماعية. لذا، يوصي البحث بضرورة ترشيد الاستهلاك وتوجيهه بما يحقّق التّنمية المستدامة ويخفّف من التّفاوت الاجتماعيّ.
الكلمات المفتاحيّة: الاستهلاك – الإنفاق – التّنمية – الاجتماعيّة – الاقتصاديّة – العيّنة.
Abstract
This study critically examines the consumption patterns of Lebanese households during religious, social, and official occasions, particularly in the context of the multifaceted economic crisis that Lebanon has been experiencing since 2019, exacerbated by the COVID-19 pandemic. The research aims to identify the determinants influencing consumption behaviors during festive periods, with particular emphasis on socio-economic factors such as income level, occupational status, and the impact of social media platforms on consumer decision-making processes. Employing a qualitative research methodology, the study integrates direct observations, interviews, and commentary analyses to provide a comprehensive understanding of consumption dynamics. The findings indicate that while consumption during holidays serves as a catalyst for economic activity and employment generation, it simultaneously poses challenges by reinforcing social stratifications and inequalities. Consequently, the study advocates for consumption rationalization strategies that align with sustainable social and economic development goals, fostering equitable growth and social cohesion.
Keywords: Consumption – Expenditure – Development – Social – Economic – Sample.
المقدّمة
يسهم نمط استهلاك الأسر خاصّةً خلال المناسبات الدّينيّة والاجتماعيّة والرّسميّة إلى حدٍّ ما في تنشيط الحركة التّجاريّة والسّياحيّة والخدماتيّة التي تشتهر بها الأسواق اللّبنانيّة من حيث جودة وتنوّع الخدمات والسّلع التي تقدّمها للمستهلك على اختلاف القدرات المادّيّة والتّنوّع الثّقافيّ والدّينيّ لدى المجتمع اللّبنانيّ؛ إذ يعطي اللّبنانيّ اهتمامًا كبيرًا لشكله الخارجيّ حيث يسعى إلى ارتداء أجمل الملابس ذات العلامات التّجاريّة المشهورة، ويتأنّى فيما يقدّمه لضيوفه من مأكولات ومشروبات وحلويّات مميّزة وثمينة، ويحرص على إضفاء جوّ من الفخامة على إحياء المناسبة من لباقة وتنسيق وزينة وأوان فاخرة… وينفق الكثير من الأموال للحصول على الإصدارات الحديثة والعلامات التّجاريّة العالميّة المعروفة… مهما كانت التّبعات المادّيّة والضّغوطات النّفسيّة التي ترافق نمط الاستهلاك هذا…
إلّا أنّ التّغيّرات الاقتصاديّة والصّحيّة التي طرأت على المجتمع اللّبنانيّ منذ العام 2019 خاصّة مع انتشار فايروس كورونا، أدّت إلى تغيّرات في نمط الاستهلاك لدى اللّبنانيّين؛ فمظاهر التّفاخر التي اعتاد اللّبنانيّون على الاهتمام بها وإبرازها ما عادت هدفًا للاستهلاك، فاللّبنانيّ الذي كان «يتديّن ليتزيّن» أصبح هدفه من الاستهلاك الحصول على أبرز مقوّمات العيش من مأكل وملبس ودواء واستشفاء وخدمات أساسيّة… وبات يبتكر الوسائط المتنوّعة لتوفير متطلّباته إمّا عبر ترشيد إنفاقه أو تطوير أعماله وزيادة إنتاجيّته أو الاعتماد على أموال المغتربين في دول الاغتراب.
من هنا انطلقت فكرة هذه المقالة ليكون عنوانها «استتهلاك اللّبنانيّين في الأعياد وانعكاسه على التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة»، للبحث أوّلًا في العوامل المؤثّرة في استهلاك الأسر في الأعياد، وثانيًا في كيفيّة انعكاس نمط الاستهلاك خلال الأعياد على التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، خاصّة بعد الأزمة الاقتصاديّة التي حلّت في البلد من انهيار لقيمة اللّيرة اللّبنانيّة أمام الدّولار الأميركيّ، وارتفاع أسعار السّلع الغذائيّة والأدوية ومختلف الاحتياجات الرّئيسة والثّانويّة للأسرة، وانخفاض قيمة الأجور لا سيّما في القطاعات الرّسميّة، وتأثيرها في تغيير نمط استهلاك الأسرة من حيث اختيار أنواع وأصناف السّلع وطرق استهلاك الأسرة بحسب سلّم الأولويّات لديهم.
أكدّت الدّراسات والأبحاث الاجتماعيّة تأثّر سلوك الفرد وتغيّر اتّجاهه عامّة وسلوكه الاستهلاكيّ خاصّة بعدد من العوامل ذات البُعد الاجتماعيّ والثّقافيّ والاقتصاديّ، واستنادًا إلى ما ورد في الأدبيّات التي تناولت موضوع العوامل المؤثّرة في الاستهلاك، يمكن استخراج العديد من العوامل النّفسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة إلّا أنّه قد اختير مفهومي التقيّد بمعايير الجماعة والاهتمام بالمكانة الاجتماعيّة كعاملين اجتماعيّين، المهنة والدخل الأسريّ وقيمة القروض أو الاستدانة كعوامل اقتصاديّة والإعلام ووسائط التّواصل الاجتماعيّ كمؤثّرات تسويقيّة، للبحث في تأثيراتها في استهلاك الأفراد خلال فترة الأعياد.
كما تحدّد موضوع الاستهلاك خلال المناسبات الدّينيّة والاجتماعيّة والأعياد (عيد الميلاد ورأس السنة وعيدي الفطر والأضحى وعيد الأمّ وعيد الحبّ)، لما تتضمّنه هذه الأعياد من مظاهر استهلاك ظرفيّة متنوّعة (ملابس، مأكولات ومشروبات وضيافات متنوّعة وأدوات منزليّة وزينة…) تتمّ في المنازل أو في المطاعم والمقاهي والفنادق، ووفود العشرات من السّيّاح والمغتربين إلى لبنان لقضاء أيّام الأعياد مع الأهل والأصدقاء والأقارب، ولما تشهده الأسواق من تزاحم للمستهلكين على شراء السّلع والمنتوجات التي تلبّي طموحاتهم ورغباتهم في قضاء أيّام الأعياد بسعادة وبركة وتبادل للهدايا وإدخال السّرور إلى قلوب محبّيهم، وارتياد المقاهي والمطاعم والأوتيلات بشكل أكبر من باقي أيّام السّنة.
بالتّالي، فإنّ البلد يشهد ما قبل حلول هذه المناسبات وخلالها ذروة النّشاط التّجاريّ والسّياحيّ والخدماتيّ ولا سيّما في المناطق التي تتمتّع بجمال الطّبيعة ووفرة المراكز التّجاريّة والمعالم السّياحيّة القريبة من المناطق السّكنيّة كما هو الحال في محافظة لبنان الجنوبيّ؛ إلّا أنّه لا بدّ من التّطرّق إلى الأزمة الاقتصاديّة التي استجدّت في لبنان منذ العام 2019، فقد أثّرت بشكل مباشر على تغيير نمط استهلاك الأسر اليوميّ بشكل عامّ، حيث تبدّلت الأولويّات واختلفت حاجات المجتمع اللّبنانيّ، فصار أكبر همّه تأمين الضّروريّ من الموادّ الغذائيّة والأدوية والمحروقات والطّاقة الكهربائيّة؛ ليعيش حياة مستقرّة وآمنة وكريمة، خاصّة بعد حدوث أزمة المصارف وخسارة المودعين لقيمة أموالهم فيها، وانهيار اللّيرة اللّبنانيّة أمام الدّولار الأميركيّ، وتتالي أزمة الشّحّ في المحروقات وانقطاع التّيار الكهربائيّ…
إلّا أنّه في المقابل، لم تمنع هذه الأزمة الاقتصاديّة فئة من اللّبنانيّين من الاستمرار بنمط الاستهلاك السّابق، على الرّغم من الغلاء الكبير للأسعار، فمن خلال الملاحظة المباشرة لبعض المطاعم والمقاهي، نرى أنّها ما زالت تستقبل عددًا لا بأس به من الزّبائن، وهو أمر يدفعنا لطرح العديد من التّساؤلات: ما مستوى القدرة الشّرائيّة لهؤلاء؟ ما نسبتهم من المجتمع؟ هل يعتمدون على أموال الاغتراب؟ أم أنّ مصدر رزقهم يخوّلهم اعتماد هذا النمط من الاستهلاك؟ هل هذه القدرة الشّرائيّة دائمة أم وقتيّة؟ وما تأثير استهلاك هذه الفئة من النّاس في تحريك العجلة الاقتصاديّة في لبنان عمومًا ومحافظة لبنان الجنوبيّ خصوصًا؟
من هنا، سنعالج موضوع البحث هذا من خلال تناول التّغيّرات التي طرأت على نمط استهلاك الأسرة خلال الأعياد في لبنان في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة التي يشهدها لبنان، وكيف يمكن أن يسهم هذا الاستهلاك في استمرار عجلة التّنمية الاجتماعية والاقتصاديّة؟
ومن هذه الإشكاليّة الرّئيسة تشكّلت لدينا تساؤلات: كيف يؤثّر الاهتمام بالمكانة الاجتماعيّة على نمط استهلاك الأسرة وعلى خياراتها الشّرائيّة خلال الأعياد؟ ما دور محدّدات الاستهلاك الاقتصاديّة (المهنة والمستوى التّعليميّ والدّخل الأسريّ) في تحديد مستوى الاستهلاك لدى الأسرة خاصّة في الأعياد؟ ما مدى تأثير وسائط التّواصل الاجتماعيّ في التّحوّلات في أنماط الاستهلاك وتحديد أولويّات التّسوّق لدى الأسرة اللّبنانيّة؟ هل يمكن الاستفادة من نمط استهلاك الأسر خلال الأعياد لتفعيل التّنمية الاجتماعيّة عبر خفض معدل الفقر والحدّ من عدم المساواة والارتقاء بحياة المواطن وفقًا للمعايير الصّحيّة والتّعليميّة والاجتماعيّة وتحقيق عمالة كاملة والأمن الشّخصيّ…؟ وهل يسهم الاستهلاك بمناسبة الأعياد في تفعيل التّنمية الاقتصاديّة عبر خلق فرص عمل وتطوير الإنتاج وتنويعه وتأمين الخدمات الحيويّة والارتقاء بالمستوى المعيشيّ للمواطنين…؟
وضعت ست فرضيّات تهدف إلى اختبار العلاقة بين “العوامل المؤثّرة في الاستهلاك” و”الاستهلاك خلال الأعياد والمناسبات” من جهة واختبار العلاقة بين “الاستهلاك” و”التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة” من جهة أخرى.
- هناك علاقة طرديّة بين اهتمام اللّبنانيّ بالمكانة الاجتماعيّة وبين الميل نحو الاستهلاك لديه خاصّة في الأعياد.
- هناك علاقة ذات دلالة إحصائيّة بين قيمة الدّخل الشّهريّ ونمط الاستهلاك الأسريّ خلال الأعياد.
- هناك علاقة ذات دلالة إحصائيّة بين نوع المهنة ونمط الاستهلاك الأسريّ خلال الأعياد.
- إنّ أفراد الأسرة المتابعين للإعلانات على مواقع التّواصل الاجتماعيّ هم أكثر خضوعًا وتأثرًا وتوجّهًا نحو الاستهلاك خاصّة قبل حلول الأعياد.
- هناك علاقة عكسيّة بين نمط استهلاك الأسر في الأعياد وتحقيق المساواة الاجتماعيّة بين أفراد المجتمع.
- هناك علاقة طرديّة بين نمط استهلاك الأسر في الأعياد وخلق فرص عمل جديدة.
اعتمدت المنهج النّوعيّ أو الكيفيّ في هذه الدّراسة، ويظهر ذلك في شكل مُشاهدات وآراء مكتوبة أو مسموعة أو تعليقات، وتتطلَّب تلك النّوعيّة من مناهج البحث العلميّ أن يتوافر لدى الباحث القُدرة على الرَّبط فيما بين جميع وجهات النظر؛ من أجل الخروج بالنّتائج، فالمنهج النّوعي هو نوع من أنواع الأبحاث العلميّة التي تعتمد على دراسة السّلوك والمواقف الإنسانيّة، وفي سبيل ذلك تُجمع المعلومات والبيانات؛ من خلال مجموعة من الوسائل مثل المُقابلات والمُلاحظات.
إن ظاهرة الاستهلاك لا تقتصر على أبعادها الاقتصاديّة – إشباع حاجات الفرد من السّلع والخدمات- لأنّها مرتبطة أشدّ الارتباط بتطوّر القيم والمفاهيم والممارسات السّلوكيّة لدى الأفراد التي تحدّد المكانة الاجتماعيّة للفئات في السّلّم الاجتماعيّ (حبيل، 2013، صفحة 215).
وهو استعمال المنتجات من دون إنتاج منتوجات اقتصاديّة أخرى أو بمعنى آخر استعمال المنتوجات من أجل الاستهلاك فقط، أو استعمال للمداخيل ومن خلاله تنعكس ثقافة الفرد أو المجموعة وتسير غالبًا إلى فعل الشّراء الذي هو قبل كلّ شيء إنفاق للمداخيل سواء أكان المستهلك في المناطق الحضريّة أو الرّيفيّة (فتيحة، 2016، صفحة 22).
ومع تقدّم الدّراسات بات الجانب الاجتماعيّ أساسيًّا لفهم اتّجاهات الإنفاق الاستهلاكيّ، إلّا أنّ الغاية من البحوث في هذا المجال كانت ذات منحى تجاريّ، إذ تركّزت التّساؤلات البحثيّة حول العناصر التي تؤثّر على سلوك الشّراء وكيفيّة التّحكّم بالمستهلكين؛ لذا كانت تتّجه إلى الأهداف التّسويقيّة أكثر من الأهداف التّوعويّة لخدمة استراتيجيّات التّنمية الاقتصاديّة (أبوغزالة، 2012).
ومع بروز مفهوم “ثقافة الاستهلاك”، اتّجهت الدّراسات إلى التّركيز على دور الإعلام والاتّصال في التّرويج لهذه الثّقافة عبر التّرويج للسّلع، وبقيت “ثقافة الاستهلاك” جزءًا من المقاربة النّقديّة لدى الباحثين في الغرب وتحمل كمفهوم قيمًا وعادات اجتماعيّة غربية بامتياز، في حين لم تصل الدّراسات في المنطقة العربيّة إلى تكوين مفهوم خاصّ للاستهلاك.
هذه النّظرة لمفهوم الاستهلاك لم تدم طويلًا، حيث ركّز ثورستين فيبلين Thorstein Veblen (1857- 1929) على الاستهلاك لدى الطّبقات الغنّيّة وربط الإنفاق الاستهلاكيّ بعوامل اجتماعيّة عدّة؛ أهمّها: الطّبقات في المجتمع. وبلور فيبلين مفهوم “الاستهلاك المظهريّ” (consommation ostantatoire) أي الاستهلاك المفرط للسّلع الذي يتجلّى عند الطّبقات الغنيّة تحديدًا (Beranger & Candela , 2011, p. 5).
كما بيّن فيبلين في كتابه “نظريّة الطّبقة المترفة” عام 1899 (The Theory of the Leisure Class) أنّ موضوع الاستهلاك المفرط للسّلع لا يقتصر على الأغنياء فقط، بل يشمل الفقراء في كثير من الأحيان عند قيامهم بشراء أشياء ليست ضروريّة وتفوق إمكاناتهم، حيث يتّجه الأفراد إلى التّماهي مع المجموعة التي ينتمون إليها، مع ميل للاقتراب من استهلاك المجموعة الأعلى منهم مباشرة، في محاولة للتّمايز عن مجموعة المنشأ. “هذا الميل للتّمايز والمقارنة مع الآخرين، ذو منشأ موغل في القدم، وهو من السّمات المتعذّر محوها في الطبيعة الإنسانيّة”. (Moawad, 2009, p. 31)
انطلاقًا ممّا تقدّم، لا بدّ من أن ننطلق من تساؤل يتمحور حول ماهيّة المتطلّبات اللّازمة لتحقيق الاستهلاك لدى المواطن اللّبنانيّ في الأعياد التي تدفع وتشكّل سلوكًا استهلاكيًّا موسميًّا، وكذلك المتطلّبات الكفيلة بتحقيق هذا الاستهلاك الموسميّ في الأعياد ذات الطّابع المستدام. إنّ عمليّة الرّبط هذه بين عمليّة الاستهلاك وتحقيق التّنمية تتطلّب القيام باتّباع إجراءات وسياسات تكون على دراية في معرفة المؤشّرات المؤثّرة في أنماط الاستهلاك لتحريك العجلة التّنموية؛ وبالتّالي جعلها أكثر عرضة للاستدامة.
2.4 ثقافة الاستهلاك الأسري لدى المجتمعات
لم يعد بمقدور مجتمع بشريّ مهما كان صغيرًا، أن يبقى بعيدًا عن مؤثّرات الثّقافة الاستهلاكيّة العالميّة التي بثّتها شبكات بالغة التّطوّر من أجهزة الإعلام والكمبيوتر وأجهزة الاتّصالات؛ فالثّقافة الاستهلاكيّة تعتمد على تجاوب المستهلك لأحداث التّسويق الإعلانيّ من حيث لفت الانتباه والفضول والتّعلّم والتّأثير في ميول الشّراء لديه وانخراطه في السّوق الحديث (Martinet, 1990, pp. 9-29).
إنّ الثّقافة الاستهلاكيّة العالميّة المعاصرة أُعدّت بهدف إضفاء مسحة جماليّة على الحياة اليوميّة مع التّشديد على أنّ هاجس الثّقافة الاستهلاكيّة، هو الإمتاع أو ثقافة المتعة أو اللّذة، عن طريق الدّعوة إلى ثقافة غير ملتزمة إلّا بالذّات الإنسانيّة الفرديّة، أي أنّها تضخم الأنا الفرديّة إلى الحدّ الأقصى وصولًا إلى النّرجسيّة وحبّ الذّات بشكل مرضيّ.
وتبرز مظاهر الثّقافة الاستهلاكيّة من خلال كثرة الاهتمام بالجسد والمظهر الخارجيّ، وتحطيم الكثير من التّقاليد المتوارثة عبر تمجيد الذّات الفرديّة المتحرّرة من كلّ القيود الاجتماعيّة، والاهتمام بالجوانب الغريزيّة للإنسان وبالمظاهر والكماليّات الشّكليّة التي تحدّد قيمة الإنسان بمقدار ما يقتنيه من أشياء مادّيّة أو مال، وتحويل جميع مظاهر الثّقافة الإنسانيّة إلى سلعة تجاريّة (الجسمي، 2008، صفحة 193).
وإذا ركّز المرء على الممارسات اليوميّة، فسوف تستمرّ حاجته لجمع المعلومات حول إمكانيّات الآخرين وأوضاعهم ومراكزهم الاجتماعيّة، عن طريق تقليد سلوكهم، ومن بين هذه المؤشّرات أنواع الطّعام التي يتناولها النّجوم، والملابس التي يرتدونها، وطبعًا هذه الاحتياجات عرضة للتّغيّر والتّقليد والنّسخ بشكل مستمرّ؛ لذلك نجد الثّقافة الاستهلاكيّة تهتمّ بالملامح النّفسيّة للمستهلك، وتتضمّن نمط الحياة والشّخصيّة والصّورة الذّاتيّة.
بدايةً سنكون مع النظرية المفسّرة التي تناولت استهلاك الحاجات الأساسيّة ودوافعها وهي نظريّة ماسلو:
تعدّ نظريّة “ماسلو” من أكثر النّظريّات تداولًا في الأوساط البحثيّة في العلوم الإنسانيّة عامّة والاجتماعيّة خاصّة، وهي من أهمّ النّظريّات الكاشفة عن حاجات الفرد الاجتماعيّة، أي ما يحتاجه الفرد في حياته اليوميّة، وذلك عبر تحديدها لسلّم أولويّاته الذي يوصل إلى ذروة الإشباع عند الفرد بعد تحقيق جميع العناصر.
وضع “ماسلو” أنموذجًا يوضّح أهمّ ما يسعى الفرد إلى تحقيقه، على شكل حاجات متعدّدة مرتّبة في هرم أسماه هرم الحاجات؛ تبدأ قاعدته بالحاجات الأساسيّة، تليها الحاجات الأخرى، صعودًا نحو القمة وفق تسلسل يعكس منظوره لهذه الحاجات؛ ويسعى الفرد إلى إشباعها تدريجيًّا، بدءًا من قاعدة الهرم وصولًا إلى رأسه، مدفوعًا بمحفّزات داخليّة؛ ولا يعني إشباع حاجة زوالها من هرمية الحاجات بل تفتح المجال إلى إشباع حاجة أخرى؛ وهكذا، فإنّ عمليّة الإشباع تستمرّ ضمن آليّة متواصلة تنبع من دوافع الفرد.
يتّضح من هرم ماسلو أنّ حياة الفرد محدّدة بالعناصر المذكورة فيه؛ وتفصيلها يأتي على الشّكل التّالي:
- حاجات فيسيولوجيّة: هي حاجات متعلّقة بما يحتاجه الإنسان كي يبقى على قيد الحياة وضمان استمراره، وهي حاجات متمثّلة في المأكل والملبس والمسكن. وتهدف هذه الحاجات إلى المحافظة على حياة الفرد، كما إنّها تحافظ على بقائه كونها تقع في قاعدة الهرم، على حسبان أنّها أولويّة في الإشباع عند الفرد، فإشباعها يحقّق الانتقال إلى إشباع حاجات أخرى موجودة في الهرم؛ فعندما تبرز الحاجة لإشباعها، فإنّ الفرد يحقّق وجوده ويحافظ عليه، فهي حاجات ضروريّة لا اختياريّة، فهي الماء والهواء والطّعام والرّاحة والنّوم والجنس، بمعنى أنّها كلّها عوامل تجعل الإنسان محافظًا على كيانه وعلى بقاء المجتمعات.
- حاجات الأمان: تتمثّل في العوامل التي تساعد في الحماية من الأخطار المهدّدة لحياة الفرد ضمن حياته اليوميّة وتحقيقها يحقّق له الاستقرار. إنّ حاجات الأمن تتمظهر في توفير العوامل التي تؤمّن حماية الإنسان من أيّ ضرر يمكن أن يعترضه في حياته، سواء كان ماديًّا أم معنويًّا، ومن ضمنها تتمّ حماية حاجاته الفيسيولوجيّة، فمن نتائج إشباع هذه الحاجة يتولّد لديه شعور بالاستقرار والاطمئنان، وهي حاجات نفسيّة يحتاجها الإنسان للحفاظ على سلوكه وتوازنه الطّبيعيّ، ومن أهمّ الأشياء أو العناصر التي يمكن أن تؤمّن هذه الحاجات: القوانين والأنظمة والتّعليمات والإجراءات التي تمنع من الاعتداء على أيّ إنسان؛ فيتولّد لدى النّاس شعور بالارتياح والاطمئنان.
- حاجات اجتماعيّة: هذا النّوع من الحاجات متعلّق بالعلاقات الاجتماعيّة، وتحقيق الانتماء والاندماج والتّضامن والتّكافل وتكوين الصّداقات في مختلف الميادين والمجالات.
- حاجات التّقدير: تتمثّل في تلك الحاجات التي يراها الفرد حقًّا له في واقعه المعاش، وهي عبارة عن حاجات مادّيّة ومعنويّة وسلوكيّة، إذ إنّ نقصانها يؤدّي إلى ضعف قيمته أمام الآخرين ممّا يؤدّي إلى اهتزاز ثقته بنفسه.
- الحاجة إلى تحقيق الذّات: إنّها الحاجات التي يسعى الفرد إليها، تنطلق من إشباع كلّ الحاجات، فيسعى الفرد إلى أن يستغلّ طاقاته وإمكاناته في أمور تحقّق ذاته وتقدّرها.
انطلاقًا ممّا سبق، فإنّ أهم بنود نظريّة الحاجات لماسلو التي تعبّر عن دوافع سعي الفرد نحو تحقيق حاجاته متعدّدة بتعدّد العوامل التي يسعى الفرد إلى تحقيقها، وهي هامّة انطلاقًا من حياة كلّ فرد، وانطلاقًا من نظرة الفرد إليها، فما يراه فرد مهمًّا قد لا يعني الآخرين، والعكس صحيح.
إنّ اعتماد الباحثة على هذه النّظريّة مرتبط بتوظيفها في إطار الاستهلاك على قاعدة تعامل الأفراد مع الأشياء عبر سلوك استهلاكيّ؛ فالفرد يقوم بعمليّة استهلاك تتمثّل في تفاعله مع الأشياء أي المنتجات، وبعد ذلك تتمّ عمليّة الشّراء ومن ثمّ الاستهلاك، هذه العمليّة منطلقة من عمليّة تفاعل مع الأشياء من أجل تحقيق أغراض نفسيّة واجتماعيّة.
2.5. نظريّة روستو في الاستهلاك
تشكّل نظريّة مراحل التّطوّر الاقتصاديّ التي روّج لها “روستو” في كتابه “مراحل النّموّ الاقتصاديّ” الذي قد استحوذ على اهتمام كبير بين أوساط المتخصّصين بالعلاقة القائمة بين الدّخل والتّنمية، وفكرة “روستو” تتلخّص في أنّ “النموّ الاقتصاديّ يتكوّن من عدّة مراحل تتعاقب بشكل زمنيّ، وأنّ كل مرحلة من هذه المراحل تمهّد الطّريق بشكل يهيّئ للمرحلة التي تعقبها، ما يشير إلى أنّ البلدان المتخلّفة تخطو في نفس المسار التي تسير عليه الدّول المتقدّمة في المدّة بين 1850-1950، إلى أن تصل إلى مرحلة المجتمع الصّناعيّ وإلى ما بعد المجتمع الصّناعيّ، والعمليّة الاقتصاديّة تكشف عن مدى مرونة الوضع الاقتصاديّ، كما يكشف عن مدى مشاركة الأفراد في العمليّة التّنمويّة سواءً الاقتصاديّة والاجتماعيّة من خلال سلوكيّات عدّة منها قدرتهم الشّرائيّة ومستويات استهلاكهم وكيفيّة تأثير ذلك في نمط حياتهم المعاش، وحسب “روستو” يمكن أن ينسب أيّ مجتمع من حيث مستوى تطوّره الاقتصاديّ إلى إحدى المراحل الخمس.
- مرحلة المجتمع التّقليديّ.
- مرحلة التّهيّؤ للانطلاق.
- مرحلة الانطلاق.
- مرحلة الاتّجاه نحو النّضج.
- مرحلة الاستهلاك الوفير.
ويرى “روستو” أنّ هذه المراحل ليست إلّا نتائج عامّة مستنبطة من الأحداث الضخمة التي شهدها التّاريخ الحديث.
3.5. نظريّة كينز التّحليليّة
تتميّز نظريّة «كينز» التّحليليّة عن الأساليب التّحليليّة التي كانت مستعملة في الاقتصاد الكلاسيكيّ، حيث طبّق “كينز” الطّريقة التّحليليّة الكلّيّة محاولًا وضع نظريّة عامّة للنّشاط الاقتصاديّ، أفضل من الجدول الاقتصاديّ الذي وضعه سابقوه الذين اهتمّوا بوضع دراسات تحليليّة جزئيّة، مثل نظريّة الإنتاج، ونظريّة التّبادل ونظريّة التّوزيع، ويعتقد كينز أنّه من الأفضل أن تدمج هذه النّظريّات الثّلاث المنفصلة، بنظريّة واحدة عامّة؛ لأنّ الإنتاج هو الذي يحدّد حجم الدّخل القوميّ الذي يحدّد بدوره المداخيل الموزّعة، كما انتقد كينز الطّريقة التّقليديّة بالنّسبة إلى النّقد؛ لأنّ النّقد ليس عنصرًا حياديًّا إنّما عنصر فاعل.
اهتمّ «كينز» بطريقة التّحليل الكلّيّة Macro-économie» حيث اهتمّ بدراسة الكمّيّات الكلّيّة مثل: الدّخل القوميّ والعمالة والعرض الكليّ والطّلب الكلّيّ… تاركًا جانب التّحليل الجزئيّ Micro-économie» مثل سلوك المستهلك والمدّخر.
- أنواع الاستهلاك الأسريّ
للاستهلاك أنواع مختلفة ومتعارف عليها في المجتمع، أبرزها الاستهلاك الطّبيعيّ أو الاعتياديّ والاستهلاك التّفاخريّ/المظهريّ، وسنتناول خصائص كِلا النّوعين مستندين في ذلك إلى الأرقام والنتائج التي بيّنتها لنا المعطيات المجمّعة من مجتمع الدّراسة.
1.6. الاستهلاك الطّبيعيّ الاعتياديّ
هو النّوع الأوّل والمتعارف عليه في المجتمع، هذا النّوع من أنواع الاستهلاك يقوم على استهلاك الحاجات الأساسيّة والضّروريّة للفرد وللأسرة التي تشكّل جزءًا أساسيًّا في الحياة اليوميّة؛؛ ويعدّ استهلاكها وتوفّرها ضرورة لاستمرار هذه الحياة، إذ لا يمكن الاستغناء عنه. إنه “استهلاك الاحتياجات الحيويّة من غذاء ومسكن وملبس وصحّة، ويحقّق إشباعًا كافيًا؛ وتحديد مستوى هذه الاحتياجات يختلف اختلافًا شديدًا بين الفئات الاجتماعيّة والمستوى الاقتصاديّ للمجتمعات (الجوهريّ، 2001، صفحة 325).
في الماضي، كانت الأسرة -ولا تزال اليوم في بعض المجتمعات القرويّة- تستهلك ما تنتجه بنفسها، وتبيع الفائض عن حاجتها أو تقايضه بسلع أو منتجات أخرى تحتاج إليها؛ “إلّا أنّ هذه التّقليدية قد تبدّلت وتحوّلت مع التّقدّم الصّناعيّ وتطوّر خطوط الإنتاج (بالحاج، 2017، صفحة 13)، إذ تحوّل استهلاك الأسرة ليتّجه نحو السّلع المصنّعة والجاهزة التي تقوم بإنتاجها المصانع الكبرى لمختلف حاجيات الأفراد والمجتمعات، كما أنّها وفّرت أنواعًا عدّة بمواصفات مختلفة لسلعة واحدة، فخلق رغبة عند المستهلك في الحصول على كمّيّة من المنتجات لإشباع رغبته.
وهناك حاجات وسلع ضروريّة تتخطّى المأكل والمشرب واللّباس والطّبابة، كالاتّصالات مثلًا لما يفرضه الواقع الثّقافيّ المعولم من ضرورة التّواصل الدّائم والبقاء على اتّصال مع الآخرين ولو افتراضيًّا، إضافةً إلى التّجهيزات المنزليّة والإلكترونيّة.
يتحمّل الأفراد أعباء ماليّة أكبر نتيجة ارتفاع معدّلات الاستهلاك، ولذا سنعرض في الجدول التّالي مدى حسبان أفراد عيّنة الدّراسة الدّخل الشّهريّ الأسريّ كافيًا لسدّ الحاجات المختلفة، وذلك استنادًا إلى قيمة الدّخل الإجماليّ للأسرة. وقد أُجري اختبار لقياس قوّة الارتباط بين متغيّري: الدّخل الإجماليّ للأسرة ومدى كفاية دخل الأسرة لسدّ الحاجات المختلفة. وأظهرت نتائج اختبار كا تربيع وجود علاقة ذات دلالة إحصائيّة بين المتغيّرين، حيث بلغ مستوى الدّلالة 0.000، وهو أقلّ من 0.01.
جدول 1: اختبار كا تربيع لقياس العلاقة بين مدى كفاية دخل الأسرة لسدّ الحاجات المختلفة والدّخل الإجماليّ للأسرة
| قوة الارتباط | الدلالة | ||
| Nominal by Nominal | Phi | 0.659 | 0.000 |
| Cramer’s V | 0.295 | 0.000 | |
| N . Valid Cases | 412 | ||
المصدر: العمل الميدانيّ الذي نفّذته الطّالبة بتاريخ 15 كانون الأوّل 2019
كما أُجري اختبار كرامرز (V& Cramer’s) وقد بلغت قوّة الارتباط 0.29 والدّلالة 0.000؛ وهذا يدلّ على أنّ العلاقة بين المتغيّرين تعدّ قويّة، وأنّ هناك تأثير مباشر للمتغيّرين في بعضهما، إذ إنّ الدّخل الإجماليّ للأسرة يؤثّر على مدى كفاية دخل الأسرة لسدّ الحاجات المختلفة لأفراد الأسرة.
جدول 2: توزّع أفراد العيّنة وفق تصنيفهم لدخل الأسرة كافيًا لسدّ الحاجات المختلفة، بحسب الدّخل الإجماليّ للأسرة
| إعتبار دخل الأسرة كاف لسد الحاجات المختلفة | الدّخل الإجماليّ للأسرة | المجموع | ||||||
| دون 500$ | 500-999$ | 1000-1499$ | 1500-1999$ | 2000-2999$ | 3000$ ومافوق | |||
| نعم | التّكرار | 0 | 4 | 0 | 0 | 92 | 48 | 144 |
| النّسبة المئويّة | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 63.9% | 33.3% | 100.0% | |
| المجموع | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 22.3% | 11.7% | 35.0% | |
| كلا | التّكرار | 12 | 60 | 56 | 32 | 4 | 0 | 164 |
| النّسبة المئويّة | 7.3% | 36.6% | 34.1% | 19.5% | 2.4% | 0.0% | 100.0% | |
| المجموع | 2.9% | 14.6% | 13.6% | 7.8% | 1.0% | 0.0% | 39.8% | |
| أحيانا | التّكرار | 0 | 4 | 44 | 20 | 24 | 12 | 104 |
| النّسبة المئويّة | 0.0% | 3.8% | 42.3% | 19.2% | 23.1% | 11.5% | 100.0% | |
| المجموع | 0.0% | 1.0% | 10.7% | 4.9% | 5.8% | 2.9% | 25.2% | |
| المجموع | التّكرار | 12 | 68 | 100 | 52 | 120 | 60 | 412 |
| النّسبة المئويّة | 2.9% | 16.5% | 24.3% | 12.6% | 29.1% | 14.6% | 100.0% | |
| المجموع | 2.9% | 16.5% | 24.3% | 12.6% | 29.1% | 14.6% | 100.0% | |
المصدر: العمل الميدانيّ الذي نفّذته الطالبة بتاريخ 15 كانون الأوّل 2019
يبيّن (الجدول 2) أنّ 29.1% من إجماليّ أفراد عيّنة الدّراسة يتراوح الدّخل الإجماليّ لأسرهم بين 2000 و2999$، 22.3% منهم رأوا أنّ الدّخل الإجماليّ لأسرتهم يمكن تصنيفه كافيًا لسدّ الحاجات المختلفة للأسرة، و1% رأوا أنّ هذا الدخل لا يمكن تصنيفه كافيًا لسدّ الحاجات المختلفة للأسرة، و5.8% عدّوا أنّ هذا الدّخل يكفي في بعض الأحيان لسدّ مختلف الحاجات التي تحتاجها الأسرة.
وهناك نسبة 24.3% من إجماليّ أفراد العيّنة يتراوح دخلهم الإجماليّ بين 1000 و1499$، 13.6% منهم أجابوا أنّ هذا الدخل لا يكفي أبدًا لسدّ الحاجات الرّئيسة للأسرة، في حين 10.7% أجابوا أنّ هذا الدّخل يكفي في بعض الأحيان لسدّ مختلف حاجات الأسرة.
كما أنّ 16.5% من إجماليّ أفراد العيّنة يتراوح الدّخل الإجماليّ للأسرة لديهم بين 500 و 999$، توزّعت نسبهم على الشّكل التالي: 1% رأوا أنّ الدّخل الإجماليّ للأسرة يعدّ كافيًا لسدّ الحاجات المختلفة للأسرة، و14.6% رأوا أنّ دخلهم الإجماليّ لا يكفي لسدّ الحاجات المختلفة للأسرة وهي النّسبة الأعلى، في حين رأى 1% فقط أنّ هذا الدّخل يمكنه أحيانًا أن يسد حاجات الأسرة المختلفة.
وبالمقابل، نرى أنّ 14.6% من إجماليّ أفراد الأسرة يبلغ دخلهم الإجماليّ 3000$ وما فوق، 11.7% أجابوا أنّ هذا الدخل يكفي لسدّ الحاجات الأسريّة المختلفة، و 2.9% أجابوا أنّ دخل الأسرة الإجماليّ الذي يبلغ 3000$ وما فوق يكفي في بعض الأحيان لسدّ مختلف الحاجات الأسريّة.
كما أن 12.6% من إجماليّ أفراد العيّنة أفادوا أنّ الدّخل الإجماليّ لأسرتهم يتراوح بين 1500 و1999$، وأجاب 7.8% أنّ هذا الدّخل لا يمكنه سدّ مختلف حاجات الأسرة، في حين رأى 4.9% أنّ الدّخل الإجماليّ لأسرهم يكفي في بعض الأحيان لسدّ الحاجات المختلفة التي تحتاجها الأسرة.
وأخيرًا هناك 2.9% من أفراد العيّنة يبلغ الدّخل الشّهريّ لأسرهم أقلّ من 500 $، وتركّزت هذه النّسبة في خانة واحدة هي “كلا” أي أنّ الدّخل الإجماليّ للأسرة لا يكفي سدّ الحاجات الرّئيسة والمختلفة للأسرة.
إن تصنيف الدّخل كافٍ أو غير كافٍ لسدّ الحاجات الأسريّة هو مسألة نسبيّة، تتحكّم فيها عوامل عدّة اجتماعيّة، ثقافيّة، مكانيّة… وغيرها. فما يمكن تصنيفه عند فئة من فئات المجتمع حاجة أو سلعة ثانويّة تعدّ عند فئة أخرى ضروريّة، وهذا ما سنبيّنه تباعًا في تصنيف الحاجات والسّلع الضّروريّة وفق عوامل عدّة تتحكّم في هذه المسألة.
2.6. الاستهلاك التّفاخريّ/ المظهريّ
الاستهلاك التّفاخريّ هو نوع “يفوق استهلاك الحاجات الأساسيّة، ويعتمد على المستهلكات الإضافيّة أو التي لا تعتمد على الاستهلاك الرئيس” (الرّمّانيّ، 2014، صفحة 159).
وقد سخر الرّمّاني من السّلوك الاستهلاكيّ الذي يحرّكه حبّ التّشبه وتقليد الآخر؛ “لأنّ فكرة مجاراة النّبلاء في حياتهم هي في حدّ ذاتها مدعاة للسّخرية، لأنّ هذا الأمر سيؤثّر على نمط حياته مع زيادة الإنفاق الأسريّ وتكبيد أسرته مزيدًا من الخسائر التي لا مبرّر لها سوى فكّ لعقد نفسيّته وتحصيل مكانة اجتماعيّة مرموقة (الرّمّاني، 2014).
وتعدّ المناسبات الثّلاث التي حدّدناها سابقًا، فرصة لتبادل وتقديم الهدايا التي تعدّ عنصرًا رئيسًا فيها، لما لها من رمزيّة من حيث التّعبير عن المحبّة والاحترام والعرفان بالجميل نحو الأمّ مثلًا، والتّودّد والألفة خاصّة في عيد الميلاد المجيد، أمّا في ليلة رأس السّنة التي تعدّ مناسبة اجتماعيّة بامتياز فإنّ تقديم الهدايا يترافق مع مظاهر احتفاليّة متنوّعة، كإقامة عشاء يضمّ مختلف المأكولات والحلويّات احتفالًا بالسّنة الجديدة وتوديع سنة مضت، وقد أشار “مارسال موس” إلى أنّ للهبة أو الهدايا أبعادًا سوسيولوجيّة (Mauss, 1989, pp. 147-151) تتمثّل في العطاء، وقبول هذا العطاء، ثمّ الرّدّ عليه إمّا بإعادة الغرض نفسه أو تقديم ما يوازيه قيمة، أي ردّ الهدية بالمثل؛ هذا من شأنه أن يقوّي الرّوابط الاجتماعيّة ويخلق الألفة بين الأفراد”، كما من شأنه أن ينعكس على نوعيّة الاستهلاك إذ إنّ إهداء هديّة ما تمنح الذي قدّم الهديّة إلى جانب صفة العطاء أيضًا مكانة اجتماعيّة، حيث كلّما كانت الهدية لها بُعد ماديّ ومعنويّ أكثر دفع المتلقّي إلى المبادرة من أجل ردّ الهديّة بأخرى لها قيمة أكثر؛ وهنا يتجلّى لدينا أسلوب الاستهلاك في الاتّجاه نحو انتقاء السّلع التّفاخريّة والثّمينة التي من شأنها أن تكبّد الفرد أعباءً مادّيّة تتحكّم فيها أبعادًا ثقافيّة واجتماعيّة ومهنيّة وغيرها…
كما أنّ هناك رمزية خاصّة لشهر رمضان عند المسلمين وعيد الأم إذ يعدّ مناسبة مميّزة جدًّا؛ لأنّه يوم يحمل رمزيّة قدسيّة لأسمى وأغلى إنسان في حياة أيّ فرد وهي “الأمّ”؛ لذا فإنّ الاحتفال بهذه المناسبة له رمزيّة عالميّة والتّعبير عنها بتقديم هديّة لها بُعد معنويّ تقديرًا للجهود والتّضحيات التي تقدّمها الأمّ لأولادها، فيتّجه الكثيرون إلى تقديم هديّة ثمينة أكانت من المجوهرات أم غيرها، إضافة إلى باقة من أغلى وأجمل أنواع الورد… إضافة إلى إقامة وليمة أو حفل عشاء مع قالب حلوى… كلّ ذلك يعكس نمطًا استهلاكيًّا معيّنًا وإن بدا كماليًّا، إلّا أنّه مع مرور الوقت أصبح مثبتًا ليس فقط محليًّا بل عالميًّا، وبالتّالي فإنّ الاحتفال بهذه المناسبات مع ما يرافقها من عادات تحوّلت إلى طقوس لها أبعاد معنويّة اجتماعيّة وحتّى دينيّة (الطّاعة والبرّ بالأمّ) إلّا أنّ لها تبعات اقتصاديّة وخيمة على الأفراد خاصّة ذوي الدّخل المتدنّي أو المتوسّط. أمّا تنمويًّا فإنّ عمليّة الاستهلاك التي ترافق إحياء هذه المناسبة وغيرها من شأنها أن تحرّك العجلة الاقتصاديّة التي تُنعش السّوق المحليّ من خلال حركة البيع والشّراء وتنوّع السّلع والبضائع والخدمات في هذه المناسبات، وهذا ما تبيّن معنا من خلال المقابلات التي أجريناها.
كما أنّ هناك توجّه في بعض المناسبات -مثل عيد الأمّ- لشراء الورود، وكأنّه أصبح عرفًا لا يمكن التّخلّي عنه، وإن قُدّمت هديّة من نوع آخر إلى جانب باقة الورد، ومن خلال مقابلات أُجريت مع بائعي محلّات الورد ضمن المجال الجغرافيّ للدّراسة، وجدنا أنّه وعلى الرّغم من الوضع الاقتصاديّ المتردّي وارتفاع أسعار الورد، إلّا أنّ الإقبال يكون كثيفًا في مواسم عدّة، مثل عيد الأمّ وعيد العشّاق، إذ إنّ للورد رمزيّته من حيث دلالته على قوّة المشاعر تجاه الشّخص الآخر خاصّة الورد الجوريّ.
أمّا بالنّسبة إلى الأنواع الأخرى من السّلع الأكثر طلبًا في الأعياد، فقد تبيّن من خلال مقابلة أجريناها في جزّين في متجر لصناعة السّكاكين، وهي حرفة تراثيّة بامتياز، أنّه ما زال الإقبال على شرائها في بعض المواسم جيّدًا، حيث إنّ القيام بإهداء هذا النّوع من الهدايا الحرفيّة هي دليل تقدير واحترام وقوّة، إضافة إلى أنّها تعبّر عن هويّة ثقافيّة خاصّة، فصناعة السّكاكين قديمة في جزّين منذ القرن التّاسع عشر وفق ما أفادنا العميد حدّاد الذي ورث هذه الصّناعة أبًّا عن جدّ.
ولمعرفة مدى اعتماد أهالي محافظة لبنان الجنوبيّ نمط الاستهلاك التّفاخريّ في الأعياد والمناسبات الدّينيّة والاجتماعيّة والرّسميّة، سنعرض بعض الجداول التي تقدّم لنا بعض المعطيات حول طبيعة الاستهلاك أثناء زيارة الأهل والأصدقاء في المناسبات من حيث: نوع الهدايا التي يصطحبها الأفراد قياسًا بالدّخل الإجماليّ للأسرة، وأكثر المناسبات التي تُحيا.
يعرض الجدول التّالي تأثير الدّخل الإجماليّ للأسرة في مدى اصطحاب الهدايا للأهل والأصدقاء والأقارب في الأعياد، فتبيّن لدينا أنّ جميع أفراد العيّنة على اختلاف قيمة الدّخل الإجماليّ لأسرهم يقومون باصطحاب هدايا للأهل والأصحاب في الأعياد والمناسبات. وهذا دليل قاطع على أنّ للهدية بُعدًا رمزيًّا إضافة إلى تحويلها إلى عادة ترافق مظاهر الاحتفال في المناسبات الدّينيّة والاجتماعيّة، وتشكّل جزءًا مهمًّا من طقوس الاحتفال بالأعياد.
جدول 3: توزّع أفراد العيّنة وفق اصطحابهم للهدايا أثناء زيارة الأهل والأصدقاء في الأعياد وتبعًا للدّخل الإجماليّ للأسرة
| الدّخل الإجماليّ للأسرة | المجموع | ||||||||
| دون 500$ | 500-999$ | 1000-1499$ | 1500-1999$ | 2000-2999$ | 3000$ ومافوق | ||||
| اصطحاب الهدايا أثناء زيارة الأهل والأصدقاء في الأعياد | نعم | التّكرار | 12 | 68 | 100 | 52 | 120 | 60 | 412 |
| النّسبة المئويّة | 2.9% | 16.5% | 24.3% | 12.6% | 29.1% | 14.6% | 100.0% | ||
| المجموع | 2.9% | 16.5% | 24.3% | 12.6% | 29.1% | 14.6% | 100.0% | ||
المصدر: العمل الميدانيّ الذي نفّذته الطالبة بتاريخ 15 كانون الأوّل 2019
في (الجدول 3) يمكن أن نلاحظ أنّ النّسبة الأكبر لأفراد عيّنة الدّراسة الذين يصطحبون الهدايا معهم في الأعياد للأهل والأقارب والأصدقاء هم ممّن تتراوح قيمة الدّخل لديهم بين 2000 و 2999$، يليهم من تتراوح قيمة الدّخل الشّهريّ لديهم بين 1000 و1499$، في حين إنّ 2.9% فقط من أفراد العيّنة الذين يبلغ الدّخل الشّهريّ لديهم دون 500% يشترون الهدايا ويقدّمونها للأهل والأقارب والأصحاب في الأعياد.
وبالتّالي يمكن استنتاج تأثير قيمة الدّخل الشّهريّ للأسرة في قرار شراء الهدايا للآخرين في الأعياد، حيث إنّ ممارسة بعض الطّقوس الاجتماعيّة التي اعتاد المجتمع اللّبنانيّ عليها قد تشكّل لبعضهم حملًا ثقيلًا على كاهلهم، فمن جهة يشعر الفرد برغبة بالاحتفال وتبادل الهدايا وإعطاء نفسه قيمة اجتماعيّة أمام الآخرين من خلال تقديم هدايا جميلة وقيّمة، ومن جهة أخرى يعرف أنّ شراء هذه الهدايا ستشكّل له عبئًا ماليًّا قد يستمرّ سداده لأشهر لاحقة… وهنا لا بدّ من أن يكون قرار الشّراء حكيمًا ومدروسًا…
في الجدول التّالي سنبيّن أهمّ المناسبات التي يزيد فيها الإنفاق والاستهلاك الموسميّ، من خلال الرّبط بين تحديد أبرز الأعياد التي تدفع أفراد العيّنة نحو المزيد من الاستهلاك وبين قيمة الدّخل الإجماليّ للأسرة:
جدول 4: توزّع أفراد العيّنة وفق الأعياد التي تدفعهم نحو الاستهلاك تبعًا للدّخل الإجماليّ للأسرة
| الدّخل الإجماليّ للأسرة | الأعياد التي تدفع المبحوثين نحو الإستهلاك | المجموع | |||||
| رمضان | عيد الميلاد، رأس السّنة الميلاديّة، عيد الأمّ | رمضان، عيد الأم | رمضان، عيد الأم، عيد الميلاد، رأس السنة الميلادية | رمضان، عيد الأم، رأس السّنة الميلاديّة | |||
| دون 500$ | التّكرار | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| النّسبة المئويّة | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| المجموع | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | |
| 500-999$ | التّكرار | 8 | 16 | 44 | 0 | 0 | 68 |
| النّسبة المئويّة | 11.8% | 23.5% | 64.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| المجموع | 1.9% | 3.9% | 10.7% | 0.0% | 0.0% | 16.5% | |
| 1000-1499$ | التّكرار | 8 | 28 | 40 | 12 | 12 | 100 |
| النّسبة المئويّة | 8.0% | 28.0% | 40.0% | 12.0% | 12.0% | 100.0% | |
| المجموع | 1.9% | 6.8% | 9.7% | 2.9% | 2.9% | 24.3% | |
| 1500-1999$ | التّكرار | 0 | 20 | 28 | 0 | 4 | 52 |
| النّسبة المئويّة | 0.0% | 38.5% | 53.8% | 0.0% | 7.7% | 100.0% | |
| المجموع | 0.0% | 4.9% | 6.8% | 0.0% | 1.0% | 12.6% | |
| 2000-2999$ | التّكرار | 16 | 16 | 32 | 40 | 16 | 120 |
| النّسبة المئويّة | 13.3% | 13.3% | 26.7% | 33.3% | 13.3% | 100.0% | |
| المجموع | 3.9% | 3.9% | 7.8% | 9.7% | 3.9% | 29.1% | |
| 3000$ ومافوق | التّكرار | 0 | 20 | 8 | 32 | 0 | 60 |
| النّسبة المئويّة | 0.0% | 33.3% | 13.3% | 53.3% | 0.0% | 100.0% | |
| المجموع | 0.0% | 4.9% | 1.9% | 7.8% | 0.0% | 14.6% | |
| المجموع | التّكرار | 32 | 100 | 164 | 84 | 32 | 412 |
| النّسبة المئويّة | 7.8% | 24.3% | 39.8% | 20.4% | 7.8% | 100.0% | |
| المجموع | 7.8% | 24.3% | 39.8% | 20.4% | 7.8% | 100.0% | |
المصدر: العمل الميدانيّ الذي نفّذته الطّالبة بتاريخ 15 كانون الأوّل 2019
يبيّن (الجدول 4) العلاقة القائمة بين الدّخل الإجماليّ للفرد والاحتفال بالأعياد التي تدفع المبحوثين نحو الاستهلاك. وقد أفاد 39.8% من إجماليّ أفراد العيّنة أنّ نسبة زيادة الاستهلاك لديهم هي في مناسبة عيد الأمّ وشهر رمضان الكريم، توزّعت هذه النّسبة على الشّكل التالي، 2.9% للّذين يبلغ دخلهم الإجماليّ دون 500$، 10.7% للّذين يتراوح دخلهم الإجماليّ بين 500 و999$، 9.7% للذين يتراوح دخلهم الإجماليّ بين 1000 و1499$، 6.8% بين 1500 و1999$، 7.8% بين 2000 و 2999$، 1.9% للذين يبلغ دخلهم الإجماليّ 3000$ وما فوق.
كما رأى 24.3% من إجماليّ أفراد العيّنة أنّ كُلًّا من “عيد الميلاد ورأس السّنة الميلاديّة وعيد الأمّ” تدفع نحو الاستهلاك، إذ إنّ هذه المناسبات الثّلاثة فرصة لتبادل ولتقديم الهدايا التي تعدّ عنصرًا رئيسيًّا فيها، لما لها من رمزيّة من حيث التّعبير عن المحبّة والاحترام والعرفان بالجميل نحو الأمّ مثلًا، والتّودّد والألفة خاصّة في عيد الميلاد المجيد؛
أمّا في ليلة رأس السّنة، التي تُعدّ مناسبة اجتماعيّة بامتياز، فإنّ تقديم الهدايا يترافق مع مظاهر احتفاليّة متنوّعة، كإقامة عشاء يضمّ مختلف المأكولات والحلويّات احتفاءً بقدوم العام الجديد وتوديع العام المنصرم. وقد أشار إليها “مارسال موس” (Mauss, 1989, pp. 147-151) إلى أنّ للهبة أو الهديّة أبعادًا سوسيولوجيّة تتمثّل في العطاء، وقبول هذا العطاء، ثمّ الرّدّ عليه إمّا بإعادة الغرض نفسه أو تقديم ما يوازيه قيمةً، أي ردّ الهدية بالمثل؛ هذا من شأنه أن يقوّي الرّوابط الاجتماعيّة ويخلق الألفة بين الأفراد”، كما من شأنه أن ينعكس على نوعيّة الاستهلاك؛ إذ إنّ إهداء هديّة ما تمنح الذي قدّم الهديّة إلى جانب صفة العطاء أيضًا مكانة اجتماعيّة حيث كلّما كانت الهدية لها بُعد ماديّ ومعنويّ أكثر دفع المتلقّي إلى المبادرة من أجل ردّ الهدية بأخرى لها قيمة أكثر؛ وهنا يتجلّى لدينا أسلوب الاستهلاك في الاتّجاه نحو انتقاء السّلع التّفاخريّة والثّمينة التي من شأنها أن تكبّد الفرد أعباءً مادّيّة تتحكّم فيها أبعادًا ثقافيّة واجتماعيّة ومهنيّة وغيرها…
وأجاب 20.4% من إجماليّ أفراد العيّنة أنّهم يحتفلون بكلّ المناسبات التي طُرحت في هذا السّؤال أي الاحتفال برأس السّنة الميلاديّة وعيد الميلاد المجيد وعيد الأمّ وشهر رمضان المبارك، وتوزّعت نسبهم تبعًا لقيمة الدّخل الشّهريّ على الشّكل التّالي: 7.8% لدى الذين يبلغ الدّخل الإجماليّ للأسرة لديهم 3000$ وما فوق، 9.7% للّذين يتراوح الدّخل الإجماليّ لديهم بين 2000 و2999$، و2.9% للّذين يتراوح الدّخل الإجماليّ للأسرة لديهم بين 1000 و 1499$، أمّا الفئات الأخرى التي تتوزّع وفق المداخيل الأخرى فقد بلغت 0%؛ لأنّها لا تستطيع تكبّد هذه المصاريف والإنفاق على متطلّباتها نتيجة لانخفاض الدّخل الإجماليّ لأسرها؛ وعليه، فإنّها تكتفي بالتّركيز على مناسبات معيّنة رئيسة، مثل عيد الأمّ ورمضان، أو عيد الميلاد المجيد، كلٌ على حدة، أو بالجمع بين مناسبتين تعدّهما الأكثر أهمّيّة، كما ظهر من خلال قراءة هذا الجدول.
ورأى 7.8% من أفراد العيّنة أنّ شهر رمضان المبارك يُعدّ من المناسبات التي تدفع الفرد إلى زيادة الاستهلاك، نظرًا لما يختصّ به من عادات وتقاليد تُفضي إلى تنوّع وكثرة المشتريات، خصوصًا في مجال الأطعمة المخصّصة لهذا الشهر الكريم. ومن أبرزها التّمر الذي يُعَدّ جزءًا من سنّة الإفطار المأثورة عن الرسول الكريم ﷺ، إذ كان يفطر على التّمر واللّبن، إضافةً إلى أصناف الضّيافات التي تُقدَّم للزّائرين المهنّئين، وعلى رأسها الحلويّات العربيّة التي تتصدّر موائد رمضان مثل “الكربوج” و”ورد الشّام” و”النّابلسية” وغيرها، وهي أطعمة غالبًا ما ينتفي حضورها بعد انقضاء الشّهر الفضيل.
تركّزت نسبة الّذين يرون أنّ الاستهلاك في شهر رمضان يزداد لدى الفئة التي يتراوح دخل الأسرة الإجماليّ لديهم بين 2000 و2999$ (3.9%)، و1.9% لكلّ من الذين يتراوح دخلهم الإجماليّ بين 500 و 999$، وبين 1000 و1499$، هذا يبيّن أنّ حجم الدّخل الإجماليّ للأسرة يتحكّم بالزّيادة في الاستهلاك حتّى في المناسبات، وانعدمت هذه النّسبة 0% لدى الفئة التي يبلغ دخلها الإجماليّ دون 500$، أمّا الفئة التي يبلغ دخلها الإجماليّ 3000$ وما فوق رأت أيضًا أنّ شهر رمضان لا يزيد من نسبة الاستهلاك لديها، وقد يرجع الأمر في ذلك إلى قدرتها على سدّ حاجاتها الرّئيسة والثّانويّة، وإلى ارتفاع القدرة الشّرائيّة لديها خارج أيّام هذا الشّهر الفضيل، حيث يمكن لها أن تستهلك أصناف المأكولات والحلويّات الخاصّة بشهر رمضان، كما يمكن لها أن تقدّم الضّيافات المتنوّعة والمشهورة خلال شهر الصّيام والمعروفة بارتفاع أسعارها، خاصّة إن كانت تُباع في المحلّات المشهورة، إضافة إلى قدرتها على إقامة الولائم ودعوات الإفطار، وشراء ملابس جديدة استعدادًا لعيد الفطر الذي يلي شهر رمضان المبارك، في حين هذه القدرة الشّرائيّة تتراجع لدى الفئات الأخرى التي تحاول أن تعيش أجواء الشّهر الفضيل بتحضير ما يمكن تحضيره في المنزل بعيدًا عن الأسواق.
وبالعودة إلى الاحتفالات برأس السنة، تفضّل الأغلبيّة أن يودّعوا سنة ويستقبلوا سنة من خلال السّهر، وذلك يتطلّب إنفاقًا أكثر من حيث التّجهيزات إن من حيث شراء لباس جديد أو الذّهاب لصالونات الحلاقة وغيرها…
فقد ارتفعت هذه النّسبة لدى الفئات التي يرتفع دخلها الإجماليّ، أيّ 6.8% للذين يتراوح دخلهم بين 1000 و1499$، و4.9% للّذين يتراوح دخلهم الإجماليّ بين 1500 و 1999$ ، و3000$ وما فوق، 3.9% لدى الفئات الذين يتراوح دخلهم بين 500 و999$ و2000 و2999$، أمّا الفئة التي يبلغ دخلها الإجماليّ دون 500$ فإنّ هذه النّسبة بقيت سلبيّة 0%، ذلك أنّ الاحتفالات بهذه المناسبات تتطلّب زيادة في استهلاك الكثير من السّلع الكماليّة التي لا يمكن للدّخل أن يكون كافيًا لتأمينها وهذا ما بيّناه سابقًا في الجدول الذي يربط بين (الدّخل الإجماليّ للأسرة وبين قدرة الدّخل على سدّ الحاجات المختلفة للأسرة).
كما أشار 7.8% من إجماليّ أفراد العيّنة إلى أنّهم يحتفلون بالمناسبات الثّلاث: شهر رمضان المبارك وعيد الأمّ ورأس السّنة الميلاديّة، وهي تمثّل بالنّسبة إليهم الأهمّ. وقد توزّعت نسب هؤلاء بين الفئات الدّخليّة المختلفة على النحو الآتي: 2.9% لمن يتراوح دخلهم الإجماليّ بين 1000 و1499 $، و1% لمن يتراوح دخلهم بين 1500 و1999$، و3.9% لمن يتراوح دخلهم بين 2000 و2999$.
من خلال ما تقدّم، يتبيّن لدينا أنّ هناك مفاضلة و تحديد لسلّم الأولويّات، يتحكّمان في الاحتفال في المناسبات وفق أهمّيّتها ورمزيّتها، إلّا أنّ المناسبات الاجتماعيّة، كعيد الأمّ، تحظى باحتفاء شبه جماعيّ، يليها شهر رمضان المبارك، ثمّ رأس السّنة الميلاديّة وعيد الميلاد المجيد. ويختلف مستوى الاحتفال بهذه المناسبات باختلاف الدّخل الإجماليّ للأسرة، غير أنّ القاسم المشترك بينها جميعًا هو أنّها ترفع معدّلات الإنفاق، نظرًا لزيادة الاستهلاك لأنواع من السّلع التي تُعَدّ ضروريّة أو مرتبطة بطقوس هذه المناسبات.
- البُعد الاجتماعيّ والاقتصاديّ للاستهلاك في الأعياد
إنّ الإنفاق في هذه المناسبات يكبّد الأسرة أعباءً ماليّة تدفعهم إمّا للاستدانة من جهات معيّنة أو طلب قروض من المصارف، والمصارف في لبنان لا تضع قيودًا على أنواع القروض المُقدّمة بل تشجّع عليها، ممّا أسهم في تحوّل المجتمع اللّبنانيّ إلى مجتمع استهلاكيّ بامتياز، عداك عن أنّ الاستهلاك لا يقتصر على حاجات الأسرة حتّى لو كانت هذه الحاجات كماليّة بل تتعدّاها إلى تأمين النّفقات الاستهلاكيّة في المناسبات العائليّة والاجتماعيّة، وتمتاز النّفقات الاستهلاكيّة في هذه المناسبات بالتّفاخر، فهي إمّا هدايا مُقدّمة لأحد أفراد الأسرة مثل الأمّ أو للأصدقاء، وتحدّد قيمة هذه الهديّة المكانة الاجتماعيّة والمهنة والرّوابط الاجتماعيّة.
إنّ البحث في تأثير مستوى دخل الأسرة في قرار الشّراء واختيار السّلع الاستهلاكيّة وكيفيّة إحياء المناسبات، كما أدرجناه سابقًا، له أهمّيّة كبيرة في تحديد نمط استهلاك الأسرة، إلّا أنّ الدّخل وحده لا يكشف المستوى المعيشيّ للأسرة وقدرتها الشّرائيّة، بل يجب البحث عن مؤشّرات إضافيّة كعدد أفراد الأسرة العاملين، وإمكانيّة حصولها على مساعدات خارجيّة، أو على قروض مصرفيّة أو الاستدانة من الآخرين… وهذا ما بحثناه في هذه الدراسة، حيث طُرح سؤال حول وجود مصادر أخرى لتغطية النّقص في النّفقات، فجاءت النّتائج على الشّكل التّالي:
جدول 5: توزّع أفراد العيّنة وفق وجود مصادر أخرى لتغطية النّقص في النّفقات
| المتغيّرات | التّكرار | النّسبة المئويّة |
| عمل إضافيّ | 36 | 8.7 |
| عمل الزّوجة | 32 | 7.8 |
| عمل الأولاد | 4 | 1.0 |
| مساعدة الأهل | 4 | 1.0 |
| استدانة | 16 | 3.9 |
| عمل الزّوجة واستدانة | 60 | 14.6 |
| عمل إضافيّ وعمل الزّوجة | 8 | 1.9 |
| عمل إضافيّ واستدانة | 32 | 7.8 |
| عمل إضافيّ وعمل الزّوجة واستدانة | 8 | 1.9 |
| دخل الأسرة كاف | 164 | 39.8 |
| قروض | 48 | 11.7 |
| المجموع | 412 | 100.0 |
المصدر: العمل الميدانيّ الذي نفّذته الطّالبة بتاريخ 15 كانون الأوّل 2019
يُظهر (الجدول 5) أنّ 39.8% من أفراد عيّنة الدّراسة يرون دخل الأسرة لديهم كافيًا لسدّ حاجاتهم الحياتيّة، أمّا باقي العيّنة فتوزّعت نسبهم بين 14.6% يعتمدون على عمل الزّوجة وعلى الاستدانة لتغطية النّقص في نفقات الأسرة، وهناك 11.7% يعتمدون على القروض المصرفيّة أو من العمل، 8.7% يعملون عملًا إضافيًّا، و7.8% يلجأ الزوج إلى القيام بعمل إضافيّ والاستدانة، كما أن 7.8% يعتمدون على عمل الزّوجة، وهناك 1% فقط من أفراد عيّنة الدّراسة يعتمدون على عمل الأولاد، و1% يعتمدون على مساعدة الأهل.
ومن خلال احتساب نسبة الأفراد الذين تضمّنت إجاباتهم “الاستدانة أو القروض” (39.6%)، يتبيّن أنّه لا يمكن إغفال عامل الاستدانة أو طلب القروض من المصرف؛ لأنه يسهم في تحليل الهدف من استهلاك الأسرة وتحديد سلّم الأولويات لديها، والتّأكّد من الأسباب الجوهريّة وراء الاستدانة أو طلب القرض، ومعرفة مدى تأثّر الأسرة بالعادات والتّقاليد ودرجة الالتزام بمعايير الجماعة المرجعيّة، ومدى الاهتمام بإظهار مكانة اجتماعيّة مرموقة وإن كانت السّبب وراء الاستدانة أو طلب القرض…
إنّ لهذا البُعد أهمّيّة فيما تحقّقه من عمليّة الإشباع الاستهلاكيّ، فالعامل النّفسيّ يتمظهر في كونه سببًا يفرّق بين الأفراد في مستوى استجابتهم للضّغوط الاستهلاكيّة (الإعلانات، الإسراف في الإنفاق) في المجتمع، فهناك من يستجيب بقدر محدّد انطلاقًا من قدرته المادّيّة، وهناك من ينجرف في الاستجابة ويُستثار لدرجة تجعله قلقًا من تخطّيه قدرته الشّرائيّة، وتشير بعض الدّراسات أنّ هذا السّلوك راجع إلى اضطرابات في مفهوم الذّات، وإنّ بعض الأفراد يسعون للبحث عن الرّفاهية (بالحاج، 2017، صفحة 163)، “إذ أجمع الباحثون على أن الثّروة هي الوسيلة الأساس للوصول إلى الرّفاهية، بحيث تستعمل الاستعمال الأمثل من دون الإضرار بالفرد من النّواحي الصّحيّة والنّفسيّة”. (الدّسوقي وآخرون، 1988، صفحة 25)
ويشكّل الإعلام الذي يستخدم أسلوب الدّعاية وسيلة لإثارة حفيظة الفرد ودافعًا للاستهلاك لقيامه باستثارة الرّغبة الاستهلاكيّة من خلال عرض المنتجات بطريقة تسويقيّة احترافيّة خاصّة مع التّطوّر التّقنيّ الذي يُظهر إبداعًا تسويقيًّا في مجال التّسويق، فيُشكّل ويُنشئ داخل الفرد رغبة في شراء منتج ما، ونضيف أنّ وسائط التّواصل الاجتماعيّ قد تتحوّل إلى عامل من عوامل التّفاخر أمام الآخرين، سواء في العالم الإلكترونيّ أو الافتراضيّ، عندما تُستخدم كوسيلة لعرض ما استهلِك واقتنِي، فيوفّر لصاحبه شعورًا بالإشباع النفسي.
العوامل المؤثرة في الاستهلاك الأسري خلال الأعياد
يوجد العديد من العوامل التي تؤثّر في سلوك المستهلك، بحيث يمكنها أن تُحدث تغيير في اتّجاهاته الاستهلاكيّة، إلّا أنّنا سنعرض هنا أبرز العوامل المؤثّرة في استهلاك أفراد المجتمع، تحديدًا خلال الأعياد المستنتجة من القراءات والدّراسات والنّظريّات المتعلّقة بموضوع الاستهلاك، فاخترنا منها تلك التي تؤثّر على نمط الاستهلاك بشكل أكبر خلال الأعياد… وهي الجماعة المرجعيّة والتّقيّد بمعاييرها والمكانة الاجتماعيّة والمهنة والدّخل الأسريّ والقروض والاستدانة ووسائط التّواصل الاجتماعيّ.
1.9 الجماعات المرجعية والتقيّد بمعايير الجماعة (العوامل الاجتماعية)
تعرّف الجماعات المرجعيّة على أنّها “الجماعة التي تخدم الفرد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتكون كنقاط ومحطّات للمقارنة أو إطار يشكّل مواقف الأفراد وسلوكهم” (سويدان و حداد، 2009، صفحة 166).
كما تُعرّف على أنّها “مجموعة الأفراد التي تؤثّر إيجابيًّا أو سلبيًّا على الفرد في اتّجاهاته وسلوكيّاته، وعلى حكمه التّقويميّ” (Ladwein, 2003, p. 25).
وحتّى يكون للجماعة تأثير كبير وفعّال فس السّلوك الاستهلاكيّ للأفراد لا بدّ من توافر الشّروط التّالية: (خيرالدين، 1998، صفحة 11).
- أن تكون السّلعة موضع الاستهلاك سلعة يمكن رؤيتها وتحديدها بسهولة بواسطة الآخرين مثل الملابس والسّاعات اليدويّة والسّيّارات.
– أن تكون السّلعة محلّ الاستهلاك سلعة بارزة تلفت الأنظار ولا يمتلكها كلّ النّاس.
– أن تكون الجماعة مترابطة بدرجة كبيرة ممّا يشجّع على الاتّصالات المباشرة أو غير المباشرة بين أفرادها.
1.1.9 أهمّ الجماعات المرجعيّة ذات الصّلة بالمستهلك
هناك أنواع مختلفة من المجموعات التي يمكن أن تمثّل جماعة مرجعيّة ذات تأثير كبير في سلوك المستهلك وتتمثّل في: (عبيدات، سلوك المستهلك، مدخل إستراتيجي، دار وائل للتوزيع، 2004، صفحة 324)
- الأسرة: وتعدّ أكثر الجماعات الأساسيّة تأثيرًا في أنماط الأفراد المنضمّين تحت لوائها، وتكمن أهمّيّة الأسرة في التّواصل المستمرّ بين أفرادها، فتؤدّي إلى تكوين مواقف سلوكيّة متشابهة نسبيًّا لدى أفرادها تتّفق مع الأنماط الحياتيّة لها.
وتعدّ الأسرة أداة يتمّ من خلاها نقل التّراث الثّقافيّ عبر الأجيال، فهي بوابة بمقتضاها تتلقّى الأجيال القادمة عادات وتقاليد وقيم ومعتقدات الأجيال السّابقة، وهي أداة اجتماعيّة ضابطة لسلوك الأفراد في الدّاخل والخارج مع الجماعات الأخرى.
- الأصدقاء: وهم عمليًّا جماعة غير رسميّة؛ لأنّها عادة ما تكون غير منظّمة، وليس لديها فعليًّا أيّ سلطات رسميّة، ذلك أنّ كلّ ما يملكه الأصدقاء كجماعة مرجعيّة عبارة عن سلطة معنويّة، هدفها التّأثير النّسبيّ في مواقف ومشاعر أصدقائهم نحو مختلف القضايا والأمور المعيشيّة المرتبطة بالعديد من السّلع والخدمات.
- جماعات العمل: قد يتجاوز الوقت الذي يمضيه الأفراد في العمل أو في وظائفهم وغيرها نصف الوقت المتاح لهم كلّ أسبوع؛ وبناءً عليه، يبدو أنّ هناك فرصة كبيرة أمام الأفراد العاملين في وظائف دائمة التّفاعل مع بعضهم بعضًا في معظم الأمور الحياتيّة والمعيشيّة.
2.1.9 المفاهيم المرتبطة بالجماعات المرجعيّة
توجد مجموعة من المفاهيم التي ترتبط كثيرًا بالجماعات المرجعيّة التي نوردها فيما يلي: (varcem, 1994, pp. 127-128).
- العرف: هو عبارة عن قواعد تحدّد أو تمنع سلوكًا معيّنًا في مواقف معيّنة، وتتمثّل وظيفة الجماعات المرجعيّة في توجيه سلوك الأفراد مثل اختيار الأغذية الصّحيّة والسّير على اليمين والطريقة المناسبة لارتداء الملابس في المناسبات والحفلات الدّينيّة والوطنيّة وغيرها، ويستمد الفرد العرف من القيم الثّقافيّة، وكلّ فرد يعمل على مخالفة أو الابتعاد عن العرف ستقوم الجماعة المرجعيّة إلى مقاطعته وتوقيع الجزاء عليه.
- الأدوار: وهي المهام التي يقوم بها الفرد أو تلك التي تحدّدها له الجماعة، فهي النّماذج الموضوعيّة للسّلوك، والمتوقّعة من الفرد في موقف معيّن؛ وبناء على الوضعيّة التي يحتلّها في ذلك الموقف، إذ يمكن للفرد الواحد أن يقوم بأدوار عدّة، فيتطلّب منه سلوكيّات مختلفة، ولكلّ دور محدّدات معيّنة تضبطه. ولتوضيح الأدوار التي يمكن لربّ العائلة مثلًا تقلّدها ندرج الشّكل التّالي:
- المكانة: هي تحديد الوضعيّة التي يحتلّها الفرد في الجماعة التي ينتمي إليها، وكذلك نفوذه وسلطته وتأثيره، فالمكانة تعكس الاحترام والتّقدير الذي يتمتّع بها الشّخص من قبل الجماعة” (الخطيب وعواد، 2000، ص.49).
- التّنشئة الاجتماعيّة: وهي عبارة عن الإجراءات التي يكتسب بواسطتها المهارات والعرف والاتّجاهات الضّروريّة لأداء الأدوار التي يتوقّع من الفرد القيام بها، فيحدث تكييف الطّفل مثلًا من خلال التّعليمات من والديه أو عن طريق المشاهدة المثمرة لسلوكهما وسلوك أفراد العائلة الأكبر سنًّا(بن عيسى، 2007، صفحة 178).
3.1.9 أثر الجماعات المرجعيّة على سلوك المستهلك
إنّ مفهوم الجماعة يدخل ضمن هذه الدّراسة بما له من تماس مباشر بعمليّة الاستهلاك عامّة، وما له من تأثير فيالاستهلاك التّفاخري وعلى أسلوب العيش لدى المستهلك.
إن الانجذاب نحو الجماعة يدفع الأفراد للتّقيّد بمعاييرها بهدف تحقيق الذّات وإثبات الهويّة ضمن الجماعة، وبالمقابل كلّ من لم يمتلك الثّقة بالنّفس أو تقدير الذّات فإنّه يصبح مُبعدًا عنها.
أظهر فيبلين (Veblen) أنّ الأفراد لديهم ميل نحو التّقيّد بمعايير الجماعة التي ينتمون إليها، وميل نحو الاقتراب من نمط استهلاك الجماعة الأعلى منهم، ويحدّد أنّ تأثير الجماعة في السّلوك الاستهلاكيّ يقوم على أمرين: أوّلًا الصّفة العامّة أو الخاصّة للاستهلاك وثانيًا نوع السّلعة.
وفي المقابل، هناك مستهلكون لديهم رغبة في الاختلاف عن الجماعة من خلال الشّعور بالتّميّز، ومثال على ذلك عند شراء الملابس، حيث يصبح عدم التّقيّد بمعايير الجماعة هدفًا لإظهار الاختلاف عنهم، وبالتّالي إعطاء هويّة ذاتيّة للفرد تتميّز عن الآخرين. إنّ عمليّة الاختلاف هذه تحدّث عنها فيبلين وعبّر عنها بمصطلح التّكبّر (Tian, 2001, pp. 20-66).
2.9 دور العادات والتّقاليد في الدّفع نحو الاستهلاك
اختلف العلماء والباحثون في استعمال مفهوم العادات والتّقاليد فهناك من يجمع بين العادات والتّقاليد على أنّهما مفهوم واحد وهناك من يميّز بينهما بحيث يدرس العادات لوحدها والتّقاليد لوحدها.
- العادات
“العادة الاجتماعيّة هي كلّ سلوك متكرّر يُكتسب اجتماعيًّا ويُتعلّم اجتماعيًّا، ويرى إدوارد سابير Edward Sapir)) أنّ العادة الاجتماعيّة مصطلح يستعمل للدّلالة على مجموع الأنماط السّلوكيّة التي تحتفظ بها الجماعة وترسمها تقليديًّا (by tradition) وهذا يميّزها عن النّشاطات التي يقوم بها الفرد. فالعادات الاجتماعيّة بإجماع علماء الاجتماع هي الدّعائم الأولى التي يقوم عليها التّراث الثّقافيّ في كلّ بيئة اجتماعية… وهي الأصول الأولى التي استمدّت منها النّظم والقوانين مادّتها، كما أنّها القوى الموجّهة لأعمال الأفراد وحياتهم” (دياب، 1966، الصفحات 104-108).
- التّقاليد الاجتماعيّة
هي أنماط من السّلوك تتضمّن القيم الذّاتيّة التي تعتزّ بها الجماعة، كما تتضمّن أنواعًا من التّفكير والتّصوّرات والمعتقدات الخاصّة بها والسّائدة فيها التي تنتقل بينها من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل (شكري، 2002، صفحة 300).
والتّقليد يهتمّ بمجمل التّصرّفات وأنماط السّلوك التي تتجلّى في مناسبات معيّنة اجتماعيّة كانت أو دينيّة؛ وبمعنى أعمّ وأشمل المناسبات الشّعبيّة، ويتصرّف إزاءها بمخزون ثقافيّ مستمدّ من تراث يؤمن بالتّواصل بين الماضي والحاضر فيغتني بتراكمات تشكّل بمجموعها تراث المستقبل. (عطية، 1996، صفحة 29).
إنّ غالبيّة اللّبنانيّين يواجهون عبئًا بسبب الإنفاق المتزايد في المناسبات إلّا أنهم يرفضون التّخلّي عن العادات والتّقاليد التي تتسبّب في زيادة الإنفاق والاستهلاك في هذه المناسبات، ومؤشّره السّوسيولوجي أنّ هذه العادات والتّقاليد إلى جانب تحلّيها بسمة العطاء ومحاولة تقديم ماهو مادّيّ ومعنويّ خير دليل على المحبّة، إذ تشكّل عاملًا مهمًّا لتقوية العلاقات الاجتماعيّة، وجامعًا، ليس فقط للجماعات التي تتشابه فيما بينها من حيث الانتماء الدّينيّ أو الطّائفيّ، بل تتعدّى الاختلاف الدّينيّ والطّائفيّ لتحلّ أجواء العيد على المجتمع ككلّ، فيشعر الجميع بفرحة حلول عيد الميلاد ورأس السّنة، كما يشعر الجميع ببركة حلول شهر رمضان المبارك، فيهيؤون للأعياد حسب قدرتهم الشّرائيّة من جهة وقناعتهم بمدى الإنفاق والاستهلاك من جهة أخرى، وذلك كلّه تحت تأثير مقوّمات عدّة مثل المستوى التعليميّ والمهنة والمركز الاجتماعي… فتؤدّي دورًا في الدّفع أو التّأنّي بمستوى الاستهلاك.
وعليه، فإنّ الإنفاق في هذه المناسبات وإن سبّب عبئًا على الفرد وعلى اقتصاد الأسرة إلّا أنّ العادات والتّقاليد الاستهلاكيّة التي تتّسم في هذه المناسبات هي أقوى من أن يتخطّاها الفرد.
تعبّر المكانة بحسب علم الاجتماع، عن الوضع الذي يشغله الشّخص أو الأسرة أو الجماعة القرابيّة في النّسق الاجتماعيّ بالنّسبة إلى الآخرين، وقد يحدّد هذا الوضع الحقوق والواجبات وأنواع السّلوك الأخرى بما في ذلك طبيعة ومدى العلاقة بأشخاص آخرين لهم مكانات مختلفة.
وتُحدّد المكانة الاجتماعيّة بالمستوى التّعليميّ والدّخل والممتلكات والتّقويم الاجتماعيّ للمهنة وبعض الأنشطة الأخرى في المجتمع.
كما عرّف رالف لينتونRalph Linton المكانة، ويعني بها وضع الفرد في المجتمع، وحدّده بأنّه مجموعة الحقوق والالتزامات، وهذه المكانة هي التي تحدّد دور الفرد في مجتمعه (غيث، 1989، صفحة 47).
ومن خلال المقابلات التي أجريت مع أصحاب متاجر الحلويّات في المدن مثل مدينة صيدا والقرى مثل العباسيّة فقد تبيّن لدينا أنّه في بعض المناسبات مثل شهر رمضان ورأس السّنة يُقبل على شراء أنواع معيّنة من الحلويّات تنفرد بها هذه المناسبات ولا تُصنع في باقي أيّام السنة، وعلى الرّغم من ارتفاع سعرها نتيجة ارتفاع تكلفتها المرهونة بتقلّبات سعر الصرف ما زال الإقبال على شراء هذه الأنواع من الحلويّات موجودًا، وهذا مؤشّر على أنّ المناسبات الاجتماعيّة تتّسم بعادات وتقاليد استهلاكيّة لا يمكن تخطّيها؛ ولكن، هل لهذه السّلوكيّات الاستهلاكيّة في المناسبات الاجتماعيّة أعباء على اقتصاد الأسرة؟ هذا ما سنبينه في الجدول التّالي.
جدول 6: توزّع أفراد العيّنة وفق تصريحهم بوجود عبء على اقتصاد الأسرة بسبب الأعياد وتبعًا لتخطّيهم العادات والتّقاليد
| وجود العبء على اقتصاد الأسرة بسبب المناسبات | المجموع | |||||
| نعم | لا | أحيانا | ||||
| تخطّي العادات والتّقاليد لتوازن اقتصاد أسر المبحوثين | نعم | التّكرار | 4 | 0 | 4 | 8 |
| النّسبة المئويّة | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | ||
| المجموع | 1.0% | 0.0% | 1.0% | 1.9% | ||
| لا | التّكرار | 180 | 164 | 60 | 404 | |
| النّسبة المئويّة | 44.6% | 40.6% | 14.9% | 100.0% | ||
| المجموع | 43.7% | 39.8% | 14.6% | 98.1% | ||
| المجموع | التّكرار | 184 | 164 | 64 | 412 | |
| النّسبة المئويّة | 44.7% | 39.8% | 15.5% | 100.0% | ||
| المجموع | 44.7% | 39.8% | 15.5% | 100.0% | ||
المصدر: العمل الميدانيّ الذي نفّذته الطّالبة بتاريخ 15 كانون الأوّل 2019
بعد أن تبيّن لنا سابقًا أنّ الاستهلاك يتضاعف في الأعياد والمناسبات لدى مختلف الفئات، كان لا بدّ من الرّبط بين إمكانيّة تخطّي العادات والتّقاليد المُصاحِبة لإحياء هذه المناسبات التي تتّسم بالإنفاق الذي يُثقل كاهل الأسرة وتبعاتها على اقتصاد الأسرة.
يُظهر الجدول (6) أنّ 44.7% من إجماليّ أفراد العيّنة أفادوا بوجود عبء على اقتصاد الأسرة بسبب المناسبات. وقد توزّعت هذه النّسبة وفق مدى إمكانيّة تجاوز العادات والتّقاليد المرتبطة بالمناسبات، إذ أعرب 43.7% عن رفضهم لتخطّي هذه العادات لما لها من رمزيّة في توطيد العلاقات الإنسانيّة، سواء على المستوى الأسريّ أم الاجتماعيّ، في حين رأى 1% إنّه يمكن تجاوزها حفاظًا على توازن اقتصاد الأسرة.
وهناك 39.8% من إجماليّ أفراد العيّنة أفادوا أنه لا يوجد عبء على اقتصاد الأسرة بسبب المناسبات وما يرافقها من أنماط استهلاكيّة، وانحصرت هذه النّسبة جميعها في رفضها لتخطّي هذه العادات والتّقاليد الإنفاقيّة من أجل توازن اقتصاد الأسرة.
في حين إنّ 15.5% من إجماليّ أفراد العيّنة أفادوا أنّه يوجد -أحيانًا- عبء على الأسرة بسبب هذه المناسبات، وتوزّعت بين 14.6% رفضوا تخطّي هذه العادات والتّقاليد، و1% أبدوا رغبتهم في تخطّي هذه العادات والتّقاليد التي تسبّب عبئًا نتيجة الإنفاق في المناسبات.
استنادًا إلى ما سبق، نرى أنّ غالبيّة أفراد العيّنة أفادوا أنّه يوجد عبء بسبب الإنفاق المتزايد في المناسبات، وأيضًا أفادوا أنّ له تأثيرًا في اقتصاد الأسرة إلّا أنّهم رفضوا التّخلّي عن العادات والتّقاليد التي تتسبّب في زيادة الإنفاق والاستهلاك في هذه المناسبات، ومؤشّره السّوسيولوجيّ أنّ هذه العادات والتّقاليد إلى جانب تحلّيها بسمة العطاء ومحاولة تقديم ما هو ماديّ ومعنويّ خير دليل على المحبّة، إذ تشكّل عاملًا مهمًّا لتقوية العلاقات الاجتماعيّة، وجامعًا، ليس فقط للجماعات التي تتشابه فيما بينها من حيث الانتماء الدّينيّ أو الطّائفيّ، بل تتعدّى الاختلاف الدّينيّ والطّائفي لتحلّ أجواء العيد على المجتمع ككلّ.
وعليه، فإنّ الإنفاق في هذه المناسبات وإن سبّب عبئًا على الفرد وعلى اقتصاد الأسرة إلّا أنّ العادات والتّقاليد الاستهلاكيّة التي تتّسم في هذه المناسبات هي أقوى من أن يتخطّاها الفرد وهذا بالتّحديد ما أوضحته نتائج هذا الجدول.
وإذ نرى أنّ الأسر اللّبنانيّة تحرص على التّقيّد بمعايير الجماعة من حيث نوع الضّيافات والتّجهيز للأعياد، فلا ترضى أن تكون دون المستوى الاجتماعيّ للمحيطين بها، وتطمح في تقديم كلّ ما هو مميّز عن الآخرين وكلّ ما يتمتّع بمواصفات ودلالات طبقيّة. ويسعى أفراد الأسر، خاصّة خلال فترة الأعياد، إلى إظهار مكانة اجتماعيّة مرموقة، ليس فقط عبر ممتلكاتهم المادّيّة الفخمة من أثاث منزل أو سيارة أو هاتف محمول وملابس، بل أيضًا عبر ما يقدّمونه للزوّار من ضيافة ووجبات وإكسسوارات وزينة… تتّسم كلّها بعلامات تجاريّة مرموقة ومعروفة تشير إلى أسعارها المرتفعة، وذلك استدلالًا على قدرتهم الشّرائيّة العالية، فيؤدّي إلى زيادة في الإنفاق خلال الأعياد والمناسبات الاجتماعيّة.
من هنا نستنتج وجود علاقة بين الاهتمام بالمكانة الاجتماعيّة وبين الميل نحو الاستهلاك، ممّا يؤكد الفرضيّة الأولى التي تنصّ على أنّه: يوجد علاقة طرديّة بين الاهتمام بالمكانة الاجتماعيّة وبين ميل الأسرة نحو الاستهلاك خلال الأعياد.
ينعكس الوضع الاقتصاديّ للفرد على اختياره للسّلعة؛ وبالتّالي على نمط استهلاكه، وهناك عدد من المتغيّرات التي تحدّد المستوى الاقتصاديّ إمّا على مستوى الفرد (محدّدات استهلاك الفرد) وتشمل العمر والمستوى التّعليميّ ومستوى الدّخل ونوع المهنة، وإمّا على مستوى الأسرة (محدّدات استهلاك الأسرة) وتشمل حجم الأسرة والمستوى التّعليميّ لربّ وربّة الأسرة ومستوى دخل الأسرة ونوع مهنة ربّ وربّة الأسرة.
ممّا لا شكّ فيه أنّ العمر يؤثّر على احتياجات الإنسان ورغباته وذوقه وحتّى في طريقة شرائه للأشياء؛ فيختلف نمط الاستهلاك بين الأجيال بسبب اختلاف الاهتمامات والأذواق والحاجات، حيث تنجذب فئة الشّباب إلى أنواع معيّنة من السّلع والخدمات خاصّة تلك التي تلقى رواجًا إعلاميًّا وقبولًا لدى الآخرين، فيما يرغب الأكبر سنًّا في الحصول على المنتجات التي تلبّي حاجاتهم بشكل عمليّ.
فالأشخاص يغيّرون مشترياتهم خلال فترة حياتهم، ويرصد المسوّقون هذه التّغيّرات فيحدّدون السّلع والمنتجات والخدمات في الأسواق تبعًا لكلّ فئة عمريّة ويضعون الخطط الملائمة لها.
هناك علاقة وثيقة بين المستوى التّعليميّ للأفراد وبين مستوى الادّخار أو شكل الاستهلاك لديهم، إذ يؤثّر التّعليم بصورة غير مباشرة في معدّلات نموّ الدّخل القوميّ من خلال التّأثيرات التي يتركها في معدّلات الادّخار وفي حجم الموارد التي تُخصّص للاستهلاك والاستثمار؛ ولهذا تعدّ النّماذج التي تُستخدم في قياس معدّلات نموّ الدّخل القوميّ استنادًا إلى مؤشّرات الادّخار وترشيد الاستهلاك نماذج صالحة لبيان دور التّعليم في النّموّ الاقتصاديّ استنادًا إلى هذين المؤشرين، بعد أن يُحدّد دور التّعليم في التّأثير في معدّلات الادّخار وشكل الاستهلاك، ويتطلّب هذا التّحديد إجراء دراسات تكشف عن مدى التّأثير الذي يتركه المستوى التّعليمي للأفراد والمجتمع في حجم الادّخار وفي صيغ الاستهلاك (سلامة،2010، ص. 112).
كما يؤثّر التّحصيل العلميّ على النّزعة الاستهلاكيّة، من حيث القدرة الذّهنيّة على تحديد أولويّات الصّرف الشّهريّ، وحساب كافّة التّكاليف والأعباء الشّهريّة التي تقع على عاتق الأسرة، ومن حيث درجة التّأثر بالعروض الاستهلاكيّة والمؤثّرات التّسويقيّة والدّعايات والإعلانات، ومن حيث درجة استيعاب برامج ترشيد الاستهلاك؛ ليكون اقتناءه للسّلع حسب الحاجة الفعليّة لها.
إنّ مقدار دخل الإنسان يؤثّر على نوعيّة مشترياته ومعدّلات صرفه على الضّروريّات والكماليّات، فالأغنياء لهم أولويّات في مشترياتهم تختلف عن أولويّات الشّراء لدى ذوي الدّخل المحدود.
فالدّخل هو تلك الموارد الماليّة الممنوحة للفرد التي تمكّنه من شراء مختلف السّلع والخدمات، ويُحدّد نصيب الفرد من الدّخل بحاصل قسمة الدّخل القوميّ الإجماليّ على عدد السّكّان الكلّيّ داخل الدّولة. وتعدّ معرفة دخل المستهلك أمر أساسيّ ومهمّ في دراسة وتحديد العمليّة الاستهلاكيّة، وقد نجد تعدّدًا في المداخيل الماليّة للمستهلك كالرّاتب النّاتج عن العمل الذي يزاوله الفرد كالمعاش والمكافآت… أو الثروة التي يملكها من خلال امتلاك بعض الأراضي (عون، 1985).
وبالعودة إلى إحياء المناسبات الاجتماعيّة في لبنان، نجد أنّ للهدايا أهمّيّة رمزيّة لدى الأسر اللّبنانيّة، فالكلّ يسعى إلى تقديم الهدايا في الأعياد، على الرّغم من الضّائقة الاقتصاديّة، حتّى لو اضطرّ إلى الاستدانة أو تحصيل قرض من العمل.
وتلجأ العديد من الأسر إلى الاعتماد على عمل الزوجة بشكل أساسيّ؛ لسدّ العجز في قدرة الأسرة على الإنفاق، وثانيًا على الاستدانة أو طلب القروض، ولا يقف حدّ الاستدانة لتأمين الحاجات الضّروريّة، بل يتعدّاه كذلك لتلبية مستلزمات الأعياد. هذا وقد تبيّن أنّ الأسر اللّبنانيّة يكثر استهلاكها بالدّرجة الأولى خلال شهر رمضان المبارك وفي عيد الأم، وبالدّرجة الثّانية في عيد الميلاد ورأس السنة.
بالتّالي، نجد أنّ الدّخل الشّهريّ للأسرة يؤدّي دورًا أساسيًّا في تحديد نمط استهلاك الأسرة، حيث كلّما ارتفعت قيمة الدّخل ارتفع مستوى الميل نحو الاستهلاك. فتتأكّد لدينا الفرضيّة الثّانية التي تنصّ على أنّ: هناك علاقة ذات دلالة إحصائيّة بين قيمة الدّخل الشّهريّ ونمط الاستهلاك لدى الأسرة في محافظة لبنان الجنوبيّ خلال الأعياد.
تعدّ مهنة الفرد من العناصر الشّخصيّة المؤثّرة في نمط استهلاكه، وهي تدخل ضمن محدّدات مكانة الفرد الاجتماعيّة، فالمهنة لها تأثير في سلوك المستهلك الشّرائيّ وعلى النّزعة الاستهلاكيّة لديه، فعندما يقرّر شراء سلعة معيّنة فهذا يعود إلى شعوره بالحاجة إلى هذه السّلعة التي تتلاءم مع طبيعة عمله (حسين، 2000، صفحة 306).
إنّ الاحتفال بالأعياد يتطلّب تجهيز أنواع معيّنة من الضّيافات تختلف من عيد لآخر، إلّا أنّه توجد أنواع معيّنة من الضّيافات هي أساسيّة ورئيسة مثل السّكاكر والشّوكولا مثلًا إلّا أنّ ما يتحكّم بهذه الضّيافة هي النّوعية المجهّزة للتّقديم، وهذه تخضع للمكانة الاجتماعيّة التي ينتمي إليها الفرد والتي تحدّدها متغيّرات عدّة منها متغيّر المهنة.
ويتزايد الإنفاق كلّما اتّسعت رقعة المعارف التي يفرضها النّوع الوظيفيّ للأفراد أو المهنة، إذ إنّ أصحاب المهن الحرّة والموظّفين في قطاع الخدمات هم الفئتان اللّتان يزداد لديهما الإنفاق في المناسبات؛ لأنّهم يتخطّون الاحتفال بالمناسبات العائليّة إلى الاحتفال بالمناسبات الخاصّة بالمعارف والأصدقاء، فيزداد مستوى الإنفاق لديهم، كذلك لا يجب أن نغفل عن دور الدّخل الذي يمنح أصحاب هذه المهن قدرة شرائيّة؛ إذًا، هناك علاقة قائمة بين الإنفاق في المناسبات والأعياد وتقديم الهدايا والمهنة التي تحدّد ضمنًا المكانة الاجتماعيّة للفرد.
وليس الاهتمام بالمكانة الاجتماعيّة وحده ما يدفع أفراد الأسرة إلى زيادة إنفاقهم على السّلع والخدمات خلال الأعياد والمناسبات، بل تبيّن أنّ المستوى التّعليميّ يحتّم على الفرد زيادة في الاستهلاك، إذ كلّما ارتفع المستوى التّعليمي ارتفع استهلاك الأجهزة الإلكترونيّة من هواتف ولابتوب وأدوات لم تعد ضمن خانة الكماليّات بل أصبحت من الأساسيّات. كما أنّ ارتفاع المستوى التّعليميّ يزيد من رغبة الفرد في شراء المنتجات الأجنبيّة المستوردة، فتبيّن أنّ لدى اللّبنانيّ ولع بكلّ ما هو مستورد من الخارج من أنواع أطعمة وألبسة وأدوات ألكترونيّة وعطورات وأكسسوارات.
وإلى جانب المستوى التّعليميّ، تعدّ المهنة من مقوّمات المكانة الاجتماعيّة، فعلى اختلاف أنواع المهن التي يمارسها اللّبنانيّون، يحرص الجميع على تجهيز ضيافة مميّزة للأعياد إلّا أنّ العاملين في قطاع المهن الحرّة كان لديهم القدرة الماليّة على تحضير الضّيافات وشراء الهدايا للأولاد والأهل والأصدقاء من دون أن يرتفع مستوى العبء الاقتصاديّ لديهم، عكس أحوال العاملين في القطاع العامّ.
ويؤدّي عمل المرأة دورًا هامًّا في زيادة مستوى الإنفاق الأسريّ في الأعياد والمناسبات، حيث يسهم في توسيع دائرة تقديم الهدايا وتنوّع الضّيافة ومصادرها.
وبالتّالي، يمكن استنتاج تأثير متغيّر مهنة الفرد في نمط الاستهلاك الأسري، فتتأكّد الفرضيّة الثّالثة التي تنصّ على أنّ: هناك علاقة ذات دلالة إحصائيّة بين نوع المهنة ونمط الاستهلاك الأسريّ خلال الأعياد.
تمتلك وسائط التّواصل الاجتماعيّ نفوذًا قويًّا ومباشرًا على الأفراد، حيث لديها القدرة على تغيير الاتّجاهات والسّلوك والآراء والميول بما يتناسب مع سياسات المستخدم والمتلقّي، ويبيّن أصحاب هذه النّظريّة اعتقادهم على بعض الافتراضات النّفسيّة والاجتماعيّة المستمدّة من علم النّفس والاجتماع السّائدة، ففي المجال النّفسيّ ساد الاعتقاد أنّ الجمهور تحرّكه عواطفه وغرائزه التي ليس بمقدوره السّيطرة عليها بشكل إراديّ، فإذا استطاعت وسائط التّواصل الاجتماعيّ إعطائهم معلومات تخاطب غرائزهم، فإنّهم سيتأثّرون مباشرة بها، ولعلّ الاستهلاك أحد أوجه هذا التّأثير، حيث إنّ المتلقّين هم الجمهور، يتلقّون كمًّا كبيرًا من المثيرات والمغريات خاصّة أنّ وسائط التّواصل الاجتماعيّ أصبحت منصّات إعلاميّة واعلانيّة، أتاحت إمكانيّة انتقال الفرد إلكترونيًّا من متلقٍ إلى صانع المعلومة ومسوّقها، كما أنّ ما حدث من ثورات عربيّة دليلًا على أهمّيّة ومكانة هذه الوسائط في مجريات الأحداث.
أمّا في الجانب الاجتماعيّ، فقد ساد الاعتقاد أنّ الأفراد في المجتمعات الجماهيريّة هي مخلوقات معزولة عن بعضها بعضًا نفسيًّا واجتماعيًّا، ولا توجد روابط قويّة تجمعهم؛ لذا هم فريسة سهلة لا يوجد من يحميها من وسائط التّواصل الاجتماعيّ (حلمي، س، 2003، صفحة 39).
وهكذا تكون وسائط التّواصل الاجتماعيّ قويّة جدًّا وقادرة على توجيه الآراء والاتّجاهات على خلاف ما كانت عليه، فبالتّكرار والإشارة يكون الفرد أمام مواجهة شرسة، وتكون أمامه عوائق متنوّعة؛ فإمّا أن ينتصر على ذاته وإمّا أن تكون العوامل الاجتماعيّة والثّقافيّة والمادّيّة قد تغلّبت عليه، والأمثلة كثيرة عمّا أحدثته وسائط التّواصل الاجتماعيّ بالحياة الأسريّة بالعلاقات الاجتماعيّة، فكما أنّها أصبحت مجتمعًا موازيًا للمجتمع الواقعيّ، فإنّه يحقّ لها كما يحقّ له، وهذا الحقّ يكون على حساب التّواجد في المجتمع الواقعيّ، “لهذا السّبب تكون وسائط الإعلام الحديثة قويّة من جانب الاستهلاك وما تعرفه من تفاخر وثقافات مختلفة تتأثّر بها الجماهير الإلكترونيّة وخاصّة جمهور النّساء”. (حلمي، س، 2003).
أوجدت وسائط التّواصل الاجتماعيّ نمطًا تسويقيًّا جديدًا وهو التّسوّق أون لاين، ولم يعد التّسوّق التّقليديّ هو نمط التّسوّق الوحيد الموجود أي ذلك الذي يتطلّب من الفرد النّزول إلى الأسواق والمراكز التّجاريّة من أجل التّبضّع.
إنّ التّسوّق عبر وسائط التّواصل الاجتماعيّ والتّسوق الأونلاينيّ أصبح أكثر استخدامًا عقب إجراءات الإغلاق التّامّ لكافّة المحالّ والمراكز التّجاريّة التي فرضتها جائحة كورونا، فأوجد ذلك الحاجة إلى التّسوّق الأونلاينيّ من أجل تأمين السّلع الاستهلاكيّة إلّا أنّ وسائط التّواصل الاجتماعيّ أدّت دورًا مهمًّا ومؤثّرًا في تحديد أنواع السلع، إذ إنّها وسائط تسويقيّة بامتياز، وذلك من خلال إمكانيّة توفير عرض المنتج وعرض مواصفاته بطريقة جاذبة وملفتة، أضف إلى ذلك أنّ العرض الدّائم والمستمرّ على مختلف هذه الوسائط من شأنها أن تدفع الفرد لشرائها حتّى لو لم تكن هناك حاجة ماسّة إليها؛ وبالتّالي، فإنّ متابعة وسائط التّواصل الاجتماعيّ من شأنها أن تزيد من نسبة الاستهلاك وخاصة لما توفّره من خدمة توفير الوقت في التّسوّق وفي إيصال السّلع المستهدف شراءها.
كما أنّ التّسوّق عبر وسائط التّواصل الاجتماعيّ من شأنه أن يزيد السّلوك التّفاخريّ لدى المتسوّقين من خلال عرض السّلع التي تسوّقوها، والتّباهي بها على الصّفحات الخاصّة لوسائط التّواصل الاجتماعيّ؛ من هنا، فإنّ وسائط التّواصل الاجتماعيّ لا تؤثّر فقط في خيارات السّلع بل تشكّل عاملًا دافعًا لاقتنائها، خاصّة أنّ الإعلان له دور مؤثّر من خلال التّرويج المستمرّ لسلع معيّنة في شرائها.
إذًا، استطاعت وسائط التّواصل الاجتماعي توفير ومنح المستهلك المزيد من السّلع والخدمات لإشباع حاجاته المادّيّة إلّا أنّ هذا الإشباع للحاجات المادّيّة كان له أثر على الشّقّ النّفسيّ الذي أثقلته التّكاليف المادّيّة، خاصّةً إذا رُبط بين النّتائج التي تّوصّلنا إليها مسبقًا وهي الأعباء الاقتصاديّة على الأسرة والفرد معًا الذي سبّبه الضّغط الاجتماعيّ الفارض لنمط حياة أوجب الفرد الالتزام به، وإلّا فسيبقى الشّعور الدّائم بالإحباط نتيجة التّفاوت والفوارق الاجتماعيّة والانتماءات الطّبقيّة التي بلغت درجة صارخة، والخوف من عدم القدرة على الحصول على هذه المنتجات والسّلع، وهو خوف يرتبط بدوره بعدم الاستقرار النّاجم عن غياب الأمن الوظيفيّ في ظلّ الوضع الاقتصاديّ المتردّي الذي نعيشه.
من هذا المنطلق، هدفتُ إلى الكشف عن تأثير وسائط التّواصل الاجتماعيّ في سلوك المستهلك اللّبنانيّ في محافظة لبنان الجنوبيّ أثناء الأعياد. ولتحقيق ذلك، جرى البحث في أكثر هذه الوسائط متابعةً عند اختيار الهدايا من جهة، وفي مدى متابعة الإعلانات عبرها من جهة أخرى، فجاءت النّتائج على النحو الآتي:
جدول 7: توزّع أفراد العيّنة وفق متابعتهم للإعلانات على وسائط التّواصل الاجتماعيّ لاختيار الهدايا وتبعًا لأكثر الوسائط متابعة
| توزّع المبحوثين حسب متابعة الإعلان على وسائط التّواصل لاختيار الهدايا | المجموع | |||||
| نعم | لا | احيانا | ||||
| أكثر وسائط التّواصل الاجتماعيّ متابعة لاختيار الهدايا | غوغل | التّكرار | 4 | 0 | 0 | 4 |
| النّسبة المئويّة | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | ||
| المجموع | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | ||
| فايس بوك وإنستغرام وغوغل | التّكرار | 124 | 0 | 16 | 140 | |
| النّسبة المئويّة | 88.6% | 0.0% | 11.4% | 100.0% | ||
| المجموع | 30.1% | 0.0% | 3.9% | 34.0% | ||
| فايس بوك وإنستغرام | التّكرار | 146 | 0 | 18 | 164 | |
| النّسبة المئويّة | 89.0% | 0.0% | 11.0% | 100.0% | ||
| المجموع | 35.4% | 0.0% | 4.4% | 39.8% | ||
| لا أتابع الإعلانات | التّكرار | 4 | 95 | 5 | 104 | |
| النّسبة المئويّة | 3.8% | 91.3% | 4.8% | 100.0% | ||
| المجموع | 1.0% | 23.1% | 1.2% | 25.2% | ||
| المجموع | التّكرار | 278 | 95 | 39 | 412 | |
| النّسبة المئويّة | 67.5% | 23.1% | 9.5% | 100.0% | ||
| المجموع | 67.5% | 23.1% | 9.5% | 100.0% | ||
المصدر: العمل الميدانيّ الذي نفّذته الطّالبة بتاريخ 15 كانون الأوّل 2019
يُبيّن الجدول (7) توزّع أفراد العيّنة وفق متابعتهم لوسائط التّواصل الاجتماعيّ بهدف اختيار الهدايا، ومدى تأثير هذه الوسائط فيهم في متابعة الإعلانات. وقد تبيّن أنّ 67.5% من إجماليّ أفراد العيّنة يتابعون الإعلانات المعروضة عبر هذه الوسائط لاختيار هداياهم. وتوزّعت نسب المتابعة على النّحو الآتي: 88.6% يتابعون كلًّا من فايسبوك وإنستغرام وغوغل معًا، و35.4% يتابعون فايسبوك وإنستغرام فقط، في حين يتابع 1% غوغل وحده، وهي النّسبة نفسها التي لا تتابع الإعلانات على الإطلاق عبر وسائط التّواصل الاجتماعيّ.
وهناك 23.1% من إجماليّ العيّنة أجابوا بأنّهم لا يتابعون وسائط التّواصل الاجتماعيّ بهدف اختيار هداياهم من خلال الإعلانات التي تُعرض على هذه الوسائط، وقد انحصرت هذه النّسبة في الخيار الذي لا يتابع الإعلانات أبدًا فيما يخصّ أكثر المواقع تفضيلًا في اختيار وسائط التواصل الاجتماعي.
كما أنّ 9.5% من إجماليّ أفراد العيّنة أجابوا أنّهم أحيانًا يتابعون الإعلانات المعروضة على وسائط التّواصل الاجتماعيّ من أجل اختيار الهدايا، وتوزّعت هذه النّسبة وفق مواقع التّواصل الاجتماعيّ الأكثر متابعةً على النحو الآتي: 3.9% للّذين يتابعون فايسبوك وإنستغرام وغوغل معًا بهدف اختيار الهدايا، و4.4% للّذين يتابعون فايسبوك وإنستغرام فقط، و1.2% للّذين لا يتابعون الإعلانات على الإطلاق عبر وسائط التّواصل الاجتماعيّ.
من خلال هذه النسب المئويّة يتبيّن لدينا أنّ معظم أفراد العيّنة من الذين أجابوا بـ “نعم + أحيانا” أي (67.5%+9.5%= 77% ) هم من الذين يتابعون مواقع التّواصل الاجتماعيّ من أجل اختيار الهدايا ويتأثّرون بالإعلانات المعروضة على هذه الوسائط، وهذا مؤشّر مهمّ على تحوّل سلوك التّسوّق من التّقليديّ إلى التّسوّق الإلكترونيّ، فالشّبكة العنكبوتيّة قد أوجدت لنا عالمًا افتراضيًّا تتوافر فيه كافّة الوسائط ليس فقط لبناء علاقات اجتماعيّة افتراضيّة أو للتّعبير عن الرّأي، بل أيضًا للتّأثير في السّلوك الاستهلاكيّ والتّسوّق، من خلال تقديم معلومات وافية عن المنتج المُسَّوق له وتأمين خدمة التوصيل إلى المنزل دون تكبد المعاناة في الذّهاب إلى الأسواق على أرض الواقع واستهلاك الوقت في عمليّة البحث عن هدية مناسبة بل يمكنك بـ “كبسة زرّ” الوصول إلى كافّة مواصفات المنتج؛ وبالتّالي اختياره إن أُعجبت به.
لذلك، نرى أنّ وسائط التّواصل الاجتماعيّ تؤدّي دورًا في تحديد خيارات المستهلك، من خلال عامل الإعلان، إذ يتابع اللّبنانيّون مواقع التّواصل الاجتماعيّ لاختيار هدايا العيد وأنواع الضّيافات الخاصّة بالأعياد والمناسبات على اختلافها، ويتأثّرون بالإعلانات الخاصّة فيها، وهذا مؤشّر مهمّ على تحوّل السّلوك الاستهلاكيّ من التّسوّق التّقليديّ إلى التّسوّق الإلكترونيّ؛ فتتأكّد الفرضيّة الرّابعة التي تنصّ على أنّ: أفراد الأسرة المتابعين للإعلانات على مواقع التّواصل الاجتماعيّ هم الأكثر خضوعًا وتوجّهًا نحو الاستهلاك خلال الأعياد.
إنّ ما سبق ذكره دلّنا على تأثير بعض العوامل الاجتماعيّة والاقتصاديّة والدّيموغرافيّة في نمط استهلاك الأسرة خلال فترة الأعياد؛ ولكن هل لهذا الاستهلاك تأثير في مستوى التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة؟ سنجيب عن هذا السّؤال في ما يلي حيث سنتعرّف على تأثير هذا المفهوم في استهلاك الأسرة خلال الأعياد.
إنّ التّنمية الاجتماعيّة هي العمليّة التي يقوم بها الأفراد أو الحكومات أو كليهما في محاولة لاستغلال الطّاقات والإمكانيّات في المجتمع في سبيل تحقيق رفاهيّة الأخير، أمّا العلاقة بين التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة فتتمثّل في حاجة التّنمية الاجتماعيّة للاقتصاديّة؛ فعن طريقها يُمكن الحدّ من الفقر وزيادة الدّخل والإنتاج وغيرها؛ وبالتّالي، الوصول إلى تحسين التّنمية الاجتماعيّة، وذلك عبر رفع مستوى الاستهلاك.
1.12 أثر الاستهلاك الأسريّ في التّنمية الاجتماعيّة
من المشاهد المتناقضة في لبنان، صور المتسوّلين وأنين العائلات المحتاجة وصرخات الموظّفين الذين تآكلات قيمة رواتبهم نتيجة انهيار قيمة العملة الوطنيّة، يقابلها صور المطاعم والحفلات المكتظّة بالرّوّاد، ومحلّات الألبسة الفاخرة التي تغصّ بالزّبائن، وكذلك صور الآباء الذين يعجزون عن شراء الحطب والمحروقات لتدفئة أبنائهم أو الاشتراك، ولو بأمبير واحد، في مولّد خاصّ لكسر ظلّام اللّيل، في حين ينعم آخرون وعائلاتهم بتدفئة مركزيّة وتيّار كهربائيّ على مدار السّاعة، أمّا الاستشفاء في لبنان فيتطلّب أن تكون من أصحاب الثّروات، أو أن تتمكّن من تأمين الفاتورة الاستشفائيّة من المحسنين في لبنان وخارجه.
وفي نتيجة لم تفاجئ اللّبنانيين، تصدّرت العاصمة اللّبنانيّة بيروت التّرتيب في مؤشّر كلفة المعيشة العالميّ الذي يصدره موقع “نامبيو” للإحصاءات، كأغلى مدينة عربيّة (تبعتها دبي والدّوحة)، وذلك لدى مقارنة مستوى الأسعار فيها بالأسعار في مدينة نيويورك، حيث بلغ مؤشّر كلفة المعيشة فيها 80.30، وحلّت في المرتبة الأخيرة على صعيد مؤشّر نوعيّة الحياة ضمن المدن العربيّة المشمولة بهذا المؤشّر بنتيجة 56.80.
هذا وقد أصبح الشّعب اللّبناني مقسّمًا إلى ثلاث فئات، فئة الأغنياء التي تشكل 25%، ولديها قدرة كبيرة على الإنفاق ولهذا السبب زاد استهلاكها، فهي لم تتأثّر بالأزمة الاقتصاديّة التي تشهدها البلاد، وفئة المسحوقين أي من هم تحت خط الفقر، وهي تشمل ما نسبته 25% من الشّعب اللّبنانيّ، في حين إنّ 50% من اللّبنانيّين لا يزال لديهم القدرة على تأمين معيشتهم وشراء حاجياتهم، من دون الدّخول في نظريّة المؤامرة وعمليّات التّهريب فيما يتعلّق بارتفاع حجم الواردات.
هذا التّناقض في نمط الاستهلاك خلال الأزمة الاقتصاديّة التي تشهدها البلاد هي محطّ تساؤل، فمع وجود العديد من التّقارير والدّراسات التي أكدّت ارتفاع نسبة الفقر، نرى أنّ الممارسات الاستهلاكيّة خاصّة في الأعياد والمناسبات الاجتماعيّة تتناقض مع نتيجة هذه التّقارير، إذ تشهد الأسواق والمحالّ التّجاريّة الكبرى زحمة كبيرة، كما تمتلئ المطاعم بروّادها، على الرغم من ارتفاع أسعار جميع أنواع السّلع الغذائيّة وغيرها.
يقول السّيّد شكري فاخوري صاحب مطعم في مدينة صور، يتميّز بتقديم طبق بحريّ تقليديّ، “أنّ وضع المطعم كان ممتازًا قبل الثّورة. وقد واجه صعوبات كثيرة خلال فترة الكورونا والأزمة الاقتصاديّة حيث أغلق المطعم أبوابه وتعذّر عليه تأمين رواتب الموظّفين وتوفير إيجار المطعم. أمّا اليوم وبعد أن استعاد المطعم نشاطه المعتاد فزوّاره هم من أصحاب الطّبقة المتوسّطة، مع وجود استثناءات تمكّن أصحاب الطّبقة الفقيرة من زيارته إذا دُعوا من قِبَل المغتربين؛ ولكنّ المطعم استعاد نشاطه وازدهاره على الرّغم من وجود الأزمات”[1].
كما أخبرنا السّيّد عمر حديد صاحب مطعم le phenicien، عن الوضع الصّعب الذي واجهه خلال فترة كورونا حيث “أغلق المطعم أبوابه مع استمرار دفع الرّواتب للموظّفين. وتجدر الإشارة إلى أنّ وضع المطعم عاد إلى التّحسُّن بعد مرور أزمة الكورونا واعتياد المواطن على أزمة الدّولار، إذ استعاد ازدهاره المعتاد ونشاطه القويّ الذي كان سائدًا قبل الأزمة على الرّغم من كونه مطعمًا لأصحاب الطّبقة المخمليّة يقدّم أطباقًا باهظة الثّمن تحتاج مكوّنات موجودة في صور، وأخرى مُستوردة كالأسماك والقريدس غير المتوفّرة في لبنان، إضافة إلى بعض الخضار والفواكه المتميّزة exotic الموجودة في بيروت. ويبلغ نشاط المطعم ذروته خلال فترات الأعياد وشهر رمضان وعيد رأس السّنة، وخلال فصل الصّيف حيث يتواجد السّائحون والمغتربون في لبنان”[2].
أمّا فيما يخصّ منتجع ilBoutique فقد أخبرنا السّيّد يوسف حديد “أنّه يعتمد على قوّة إدارته، حيث إنّ أسعار المنتجع باهظة بسبب تأمين بيئة رّفاهية عالية، وخدمات خمس نجوم. والمنتجع لم يتأثّر بأزمة كورونا إذ دعت الحاجة لاستمرار هذا النّوع من العمل الذي يوفّر الرّاحة للنّاس بل على عكس في فترة كورونا اشتغلنا بجنون. وما زال العمل مزدهرًا ازدهارًا باهرًا بعد مرور الأزمة ودخول البلاد في أزمات جديدة مع تصنيف المنتجع كمناسب للطّبقة الاجتماعيّة المخمليّة إذ يُحجز مسبقًا؛ لأنّ الطّلب كبير، وخصوصًا في مرحلة الأعياد حيث نستعين بعمّال غاية في الاحترافيّة والتّميّز، حيث يتطلّب العمل، وكمبادرة لتشجيع التّنمية الاقتصاديّة في المنطقة”[3].
نستنتج هنا، أنّ الأزمة الاقتصاديّة التي حلّت على لبنان أثّرت على طبقة محدّدة من المجتمع اللّبنانيّ، وهي الطّبقة شديدة الفقر، أمّا باقي اللّبنانيين، فيمكن تقسيمهم ما بين الأغنياء أصحاب الثّروات الذين لم يتأثّروا بتبعات الأزمة بشكل كبير، فاستمرّ نمط استهلاكهم التّرفيّ، وأسهموا بإنعاش بعض القطاعات الخدماتيّة، خاصّة في مرحلة الأعياد والمناسبات الاجتماعيّة، أمّا القسم الآخر فهم اللبنانيّون ممّن حالفهم الحظّ كونهم يحصلون على مرتّباتهم بالعملة الأجنبيّة، أو ممّن يحصلون على أموال من ذويهم المغتربين.
هذه الفئة من المجتمع اللّبنانيّ هي التي شعرت بشيء من البحبوحة في بداية الأزمة الاقتصاديّة؛ لأنّ ارتفاع قيمة الدّخل لديهم مقابل انخفاض قيمة العملة الوطنيّة، كان أكبر من ارتفاع أسعار السّلع، في بداية الأزمة، أي خلال ثمانية أشهر تقريبًا، فساعدهم ذلك على تحقيق شيء من الاستقرار المادّيّ وارتفاع القدرة الشّرائيّة لديهم، فشكّلوا بالتّالي قوّة مساعدة للأسواق التّجاريّة ولقطاع الخدمات من مطاعم ومنتجعات ومقاهي… أسهمت في تحريك العجلة الاقتصاديّة وإبقاء حركات الاستيراد لمختلف البضائع والسّلع حتّى مع ارتفاع أسعارها.
اليوم، وقد دخلت الأزمة الاقتصاديّة في لبنان عامها السّادس، من دون أيّ بصيص أمل للخلاص، في وقت بلغ الاحتقان الشّعبيّ ذروته، ومع ذلك لم يترجم على الأرض إلّا من خلال تحرّكات خجولة في بعض المناطق لا تعكس صورة الثّورة التي انطلقت في 17 أكتوبر 2019، حين تظاهر لبنانيّون في الشّارع رفضًا لإقرار ضرائب جديدة، قبل أن تتوسّع دائرة الاحتجاجات؛ لتعمّ مختلف المناطق، ويرتفع سقف المطالب، من الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، إلى رحيل ومحاسبة الطّبقة السّياسيّة، تحت شعار “كلّن يعني كلّن”.
عدّة انتقادات يوجّهها لبنانيّون إلى بعضهم بعضًا، فكلّ منهم يسأل الآخر عن أسباب صمته في الوقت الذي يجب فيه رفع الصّوت وإعادة إحياء نبض الشّارع مع تفاقم الأمور، لا سيّما مع وصول سعر صرف الدّولار إلى رقم “جنونيّ”، فأسفر عنه من تضخّم طال كافّة الأسعار والسّلع، واتّساع رقعة البطالة والفقر وانسداد الأفق في ظلّ عدم انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة لإدارة البلد.
على الرّغم من الأزمة الاقتصاديّة التي حلّت في لبنان، نرى أنّ التّقسيم الطّبقيّ البارز الذي حلّ على المجتمع اللّبنانيّ، أسهم من جهة في اختفاء الطّبقة الوسطى، وفي ظهور طبقة من الميسورين الجدد من جهة أخرى، هذه الطّبقة هي التي عملت على استمرار النشاط الاقتصاديّ من خلال الموارد الماليّة المتاحة لها (الدّخل الشّهريّ بالعملة الأجنبيّة، وأموال ذويهم المغتربين)، ما يفسّر الحركة التّجاريّة النّاشطة في الأسواق اللّبنانيّة على الرغم من ارتفاع أسعار السّلع وانخفاض قيمة العملة الوطنيّة بشكل جنونيّ.
وفي مقابلة أجريت مع السّيّد أحمد حيدر صاحب محلّ حلويّات في صور، قال “المحلّ يتميّز بأنّه شعبيّ، يزدهر العمل فيه في فترات الأعياد حيث يكون الإقبال محصورًا بالفئات الشّعبيّة الفقيرة التي ما زالت تُقبِل على شراء الحلويّات حاليًّا على الرّغم من الأزمات، مع انخفاض في أعداد الحلويات التي تقوم بطلبها. ولكنّ العمل مزدهر والمحلّ نشيط”[4].
كما قال السّيّد جورج الخوري صاحب محلّ للحلويّات في جزّين، أنّ عملهم يبلغ ذروته في فترات الأعياد وبالأخصّ الميلاد ورأس السّنة إذ يكون المصدر الأساسيّ للنّشاط خلال فصل الشّتاء “نحنا اتكالنا عالأعياد”. وقد أغلق المحلّ أبوابه خلال أزمة كورونا ومررنا بظروف قاسية إذ كنت مطالبًا بدفع الإيجار في غياب العمل، ولكن في الفترة الأخيرة بدأت العمل من المنزل حتّى أتمكّن من الاستمرار. المحلّ تأثّر بالأزمة إذ كان مزدهرًا قبلها، ولكنّه عاد إلى ازدهاره المعتاد الذي تأثّر مجدّدًا ببلوغ الدّولار حافّة الـ50 ألفًا إذ خفّ الطّلب والشّراء حتّى من قِبَل الطّبقة الميسورة التي أصبحت تكتفي بشراء حاجتها بكمّيّات قليلة”.
ويقول السّيّد محمّد نور الدّين مدير صالة Cremino، “أنّ نشاطهم في فترة الأعياد يبلغ ذروته كعيد الميلاد ورأس السّنة وخلال شهر رمضان وعيد الأضحى وعيد الحبّ وعيد الأمّ. وقد كان عمل المطعم مزدهرًا قبل أزمة كورونا حيث إنّه توقّف عن العمل خلالها، إلّا أنّه استعاد نشاطه وازدهاره الآن وأصبح الإقبال عليه من قِبَل الطّبقات الميسورة، فخلال فترات الأعياد نستعين بموظّفين جدد بسبب الضّغط الكثيف، أمّا عن الزّبونات فهي من جميع المناطق بما فيهم المغتربين والسّوّاح”[5].
أمّا السّيّد فادي القنزح صاحب مطعم الشّلال في جزّين فيقول: “إنّ أعياد رأس السّنة والميلاد والأضحى وشهر رمضان هي الفترات التي يبلغ فيها العمل قمّة ذورته وازدهاره حيث يستعينون بأعداد كبيرة من العمّال. وهو يقوم بتأمين الطّعام من جزّين باستثناء اللّحوم حيث إنّ الكمّيّة الكبيرة التي يحتاجها غير متوفّرة في جزّين. أسعار هذا المطعم تناسب الجميع، لذا فالإقبال القويّ مستمرّ حاليًّا على المطعم من قِبَل جميع الفئات الاجتماعيّة، فزوّارنا من كافّة المناطق “عنّا زبونات دوّيمة وزبونات جديدة”.
يمكن أن نستنتج هنا أنّه على الرّغم من الأزمة الاقتصاديّة التي حلّت على لبنان، ما زال قطاعا السّياحة والخدمات في إنتاجيّة مستمرّة خاصّة خلال فترة الأعياد، وتسهم حركة النّشاط الاقتصاديّ في هذين القطاعين، في تأمين فرص عمل بسبب الحاجة إلى اليد العاملة الإضافيّة في المناسبات الاجتماعيّة والأعياد.
ففي مقابلة أُجريت مع أمين سرّ تعاونيّة السّكّاكين الجزّينيّة السّيّد جوزيف عون قال: “هذا المحلّ يختصّ ببيع الهدايا التي ترمز إلى الأصالة والعراقة والتي كانت تُهدى إلى الملوك من قِبَل الأثرياء لأجل التّباهي والمفاخرة. ويقول: إنّ استيراد هذه البضاعة مكلف، وبالتّالي أصبحت باهظة الثّمن حتّى أنّ الطّبقة الميسورة جدًّا بات اهتمامها بشرائها محدودًا وعلى الرّغم من الوضع السّيّىء هناك أشخاص قلّة ما زالت تطلب هذا النّوع من الهدايا، فهو محصور بالصّناعة الجزّينيّة؛ ولكنه معروف على صعيد الوطن والمهجر”[6].
كما أخبرنا الكابتن حبيب كرم صاحب خمارة ومصنع للنّبيذ، “أنّ العمل يبلغ ذروته في فترة الأعياد إذ يكثر الطّلب على النّبيذ من كافّة أنحاء لبنان وليس من جزّين فقط، إضافة إلى التّصدير للخارج، وتزداد رواتب العاملين لديه أيضًا. والجدير بالذّكر أنّه يشجّع الآخرين على زراعة العنب حتّى يتمكّن من أخذ المحصول وتصنيع النّبيذ إذ يساعد هذا الأمر على إحداث تنمية اجتماعيّة اقتصاديّة، وعلى إبراز جودة ونوعيّة النّبيذ العريقة التي يصدّرها لبنان إلى الخارج. والعمل لديه ما زال مزدهرًا كالسّابق وأكثر”[7].
وتقول السّيّدة إستيل أبي نادر صاحبة منتجع Blue Jay Valley روم: “إنّ ضغط العمل قويّ وبالأخصّ في فترات الأعياد حيث يصبح دوام العاملين مضاعفًا، وهذا يعود بالمنفعة المادّيّة عليهم كعاملين، وقد كان نشاط المنتجع باهرًا خلال أزمة كورونا وبلغ ذروته. وعلى الرّغم من تأثّر المنتجع ببداية الأزمات الحاليّة إلّا أنّ العمل الآن عاد إلى ازدهاره المعتاد بل وتفوّق على نشاطه السّابق وأصبح العمل في ذروته نحن منفوّل حجوزات من قبل بشهر للفئات الاجتماعيّة المخمليّة من كافّة المناطق، وكذلك الاعتماد قويّ على المغتربين والسّوّاح”.
وفي مقابلة مع السّيّدة دانا موسى في خان الصّابون قالت: “إنّ الخان يزدهر عمله في فترات الأعياد وبشدّة. وهو مختصّ بصناعة الصّابون وبتشجيع المحترفين المختصّين بصناعة الصّابون والتّطريز على أنواعها بحسب المناسبة، إضافة إلى توفير نوعيّات من الزّجاج غير موجودة سوى في الصّرفند، فتكون بمثابة هدايا تُقَدَّم في الأعياد وبالأخصّ للمغتربين والسّوّاح. والصّابون اللّبنانيّ محطّ اهتمام، إذ قالت: إنّ الإقبال عليه كبير وهناك الكثير من الأعمال المبتكرة المتعلّقة به، إذ نصنع أدوات تناسب الأعياد باختلاف مناسباتها كالقماش واللّوحات والزّيوت والكريمات. والخان يقوم بالتّصدير للخارج. وهذا المكان كما أخبرتنا السّيّدة دانا يهتمّ بإيجاد فرص عمل للنّساء في مجال التّطريز وصناعة الصّابون، فيساعد على خلق دورة اقتصاديّة قويّة إذ يزدهر المبيع بشكلّ قويّ”[8].
يعدّ لبنان نموذجًا منفردًا في مجال الاستهلاك وتأثيره في الاقتصاد، فعلى الرغم من الأزمة الاقتصاديّة التي حلّت به، من تدهور لقيمة العملة الوطنيّة وارتفاع أسعار السّلع والبضائع بشكل جنونيّ، وانعدام أغلب مقوّمات الحياة فيه، نرى أنّه يعتمد في تحريك عجلة اقتصاده واستمرار النّشاط الاقتصاديّ فيه خاصّة خلال الأعياد، على حركة الاستهلاك التي تثيرها الطّبقة الاجتماعيّة الحديثة المؤلّفة من الأغنياء القدامى والأغنياء الجدد، ففي حديث مع السّيّدة زينب خليفة في محلّ حلويات البابا الممتازة قالت: “إنّ المحلّ أغلق أبوابه خلال أزمة كورونا إلّا أنّ زبائن المحلّ بقوا ثابتين ومعروفين والصّلة وثيقة بينهم وبين المحلّ، على الرّغم من الأسعار المرتفعة حاليًّا، إذ ما زالوا يقبلون على المحلّ بالمعدّل ذاته في مرحلة ما قبل الأزمة. وخلال فترات الأعياد يستعينون بعدد كبير من العمّال، حتّى العمّال يتّكلون على هذه الأعياد طبعًا من حيث المردود الماليّ، أما عن زبائن المحل فهم من كافّة المناطق اللّبنانيّة، إضافة إلى عدد كبير من السّيّاح والمغتربين و”عنّا بفترة الأعياد كمّيّة كبيرة من التّصدير للخارج”[9].
ويقول السّيّد هادي نمّور صاحب محلّ ورد في جزّين إنّ العمل مزدهر على الرّغم من انخفاض إقبال النّاس على الشّراء بعد الأزمة بسبب ارتفاع الأسعار، ويبلغ العمل ذروته في عيدي الحبّ والأمّ إضافة إلى عيد رأس السّنة، إذ يكثر الإقبال على الشّراء ويزدهر العمل على الرّغم من ارتفاع الأسعار[10].
كما تقول السّيّدة نادين فرحات وهي صاحبة محلّ ورد في صور “بأنّ العمل يزدهر جدًّا في فترات الأعياد وبالأخصّ عيدي الحبّ والأمّ وعيد الميلاد. وقد قالت إنّ الإقبال كان كبيرًا هذا العام على الرّغم من ارتفاع الأسعار الكبير، هناك تفاوت بين الزّبونات في ناس بتاخد زهرة وفي ناس زهور وشتول؛ لكن العادات ما زالت على الرّغم من الأزمة”؛ أمّا عن العمّال فقالت: “طبعًا نستعين بعمال خلال فترات الأعياد”.
استنادًا إلى ما ورد سابقًا، يمكن التّوصّل إلى أنّ تحقيق التّنمية الاجتماعيّة يصبح هدفًا صعبًا في ظلّ عدم الاستقرار الماليّ والاقتصاديّ للدّولة بشكل عام وللأسر بشكل خاصّ، حيث يتعثّر الوصول إلى تحقيق مساواة أو عدالة اجتماعيّة خاصّة في مجال الاستهلاك، كما هو الحال في لبنان اليوم، حيث تبيّن أن “فئة الأغنياء التي تشكّل 25%، لديها قدرة كبيرة على الإنفاق؛ ولهذا السبب زاد استهلاكها، فهي لم تتأثّر بالأزمة الاقتصاديّة التي تشهدها البلاد، وفئة المسحوقين أي من هم تحت خطّ الفقر، وهي تشمل ما نسبته 25% من الشّعب اللّبنانيّ، في حين إنّ 50% من اللّبنانيّين لا يزال لديهم القدرة على تأمين معيشتهم وشراء حاجيّاتهم، وذلك بسبب اعتمادهم على الأموال التي يرسلها ذويهم المغتربين من الخارج. هذا ما يؤكّد الفرضيّة الخامسة التي تنصّ على أنّ هناك علاقة عكسيّة بين نمط استهلاك الأسر في الأعياد وبين تحقيق المساواة الاجتماعيّة في محافظة لبنان الجنوبيّ.
إنّ هذه التّبعات لم تطل كافّة شرائح المجتمع اللّبنانيّ، فعلى الرّغم من اختفاء الطّبقة الوسطى، إلّا أنّ طبقة من الميسورين ظهرت خلال هذه الأزمة، أسهمت إضافة إلى الأغنياء والمترفين في تحريك عجلة النّشاط الاقتصاديّ في البلد، فأسهم في تحفيز الإنتاج في بعض القطاعات، خاصّة قطاع السّياحة والخدمات، وزيادة فرص العمل في هذه القطاعات لا سيّما في فترات الأعياد، كعيد الميلاد ورأس السّنة وعيد الأمّ وعيد الحبّ وخلال شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى… هذا تأكّد من خلال المقابلات التي أجريت مع العاملين في مختلف مجالات قطاع السّياحة والخدمات. وهذا يؤكّد الفرضيّة السّادسة التي تنصّ على: هناك علاقة طرديّة بين نمط استهلاك الأسر في الأعياد وبين زيادة فرص العمل في محافظة لبنان الجنوبيّ.
إذًا، مرّ المجتمع اللّبنانيّ، بكثير من الأحداث والأزمات كانفجار المرفأ وانتشار جائحة كورونا، ثمّ الأزمة الاقتصاديّة، هذه الأحداث كان لها تبعات على الأوضاع الصّحيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة للأسرة اللّبنانيّة، فغيّرت سلوكيّات الأسر من حيث العلاقات الاجتماعيّة وطرق إحياء المناسبات ومن حيث أولويّاتها الاستهلاكيّة.
الخاتمة
لقد أظهرت نتائج البحث أنّ الأزمة الاقتصاديّة الرّاهنة في لبنان، على الرّغم من حدّتها وتداعياتها على مختلف الشّرائح الاجتماعيّة، لم تمنع فئة من اللّبنانيّين من الحفاظ على أنماط الاستهلاك السّابقة، خصوصًا خلال الأعياد والمناسبات. ويعكس هذا السّلوك الذي يتراوح بين الاستهلاك الاعتياديّ والاستهلاك التّفاخريّ، تأثيرًا مباشرًا للمكانة الاجتماعيّة في تشكيل القرارات الشّرائيّة، بحيث تُصبح هذه القرارات أداة لإبراز الانتماء الطّبقيّ والاجتماعيّ، حتّى في ظلّ ظروف ماليّة ضاغطة.
كما تبيّن أنّ العوامل الاقتصاديّة، وفي مقدّمتها قيمة الدّخل الشّهري ونوع المهنة، تمارس دورًا حاسمًا في تحديد مستوى الاستهلاك، وأنّ وسائط التّواصل الاجتماعيّ أضحت من أبرز المؤثّرات في صياغة توجّهات الأسر اللّبنانيّة نحو الشّراء، إذ تضخ هذه الوسائط إعلانات مكثّفة قبل الأعياد، فيتعزّز الميل إلى اقتناء السّلع والخدمات ذات الطّابع الرّمزيّ والاجتماعيّ.
من جهة أخرى، أظهر التّحليل أنّ أنماط الاستهلاك في الأعياد قد تحمل أثرًا مزدوجًا على التّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة؛ فهي من ناحية قد تُسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الأسواق، ومن ناحية أخرى قد تعمّق الفجوات الاجتماعيّة وتزيد من مظاهر اللامساواة إذا اتّخذت طابعًا استهلاكيًّا مظهريًّا غير متكافئ.
وبذلك، يتّضح أنّ فهم العلاقة بين الاستهلاك والعوامل الاجتماعيّة والاقتصاديّة، خاصّة في المناسبات، يوفّر أرضيّة مهمّة لصياغة سياسات متوازنة تدعم التّنمية المستدامة، من خلال ترشيد الاستهلاك وتعزيز دوره كرافعة اقتصاديّة واجتماعيّة، بدلًا من أن يكون عامل ضغط على الأسر أو مسببًا لزيادة التّفاوت الاجتماعيّ.
المصادر
Beranger, F., & Candela , A. (2011). Definir et illustrer le concept de consommation ostentatoire. ESAM Bachelor.
Ladwein. (2003). Le matérialisme ordinaire et la satisfaction dans la vie : vers une approche segmentée. Venise: Congrès international «Les Tendances en Marketing .
Martinet. (1990). Grandes questions épistémologiques et sciences de gestion,. Epistémologie et Sciences de Gestion, éd. Martinet A.A, Economica.
Mauss, M. (1989). Essai sur le don, forme et raison de l’echange dans les societes archaiques, in sociologie et antropologie, 3EME EDITION. Quadrige: PUF.
Moawad. (2009). Les Facteurs explicatifs de la consummation ostentatoire des produits de luxe- le cas du Liban. (Dessertation Publiee). Retrieved from https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00413921/document.
Tian. (2001). Consumers’ need for uniqueness: Scale development and validation. Journal of Consumer Research.
varcem, V. (1994). ,janssene –consommateur ,facteurs umflat (martine),Comporte externe dinfleunce, brexelles, de boeck – wessonad.
حسين, ع. (2000). تنمية المهارات البيعيّة. عمان: دار الرّضا للنّشر، الطّبعة الأولى.
حلمي،س. (2003). تأثير الاتّصال عبر الإنترنت في العلاقات الاجتماعيّة. مجلّة جامعة دمشق.
شكري, ف. (2002). القيم الأخلاقيّة بين الفلسفة والعلم. دار المعرفة الجامعيّة.
عبد الله الجسميّ. (2008). الهويّة وثقافة العولمة. العين، الإمارات: دار التّنوير للنّشر.
عطيّة, ع (1996). المجتمع الدّين والتّقاليد بحث قي إشكاليّة العلاقة بين الثّقافة والدّين والسّياسة. لبنان، طرابلس: منشورات جروس برس.
عمر خير الدّين. (1998). التّسويق، المفاهيم والاستراتيجيّات. القاهرة: مكتبة عين الشّمس.
عنابي بن عيسى. (2007). أثر سلوك المستهلك الجزائريّ على السّياسات التّسويقية والمركز التّنافسي التّسويقيّ للشّركات المنتجة للثّلاجات، حالة المؤسّسة الوطنيّة للصّناعات الكهرو مترليّة. الجزائر: أطروحة دكتوراه، المدرسة العليا للتّجارة.
غيث, م. ع. (1989). دراسات في علم الاجتماع القرويّ. لبنان: دار النّهضة العربيّة، بيروت، الطّبعة الأولى.
فريد الرّماني. (2014). الاستهلاك التّرفيّ في العصر الحديث. السّعودية: مركز الأبحاث العالميّ.
فوزية دياب. (1966). القيم والعادات الاجتماعيّة. دار الكتاب العربيّ.
فيرونيك أبوغزالة. (2012). دور الإعلام المرئيّ الّلبنانيّ في تفعيل استراتيجيّات ترشيد الاستهلاك وتعزيز ثقافة الإنتاج والادّخار لدى اللّبنانيّين”،الجامعة اللّبنانيّة، كلّيّة الإعلام. تمّ الاسترداد من http://maharat-news.com/Temp/Attachments/94eec220-a25c-42d6-bf93-a90c3516b485.pdf
محمّد إبراهيم عبيدات. (2004). سلوك المستهلك، مدخل استراتيجيّ،. الأردن: دار وائل للتّوزيع والنّشر، الطّبعة الرّابعة.
محمّد الجوهريّ. (2001). المدخل إلى علم الاجتماع. القاهرة: سلسلة علم الاجتماع المعاصر، العدد الثّاني.
محمّد عمر حبيل. (2013). المظاهر الاجتماعيّة والثّقافيّة المحدّدة لنمط الاستهلاك في المجتمع اللّيبيّ. ليبيا: المجلة الجامعة، العدد الخامس، المجلد الثّاني.
مفتاح بالحاج. (2017). نمط الاستهلاك الأسريّ في ظلّ المتغيّرات المجتمعيّة. ليبيا: مجلّة كلّيّة الآداب، العدد الثاني .
ممدوح الدّسوقيّ، و أخرون. (1988). أولويّات في علم الاقتصاد. ليبيا: الدّار الجماهيريّة للنّشر والتّوزيع والإعلان.
نظام سويدان، وشفيق حدّاد. (2009). التّسويق مفاهيم معاصرة. عمّان: دار الحامد للنّشر والتّوزيع.
نومية فتيحة. (2016). الثّقافة الاستهلاكيّة في المدينة، مدينة مستغانم نموذجًا، دراسة ماستر. مستغانم: جامعة عبد الحميد بن باديس، كلّيّة العلوم الاجتماعيّة.
[1] مقابلة أُجريت مع السيد شكري فاخوري، صاحب مطعم بحري في مدينة صور، بتاريخ 17 تشرين أول 2023.
[2] مقابلة أجريت مع السيد عمر حديد، صاحب مطعم le phenicien، بتاريخ 25 تشرين ثاني 2023.
[3] مقابلة أجريت مع السيد يوسف حديد، صاحب منتجع ilBoutique، بتاريخ 15 كانون ثاني 2023.
[4] مقابلة أجريت مع السيد أحمد حيدر، صاحب محل حلويات، بتاريخ 20 أيلول 2023.
[5] مقابلة أجريت مع السيد محمد نور الدين، مدير صالة Cremino، بتاريخ 20 أيلول 2023.
[6] مقابلة أجريت مع السيد جوزيف عون، أمين سرّ تعاونية السكاكين الجزينية، بتاريخ 17 تشرين أول 2023.
[7] مقابلة أُجريت مع السيد حبيب كرم، صاحب خمارة ومصنع نبيذ، بتاريخ 17 تشرين أول 2023.
[8] مقابلة أجريت مع السيدة دانا موسى، صاحبة محل خان الصابون، بتاريخ 17 تشرين أول 2023.
[9] مقابلة أجريت مع السيدة زينب خليفة، موظفة في محل حلويات البابا الممتازة، بتاريخ 17 تشرين أول 2023.
[10] مقابلة أجريت مع السيد هادي نمّور، صاحب محل زهور في جزين، بتاريخ 17 تشرين أول 2023.