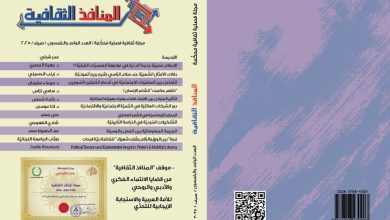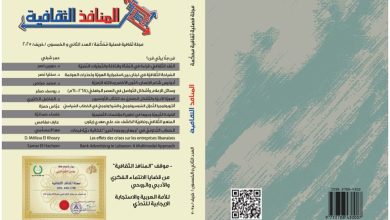السّياحة الثّقافيّة في لبنان بين استمراريّة الهويّة وتحدّيات العولمة: دراسة حالة دير القمر
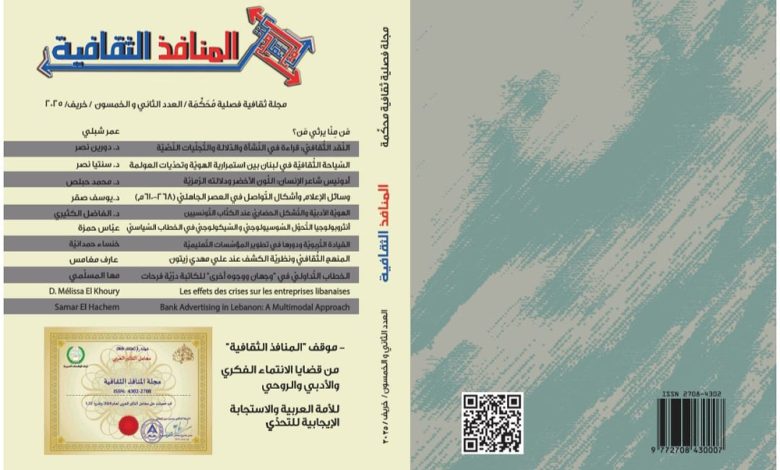
السّياحة الثّقافيّة في لبنان بين استمراريّة الهويّة وتحدّيات العولمة: دراسة حالة دير القمر
Cultural tourism in Lebanon between the continuity of identity and the challenges of globalisation: the case study of Deir El Qamar
د. سنتيا نصر[1]
Dr Cynthia Nasr
تاريخ الاستلام 3/ 5/ 2025 تاريخ القبول 30/ 5/ 2025
الملخّص
يشكّل التّراث الثّقافيّ ركيزة أساسيّة من ركائز الهويّة اللّبنانيّة، حيث تتلاقى فيه المكوّنات التّاريخيّة والدّينيّة والفنيّة لتكوّن لوحة حضاريّة فريدة. إلّا أنّ هذا التّراث، الذي يمثّله القطاع السّياحيّ الثّقافيّ، يواجه اليوم تحدّيات جذريّة بفعل العولمة وتسارع وتيرة التّحوّلات الرّقميّة .يهدف هذا البحث إلى تحليل واقع السّياحة الثّقافيّة اللّبنانيّة، مع إبراز التّحدّيات الّتي تواجهها والفرص الممكنة، عبر استخدام منهج وصفيّ تحليليّ مدعوم بمراجعة أدبيّة حديثة ودراسة حالة ميدانيّة لبلدة دير القمر. يعتمد البحث على أحدث المصادر الأكاديميّة والتّقارير الدّولية لضمان تقديم قراءة معاصرة، ويخلص إلى ضرورة تبنّي استراتيجيّات ذكيّة توازن بين حماية الهويّة الثّقافيّة والانفتاح الواعي على السّياحة العالميّة.
الكلمات المفتاحيّة: السياحة الثّقافيّة، الهويّة اللّبنانيّة، العولمة، دير القمر، التّنمية السّياحيّة المستدامة.
Abstract
Cultural heritage constitutes a fundamental pillar of Lebanese identity, where historical, religious, and artistic elements intertwine to form a unique civilizational mosaic. However, cultural tourism in Lebanon faces profound challenges due to globalization and the accelerating pace of digital transformations. This research analyzes the current state of Lebanese cultural tourism, highlighting challenges and opportunities, through a descriptive analytical approach supported by a recent literature review and a field case study of Deir El Qamar. It relies on updated academic sources and international reports to provide a contemporary perspective. The study concludes that smart strategies balancing cultural identity protection with mindful openness to global tourism are essential for sustainable development.
Keywords: cultural tourism, Lebanese identity, globalization, Deir El Qamar, sustainable tourism development.
المقدّمة
في ظلّ تسارع العولمة الثّقافيّة وتوسّع الرّقمنة السّياحيّة، يتعرّض التّراث الثّقافيّ اللّبنانيّ لضغوط متنامية تهدّد بتقويض توازنه الرّمزيّ ووظيفته المجتمعيّة، ما يطرح تساؤلات ملحّة حول قدرة المجتمعات المحليّة على صون أصالتها وهويّتها ضمن فضاء سياحيّ عالميّ يتّجه نحو التّوحيد والتّسليع الثّقافيّ[2]. لم تعد السياحة مجرّد نشاط اقتصاديّ عابر، بل غدت ساحة حيويّة يتقاطع فيها البعد الاقتصاديّ بالرّمزيّ، حيث تتشكّل العلاقات بين الإنسان ومكانه، وبين الزّائر والمُستضاف، وبين الماضي بوصفه إرثًا والرّاهن بوصفه تحدّيًا.
تُطرح في هذا السّياق إشكاليّة محوريّة: هل يمكن للسّياحة الثّقافيّة أن تؤدّي دورًا بنيويًا في الحفاظ على الهويّة المجتمعيّة، أم أنّها، بفعل منطق السّوق والعرض، تصبح أداة لطمس الذّاكرة وتحويلها إلى منتَج استهلاكيّ قابل للتّداول؟ من هذه الإشكاليّة، ينطلق البحث الحالي من فرضيّة مركزيّة مفادها أنّ السّياحة الثّقافيّة، إذا ما أُديرت برؤية نقديّة قائمة على شراكة محليّة، يُمكن أن تتحوّل من مجرّد نشاط ترفيهيّ إلى أداة استراتيجيّة لإحياء الهويّة وتعزيز الاستدامة الرّمزيّة والاقتصاديّة على حدّ سواء.[3]
ويتمحور هذا المقال حول دراسة حالة بلدة دير القمر، تلك البلدة اللّبنانيّة العريقة الّتي شكّلت على امتداد قرون نموذجًا فريدًا لتحوّلات الفضاء السّياحيّ والثّقافيّ. من موقعها كفضاء تراثيّ نابض بالحياة إلى انخراطها في منطق التّسليع السّياحيّ، تبرز دير القمر بوصفها مختبرًا حيًّا يُجسّد التّوتّر القائم بين الأصالة والانخراط في السّوق السّياحيّ المعولم[4]. وعليه، يهدف هذا البحث إلى تحليل المشهد الثّقافيّ والسّياحيّ في لبنان من خلال المقاربة النّقديّة لواقع دير القمر، بما يكشف عن التّحديات البنيويّة التي تواجهها الهويّة المحليّة في زمن العولمة، والفرص الممكنة لتجاوزها. منهجيًا، يعتمد البحث مقاربة وصفيّة تحليليّة ذات بعد نقديّ، ترتكز على مراجعة أدبيّة حديثة لمفاهيم السّياحة الثّقافيّة، والهويّة، والعولمة، وتسليع الثّقافة، كما وردت في الدّراسات الأكاديميّة العربيّة والغربيّة المعاصرة[5]. وتمّ تعزيز هذه المقاربة بتحليل كيفيّ لمضامين الخطابات، والتّحوّلات المجاليّة والاجتماعيّة المرتبطة بالمكان، استنادًا إلى الملاحظة المباشرة، والمصادر المكتوبة، والمقاربات النّظريّة ذات الصّلة. وقد تمّ اختيار دير القمر كدراسة حالة نظرًا لما تمثّله من نموذج حيّ لتحوّلات السّياحة الثّقافيّة في لبنان، ولكونها تُجسّد بوضوح التّوتر الحاصل بين الحفاظ على التّراث والانخراط في السّياحة المعولمة.[6]
أولًا: الإطار النّظريّ، العولمة الثّقافيّة والسّياحة
أ. مفهوم العولمة الثّقافيّة
تشير العولمة الثّقافيّة إلى تلك العمليّة المتسارعة الّتي تنتقل فيها الرّموز والقيم والممارسات الثّقافيّة بين المجتمعات، متجاوزة الحدود الجغرافيّة، بفعل التّوسّع الهائل في الإعلام، والاتّصالات، والاقتصاد الرّقميّ. وقد أدّى هذا الانتقال إلى بروز أنماط عيش موحّدة ومعولمة، غالبًا ما تُفرض على المجتمعات الصّغيرة، مهدّدة تنوّعها وتجذّرها المحليّ[7]. يرى توملينسون أنّ العولمة الثّقافيّة ليست مجرّد تبادل رمزيّ بريء، بل هي شكل من “التّوسّع الأفقيّ للرّموز المهيمنة”، حيث تتعرّض المجتمعات لضغوط رمزيّة تُعيد تشكيل ذاكرتها الجماعيّة وتؤثّر في سرديّتها الذّاتيّة[8].
تكتسب هذه الظّاهرة أبعادًا أكثر تعقيدًا حين تقترن بالمجال السّياحيّ، إذ تُصبح الثّقافة موضوعًا للتّسويق والعرض، وتتحوّل المواقع التّراثيّة إلى فضاءات استهلاكيّة مصمّمة وفق ذوق الزّائر لا خصوصيّة المجتمع. وهنا تكمن المفارقة: الانفتاح السّياحيّ الّذي يُفترض به أن يُعرّف الآخر على الثّقافة المحليّة، قد يتحوّل في غياب التّوازن إلى آلية طمس رمزيّ وتسويق سطحيّ [9]في الحالة اللّبنانيّة، تتجلّى العولمة الثّقافية بشكل حادّ في القرى والمناطق ذات الخصوصيّة التّراثيّة، حيث تُفرض نماذج تمثيل جاهزة للثّقافة المحليّة، منقوصة من عمقها التّاريخيّ والرّمزيّ. وتتحوّل الهويّة إلى أداء مكرّر قابل للتّسويق، بينما تتراجع قدرة المجتمعات على التّحكم في سرديّتها الذّاتيّة. يطرح هذا الواقع تحدّيات جديّة أمام السياحة الثّقافيّة التي باتت، أكثر من أيّ وقت مضى، بحاجة إلى مقاربات تحمي التّعدّد وتحفظ الذّاكرة من الاجتثاث الرّمزيّ.
ب. التّسليع الثّقافيّ
يُقصد بمفهوم “التّسليع الثّقافيّ” تلك العمليّة الّتي تتحوّل بموجبها العناصر الثّقافيّة من طقوس، وممارسات، ورموز، وأزياء، وموسيقى، وأطعمة، وحتّى اللّغة إلى سلع قابلة للتّرويج والتّداول ضمن السّوق السّياحيّ، خارج سياقاتها الأصليّة[10]. هذا التّحوّل لا يحدث بشكل فجّ أو قسريّ دائمًا، بل يتسلّل تدريجيًا بفعل ضغط السّوق، وتوقّعات المستهلك، وآليات التّرويج الّتي تُعيد تقديم الثّقافة بوصفها “مادّة جذّابة” أكثر منها تجربة حيّة .يحذّر كوهين من خطورة هذا المسار، ويرى أنّ تقديم الثّقافة المحليّة كمنتج مُعدّ مسبقًا يفصلها عن جذورها الاجتماعيّة والرّمزيّة، ويُفرغها من مضمونها الحقيقيّ. ما يبدو للزّائر كاحتفاء بالتّراث، قد يكون في الواقع شكلاً من أشكال نزع الحياة عن هذا التّراث، حين يُقدَّم في عروض فولكلوريّة أو في مهرجانات ترفيهيّة أُعدّت خصّيصًا للإبهار، لا للتّعبير الصّادق عن الحياة اليومية[11]. ويُضيف أنّ التّسليع لا يؤثّر فقط في طريقة عرض الثّقافة، بل يعيد تشكيل مفهوم الهويّة المحليّة ذاتها، بحيث تُعاد صياغتها وفق أذواق خارجيّة استهلاكيّة، لا انطلاقًا من عمقها التّاريخيّ.[12]
في السّياق اللّبنانيّ، تبدو مظاهر التّسليع واضحة في عدّة قرى ومواقع تراثيّة، حيث يتمّ تحويل البيوت التّقليديّة إلى مطاعم أو بيوت ضيافة دون مراعاة السّياق المعماريّ والاجتماعيّ، وتُستبدل الممارسات الشّعبيّة العفويّة بنسخ معدّة للتّصوير. ويُلاحظ أن بعض هذه المبادرات، رغم نواياها الحسنة، تُساهم في إنتاج “ثقافة بلا سياق”، تُعرَض وتُستهلك بسرعة، وتفقد أثرها التّفاعليّ الحقيقيّ .وبذلك، لا تقتصر خطورة التّسليع على تزييف التّجربة السّياحيّة، بل تتعداها إلى تهديد حقيقيّ للهويّة المجتمعيّة. إذ تتحوّل المجتمعات من فاعلة إلى مؤدّية، ومن راوية للقصص إلى ديكور خلفي للعرض. ويستدعي هذا الواقع مراجعة عميقة للسّياسات السّياحيّة، لإعادة الاعتبار للمجتمعات بوصفها شريكة في بناء التّجربة، لا مجرّد أداة للعرض أو الاستهلاك .في مقابل التّصورات النّقدية المتشائمة بشأن أثر العولمة والتّسليع على الثّقافة، تبرز أطروحة أكثر توازناً مفادها أنّ الهويّة ليست معطىً ثابتًا أو جوهرًا ساكنًا، بل هي بناء اجتماعيّ ديناميكيّ يتشكّل باستمرار من خلال التّفاعل، والسّرد، والتّمثيل[13]. بهذا المعنى، يمكن للسّياحة الثّقافيّة أن تكون فرصة لإعادة صياغة الهويّة وتعزيزها، لا فقط تهديدًا لها، شريطة أن تُدار التّجربة السّياحيّة بمشاركة فعّالة من المجتمعات المحليّة، وباحترام حقيقيّ للسّياق الاجتماعيّ والثّقافيّ.
يُعتبر ماكانيل من أبرز المنظّرين الّذين قدّموا هذه الرّؤية البديلة، حيث يرى أنّ السّائح لا يكتفي باستهلاك مشهد ثقافيّ جامد، بل يبحث عن تجربة تفاعليّة قائمة على المعنى، واللّقاء، والانغماس في الثّقافة[14]. من هنا، تصبح السّياحة فضاءً للتّفاوض الرّمزيّ بين المحليّ والعالميّ، لا مسرحًا لهيمنة أحد الطّرفين. ويقترح ماكانيل مقاربة “السّياحة كتجربة”، بدلًا من “السّياحة كعرض”، حيث يتمّ إشراك المجتمع المحليّ في بناء وتقديم التّجربة الثّقافيّة.[15] تُعزّز هذه الرّؤية الدّراسات الحديثة في مجال السّياحة الذّكيّة، والّتي تؤكّد أنّ التّكنولوجيا حين تُستخدم بوعي لا تُقصي الثّقافة، بل قد تعمّقها. وقد أظهرت أبحاث غريتزل وزملائها أنّ التّطبيقات الرّقميّة، مثل الجولات التّفاعلية أو الحكايات السّمعية، يمكن أن تساهم في نقل التّجربة الثّقافيّة بطرق أكثر تأثيرًا، دون أن تُختزل في صورة أو مشهد مرئيّ وحسب[16]. هذه الأدوات تسمح للزّائر بفهم أعمق للمكان، وللمجتمع المحليّ بالمشاركة في صناعة المعنى، مما يُعيد التّوازن إلى العلاقة بين المستضيف والزّائر .في السّياق اللّبنانيّ، يمكن أن تمثّل هذه الرّؤية أفقًا حقيقيًا لتطوير السّياحة الثّقافيّة، حيث تُقدَّم الهويّة لا كموروث ساكن، بل كمجموعة من الممارسات الحيّة، والعلاقات الاجتماعيّة، والسّرديّات المتغيّرة الّتي تعكس الحياة اليوميّة بقدر ما تعكس الماضي. شرط ذلك أن تُبنى التّجربة بمشاركة مجتمعيّة فعليّة، لا بوصفات تسويقيّة جاهزة.
ثانيًا: التّحديات الكبرى أمام السّياحة الثّقافيّة اللّبنانيّة في عصر العولمة
- 1. تهميش الأصالة لصالح المتطلّبات الاستهلاكيّة
أدّت ضغوط العولمة السّياحيّة إلى إعادة تشكيل الثّقافة المحليّة في لبنان لتتناسب مع أذواق الزّوّار وتوقّعاتهم، لا مع منطق المجتمع وذاكرته. فقد باتت المجتمعات مضطرّة إلى “إعادة تقديم” موروثها الثّقافيّ في قوالب تجاريّة سهلة الهضم، مهدّدة بذلك المعنى الأصليّ والممارسة الأصيلة. ويُحذّر كوهين من هذا المنحى، مؤكّداً أنّ التّبسيط التّجاريّ للممارسات الثّقافيّة يؤدّي إلى اختزالها في “صور نمطيّة” قابلة للتّسويق، لكنّها خاوية من دلالتها .[17]في السّياق اللّبنانيّ، يتجلّى هذا التّحوّل في العديد من المهرجانات والمناسبات الشّعبيّة، التي تحوّلت من فضاءات احتفال بالتّراث الحي إلى عروض فولكلوريّة مُعدّة سلفًا، تُقدَّم كخلفيّات بصريّة مبهرة تصلح للتّصوير والنّشر، لا كفضاءات للتّفاعل الإنسانيّ العميق. ويشير تقرير حديث صادر عن منظّمة اليونسكو إلى أن هذا “التّحوير الاستهلاكيّ للثّقافة” يُضعف الرّابط الوجدانيّ بين المجتمع وتراثه، ويُفرغ التّجربة السّياحيّة من بعدها الرّمزيّ[18]. ويطرح هذا الواقع تحدّيًا مزدوجًا: فمن جهة، تسعى المجتمعات لجذب الزّوّار لضمان مردود اقتصاديّ، ومن جهة أخرى، تُجبر على تقديم نفسها ضمن منطق سوقيّ يُنتج تمثيلات لا تُعبّر عنها فعليًا، بل قد تُشوّه صورتها الحقيقيّة أمام الزّائر.
- 2. العولمة الرقميّة وأثر وسائل التّواصل الاجتماعيّ
لم تعد التّجربة السّياحيّة، في ظلّ التّحوّلات الرّقميّة المتسارعة، مقترنة بالحضور الفيزيائيّ في المكان فقط، بل باتت مشروطة بممارسات النّشر الفوريّ والمشاركة البصريّة عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ. لقد تغيّر مفهوم “زيارة الموقع الثّقافيّ” من كونه لحظة تفاعل مع الذّاكرة والرّمز إلى كونه فرصة لالتقاط صور جذّابة قابلة للمشاركة. يُشير الباحثون إلى أنّ هذه النّزعة الرّقميّة الجديدة أسهمت في تحويل السّياحة الثّقافيّة من تجربة معرفيّة وشعوريّة إلى لحظة فوتوغرافيّة مختزلة، تُعرض لا تُعاش .[19]وقد لاحظت غريتزل وزملاؤها أن حضور الزّائر بات موجَّهًا أكثر نحو البحث عن “زاوية تصوير مثاليّة” بدلاً من اكتشاف معنى المكان[20]. في هذا السّياق، تراجعت أهمّيّة الحوار مع المجتمع المحليّ، أو الاستماع إلى سرديّاته، لصالح التّفاعل مع الصّور والمرئيّات الّتي يُنتجها الفضاء الرّقميّ. وتؤكّد تقارير اليونسكو أنّ هذا السّلوك أدّى إلى تآكل تدريجي في العلاقة بين الزّائر والمكان، وتفريغ المواقع التّراثيّة من محتواها التّربويّ والوجدانيّ .[21]في لبنان، تأثّرت العديد من المواقع التّراثيّة لا سيما في القرى الجبليّة بهذا المنطق، إذ باتت تُصمم وتُروَّج وفق معايير جماليّة رقميّة، لا ثقافيّة. وغالبًا ما تُقصى عناصر من التّراث المحليّ لأنّها “لا تصلح للتّصوير” أو “غير قابلة للانتشار”. بهذا، تتحوّل التّجربة الثّقافيّة إلى تفاعل بصريّ سطحيّ، تُختزل فيه الذّاكرة الجماعيّة إلى مشهد قابل للنّشر الفوريّ، لا للممارسة أو التأمّل.
- 3. غياب السّياسات الثّقافيّة المتكاملة
تعاني السّياحة الثّقافيّة في لبنان من غياب واضح لاستراتيجيّة وطنيّة شاملة تدمج بين القطاعات المعنيّة، كالثّقافة، والتّعليم، والسّياحة، والاقتصاد. ويتجلّى هذا النّقص في ضعف التّنسيق المؤسّسي، وتضارب الصّلاحيات، وغياب خارطة طريق موحّدة تحدّد الأهداف، وآليات التنفيذ، ومؤشّرات المتابعة[22]. ويُبرز البنك الدّوليّ في تقريره الإقليميّ أنّ صون التّراث الثّقافيّ، كمدخل للتّنمية المستدامة، لا يمكن أن يتحقّق في غياب بنية مؤسساتيّة متكاملة تُشجّع على الشّراكة بين الدّولة والمجتمع المدنيّ والقطاع الخاصّ .[23]في لبنان، ما تزال العديد من المبادرات الثقافيّة والمشاريع السيّاحيّة ذات طابع فرديّ أو محليّ ضيّق، وتفتقر إلى استمراريّة أو دعم مؤسّسي حقيقيّ. وغالبًا ما تكون تلك المبادرات موسميّة، أو مدفوعة باعتبارات انتخابيّة، لا بآفاق تنمويّة طويلة المدى. يُضاف إلى ذلك أنّ القرى والمواقع التّراثيّة التي تُعد خزانات رمزيّة وسياحيّة لا تحظى بدعم كافٍ في مجالات التّدريب، والتّسويق، والبنية التّحتيّة، ممّا يعيق قدرتها على جذب الزّوار أو تطوير منتجات سياحيّة نوعيّة .[24]هذا الغياب للسّياسات المتكاملة ينعكس أيضًا على البرامج التّعليميّة، الّتي قلّما تُدرج مفاهيم السّياحة الثّقافيّة، أو تدمج الطّلاب في مشاريع تراثيّة ميدانيّة. كما أنّ ضعف الاستثمار في رأس المال البشريّ من خلال تدريب أدلاء محليّين، أو تطوير المحتوى الثّقافيّ يحدّ من قدرة لبنان على تحويل تراثه المتنوّع إلى مورد سياحيّ مستدام.
- 4. التّحدّيات السّياسيّة والأمنيّة
لا يمكن فهم واقع السّياحة الثّقافيّة في لبنان دون الأخذ بعين الاعتبار السّياق السّياسيّ والأمنيّ المتقلّب، الّذي يُلقي بظلاله على جميع أشكال الاستثمار والتّنمية، بما في ذلك السّياحة[25]. فالصّراعات المتكرّرة، والأزمات الحكوميّة، والانقسامات الطّائفية، والانهيارات الاقتصاديّة المتلاحقة، تُنتج مناخًا من عدم الاستقرار يجعل من الصّعب التّخطيط لبرامج سياحيّة طويلة الأمد. ويؤكّد بيرمان أنّ الوجهات السّياحية الّتي تعاني من اضطرابات سياسيّة مزمنة غالبًا ما تفقد ثقة المستثمرين، كما يتراجع فيها الطّلب السّياحيّ لصالح أماكن أكثر أمنًا واستقرارًا.[26]
في لبنان، انعكست هذه الأزمات بشكل مباشر على المشاريع الثّقافيّة والتّراثيّة، حيث تمّ تعليق عدد كبير من مشاريع التّرميم والتّأهيل، أو إلغاؤها بالكامل بسبب غياب التمويل أو غموض الأفق السّياسيّ. كما أدّى ذلك إلى فقدان عدد من الكفاءات المحلّيّة المؤهّلة في مجالات الإدارة الثّقافيّة، نتيجة الهجرة أو تدهور أوضاع القطاع العامّ.
وعلاوة على ذلك، تُوظّف الثّقافة أحيانًا في الخطاب السّياسيّ اللّبنانيّ بوصفها رمزًا للهويات المتنافسة، لا كجسر جامع بين مكوّنات المجتمع. هذا التّسييس للثّقافة يُعيق بناء سرديّة وطنيّة شاملة قادرة على التّرويج للسّياحة الثقافيّة بوصفها مساحة حوار وانفتاح، بدلًا من أن تُختزل في مهرجانات ذات طابع فئويّ أو مناطقي. ويُساهم غياب خطاب ثقافيّ جامع في تضييق جمهور السّياحة الثقافيّة الدّاخليّ، ويحدّ من فرص انفتاح لبنان خارجيًّا على أسواق جديدة.[27] وبهذا، تصبح السّياحة الثّقافيّة في لبنان رهينة لسياق سياسيّ متوتّر، لا يتيح لها النّضج أو التّحول إلى رافعة تنمويّة مستدامة، بل يُعيد إنتاج هشاشتها، ويجعلها تابعة للظّروف لا صانعة لها.
ثالثًا: دير القمر نموذج حيّ للسّياحة الثّقافيّة اللّبنانيّة
- 1. الجذور التّاريخيّة والثّقافيّة
تقع بلدة دير القمر في قضاء الشّوف بجبل لبنان، وتُعدّ من أبرز القرى اللّبنانيّة ذات الطّابع التّراثيّ المتجانس، نظرًا لتاريخها العريق، وعمارتها التّقليديّة، ومكانتها السّياسيّة والثّقافيّة[28]. فقد كانت في القرن السّادس عشر عاصمةً لإمارة جبل لبنان خلال عهد الأمير فخر الدّين المعنيّ الثّاني، الّذي اتّخذها مقرًّا لحكمه، ممّا منحها دورًا محوريًّا في التّشكّل السّياسيّ والرّمزيّ للكيان اللّبنانيّ النّاشئ آنذاك .[29]تتميّز البلدة بتخطيط عمرانيّ متكامل يعكس نمط الحياة اللّبنانيّة التّقليديّة: ساحات مرصوفة بالحجر، أزقّة ضيّقة تتخلّلها أقواس مقنطرة، ومبانٍ من الطّراز العثمانيّ المحلّيّ. ومن أبرز معالمها: قصر الأمير يوسف الشّهابيّ، كنيسة سيّدة التّلة، وساحة فخر الدّين، وهي مواقع ما تزال تحتفظ بأصالتها المعماريّة، وتشكّل مجتمعة نواة الهويّة المعماريّة للبلدة.[30] وقد حظيت دير القمر باعتراف دوليّ بأهمّيّتها التراثية، إذ أُدرجت ضمن عدد من برامج الحماية والصّون الثّقافيّ التّابعة للمجلس الدّوليّ للمعالم والمواقع (ICOMOS)، كما نُفّذت فيها مشاريع ترميم بتمويل من اليونسكو، ما يعكس مكانتها كموقع رمزيّ في مشهد السّياحة الثّقافيّة اللّبنانيّة .[31] لكن الأهم من المكوّن المعماريّ هو البُعد الاجتماعيّ والثّقافيّ الذي تحتفظ به البلدة، فهي ليست مجرد “متحف مفتوح”، بل مجتمع نابض بالذّاكرة الحيّة والعلاقات العائليّة المتجذّرة، ما يجعل من تجربة زيارتها فعل تواصل مع طبقات متعدّدة من التّاريخ والرّمز.
- تحوّلات السّياحة الثّقافيّة في دير القمر
مع نهاية الحرب الأهليّة اللّبنانيّة وعودة الاستقرار النّسبيّ في التّسعينيّات، شهدت دير القمر إقبالًا متزايدًا من الزّوّار، سواء من اللّبنانيين أو الأجانب، الباحثين عن تجربة تراثيّة “أصيلة”، تجمع بين الطّابع المعماريّ، والمشهد الطبيعيّ، والهدوء الرّيفيّ[32]. في بداياتها، كانت الزّيارات ذات طابع عائليّ أو تربويّ، تتمحور حول التّجوّل في السّاحات الحجريّة، أو زيارة الكنائس القديمة، أو التّعرّف على تاريخ الأمراء الشّهابيّين. غير أنّ هذا الطّابع تغيّر تدريجيًا مع انتشار وسائل التّواصل الاجتماعيّ، وتصاعد ظاهرة “السّياحة الفوتوغرافيّة”، حيث بات كثير من الزّوار يأتون بهدف التقاط صور في زوايا معيّنة من البلدة، أكثر من رغبتهم في التّفاعل مع تاريخها أو سكّانها. وتحوّلت تجربة الزّيارة من تواصل ثقافيّ إلى ممارسة بصريّة موجّهة نحو”المشاركة الرّقميّة”، ما أضعف البعد التّفاعليّ للزّيارة.[33] يصف غريتزل وزملاؤها هذا النّمط من الاستهلاك الثّقافي السّريع بـ”الانزلاق من التّجربة إلى التّمثيل”، حيث يُصبح الفعل السّياحيّ مؤطّرًا بقواعد العرض على المنصّات الرّقميّة، لا بحبّ الاكتشاف أو الفضول المعرفيّ[34]. في هذا السّياق، فقدت بعض عناصر التّراث في دير القمر معناها الحيّ، لتُعاد صياغتها كخلفيّة جماليّة تلبّي حاجات الزّائر الرقميّة، بينما تراجع دور السّكان المحليّين من فاعلين إلى عناصر صامتة في مشهد الاستهلاك. وقد انعكس هذا التّحول على العلاقة بين الأهالي والزّوّار، إذ عبّر عدد من السّكان عن شعورهم بأنّ البلدة “أصبحت مسرحًا للعرض”، لا مجتمعًا تُحتَرم ديناميّاته الخاصّة. هذا الواقع يطرح تساؤلات حول حدود الفائدة الاقتصاديّة للسّياحة إذا ما أتت على حساب البنية الاجتماعيّة والمعنى الرّمزيّ للتّراث.
- العولمة الثّقافيّة والمخاطر المحدقة
تُحذّر دراسات حديثة في مجال التّراث والسّياحة من أنّ إدماج القرى التّراثيّة في مسارات السّياحة العالميّة دون رؤية نقديّة واستراتيجيّة حماية متماسكة، قد يؤدّي إلى تحويل هذه المواقع من فضاءات معيشة وذاكرة إلى “مشاهد استهلاك سياحيّ” تفقد تدريجيًا روحها الأصليّة[35]. وتشير هذه الدّراسات إلى أنّ “النّجاح السّياحيّ السّريع” في بعض القرى قد يُخفي في طيّاته عمليّة تآكل تدريجيّ للهويّة، نتيجة الاستجابة غير المدروسة لمتطلّبات السّوق.[36] في دير القمر، برزت خلال العقدين الأخيرين مؤشّرات واضحة على هذا التحوّل، منها افتتاح منشآت تجاريّة ذات طابع تجميليّ لا يعكس روح المكان، أو إقامة فعاليّات موسميّة ترفيهيّة لا تمتّ بصلة إلى السّياق الثّقافيّ المحليّ، بل تستجيب لأذواق جماهيريّة متنوّعة، بعيدة عن البيئة الاجتماعيّة الأصيلة للبلدة. كما تمّ تحويل بعض الأبنية التّراثيّة إلى مطاعم أو صالات استقبال، ما أفقدها طابعها السّكني الرمزيّ.[37] يتفق كوهين وماكانيل على أنّ هذا النّوع من “التّسليع القسريّ” للثّقافة لا يُفرّغ المكان من رمزيّته فحسب، بل يُعيد تشكيله ليُناسب صورة ذهنيّة جاهزة في مخيّلة السّائح، لا في وعي المجتمع المحليّ[38]. وهنا يكمن الخطر الأكبر: أن تتحوّل البلدة من نسيج اجتماعيّ متجذّر إلى صورة جامدة، ومن فضاء للذّاكرة إلى “ديكور تراثيّ” قابل للتّصوير، لا للعيش. وفي ظل غياب تشريعات واضحة أو أدوات رقابيّة فاعلة، تتّجه بعض القرى اللّبنانيّة ومنها دير القمر إلى الوقوع في فخ “التّمثيل السّياحيّ المفرط”، الّذي يُخضع التّراث لمتطلّبات العرض، ويجعل من أصالة المكان رهينة لجاذبيّته الاستهلاكيّة، لا لقيمته الثّقافيّة الفعليّة.
- المبادرات المجتمعيّة للحفاظ على الأصالة
رغم التّحدّيات المتعدّدة الّتي تواجه السّياحة الثّقافيّة في دير القمر، برزت في السّنوات الأخيرة مبادرات مجتمعيّة محليّة تهدف إلى صون التّراث المعماريّ والرّمزيّ، وتعزيز الانتماء الهويّاتيّ في وجه تيّارات العولمة والتّسليع. هذه المبادرات، التي غالبًا ما تنبع من المجتمع الأهليّ أو من منظّمات غير حكوميّة بالتّعاون مع المؤسّسات الدّوليّة، تعبّر عن وعي متزايد لدى السّكان بأهميّة الحفاظ على طابع البلدة كمجتمع حيّ، لا كمشهد تصويريّ عابر.[39]
من بين أبرز هذه الجهود يمكن الإشارة إلى مشروع ترميم ساحة الأمير فخر الدّين، الّذي نُفّذ بدعم من اليونسكو عامّ 2021، مستهدفًا إعادة إحياء السّاحة كمركز تفاعليّ مجتمعيّ لا مجرّد معلم معماريّ[40]. كما نُظّمت مهرجانات محليّة تُركّز على الفنون الشّعبيّة كالدّبكة والموسيقى التّقليديّة، بعيدًا عن الاستعراضات الاستهلاكيّة التي تُشاهد في بعض المناسبات التّجاريّة الكبرى. إلى جانب ذلك، أطلقت جمعيّات محليّة حملات توعية موجّهة للأطفال والشّباب، تسعى إلى غرس مفاهيم التّراث والذّاكرة والهويّة في الأجيال الصّاعدة. وتُظهر دراسة صادرة عن الجامعة اللّبنانية الأمريكيّة أنّ مشاركة السّكان المحليّين في تصميم وتقديم التّجربة السّياحية لا تعزّز الاستدامة فقط، بل تُعيد الاعتبار للسّكان كمشاركين فاعلين في صياغة سرديّتهم الخاصّة.[41] ويؤكّد تقرير البنك الدّوليّ أنّ المجتمعات الّتي تُشارك فعليًّا في إدارة السّياحة، تُظهر قدرة أكبر على مواجهة الضّغوط الخارجيّة، وحماية تراثها من الاستغلال التّجاريّ[42]. هذا ما يجعل من المبادرات المجتمعيّة في دير القمر نموذجًا يُحتذى، وإن كان بحاجة إلى دعم مؤسّساتي مستدام، وإلى ربط هذه الجهود المحليّة بسياسات وطنيّة متكاملة تعترف بقيمة التّراث الحيّ بوصفه موردًا استراتيجيًّا للتّنمية.
رابعًا: رؤية نقدية لاستدامة السّياحة الثّقافيّة اللّبنانيّة
- 1. إعادة تحديد دور المجتمع المحليّ
تشير تقارير اليونسكو إلى أن استدامة السّياحة الثّقافيّة لا تكتمل عبر حماية المباني والمعالم فقط، بل تستلزم إشراك المجتمع المحليّ في إنتاج التّجربة السّياحيّة، ليس كمستضيف سلبيّ، بل كحامل للمعرفة والهويّة والذاكرة[43]. بهذا المعنى، لم تعد الثّقافة مجرّد مورد للعرض، بل أصبحت مسألة تمكين اجتماعيّ، حيث تُعيد المجتمعات تعريف ذاتها من خلال آليّات التّفاعل مع الزّائر، لا من خلال الانغلاق أو التّمثيل التّجاريّ. في لبنان، تعاني العديد من القرى التّراثيّة من غياب هذا التّمكين، حيث تُفرض عليها نماذج عرض ثقافيّة جاهزة من دون أن تُستشار في كيفيّة تقديم سرديّاتها أو تفسير رموزها. وكثيرًا ما يُوظّف السّكان كـ”خلفيّة بشريّة” لمهرجانات أو أنشطة سياحيّة لا تعبّر عنهم. ويعيد هذا الواقع إنتاج التّفاوت بين من يتحكم في الخطاب الثّقافيّ ومن يُستخدم فيه .[44] وتوصي الأدبيّات الحديثة في السّياحة الثّقافيّة بتطبيق مبدأ “التّمكين التّشاركيّ”، والذي يُمكّن المجتمعات المحليّة من أن تكون طرفًا فاعلًا في صناعة التجربة، وليس مجرّد وسيلة للرّبح أو التّجميل[45]. ويبرز في هذا السّياق النموذج المغربيّ في فاس، حيث تمّ إشراك الحرفيّين المحليّين في تصميم المسارات السّياحيّة وتحديد سرديّة الحيّ التّاريخيّ، ما أدّى إلى خلق علاقة تفاعليّة بين الزّائر والمجتمع[46]. مثل هذا النّموذج قد يُلهم المبادرات اللّبنانيّة النّاشئة، خصوصًا في مواقع مثل دير القمر، بشرط أن يُدعم بإرادة سياسيّة ورؤية مؤسّساتيّة واضحة.
- 2. إدماج التّكنولوجيا بذكاء لخدمة الأصالة
رغم ما تثيره الأدوات الرّقميّة من مخاوف تتعلّق بالتّسطيح والتّمثيل السّطحيّ للتّراث، تشير دراسات متقدّمة إلى أنّ التّكنولوجيا، إذا ما استُخدمت بوعي نقديّ، يمكن أن تُشكّل رافعة قويّة لحماية الأصالة وتعزيز التّفاعل الثّقافيّ[47]. فالتّقنيّات مثل الواقع المعزّز، والجولات السّمعية التّفاعليّة، والتّطبيقات المخصّصة لرواية القصص المحليّة، قد تُعيد تشكيل تجربة الزّائر على نحو يعمّق فهمه للمكان ويُحترم فيه السّياق الثقافيّ المحليّ.[48] وتؤكّد غريتزل وزملاؤها أنّ “السّياحة الذّكيّة” لا تعني استبدال العنصر الإنسانيّ بالتّقنيّة، بل توظيف الرّقميّة لتوسيع أفق الإدراك والتّفاعل[49]. فبدلًا من التقاط الصّور العابرة، يستطيع الزّائر من خلال تقنية الواقع المعزّز أن يتعرّف على قصص السّكان، أو تفاصيل البناء، أو الأحداث التّاريخيّة التي شهدها الموقع، ما يُحدث توازنًا بين الحضور البصريّ والحضور المعرفيّ. في السّياق اللّبنانيّ، يُعد هذا التّوظيف الذّكيّ للتّقنيّة فرصة واعدة، خصوصًا في ظل جاذبيّة الهواتف الذّكيّة لدى فئات الشّباب. ويمكن، على سبيل المثال، تطوير تطبيق خاصّ بدير القمر يُوفّر محتوى صوتيًا متنوعًا، يُروى بصوت أبناء البلدة، يتناول الحكايات العائليّة، والعادات، وطقوس الحياة اليوميّة، ما يجعل من الزّائر مشاركًا في تجربة سرديّة حيّة لا مستهلكًا صامتًا لصور سريعة. لكن لتحقيق ذلك، لا بدّ من توافر بنية تحتيّة رقميّة، وتدريب محليّ، وتعاون فعليّ بين المطوّرين التّكنولوجيّين والمجتمعات المحليّة، لتفادي تحويل الأدوات الرّقميّة إلى مجرّد وسيلة أخرى للسّطحيّة والانبهار الخاوي.
3 . تبني سياسات ثقافيّة سياحيّة وطنيّة متكاملة
تعاني السّياحة الثّقافيّة في لبنان من غياب سياسة وطنيّة موحّدة تنسّق بين مختلف الوزارات والمؤسّسات المعنيّة، مثل وزارات السّياحة، والثّقافة، والتّربية، والاقتصاد، ما يؤدّي إلى تشتّت الجهود، وتكرار المبادرات، وانعدام الرّؤية الشّمولية لتفعيل التّراث كأداة للتّنمية[50]. ويُشير البنك الدّوليّ إلى أنّ استدامة السّياحة الثّقافيّة تتطلّب تكاملًا أفقيًّا بين القطاعات، وتنسيقًا عموديًّا بين المستويات المركزيّة والبلديّة، إضافة إلى تمكين المجتمعات المحليّة[51]. في النّموذج المغربيّ، على سبيل المثال، ساهم إنشاء “اللّجنة الوطنيّة للتّراث” الّتي تضمّ فاعلين من القطاعين العامّ والخاصّ، في وضع خارطة طريق وطنيّة لصون التّراث الثّقافيّ وربطه بالتّنمية السّياحيّة[52]. بالمقابل، يفتقر لبنان إلى جهاز تنسيقيّ مماثل، ما يجعل من المبادرات الثّقافيّة رهينة مزاجيّة سياسيّة، أو مرهونة بتمويلات خارجيّة غير مستدامة. كما أن غياب التّكامل بين التّعليم والثّقافة يُعد من أبرز مكامن الخلل، إذ ما تزال البرامج المدرسيّة خالية من أيّ تدريب ممنهج على التّراث أو السّياحة الثّقافيّة، ما يُضعف علاقة النّاشئة بالهويّة المحليّة. ويُوصي تقرير اليونسكو الأخير بضرورة إدماج الثّقافة في المناهج، وتفعيل برامج التّوأمة بين المدارس والمواقع التّراثيّة، لتنشئة جيل واعٍ بهويّته وقادر على التّعاطي النّقديّ مع الزّائر، بدلًا من أداء دور المتفرّج أو المؤدّي[53]. أخيرًا، فإنّ ربط السّياحة الثّقافيّة بالسّياسات الاقتصاديّة أمر بالغ الأهميّة. إذ إنّ التّراث، حين يُدمج في الخطط التّنمويّة الشّاملة، يمكن أن يتحوّل إلى مصدر دخل حقيقيّ، ومجال لخلق فرص عمل محليّة، لا سيّما في المناطق الرّيفيّة المهمّشة. ولتحقيق ذلك، لا بدّ من رؤية مؤسّساتيّة تؤمّن بأنّ الثّقافة ليست كماليّات، بل استثمار طويل الأمد في رأس المال الرّمزيّ والاجتماعيّ.
- 4. بناء سرديّات ثقافيّة أصيلة وحديثة
أحد أبرز التّحدّيات الّتي تواجه السّياحة الثّقافيّة في لبنان هو تقديم الهويّة المحليّة بوصفها “أثرًا من الماضي”، منزوعة من سياقها الاجتماعيّ الحيّ، وعرضها كصورة جامدة تُروَّج من خلال المعالم المعماريّة أو المناسبات المتحفيّة[54]. غير أنّ المفهوم المعاصر للهويّة كما تطرحه الأدبيّات الحديثة يشدّد على أنّها ليست تراكمًا للماضي فقط، بل ممارسة حيّة تتجدّد من خلال الحياة اليوميّة، والعلاقات، والطّقوس، واللّغة، والتّفاعل المستمر بين الأفراد والمكان[55]. في هذا الإطار، يقترح ماكانيل تجاوز الرّؤية التّقليديّة الّتي تساوي بين الهويّة والتّراث المادّي، لصالح رؤية تعتبر الهويّة سردًا حيًا، يُعاد بناؤه من خلال التّجربة والمشاركة[56]. فبدلًا من عرض “البيت القديم” بوصفه كائنًا منفصلًا عن الحياة، يمكن تقديمه كمجال معاشٍ تتداخل فيه قصص العائلة، ونمط الضّيافة، وطريقة الطّهو، وطقوس المناسبات الاجتماعيّة. هذا ما يخلق علاقة أكثر عمقًا وصدقًا بين الزّائر والمكان. في دير القمر، يمكن أن تُبنى التّجربة السّياحيّة على هذا المنطق السّرديّ، حيث يتاح للزّائر الاستماع إلى روايات السّكان حول تاريخ بيوتهم، أو التّعرّف على كيفيّة صناعة الخبز التّقليديّ، أو المشاركة في جلسة قهوة عائليّة في فناء قديم. هذه التّفاصيل، الّتي قد تبدو هامشيّة في أعين المخطّطين، هي بالضّبط ما يُعطي للمكان روحه، ويمنحه معنى يتجاوز الصّورة. وتُبرز أبحاث السّياحة التّجريبيّة أنّ مثل هذا النّمط السّرديّ لا يعزّز فقط تجربة الزّائر، بل يُسهم في تعزيز انتماء السّكان أنفسهم، ويُعيد لهم موقع الفاعل في رواية الذّات، بدلًا من تمثيلها بطريقة مسطّحة أو مفروضة[57]. وهكذا، تصبح السّياحة الثّقافيّة أداة مزدوجة: للمعرفة والانتماء، وللإدراك والتّمكين.
خامسًا: خاتمة وتوصيات
أظهر هذا البحث، من خلال تحليل نقديّ لدراسة حالة بلدة دير القمر، أنّ السّياحة الثّقافيّة ليست مجرّد نشاط اقتصاديّ أو ترفيهيّ، بل مجال حيويّ تتقاطع فيه السّياسات، والسّرديّات، والرّموز، والضّغوط العالميّة، لتُعيد تشكيل العلاقة بين المجتمع وتراثه. وقد بيّن هذا التّحليل أنّ الهويّة الثّقافيّة اللّبنانيّة ليست كيانًا ثابتًا، بل هي بناء متجدّد، يُعاد إنتاجه باستمرار تحت تأثير العولمة السّياحيّة، والرّقمنة، والتسليع الرّمزيّ.[58] وفي حين تُواجه السّياحة الثّقافيّة تهديدات حقيقيّة تتراوح بين طمس الأصالة، وتفريغ الممارسة من معناها، والتّهميش المجتمعيّ، فإنّها في الوقت نفسه تفتح آفاقًا لإعادة إحياء الذّاكرة الجمعيّة، وتعزيز الانتماء، وتحقيق تنمية قائمة على الثّقافة، بشرط أن تُدار برؤية نقديّة تشاركيّة، تُعيد للسّكان المحليّين موقع الفاعل لا المفعول به[59]. تُجسّد دير القمر نموذجًا حيًّا لهذا التّوتّر الخلّاق بين الهويّة والتّسويق، بين الماضي والحاضر، بين العمق والسّطحية. فرغم الضّغوط الّتي تعاني منها البلدة، لا تزال تحتفظ بروحها المعماريّة والاجتماعيّة، ما يجعل منها مختبرًا فعليًّا لتجريب مسارات جديدة في إدارة السّياحة الثّقافيّة.
انطلاقًا من ذلك، يقترح البحث التّوصيات الآتية:
- وضع استراتيجيّة وطنيّة متكاملة للسّياحة الثّقافيّة، بمشاركة وزارات الثّقافة والسّياحة والتّعليم، مع تعزيز دور البلديّات.
- 2. تمكين المجتمعات المحليّة من تصميم وتقديم سرديّاتها الثّقافيّة ضمن التّجربة السّياحيّة، عبر آليات تشاركيّة لا رمزيّة.
- 3. إدماج أدوات التّكنولوجيا الذّكيّة لتوسيع الفهم وتعزيز التّفاعل، شرط عدم اختزال التّجربة إلى تمثيلات بصريّة سطحيّة.
- 4. تحفيز السّياحة البطيئة القائمة على العمق والتّفاعل، بدل منطق السّرعة والصّورة الفوريّة.
- 5. تعزيز التّعاون الدولي مع منظّمات مثل اليونسكو وICOMOS لضمان صون التّراث ضمن رؤية استدامة طويلة الأمد.
سادسًا: آفاق البحث المستقبليّة
يفتح هذا البحث المجال أمام عدد من الأسئلة البحثيّة الّتي ما تزال بحاجة إلى دراسات ميدانيّة ومعمّقة، خصوصًا في ظلّ التّحولات المتسارعة الّتي يشهدها قطاع السّياحة الثّقافيّة في المنطقة العربيّة عمومًا، وفي لبنان خصوصًا. ويمكن اقتراح المحاور الآتية كامتداد طبيعيّ لمسار البحث الرّاهن:
- 1. كيف تؤثّر الرّقمنة المتزايدة على إدراك السّياح للهويّة الثّقافيّة في القرى اللّبنانيّة؟
فمع هيمنة المنصّات البصريّة وتطبيقات التّوجيه الذّكيّة، يبدو أنّ العلاقة بين الزّائر والمكان أصبحت خاضعة لأنماط تمثيل محدّدة سلفًا، ما يستدعي تحليلًا سوسيولوجيًّا لآليات الاستقبال وإنتاج المعنى.
- 2. ما نوع العلاقة التي يطوّرها السّكان المحليّون مع الزّائر في ظلّ سياسات السّياحة الثّقافيّة؟
هل هي علاقة تعاقديّة؟ تعبيريّة؟ رمزيّة؟ وهل تتغيّر هذه العلاقة حين يُشرك المجتمع في صناعة التّجربة؟
- 3. هل يمكن تصميم مسارات سياحية قائمة على سرديات السكان المحليين بدل الخطابات الرّسميّة والمؤسّساتيّة؟
وهذا يتطلّب أدوات منهجيّة جديدة تعتمد على الإثنوغرافيا التّشاركيّة، وتحليل الخطاب، وتقنيّات الاستماع المجتمعيّ.
- 4. كيف يمكن مقارنة التّجربة اللّبنانيّة بتجارب دول متوسطيّة مشابهة مثل تونس، المغرب، أو إيطاليا؟
إذ إنّ بعض هذه الدّول قطعت شوطًا في إدماج السّياحة الثّقافيّة ضمن رؤية شموليّة للتّنمية، ما يُتيح مقارنات مفيدة لفهم نقاط القوّة والقصور في النّموذج اللّبنانيّ[60].
فتح هذه المسارات لا يعني التّشكيك في الجدوى الحاليّة للسّياحة الثّقافيّة، بل يعني إعادة طرح الأسئلة حول ما نعتبره “هويّة” و”تراثًا” و”أصالة”، داخل عالم سريع التّغيّر، تُعاد فيه صياغة المفاهيم بقدر ما تُعاد صياغة المواقع.
المراجع
-أمين، سمير، (2002)، العولمة والهويّة الثقافيّة، القاهرة، دار العين للنّشر.
-أوسوالد، هنري(2018). Cultural Tourism and Contemporary Challenge ، لندن: مطبعة جامعة كامبريدج.
-بيرمان، بروس. (2017). Politics and Tourism in the Arab World. بيروت، دار الساقي.
-بو خليل، شفيق، (2010)، التّراث والسّياحة الثّقافيّة في الوطن العربيّ، بيروت، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر.
-تابت، ياسمين، (2021)، مكين الحرفيين المحليّين في السّياحة الثّقافيّة، حالة مدينة فاس، التّخطيط السّياحيّ والتّنمية، 18(2)، 134–149.
-توملينسون، جون، (2005)، العولمة والثّقافة (فايز الصّيّاغ، المترجم)، بيروت، المنظّمة العربيّة للتّرجمة.
-تيموثي، دالن ج. (2011). Cultural Heritage and Tourism: An Introduction.بريستول، مطبعة تشانيل فيو.
-الجميّل، بيار، (2008)، الهويّة اللّبنانيّة والتّحدّيات المعاصرة، بيروت، دار النّهار.
-الخطيب، محيي الدّين، (2004)، تاريخ لبنان السّياسيّ، بيروت، دار العلم للملايين.
-خالد، إيمان. (2020). “سياسة التّراث الوطنيّة والتّنمية الثّقافيّة في المغرب”. المجلّة الدّوليّة للسّياسات الثّقافيّة، 26(4)، 471–483.
-سميث، ميلاني كاي وريتشاردز، غريغ (محرران). (2006). Cultural Tourism in a Changing World: Politics, Participation and (Re)Presentation. كليفدون، مطبعة تشانيل فيو.
-سيغالا، ماريانا. (2014). “وسائل التّواصل الاجتماعيّ والسّياحة الثّقافيّة”. في وسائل التّواصل الاجتماعيّ في السّفر والسّياحة والضّيافة، لندن، روتليدج ، ص 273–288.
-غريتزل، أولريكه وآخرون. (2015). “Smart Tourism: Foundations and Developments”. الأسواق الإلكترونيّة، 25(3)، 179–188.
-غريتزل، أولريكه وجمال، تزيم وآخرون. (2017). “Creating Augmented Tourism Experiences with Technology”. وجهات نظر في إدارة السّياحة، 23، 83–86.
-غريتزل، أولريكه وجمال، تزي. (2018).“Tourist Consumer Behavior: Concepts, Influences and Opportunities”. في دليل روتليدج لتجربة السّياحة وتسويقها. لندن: روتليدج.
-كوهين، إريك. (1988). “Authenticity and Commoditization in Tourism”. حوليّات أبحاث السّياحة، 15(3)، 371–386.
-ماكانيل، دين. (1976). The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. بيركلي، مطبعة جامعة كاليفورنيا.
-ماكغرينوود، دافيد. (1989). “Culture by the Pound: An Anthropological Perspective on Tourism’s Commoditization of Culture”. في الضيوف والمضيفون، أنثروبولوجيا السياحة ، فيلادلفيا: مطبعة جامعة بنسلفانيا ص 171–185.
-هال، ستيوارت. (1990). “Cultural Identity and Diaspora”. في الهوية، المجتمع، الثقافة، الاختلاف، تحرير جوناثان رذرفورد،لندن، لورانس وويشوارت ص 222–237.
-يونسكو، (2016)، الثّقافة، مستقبل المدن، باريس، منظّمة الأمم المتّحدة للتّربية والعلم والثّقافة.
-يونسكو. (2019). Tourism and Culture for Sustainable Development in the MENA Region. واشنطن: مجموعة البنك الدّوليّ.
-يونسكو، (2022)، الثّقافة في أوقات الأزمات، تقرير عالميّ، باريس، منظّمة الأمم المتّحدة للتّربية والعلم والثّقافة.
-يونسكو، (2022)، الثّقافة في أوقات الأزمات، توصيات سياسيّة من أجل التّعليم الثّقافيّ، باريس، اليونسكو.
-يونسكو، (2022)، مبادرة ترميم التّراث الثّقافيّ في دير القمر، تقرير داخليّ، باريس، يونسكو.
-يونسكو والـICOMOS. (2021). التّراث العالميّ ومشاركة المجتمعات: دراسة حالة لبنان. باريس: منشورات يونسكو.
-يوري، جون ولارسون، يوناس، (2011)، The Tourist Gaze 3.0، لندن: منشورات ساج.
[1] أستاذة مساعدة، الجامعة اللّبنانيّة قسم الجغرافيا، كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، الفرع الثاني Cynthianasr33@hotmail.com
[2] توملينسون، جون. العولمة والثّقافة. ترجمة فايز الصيّاغ. بيروت: المنظّمة العربيّة للتّرجمة، 2005، ص. 44
[3] أمين، سمير. العولمة والهويّة الثّقافيّة. القاهرة، دار العين للنّشر، 2002، ص 78.
[4] الجميّل، بيار. الهويّة اللّبنانيّة والتّحدّيات المعاصرة. بيروت: دار النّهار للنّشر، 2008، ص 92.
[5] أوسوالد، هنريتا. السّياحة الثّقافيّة والتّحدّيات المعاصرة. لندن: مطبعة جامعة كامبريدج، 2018، ص 113.
[6] الجامعة اللّبنانيّة الأمريكيّة. دراسة ميدانيّة حول السّياحة الثّقافيّة في لبنان: التّحدّيات والفرص. بيروت: الجامعة اللّبنانيّة الأمريكيّة، 2020، ص 25.
[7] أمين، سمير، العولمة والهويّة الثقافيّة، القاهرة، دار العين للنّشر، 2002، ص 51.
8جون توملينسون، العولمة والثّقافة، ترجمة فايز الصيّاغ، (بيروت: المنظّمة العربيّة للتّرجمة، 2005)، ص 42.
[9] أوسوالد، هنريتا، السّياحة الثّقافيّة والتّحدّيات المعاصرة. لندن، مطبعة جامعة كامبريدج، 2018، ص 129.
[10] غرينوود، ديفيد، “الثّقافة بالوزن: منظور أنثروبولوجيّ للسّياحة كتسليع ثقافيّ”. المضيفون والضّيوف: أنثروبولوجيا السّياحة، تحرير فالين سميث، فيلادلفيا، دار نشر جامعة بنسلفانيا، 1989، الصّفحات 171–185.
[11] كوهين، إريك. “الأصالة وتسليع الثّقافة في السّياحة”. حوليّات أبحاث السّياحة، ج. الهويّة السّياحية الدّيناميكيّة، المجلد 15، العدد 3، 1988، ص. 371-386.
[12] كوهين، إريك. “الأصالة وتسليع الثّقافة في السّياحة”. حوليّات أبحاث السّياحة، ج. الهويّة السّياحية الدّيناميكيّة، المجلد 15، العدد 3، 1988، ص377.
[13] هول، ستيوارت. “الهويّة الثّقافيّة والشّتات.” في: الهويّة: المجتمع، الثّقافة، الاختلاف، تحرير: جوناثان رذرفورد. لندن: لورانس وويشارت، 1990، الصّفحات 222–237.
[14] ماكانيل، دين. السّائح: نظريّة جديدة للطّبقة التّرفيهيّة. بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنيا، 1976، ص. 13.
[15] ماكانيل، دين. السّائح: نظريّة جديدة للطّبقة التّرفيهيّة. لوس أنجلوس: مطبعة جامعة كاليفورنيا، 1976، ص. 29.
[16] غريتزل، أولريكه، ماريا سيغالا، تشيلين شيانغ، وتشولموكو. “السّياحة الذّكيّة: الأسس والتّطورات.” الأسواق الإلكترونيّة، المجلد 25، العدد 3، 2015، الصّفحات 179–188.
[17] كوهين، إريك. “الأصالة وتسليع الثّقافة في السّياحة”. حوليّات أبحاث السّياحة، ج. الهويّة السّياحية الدّيناميكيّة، المجلّد 15، العدد 3، 1988، ص375.
[18] اليونسكو. الثّقافة في أوقات الأزمات: تقرير عالميّ. باريس: منظّمة الأمم المتّحدة للتّربية والعلم والثّقافة، 2022، ص 47.
[19] أوري، جون، ولارسون، يوناس. نظرة السّائح 3.0. لندن: منشورات ساج، 2011، الصفحات 19-18.
[20] غريتزل، أولريكه، ماريا سيغالا، تشيلين شيانغ، وتشولمو كو، “السياحة الذكية: الأسس والتطوّرات.” الأسواق الإلكترونية، المجلد 25، العدد 3، 2015، ص 182.
[21] اليونسكو، الثقافة في أوقات الأزمات: تقرير عالمي. باريس: اليونسكو، 2022، الصفحات 55–56.
[22] الجميّل، بيار، الهويّة اللّبنانيّة والتّحدّيات المعاصرة، بيروت، دار النّهار للنّشر، 2008، ص 133.
[23] البنك الدّوليّ، السّياحة والثّقافة من أجل التّنمية المستدامة في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، واشنطن العاصمة: مجموعة البنك الدّولي، 2019، ص 28.
[24] أوسوالد، هنريتا، السّياحة الثّقافيّة والتّحدّيات المعاصرة، لندن، مطبعة جامعة كامبريدج، 2018، ص 147.
[25] الخطيب، محيي الدّين، تاريخ لبنان السّياسيّ، بيروت، دار العلم للملايين، 2004، ص 211.
[26] برمان، بروس، السّياسة والسّياحة في العالم العربيّ، بيروت، دار السّاقي، 2017، ص 65.
[27] اليونسكو، الثّقافة في أوقات الأزمات، تقرير عالميّ، باريس، منظّمة الأمم المتّحدة للتّربية والعلم والثّقافة، 2022، ص 91.
[28] بو خليل، شفيق. التّراث والسّياحة الثّقافيّة في الوطن العربيّ، بيروت، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر، 2010، ص 145.
[29] الخطيب، محيي الدّين، تاريخ لبنان السّياسي. بيروت، دار العلم للملايين، 2004، ص 117.
[30] الجميّل، بيار، الهويّة اللّبنانيّة والتّحدّيات المعاصرة، بيروت، دار النهار، 2008، ص 189.
[31] اليونسكو والمجلس الدّوليّ للمعالم والمواقع (إيكوموس)، التّراث العالميّ ومشاركة المجتمعات، دراسة حالة من لبنان، باريس، منشورات اليونسكو، 2021، ص 32.
[32] الجامعة اللّبنانيّة الأمريكيّة، دراسة ميدانية حول السياحة الثقافية في لبنان، التّحدّيات والفرص، بيروت، الجامعة اللبنانية الأمريكية، 2020، ص 19.
[33] غريتزل، أولريكه وآخرون، “السّياحة الذكية: الأسس والتطورات.” الأسواق الإلكترونية، المجلد 25، العدد 3، 2015، الصفحات 179–180.
[34] غريتزل، أولريكه، وتازيم جمال، “سلوك المستهلك في السياحة: المفاهيم، التأثيرات، والفرص.” في: دليل روتليدج لإدارة وتسويق تجربة السياحة، تحرير: نويهوفر وآخرون، لندن، روتليدج، 2018، ص 154.
[35] أوزوالد، هنرييتا، السّياحة الثّقافيّة والتّحدّيات المعاصرة، كامبريدج، مطبعة جامعة كامبريدج، 2018، ص 171,
[36] ريتشاردز، غريغ، “السّياحة الثّقافيّة، مراجعة للأبحاث والاتّجاهات الحديثة.” مجلة إدارة الضّيافة والسّياحة، المجلّد 36، 2018، الصّفحات 12–14.
[37] بو خليل، شفيق، التّراث والسّياحة الثّقافيّة في الوطن العربيّ، بيروت، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر، 2010، ص 152.
[38] ماكانيل، دين، السّائح: نظريّة جديدة للطّبقة التّرفيهيّة. بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنيا، 1976، الصّفحات 45-46.
[39] الجامعة اللّبنانيّة الأمريكيّة، دراسة ميدانيّة حول السّياحة الثّقافيّة في لبنان، التّحدّيات والفرص، بيروت، الجامعة اللّبنانيّة الأمريكيّة، 2020، ص 27.
[40] اليونسكو، مبادرة إعادة تأهيل التّراث الثقافي في دير القمر، تقرير داخليّ، باريس، اليونسكو، 2022، ص 14.
[41] اليونسكو، مبادرة إعادة تأهيل التّراث الثّقافيّ في دير القمر، تقرير داخليّ، باريس، اليونسكو، 2022، ص 19.
[42] البنك الدّوليّ، السّياحة والثّقافة من أجل التّنمية المستدامة في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، واشنطن العاصمة، مجموعة البنك الدّوليّ، 2019، ص 42.
[43]اليونسكو، الثّقافة، مستقبل حضريّ – تقرير عالميّ حول الثّقافة من أجل التّنمية الحضريّة المستدامة، باريس، اليونسكو، 2016، ص 93.
[44] أوسوالد، هنريتا، السّياحة الثّقافيّة والتّحدّيات المعاصرة، لندن، مطبعة جامعة كامبريدج، 2018، ص 165.
[45] تيموثي، دالن جي، التّراث الثّقافيّ والسّياحة، مقدمة، بريستول، منشورات تشانل فيو، 2011، الصّفحات 104–107.
[46] تابت، ياسمين، “تمكين الحرفيّين المحليّين في السّياحة الثّقافيّة، حالة مدينة فاس،” تخطيط وتطوير السياحة، المجلد 18، العدد 2، 2021، الصّفحات 134–149.
[47] سيغالا، ماريانا، “وسائل التّواصل الاجتماعيّ والسّياحة الثّقافيّة،” في، وسائل التّواصل الاجتماعيّ في السّفر والسّياحة والضّيافة، تحرير، سيغالا وآخرون، لندن، روتليدج، 2014، ص 273.
[48] غريتزل، أولريكه، تازيم جمال وآخرون، “خلق تجارب سياحية معززة من خلال التكنولوجيا”، منظورات في إدارة السياحة، المجلد 23، 2017، الصّفحات 83–86.
[49] غريتزل، أولريكه وآخرون، “السّياحة الذّكيّة: الأسس والتّطوّرات”، الأسواق الإلكترونية، المجلد 25، العدد 3، 2015، ص 185.
[50] الجميّل، بيار، الهوية اللّبنانيّة والتّحدّيات المعاصرة، بيروت، دار النّهار، 2008، ص 202.
[51] البنك الدّوليّ، السّياحة والثّقافة من أجل التّنمية المستدامة في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، واشنطن العاصمة، البنك الدّوليّ، 2019، ص 4.
[52] خليل، إيمان، “سياسة التّراث الوطنيّ والتّنمية الثّقافيّة في المغرب”، المجلّة الدّوليّة للسّياسات الثّقافيّة، المجلد 26، العدد 4، 2020، الصّفحات 471–483.
[53] اليونسكو، الثقافة في أزمة، توصيات سياساتية من أجل التعليم الثقافي، باريس، اليونسكو، 2022، الصّفحات 61–62.
[54] ريتشاردز، غريغ، “السّياحة الثّقافيّة، مراجعة للأبحاث والاتّجاهات الحديثة” ، مجلّة إدارة الضّيافة والسّياحة، المجلّد 36، 2018، ص 11.
[55] هول، ستيوارت، “الهوية الثّقافيّة والشّتات،” في، الهويّة، المجتمع، الثقافة، الاختلاف، تحرير، جوناثان رذرفورد، لندن، لورانس وويشارت، 1990، ص 226.
[56] ماكانيل، دين، السائح: نظرية جديدة للطبقة الترفيهية، بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنيا، 1976، الصّفحات 50–52.
[57] باين، بي، جوزيف، وجيلمور، جيمس إتش، اقتصاد التجربة: العمل كمسرح وكل مشروع خشبة مسرح، بوسطن: مطبعة كلية هارفارد لإدارة الأعمال، 1999، الصّفحات 86–87.
[58] هول، ستيوارت، “الهوية الثقافية والشتات”، في: الهوية، المجتمع، الثقافة، الاختلاف، تحرير: جوناثان رذرفورد، لندن: لورانس وويشارت، 1990، ص 228.
[59] تيموثي، دالن جي، التراث الثقافي والسياحة: مقدمة، بريستول: منشورات تشانل فيو، 2011، الصّفحات 193–195.
[60] سميث، ميلاني ك، وريتشاردز، غريغ، السياحة الثقافية في عالم متغير: السياسة والمشاركة والتمثيل، كليفيدون: منشورات تشانل فيو، 2006، الصّفحات 216–220.