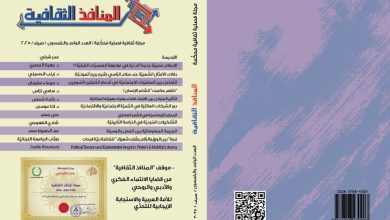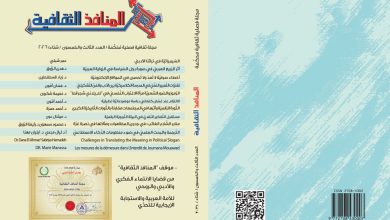الخطاب التّداوليّ في مجموعة “وجهان ووجوه أخرى” للكاتبة درّيّة فرحات
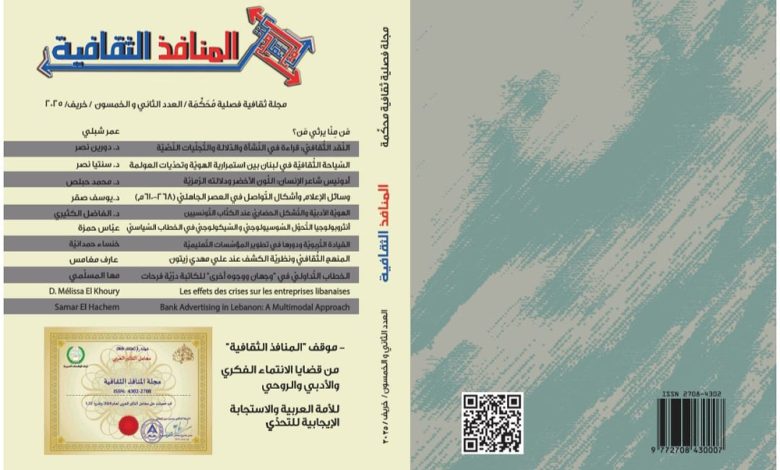
الخطاب التّداوليّ في مجموعة “وجهان ووجوه أخرى” للكاتبة درّيّة فرحات
Pragmatic Discourse in the Collection Two Faces and Other Faces by Dorria Farhat
مها هاني المسلّمي
Maha Hani Al-Musallami
تاريخ الاستلام 14/ 7/ 2025 تاريخ القبول 2/ 8/2025
المستخلص
تُسلّط هذه الدّراسة الضّوء على الخطاب التّداوليّ في مجموعة “وجهان ووجوه أخرى” للكاتبة درّيّة فرحات، بهدف الكشف عن كيفية توظيف الكاتبة للظّواهر التّداوليّة في بناء المعنى المكثّف للقصّة القصيرة جدًّا. تتناول الدّراسة الظّواهر المحوريّة المتمثّلة في الأفعال الكلاميّة، الاستلزام الحواريّ، ودور كلّ من المقام والافتراض المسبق، بالإضافة إلى آليات السّخريّة والمفارقة والرّمزيّة والإيحاء. تعتمد الدّراسة المنهج التّداوليّ التّطبيقيّ، متجاوزة التّحليل البنيويّ لتسبر أغوار الدّلالات غير المصرح بها.
وقد كشف التّحليل أنّ إيجاز القصّة القصيرة جدًّا في المجموعة يُعدّ محفّزًا لتوظيف آليات تداوليّة مكثّفة. فالكاتبة تستثمر ببراعة الأفعال الكلاميّة، خاصّة الإخباريّة والتّعبيريّة، لتقديم مشاهد مكثّفة ذات دلالات نفسيّة واجتماعيّة عميقة. كما تتبنى الاستلزام الحواريّ بصفته ركيزة أساسيّة لبناء المعنى الضّمنيّ، من خلال انتهاك مقصود لمبادئ التّعاون، ما يدفع القارئ إلى المشاركة الفاعلة في استنتاج الدّلالات. علاوة على ذلك، يؤدّي المقام والافتراض المسبق دورًا حيويًّا في تكثيف المعنى وتوجيه التّلقي، فيما تُعزز السّخريّة والرّمزيّة من حدّة النّقد وتُعمّق الدّلالات المتعلّقة بثيمات الازدواجيّة وتعدّد الأقنعة.
تُظهر النّتائج أنّ إيجاز القصص في “وجهان ووجوه أخرى” لا يُعدّ سمة شكليّة فحسب، بل هو عامل جوهري يُحوّل القارئ من متلقٍ سلبي إلى شريك فعّال في عملية بناء المعنى وكشف “الوجوه” المتعدّدة التي تُقدمها المجموعة، مما يُبرز قدرة هذا الجنس الأدبيّ على إحداث تأثير عميق بكلماتٍ قليلة.
الكلمات المفتاحيّة: الخطاب التّداوليّ، القصّة القصيرة جدًا، درّيّة فرحات، الأفعال الكلاميّة، الاستلزام الحواريّ، المقام، الافتراض المسبق، الازدواجيّة.
Abstract
This study sheds light on the pragmatic discourse in Durriya Farhat’s short story collection “Two Faces and Other Faces,” aiming to reveal how the author employs pragmatic phenomena to construct the condensed meaning of the very short story. The study addresses core phenomena, including speech acts, conversational implicature, and the role of context and presupposition, in addition to the mechanisms of irony, sarcasm, symbolism, and suggestion. The study adopts an applied pragmatic methodology, moving beyond structural analysis to delve into unspoken meanings.
The analysis reveals that the brevity of the very short stories in the collection serves as a catalyst for employing condensed pragmatic mechanisms. The author masterfully utilizes speech acts, especially assertive and expressive ones, to present condensed scenes with deep psychological and social connotations. She also adopts conversational implicature as a fundamental pillar for constructing implicit meaning through the deliberate violation of cooperative principles, which compels the reader to actively participate in inferring the connotations. Moreover, context and presupposition play a vital role in intensifying meaning and guiding reception, while irony and symbolism enhance the sharpness of criticism and deepen the connotations related to the themes of duality and multiple masks.
The findings demonstrate that the brevity of the stories in “Two Faces and Other Faces” is not merely a formal characteristic but a crucial factor that transforms the reader from a passive recipient into an active partner in the process of meaning construction and uncovering the multiple “faces” presented by the collection. This highlights the ability of this literary genre to create a profound impact with few words.
Keywords: Pragmatic discourse, very short story, Dorria Farhat, speech acts, conversational implicature, context, presupposition, duality.
المقدمة
تُمثّل القصّة القصيرة جدًّا في الأدب العربيّ المعاصر جنسًا أدبيًّا يفرض إيقاعًا خاصًّا في التّلقي، ويستدعي من القارئ مشاركة فاعلة في استخلاص المعنى من عتبات نصّيّة مكثفة. فبعيدًا من الإسهاب، يعتمد هذا الجنس الأدبيّ على الإيجاز الشّديد، ما يجعل كلّ كلمة أو جملة افتتاحيّة ذات دلالة، أو يشكّل العنوان مفتاحًا يفتح آفاقًا واسعة للتّأويل. تتجاوز هذه النّصوص السّرد المباشر لتُركّز على إحداث صدمة دلاليّة أو ومضة معرفيّة في مساحة سرديّة موجزة، ما يجعلها ميدانًا خصبًا للدّراسات الّتي تتجاوز التّحليل السّرديّ التّقليديّ نحو مقاربات أكثر عمقًا، لا سيما تلك الّتي تُعنى بكيفية بناء المعنى وتلقيه. وفي هذا السّياق، تبرز مجموعة “وجهان ووجوه أخرى” للكاتبة درّيّة فرحات، وهي مجموعة تتوزّع على تسع كوكبات، كلّ منها يضمّ عددًا متنوّعًا من القصص القصيرة جدًا، لتُقدّم نموذجًا مُكثفًا يتناول ثيمات الازدواجيّة، التّناقض بين الظّاهر والخفي، وتعدّد الأقنعة الّتي يرتديها الإنسان في حياته اليوميّة.
إنّ استكشاف الأبعاد الخفيّة لهذه المجموعة القصصيّة يتطلب منهجًا تحليليًّا قادرًا على سبر أغوار الدّلالات غير المصرح بها، وهنا يبرز المنهج التّداوليّ أداة تحليليّة محوريّة. فالتّداوليّة تُقدّم إطارًا نظريًّا ومفاهيميًا غنيًّا لفهم آليات بناء الدّلالة في القصّة القصيرة جدًّا، لاسيما تلك الّتي تركّز على المفارقات الإنسانيّة والاجتماعيّة.
تهدف هذه الدّراسة إلى تحليل “الخطاب التّداوليّ” في مجموعة “وجهان ووجوه أخرى” ككلّ، مع التّركيز على مجموعة من الظّواهر التّداوليّة المحوريّة؛ وهي: الأفعال الكلاميّة الّتي تشكل أبعادًا وظيفيّة للنّصّ، والاستلزام الحواريّ الّذي يُسهم في توليد المعاني الضّمنيّة، ودور المقام والافتراض المسبق في توجيه التّلقي. وذلك من خلال تتبع تجلّيات هذه الظّواهر عبر قصص المجموعة، من مختلف كوكباتها، للكشف عن كيفية بناء المعنى، وتأثير الكاتبة في القارئ، وكيف أنّ إيجاز هذه القصص يضاعف من أهمية هذه الأبعاد التّداوليّة في كشف “الوجوه” المتعدّدة للشّخصيّات والمواقف.
الإشكالية البحثيّة: كيف توظّف الكاتبة الظّواهر التّداوليّة (الأفعال الكلاميّة، الاستلزام الحواريّ، المقام، الافتراض المسبق) في بناء المعنى المكثّف للقصّة القصيرة جدًّا ضمن مجموعة “وجهان ووجوه أخرى” وما الأثر الّذي تحدثه هذه الظّواهر في تفاعل القارئ مع النّصّ وتلقيه للدّلالات الضّمنيّة المتعلقة بثيمات الازدواجيّة وتعدّد المظاهر؟
- I. الإطار النظريّ
يُعَدُّ المنهج التّداوليّ (Pragmatics) أحد أبرز المناهج اللّسانيّة الحديثة الّذي يُعنى بدراسة اللّغة في سياق استخدامها الفعليّ، متجاوزًا التّحليل البنيويّ للّغة بمعزل عن مستعمليها. فبينما يهتم النّحو والصّرف بدراسة بنية الجملة والكلمة، وعلم الدّلالة بدراسة المعنى الحرفيّ للألفاظ، يركّز المنهج التّداوليّ على المعنى الّذي يقصده المتكلّم أو الكاتب، وكيف يفهمه المتلقي في ضوء السّياق والمقام. (سعيد، 2005، ص. 45) إنّه يدرس العلاقة بين اللّغة ومستخدميها، وكيف تُستخدم اللّغة لإنجاز أفعال معينة وتحقيق أغراض تواصليّة. (سيرل، 1969).
تُشكّل مفاهيم تداوليّة عدّة ركائز أساسيّة لهذا المنهج، وتُعدُّ ذات أهمية خاصّة عند تحليل النّصوص الأدبيّة، لا سيما القصّة القصيرة جدًّا الّتي تعتمد على الإيجاز والتّكثيف في بناء دلالاتها، إذ تفرض طبيعتها المكثفة على الكاتبة توظيف هذه المفاهيم ببراعة لضغط المعنى، وتحفيز القارئ، وتجاوز حدود ما هو مصرح به.
١. الأفعال الكلاميّة (Speech Acts)
يُعدُّ مفهوم الأفعال الكلاميّة، الّذي طوّره الفيلسوف اللّغويّ جون أوستن (J.L. Austin) ومن بعده جون سيرل (J.R. Searle)، من أبرز مفاهيم التّداوليّة. يفترض هذا المفهوم أنّ اللّغة ليست مجرد وسيلة لوصف العالم، بل هي أداة لإنجاز أفعال. (1962, Austin,ص.12) فعندما نتحدّث أو نكتب، فإنّنا لا نقول شيئًا فحسب، بل نفعل شيئًا. تُصنَّف الأفعال الكلاميّة عادة إلى:
– الفعل الإنجازيّ (Locutionary Act): وهو فعل القول نفسه، أي المعنى الحرفي للكلمات.
– الفعل الإنجازيّ بالقوة (Illocutionary Act): وهو القصد أو الغرض من القول، أي ما يفعله المتكلّم بقوله (مثل: الإخبار، الأمر، الوعد، السّؤال، التّعبير عن المشاعر).
– الفعل الإنجازيّ بالأثر (Perlocutionary Act): وهو الأثر أو النّتيجة الّتي يحدثها القول على المتلقي (مثل: الإقناع، الإخافة، الإضحاك).
في القصّة القصيرة جدًّا، تُستخدم الأفعال الكلاميّة بكثافة وتركيز، وغالبًا ما تكون ضمنيّة، حيث يُترك للقارئ استنتاج القصد من الأفعال اللّغويّة للشّخصيّات أو الرّاوي. فإيجاز النّصّ يدفع الكاتب إلى توظيف أفعال كلاميّة ذات قوّة إنجازيّة عالية، تُحدث أثرًا كبيرًا في مساحة صغيرة. إنّ تفضيل الكاتب للأفعال الكلاميّة الضّمنيّة في هذا الجنس الأدبيّ لا يأتي من قبيل الصّدفة؛ بل هو اختيار واعٍ يهدف إلى تفعيل قدراته التّأويليّة لفكّ شيفرة القصد الخفي، ما يجعل التّجربة القرائيّة أكثر عمقًا وإشراكًا.
۲. الاستلزام الحواريّ (Conversational Implicature)
قدم الفيلسوف اللّغويّ بول جرايس (H.P. Grice) هذا المفهوم لشرح كيف يمكن للمتكلّم أنّ يوصل معنى أكثر ممّا يقوله حرفيًّا. يعتمد الاستلزام الحواريّ على مبدأ التّعاون (Cooperative Principle) وقواعده الأربع (الكم، الكيف، العلاقة، والأسلوب) يفترض هذا المبدأ أنّ كلّ مشارك في عملية التّواصل يسعى لتقديم مساهمة مفيدة وملائمة، إذ يفهم كلّ طرف أنّ الطرف الآخر يتعاون معه لإيصال المعنى، وعندما ينتهك المتكلّم إحدى هذه القواعد عمدًا، فإنّه لا يرتكب خطأ، بل يُنشئ استلزامًا حواريًّا يدفع المتلقي إلى استنتاج معنى ضمني. يتجاوز المعنى الحرفي للكلمات.
في القصّة القصيرة جدًا، يُعدُّ الاستلزام الحواريّ أداة جوهريّة لبناء المعنى. فالكاتب، بحكم إيجازه، غالبًا ما “ينتهك” عمدًا قاعدة الكم (لا يقول كلّ شيء صراحة) أو قاعدة الأسلوب (يستخدم لغة رمزيّة ومكثّفة)، ما يُجبر القارئ على تفعيل قدراته الاستنتاجيّة لملء الفراغات الدّلاليّة، واستخلاص المعاني العميقة الّتي لم تُصرح بها الكلمات مباشرة. هذا التّكثيف يُحمّل القارئ مسؤوليّة كبرى في فكّ الشّفرات الدّلاليّة، ويجعل من القصّة القصيرة جدًّا حقلًا خصبًا للتأويلات المتعددة، إذ لا يُقدم المعنى بشكل جاهز، بل يُبنى بالتعاون الضّمنيّ بين الكاتبة والقارئ.
۳. المقام (Context)
يُشكل المقام البيئة الّتي تُنتج فيها اللّغة وتُفهم. وهو يتجاوز المعنى اللّغويّ ليشمل مجموعة من العوامل غير اللّغويّة الّتي تؤثر في فهم الخطاب. يمكن تقسيم المقام إلى:
– المقام اللّغويّ (Linguistic Context): وهو ما يحيط بالعبارة من نصوص سابقة أو لاحقة.
– المقام الموقفيّ (Situational Context): وهو الظّروف المحيطة بالقول، مثل الزّمان والمكان، العلاقة بين المتحدّثين، الموضوع، والغرض من التّواصل.
– المقام المعرفيّ (Cognitive Context): وهو المعرفة المشتركة بين المتحدّثين أو بين الكاتب والقارئ.
في القصّة القصيرة جدًّا، يؤدّي المقام دورًا حيويًّا في تكثيف المعنى. فإيجاز النّصّ يعني أنّ الكاتب لا يستطيع تقديم تفاصيل كثيرة عن الزّمان والمكان أو الخلفيات. لذا، يعتمد على إشارات موجزة في المقام الموقفيّ، أو على معرفة القارئ المسبقة (المقام المعرفيّ) لتوجيهه نحو فهم الدّلالات المطلوبة، ما يجعل كلّ كلمة أو إشارة ذات وزن تداوليّ كبير. تتداخل هذه الأبعاد السّياقيّة بشكل معقد في النّصوص الأدبيّة، وتستفيد الكاتبة من هذا التّداخل ببراعة لتصنع دلالات غنيّة، إذ قد يكفي ذكر كلمة واحدة أو إشارة عابرة لتحيل القارئ إلى عالم كامل من المعاني المفترضة ضمن مقام معين.
٤. الافتراض المسبق (Presupposition)
يشير الافتراض المسبق إلى المعلومات الّتي يفترض المتكلّم أنّها معروفة أو مُسلَّم بها لدى المتلقي قبل بدء عملية التّواصل. هذه الافتراضات لا تُصرّح بها صراحة، ولكنّها ضروريّة لفهم المعنى الكامل للعبارة. في القصّة القصيرة جدًّا، يُستخدم الافتراض المسبق بكفاءة عالية لضغط المعلومات. فالكاتب يفترض معرفة معينة لدى القارئ بالثّقافة، أو التّاريخ، أو التّجارب الإنسانيّة العامّة، ما يسمح له بالإيجاز الشّديد دون فقدان المعنى. هذا المفهوم يُسهم في إثراء النّصّ بالدّلالات دون الحاجة إلى الإطناب، ويُبرز العلاقة التّشاركيّة بين الكاتب والقارئ في بناء المعنى. إنّ قدرة الكاتبة على تفعيل الافتراضات المسبقة لدى القارئ هي ما تمكنّه من خلق نصوص مكثّفة وغنيّة بالدّلالات الّتي تقرأ ” ما بين السّطور” ما يجعل القارئ طرفًا أساسيًّا في استكمال المعنى المقصود.
٥.المؤلف الضّمنيّ والقارئ الضّمنيّ (Implied Author and Imphied Reader)
يعدّ مفهوما المؤلّف الضّمنيّ والقارئ الضّمنيّ اللّذان بلورهما النّاقد الأدبيّ وأين سي. بوث (Wayne C. Booth) من المفاهيم التّداوليّة الأساسيّة الّتي تُعزز فهمنا لعملية التّواصل الأدبيّ. فالمؤلّف الضّمنيّ ليس الكاتب الحقيقي بشخصه. بل هو الصّورة الّتي يبنيها النّصّ عن مؤلفه، أو النّسخة المثاليّة للكاتبة كما تُقدمها في عملها الأدبيّ نفسه. إنّه الصّوت الّذي يحدّد قيم النّصّ ومعتقداته وتوجهاته، وهو ما يُدركه القارئ من خلال اختيارات الكاتب الأسلوبيّة، والبلاغيّة، والسّرديّة.
في القصّة القصيرة جدًّا، تُصبح أهمية هذين المفهومين مضاعفة، نظرًا لإيجاز النّصّ وتكثيفه، فالكاتبة تبني نصوصها بطريقة تتطلّب من القارئ تفعيل قدرات استنتاجيّة وتأويليّة عالية، وملء الفراغات الدّلاليّة، والتقاط الإشارات الخفيّة. إنّ القصص المكثّفة في مجموعة “وجهان ووجوه أخرى” لا تتحدّث إلى أي قارئ، بل تستدعي قارئًا واعيًّا بضرورة البحث عن المعاني غير المصرح بها، واستكشاف التّناقضات الكامنة بين الظّاهر والخفي، وفهم الأقنعة التي تقدّمها الشّخصيّات والمواقف. هذه العلاقة التّشاركيّة بين المؤلّف الضّمنيّ والقارئ الضّمنيّ هي ما يُثري تجربة التّلقي ويجعل النّصّ يُفصح عن “وجوهه” المتعددة من خلال التّفاعل المستمر بين النّص ومتلقيه الماهر.
تُعدُّ هذه المفاهيم التّداوليّة أدوات أساسيّة في تحليل مجموعة “وجهان ووجوه أخرى”، إذ ستمكننا من سبر الأبعاد الخفيّة للخطاب، وكشف كيفية بناء المعاني المتعلّقة بالازدواجيّة والتّناقض بين الظّاهر والخفي، وفهم الأثر الّذي يتركه الكاتب في المتلقي من خلال إيجازه وتكثيفه اللّغويّ.
بعد استعراض المفاهيم الأساسية للمنهج التّداوليّ، سنتناول في الجزء التالي كيفية تجلّي هذه المفاهيم في نصوص مجموعة “وجهان ووجوه أخرى” ذلك لسبر أغوار دلالاتها المكثفة وأبعادها المخفيّة.
- II. التّحليل التّطبيقيّ
يُسهم المنهج التّداوليّ في كشف الطّبقات الدّلاليّة الخفيّة في نصوص القصّة القصيرة جدًّا ضمن مجموعة “وجهان ووجوه أخرى”، إذ تتجلّى العلاقة الوثيقة بين البنيّة اللّغويّة للقصّة وغرضها التّواصلي وتأثيرها في المتلقي. إنّ إيجاز هذا الجنس الأدبيّ يدفع الكاتب إلى توظيف آليات تداوليّة مكثّفة لضغط المعنى، وإثارة الفضول، ودفع القارئ إلى المشاركة الفاعلة في بناء الدّلالة.
١. الأفعال الكلاميّة في “وجهان ووجوه أخرى”
تُمثل الأفعال الكلاميّة القوة الإنجازيّة الكامنة وراء كلّ جملة، فكل قول هو فعل. في مجموعة “وجهان ووجوه أخرى”، لا تقتصر الأفعال الكلاميّة على الحوارات الصّريحة (الّتي قد تكون نادرة أصلاً في هذا الجنس)، بل تتجسّد بقوّة في السّرد نفسه، وفي الأفعال الّتي تقوم بها الشّخصيّات أو تُوصف بها. يغلب على هذه المجموعة ثلاثة أنواع رئيسة من الأفعال الكلاميّة:
أ- الأفعال الإخباريّة (Assertives): هي الأفعال التي تهدف إلى وصف حالة من العالم، أو تقديم معلومات، أو التّعبير عن اعتقاد. وهي مهيمنة في القصص القصيرة جدًّا بشكل عام لأنّها تقدم المشهد أو الحدث الأساسي بإيجاز.
– في قصّة “زهو”: “انتظر دوره وسط الزحام وقطرات العرق على جبهته ليحصل على نسخة من الرّواية ذائعة الصّيت… خرج من القاعة رافعًا رأسه مزهوًا”. هذه الأفعال الإخبارية (انتظر، خرج) لا تقدم معلومات فحسب، بل توحي بحالة نفسيّة للبطل. فالإخبار عن “قطرات العرق” و”الخروج مزهوًا” يُخبر عن تناقض داخلي (قلق وفخر)، ما يُعد فعل إخبار يكشف عن صفة شخصية.
– في قصة “حياة”: “أكياس طحين مكدّسة في زاوية… هي فتحت عينيها أختها بقربها”. هذه الأفعال الإخبارية (مكدّسة، فتحت، بقربها) تُخبر عن واقع مؤلم ومصير محتوم. الإخبار بـ “بقربها” يحمل صدمة ويكشف عن عنف التّضحية.
– في قصة “نجاح”: “دعي إلى حضور مؤتمر مهم… وصل متأخرًا عن موعد جلسته. طلب منه اختصار مداخلته… للتوجه للاحتفاء بغداء جماعيّ بنجاح المؤتمر.” هذه الأفعال الإخبارية (دُعي، وصل، طلب) تُخبر عن تسلسل أحداث تكشف عن سطحيّة الحدث، فالمعلومات المقدمة تتصاعد لتُخبر عن تحوّل الهدف من المعرفة إلى المظاهر الاحتفاليّة.
– في قصة “وجهان”: “كان يرفع على الأكتاف في المظاهرات، يصدع صوته بحقوق المواطنين. حصل على إجازته الجامعيّة بمهارته في الغش.” الأفعال الإخباريّة هنا (يرفع، يصدع، حصل) تقدم تناقضًا صارخًا بين المظهر العلنيّ البطل والواقع الشّخصيّ للغشاش، كاشفة عن ازدواجيّة في الشّخصيّة.
ب- الأفعال التّعبيريّة (Expressives): هي الأفعال التي تُعبر عن مشاعر المتكلّم أو حالته النّفسيّة (مثل: الشّكر، الاعتذار، التّهنئة، الحزن، الفرح). غالبًا ما تكون هذه الأفعال ضمنيّة في القصّة القصيرة جدًّا، ويُترك للقارئ استنتاج المشاعر من الأوصاف أو النّتائج.
– في قصة “زهو”: “قطرات العرق على جبهته… خرج من القاعة رافعًا رأسه مزهواً”. بالرغم من عدم وجود فعل كلامي صريح يُعبّر عن القلق أو الفخر، إلّا أنّ الأوصاف الجسدية (“عرق”، “رافعًا رأسه”) تُعد أفعالًا تعبيريّة ضمنيّة عن توتره وامتلاءه بالفخر بعد الاعتراف.
– في قصة “أدوار”: “بائع الشّاي يحسد العابر، والعابر يغبط بائع الشّاي على ابتسامته المشرقة.” الأفعال هنا (يحسد، يغبط) هي أفعال تعبيريّة صريحة تُظهر المشاعر الدّاخليّة المتناقضة للشّخصيّات، وتكشف عن عدم الرّضا العام رغم اختلاف الظّاهر.
– في قصة “احتراف”: “تصبب العرق من جبينه، زاغت عيناه… تعلو وجهه علامات الثّقة.” هذه الأوصاف تُعبّر عن حالتين نفسيتين متباينتين للغشاشين (قلق وخوف مقابل ثقة وارتياح)، وهي أفعال تعبيريّة ضمنيّة تُظهر الفرق بين الغشاش المبتدئ والمحترف.
– في قصة “عاجي”: “سرح خياله بعظمة ما يقول، حلّق ببرجه العاجي يسمع تصفيح الجماهير تغلغل. عاد إلى واقعه. رأى القاعة فارغة.” الأفعال التّعبيريّة هنا ضمنيّة تمامًا، حيث تُعبّر عن شعور الزّهو والوهم الذي يعيشه المتحدّث، ثمّ صدمة الخيبة عند عودته للواقع.
ج- الأفعال الإعلانيّة (Declarations): هي الأفعال التي تُحدث تغييرًا في الواقع بمجرد قولها (مثل: إعلان الزّواج، الحكم في المحكمة، التّسميّة). قد لا تكون هذه الأفعال شائعة بوضوح في القصّة القصيرة جدًّا، لكنها قد تظهر بشكل رمزيّ أو نتيجة فعل ما.
– في قصّة “نجاح”: “طلب منه اختصار مداخلته، لإنهاء الجلسات والتّوجّه للاحتفاء بغداء جماعي بنجاح المؤتمر.” الطّلب هنا (فعل توجيهي) يُحدث فعلًا إعلانيًّا غير مباشر: إلغاء أهمية المحتوى وإعلان نجاح المؤتمر بناءً على إتمامه الشّكليّ، وليس جودته.
خلاصة الأفعال الكلاميّة:
يُلاحظ أنّ الكاتبة دريّة فرحات في مجموعة” وجهان ووجوه أخرى” تميل إلى توظيف الأفعال الإخباريّة بكثافة لتقديم المشهد أو الحدث، ثمّ تدعمها بأفعال تعبيريّة ضمنيّة (من خلال الوصف الدّقيق للحالات الجسديّة أو النّفسيّة) للكشف عن المشاعر المعقّدة، بينما الأفعال الإعلانيّة قد تأتي على شكل نتائج حاسمة تنهي القصّة وتغيّر من واقع الشّخصيّات بشكل جذريّ. يتجلّى من خلال هذا التّوظيف كيف أنّ الأفعال الكلاميّة، حتى في إيجازها، تُسهم في كشف الازدواجيّة الكامنة في الشّخصيّات والمواقف، وتُظهر التّباين بين ما يُقال صراحة وما يُضمر، مؤكّدة طبيعة “الوجهين” الذين تتناولهما المجموعة. هذا التّكثيف في استخدام الأفعال الكلاميّة يعدّ أساسًا لعمل آليات تداوليّة أخرى كالاستلزام الحواريّ، الّذي يعتمد على قدرة القارئ على استنتاج المعنى الخفي.
إذا كانت الأفعال الكلاميّة تُبرز القصد والضّمنيّ في نصوص الكاتبة، فإنّ الاستلزام الحواريّ يذهب أعمق ليكشف عن المعاني الكامنة الّتي تُبنى عبر خرق متعمد لقواعد التّواصل، مما يُشرك القارئ في عملية فكّ الأسرار الدّلاليّة.
۲. الاستلزام الحواريّ وبناء المعنى الضّمنيّ
يُعد الاستلزام الحواريّ من أهم الأدوات الّتي يعتمد عليها الكاتب في القصّة القصيرة جدًّا لبناء المعنى الضّمنيّ وتكثيف الدّلالة، وذلك بانتهاك مقصود لمبدأ التّعاون الغرايسي، خاصّةً قاعدة الكم (عدم الإفصاح عن كلّ شيء) وقاعدة الأسلوب (توظيف الإيجاز والرّمزيّة). يدفع هذا الكاتبة القارئ إلى المشاركة الفاعلة في سدّ الفجوات الدّلاليّة واستنتاج ما لم يُصرح به.
فكيف تسهم خاصية “الإيجاز” في القصّة القصيرة جدًّا في توليد الاستلزام الحواريّ بكثافة؟
– إنّ القصّة القصيرة جدًّا بطبيعتها تُجبر الكاتب على حذف الكثير من التّفاصيل والسّياقات، ما يخلق فجوات نصيّة يملؤها القارئ من خلال استنتاجاته. هذا الحذف المتعمد هو في حدّ ذاته انتهاك لقاعدة الكم، ما يولد استلزامات حواريّة متعددة. القارئ لا يتلقى معلومات جاهزة، بل يُحفز لإعمال فكره لفك شيفرة النّصّ.
ما هي أنواع المعلومات التي تفضل الكاتبة تركها ضمنيّة؟
-غالبًا ما يترك الكاتب ضمنيًا: الدّوافع الحقيقية للشّخصيّات، الخلفيات التّاريخيّة أو الاجتماعيّة للحدث، المشاعر العميقة غير المصرّح بها، والنّقد اللاذع للمجتمع أو الظّواهر الإنسانيّة. هذا يمنح القصّة عمقًا ويتيح تفسيرات متعدّدة.
– في قصة “زهو”: “خرج من القاعة رافعًا رأسه مزهواً، يحمل الرّواية بأطراف أصابعه تبللت من العرق، تكاد تقع.”
– الاستلزام الحواريّ: انتهاك قاعدة الكيف (لا يقول الحقيقة كاملة حول مشاعره). القارئ هنا يستلزم أنّ الزّهو الخارجي لهذا الشّاب ليس نابعًا من ثقة حقيقيّة بالنّفس، بل يختلط بقلق أو توتر شديد (التّعرّق والخوف من سقوط الرّواية). هذا يفتح الباب لاستلزام أنّ النّجاح الخارجيّ قد يكون مصحوبًا بضغوط داخليّة أو شعور بعدم الاستحقاق.
– في قصة “نجاح”: “طلب منه اختصار مداخلته، لإنهاء الجلسات والتّوجّه للاحتفاء بغداء جماعيّ بنجاح المؤتمر.”
* الاستلزام الحواريّ: انتهاك قاعدة العلاقة (التّركيز على الغداء بدلاً من المحتوى العلميّ).
* الاستلزامات: يُستلزم أنّ “نجاح المؤتمر” لم يكن مرتبطًا بعمق الأوراق البحثيّة أو تبادل المعرفة، بل بإتمامه الشّكليّ، وأنّ المظاهر الاجتماعيّة والاحتفالات طغت على الجوهر العلميّ. يولّد هذا استلزامًا ساخرًا ونقدًا ضمنيًا لسطحيّة بعض الفعاليات الأكاديميّة.
– في قصّة “أدوار”: “بائع الشّاي يحسد العابر، والعابر يغبط بائع الشّاي على ابتسامته المشرقة.”
* الاستلزام الحواريّ: انتهاك لقاعدة الكم (لا يشرح لماذا يحسد هذا أو يغبط ذاك).
* الاستلزامات: يُستلزم أنّ السّعادة والرّضا لا يرتبطان بالضّرورة بالمظاهر الخارجيّة للثّروة أو المكانة. الكاتبة تترك للقارئ استنتاج أنّ كلّ طرف يرى ما ينقصه في حياة الآخر، وأنّ الأدوار الاجتماعيّة قد تكون قشورًا تخفي مشاعر داخليّة معقّدة من عدم الرّضا أو البحث عن السّكينة.
– في قصّة “وجهان”: “كان يرفع على الأكتاف في المظاهرات، يصدع صوته بحقوق المواطنين. حصل على إجازته الجامعيّة بمهارته في الغش. حصل له مستقبل باهر.”
* الاستلزام الحواريّ: انتهاك لقاعدة الكيف (لا يقول الحقيقة كاملة حول مصدر نجاحه)، وتناقض صريح.
* الاستلزامات: الكاتبة تدفع القارئ لاستنتاج أنّ “المناضل” هو في الحقيقة انتهازي، وأنّ شعاراته مجرد قناع. “مستقبل باهر” يُستلزم أنّه تحقق بطرق غير مشروعة، ممّا يولّد نقدًا لاذعًا للازدواجيّة الأخلاقية في المجتمع الّذي قد يكافئ الفاسدين.
خلاصة: إنّ إيجاز القصّة القصيرة جدًّا يدفع الكاتبة في مجموعة “وجهان ووجوه أخرى” إلى استخدام الاستلزام الحواريّ ركيزة أساسيّة لبناء المعنى. فهي لا تقدّم للقارئ الدّلالة جاهزة، بل تتركه يستنتجها من خلال الفجوات النّصيّة والتّناقضات الظّاهريّة، وتُجبر القارئ على كشف الوجوه المتعددة من خلال إشارات مكثفة تُوجّه القارئ لاكتشاف الخفايا، فهذه الأدوات تُبرز الشّراكة المعرفيّة بين الكاتب والقارئ في بناء الصّورة الكاملة، ما يعمق تجربة القراءة ويجعلها أكثر تفاعليّة.
۲. دور المقام والافتراض المسبق
يؤدّي المقام (Context) بأبعاده المختلفة اللّغويّ، الموقفيّ، والمعرفيّ دورًا محوريًّا في القصّة القصيرة جدًّا، فهو البيئة التي تُولد فيها الدّلالة وتُستنتج. نظرًا لإيجاز هذه النّصوص، لا تُقدم الكاتبة تفاصيل كثيرة عن الزّمان أو المكان أو الخلفيات، بل تعتمد على إشارات مكثفّة، وعلى ما يفترضه من معرفة مشتركة مع القارئ (الافتراض المسبق)، لتوجيهه نحو المعاني المطلوبة.
– دور المقام (الزّمان والمكان والظّروف)
المقام الموقفي في بناء الثيمة:
– في قصة “زهو”: “انتظر دوره وسط الزحام وقطرات العرق على جبهته ليحصل على نسخة من الرواية ذائعة الصّيت… خرج من القاعة رافعًا رأسه مزهوًا”. المقام هنا هو “قاعة” توزيع (أو بيع) “رواية ذائعة الصّيت” وسط “زحام”. هذا المقام يوحي بحدث ثقافيّ مهم، وبسعي حثيث خلف الشّهرة أو النّجاح. إنّ حرارة المكان و”العرق” يشدّدان على قيمة هذا السّعي، بينما “رفع الرأس” بعد الخروج يؤكّد تحقيق الهدف الظّاهري في هذا المقام. هذا المقام يبني ثيمة التباهي بالانتماء لتيار ثقافي سائد.
-في قصة “حياة”: “أكياس طحين مكدّسة في زاوية… ثلاثة أكياس كبار هاربة تسارعت في الطريق”. المقام المكانيّ (الزّاوية، الطّريق) هو مكان هامشي ثمّ مكان للحركة المجهولة المصير. “الزّاوية” توحي بالإهمال، بينما “الطّريق” يشير إلى مسار لا مفر منه. هذه الأمكنة، مع فعل “نزفت طحينها”، تضع القصّة في مقام تراجيديّ وجوديّ يدور حول التّضحية والحتميّة.
– في قصّة “نجاح”: “مؤتمر مهم يتناول قضيّة نقديّة… وصل متأخرًا عن موعد جلسته… لإنهاء الجلسات والتّوجه للاحتفاء بغداء جماعي بنجاح المؤتمر.” المقام هو “المؤتمر” الّذي يُفترض أنّ يكون جادًا وذا قيمة علميّة. لكن الإشارة إلى “اختصار المداخلة” لأجل “الغداء الجماعيّ” يحوّل هذا المقام من مكان للمعرفة إلى مكان للمظاهر الاجتماعيّة، ما يؤثّر على فهمنا لـ “نجاح” المؤتمر نفسه، ويعمق السّخريّة.
-في قصّة “احتراف”: “قاعات الامتحان”. هذا المقام يفرض قواعد صارمة تتعلق بالنّزاهة والتّقييم. الكشف عن أنّ الغش يحدث في هذا المقام بالذّات، ويُمارس بـ “احتراف”، يزيد من حدّة المفارقة الأخلاقيّة ويجعل النّقد أكثر مرارة.
– في قصّة “عاجي”: “أعلى المنبر… القاعة فارغة”. المقام هو مكان الخطاب العام والقيادة والتّأثير. التّناقض بين “أعلى المنبر” (المكان الّذي يرمز للسّلطة والتّأثير) و”القاعة الفارغة” (المكان الّذي يرمز للعزلة والوهم) يُسهم في بناء المعنى الجوهريّ للقصّة حول الغرور والانفصال عن الواقع.
* الافتراض المسبق في ضغط المعنى:
تعتمد الكاتبة بشكل كبير على افتراض معرفة القارئ بخلفيّات ثقافيّة، اجتماعيّة، أو حتى نفسيّة معينة، لتقديم قصصها بإيجاز.
– في قصّة “زهو”: “رواية ذائعة الصّيت”. تفترض الكاتبة أنّ القارئ يدرك معنى “ذائعة الصيت” وما تثيره من ضجة أو رغبة في الامتلاك، وأنّ امتلاكها يمثل نوعًا من “الزهو” الاجتماعي المرتبط بالموجة الرائجة، حتى لو كان ذلك على حساب الجودة الشّخصية أو الرّاحة.
– في قصّة “حياة”: “أكياس طحين مكدّسة”. يفترض القارئ أنّ الطحين هو أساس الحياة والقوت. وعندما “تنزف” الأكياس، يُستفاد من هذا الافتراض المسبق لفهم معنى الفناء.
– في قصّة “نجاح”: “مؤتمر مهم يتناول قضيّة نقديّة”. تفترض الكاتبة أنّ القارئ يدرك القيمة المفترضة للمؤتمرات النقديّة، وأهمية الأوراق البحثيّة، وأنّ “الغداء الجماعيّ” عادة ما يكون ثانويًّا بالنّسبة إلى الجانب العلميّ. هذا الافتراض المسبق يُسهم في تعزيز المفارقة والسّخريّة من تحول الأولويات.
-في قصّة “أدوار”: “بائع الشّاي يحسد العابر، والعابر يغبط بائع الشّاي على ابتسامته المشرقة”. تفترض الكاتبة أنّ القارئ يدرك الفروقات الطّبقيّة والاجتماعيّة التي تجعل “العابر بسيارته الفاخرة” يبدو وكأنّه الأوفر حظًا، وأنّ “بائع الشّاي” هو الأقل مكانة. هذا الافتراض يُستخدم ليُفاجئ القارئ بتناقض المشاعر، فيُثبت أنّ الظّاهر ليس دائمًا هو الحقيقة، وأنّ السّعادة قد لا ترتبط بالثّراء.
– في قصّة “وجهان”: “يرفع على الأكتاف في المظاهرات، يصدع صوته بحقوق المواطنين. حصل على إجازته الجامعيّة بمهارته في الغش.” تفترض الكاتبة أنّ القارئ يمتلك افتراضات مسبقة عن “المظاهرات” كفعل نضالي من أجل مبادئ نبيلة، وعن “الجامعة” كمكان للنزاهة العلميّة. هذا التناقض بين الافتراضات المسبقة عن هذه الأماكن والأفعال، وبين السّلوك الفعليّ للشّخصيّة (الغش)، هو ما يُحدث الصّدمة ويكشف “الوجهين”.
– في قصّة “اختلاف”: “تخفيف المعطى المطلوب… أنموذج لائق بالمستوى، حفاظًا منه على الغد، ومحبة للوطن. امتلأت القاعة الأولى بالطّلاب.” يفترض الكاتب أنّ القارئ يدرك أهمية الجودة التّعليميّة، وأنّ التّسهيل المبالغ فيه قد يؤثّر سلبًا في “الغد” و”الوطن”. القارئ يستند إلى هذا الافتراض المسبق ليفهم مرارة امتلاء القاعة الّتي تبنت النّهج الأسهل، وأنّ هذا الامتلاء قد لا يكون بالضّرورة دليلًا على الأفضلية الجوهريّة.
خلاصة
تستخدم الكاتبة في “وجهان ووجوه أخرى” المقام والافتراض المسبق ببراعة لضغط المعنى. فهي توفر إشارات سياقيّة محدودة لكنّها قوّية، وتفترض معرفة مشتركة لدى القارئ، ما يسمح لها بتمرير دلالات عميقة ومعقدّة حول المفارقات الإنسانيّة والاجتماعيّة في مساحة نصيّة ضيقة. هذه المفاهيم التّداوليّة تحول القارئ من متلقي سلبيّ إلى مشارك فعّال في فكّ شفرة النّص، وإدراك “الوجوه” المتعدّدة للواقع.
٤. الجوانب التّداوليّة الأخرى
إلى جانب الأفعال الكلاميّة، والاستلزام الحواريّ، ودور المقام والافتراض المسبق، تُوظّف مجموعة “وجهان ووجوه أخرى” آليات تداوليّة أخرى تُسهم في تعميق الدّلالة وإثراء تجربة التّلقي، أبرزها السّخرية والمفارقة، والرّمزيّة المكثّفة.
أ- السّخريّة والمفارقة (Irony and Sarcasm):
تُعد السّخريّة أداة تداوليّة قوية تُستخدم لقول عكس ما يُقصد حرفيًا، أو للكشف عن تناقضات مؤلمة أو مضحكة في الواقع. يعتمد الكاتب على السّخريّة والمفارقة للكشف عن الزّيف، والنّفاق، والسّطحيّة، أو عبثيّة بعض المواقف الإنسانيّة والاجتماعيّة. تُولد السّخريّة هنا من انتهاك مقصود لقاعدة الكيف (قول ما هو غير حقيقي أو مضلل ظاهريًّا)، ما يدفع القارئ إلى استنتاج المعنى الحقيقي (السّاخر).
– في قصّة “نجاح”: “طلب منه اختصار مداخلته، لإنهاء الجلسات والتّوجّه للاحتفاء بغداء جماعيّ بنجاح المؤتمر.” تكمن السّخريّة هنا في ربط “نجاح المؤتمر” بإتمامه الشّكلي وتناول الغداء، وليس بعمق المحتوى أو الأوراق البحثيّة. فتبرز السّخريّة من المظاهر التي تطغى على الجوهر في الفعاليّات الأكاديميّة أو المهنيّة، ويوحي بأنّ الهدف الحقيقي أصبح اجتماعيًّا لا علميًّا.
– في قصّة “وجهان”: “كان يرفع على الأكتاف في المظاهرات، يصدع صوته بحقوق المواطنين. حصل على إجازته الجامعيّة بمهارته في الغش. حصل له مستقبل باهر.” السّخريّة هنا لاذعة ومريرة. فالبطل الذي يرفع شعارات النضال من أجل “حقوق المواطنين” هو نفسه من يحصل على “مستقبل باهر” بـ “مهارته في الغش”. الكاتبة تسخر من النّفاق الاجتماعيّ والسّياسيّ، وتوحي بأنّ النّجاح في هذا الواقع قد يُبنى على الفساد والازدواجيّة الأخلاقيّة.
– في قصّة “احتراف”: “جلس الآخر في المقعد الأمامي، تعلو وجهه علامات الثّقة، أتقن نقل الإجابات. خرج مزهوًا بنجاحه.” السّخريّة هنا تكمن في وصف “الغش” بـ “الاحتراف” وربطه بـ”الثّقة” و”النّجاح”. الكاتبة تسخر من نظام يكافئ الغشاش المتقن، ويوحي بأنّ المهارة قد تُستخدم في أغراض غير أخلاقيّة وتُحقق النّجاح الظّاهريّ على حساب النّزاهة.
– في قصّة “أدوار”: “بائع الشّاي يحسد العابر، والعابر يغبط بائع الشّاي على ابتسامته المشرقة.” المفارقة السّاخرة هنا تكشف أنّ كلّ طرف يرى النّقص في حياته ويكملها بما يظنه موجودًا عند الآخر، ما يسخر من فكرة أنّ الثّراء يجلب السّعادة بالضّرورة، ويوحي بأنّ الرّضا قد يكون أندر من الماديّات.
ب- الرّمزيّة والإيحاء (Symbolism and Suggestion):
تُعدّ الرّمزيّة أداة تداوليّة حيويّة في القصّة القصيرة جدًّا، إذ تُستخدم الكلمات أو الأشياء أو الأفعال للدّلالة على معانٍ أعمق وأوسع من معناها الحرفيّ. تعتمد الكاتبة على الرّموز لتكثيف الدّلالة، وإثارة التّأمّل، وترك مساحة واسعة لتأويل القارئ. غالبًا ما تعمل الرّمزيّة جنبًا إلى جنب مع الاستلزام الحواريّ والافتراض المسبق، إذ يُفترض أنّ القارئ يمتلك المعرفة الثّقافيّة أو الإنسانيّة اللازمة لفكّ رموز هذه الإشارات.
– في قصّة “عاجي”: “حلق ببرجه العاجي يسمع تصفيح الجماهير تغلغل. عاد إلى واقعه. رأى القاعة فارغة.” “البرج العاجي” يرمز إلى العزلة، الانفصال عن الواقع، والغرور الذي يدفع الشّخص للعيش في عالم من الأوهام الذّاتية. رؤية “القاعة الفارغة” ترمز إلى صدمة العودة إلى للواقع وكشف زيف هذه الأوهام.
– في قصّة “النّجاة”: “خلع نعله البالي، رمى أدوات عمله التي عفا عليها الزّمن. وظلّ يحلم…” “النّعال البالية” و”أدوات العمل التي عفا عليها الزمن” ترمز إلى أعباء الماضي، الرّوتين المنهك، والقيود الماديّة. التّخلّص منها يرمز إلى التّحرّر الرّوحي والنّفسيّ، و”الحلم” يرمز إلى الملاذ الأخير والخلاص من واقع قاسٍ.
– في قصّة “دموع”: ” آبت ضاحكة وفي عينيها دموع التّماسيح”، “دموع التماسيح” هي رمز شائع للخداع، الدّموع الزّائفة، والتّلاعب العاطفيّ. استخدام هذا الرّمز يكشف بوضوح عن حقيقة نوايا الشّخصيّة المخادعة، ويوحي بأنّ المظهر العاطفيّ قد يكون قناعًا يخفي شرًا.
الخاتمة
لقد سعت هذه الدّراسة إلى الكشف عن آليات توظيف الكاتبة ” درّيّة فرحات ” للظّواهر التّداوليّة في بناء المعنى المكثّف ضمن مجموعتها القصصيّة “وجهان ووجوه أخرى” وبيان الأثر الّذي تحدثه هذه الظّواهر في تفاعل القارئ وتلقيه للدّلالات الضّمنيّة المتعلقة بثيمات الازدواجيّة وتعدّد المظاهر.
لقد كشف التّحليل التّطبيقيّ أنّ الكاتبة تستثمر ببراعة الأفعال الكلاميّة، سواء الصّريحة منها أو الضّمنيّة (بخاصّة الإخباريّة والتّعبيريّة) لتقديم مشهد مكثف ينطوي على دلالات نفسيّة واجتماعيّة عميقة تفوق المعنى الحرفي. كما تبين أنّ الاستلزام الحواريّ يُعدّ ركيزة أساسيّة في بناء المعنى الضّمنيّ، إذ تدفع الكاتبة القارئ إلى المشاركة الفاعلة في سدّ الفجوات النّصيّة واستنتاج ما لم يُصرّح به، وذلك عبر انتهاك مقصود لمبادئ التّعاون، ما يُعمّق تجربة القراءة ويجعلها أكثر تفاعليّة.
على نحو متوازٍ، أظهرت الدّراسة الدّور الحيوي الّذي يؤديه المقام بأبعاده المختلفة (اللّغويّ، الموقفيّ، المعرفيّ) في تكثيف الدّلالة وتوجيه التّلقي، فإشارات المقام الموجزة والافتراضات المسبقة الّتي تعتمدها الكاتبة على معرفة القارئ تُمكّنها من تمرير رسائل معقّدة في مساحة نصّيّة ضيقة. كما عزّزت السّخريّة والمفارقة من حدّة النّقد اللّاذع للظّواهر الاجتماعيّة السّلبيّة كالازدواجيّة والنّفاق. بينما أسهم الإيحاء والرّمزيّة في إثراء النّصوص بدلالات أعمق تتجاوز الواقع المباشر.
تُظهر هذه الدّراسة أنّ إيجاز القصّة القصيرة جدًّا في مجموعة “وجهان ووجوه أخرى” ليس مجرد سمّة شكليّة، بل هو محفّز لتوظيف آليات تداوليّة مكثّفة تُحوّل القارئ من متلقٍ سلبي إلى شريك فعّال في عملية بناء الدّلالة. فالنّصوص لا تقدّم “الوجوه” جاهزة، بل تُدفع القارئ إلى فكّ شيفرتها واستنتاج حقيقتها الخفيّة، مما يُعلي من قيمة التّفاعل التّواصلي ويُبرز قدرة هذا الجنس الأدبيّ على إحداث تأثيرعميق بكلمات قليلة.
ختامًا، تقدّم هذه الدّراسة إضاءة على الأبعاد التّداوليّة الغنيّة في نصوص الكاتبة درّيّة فرحات، وتُسهم في إثراء فهمنا لكيفية عمل الخطاب الأدبيّ المكثّف في القصّة القصيرة جدًّا. واقترح آفاقًا بحثيّة مستقبليّة، ومنها دراسة الجوانب التّداوليّة في أعمال أخرى للكاتبة، أو إجراء دراسات مقارنة بين نصوصها ونصوص أخرى من جنس القصّة القصيرة جدًّا لكشف تنوّع الأساليب التّداوليّة في هذا الفنّ الأدبيّ.
المصادر والمراجع
-براون، ج. ب؛و يول، جورج (١٩٩٧). تحليل الخطاب. (م. ل. الزليطي و م.التريكي، مترجمون). جامعة الملك سعود (نُشر العمل الأصليّ ١٩٨٣).
-بلانشيه، ف. (٢٠٠٧). التّداوليّة من أوستين إلى غوفمان. (ترجمة ص. الحباشة.) دار الحوار للنشر والتّوزيع.
– الزبيدي، أ. (2010). القصة القصيرة جداً: طبيعتها وخصائصها. مجلة الآداب، ( 25(3))، 112-130.
– سعيد، ج. (2005). مفاهيم في علم اللغة التطبيقي. دار الكتب العلميّة.
-الشّهري، ع. هـ. ب. ظ. (٢٠٠٤). استراتيجيات الخطاب.. دار الكتاب الجديد المتحدة.
-صحراوي، م. (٢٠٠٥). التّداوليّة عند العلماء العرب. دار الطليعة للطباعة والنشر.
-علوي، ح.إ. (٢٠١٤). التّداوليّة علم استعمال اللّغة. عالم الكتب الحديث.
– العلي، م.، والناصر، س. (2020). نظرية التداولية وتطبيقاتها. دار الشروق.
– فرحات، درية. (2025). وجهان ووجوه أخرى. دار النهضة العربيّة.
-نحلة، م. أ. (٢٠٠٢). آفاق في البحث اللّغويّ المعاصر. دار المعرفة الجامعية.
-يول، ج. (٢٠١٠). التّداوليّة. (ق. العتّابي، مترجم) الدار العربيّة للعلوم ناشرون دار الأمان.
-Austin, J. L. (1962). How to do things with words. Harvard University Press. –
– Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some universals in language usage. Cambridge University Press, 7(2), 295-326
– Searle, J. R., & Vanderveken, D. (1985). Foundations of illocutionary logic. Cambridge: Cambridge University Press
– Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), Syntax and semantics, Vol. 3: Speech acts (pp. 41-58). Academic Press.