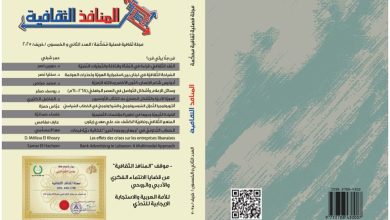المنهج الثّقافيّ ونظريّة الكشف: نحو تأصيل منهجيّ في ضوء المشروع النّقديّ عند علي مهدي زيتون
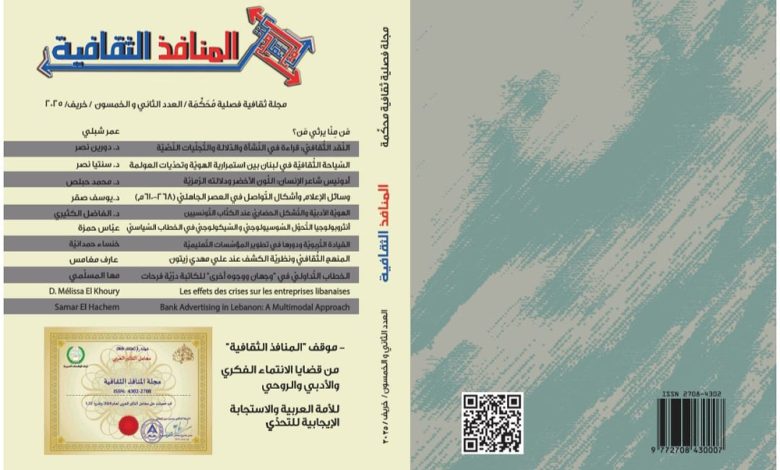
المنهج الثّقافيّ ونظريّة الكشف: نحو تأصيل منهجيّ في ضوء المشروع النّقديّ عند علي مهدي زيتون
The Cultural Approach and the Theory of Unveiling: Towards a Methodological Foundation in Light of Ali Mahdi Zaytoun’s Critical Project
عارف مغامس
Aref Mghames
تاريخ الاستلام 15/ 7/ 2025 تاريخ القبول 1/ 8/2025
الملخص
يقدّم هذا البحث قراءة تحليليّة لمشروع علي زيتون النّقديّ، الذي يقوم على المنهج الثّقافيّ في تلازمه مع نظريّة الكشف، بوصفهما رؤية تتجاوز الأطر البنيويّة والشّكلانيّة إلى مقاربة النّص الأدبيّ ضمن سياقاته الثقافيّة والاجتماعيّة والتّاريخيّة، مع الحفاظ على بنيته الجماليّة. يركّز المنهج الثّقافيّ، وفق رؤية زيتون، على استنطاق الأنساق المضمرة واستكشاف ما وراء المعنى، استنادًا إلى تأويل عرفانيّ يجعل النّص فضاء معرفيًّا يتفاعل فيه الجمالي مع الثّقافيّ.
يعتمد البحث منهج التّحليل المقارن لبيان موقع المنهج الثّقافيّ ونظريّة الكشف بين المناهج النّقديّة الحديثة، وإبراز دورهما في تجديد مقاربة النصوص الأدبيّة وإغنائها برؤية نقديّة متكاملة.
الكلمات المفتاحيّة: المنهج الثّقافيّ- نظريّة الكشف- علي زيتون- النّقد الثّقافيّ- الأنساق المضمرة- التّأويل- المناهج النّقديّة الحديثة- النّقد العربيّ المعاصر.
Abstract
This study presents an analytical reading of Ali Zeitoun’s critical project, founded on the Cultural Approach in conjunction with the Theory of Unveiling as a vision that transcends structuralist and formalist frameworks to approach literary texts within their cultural, social, and historical contexts, while preserving their aesthetic structures. The Cultural Approach, as conceptualized by Zeitoun, focuses on revealing latent patterns and exploring the realm beyond meaning, grounded in a gnostic interpretation that renders the text as a cognitive space where the aesthetic and the cultural interact.
The research adopts a comparative analytical method to highlight the position of the Cultural Approach and the Theory of Unveiling among modern critical methodologies, and to demonstrate their role in renewing the approach to literary texts and enriching them with an integrated critical vision.
Keywords: Cultural Approach- Theory of Unveiling- Ali Zeitoun- Cultural Criticism- Latent Patterns- Interpretation- Modern Critical Methodologies- Contemporary Arab Criticism
مقدّمة
شكّلت المناهج النّقديّة الحديثة تحوّلّا جوهريّّا لاستنطاق النّصوص وفهمها وتحليلها، في سعيها إلى تجديد فهمنا للأدب بوصفه تجربة حيّة تعكس تنوّع السّياقات والمرجعيّات، من خلال القراءات المتعدّدة التي تجاوزت القراءة الجماليّة والبنيويّة إلى استكشاف البنى الثّقافيّة والنّفسيّة والاجتماعيّة التي تكمن فيها.
وإذ بدا منتصف القرن العشرين مسرحًا لهذا المسار المعرفي الذي اتّجه من تحليل البنية إلى توسيع مفهوم العلامة وتحليل السّمات الفنيّة واللّغويّة، ثم إلى تفكيك المعنى وتأويله ثقافيّّا وفكريّّا وهدم اليقين الدّلاليّ، نتيجة التحوّلات التي اتّسم بها الفكر الغربيّ والعربيّ معا، جاء المنهج الثّقافيّ ليعلي من شأن العلاقة بين الأدب والثّقافة لكشف أنساق سلطة النّص وهويته ضمن رؤية تأويليّة تتجاوز تحليل النّسق إلى استكشاف أبعاده القصيّة الكامنة فيما وراء المعنى، وقراءة ما استبطن فيه لإضاءة رموزه وفاق ما أسماه علي زيتون ب” نظريّة الكشف” التي عطفها في العنوان على “المنهج الثّقافيّ”.
وفي هذا السّياق، قدّم علي زيتون رؤيته التي تطرح الإشكاليّة المركزيّة الآتية:
إلى أيّ مدى استطاع المنهج الثّقافيّ أن يوفّق بين المناهج الحديثة التي شغلت حيّزًا كبيرًا في النّقد المعاصر وبين المقاربة الثّقافيّة للنّص في ضوء نظريّة الكشف التي شكّلت بحدّ ذاتها رؤية خاصة ترى ما لم تره القراءات السّابقة؟
وما موقع هذه الرّؤية في الدّراسات النّقديّة الحديثة؟ وهل يُعدّ ما قدّمه المؤلّف استمرارًا وتعديلًا لتلك المناهج وامتدادًا لفضائها المعرفيّ؟ أم هو على قطيعة معها؟
يتاح لهذه الإشكالية أن تطرح الفرضيّات الآتية:
إن المنهج الثّقافيّ عند علي زيتون شكّل تحوّلّا جديدّا في مسار الدّراسات النّقديّة الحديثة والمعاصرة. فهو لا يتوقف عند تحليل البنى النّصيّة فحسب، بل يتوسّل الكشف التّأويليّ والرّمزي لإنتاج المعنى، وتشكيل النّسق النّصيّ بوعي معرفيّ وجماليّ مرتكز إلى البعد الثّقافيّ.” خصوصًا أنّ المنهج الثّقافيّ منهج منتم إلى الحداثة من جهة أو إلى مؤسّسة النّقد الأدبيّ من جهة أخرى”[1]
إن نظريّة الكشف بما تكتنزه من أبعاد تأويليّة وعرفانيّة ووجوديّة قادرة على تمييز المنهج الثّقافيّ عمّا ساد من دراسات، وتخصيصه برؤية كشفيّة عميقة. وهي نظريّة تقوم على كشف ما تكتنزه النصوص من خصوصيات معرفيّة، وتحويلها إلى مفاهيم ثقافية، مرتكزة إلى مناهج سابقة من دون الانصهار بها، فضلا عن معارضة بعضها.
جدليّة النّص والسّياق في ضوء تصوّر الكاتب
يحتلّ النص عند النّاقد علي زيتون موقعًا من مواقع الدّهشة الدائمة، والقوّة الخفيّة الضمنيّة. إذ ينطلق إلى داخله بأدواته الخاصة التي ينفرد بامتلاكها وباستخدامها في تطويع النص وتفجيره من داخله، ليخرج منه على طريقته برؤية تعبّر عن الفعاليّة الأرقى في حياة أيّ إنسان، إذ” إنّ هذه الرّؤية فعاليّة مركّبة قوامها ثقافة الفرد، قناعاته، همومه، اهتماماته، انفعالاته”[2] وهي مكوّنات تتعالق فيما بينها بما تملكه من مقومات الأدبيّة لتنصهر في تركيب موحّد، وبأنساق تربط النص بمنظومات ثقافيّة تحمل أبعادا فكريّة وعرفانيّة قاربها علي زيتون بمدلولات مكتشفة وعلاقات نشأت من تموضعها الجديد لينتج منها المنهج الثّقافيّ المرتكز إلى نظرية الكشف، بما تحمله هذه النظرية من عمق ثقافي وفكري مبنيّ على فضاء الرّؤية إلى العالم.
وإذ تُعد تجربة علي زيتون النّقديّة علامة فارقة في مسار النّقد الثّقافيّ، فذلك لأنّ المنهج الثّقافيّ الذي قدّمه يستند إلى خصوصيات ثقافيّة متعدّدة، تشكّلت من منابع عربيّة وإسلاميّة، تلاقت مع مشارب ثقافيّة غربيّة تعامل معها علي زيتون بعقل نقديّ وعلميّ استباقيّ، انطلاقًا من أنّ النّص الأدبيّ ليس معزولًا عن محيطه الثّقافيّ. إذ تكمن أهميته في أنهّ أعاد الاعتبار إلى الدّور الفاعل والمؤثّر للثّقافة في إنتاج النّصوص الأدبيّة لاستنطاق المسكوت عنه عبر رؤية عرفانيّة تأويليّة.
إن تحليل مشروع علي زيتون النّقديّ، ينطلق من الإمساك بمفاتيح الرّؤية إلى العالم، لفهم أثرها في تطوّر أدوات كشف القيم الفنيّة وآلياتها، وصياغة مفاهيم جماليّة وفكريّة منها. وهي مفاهيم تعزّز قراءة المسكوت عنه الكامن خلف النّصوص الأدبيّة، لإدراك الحقائق الماورائيّة، وتفكيك بنياتها الدّلاليّة والثّقافيّة. حيث اتسمت الدّراسات النّقديّة الحديثة بالتحوّل المعرفي من مركزيّة النص الأدبيّ وبنيته المغلقة إلى مدارات أكثر ارتباطا بالسّياق الثّقافيّ المتجاوز حدود التّحليل إلى فضاء كشف تلك الأنساق المضمرة، مع الحفاظ على خصوصية البنى الجماليّة للنّص.
نشأة المنهج تحت ظلال الكشف
ارتبطت نشأة المنهج الثّقافيّ بالتحوّلات المعرفيّة لما بعد الحداثة، وقد جاء استجابة لحاجة الدّرس النّقديّ إلى رؤية كاشفة تنطلق من أنّ النص الأدبيّ يمتلك مقوّمات ومكوّنات معرفيّة وجماليّة جعلته منفتحًا على العالم. خصوصًا أنّ دراسة النّصوص تأسيسًا على هذا المنهج ” كانت مرتكزة إلى نظريّة الكشف الأدبيّة التي تمثّل تجاوزًا للنّظريتين المعروفتين قبلها: نظريّة الانعكاس التي ترى أنّ الأدب انعكاس للعالم المرجعيّ. ونظرية الانكسار التي ترى أنّه تعديل يُجرى على العالم المرجعيّ”[3]. ويأتي العالم الفنيّ بفرادته وخصوصيته ليعيد تشكيل البعد الجماليّ وقراءته بأدوات معرفيّة مختلفة عن تلك التي تعاملت مع النّصوص الأدبيّة بحسب نظريتي الانعكاس والانكسار الأدبيّتين. وهي قراءة تتجاوز الاستغراق البنيويّ للنّص وسلطة البلاغة، لتدخل في فضاء الهوية وسلطة المعنى المتشكّل من الأنساق الفكريّة وتلاقيها مع الأنساق البلاغيّة والأسلوبيّة والدّلاليّة، وارتباطها جميعها بفلسفة الكشف الجماليّ، والبعد الكونيّ والرّؤيويّ. ذلك يعني أنّ” النص يُخفي شيئا، وهذا يعني بدوره أنّ النص يوحي، بل ربّما يقول، أو يجسّد، أو يمثّل، ولكنّه لا يكشف شيئا كشفا مباشرا”[4]. فقوّة النص المرجعيّة مستمدّة من قوّة رؤية الأديب وعمق ثقافته وطواعيّة توظيفها في سياق الكشف عن الانساق الثّقافيّة والفكريّة، بوصفها الخاصيّة الأساس التي تجدّد الأشياء وعلاقاتها، وتنشئ علاقات متحرّكة بين الكلمة والكلمة، وبين نسيج الكلمات وأشياء العالم التي أعيد تسميتها من جديد في فضاء رؤيويّ ينفصل عن مساره المستنزف، ليتّصل مع ما لم يسمّ من تلك الأشياء التي تكمن فيها الذّات العارفة. حيث يبدو الاتّصال بها يخضع لوسائط حدسيّة واشراقيّة ورؤيويّة. لأنّ “الحقيقة ليست في ما يقال أو في ما يمكن قوله، وإنّما هي دائما في ما لا يقال، في ما يتعذّر قوله، إنّها، دائمًا، في الغامض، الخفي، اللّا متناهي”[5] وإذ تشكّل نظريّة الكشف منهجًا يستنطق البنيات العميقة للنص الثّقافيّ، فهي تقارب اللامتناهي الذي تحدث عنه أدونيس من زاوية رؤية ترتكز إلى خصوصية العلاقة بين النّص والثّقافة، فتتموضع بنية النّسق من داخل النّص من دون تعميم النّسق الثّقافيّ بوصفه مستقلًا عن المفهوم الجماليّ للنّصّ. لأنّ “الشّاعر هو من يخلق أشياء العالم بطريقة جديدة”[6].
المعرفة بين أنسنة المنهج والثّقافة
تشكّل نظريّة الكشف بما تحمله من عمق معرفي مادة انخطاف نحو قاع المعنى في بعده الذوقي من جهة، ولغة مشحونة بالهم الثّقافيّ الذي يجعل للمعنى قيمة إنسانيّة إضافة إلى قيمته الأدبيّة والمعرفيّة والبلاغيّة، ذلك أنّ الكلام” توظيف للنظام اللّغويّ، والرّؤية المخصوصة توظيف للثّقافة، وكما يحضر النظام اللّغويّ في الخطاب تحضر الثّقافة فيه”[7]. إذ يجعل منهج الكشف وسيلة تأويليّة تتجاوز التحليل الثّقافيّ التّقليديّ، لتدخل في فضاء كشف الأنساق المضمرة وربط النّص بسياقاته المتعدّدة، وتأويل الرّموز والدّلالات التي تحمل الوعي الجمعيّ.
يرتكز المنهج الثّقافيّ عند علي زيتون على آليات الكشف النّقديّ، بوصفه منهجًا يستنطق البنى المسكوت عنها لاستقراء الأنساق الثّقافيّة المضمرة في بنية النّص، لكشف طبقاته الدّلاليّة والثّقافيّة وتتبّع شيفراته التي يشكل تفكيكها إعادة إنتاج للنّص، لأن الكتابة الإبداعيّة “تتطلّع إلى استعادة ما فقده العالم من فطرة وحميميّة في علاقاته”[8]
والكشف مرتبط منذ القدم بالمعرفة الحدسيّة الإشراقيّة في تجاوزها العقل وعالم الحس، حيث تكون أشياء العالم منفصلة، بعضا عن بعض، لكن في الرّؤية الاشراقيّة تتّحد في ما بينها، وتتآلف فتتسع آفاق الرائي ويصير المرئي أكثر انكشافا وتجوهرًا، متخفّفا من هويته الظّاهرة والمقروءة بما حملته من موروث تاريخيّ، لتصبح هويّة مفتوحة على قراءات دلاليّة متعدّدة استدعاها الكشف التّأويليّ المرتكز إلى الثّقافة، بوصفها منهجا يؤسّس لبصيرة ثقافيّة ترى في النص ما لا يراه النّقد التّقليديّ.
وإذا كانت الثّقافة منهج حياة أنتجته التّجربة في أبلغ تجلّياتها المعرفيّة، فإنّ الكشف هو تجلّ جديد من تجلّيات الجدة والإبداع، وهو عمق من أعماق الثّقافة التي أنتجب تلك الجدة في لحظة إمساكها بخيوط العلاقة بين العالم المرجعيّ والعالم الفني المكتشف.
تنبع أهمية موقف علي زيتون في مقاربته المنهج الثّقافيّ من أنّه طرح آليّات ومفاهيم ذات أهميّة خاصة بعلاقة المنهج مع المناهج الأخرى، لا سيّما البنيويّة والسّيميائيّة والسّرديات، وبعلاقة ضدّيّة مع التّفكيكية، وتكمن الخصوصيّة في أنه تصدّى للتّجربة الثّقافيّة العربيّة الحديثة وإشكالياتها من موقع العارف بمكامن عجز العقل العربيّ عن مواجهة العقل الغربي بأدوات معرفيّة معاصرة، لينطلق من علاقته بالفلسفتين الماركسية والوجودية، وبالافكار القومية، والمعرفة الأدبيّة عبر مدارس ومذاهب متنوعة، ليصل إلى ” أنّ الثّقافة العربيّة قادرة على تزويدنا بمفاتيح أساسيّة نواجه بها الثّقافة الغربيّة من دون أن نتخلى عن الشخصية الثّقافيّة العربيّة المضيعة في ظل تعطّل العقل العربيّ ما يزيد على الثمانية قرون”[9].
إنّ امتلاك الأديب لثقافة عصره يضعه في موقع مغاير، والخاصيّة الأساس في هذا الامتلاك تحيلنا إلى قدرته على هضم تلك الثّقافة واستيعابها ومحاورتها لينتج ثقافته الخاصة، وهي في جانبها الابداعي تتمايزعن امتلاك الآخرين لتلك الثّقافة. ذلك أن الشّعر”خلق يمارسه الشّاعر، فيما يخلق مسافة بينه وبين التراث من جهة، وبينه وبين الواقع من جهة ثانية”[10]
فالأديب ينظر بعين رائية ومن زاوية رؤية مختلفة عن رؤية الآخرين، وإن تكن لكلّ أديب خصوصيته وثقافته واسلوبه وأدواته الكتابيّة فإنّ سؤالا مركزيّا شغل الساحة النّقديّة طرحه علي زيتون في فصل بعنوان ” من هو الشّاعر؟ ليصل إلى استنتاج ” الشّاعر مقيم في منطقة الفالق الزّلزاليّ التي لا يمكن أن يتحمّلها المتعلّم العارف العاديّ. يحتاج الشّاعر ليكون شاعرًا إلى ثلاثة أمور لا يتوافر بعضها إلا للخاصة من المثقفين”[11] فكلما انكشف طريق أمام الشّاعر يقودنا إلى مزيد من الكشف عن الأقاصي، ليقدم واقعًا من مستوى مغاير ومختلف، حينها يصير الكشف نتاج وسائط أخرى، مرتبطة بالحدس والاشراق، لأنّ الشّعر يقيم الصّلة الجماليّة والأكثر شفافيّة وغنى مع الآخر. ذلك أنّه” الأكثر قدرة على كشف الذّات لذاتها، وعلى أن يكشف لها بعدها الآخري، والذّات في حاجة إلى هذا البعد، لا لكي تتآخى وتتماثل وتتماهى وحسب، وانّما لكي تتفردن أيضا في الوقت ذاته”[12]. إذ لا يتميز الشّاعر بنقل مشهديّة أو تصويرها من منظور نقلي ولا يكتفى أيضا بما هو عقليّ، لأنّ على الشّاعر أن يخلق مشهدياته وعلى النّاقد أن ينظر إلى تلك المشهديات بعين الخلق والكشف أيضا، وليس بعين النقل وقراءة الظاهر.
وعليه، فإنّ نظريّة الكشف التي ربطها الدكتور علي زيتون بالمنهج الثّقافيّ هي تجاوز ليس فقط للشّكل والظّاهر، ولا للتأمّل في أشياء العالم، بل لكلّ ما هو مقروء من خلال التّحليل النّصي المرتكز إلى الطّرائق التّقليديّة، والارتكاز إلى الكشف عن اللامرئي كبنية ثقافيّة ومعرفيّة وفكريّة، إلى جانب بنيتها الجماليّة والبلاغيّة والتصويريّة.
المنهج الثّقافيّ في ضوء المناهج الحديثة: تقاطعات واختلافات
توقّف نقّاد النصف الثاني من القرن العشرين عند الرّؤية الشكليّة للنص وآليات تجاوزها، خصوصًا في ظل التحوّلات العميقة التي شهدتها المناهج النّقديّة، والتي أدت إلى حدوث تحوّل جذري في طرائق التّفكير النّقديّ وأنساقه. إذ، لم يعد يأمن الفكر النّقديّ لتلك الطّمأنينية التي فرضتها الكلاسيكيّة. فالانفتاح على آفاق الفلسفات الحديثة واللّسانيّات، فتحت آفاق النّصوص المعرفيّة والفكريّة.
وإذا كانت المناهج النّقديّة المتعدّدة كالبنيويّة والسّيميائيات والتّفكيك وغيرها من المناهج قد قدّمت رؤيتها انطلاقًا من فهمها للعمل الأدبيّ ومرجعيّاته وبنياته، فقد ضعف تأثير التّصنيفات التّقليديّة التي طالما كانت تقيم حدودًا فاصلة بين النّص ومحيطاته، وبين ما هو جماليّ وما هو مرجعيّ. ليتحوّل النّقد مع المنهج الثّقافيّ من فاعليّة تابعة للنّص الإبداعيّ إلى فاعليّة موجِّهة له. فالبنيويّة وضعت النّص في قلب النّسق، مركّزة على العلاقات بين مكوّناته، واهتمت برصد البنى الدّاخليّة المغلقة للنّص. بينما تقوم التّفكيكية على تفكيك البنية النصيّة للكشف عن تناقضاتها الدّاخليّة وتجنّب تثبيت المعنى او إحالته إلى إطار قيمي او ثقافيّ محدد.
أما المنهج السّيميائيّ، فقد اتّجه نحو تحليل أنظمة العلامات والرّموز داخل النّص الأدبيّ، حيث ركّز على كيفية إنتاج المعنى من خلال نظام دلاليّ يحكم العلاقة بين الدّال والمدلول. في حين قدّم المنهج الثّقافيّ رؤية أكثر انفتاحًا على الحقول المعرفيّة واتّجه نحو تحليل العلامات من حيث علاقتها بالثّقافة وربطها بالبنية العميقة للنّص ومساءلته بوصفه فضاءً معرفيًّا ومساءلة شروط انتاجه وإشكالياته.
لم يرفض المنهج الثّقافيّ تلك المناهج، بل تقاطع مع بعضها بمنهجيّة التّحليل النّصيّ وفهم الأنساق، وتجاوزها محتفظًا بخصوصيته الكشفيّة، ليعيد ربط النّص بسياقه من خلال الارتكاز إلى سلطة الكشف عن النّسق الثّقافيّ وآفاقه المعرفيّة، لأنّ المنهج الثّقافيّ يرتكز إلى رؤية المبدع، ” وإذا كانت الرّؤية بنية شديدة التّعقيد، فذلك يعني أنّ رؤية أي فرد قائمة على خصوصية مرتبطة بخصوصية مكوّناتها: ثقافة، قناعة، وهما، واهتماما”[13] وهو إلى ذلك، يعارض التّفكيكيّة التي هي أقرب ما تكون إلى مشروع تقويضي، بينما يسعى المنهج الثّقافيّ إلى بناء الوعي الثّقافيّ في بعده الإيجابي. ويستخدم الكشف لفهم الدوافع الثّقافيّة وتظهير سلطة النص الخفيّة لاستنطاق المسكوت عنه، واستنتاج رؤية ثقافيّة كاشفة.
وبما أنّ العمق الدّلاليّ يكمن في الغياب ويجيء من الخفاء، فإنّ نظريّة الكشف عند علي زيتون تقوم على التّأويل العميق لتحقيق وعي جدليّ بين النّص والثّقافة. إذ يشكّل هذا التّأويل سعيًا إلى تخليص المتلقي من سلطة التّلقين، ودفعه باتّجاه الانتاج المعرفيّ.
بين تحوّلات المناهج وسؤال التّجديد النّقديّ
شهدت المناهج النّقديّة منذ خمسينيات القرن الماضي تحوّلات معرفيّة ومنهجيّة عميقة. فقد اهتزّت ركائز الحدود بين المناهج التي اعتاد عليها النّقد الأدبيّ، وبدأ تأثيرها يتلاشى. ولم يعد للتّصنيف التّقليديّ البريق الذي حضي به لقرون مديدة. ليتبلور وعي نقدي مغاير بتأثير الفلسفات الحديثة وإعمال العقل العلمي ودخول الدّراسات الثّقافيّة على الساحة النّقديّة.
ومع تأثير ما بعد البنيويّة، والماركسيّة الجديدة، وعلم السّيمياء والتّفكيكيّة، وما عرف بالسّرديات الحديثة، تشكّلت رؤية نقديّة انطلقت من قراءة النّص بوصفه موقعًا مفتوحًا على حقل واسع من الاحتمالات التي ينتج عنها هويّات متعددة.
اتّخذ مشروع علي زيتون النّقديّ طابعًا منهجيّا يتجاوز البروتوكول الشّكليّ لبعض المناهج ويلتقي مع حاجة الفكر العربيّ إلى رؤية نقديّة تجاوزيّة استقطبها المنهج الثّقافيّ مع احتكاكه وارتباطه بنظريّة الكشف التي مثّلت جوهر هذا التوجّه نحو الكشف الثّقافيّ ومساءلة العقل، وشحن الذات بالفاعليّة التّأويليّة التي تؤسّس لدينامية النص الشّعريّ واكتشاف بناه العميقة، إذ أنّ ” الشّعريّة لا تتخذ اللّغة بعامة موضوعا لها، بل تقتصر على شكل من أشكالها الخاصة. والشّاعر بقوله لا بفكره وإحساسه. إنّه خالق كلمات وليس خالق أفكار”[14]
وعليه، فإنّ المشروع النّقديّ عند علي زيتون شكّل إضافة نوعية في ميدان الدّراسات النّقديّة المعاصرة والحديثة، وفي محاولته لتأسيس منهج متكامل يرتكز إلى فاعلية التّحليل الثّقافيّ والتّأويل المعرفيّ، في ضوء رؤية نقديّة منفتحة على فضاء التّأويل وقابلة لاستيعاب الأسئلة الكبرى التي تواجه الثّقافة، من أجل بناء نظريّ لمقاربة نقديّة تنطلق من النّص إلى النّسق، ومن البنية إلى تفرّد نظريّة الكشف، حيث أنّ الكشف بالنّص والثّقافة أسسًا لسرديّة العقل النّقديّ عند علي زيتون ولتناغمه بين الخطاب والمرجعيّة. لأنّ “امتلاك الثّقافة أن ننتج علومًا تجيب عن أسئلتنا الحرجة، وتشكّل حلولاً لمشكلاتنا، لأنّ مثل هذه الثّقافة كفيلة بإنتاج سيمائيّتنا”[15].
خاتمة
يقيم كتاب المنهج الثّقافيّ ونظرية الكشف تكاملًا جدليًّا بين تحليل النّص في إطار الهمّ الثّقافيّ واستكناه الجانب الجماليّ والمعرفيّ. وهو إذ يتجاوز المناهج التّقليديّة عبر تخطّيها، فإنّه يعيد الاعتبار للسّياقات الفكريّة والتاريخيّة مستحضرًا البعد الأخلاقي على اعتبار أنّ النّاقد ليس محللًا فحسب، بل هو منتج للثّقافة ومساهم أساسي في تشكيل الوعي، وفي منح النّقد بعدًا إنسانيًّا، وتحقيق جماليّة الخطاب، لأنّ ” كمال الجمال الأدبيّ هو في تمام التّعبير والدّلالة اللّذين هما ذوا بعد ثقافيّ”[16].
يرسخ الكتاب مشروعًا حضاريًّا يجمع بين التّحليل الثّقافيّ والكشف المعرفيّ التّحرريّ الذي يفتح آفاقا بحثيّة جديدة في الدّراسات المعاصرة، خصوصا أن ” المنهج الثّقافيّ تنظيرا وإجراء هو من المناهج الفاعلة التي تستطيع أن تنطق ما سكت من أبعاد فنيّة يكتنزها الخطاب. وهذا ما يسوّغ وجوده في الحياة النّقديّة الحديثة”[17] وهو بذلك يملك قابليّة تطويره وتوظيفه كونه يمتلك مرونة تناسب مختلف الاجناس الأدبيّة ضمن خصوصيّة كلّ جنس أدبيّ.
رغم عمق الرّؤية، ونجاح المؤلّف في تقديم مادة جديرة بالدّراسة نظريًّا وتطبيقيًّا، ثمة حاجة إلى دراسات تطبيقيّة موسّعة تقارب آليات الكشف التي تحدث عنها المؤلّف لتوضيح التّمايز المنهجيّ وخصوصياته.
قائمة مراجع البحث
- أدونيس، الصّوفية والسّورياليّة، دار السّاقي، فردان، بيروت، لبنان،2010 ط4.
- أدونيس، زمن الشّعر، دار السّاقي، فردان، بيروت،2005..
- أدونيس، الثابت والمتحوّل، بحث في الابداع والاتباع عند العرب، صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشّعريّ، دار السّاقي، الحمرا، بيروت، ج4، 2002، ط 8.
- زيتون، علي، المنهج الثّقافيّ ونظرية الكشف، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سورية،2021، ط1.
- زيتون، علي، في مدار النّقد الأدبيّ، الثّقافة، المكان، القص، دار الفارابي، بيروت، 2011.
- سعيد، إدوارد، العالم والنّص والنّاقد، تر:محمد عصفور، مراجعة وتقديم: محمد شاهين، دار الآداب،بيروت،ط1، 2017.
- – سلدن، رامان، النظريّة الأدبيّة المعاصرة، تر: سعيد الغانمي، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر، بيروت، ساقية الجنزير، 1996، ط1.
- عصفور، جابر، آفاق العصر، دار المدى للثّقافة والنّشر، سوريا، دمشق، 1997، ط1.
- القعود، عبد الرحمن، الإبهام في شعر الحداثة، عالم المعرفة، 2002، عدد279.
- كريستيفا، جوليا، السيمائية علم نقديّ، أو نقد العلم، العرب والفكر العالميّ، ترجمة جورج أبي صالح، العدد الثّاني، 1988.
- كوهين، جان، بنية اللّغة الشعريّة، تر محمد برادة ومخمد العمري، 1986، الرّباط، دار توبقال للنّشر.
[1] – علي زيتون، المنهج الثقافي ونظريّة الكشف، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط1، 2021، ص73.
[2] – م. ن. ص52.
[3] – علي زيتون، المنهج الثقافي ونظرية الكشف، ص9
[4] إدوارد سعيد، العالم والنص والناقد، تر:محمد عصفور، مراجعة وتقديم: محمد شاهين، دار الآداب،بيروت،ط1، 2017، ص264.
[5] – أدونيس، الصوفية والسوريالية، دار الساقي، فردان،ب يروت، ط10، ص، 188.
[6] – أدونيس، زمن الشعر، دار الساقي، فردان، بيروت، 2005، ص17.
[7] – علي زيتون، المنهج الثقافي ونظرية الكشف، ص27
[8] – عبد الرحمن القعود، الإبهام في شعر الحداثة، عالم المعرفة، 2002، عدد279، ص 56.
[9] – علي زيتون، المنهج الثقافي ونظرية الكشف، ص 26
[10] – أدونيس، الثابت والمتحوّل، صدمة الحداثة، دار الفكر، بيروت، ص 18.
[11] – علي زيتون، م. س. ص100.
[12] – أدونيس، الصوفية والسوريالية، ص 192
[13] – علي زيتون، المنهج الثقافي ونظرية الكشف، ص47.
[14] – جان كوهين، بنية اللّغة الشّعريّة، تر محمد برادة ومخمد العمري، 1986، الرباط، دار توبقال للنشر، ص40.
[15] – جوليا كريستيفا، السيمائية علم نقديّ، أو نقد العلم،العرب والفكر العالمي، ترجمة جورج أبي صالح، العدد الثاني، 1988، ص32.
[16] – علي زيتون، في مدار النّقد الأدبيّ، الثّقافة، المكان، القصّ، دار الفارابي، بيروت، 2011، ص 28.
[17] – م.ن. ص11.