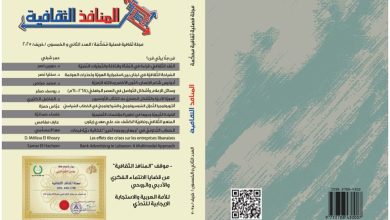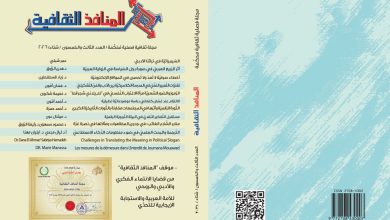الصّورة الشّعريّة ووظيفتها الدّلاليّة في “الدّيوان الغربيّ” لجوزف الصّايغ
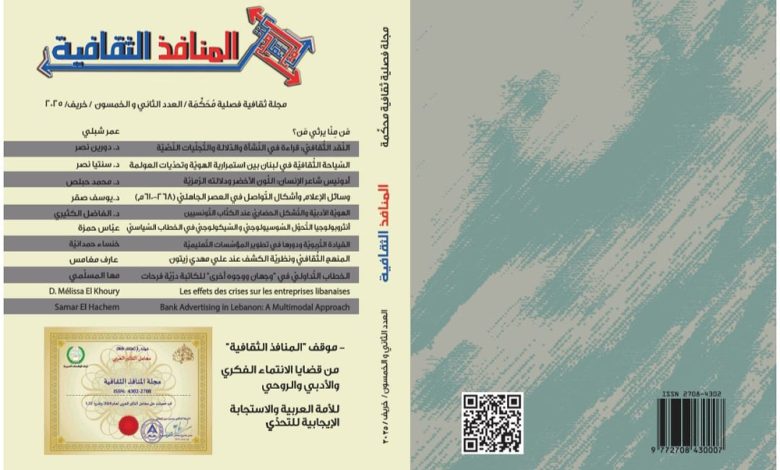
الصّورة الشّعريّة ووظيفتها الدّلاليّة في “الدّيوان الغربيّ” لجوزف الصّايغ
L’image poétique et sa fonction sémantique dans “Le Recueil Occidental” de Joseph Sayegh.
سيمونا بردويل
Simona Bardawil
تاريخ الاستلام 1/ 6/ 2025 تاريخ القبول 25/ 6/2025
الملخص
تتناول هذه الدّراسة الصّورة الشّعريّة في ديوان “الغربيّ” لجوزف الصّايغ، مركزّة على وظيفتها الدّلاليّة والفنّيّة. تبيّن الدّراسة كيف تجاوز الصّايغ الفهم التّقليديّ للصّورة بوصفها مجرد تمثيل بلاغيّ، ليمنحها أبعادًا رمزيّة وفلسفيّة ترتبط بتجربته الذّاتيّة والإنسانيّة.
اعتمد الصّايغ على الاستعارة والتّشبيه والكناية لتجسيد رؤاه، فجاءت الصّور الشّعريّة في الدّيوان مشبعة بالرّموز والدّلالات المتعدّدة، تكشف عن قلق وجوديّ، وغربة داخليّة، وصراع بين الشّرق والغرب، خاصةً بين مدينتي زحلة وباريس. الصّورة الشّعريّة لديه ليست وصفًا للواقع، بل نافذة على باطن التّجربة، وعلى عالم متحوّل دائمًا، تتقاطع فيه الذّات مع المكان والزمان.
تميّزت صور الصّايغ بالحركية، وتوظيف الألوان، وانعكاس النّفسيّة المتوترة، حيث صوّر المدينة الغربيّة كفضاء اغتراب، مقابل الحنين إلى الشّرق. استعان الشّاعر بتقنيّات تعبيريّة حديثة، واستثمر الرّمز والصّورة المجازيّة لتوصيل المعاني العميقة، فاختلط الواقعيّ بالحلمي، والحسيّ بالفكريّ، ما يعكس ثقل التّجربة الحضاريّة والوجدانيّة لديه.
تشير الدّراسة إلى أن الصّورة الشّعريّة عند الصّايغ لا تقتصر على الجماليّات الشكلية، بل تُبنى لتؤسس رؤية شعريّة فلسفيّة وجماليّة، تعبّر عن الذّات في صراعها مع العالم، وتفتح آفاقًا جديدة في الشّعر العربيّ الحديث.
الكلمات المفاتيح: الصّورة الشّعريّة – الدّلالة – الاستعارة – الإيقاع والموسيقا الشّعريّة – الاغتراب- الرّمز -الذّات الشّعريّة.
Résumé:
Cette étude explore l’image poétique dans Le Recueil Occidental de Joseph Sayegh, en mettant l’accent sursa fonction sémantique et esthétique. Elle montre comment Sayegh dépasse la conception classique de l’image comme simple ornement rhétorique, pour en faire un véritable espace symbolique et philosophique, enraciné dans une expérience personnelle et existentielle profonde.
Le poète recourt à des procédés tels que la métaphore, la comparaison et la métonymie pour exprimer ses visions intérieures. Ses images poétiques, riches en symboles et en significations multiples, traduisent une angoisse existentielle, un sentiment d’exil intérieur, ainsi qu’un conflit identitaire entre l’Orient et l’Occident, incarné par les villes de Zahlé et de Paris.
Ces images ne se limitent pas à représenter la réalité, mais ouvrent une fenêtre sur l’univers intime du poète, où le temps et l’espace se confondent dans un mouvement fluide. Elles se caractérisent par leur dynamisme, leur musicalité, et l’usage expressif des couleurs, traduisant des états d’âme tourmentés.
L’étude met en évidence la manière dont Joseph Sayegh emploie la poésie comme outil de questionnement ontologique, et comment ses images participent à la création d’un langage symbolique, à la fois lyrique et philosophique. Ainsi, l’image poétique chez lui devient un acte de résistance contre l’aliénation, une quête esthétique et spirituelle, et un pont entre les cultures.
Les mots-clés:
L’image poétique – La signification sémantique – La métaphore – Le symbole – Le rythme / la musicalité poétique – L’aliénation – Le moi poétique.
المقدمة
تعدّ دراسة الصّورة الشّعريّة بمفهومها الحديث المختلف عن المفهوم القديم المحصور بعلاقة المعنى الحقيقي بالمعنى المجازيّ، والمائل الى البساطة والوضوح المنعكس من البيئة العربيّة القديمة، والقائمة حديثًا على البناء الفنّيّ والإبداعيّ، إلى جانب التّشابيه والاستعارات والدّلالات والانزياحات المختلفة بطرائق أكثر عمقًا وتشابكًا وتعقيدًا، “في سياقها نغمة خفضية من العاطفة الإنسانيّة”[1]، “شحنت- منطلقةالى القارىء- عاطفة شعريّة أو انفعالًا” [2]داخل كلمات “استعاريّة الى درجة ما”[3]، تعامل معها الشّاعر “جوزف الصّايغ” في ديوانه، كـ”وسيلة فنّيّة جوهريّة لنقل تجربته في معناها الجزئيّ والكليّ”[4]، مفككًّا ومركبًّا إيّاها ليأخذ المتلقي إلى عالم الخيال والدّهشة وأشياء الجمال لأنّ الصّورة الشّعريّة “لا تكتفي بمجرد التّفتيش بل تحاول عامدة أن تنقل الانفعال الى الآخرين وتثير فيهم نظير ما أثارته تجربة الشّاعر فيه من عاطفة.”[5]
يتميّز الشّاعر جوزف الصّايغ بفرادة تجربتِه وتقنيّة استخدامه للألفاظ والصّور الشّعريّة. فهو شاعرٌ وأديب لبنانيّ أطل في بداية السّتينيّات على مملكة الشّعر والإبداع، فمزج بين الأدب والفنّ مبدعًا ثلاثة عشر ديوانًا. فتألّق فكريًّا مؤسسًّا الرّابطة الفكريّة، موّلدًا من حبر قلمه رموزًا وصورًا ودلالات أغنت أدبَه، فاستطاع الجمع في شعره بين الشّرق والغرب في عزّ انفعالها العصرانيّ محرزًا لقاء فريدًا، امتزجت بداخله اللّغة العربيّة بأصالاتها بالحضارة الغربيّة. فتنوّعت مؤلّفاتُه الشّعريّة منها والنّثريّة ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: قصورٌ في الطّفولة، قيلولة الصّل، كتاب آن كولين، العاشق، سعيد عقل وأشياء الجمال…
ودراسة الدّيوان الغربيّ لجوزف الصّايغ تشكل نقطة مهمّة وأساسيّة، إذ يتأنّق بفكره حاشدًا فيه الرّموز والصّور[6]، مقلعًا عن العموديّة الصّارمة الى التّساهل العروضيّ في الزّحاف والقوافي وأحيانًا في الرّوي تأثرًا بتيار الحداثة. فيندمج بالأشياء ويُدخل عليها أحاسيسه فينتزع صوره من واقعه، وإن كانت تبدو غير واقعيّة. فيجسد صورًا حضاريّة من الغرب مستوحاة من باريس، تتخللها طرافةٌ تغني الأدب وتنعشه.
يعدّ هذا البحث بابًا مهمًّا في مجال قسم اللّغة العربيّة وآدابها، لأنّه يقدّم معرفة جديدة تُفيد المكتبة العربيّة وتسلّط الضّوء على شاعر لَهُ مكانته في عالم الشّعر والإبداع. إضافةً لإظهار جوانب الجمال والإبداع في صورِهِ الشّعريّة المتمثلّة في الدّيوان الغربيّ، التي تحتل أهمية كبيرة لدى الناقد المعاصر لأنها وسيلته الأساسيّة لفهم القصائد وموقف الشّاعر من الحياة. هذه الصّور التي تعتبر اللُّبَاب الشّعريّ، والتي تلعب وظيفة دلاليّة جديرةً بأن تُدرس.
يحتلّ الدّيوان الغربيّ موقعًا مهمًّا من نتاج الشّاعر، فكتابته استمرّت منذ العام 1954 الى العام 1993. جسّد من خلاله صورًا شعريّة زاخمة وعواطف استطاع الشّاعر إيصالها من خلال التّصرّف باللّغة والتّلاعب بالبنيّة الشّعريّة، ليدرك المتلقي أنّها محصلّة لتراكم معرفيّ وتجربة شعريّة تشكّلت من خلال الصّور الشّعريّة، فأضفت جمالًا تلاشت غربته الميتافيزيقيّة معها شعوره بالغربة.
- أسئلة الكتابة([7])
منذ أسئلة سارتر (J.P Sartre) الثلاثة:
تطرح أسئلة سارتر الثّلاثة حول الكتابة الأدبيّة – لماذا يكتب الأديب؟ ماذا يكتب؟ ولمن يكتب؟ – إشكاليّة الأدب وأهدافه الأساسيّة. فالأدب ليس مجرد تقليد للواقع أو نسخه الحرفيّة، بل هو رؤية روحيّة تعيد خلق الواقع أو تبتكر واقعًا أعمق وأكثر غنى. يخضع الفنان في اختياره لمواد الحياة لقانون الأثر الذي ينقل جوهر الحياة وحساسيتها، وليس تفاصيل الواقع التّافهة، ويكون مسؤولًا عن زاوية الّرؤية التي يقدّم من خلالها هذا الواقع، ما يحدّد مادة الكتابة وكيفية طرحها وجمهورها. يحمل الأدب مسؤولية تأريخ عصره والتّفاعل مع تحرّكاته الاجتماعيّة والنّفسيّة، وإلا يصبح مجرد تمثيل مزيف أو ابتعاد عن الواقع. يبرز الكاتب الفرد في علاقته مع المجتمع محاطًا بقيود وحريّة، ويجب أن يكتب بروح صادقة تعكس إحساسه الحر، بعيدًا من الوظائفيّة والمصالح الشّخصيّة الضّيقة. كما أنّ موضوعات الكتاية الأدبيّة ليست مجرد تقنيات، بل أوعية لرؤى إنسانيّة تتجاوز الزّمان والمكان.
الصدق في الكتابة هو ما يثبت العمل الأدبيّ ويمنحه مكانته الحقيقية، إذ لا توجد كتابة من دون دافع، حيث تتجلّى من خلالها الصّراعات الوجوديّة والمشاعر الداخليّة التي تحدد إنسانيّة الكاتب. يتطوّر إبداع الأديب بتغيّر العصور والظّروف، معبرًا عن الحياة ومناقشًا العواطف والنّماذج البشريّة، ويبقى السّؤال الأساسيّ: لمن يكتب الأديب؟ وهو سؤال يعكس العلاقة الجوهريّة بين الكاتب وقارئه وتأثير الأدب على الإنسان. تتحوّل أهداف الإنسان وتتبدّل، ولا تستقر على أحوال بمستوياتها كافة، فرديّة وجمعيّة، والحال هذه. فالأديب يصوّر استجاباته للحياة، في أرحب معانيها وأعمقها مستعينًا بمشاعره وعطاءات الفكر الجماعيّ من حوله. وقد نضج وتسامى، يعالج ما يشعربه من مشاكل، يرى ضرورة معالجتها خاصة أو عامة، ومن دون تقنين لمشاعره، وهو يكتب ما يتلازم مع هذه المشاعر بلغة أدبيّة حيّة وحيويّة، وإلا فمكتوب الأديب يسقط من الأدب إلى التّهريج. وقد أسقط الأديب عن نفسه، اسمه ساعة يسقط عن الأدب إنسانيّته التي ترتفع فوق كل تخالف، هذا الارتفاع الذي يصير ترفعًا برسمه الفنّ الأدبيّ يصوره جميعًا، ينقل الأديب في كل أحواله: فرحًا وحزنًا، قوّة وضعفًا وأشواقًا إلى المثل، يحاول أن يرقى إليها كافة، في سبيل كشف آفاق إنسانيّة في إنسانيّة الجميع، ولا سيما في لغة الشّعر، وفي أساسه التّجربة الشّعريّة([8]).
ب- التّجربة الشّعريّة
التّجربة الشّعريّة هي تفاعل داخليّ عميق بين الذّات والكون، يتجاوز المهارة الفنّيّة إلى تعبير صادق ينبع من وعي الشّاعر وحدسه وإخلاصه الفنّيّ.
يقوم الخيال بدور الوسيط في تحويل الجزئيّات الحسية إلى رؤى موحدة، تُنقل شعريًّا عبر صور وتراكيب تكشف عن جوهر الأشياء وتخلق وحدة فنّيّة تمثّل حقيقة الوجود كما يشعر بها الشّاعر.
ج – اللّغة والشّعر
ارتبطت نشأة الشّعر باللّغة في نموها الجمالي، بعد أن كانت هذه اللّغة نفعية مباشرة، والواقع أن النفعية اللغويّة سابقة على جماليتها، إذ اللّغة هي أداة الصّلة بين الفرد وغيره، وكانت وسيلة للعمل، بل، ونوعًا من العمل، إذ كانت للأصوات البدائيّة مفاهيمها الدّلاليّة بين مجموعة محددة من البشر يفهمونها، فتتم في ما بينهم دورة التّعامل، ومواجهة ما قد يعترضهم من صعوبات، وتطورت اللّغة في تراكيبها وكلماتها وتجاوزت المحسوس إلى المتصور المجرد من الأشياء، فإذا الأشياء المجردة ترتبط بمدلولاتها الحسية، وهذا التجريد أنتج الدّلالة الحدسية للكلمات في تلك المرحلة. انتقلت اللّغة من التّعبير عن المحسوس إلى التجريد، مما أثار دهشة الإنسان الأول وأدى إلى خلق صور شعريّة قوية أثرت في الفكر والسّلوك. الشّعر كان وسيلة ربط بين الناس والأسطورة، مقدمًا رسالة جماعية لتربية الأجيال وتمجيد الفضائل، ومع تطوره الحديث، تجاوز الشّعر الذّاتيّة إلى الاهتمام بالقضايا الاجتماعيّة، حيث تداخلت التّجارب الفرديّة مع الجماعيّة في تعبير وجدانيّ إنسانيّ يعكس مكنونات النّفس والكون عبر الصّور الفنّيّة المتميزة.
د – المكونات الشّعريّة في الدّيوان الغربيّ
الشّعريّ: تشكل السيرة الذّاتيّة رافدًا أساسيًا في التّجربة الشّعريّة، إذ تمنح العمل طابعًا شخصيًّا يعكس عمق التّجربة الذّاتيّة ويؤسس لجماليّة صادقة إذا ما تحققت بتوازن بعيدًا من النّرجسية أو التّزويق الفارغ.
كما أنّ اللّغة في يد الشّاعر المبدع ليست مجرد أداة بل هي تعبير عن الأصالة، تكشف عن خصوصية الذّات وفرادتها في التّعبير الفنّيّ والانفعالي.
وعليه، فإنّ الأثر الفنّيّ يصبح انعكاسًا لتجربة فريدة تنبع من الشّاعر نفسه، تتمايز في تفاعلها وإنتاجها عن تجارب الآخرين مهما تشابهت في الحدث أو الشعور. وفي قراءة لسيره جوزف صايغ الذّاتيّة نجد أنا أمام بعض مكونات شعر الشّاعر في “الدّيوان الغربيّ”([9]).
أول ما تفتحت براعم “الدّيوان الغربيّ” في باريس، وقد أقام فيها الشّاعر ما بين (1954-1964) وفي أول ذلك العقد، وقد أخذ الدّيوان الشّاعر إلى أوراقه، فسجل حياة هي هذه الكلمة، يعانيها تتكرّر عنده ولا تنتهي، فقد كانت القصائد “بنات اللّقاء مع مدينة الحلم”([10])، فجاءت ثمرات المشاهدة، عميقة تعبّر عن دهشة الشّاعر الأوليّة، ترتسم عنده وفيه كصور عن انفعالات ابتدائيّة تتيمّم البدايات، وإذا هي رجع ما بين الرّؤية بالبصيرة، والإبصار بالرّؤية، استجلاء لتلك الأقاليم الغامضة الواقعة على تخوم الاثنين ([11]).
حمل الطفل الذي في الشّاعر مدينة الحلم، تخطر بباله ومعه أنى وكيفما خطر، فكانت صورها معه. وجد الشّاعر في باريس ملاذًا نفسيًا وجماليًا يحرّره من قيود الواقع الشّرقي القاسي والتقاليد التي كبّلته في زحلة، فصوّرها مدينة الحلم والانفتاح والحب المحرَّر.
الغربة التي عاشها كانت مزدوجة: جغرافيّّة عن باريس التي يحب، وروحية عن زحلة التي ينتمي إليها جسدًا ويغترب عنها وجدانًا.
“الدّيوان الغربيّ” يعكس هذا التمزّق بين الشّرق السّاحق والغرب الجماليّ، حيث تحوّلت باريس إلى وطن بديل يتشكّل في داخله بصفته شكلًا من أشكال الخلاص الشّعريّ والوجدانيّ.
وفي تفصيل هذا، يغوص الغرب في أعماق الشاعر منذ أوائل حياته – الوَهَميّات – فهُنّ قد خرجنَ من شعر جوتيه، وموروا، وشكسبير، ولمعنَ فوق الشاشة الفضية “نجمات جميلات” تحفّ بهن موسيقى بلا دَهْن، وينطقن إلى جانب من ينطق. هناك فلسفة الغرب، ويعني “يطنّه” الشّاعر بمقابل حال “الإقفار” الذي كان يشعر به، وثِقَلة في تلك الأيام، إقفارًا شرقيًّا في كل شيء حتى التلف. فإذا علاقة الشّاعر وجيله “بالغرب” علاقة خدر وتحذير عن واقعهم “الشّرقيّ”: الشّعر، والأدب، والفلسفة، والموسيقى، والسّينما، والفنون إجمالًا، هي مخدّراتنا المفضلة، الضرورية والمنقذة. ([12]).
أما كون جوزف صايغ الشّعريّ، فيرتكز على نتاج الشّاعر بول فاليري والفيلسوف نيتشه وبتهوفن وموزار الغربيّين وعلى شعر سعيد عقل من الشّرق، ومعهم تجاوز التّلف في اسفاف “بيئتي الأولى”([13]) يؤكد عليه الشّاعر ويحذفه، وعليه أن يحصن نفسه من هذه الالتهابات الفاجعة بمواجهة هدفها، تأخذه إلى الاضمحلال وتتسامى به فوق الواقع المعيوش، لا سيما ما كان منه علاقة الشّاعر بمدرسته التي كانت تحول دون المرغوب وتحيل على المطلوب فقط: “كانت المدرسة سخبًا حقيقيًا لخيالي، ولحس الحظ كانت باريس”([14]).
ه_المرحلة الباريسيّة
يرى الشّاعر في هذه المرحلة عيشه الآخر الأطر والجديد القديم بحيث أن خيالات الحلم الباريسيّ، ارضتها مشاهد الواقع، لتدفع إلى السطح ردة فعل الشّاعر في كلماته: إذن- هذه هي:
لقد كانت رحلة استكشاف عن قرب، مبعدة من أحلام الفراق والشّوق إلى اللّقاء، فكل شيء في باريس هو “آخر” في الفن ّوالعمارة والطّبيعة وكل جمال، يلفّها جميعها “_ شعريّ”، عناصره كل هذا الهوى الباريسيّ في نفس الشّاعر، تعلق أشياء المدينة، يحبّها، تقيم في نفسه هوى وغوىً، جدّدا في نفسه، يتصرف للآني ويشرق به شعره في كل ما حوله من أشياء الطّبيعة والتّاريخ والنّاس، فيواصل وصالًا، ثراءً طائلًا، ودوام إثراء وديمومة وقد أدرك الشّاعر: “أن التّاريخ، إن هو مات لم يمت معه الماضي فحسب، بل الحاضر والمستقبل”([15]).
عودة إلى التّاريخ وبحسب جوزف صايغ، أنّ لا إطلاق في ما قاله عن التّاريخ، ويتابع أن هناك تواريخ وجب أن تُقفل، ذلك أنّ تاريخًا لا يؤرّخ للمستقبل فعدم وجوده وقتله أجدى، والتّاريخ ليس مجرد علاقة بين تاريخ ومؤرّخ له، بل هي العوامل المؤسّسة الصّانعة لهذا التّاريخ والواجب التأكيد عليها: “وهي عوامل البيئة والمناخ والمجاورة والجغرافيا والدين”([16]).
من خلال قراءته للتّاريخ، وكيف يكون، وكيف يريده برزت عند الصّايغ أسس العوالق الراّبطة بينه وبين باريس، بكل عناصرها ومكوّناتها وبكل رمزيّتها، فباتت ليس مجرد ملاذ وحلم، بل مدينته التي أعادت تكوينه، كإنسان أصرَّ على قفل شرقه السّابق على وجوده الباريسيّ الرّاهن فقد ضيق عليه الزّمن الجديد “فسحة الاستمتاع بالكسل والضّجر والحياة، لذا هو يقبل على الحياة بمثل هذا الشّره الذي يميزه، عندما تتاح له الحياة، وكأنّ لا حياة أتيحت له في ما سبق من أيامه التي يعيشها فهو “ينقضّ على التهام المتع التهامًا فردانيًا، أنانيًا، بمثل ذلك السّهم الذي أتصوّره يميز البدائيّ ملتهمًا طعامه من ندرة من الغذاء بدائية”([17]).
إلى جانب هذه البدائيّة الماديّة، الأكولة بإفراط، فإن جانبًا آخر علويًا وجوهريًا، برز في هذه المرحلة، برز للشّاعر عامًا ويجب الإمساك به، وهو علو همة الإنسان في تحرره من الغيبيّات، وتحكيمه العقل، ووضعه الحرية والعدالة فوق كل شيء، أي حيث يجب أن تكونا([18]).
هذه العلويّة (الغربيّة عند الصّايغ)، ولدت ثالوث الحق والخير والجمال، والثّالوث السّقراطيّ عرّف بالله، والله عرف بالجمال، و الجمال قيمة القيم، لأنه قبل وفوق كل شيء، هو حرية تولّد الحب هكذا اندرجت روما، وعليه درجت اوروبا مع ابرز منائرها الفلسفيّة والرّوحيّة، وبالأخص السياسية،” وفيه رحت اراجع نفسي، فاستعيدها لاعيدها إلى هذه المراجع”([19]).
هذا “الغرب” بينابيعه الرّوحيّة فكرًا وفلسفة وفنونًا وشعرًا، ومعلمو الشّاعر الخمسة سكنوا روحه، على ما في أنفسهم وبيئاتهم من حرية ترفع إلى العلى وتدفع إلى الأمام، فإن استلابًا أو ما يضاهيه اسر نفس الشّاعر، جعله يركض وراء الينابيع ليجد ذاته في تفجرّها وإلى الأساطير ليخدر هذه الذّات، وإلى غابة بروسليان سعيًا وراء حكايات شعبية يلفها غموض الأسانيد ليوقظ توهج الخيال الشعبي ويؤجج البال بالسطور([20]).
بين قبري غوثيه وبول فاليري، أقامت باريس جوزف صايغ، بكل أشيائها منذ قديسيها وملعونيها حزنها ومنذ أفراحها، وحتى صمتها الّنبيل حتى ضجيجها في الحانات والمكتبات، ومن المحطّات إلى المواني فدور الاوبرا والمسارح، والأديرة والقصور وحدائقها إلى آخر السّلسلة مرورًا بإذاعتها، وليس انتهاء بفلاسفتها من بشلار إلى هايدغر، فلا ننسى سارتر ودي برقوار ومارلو بونتي وغيرهم كثير.
وفي الأماكن ترتسم صور المقاهي الباريسيّة وقد حملت أسماء: “الكابولا” و”تنباك” “السربون”، و”الرّوم”، و”الكافية دي لاتيه” إلى صور شكلت الخلفية العريضة لصورة باريس الشّاعر، صورة وصور مدن أوروبية أخرى وتمثلها في صباحات فلورنسا وبخلفية فنّيّة، رسمها الشّاعر كما يتمناها وكما يجب مع حديثه عن مدينته وأصابيح تموخل الرأس صرفتها في مناجاة تلك التجليات حتى لتخال عصر بريكلس كله انبعث في عصر انبعاث هذه المدينة([21]).
يشكّل “الدّيوان الغربيّ” لدى جوزف صايغ ترجمة لانبهاره بباريس واغترابه بين الشّرق والغرب، حيث تتجسد ازدواجية الانتماء الرّوحيّ في شعره كهوية ثقافية موحّدة تتجدد باستمرار.
لقد كانت “الثقافة” هي المرجعية الأسمى لشخص الشّاعر، يغول عليها ليلملم شتات الغريب فيه عن القطبين، وفي هذين “الثقافي والمثقف” وجد الشّاعر نفسه وكيّنها” ككيان هو أقرب ما يكون إلى طبيعة الأشياء يهاجر ما بين الاثنين ينتمي ولا ينتمي يكون في المكانين ولا يكون ولكنّه في حال لا يغيب عن الشّعر ولا عن الموسيقى ولا عن الجمال، حيث هذا الجمال رأس الوجود، وبوجوده تتلاشى غربة الشّاعر وكذلك الشعور بها وقد اشرق الجمال يعلو نجمه ليعطي توقًا للحياة لا تكون بغير هذا الجمال.
و_ النّص الشّعريّ
- تعريف: نقرأ في لسان العرب مادة (ش،ع،ر) أي علم، وهو منظوم القول، غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية”، ويضيف اللسان: “والشّعر هو الفريضي، وقائله شاعر لأنه يشعر ما لا يشعر به غيره، أي يعلم”([22]).
فالشّاعر هو العالم وقد شعر ما لم يشعره غيره، وفي ذلك تشديد على تفرده في درايته وحدسه ورؤياء، وعلى علمه بأسرار اللّغة ونظم الكلام الموزون والمقفى.
ويذهب معنى الكلمة في الأجنبية (Poete, Poet) بالفرنسية أو الانكليزية وغيرهما ليدل على الصانع الماهر والحاذق، وفي ذلك تشديد على دربه الشّاعر وقدرته على صوغ الكلام بدراية وأناقة، والتصرف باساليب التّعبير وأشكاله كصانع يعالج مواد صناعته التي يبرع بها.
وبمرجعية أصل الكلمة “الشّاعر” لغويّا، فإن ملاحظة تميز علاقته باللّغة، وخصوصية هذه العلاقة، فلا نكون كعلاقة غيره بها وهي علاقة عادية عمومًا، فإن ينتفع الناس باللّغة حين يستعملونها لتأمين حاجات التواصل والفهم والإفهام، مع تركيز منهم على محتوى هذه اللّغة أو تلك لا على شكل التّعبير نرى الشّاعر يستخدم نفس هذه اللّغة، كأداة تواصل وظيفي، وأداة تعبير فني أنيق، جميل ومؤثر. وقد ميز علماء اللّغة الوظيفة التواصلية المرجعية من تلك الوظيفة الشّعريّة، فما هي الوظيفة الشّعريّة للغة؟
- وظيفة اللّغة الشّعريّة: تتجاوز الوظيفة الشّعريّة للغة الشّعر بتعريفه التّقليديّ:”الكلام الموزون والمقفى”، لنصل أنواعًا عدة من النثرالفنّيّ، تستخدم اللّغة استخدامًا يخرق العادي والمألوف، ما نعلق منه بأساليب التّعبير وأشكاله، أو بالذّاتيّة الفريدة في معالجة المضمون وكثيرة هي الفنون الأدبيّة التي تدخل في إطار وظيفة اللّغة الشّعريّة (القصة الفنّيّة، بعض المقالات… الخ).
وعلى كثرة ما نشر حول سر شعريّة اللّغة، في حقبات أدبية لغويّة ونقدية متباعدة ومتقاربة، فإن اهتمام كل من علماء الألسن والرّموز ونفاذ الأدب، ركزوا اهتمامهم في محورين:
أولًا: شكل التّعبير
ثانيًا: ذاتية الرؤيا وقراءتها
إنّ القراءة للنص الشّعريّ منذ تعريفه مرورًا بوظيفة لغته وفنه، فذاتية الرؤيا وقراءتها في النص تأخذنا إلى جسد القصيدة وتلون بألوان الصّورة أو الصّور الشّعريّة، تتهاوى في متنه ماهية وظيفة([23]). فما هي الصّورة الشّعريّة؟
يصعب تقديم تعريف قاطع للصّورة الشّعريّة، لا سيما وأنّها في كلاسيكيات الشّعر، ونواتجه والبواكير، اقتصرت على الصّناعة الشّعريّة، ولم تحمل في طياتها معنى محددًا، مجردًا تشير إليه وإلى هذا يشير بارت في قوله: “إن اقتصاد اللّغة الكلاسيكية، نثرًا وشعرًا، ذو طابع علائقيّ، بمعنى أنّ الألفاظ فيه تجريديّة ما أسكن، خدمة لمصلحة العلاقات”([24]) وفي تفصيل ما تقدم، كان الأدب الكلام الفنّيّ الجميل، ينقل التّجربة النّفسيّة التي تتكون من أفكار وصور وعواطف وأنغام، والصّورة في الأدب عنصر انطباعي، يرسخ في خيال القارئ، ويضعه في جو الأديب نفسه أو في جو قريب من ذلك، وقد يوحى إليه بأجواء أخرى ينتقل إليها خياله.
ولأهمية الصّورة في الأدب، شبه قدماء اليونان الشّعر بمركبة فخمة يجرها جوادان هما العاطفة والخيال، ويوجهها حوذي حكيم هو العقل.
والصّورة عند الانسان وجدت قبل اللّغة، وقد استعان بها للتّعبير عن ذاته قل أن يبلغ مرحلة النطق، ومن ثم كانت الكتابة.
أما في النقد الحديث، فقد انطلقت اللّغة لتتخطى الحدود، وتكشف عن المعاني الأعمق والأكثر دلالة، وهو ما أدى إلى اختلاف البلاغيين والنقاد المعاصرين حول هذا المفهوم كونه يتبع رؤية فنّيّة مختلفة، وبالتالي فإن هذا المفهوم وتطوره، أمر حتمي وطبيعي لأنه مرتبط بالشّعر الذي يملك طبيعة متغيرة([25]).
وإذ نورد بعض تعريفات الصّورة لنراها: “اللفطة المأخوذة لأحداث مختلفة، يضفي الشّاعر عليها الحياة والحركة واللون لتصبح كائنًا جديدًا”([26]) ويرى محمد الجيار في الصّورة: إنها “جوهر الشّعر وأداته القادرة على الخلق والابتكار والتحوير والتعديل، وتشكيل موقف الشّاعر من الواقع وفق إدراكه الجمالي الخاص”([27]).
أما محمد هدية، فينظر إلى الصّورة الشّعريّة على أنها: “نقل لحالة عاشها الشّاعر ضمن قالب بياني قام بصنعه، ذاكرًا فيه حالاته العاطفية أو تجربته الحسية”([28]).
الصّورة إذن، هي لغة مشكلة بالحالات النّفسيّة والشعوريّة، وعليه: “فالصّورة في الأسلوب هي إعطاء الفكرة المجردة شكلًا محسوسًا في الشّعر خاصة. فهي لا تقتصر على المجرد والمحسوس، بل تجمع أمورًا متناقضة ومتباعدة ومختلفة لتأتلف في إطار شعوري وتتخذ افق تشكل تعددية الوجود للوحدة التامة”. مع هذه التعريفات، صارت الصّورة الشّعريّة تركيبًا لغويّا ذا عمق، يستمد الكثافة من تراكيبه، ويمكن الشّاعر من تصوير معنى عقلي وعاطفي متخيل، ليكون المعنى… تجليًا أمام المتلقي، فيستمتع بجماليّة الصّورة، وقد اخترقت الحدود المرئية المكشوفة بالحواس للولوج إلى عمق الأشياء مع بقاء الإدراكات الحسية المحفزة للتخيل.
إن الشّاعر يولي هذه الصّورة الشّعريّة اهتمامًا وعناية، يسمحان له بتصوير العالم المرجعي، وكل ما يدور بخاطره ووجدانه، فينقلها للمتلقي بإبداع، لأنّها السمة التي تميز الخطاب الشّعريّ، والمزيج المكون من الجانب المادي والرّوحيّ. لكنها، مهما بلغت من براعة تبقى بحاجة إلى عناصر العمل الشّعريّ الأخرى لأنها جزء لا يتجزأ منه، هذا في الماهية فماذا عن وظيفة الصّورة؟
إنّ للصّورة الشّعريّة دورًا مركزيًّا في التّعبير عن المشاعر والأفكار الدّاخليّة للشّاعر، حيث تجسّد الفكرة بطريقة تؤثر مباشرة في مخيلة المتلقي وتجعله يشارك في تجربة الشّاعر الوجدانيّة. تؤدي الصّورة وظيفة نفسيّة وتأثيريّة تكشف عن مهارات الشّاعر في التّواصل والإبداع، بالإضافة إلى وظيفة تحليليّة تشرك المتلقي في تأويل المعاني العميقة خلف الكلمات. كما تمثل الصّورة الشّعريّة حالة ثقافيّة وإنسانيّة ترتبط بالوجود والخيال، لتفتح آفاقًا فنّيّة وإنسانيّة تسعى نحو المعرفة والإبداع.
يقول أرسطو “إنّ التّفكير مستحيل من دون صور”[29]، ففي ظل عصر الصّورة يتشكل عالم آخر وجديد، تتأكد معه فاعلية هذا المكون ما فوق الكلمات المفردة وقد فاقتها الصّورة، و”إن وصلت ألفًا” بحسب المثل الصّيني.
ذلك أن الصّورة “تمعن” الكلمات، تتنبؤها فتسمو بالملفوظ إلى مرتبة غير المرئي، فلا نسخ بل تحفيز للخيال على أن يتحرّك ويحرّك باتّجاه الشّكل والتّشكيل، وهنا تبرز الصّورة في البيت الشّعريّ الذي يتجاوز صوتيّة الحروف وتسطيرها، إلى حدوثه هذا الكون الكليّ، يسهم في ضخ المعنى في صور لا مكان لها إذا ما كانت غير ذات معنى فلا يمكن تمثلّها عقليًا.
إنّ المعنى هو في أساس التّفكير الخاص بالصّور مثلما هو أمر ضروريّ في التّفكير اللغويّ، لأنّ الصّورة تساعد في فهم الكلمات وتذكّرها، إذ أنّها تقوم بالوظيفة التّرابطيّة الخاصة بين الكلمات بعضها ببعض.
هذا الموقع الهام والأساس للصّورة الشّعريّة يأخذنا إلى فاعلية الحضور الدّلاليّ لهذه الصّورة في متن الشّعر، فما هي وظيفة الصّورة الدّلاليّة؟
- الدّلالة
علم الدّلالة (symantic) علم لغويّ حديث يبحث في الدّلالة اللغويّة التي تلتزم حدود النظام اللغويّ، والعلاقات اللغويّة، استنادًا إلى العلميّة السوسريّة([30]) في الدّراسات اللغويّة، فيكون الفصل في الدّلالة اللغويّة لجذر العلامة اللغويّة ثم لصيغتها. ويتعدّى هذا العلم دراسة معاني المفردات إلى دراسة معاني الجمل والملفوظات على حد سواء، بما يراعي تلازم النّحو والدّلالة. واختصارًا لحقيقة هذا العلم يقول إنّه المنهاج اللّسانيّ في دراسة الدّلالة. والدّلالة في الغرب الحديث، موضوع علمين متمايزين متصلين من السّيماتيك والسّيميولوجيا وتحفل العربيّة بترجمات تتناول هذين العلمين، والمصطلح في العربيّة ملتبس ومضطرب، فلا يكاد يفقه أساسيات هذين العلمين، فيضطر إلى بذل جهود كبيرة من أجل استيعابها.
أما هدف علم الدّلالة الآخر (symiolag) فهو “صوغ الممارسات المتجاوزة اللّسانيّات وقوليتها، وهنا يتعدّى هذا العلم العلامة اللغويّة إلى غير اللغويّة: إشارات السير، حركات الجسد، اللباس وغيرها([31]).
وقد اختلف في أي من العلمين يتّسع للآخر في أثناء البحث عن أنظمة إنتاج الدّلالة وهو ما اختلف فيه الغربيّون عن العرب، وذلك بمرجعية “النّص القرآني وحضارته” وقد أنتجت هذه المرجعيّة البحث في الدّلالة على حالة العربيّة، بحيث استقطب هذا النّص كل العلوم العربيّة حول نفسه، وعليه أقام تماسك تلك العلوم وتكاملها([32]).
وإن تفعل في “حضارة النّص”، فالفرضيّة أن الحضارة العربيّة فعل لغويّ، وأنّ كل ما يصدر عن هذه اللّغويّة، يتتابع في ظل “سكون” إلى حقائق، أوجدها النّص في هذا “السّكون” الذي لم تركن إليه الحضارة الغربيّة فتدافعت أسئلتها في كل اتّجاه تتشكّل مع وجود المراحل، يحاول معها طارحها أن يجيب على التّحديات التي تجبهه لتهدد وجوده في السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع، وفي مجمل هذا الوجود([33]).
عود إلى “السّكون” العربيّ بمرجعية حضارة النّص، فإنّه نظام أساسيّ في توليده جميع الأنظمة الدّلاليّة البيماتيكية أو سيمولوجية وفي كل الأزمنة، فمع ظهور الوحي، وإشراقة لغة القرآن تغيّرت دلالات اخترنا تحليله في هذا الدّيوان؟
- دراسة نماذج من التّشبيه في الدّيوان الغربيّ لجوزف الصّايغ
- “باريس“ تُشبه بالحلم، المدينة الساحرة التي تجذب الشّاعر، لكنها تبقى مجرد وهم جميل.
- الشّاعر يستخدم أنواعًا مختلفة من التّشبيه (المؤكد، البليغ، المجمل، الضمني) لتصوير الحالات الشّعوريّة.
في قصائد مثل “الضّفاف”، يظهر التّوتر بين واقع التّجربة والوهم الذي يحاول الشّاعر الاتكاء عليه.
“على الضّفاف، حيث اساطير غيوم المساء
ترسم باريس بظل وماء”.
على مرايا موجة شاعره، وفي التفاف([34])”
وقد شبه الغيوم في تشكلّاتها بالأساطير، فإنّها رسمت بهذه التّشكيلات عالمًا متخيلًا مفعمًا بجمال هذه الغيوم، وفي داخل جمال الطبيعة الباريسيّة المتواجدة على أراضيها، مستسلمًا إلى خدر تلك الحاسة السحرية السادسة: المخيلة، فإذا صفاء بلوري، يسيل شعرًا، يبذله الشّاعر ليشف عن ما وراءه في نفس الشّاعر، وإشراف شاعريته.
هذه المخيلة التي حملت في خاطرة باريس الحلم، هي نفسها تابعت ثابت إلى الشّاعر، صور الجمال الحضاريّة فلم يقف هذا الجمال ولم يتحدّد بحدود تشكلّات الحجر والماء والشّجر، بل، انسحب هذا الشّعور بالجمال إلى أعمق في وجه المرأة. ففي كلامه عن مدينته أغرفة، مثل امرأة أغوته، فإذا هو، يشبّه النّساء وساحة سان جرمان في المساء بالأفيون المخدر، مع استعماله التّشبيه الضّمني، يفتتحه بـ “نعم”، كافتتاح تقريريّ، يحكم بجزم الأمور، بعيدًا من اي نقاش أو مداولة:
“نعم المخدر المسمى: نساء
ينسيهم في زحمة الأقبيهْ
أوطانهم، يمحنهم في البقاء
سعادة عن السما مغنيهْ([35])”
يستخدم الشّاعر التّشبيه ليعبّر عن اغترابه، ويقدّم المجون الغربيّ كاغتراب داخليّ أكثر منه انحلالًا أخلاقيًا. ويشبّه نفسه بالمصابيح الثّابتة وسط الحياة المتدفقة، ما يعكس حالته الشّعوريّة من جمود وعجز.
ففي قصيدة “على جسور السّين”، تتشابك الأساطير والغيوم والنهر لتعبّر عن عمق الشّعور بالجمال المؤقت والزاّئل.
- المرأة تظهر في صور راقيات الباليه، حيث يُعلي الشّاعر من جمالهنّ في تشبيه يحمل بعدًا روحانيًا، رافعًا إياهن فوق المستوى البشري. وينتقل من الآلم الى اللذة لتحمل قصيدة “راقصات البالية”، رؤية الشّاعر إلى المرأة كحاضنة للحياة، ومعطيتها، في إطار الجمال، فتظهر كأنغام تغادر الوتر لتنشر الحياة والسحر:
“اللواتي مثل أنغامٍ يغادرنا الوتر
قد توافدن فكثرن مدى البال، السحر
من سراب الحسن أقبلن، تمايلن،أنثنينا
اللواتي هنّ أفياء وأضواء-إلينا!”[36]
حوّل الشّاعر راقصته في هذه القصيدة إلى مشاعر موصوفة تتمايل وترقص فوق فرضيات واقعها الماديّ، الجسد يعرض مفاتن، وينشر أحاسيس، إذ الشّاعر ينقل هذه الرّاقصة من أرض الماديّ إلى ذلك الأثيريّ- الشّعوريّ، فارتفعت ورقصها إلى الشّعر والجمال. والشّاعر هنا يتأثر ببول فاليري وقد جسد راقصة الباليه راسمًا رقصها غموضًا، يجعل الروح تبصر اشياء ما كانت في الحسبان:
“Le dialogue de l’ame et la danse favorise cette angoissante et delectable incertitudes”.
فراقصة بول فاليري، وهي تتحرك رقصًا وتحرك قدميها، تأخذ الشّاعر إلى فضاءات أعرض وعوالم أعلى، فيجنح تقليده، إلى الخلق الالهي، كما هي راقصة جوزف الصّايغ: “بشرًا كنّ: فبتن الآن يعلون البشر”[37]، يجسده هذا العمل الإبداعيّ في توليد الأفكار الشّعريّة كأنّ بها قبسًا الهيًا: وهو هنا، الشّاعر الذي ميّز نفسه عن غيره من الشّعراء، وقد نقل صورة هذه الراقصة، ومدى انعكاسات جمالها، وأثر الجمال التي شبهه بأحاسيس من يراها وفي شعره.
فتظهر هنا ثقافة غربيّة شرقيّة وقد مزج الشّاعر الزّحلاويّ فيما بينها مولدًا صورة حضاريّة تعود الى الحضارات السّابقة ترفع المرآة وجمالها، لتصبح المرآة آلهة قادرة على صنع الجمال. وليتمكّن من إيصال الصّورة أي صورة جمال “راقصات الباليه” مع إقترانها بإيقاعٍ قويّ لكي يلتف كلّ الغموض عنها، كونها صورة جديدة في الشّعر العربيّ، فصبّها داخل إيقاعٍ خارجيّ قائمٍ على البحر البسيط ، هذا بحر الرّقة والجزالة كرقة الرّاقصات الباعثات للنّغم فوظفه شاعرنا خدمة للصّورة الشّعريّة، مضيفًا إيقاعًا داخليًّا قائمًا على التّشبيه السّابق ذكره أعلاه إلى جانب المحسنات البديعية الأخرى وحسن اختيار الحروف والدّلالات[38] من قبل الشّاعر ووضعها داخل السّياق مما حقق إيقاع الشّعر داخل السّطور الشّعريّة.
أخذت الرّحلة الشّاعر إلى فرنسا، إلى بانوراما حضاريّة وقد أوجزت مشهديتها بصورة حضاريّة غربيّة، راقية رآها وأرجعها بأفكاره، وحواسه ومع ماله من الشّعور، وذلك من خلال أحلامه الثّقافيّة المرتكزة على القراءة والموسيقا، يطّلع عليها، ويستطلعهما حضارة، حاضرة في خياله، قبل أن تتجسد أمامه ليراها تتجلى في المكان وأمام ناظريه، فأَعملَ التّشابيه لينتقل بين الضّمني والمرسل، ليبرز باريس بسماتها وأحلامه الجماليّة، وكما اصطنعها لنفسه، وما كانت سوى وهم في جماليّة وهم، سلكه طريقًا لنجاحه، يصور ما يراه، يطلق عليه أسماء نسجها من مشاعره وأفكاره، ليشعر من يقرأه بالجمال الممتع الذي يثير البهجة والفرح في النّفس([39]).
لقد تنقل الشّاعر بين المحسوس والمجرد، متأثرًا بعلم الجمال، بما هو، العلم القديم الحديث، والمرتبط بالمباحث الفلسفيّة في بداياته، والمثعر كعلم في بداية النهضة الأوروبية.
واستطاع الشّاعر عبر التّشبيه أن يعبّر عن انبهاره بالحضارة الغربيّة، وفي الوقت ذاته اغترابه عنها. لم تكن المدينة مجرد مكان، بل كيانًا جماليًا، حمله الشّاعر في داخله قبل أن يراها.
وظّف التّشبيه لخلق توازن بين الواقع القاسي والحلم المتخيّل، وساهم في إبراز شاعرية الذّات المتأملة، التي وجدت في الجمال والوهم وسيلة للهروب من الرّتابة والضّياع.
وتبرز الوظيفة الدّلاليّة للتّشبيه في قدرته على نقل الإحساس بالجمال، والكشف عن الازدواجيّة بين الظّاهر والباطن، بين الحياة والزّوال، وبين الذّات والعالم.
- دراسة نماذج من الاستعارة في الدّيوان الغربيّ لجوزف صايغ
الشّاعر يعبّر في قصائده عن حالة الاغتراب والتّوتر بين الشّرق والغرب، حيث يصوّر باريس ببرود عاطفيّ وغموض، كأنّها حجر بارد وسماء مظلمة، ما يعكس إحساسه بالغربة والاختلاف عن وطنه.
مثال من قصيدة:
“عايشتها، عايشت فيها الحجر
وعاش بي صقيعها والضباب
زرعت أحلام الهوى والشباب
فأورقت في وهم ذاك التراب”[40]
يتكرّر فعل “عايشت” للتّأكيد على حالة الاندماج في الواقع الجديد رغم برودته، كما يستخدم إيقاع بحر الرجز الذي يعكس تغير المشاعر وعدم الاستقرار.
الصّور الشّعريّة في الدّيوان تعتمد على مزج الألوان والإحساس لتعبر عن الحزن، الألم، والغربة، كما في وصف المساء الباريسيّ الذي يلون الشتاء بالحزن النّفسيّ:
“واطئة، هذا المساء، السماء
تجرد الرماد فوق السطوح
تنوح في قلبي، وقلبي ينوح
ويرسم الدنيا بلون الشتاء”
هنا يصبح اللون مجازًا للحالة النّفسيّة، والتّكرار في البيت يعزّز الإحساس بالكآبة.
في قصيدة “مونمارتر الرّسامين” يجمع الصّايغ بين حياة الرّسامين وألوان لوحاتهم، موحيًا بأنّ هذه اللّوحات تعبر عن معاناة وألم داخليّ، حيث رسموا أحلامهم وسجنوا ألوانهم في الحزن.
الشّاعر يعكس عبثية الحياة والواقع من خلال هذه الاستعارات التي تعبر عن الحالة النّفسيّة والتّجربة الإنسانيّة في الغرب، مع تأكيد على الصراع الداخليّ بين الحضور والغياب، الحياة والموت، الشّرق والغرب.
ج – دراسة نماذج من الكناية في الدّيوان الغربيّ
1. الكناية عن صفة:
بين عالمين، عالم الواقع، وذلك الشّعريّ، وقد عاناهما الشّاعر في رحلته ما بين مشرقه الزّحلي وغربه الباريسيّ، عاش حال تأرجح بين أمس حلمي ويوم معيوش بمعطيات الواقع مخيب للآمال في ما رآه من جسد الحقيقة أمام عينيه:
“مثل من كانت له يومًا حبيبة
واستهامته النساء عابرات
فمضى، في وهمه، حتى الممات،
دون أن يسعد في حب الغريبة([41])
برجوع جوزف صايغ، أمسه بجميعه، نجد فيه هذا الحنين إلى ما كانت عليه علاقته بمدينته، فجرته “ضفاف السّين” من الشّجر الذي أخذه إلى “وراء جميل” هو وراء الحلم، فالمكان في زمن معيّن يحمل دلالات الى زمن آخر بعيد، فينعكس الزّمن الماضي على الحاضر مما يجعل القارىء أمام أفكار جديدة عن المدينة الحلم. هذا الحلم يسعى إليه ويرسم خطوطه، أشكاله، وألوانه، ويوشحه بما فيه من طوق لحبيب، رسم هو صورته كأبهى ما يرسمه شاعر لصورة من يحب، ولكن ما واجهه، وعلى أرض الواقع، أشعره صدمة أذهلته وتركت مرارة في داخله، لكأنه أحس بالخسران وتلمسه بعد ما شفت الرؤيا لتكتف عن عالم مادي، يترسمه في هذه الصّور الجديدة لجميلات يعبرن من أمامه فتذهله عن حبيبته، ولا يكون له من ما يرى إلا الحلم العابر، يتكتف في كل لحظة بعده عن حبيبته، وعدم استقرار لم يجن منه إلا همًا بعد الحلم الجميل. نجد علاقة بيت الضدين في هذه القصائد ممّا أمكننا أن نسميه أيضًا طباق، وكون هذه العلاقة الناشئة قويّة “بحيث يؤدي استدعاء اللفظ والمعنى وربما الجرس”[42]. وهكذا يسهم الطّباق في خلق الإيقاع المساعد لإظهار صورة الإنجراف وراء النّساء العابرات ذات المشاعر العابرة البعيدة من الحب والإخلاص وترك الحبيبة الشّرقية التي تحمل كل المشاعر الصّادقة، مستعملًا الفعل الماضي الدّال على ثبات الحب. فهذه الحبيبة ما زالت تحبّه وتنتظر عودته لها، فالشّرق مليءٌ بعواطف لا تستطيع دول آخرى جعله يشعر بها إلا لدقائق عابرة.
ويتابع الشّاعر، الكشف عن ذاته الجريح، بكل الخيبة التي يلقاها، ويعيشها في “غربته” فمع كتاباته عن الأجمل جرحه وعن الألم والفرح المتلازمين عنده، وهي سمة إنسانيّة، في داخل كل منا، ولا سيما المخبون منا، حيث السعادة يترافق فيها جناحاها ويجتمعان: الألم والفرح، على أن مفارقة الأول وتخطيه تؤسس للسعادة الحقيقية.
إن معاناة الوجد، يكايدها الشّاعر، انعكست عنده في هذا الوجود المعذب، وقد تشكل بمفاعيل الألم الموجود في عمق مشاعر، يكنى عنها بـ “جحيم الوجود”، وقد اعتبر الشّاعر أن الوجود كله آلام فانعكس عنده، خارج هذا الوجود على داخله، فبانت عليه هذه المشهدية الحزينة، مرثيةً لعالم بات حلمًا ليصير في يوم الشّاعر، آمر بطعم الكابوس وضبابيته:
“أين هو اليوم متى كنته؟
والفتيان والجنون الجميل؟
كيف التقى الصابح ظل الأصيل
وكيف أصبحت وما عدته؟!
لم يبق فوق النهر إلا الضباب…
فكل من أحببتهم في غياب([43]).
يظهر هنا الاستفهام الاستنكاري، مكررًا أسئلة يطرحها الشّاعر على نفسه مضيفًا نغمًا موسيقيًا ومسلطًا الضوء على المكان مع استعماله “أين” للدّلالة على ضياعه في هذا الوجود وجهله للمكان لأنّ الأخير يفتقد كل المشاعر فيصبح الشّاعر فاقدًا الإنتماء للمكان. لأنّ المكان تجاوز الواقع الملموس ليصبح ذات طبيعة متحرّكة تقود المكان الشّعريّ الى الواقع الشّعريّ. ويستخدم بالتالي الأداة: “كيف” ليبرز الحالة التي يعيشها، هذه الحالة التي ترسم بدورها المكان “لأن المكان دون الإنسان عبارة عن قطعة من الجماد لا روح فيها”[44] ، وهكذا لم يبقَ فوق النّهر إلا الضّباب أي حزنه الذي أفقد النّهر أي الحياة في باريس صفتها المعتادة. وكما يرى ابن جني: “أنّ هناك مناسبة بين الحروف وصوت الحدث كقضم التي تستعمل لأكل اليابس وخضم التي تستعمل لأكل الرطب فهناك صلة بين الصوت والمعنى” نلحظ تكرارًا لحرف الباء ليخدم هذه فكرة يوم الشّاعر المرير الكبوسيّ الممتلىء بالضباب ، فحرف الباء في السطرين 🙁 لم يبق فوق النهر إلا الضباب…فكل من أحببتهم في غياب([45]).حرف شفوي شديد مجهور منفتح، وهذه الحروف تبين لحظة الاندفاع والانفعال أمام ما رآه صباحًا في وجه المدينة، كما أنها توضح لنا نوعاَ من السرعة في حركة الإيقاع.هذا ايقاع الحرف والكلمة الذي يلعب الدور الكبير في الموسيقا الخفيّة.
أما وأنّنا بيّنا تقنية الكناية عن الصّفة في ما قرأنا في متن “الدّيوان الغربيّ” فيعاودنا السّؤال: ما هو دورها الدّلاليّ؟
ابدعت استعمالات الشّاعر للكناية مع استعماله للاستعارة والتّشبيه، شعريّة جديدة بمفرداتها الجديدة في تشكيلها كما في أسمائها، ما يعني أنّه من منطلق الرّبط ما بين اللّغة واللّسان، وليس الكلام، فإنّها اللّغة كمنطوق للثّقافيّ في الفكر اللّغويّ للشاعر، أكدت على المصطلح الشّعريّ في ديوانه، كأرفع ما يكونه المصطلح، عنوانًا للابداعات الفكر لغويّة في نصه الباريسيّ مستفيدًا من جدليّة العلاقة ما بين مكانين زحلة/ باريس بحيث تصير كل منهما كناية عن عالم شاعريّ آخر متمايز عن ذلك الواقعيّ، ومميز لكل من المكانين كل على حده وفيه مكان آخر مغاير لسابقه:
أنا عشقي كان، بالأمس مدينة
اسمها سحر ووهم وجنون
منه غذيت حنيني بالفتون[46]
2. كناية عن موصوف
يعيش الشّاعر حالة من التّأرجح بين الأمس المليء بالحلم وبين ما يصادفه من خيبة للأمل أمام ما رآه. فتظهر ازدواجيته في الانتماء الرّوحيّ مستخدمًا الكناية عن الموصوف، وهي التي تذكر الصّفة ولا تذكر الموصوف بل تكتفي بالاشارة إليه مستخدمة لشىء خاص فيه: كلقب أو تركيب معين.
تمثلّت “زحلة” لديه ب”نائي الدّيار” فهي تلك الدّيار النّائية البعيدة من صخب المدينة إذ تسود العادات والتّقاليد المُحافظة الى جانب الطّبيعة الخلابة البدائيّة، حيث ترك الأهل حازمًا أمتعته نحو “الأرض السّعيدة” كناية عن باريس، الأرض التي لا طالما حلم بأنّها السّعادة الأبديّة:
“فتركت الأهل، في نائي الديّار
حازمًا عزمي الى الأرض السعيدة.”
فتشكّلت الكناية لديه منقسمة بين الشّرق والغرب، بين زحلة وباريس، ليشكلا الماضي والحاضر. فتكون “أرضًا بعيدة ” و”دُنى المجهول” كنايتان عن زحلة الماضي التي أصبحت مكانًا بعيدًا تجعل من الشّاعر “غريب الدار” كناية عنه ، هو الذي أصبح غريبًا في دياره. يقابلها إشاراتٌ وصفات: الغريبة الماكرة ، خليلتي الماكرة، العاشقة، أرض توهمي ، تشكل كنايات عن باريس أي كناية عن موصوف، حيث يختصر باريس الكبيرة وحياتها. لتدلّ في طياتها عن صفات رآها الشّاعر وأدركها، وانعكست عليه بطريقة عكسيّة وبواقعها القاسي، تاركة لزحلة النّقاوة البعيدة الملمس ومعطيةً لباريس الماكرة الخذل والتوهم. يرسم من خلالها الشّاعر ما تتأجج في نفسه من مشاعر ومن أفكار محدثًا إيقاع المعنى المؤثر في نفس المتلقي الى أبعد الحدود.
3. الكناية عن نسبة
وفيها يذكر الموصوف مع ذكر شيء يناسبه ثم نذكر الصفة، ثم تنسب الصفة إلى الشيء الملازم للموصوف. وفي قصائد الدّيوان الغربيّ يبين لنا الشّاعر الحال لجيل ما بعد الحرب، وقد اجتمع أبناؤه ليعيشوا في ساحة سان جرمان في المساء.
الجميع متواعدون، ومختلفون في أشكالهم الجسمانيّة، لكنّهم في منابت همومهم وعمق مشاعرهم توحدهم هذه الحال النّفسيّة القلقة والمربكة فيذهبون إلى أخيلتهم وقد تخلوا عن الجهات المدن التي نزلوا منها إلى هذه الساحة:
“من مدن الشّمال، حتى الجنوب،
تواعدوا: إن الهوى موعد
في غير سان- جرمان لا يُسعدُ
وشرّقوا، في صبح هذا الغروب([47])
هذا المواعد ليست مواعدة العشاق والمحبين، لكنّها مواعدة من نوع آخر، مواعدة في جوهرها الهروب من الواقع حيث يهربون إلى أخيلتهم المتوهمة وأوهامهم المتخيلة لأنّ الواقع الحقيقي الذي يرغبون فيه ولا يعيشونه لأنّهم لا يريدونه هو هذه الحال من الأخيلة، حيث اللامكان يحلّ محل المكان، وهكذا، يهربون إلى واقع، ويهربون من أي ماضي إلى ما هو أساس عيشهم، وأم اهدافهم الهروب من مآسيهم.
أما الآمال ففي النوافذ، والفسحات الأرحب، والأكثر إشراقًا على الحياة ومن خلالها، ينقذ الانسان من حكم مؤبد بالاشغال الشاقة، إلى فضاءات اوسع، يهرب من بين قضبان سجنه لينسج عالمه الخاص، ولهذا كان لا بد له من سلاح المواجهة، وقد وجده في هذا الوهم المخلص مما هو فيه من فراغات الحزن والدموع:
“ما أوحش الدنيا بهذا القطار
مفرغا زاغه في الضلوع
وحوله الأشياء نحو الضلوع
تضفي على الألفاظ شكل الدموع([48])
هكذا نظر الشّاعر لدنيا، وقد اكتملت بالفراغ، يشغل كل شيء في انحائها، فلا يبقى إلا الشجو، وأنظاره “حزنًا” مقيمًا يرسم الألفاظ تشكيلات الدمع والشّاعر هنا يسلك أبياته مسلك الكناية عن نسبة بحيث الشجو والدموع يتلازمان في الحزن الذي يلف رحلة هذا القطار، الدنيا التي هي بالنسبة إلى الشّاعر دنيا حزينة وفارغة، وقد عاشها كما هي، وقد اتسمت بهذا الفراغ والفراق بعد صيف، يكنى به الشّاعر عن الحياة الجميلة، يلتقيان الصف والحياة في الجمال، ولكن النهاية هي الحقيقة الوحيدة، الواقعة في نهاية الجنون، فنهاية الصف، كما نهاية الحياة، وقد ملئت ذكريات صيفية (نفسه)، والرحيل يحدد خط النهاية لهذا الصيف- الطبيعي- النّفسي، وهو أوان الرحيل عن زحلة بكل الشّرق النابض فيها، وبها، ليرجع مع الخريف إلى المرتبة الرمادية حتى الشتاء، والشتاء هنا، حزن النّفس ومعاناتها فراق مع أن تكون حيث نبضها، إلى سجن لم يكتبه على نفسه، ولكنه، بينما، ينسج خيوط عالمه الخاص، فإنّه يحاكي هذه الخيوط، سيرفع عمارة وهمه ليدرأ عنه ظلمة السّجن وخصوب معاناته:
عدتُ مع الخريف للمدينة
في أضلعي الطيور تطوي الجناح
وقد وصلت في قطار الصباح
وحدي، إلى المحطة الحزينة([49])
تُبرز الدّراسة تطوّر مفهوم الصّورة الشّعريّة بين مقاربتين: التّقليديّة التي تركز على العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازيّ، والحديثة التي تعتمد على البناء الفنّيّ والإبداعيّ في القصيدة، مستعينة بالتّشابيه والاستعارات والكنايات والدّلالات والانزياحات، مما يتطلب من الشّاعر تفكيك وتركيب بنيان الصّورة ليتيح للمتلقي دخول عالمه الشّعريّ الممتلئ بالخيال والدهشة والجمال.
في تجربة جوزف صايغ في “الدّيوان الغربيّ”، نلحظ تقنية شعريّة متميزة تجمع بين الأدب والفن، وتدمج بين ثقافات الشّرق والغرب بلغة عربيّة أصيلة، ما أضفى على شعره ثراءً فكريًا وجماليًا. تتّسم صوره الشّعريّة بالاهتمام بالزمان والمكان، فباريس وزحلة تشكلان خلفية حيوية لشعره، يتفاعل مع تفاصيلهما بعمق نفسي ووجدانيّ، حيث يعكس الزمان ما بعد الحرب والحالة النّفسيّة للشاعر، ويستخدم الألوان لتجسيد التحولات الشّعوريّة.
تؤدّي الاستعارة والتّشبيه والكناية دورًا أساسيًّا في بناء الصّور الشّعريّة عند الصّايغ، فالتّشبيه ينقل القارئ بين صور متداخلة، بينما تضفي الاستعارات معاني رمزيّة جديدة تعمّق فهم الوجود. الكناية تتجسّد كوسيلة فنّيّة تجسد الألم والواقع القاسي، وتعبر عن الصّراع الداخليّ بين الألم والوهم، وتبرز أهمية التّمسك بالحياة رغم قسوتها.
يستخدم الشّاعر أساليب إيحائية ورمزيّة تجمع بين الجمالي والفلسفي والوجودي، معتمدًا على ثلاثية التّشبيه والاستعارة والكناية لتشكيل صور فنّيّة تنقل واقعه وعواطفه. قصائده تتسم برومانسية أحيانًا وبرنسية أخرى، حاملة أفكارًا فلسفيّة عميقة، وتجسد أحلامه، مخاوفه، وقلقه، الذي يواجهه عبر شبكة من الأوهام والجمال.
الدّيوان يعكس الفوارق بين مدينتين، زحلة وباريس، من مناخ وبنية وانفعالات، ويقدم صورة شعريّة غنية تجمع بين الإيقاع والوزن والقافية، مؤشرًا إلى موهبة الشّاعر وعمق تجربته، معجميًا وبلاغيًا، حيث جعل من الاستعارة والتّشبيه والكناية أدوات أساسية تكشف أسرار بلاغة الصّورة الشّعريّة وتميزها.
في النّهاية، تؤكد الدّراسة أنّ الصّورة الشّعريّة في شعر جوزف صايغ ليست مجرد زينة لغويّة، بل جسد يربط بين الشّاعر والقارئ، بين المعنى والخيال، وتجسيد حي لتجربة إنسانيّة مليئة بالمفارقات، حيث تظل الصّورة الشّعريّة أساس الشّعر وأداة تعبيره الجوهرية، تفتح آفاقًا جديدة لفهم جماليّات النص الشّعريّ ودلالاته العميقة.
المصادر والمراجع
[1] محمد حسن عبدالله، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، 1990م، ص32
[2] م.ن، ص 32
[3] م.ن، ص32
[4] محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث،دار النهضة مصر للطباعة القاهرة، 1984 ،ص442.
[5] شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ط6، دار المعارف القاهرة، ص150
[6] موريس وديع النجار،طيور المحابر، دار نلسون، السويد، 2015م، ص68.
([7]) طرح هذه الأسئلة الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر في كتابه “ما الأدب”، باريس، ط غاليمار، 1948، تعريب محمد غيمي هلال: دار العودة، بيروت، 1984.
[8] طرحت مسألة الكناية في إطار البحث عن “ماهية الكناية، كمدخل إشكالي لبحث إشكالية التجربة الشعرية كونها تحمل أبعاد الفكر يتنقل بين الناس مع الكلمات او في ظلالها.
[9]جوزيف الصايغ: الديوان الغربي، التعاونية اللبنانية للتأليف والنشر،بيروت-لبنان، ط 1، 1993
[10] م.ن: الديوان الغربي، ص 11.
[11] محمد العمشاوي: قضايا الأدب، مصدر سابق، ص 11-13.
[12] جوزف الصايغ: الديوان الغربي، ص 15.
[13] م.ن، ص 16.
[14] م.ن، ص 18.
[15] م.ن، ص 18.
[16] جوزف الصايغ: الديوان الغربي ، ص 19.
[17] م.ن، ص 19.
[18] م.ن، ص 20.
[19] م.ن، ص 21.
[20] م.ن، ص 23.
[21] م.ن، 23-24.
[22]ابن منظور: لسان العرب، مادة (ش، ع، ر).
[23] محمد الجيار: الصورة الشعرية عند أبي قاسم الشابي، ص 6.
[24] رولان بارت: الدرجة صفر للكتابة.
[25]محمد سعد : “العلاقات النحوية وتشكيل الصورة الشعرية، عند محمد عفيفي مطر، ص 11.
[26] محمد القاسمي : الصورة الشعرية بين الايداع والممارسة النقدية، مجلة فكر ونقد، السنة 4، عدد 37، سنة 2001، ص 67.
[27] محمد الجيار: الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، ص 6.
[28] اسماعيل عز الدين: الشعر العربي المعاصر، ص 161.
[29] http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/images/stories/595-624.pdf.
[30]نسبة إلى فرديناودي سوسير، صاحب “محاضرات في الألسنية العامة”، وقد نشرها طلابه، ترجمها: يوسف غازي، لبنا، دار نعمان، 1984.
[31]رولان بارت : علم الدلالة، ترجمة محمد البكري، اللاذقية، دار الحوار، ص 47 وما بعدها.
[32] علي زيتون: الاعجاز القرآني وآلية التفكير العقدي عند العرب، دار الفارابي، ص 231.
[33] م.ن، ص 233.
[34] علي زيتون: مصدر سابق، ص 41.
[35]جوزف الصايغ: الديوان الغربي، م.س، ص 48.
[37] جوزف الصايغ: الديوان الغربي، ص51.
[38] بوحوش رابح: اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم،2006،ص28.
[39] نبيل راغب: التفسير العلمي، نحو نظرية عربية جديدة، دار نوبار، للطباعة، القاهرة، ط1، م1997، ص304.
[40] جوزف الصايغ: الديوان الغربي، م.س، ص 50.
[41] المصدر السابق، ص 203.
1 البيلي،أحمد عزت، المعجم الشعري لأبي تمام والبحتري،رسالة دكتراه، كلية دار العلوم،1988،ص18.
[43] الديوان الغربي، ص 45.
[44] شاهين، أسماء، جماليات المكان في روايات جبرا ابراهيم جبرا،المؤسسة العربية للدراسةوالنشر، ط1، بيروت، 2001م.
[45] الديوان الغربي، ص 45.
[46] الديوان الغربي، ص 31.