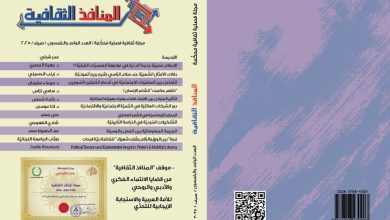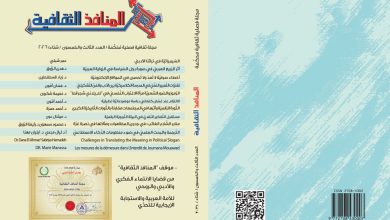النّقد الثّقافيّ: قراءة في النّشأة والدّلالة والتّجلّيات النّصّيّة
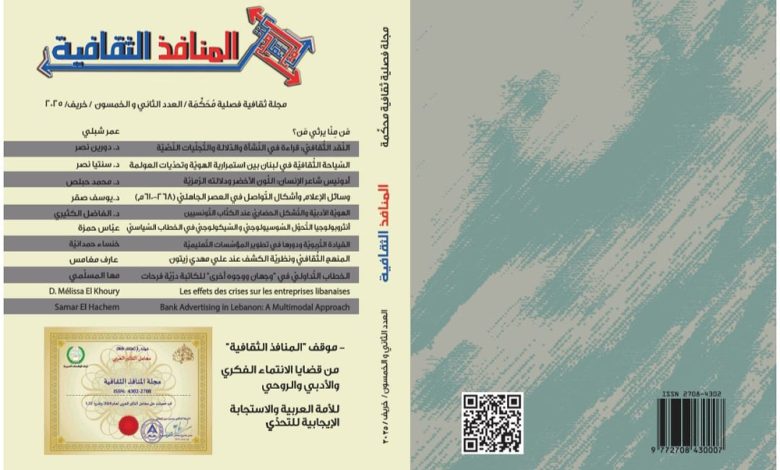
النّقد الثّقافيّ: قراءة في النّشأة والدّلالة والتّجلّيات النّصّيّة
Culture-based criticism: A Reading of Its Genesis, Significance, and Textual Manifestations
د. دورين نصر[1]
Dr. Dorine Nasr
تاريخ الاستلام 5/ 7/ 2025 تاريخ القبول 30/ 7/2025
الملخّص
يُعدّ النّقد الثّقافيّ أحد أبرز التّحوّلات المعرفيّة والمنهجيّة التي طالت الحقل النّقديّ المعاصر؛ إذ لم يعد النّصّ الأدبيّ يُقرَأ بوصفه كيانًا جماليًّا منغلقًا على ذاته، بل بوصفه خطابًا متشابكًا مع البنى الثّقافيّة والرّمزيّة والاجتماعيّة التي تُنتجه وتؤوّله. لقد أزاح النّقد الثّقافيّ مركزيّة الأدب لصالح الثّقافة، وتوسّع في أدواته ومجالاته ليشمل المقروء والمرئيّ، والمكتوب والمُتخَيَّل، جامعًا بين الخطابات الإعلاميّة والفنّيّة والمرجعيّة.
تتمحور هذه الدّراسة حول إضاءة عامّة على السّياقات التي أفرزت النّقد الثّقافيّ ومفهومه كما تبلوَرَ في الفكر الغربيّ، ثمّ تجلّياته النّصّيّة التّطبيقيّة في أنموذجين: قصيدة “قارئة الفنجان” لنزار قبّاني، ومشهد “موت عدلا” في مسلسل بالدّم. وقد انطلقنا فيه من فرضيّة مفادها أنّ النّقد الثّقافيّ لا يُقوّض الأدب، بل يُعيد تموضعه ضمن شبكة المعاني والصّراعات الرّمزيّة التي تنتجها الثّقافة.
الكلمات المفاتيح: النّقد الثّقافيّ، أنساق مُضمَرة، قارئة الفنجان، بالدّم، المجتمع، السّيميائيّة، الرّموز.
Abstract
Culture-based criticism represents one of the most significant epistemological and methodological shifts that have shaped contemporary critical discourse. Literary texts are no longer viewed merely as aesthetic objects enclosed within theirselves, but as discourse embedded within the cultural, symbolic, and social structures that produce and interpret such works. Cultural criticism has displaced the primacy of literature in favor of culture, expanding its analytical tools and fields of inquiry to encompass both the readable and the visible, the written and the imagined—bridging media, artistic, and referential discourses.
This study provides a comprehensive overview of the contexts that gave rise to cultural criticism and examines how its conceptual framework crystallized within Western thought. It then investigates its practical textual applications through two models: Nizar Qabbani’s poem *“The kariaat Al fonjen”* and the *“Death of Adla”* scene from the television series *Bil Dam*. The central hypothesis of this study is that cultural criticism does not diminish literature but rather repositions it within the complex network of meanings and symbolic tensions generated by culture.
Keywords
Cultural criticism, implicit systems, kariaat Al fonjen, Bil Dam, society, semiotics, symbols.
المقدّمة
يُعَدّ النّقد الثّقافيّ (Cultural Criticism) واحدًا من أبرز الأنشطة الفكريّة العميقة التي تتّكئ على الثّقافة بمفهومها الواسع والعريض، حيث يتّخذ أصحابه من الأنشطة الإنسانيّة العامّة موضوعات للبحوث ومجالات للدّراسة، محاولين بها ومن خلالها التّعبيرَ عن مواقف محدّدة تجاه تبدّلات الثّقافة وتقلّبات السّلطة في المجتعمات الرّأسماليّة المعاصرة.
وقد شُغل أصحاب النّقد الثّقافيّ بتتبّع الأدوار الاجتماعيّة التي يمكن أن تؤدّيها الفنون والآداب المختلفة، كما اهتمّوا أيضًا ببحث الآثار المختلفة المترتّبة على المزج بين الإبداع والفكر، وبشكل خاصّ في مجال الحراك الاجتماعيّ، وانتبهوا كذلك للقضايا المجتمعيّة مثل قضايا التّعليم، والنّموّ السّكّانيّ، والتّحوّلات الاجتماعيّة والاقتصاديّة في أطر المجتمعات الرّأسماليّة الحديثة، وحتّى الملابس والأزياء، فراحوا يولونها عناية خاصّة، وينشغلون بما تعكسه من دلالات ثقافيّة؛ كما بالغوا في اهتمامهم برصد فئات المهمّشين والشّعبيّين والإقليميّين، وتتبّعوا كلّ ما يختصّ بالأقلّيّات على نحوٍ عامّ، مع عنايتهم البالغة بالإبداعات الثّقافيّة المختلفة لهؤلاء المهمّشين والشّعبيّين والإقليميّين في مختلف أرجاء المعمورة.
ولم يقتصر اهتمام أصحاب النّقد الثّقافيّ على صور ما أسلفنا فحسب، بل تجاوزوا كلّ ذلك إلى ما هو أكبر وأشمل، وهو نقد الثّقافة بمفهومها الواسع والعريض، وتحليل أنشطتها المؤسّساتيّة، من خلال استعانتهم بمناهج مستقاةٍ من مرحلة ما بعد البنيويّة.
وفي ضوء ذلك، سنقسم هذا البحث إلى قسمين: قسم نظريّ نسلّط فيه الضّوء على مفهوم النّقد الثّقافيّ وجذوره ونشأته، يليه قسم تطبيقيّ نتوقّف فيه عند قصيدة “قارئة الفنجان” للشّاعر نزار قبّاني بوصفها نصًّا شعريًّا يتقاطع مع أنساق الثّقافة العربيّة في تمثيل المرأة والقدر، وعند مشهد “موت عدلا” من مسلسل “بالدّم” باعتباره خطابًا بصريًّا يُجسّد تمثيلات العنف والسّلطة والطّبقيّة في الموروث الجمعيّ.
وينطلق هذا البحث من الإشكاليّة الآتية:
هل يتيح النّقد الثّقافيّ، بوصفه منهجًا عابرًا للتّخصّصات، تفكيكَ الأنساق المُضمَرَة والتّمثيلات الرّمزيّة للسّلطة والهويّة في النّصوص الإبداعيّة؟
وتتفرّع عن هذه الإشكاليّة التّساؤلات التّالية:
-هل يمكن اعتبار البنية الجماليّة للنّصّ خطابًا ثقافيًّا يُعيد إنتاج الأنساق السّلطويّة أو يعمل على تفكيكها؟
-هل يمنح النّقد الثّقافيّ المتلقّي سلطة التّأويل بما يكشف عن تعدّديّة المعنى ونسبيّته؟
-كيف تتباين تمثيلات الجسد والهويّة والسّلطة في النّصوص النّوعيّة المختلفة (شعر، دراما) عند إخضاعها للقراءة الثّقافيّة؟
أمّا المنهج المعتمد في هذه الدّراسة فهو المنهج الثّقافيّ النّقديّ (النّقد الثّقافيّ)، بوصفه منهجًا تفاعليًّا، بَيْنيًّا، يتقاطع مع العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، ويهدف إلى تحليل النّصوص بوصفها تجلّيات لخطابات ثقافيّة تنتجها بنى السّلطة والمعرفة والهويّة.
فما هو مفهوم هذا النّقد؟ إلى متى تعود جذوره، وما هي مراحل نشأته؟ وكيف تجلّى تطبيقيًّا في الأنموذجين المختارَين للدّراسة؟
أوّلًا- القسم النّظريّ: إضاءة عامّة على النّقد الثّقافيّ
إنّ مفهوم النّقد الثّقافيّ مصطلح معاصر يرتبط بتوجّهات ما بعد الحداثة، يعمل في حقل واسع ومتعدّد ومتنوّع ومتداخل؛ فهو ينفتح على مجالات فكريّة ومعارف اجتماعيّة وإنسانيّة كنظريّة الأدب والتّحليل النّفسيّ وعلم العلامات وغيرها. وقد اختلف النّقّاد حول النّقد الثّقافيّ بين مَن عدّه منهجًا نقديًّا، وآخر رآه نشاطًا نقديًّا، غير أنّ النّقد الثّقافيّ نشاط فكريّ وليس مجالًا معرفيًّا خاصًّا بذاته، يهتمّ بالنّصوص المهمّشة التي لم يتناولها النّقد الأدبيّ، ودراسة الأدب الفنّيّ والجماليّ، كونه يمثّل ظاهرة ثقافيّة.
1- مفهوم النّقد الثّقافيّ
النّقد الثّقافيّ منهج فكريّ غربيّ الأصل، ظهر في أوروبا في حدود القرن الثّامن عشر الميلاديّ[2]، وكذلك عند الأميركيّين، ويمثّلهم فنسنت ليتش (Vincent Leitch) الذي دعا إلى نقد ثقافيّ “ما بعد بنيويّ”[3]. ويقصد بما بعد البنيويّ “ما بعد الحداثة”، إذ إنّ النّقد الثّقافيّ يندرج ضمن الإطار الفكريّ لما بعد الحداثة. وكان الهدف بطبيعة الحال توسيع أفق ما بعد البنيويّة، ليحتوي ذلك الزّخم الجديد للنّظريّة في مختلف الاتّجاهات، ويشمل مذاهب وتيّارات نقديّة متعدّدة، مثل: “ما بعد الكولونياليّة والمادّيّة، والثّقافيّة، والماركسيّة الجديدة، والتّاريخيّة الجديدة، والنّقد النّسويّ، والنّقد الثّقافيّ”[4].
يقوم النّقد الثّقافيّ عند ليتش كما يرى الغذاميّ على ثلاث خصائص هي[5]:
1-لا يؤطّر النّقد الثّقافيّ فعله تحت إطار التّصنيف المؤسّساتيّ للنّصّ الجماليّ، بل ينفتح على مجال عريض من الاهتمامات إلى ما هو غير محسوب في حساب المؤسّسة، وإلى ما هو غير جماليّ في عرف المؤسّسة، سواء أكان خطابًا أم ظاهرة.
2-يستفيد النّقد الثّقافيّ من مناهج التّحليل مثل تأويل النّصوص ودراسة الخلفيّة التّاريخيّة، إضافة إلى إفادته من الموقف الثّقافيّ النّقديّ والتّحليل المؤسّساتيّ.
3-إنّ الذي يميّز النّقد الثّقافيّ الما بعد البنيويّ هو تركيزه الجوهريّ على أنظمة الخطاب كما هي لدى بارت (Barhes) ودريدا (Derrida) وفوكو (Foucault)، خصوصًا في مقولة دريدا أن لا شيء خارج النّصّ، وهي مقولة يصفها ليتش بأنّها بمثابة البروتوكول للنّقد الثّقافيّ الما بعد بنيويّ، ومعها مفاتيح التّشريح النّصوصيّ كما عند بارت، وحفريّات فوكو. وبذلك تجاوز النّقد الثّقافيّ كلّ ما هو شكلانيّ، وتحوّل إلى البحث عن الأشكال الثّقافيّة التي لم يهتمّ بها النّقد القديم حسب ما يرى ليتش.
أمّا بالنّسبة إلى آرثر أسا بيرغر (Arthur Asa Berger) فالنّقد الثّقافيّ هو “نشاط وليس مجالًا معرفيًّا خاصًّا بذاته، وإنّ نقّاد الثّقافة يطبّقون المفاهيم والنّظريّات على الفنون الرّاقية، والثّقافة الشّعبيّة، والحياة اليوميّة، وعلى حشدٍ من الموضوعات المرتبطة. فإنّ النّقد الثّقافيّ هو مهمّة متداخلة، مترابطة متجاوزة متعدّدة. وإنّ نقّاد الثّقافة يأتون من مجالات مختلفة ويستخدمون أفكارًا ومفاهيم متنوّعة”[6]. وهو ينفتح على العديد من العلوم والنّظريّات ويفيد منها، وبمقدوره “أن يشمل نظريّة الأدب والجمال والنّقد، وأيضًا التّفكير الفلسفيّ، وتحليل الوسائط والنّقد الثّقافيّ الشّعبيّ، وبمقدوره أيضًا أن يفسّر نظريّات ومجالات علم العلامات، ونظريّة التّحليل النّفسيّ، والنّظريّة الاجتماعيّة الأنثروبولوجيّة…”[7]. فيكون بذلك شأنه شأن الدّراسات الثّقافيّة، لأنّ كليهما أفاد من نظريّة الأدب والجمال وما إلى ذلك.
وفيه يقول الدّكتور عبد الوهّاب أبو هاشم: “إنّ النّقد الثّقافيّ هو منهج سبقنا إليه الغرب (أمريكا وفرنسا)، له أدواته للكشف عن المُضمر النّسقيّ في العمل الأدبيّ”[8].
يؤكّد حفناوي بعلي أنّ هذا النّقد الثّقافيّ “نشاط وليس مجالًا معرفيًّا قائمًا في ذاته، وأنّ النّاقد الثّقافيّ أو نقّاد الثّقافة، يطبّقون المفاهيم والنّظريّات المتنوّعة في تراكيب على الفنون الرّاقية والثّقافة الشّعبيّة والحياة اليوميّة…، وبمقدور [هذا النّقد] أن يشمل نظريّة الأدب والجمال والنّقد والتّفكير الفلسفيّ وعلم العلامات والنّظريّة الاجتماعيّة والأنثروبولوجيّة”[9]. وبالنّتيجة، يتّفق حفناوي بعلي مع آرثر أسا بيرغر على أنّ النّقد الثّقافيّ نشاط.
أمّا عبد الله الغذاميّ فقد عرّفه بأنّه “فرع من فروع النّقد النّصوصيّ العامّ…، معنيّ بنقد الأنساق المُضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثّقافيّ بكلّ تجلّياته وأنماطه وصِيَغه…[وهو يهتمّ] بكشف… المخبوء من تحت أقنعة البلاغيّ/ الجماليّ”[10]. فالغذاميّ بقوله هذا يستبعد الجماليّات من دائرة النّقد الثّقافيّ. والجدير بالذّكر أنّ هذا النّقد يدرس النّصوص والخطابات الأدبيّة التي تحمل أنساقًا وصورًا ثقافيّة وما إلى ذلك، سواء أكانت شعرًا أم قصّة أم رواية أم مسرحيّة.
فالنّقد الثّقافيّ يواكب روح العصر، ويستلهم الواقع؛ لذلك يحتاج إلى تأنٍّ ودقّة ومراجعة عميقة وجادّة. وتبرز أهمّيّته في جرأته وإمكانيّته على التّجدّد والإنتاج، وهذا ما جعله نشاطًا فكريًّا، إذ “يتّخذ من الثّقافة بشموليّتها موضوعًا لبحثه وتفكيره، ويعبّر عن مواقف إزاء تطوّراتها وسماتها”[11]، فلم يكن النّقد الثّقافيّ بديلًا عن النّقد الأدبيّ بقدر ما كان محاولة منهجيّة تتمحور حول استكشاف الأنساق الثّقافيّة المُضمرة، سواء أكانت تلك الأنساق مهيمنة أم هامشيّة.
والعلاقة بين النّقد الأدبيّ والنّقد الثّقافيّ علاقة تكامل لا علاقة إلغاء أو تنافس؛ فالنّقد الثّقافيّ لا يحلّ محلّ النّقد الأدبيّ أو يلغيه، لأنّه يستعين بالمناهج كافّة وينفتح عليها، ومن ضمنها النّقد الأدبيّ. وقد تطوّر النّقد الثّقافيّ عن النّقد الأدبيّ الذي بقي على تقاليده في نقد النّصوص وتفسيرها، ثمّ إصدار الحكم النّقديّ عليها. وبالتّالي، فقد عرف مراحل تطوّريّة مختلفة.
2- مراحل تطوّر النّقد الثّقافيّ
ظهر النّقد الثّقافيّ في الغرب في القرن الثّامن عشر، لكنّه كمصطلح لم يكن موجودًا قبل منتصف القرن العشرين. ولم يكن بروزه وليد صدفة، بل جاء نتيجة سياقات مرتبطة بتطوّر الفكر الغربيّ منذ القرن التّاسع عشر. وقد أتى ردّة فعل على محدوديّة النّقد الأدبيّ التّقليديّ، متجاوزًا النّصوص إلى تحليل الخطاب، والتّمثيلات، والسّلطة، والهويّة. وتتمثّل جذوره في عدّة محطّات أساسيّة، من أبرزها:
2-أ-المرحلة الأولى: مدرسة فرانكفورت[12]
تُعدّ النّواة الأولى للنّقد الثّقافيّ. ظهرت في ألمانيا بين الحربين العالميّتين، وانتقلت لاحقًا إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة بعد صعود النّازيّة.
أبرز المفكّرين في هذه المرحلة: ثيودور أدورنو (Theodor Adorno)، وماكس هوركهايمر (Max Horkheimer)، وهربرت ماركوزه (Herbert Marcuse).
ركّز هؤلاء على نقد الثّقافة الجماهيريّة، وربطوا الإنتاج الثّقافيّ بالبنية الرّأسماليّة معتبرين الثّقافة أداة أيديولوجيّة تُستخدم لإعادة إنتاج الأيديولوجيا السّائدة وتخدير وعي الجماهير. وقد أسهموا في النّقد الثّقافيّ من خلال تقديم تحليل ثقافيّ للسّلطة والرّأسماليّة من منظور ماركسيّ، ومهّدوا لفكرة أنّ الثّقافة ليست حياديّة بل بنية موجّهة أيديولوجيًّا.
2-ب- المرحلة الثّانية: ما بعد البنيويّة وتفكيك مركزيّة المبنى[13]
ظهرت ما بعد البنيويّة في ستّينيّات القرن العشرين في فرنسا، ردًّا على البنيويّة التي كانت ترى أنّ المعنى يُبنى داخل أنظمة مغلقة، كاللّغة أو الأسطورة أو الثّقافة. أمّا ما بعد البنيويّة فقد أعلنت رفض الثّبات، والنّسق، والسّلطة التّفسيريّة الواحدة، وهذا ما وفّر أرضيّة خصبة لنشوء النّقد الثّقافيّ لاحقًا.
وقد طرح دريدا مفهوم “التّفكيك” الذي لا يعني الهدم، بل إظهار تناقضات النّصّ، وأكّد أنّ المعنى غير ثابت، بل يتأجّل باستمرار بسبب انزلاقات اللّغة، وشكّك في مركزيّة الذّات، والحقيقة، والعقل، ما أعاد تشكيل نظرتنا إلى الخطابات الثّقافيّة.
أمّا فوكو، فرأى أنّ الخطاب يُنتج المعرفة، وهو ليس أداة تواصل بريئة، بل نظام سلطة. وقد حلّل كيف تتحكّم المؤسّسات (كالطّبّ، الدّين، السّجون) في تشكيل الذّات والمعنى، ممهّدًا لنشوء نقد الخطاب في الدّراسات الثّقافيّة والنقد الثّقافيّ.
وتحدّث جان بودريار (Jean Baudrillard) عن مفهوم المحاكاة والواقع الفائق (Hyperreality)، وهما من أبرز أسس النّقد الثّقافيّ في ما بعد الحداثة، إذ يقترح أنّ الثّقافة تمرّ بأربع مراحل في علاقتها بالواقع:
1-الرّمز: يعكس واقعًا حقيقيًّا (مثل صورة طبق الأصل).
2-التّشويه: الرّمز يشوّه الواقع الذي يمثّله.
3-التّمثيل الذي يدّعي الواقعيّة من دون مرجعيّة: أي لا يعود لواقع بل لنسخة من واقع.
4-المحاكاة: لا يوجد واقع أصليّ، بل الرّمز يصبح هو الواقع. فالمحاكاة هي إنتاج نسخ لا تحاكي شيئًا حقيقيًّا، بل تصنع وهمًا بالواقع.
مثلًا: الإعلام، والإعلان، والسّينما، ومواقع التّواصل، تُنتج عالمًا من الصّور التي تحلّ مكان الواقع الأصليّ (مثال: في ديزني لاند تُصنع حقيقة خياليّة أكثر جاذبيّة من الواقع، ويُقبل النّاس عليها كأنّها الأصل).
والواقع الفائق هو حالة اندماج المحاكاة مع الواقع بحيث لا يستطيع الإنسان التّمييز بين الحقيقة والصّورة، العالم مغمور بالصّور، والرّموز، والشّفرات التي تحلّ محلّ التّجربة الواقعيّة.
النّتيجة: انهيار المعنى، لأنّ كلّ شيء صار تمثيلًا لشيء آخر غير موجود.
وعليه، فهو يرى أنّ الثّقافة الحديثة أصبحت خاضعة لمنطق السّوق والاستهلاك الرّمزيّ، والسّياسة، والإعلام، والحياة اليوميّة تتحوّل إلى عروض ومحاكاة للسّلطة والمعنى.
من هنا، لا يقدّم بودريار فقط نقدًا للثّقافة، بل يتنبّأ بزوال الواقع نفسه في ظلّ هيمنة الصّور والمحاكاة. نقده جذريّ وحداثيّ بامتياز، وقد أثّر في مجالات الإعلام، والسّيميولوجيا، والفكر الثّقافيّ والسّياسيّ.
من هنا، يتلخّص أثر ما بعد البنيويّة في النّقد الثّقافيّ كما يلي:
-تحرير النّقد من الحدود الأدبيّة الصّارمة نحو تحليل الخطابات.
-التّشكيك في الخطابات الكبرى: القوميّة، العقلانيّة، الإنسانيّة، الهويّة.
-تمهيد الطّريق لفحص التّمثيلات الثّقافيّة بوصفها بنيات أيديولوجيّة.
2-ج-المرحلة الثّالثة: الدّراسات الثّقافيّة: التّحوّل إلى تحليل الحياة اليوميّة[14]
ظهر هذا التّيّار في ستّينيّات القرن الماضي في بريطانيا مع تأسيس مركز الدّراسات الثّقافيّة المعاصرة في جامعة برمنغهام، مع ريتشارد هوغارت (Richard Hoggart)، ثمّ رايموند ويليامز (Raymond Williams) وستيورات هول (Stuart Hall).
تحوّلت النّظرة إلى الثّقافة من كونها نخبويّة إلى كونها مجالًا للصّراع والممارسة اليوميّة.
أبرز الخصائص التي تميّزت بها:
أ-التّركيز على الثّقافة الشّعبيّة، لا باعتبارها تافهة، بل كمرآة لأعمق البنى الاجتماعيّة والرّمزيّة.
ب-الدّمج بين الأدب والإعلام والجندر والعرق باعتبارها حقولًا مترابطة داخل الحياة اليوميّة.
ج-نقد الهيمنة الثّقافيّة (هيمنة المعنى) بالاعتماد على مفهوم غرامشي للهيمنة[15]، ودراسة كيف تفرض الثّقافة السّائدة تصوّراتها على الأفراد.
د-دور المتلقّي: لم يعد المتلقّي سلبيًّا، بل أعاد إنتاج المعنى من موقعه الطّبقيّ والثّقافيّ.
أبرز المفكّرين في هذه المرحلة:
-رايموند ويليامز: الثّقافة عمليّة اجتماعيّة حيّة.
-ستيوارت هول: تحليل التّشفير والتّفكيك في الإعلام، ودراسة تمثيل العرق والهويّات.
-ريتشارد هوغارت: مؤسّس مفهوم الثّقافة الحيّة المرتبطة بالطّبقات الكادحة.
في هذه المرحلة لم يعد النّقد مقتصرًا على النّصوص، بل انتقل إلى تحليل العادات، والموضة، والتّلفزيون، واللّغة اليوميّة، وأنماط الاستهلاك، بوصفها نصوصًا ثقافيّة مشبعة بالسّلطة والرّمزيّة.
فتح هذا المجال أفقًا واسعًا للنّقد الثّقافيّ لفهم الإنسان المعاصر في بيئته المعيشيّة لا في برجه النّصّيّ العاصي.
بعد هذا العرض الموجز لمراحل تطوّر النّقد الثّقافيّ، من تنظيرات مدرسة فرانكفورت في تفكيك السّلطة والهيمنة، إلى تفكيك ما بعد البنيويّة البنى المعرفيّة واللّغويّة، وصولًا إلى تحليل الحياة اليوميّة كما بيّنت الدّراسات الثّقافيّة البريطانيّة، يبدو واضحًا أنّ النّقد الثّقافيّ تجاوز مهمّته التّحليليّة البحتة ليغدو عدسة فاحصة للرّموز في كلّ تمثّلاتها.
ولعلّ التّحدّي الأكبر لا يكمن في توصيف هذه المراحل، بل في اختبار فاعليّتها التّحليليّة عند مقاربتها لنصوص أدبيّة تحتكم إلى تعقيدات اجتماعيّة وتاريخيّة وجماليّة متشابكة.
هنا تتجلّى الوظيفة الحيّة للنّقد الثّقافيّ، ليس فقط بوصفه ممارسة فكريّة، بل كونه أداة لفهم كيف يُعاد إنتاج السّلطة والمعنى والهويّة في النّصوص الثّقافيّة.
ثانيًا- القسم التّطبيقيّ: أنموذجان تطبيقيّان في ضوء النّقد الثّقافيّ
تتيح الدّراسة التّطبيقيّة فَهمًا أوسع للنّقد الثّقافيّ، كونها تُخضع النّصّ لمبضع التّحليل على ضوء نظريّات هذا المنهج، ما يكشف عن الأبعاد الدّلاليّة والأنساق الثّقافيّة التي يتضمّنها، ويُكسب البحث ديناميكيّة وحيويّة.
وعليه، ارتأينا توظيف النّقد الثّقافيّ في الشّعر، من خلال تحليل قصيدة “قارئة الفنجان” للشّاعر نزار قبّاني، وفي الدّراما، من خلال تحليل مشهد “موت عدلا” في مسلسل “بالدّم”.
1- تحليل قصيدة “قارئة الفنجان”
تمثّل قصيدة “قارئة الفنجان” للشّاعر نزار قبّاني أنموذجًا تحليليًّا، لا لتناول قضيّة “المرأة – الجسد” كما يوحي ظاهرها، بل لتفكيك البنية الثّقافيّة التي تنتج خطابًا جديدًا يحكم علاقة الرّجل بالزّمن والمصير.
1-أ- النّصّ
جلسَت والخوفُ بعينيها
تتأمّلُ فنجانيَ المقلوب
قالت: يا ولدي… لا تحزَنْ
فالحبُّ عليكَ هو المكتوب
يا ولدي، قد ماتَ شهيدًا
مَن ماتَ على دين المحبوب
فنجانُك دنيا مُرعبةٌ
وحياتُك أسفارٌ وحروبْ
ستحبُّ كثيرًا يا ولدي
وتموتُ كثيرًا يا ولدي
وستعشقُ كلَّ نساء الأرض
وترجِعُ كالملكِ المغلوبْ
بحياتك يا ولدي امرأةٌ
عيناها، سُبحانَ المعبودْ
فمُها مرسومٌ كالعنقودْ
ضحكتُها موسيقى وورودْ
لكنّ سماءَكَ ممطرةٌ
وطريقَك مسدودٌ… مسدودْ
فحبيبةُ قلبك.. يا ولدي
نائمةٌ في قصرٍ مرصودْ
والقصرُ كبيرٌ يا ولدي
وكلابٌ تحرسُهُ… وجنودْ
وأميرةُ قلبكَ نائمةٌ
مَن يدخلُ حُجرتَها مفقودْ
مَن يطلبُ يدَها…
مَن يدنو من سورِ حديقتِها… مفقودْ
مَن حاولَ فكَّ ضفائرَها…
يا ولدي…
مفقود… مفقود
بَصّرتُ… ونجَّمتُ كثيرًا
لكنّي… لم أقرأ أبدًا
فنجانًا يشبهُ فنجانَكْ
لم أعرف أبدًا يا ولدي…
أحزانًا تشبهُ أحزانَكْ
مقدورُك… أن تمشيَ أبدًا
في الحبِّ… على حدِّ الخنجَرْ
وتظلَّ وحيدًا كالأصدافْ
وتظلَّ حزينًا كالصّفصافْ
مقدوركَ أن تمضيَ أبدًا…
في بحرِ الحبِّ بغيرِ قُلوعْ
وتحبَّ ملايينَ المرّات…
وترجِعَ كالملكِ المخلوعْ.
إنّ قراءة هذه القصيدة من منظور النّقد الثّقافيّ تتجاوز البُعد الرّومانسيّ لتلامس عمق البنية الذّكوريّة العربيّة، والتي تلجأ إلى الأنثى بوصفها وسيلة للكشف عن المجهول. من هنا، يصبح السّؤال المركزيّ: كيف تعيد القصيدة إنتاج خطاب الهيمنة الذّكوريّة من خلال استعارتها لسلطة قارئة الفنجان؟ وهل يمكن للنّصّ أن يُقرَأ باعتباره مساحة صراع ثقافيّ خفيّ بين العاطفة والسّلطة؟
1-ب- القصيدة في ضوء النّقد الثّقافيّ
بالاعتماد على مسارات النّقد الثّقافيّ، وتحليل الخطابات الرّمزيّة والسّلطويّة داخل النّصوص، يمكن تفكيك قصيدة “قارئة الفنجان” وفق الآتي:
– الخطاب القدَريّ والهيمنة الرّمزيّة
القصيدة مشبعة بخطاب قدَري يُنزّه الحبّ ويجعله قوّة غيبيّة لا مفرّ منها: “فالحبّ عليك هو المكتوب”. هذا الاستسلام للقدر يُعيد إنتاج تصوّر ثقافيّ عربيّ يرى في الحبّ مصيرًا حتميًّا، لا تجربة إنسانيّة قابلة للتّشكيل. هنا، تنسحب الفاعليّة من الذّات، وتُستبدل بها صياغة الهويّة العاطفيّة للرّجل.
-حضور المرأة كونها كاهنة وقدرا
لا تُستحضر المرأة في القصيدة كامرأة حقيقيّة، بل كرمز مزدوج: فهي “قارئة الفنجان” التي تمتلك سلطة النّبوءة، وهي في الوقت نفسه “أميرة” نائية، ومقموعة، ومحروسة. في كلا الدّورين، تُفرَّغ المرأة من إنسانيّتها، ويُحمّل جسدها رمزيّة ثقافيّة فائضة: فتارة هي مَن تكشف المستقبل، وطورًا يَستحيل الوصول إليها. وهي مفارقة تُرسّخ نمط “الأنثى الغامضة/ المقدّسة”، الشّائع في الثّقافة العربيّة الذّكوريّة.
-خطاب الحصار والاستحالة
“نائمة في قصرٍ مرصود… وكلابٌ تحرسه… وجنود”، “مَن يدخل حجرتَها مفقود”. هذه العبارات تشكّل تمثيلًا ثقافيًّا لحصار الرّغبة، وتُعيد إنتاج خطاب الإحباط، لا بوصفه مشكلة نفسيّة، بل ثقافة تُرسّخ استحالة الحبّ، وتعذيب الرّغبة، وكأنّ العشق محكوم بنظام منع، وتابوهات طبقيّة أو جنسيّة.
-بنية البكائيّة وتكريس الرّجولة الجريحة
الشّاعر يصوغ هويّة رجوليّة مأزومة، مصلوبة على خشبة الحنين والانكسار. “وتحبّ ملايين المرّات… وترجع كالملك المخلوع”. الرّجولة لا تحتفل بالاختيار، بل تتمركز حول الخسارة، ما يعكس مركزيّة “الرّجل الضّحيّة” في الثّقافة العربيّة، وهو عنصر بالغ الأهمّيّة في نقد بنية الذّكورة الشّرقيّة.
-غياب البعد السّياسيّ/ الاجتماعيّ الظّاهر
رغم الطّابع العاطفيّ للقصيدة، فهي تستبطن تمثيلاتٍ ثقافيّةً للسّلطة والحصار الاجتماعيّ، خصوصًا في بناء العلاقة بين الحبّ والحرب، بين العشق والموت، بين المرأة والسّلطة. لذا، يمكن تأويل النّصّ بوصفه مرآةً تُعيد إنتاج تصوّرات المجتمع عن الحبّ والقدر، لا باعتبارها أحوالًا فرديّة، بل تمثّلات ثقافيّة.
وعليه، فإنّ قصيدة “قارئة الفنجان” نصّ مشبع بدلالات ثقافيّة عميقة، تُعيد إنتاج أنماط سلطويّة تحت غطاء الجمال الشِّعريّ. وهنا تتجلّى وظيفة النّقد الثّقافيّ: زعزعة ما يبدو شعريًّا محضًا لكشف ما هو رمزيّ، وبنيويّ، ومهيمن. القصيدة تمنح المرأة سلطة ظاهريّة، لكنّها في العمق تكرّس ثنائيّة السّيطرة والفقد، الحضور والغياب، المقدّس والممنوع، وتُثبّت خطابًا قدريًّا يُحاكي القهر الجمعيّ المقمّط في رداء الحبّ.
2- تحليل مشهد “موت عدلا”
تناول مسلسل “بالدّم” الذي عُرِض على إحدى المحطّات التّلفازيّة اللّبنانيّة في شهر رمضان المنصرم، العديد من القضايا الاجتماعيّة التي يعاني منها المجتمع العربيّ، ومنها قضيّة الشّرف، وتهميش المرأة، والاتّجار بالأطفال… وهي من القضايا التي غالبًا ما يتمّ السّكوت عنها في الخطاب العامّ.
2-أ-انعكاس المجتمع في الخطاب الثّقافيّ
تناولَ المسلسل، كما أشرنا، ضمن القضايا التي طرحها، قضيّة تجارة الأطفال، وتعمّق في وصف تداعياتها على الأشخاص والمجتمع. ولعلّ الشّخصيّة التي مثّلت هذا الدّور خيرَ تمثيل هي “عدلا”، الشّابّة البسيطة التي لجأت إلى حيّ شعبيّ عندما كانت حاملًا، هربًا من عائلتها، ومَكَثَت في منزل القابلة القانونيّة المتورّطة في الاتّجار بالأطفال، ما يضعها في موقع اجتماعيّ هشّ ومعرّض للاستغلال والعنف، ويُبرز مدى محدوديّة خياراتها، وانعدام شبكات الدّعم الآمنة لها. فهروب “عدلا” من عائلتها بسبب الحمل خارج إطار الزّواج يسلّط الضّوء على الخطابات الثّقافيّة المحافظة التي تفرض وصمة عار اجتماعيّة قاسية على النّساء اللّواتي يخرجن عن التّقاليد. حملُها ووضعُها كامرأة وحيدة يجعلانها عرضة للتّهميش والاستغلال في مجتمع ما يزال يحمل أحكامًا مُسبقة تجاه هذه الفئة.
والجدير بالذّكر أنّ ارتباط “عدلا” بالطّفل المفقود من خلال الدّمية “غدي” يحمل دلالات عميقة حول الأمومة المهمَّشة والفقد، لأنّ هذا الارتباط المرضيّ بالدّمية يكشف عن أثر الصّدمة في سياق التّهميش الاجتماعيّ. فهل يُعدّ هذا الارتباط بالدّمية نوعًا من المقاومة الصّامتة للظّروف القاسية؟ وما الدّلالات الاجتماعيّة التي يمكن استنتاجها من مشهد “موت عدلا”؟
2-ب-الدّلالات الاجتماعيّة التي يحملها مشهد “موت عدلا”
حملت شخصيّة “عدلا” ولا سيّما مشهد موتها، أنساقًا ثقافيّة ترجمت الأوضاع الاجتماعيّة في المجتمعات العربيّة، نذكر منها:
-النّسق الثّقافيّ الذّكوريّ
لعلّ المشهد الأشدّ وقعًا في النّفس والأكثر إيلامًا، كان احتفال “عدلا” بعيد ميلاد “غدي” قبل مقتلها، ما يؤكّد عمق جرحها وحرمانها، فيتحوّل طفلُها الافتراضيّ “غدي” علامة على الحنين إلى أمومة. وليس مقتل “عدلا” على يد أخيها في جريمة شرف إلّا تجسيدًا مُرَوِّعًا للعنف الذّكوريّ وسلطة العائلة الأبويّة في المجتمعات التي ما تزال تتبنّى مفاهيم الشّرف القائمة على قمع حرّيّة المرأة وحياتها. هذا المشهد يكشف عن النّسق الثّقافيّ الذّكوريّ الذي يمنح الذّكور الحقّ في التّحكّم بحياة الإناث ومعاقبتهنّ باسم الحفاظ على شرف العائلة. هكذا يصبح هذا المشهد أيقونة لظاهرة جرائم الشّرف في المجتمعات العربيّة. أمّا دم “عدلا” المسكوب فعلامة مؤثّرة تُحيل مباشرة إلى أنّ الرّوابط العائليّة تُبنى أحيانًا على العنف لا الحبّ. كما أنّ تصوير موت “عدلا” أمام ابنها “غدي” يشكّل علامة بصريّة قويّة، حيث يُظهر المونتاج التّباين بين براءة الطّفل وقسوة الجريمة، مُستحضرًا سيميائيّة “الضّحايا الصّامتة”. فالمشهد يُفكّك التنّاقض بين الاحتفال بعيد الميلاد (رمز الحياة) والقتل (رمز الموت)، كاشفًا عن الازدواجيّة الأخلاقيّة في المجتمع.
– أبعاد التّفاعل بين الحدث والمتلقّي
الواقع، أنّ التّفاعل الواسع للجمهور مع شخصيّة “عدلا” والتّعبير عن الحزن لوداعها، والمطالبة بإطلاق أغنية المشهد وإطلاق البالونات التي ترمز إلى صعود الرّوح إلى السّماء، كلّ هذا يشير إلى قدرة هذه الشّخصيّة المُهَمَّشة على لمس قلوب المشاهدين، وإثارة تعاطفهم، ما يُمكن تحليله من منظور سوسيولوجيا التّلقّي، إذ رأى الجمهور في هذه الشّخصيّة انعكاسًا لمعاناة الفئات المهمَّشَة في المجتمع.
هكذا يبدو النّصّ مقرونًا في تفاعلاته بالمجتمع، وتقاطعاته بأنظمة الإنتاج وأنظمة الاستقبال، وذلك للكشف عن التّعقيدات القائمة بين النّصوص والجمهور، والقوى التي تتولّى إنتاج الوسائل، في حركة السّياق الاجتماعيّ.
-رمزيّة أغنية الختام: “نملة صغيرة”
إنّ اختيار أغنية “نملة صغيرة” للمشهد الختاميّ يضيف طبقة أخرى من التّحليل الرّمزيّ، حيث يمكن للنّملة الصّغيرة أن ترمز إلى الضّعف والصّبر، وهي صفات قد تكون مرتبطة بشخصيّة “عدلا”. هذه الأخيرة التي تجاوزت كونها مجرّد شخصيّة دراميّة لتصبح نظامًا من العلامات التي تفكّك الخطاب السّائد حول الجندريّة (Gender)، والعنف والهويّة، عبر توظيف السّيميائيّات البصريّة (المونتاج، الألوان)، والسّمعيّة (الأغنية)، والسّرديّة (المصير المأسويّ)، فتتحوّل “عدلا” إلى علامة ثقافيّة تطرح أسئلة نقديّة حول المسكوت عنه في المجتمع.
فالسّيميولوجيا تكشف أنّ الموت الدّراميّ لـ “عدلا” ليس نهاية، بل بداية لتفكيك رموز القمع. واسم “عدلا” نفسه يحمل دلالة سيميائيّة: “عدلا” من العدل تُقتل ظُلمًا، ما يُظهر الانزياح بين الدّالّ (الاسم) والمدلول (المصير) لتفضح غياب العدالة الاجتماعيّة.
الخاتمة
النّقد الثّقافيّ هو مقاربة تحليليّة، يهدف إلى فحص الأنظمة والقيم والممارسات الثّقافيّة في المجتمع وفهمها، ومعرفة كيفيّة تأثيرها في الأفراد والمجتمات. وبناء عليه، عمدنا إلى تحليل أنموذجين: شعريّ ودراميّ، وهما: قصيدة “قارئة الفنجان” للشّاعر نزار قبّاني، ومشهد “موت عدلا” من مسلسل بالدّم، ضمن إطار النّقد الثّقافيّ، ما أتاح لنا استكشاف البنى العميقة الكامنة في اللّغة والرّموز خلف النّصوص الجماليّة.
وقد مرّ هذا النّقد بمراحل متشابكة، من جذور فلسفيّة واجتماعيّة، إلى مرحلة ما بعد البنيويّة، ثمّ إلى تفكيك الحياة اليوميّة، فوسّع مداركه من سلطة النّصّ إلى سلطة المعنى.
لكن ما طرحناه في هذا البحث يتجاوز استعادة المسار ليقترح رؤية جديدة: الانفتاح على نقد ثقافيّ بَينيّ-تفاعليّ-حيّ، ينصهر فيه تحليل الخطاب مع تحليل الأنساق المُضمَرة، في قراءة جديدة للثّقافة لا تكتفي بتفكيك السّلطة، بل تراقب إنتاجها، وتَوَزُّعَها، وتحوّلاتِها عبر الزّمان والمكان.
إنّ المستقبل الحقيقيّ للنّقد الثّقافيّ لا يكمن فقط في تعدّد المناهج، بل في تحوّل النّاقد نفسه إلى ذات متعدّدة التّخصّصات، واعية لاختلافات الحقول، ومؤمنة بإمكانات قرائيّة جديدة تتجاوز ثنائيّة الجماليّ/الإيديولوجيّ نحو أفق تفاعليّ متجدّد.
قائمة المصادر والمراجع
-أبو هاشم (عبد الوهّاب)، “مشروع النّقد الثّقافيّ”، جمعيّة الثّقافة والفكر الحرّ، ملتقى الإبداع الأدبيّ، اللّقاء الخامس، 17 أبريل 2003.
-أخضريّ (نجاة)، النّقد الثّقافيّ وواقعه في الجزائر، في سبيل مقاربة بينيّة، حفناوي بعلي نموذجًا، الجزائر، جامعة سيدي بلعبّاس، ع 2، ديسمبر 2020.
-أدورنو (ثيودور) وهوركهايمر (ماكس)، جدل التّنوير، ترجمة حنّا عبّود، بيروت، المنظّمة العربيّة للتّرجمة، 2005.
-بعلي (حفناوي)، مدخل في نظريّة النّقد الثّقافيّ المقارن، ط1، الجزائر، الدّار العربيّة للعلوم – ناشرون، 2007.
-بوديار (جان)، المجتمع الاستهلاكيّ: أساطير وسلوك، ترجمة عبده عبّود وآخرون، بيروت، المنظّمة العربيّة للتّرجمة، 2008.
-بيرغر (آرثر أسا)، النّقد الثّقافيّ تمهيد مبدئيّ للمفاهيم الرّئيسيّة، ترجمة وفاء ابراهيم ورمضان بسطاويسيّ، ط 1، القاهرة، المجلس الأعلى للثّقافة، 2003.
-جابر (نادين)، مسلسل “بالدّم”، إخراج فيليب أسمر، إنتاج شركة “إيغل فيلمز”، عُرضَ في موسم رمضان 2025.
-حمّودة (عبد العزيز)، الخروج من التّيه: دراسة في سلطة النّصّ، الكويت، سلسلة كتب ثقافيّة يصدرها المجلس الوطنيّ للثّقافة والفنون والآداب، العدد 289، نوفمبر 2003.
-دريدا (جاك)، الكتابة والاختلاف، ترجمة كمال بو منير، الجزائر، دار الاختلاف بالتّعاون مع منشورات ضِفاف، بيروت، 2012.
-الرّويلي (ميجان) والبازعي (سعد)، دليل النّاقد الأدبيّ: إضاءة لأكثر من سبعين تيّارًا ومصطلحًا نقديًّا معاصرًا، ط 3، الدّار البيضاء، المركز الثّقافيّ، 2002.
-الغذاميّ (عبد الله)، النّقد الثّقافيّ: قراءة في الأنساق الثّقافيّة العربيّة، ط1، المغرب، المركز الثّقافيّ العربيّ، 2000.
-فوكو (ميشال)، أركيولوجيا المعرفة، ترجمة ماهر فريد، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، سلسلة الفكر المعاصر، 2005.
-قبّاني (نزار)، قصائد متوحّشة، 1970، books-library.online (AlAdkawia.net).
-ماركوزه (هربرت)، الإنسان ذو البعد الواحد، ترجمة جورج طرابيشي، بيروت، دار الآداب، 1988.
-هول (ستيوارت)، التّمثيل: الثّقافة والتّمثيلات الثّقافيّة، ترجمة سعيد بو كرامي وآخرون، القاهرة، المركز القوميّ للتّرجمة، 2019.
-ويليامز (رايموند)، الكلمات المفاتيح: مفردات الثّقافة والمجتمع، ترجمة عبد السّلام بنعبد العالي، الدّار البيضاء، دار توبقال، 2007.
[1] باحثة وأكاديميّة لبنانيّة. حائزة شهادة دكتوراه في اللّغة العربيّة وآدابها في معهد الآداب الشّرقيّة – جامعة القدّيس يوسف. تدرّس في جامعة البلمند وجامعة القدّيس يوسف.
[2] ينظر: ميجان الرّويلي وسعد البازعيّ، دليل النّاقد الأدبيّ: إضاءة لأكثر من سبعين تيّارًا ومصطلحًا نقديًّا معاصرًا، ط3، الدّار البيضاء، المركز الثّقافيّ، 2002، ص 306.
[3] الموضع نفسه.
[4] عبد العزيز حمّودة، الخروج من التّيه: دراسة في سلطة النّصّ، الكويت، سلسلة كتب ثقافيّة يصدرها المجلس الوطنيّ للثٌّقافة والفنون والآداب، العدد 289، نوفمبر 2003، ص 221.
[5] عبد الله الغذاميّ، النّقد الثّقافيّ: قراءة في الأنساق الثّقافيّة العربيّة، ط1، المغرب، المركز الثّقافيّ العربيّ، 2000، ص 32.
[6] آرثر أسا بيرغر، النّقد الثّقافيّ تمهيد مبدئيّ للمفاهيم الرّئيسيّة، الكويت، ترجمة وفاء ابراهيم ورمضان بسطاويسيّ، ط1، القاهرة، المجلس الأعلى للثّقافة، 2003، ص 30، 31.
[7] م. ن.، ص 31.
[8] عبد الوهّاب أبو هاشم، مشروع النّقد الثّقافيّ، جمعيّة الثّقافة والفكر الحرّ، ملتقى الإبداع الأدبيّ، اللّقاء الخامس، الخميس 17 أبريل 2003. أيضًا: نجاة أخضريّ، النّقد الثّقافيّ وواقعه في الجزائر: في سبيل مقاربة بينيّة حفناوي بعلي نموذجًا، الجزائر، جامعة سيدي بلعبّاس، ع 2، م 1، ديسمبر 2020، ص 68.
[9] حفناوي بعلي، مدخل في نظريّة النّقد الثّقافيّ المقارن، ط1، الجزائر، الدّار العربيّة للعلوم – ناشرون، 2007، ص 20 (ومن الملاحظ أنّ حفناويّ قد أورد تعريف آرثر أسا بيرغر للنّقد الثّقافيّ من دون الإشارة إليه).
[10] عبد الله الغذاميّ، م. س.، ص 83، 84.
[11] ميجان الرّويليّ وسعد البازعيّ، م. س.، ص 305.
[12] أنظر: ثيودور أدورنو وماكس هوركهايمر، جدل التّنوير، ترجمة حنّا عبّود، بيروت، المنظّمة العربيّة للتّرجمة، 2005؛ هربرت ماركوزه، الإنسان ذو البعد الواحد، ترجمة جورج طرابيشيّ، بيروت، دار الآداب، 1988.
[13] انظر: جاك دريدا، الكتابة والاختلاف، ترجمة كمال بو منير، الجزائر، دار الاختلاف، بالتّعاون مع منشورات ضفاف، بيروت، 2012؛ ميشال فوكو، أركيولوجيا المعرفة، ترجمة ماهر فريد، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، سلسلة الفكر المعاصر، 2005؛ جان بودريار، المجتمع الاستهلاكيّ: أساطير وسلوك، ترجمة عبده عبّود وآخرون، بيروت، المنظّمة العربيّة للتّرجمة، 2008.
[14] انظر: رايموند ويليامز: الكلمات المفاتيح: مفردات الثّقافة والمجتمع، ترجمة عبد السّلام بنعبد العالي، الدّار البيضاء، دار توبقال، 2007؛ ستيورات هول، التّمثيل: الثّقافة والتّمثيلات الثّقافيّة، ترجمة سعيد بو كرامي وآخرون، القاهرة، المركز القوميّ للتّرجمة، 2019.
[15] نظريّة الهيمنة عند غرامشي تعني قيادة مجموعة اجتماعيّة مثل الطّبقة الحاكمة، مجموعات أخرى، ليس بالقوّة والإكراه فقط، بل من خلال القيادة الفكريّة والأخلاقيّة والثّقافيّة.