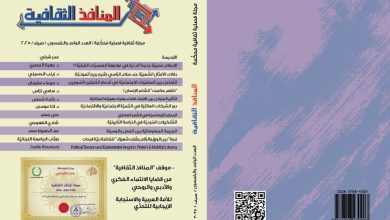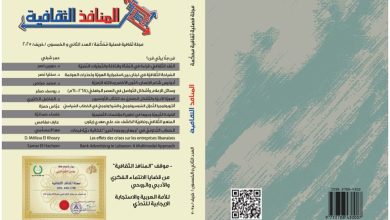الهُويّة الأدبيّة والتّشكّل الحضاريّ عند الكتّاب التّونسيّين
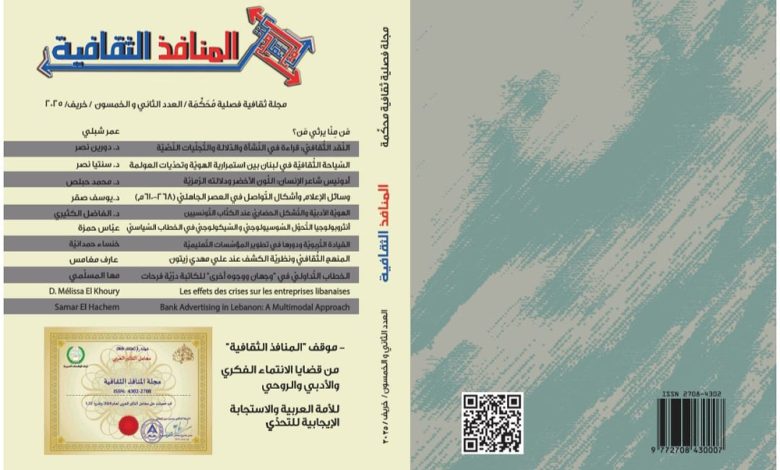
الهُويّة الأدبيّة والتّشكّل الحضاريّ عند الكتّاب التّونسيّين
Literary Identity and Civilizational Formation among Tunisian Writers
د. الفاضل بن حميدة الكثيري[1]
Dr. Fadhel ben hamida kathiri
تاريخ الاستلام3/ 6/ 2025 تاريخ القبول 30/ 6/2025
ملخص
تبحث هذه الدّراسة في مسألة الهُويّة الأدبيّة والفكريّة عند الكتاب التّونسيّين انطلاقًا من المواضيع المطروحة من خلال المكان كوطن، والإقليم كامتداد وانعكاس في الصّراع الثّقافيّ بين الأنا والآخر في علاقة المستعمَر بالمستعمِر من خلال فرض الإرادات أو تثبيت سرديّات تشرعن هذا الواقع.
وفي هذا الإطار تصبح الهُويّة الأدبيّة متغيّرة بتغيّر المجتمع نفسه، وبخاصة إذا نظرنا إلى العمل الرّوائيّ في رصده لتغيّرات المجتمع؛ سواء أكان على مستوى الفرد أو الأسرة أو الوعي المتشظّي في مخيال التّكتّلات الفكريّة؛ والذي يصل في بعض جوانبه إلى حد الصّراع. وهنا تكمن الخطورة في تضييق مساحة الوعي في وطن كان من المفترض أن يتّسع للجميع من دون إقصاء.
إنّ التماس الحضاريّ يواكبه تماس لغويّ وتماس تاريخيّ وتماس سياسيّ، لكنّه لم ينتج صيغة استنهاضيّة، تراعي المرجعيّة التّاريخيّة ؛ وهي تستعيد في كل حدث زمام المبادرة في رسم العلاقة بين الشّرق والغرب، بين الرّجل والمرأة، بين المعرفة والتّقدّم من جهة، وبين الماديّة الوثنيّة والجهل المقدّس من جهة أخرى.
الكلمات المفاتيح: الهُويّة – الفكر الحالم – الانبتات – السّطوة – التماس الحضاريّ – النّسويّة – الاستنهاض – سرديّة الجهل المقدس – المدارس الفلسفيّة.
Abstract
This study examines the issue of literary and intellectual identity among Tunisian writers based on the topics raised through the place as a homeland and the region as an extension and reflection of the cultural conflict between the self and the other in the relationship of the colonized with the colonized through imposing wills or installing narratives that legitimize this reality.
In this context، literary identity becomes variable as society itself changes، especially if we look at the work of fiction in its monitoring of changes in society. Whether it is at the level of the individual، the family، or the fragmented awareness in the imagination of intellectual blocs; Which in some aspects reaches the point of conflict. Here lies the danger in narrowing the space of awareness in a nation that was supposed to accommodate everyone without exclusion.
The civilizational quest is accompanied by a linguistic contact، a historical contact، and a political contact، but it did not produce a rousing formula that takes into account historical reference. In every event، it regains the initiative in drawing the relationship between East and West، between men and women، between knowledge and progress on the one hand، and pagan materialism and sacred ignorance on the other hand.
مقدمة
حملت الظّروف الّتي مرّت بها البلاد العربيّة خطوطًا متداخلة في معظم الأحيان، وثنائيات متعارضة ومتضاربة في كثير من الأحيان ومتساوقة في حين آخر؛ وكأنّ الأمّة العربيّة قد عادت تتململ باحثة عن ذاتها، ساعية إلى حقّها في الحياة. وهذا التّحرّك الجماعيّ الّذي بدأ قبل مجيء الحملة الفرنسيّة، تحوّل إلى شبه حال مرضيّة مع قدوم الغزاة الفرنجة، إذ وقفت على إثره المؤسّسات الدّينيّة شبه رافضة لوجوده، فيما وقفت المؤسّسة الرّسميّة شبه متردّدة به. وبين القبول والرفض نشأت حركات وتيارات فكريّة، بعضها يتقفّى آثار الغرب شبرًا بشبر وذراعًا بذراع ، وبعضها الآخر يبحث عن بديل يعيد به تشكيل ذاته خارج تقليد الآخر الغازي. ولم يتبلور الموقف بشكل جليّ، وبخاصة أنّ الحركات المقاومة لم تكن تملك ما يوازي معدّات المحتلّ الجديد وأساليبه وعلومه، فكانت المعركة شبه مختلة أمام هذه الوضعية. لذلك أصبح اللّجوء إلى الحلّ الرّومنسيّ مثالًا لإرساء قناعة ضبابيّة وفق تعبير رومنسيّ. ولم تكن الرّومنسيّة لها طابع واحد في العالم العربيّ بل شملت عناصر تشكيل المجتمع بما فيها الهُويّة والأدب والنّمط الحضاريّ.
أوّلا: مفهوم الهُويّة
تعدّدت مفاهيم الهُويّة لما في اللّفظة من أوجه احتملت غير دلالة، فمنها الفعل المجرد هوى ومنها ضمير الغائب هو، ومنها الهاوية والهوة، إلا أنّنا سنتتبع ذلك في اللّغة.
أ- الهُويّة في اللّغة
إذا كانت الهُويّة في اللّغة تعني الأرض المنخفضة والبئر البعيدة القعر كما وردت في الشّعر العربيّ (الجاهليّ) على لسان ذرار الشّماخ في بيته الشّعريّ:
” فلمّا رأيت الأمر عرش هُويّة
تسليت حاجات الفؤاد بشمَّرا”[2]
والمعنى فيه تصغير لكلمة “الهوة”، إلا أنّها عند أهل الحقّ تبقى “الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق، اشتمال النّواة على الشّجر”[3].
وإذا كان التّعريف اللّغويّ للهويّة قد حصرها في الانخفاض والغور الّذي يحتاج إلى جهد ذهنيّ وعقليّ لمعرفته، فإنّ موضوعنا يتناول الهُويّة من جانبها الاصطلاحيّ الحديث الّذي يركز على الصّفات المحوريّة لها. فالهُويّة مصطلح متطوّر الدّلالة، لكنّه محصور في بوتقة التّطابق والتّشابه لما هو متماثل الذي يميّز قومًا عن آخرين، لتأخذ ماهيتها من مجموع الصّفات والسّمات والمعتقدات والقيم التي تميّز شخصًا أو مجموعة عن غيرهم، وتشكّل تفرّدهم وإحساسهم بالذّات. هي أيضًا حقيقة الشّيء أو الشّخص التي تميزه عن غيره.”[4] بهذا السّياق الاصطلاحيّ يمكن أن نطلق على مجموعة من متكلمي لغة واحدة “هويّة موحدة”، ولكن هذا التّحديد يظلّ مطّاطًا.
ب. التّعريف المكاني: تبلور التّعريف المكانيّ للهويّة مع كثرة الصّراعات والحروب، فأصبح الصّراع يتحدّد وفق المكان والمحاربين والأحداث، ووفق مقتضيّات السّكان، بعدما تحوّلت القبيلة إلى دولة. فالمكان هنا أخذ مواصفات مالكيه وسكّانه والمتواجدين عليه. مع تطوّر الفارق بينه وبين ديار سلمى عند امرئ القيس.
فمكان الهُويّة هو مكان المقتضى والضّرورة العصريّة بعدما تغير نمط العيش من التّرحال والتّنقل إلى الاستقرار والتّمدن، وهو يعني الامتداد والاتّساع للمحل والفضاء الذي يحيط به بما يحمله من علامات جغرافيّة مرتبطة بتشكيل هويّة المكان، وهويّة الإنسان الذي يعيش عليه. وإنّ أي تغييرات قسريّة (قهريّة) تحدث في المكان من شأنها أن تُحدث انشراخات في الشّفرة العلائقيّة بين الإنسان والمكان، كما حدث مع الشّعب الأندلسيّ ويحدث الآن مع الشّعب الفلسطينيّ.
وقد تحوّل المكان إلى مسرح سرديّ حتّى صار مجالًا من أوسع مجالات الإبداع التي تضفي على الخطاب الرّوائيّ الرّاهن رافدًا من روافد الثّراء والجمال وتحدّد هويّته التّاريخيّة والحضاريّة والثّقافيّة.
ثانيًا: المفهوم الأدبيّ للهويّة: ارتسمت الهُويّة عبر الأدب الذي كتب في المائة سنة الماضية، وتمثّل المنعطف الذي وضع بصماته على ترسيم جغرافيّة الوطن العربيّ من جهة، وشعوبه من جهة أخرى. وما لا شكّ فيه أنّ هذه الهُويّة الأدبيّة عند الكتاّب في تونس لم تخرج في معالجتها لقضايا أصلها من تلك الصّيحات التي أطلقها أدباء المشرق بل وصل الأمر إلى مشاركة نوبات الانفعال في صيحات المشرق والمغرب على حد سواء في الأزمات والاجتياحات وإرهاصات الإخفاق وربما بعض النجاحات. وبما أنّ معظم الأزمات تعمّ عالمنا العربيّ جرّاء وجود الكيان الصّهيونيّ وتبعاته في تشكيل واقعنا كي يضمن استمراره، فإنّ المفهوم الأدبيّ للهويّة قد وسم بحدود معجمه اللّغويّ وشحنته النّفسيّة وزمكانه المضطرب.
- المعجم اللّغويّ: مثل القاموس العربيّ بمفردات البناء اللّفظيّ لهويتنا الحالية، وقد جاءت الحقول التّعبيريّة سجلًا مهمًّا في كشف الانزياحات اللّغويّة كونه دليلًا على انزياح آخر طال شرائح المجتمع، وبخاصة في حقبة ما بعد الحداثة التي تسمّى عولمة عندما سقطت كل جدران الحصانة للدّولة القطريّة. ومن هنا كان اطّلاع أدبائنا على ما أنتجه الآخر جزءًا مهمًّا في الانطلاق بالمنطوق اللّغويّ لتشكيل عالمهم. وهو تحوّل جذريّ في الشّكل والمضمون، بحيث يفتح الأدباء الجدد آفاقًا جديدة للتّعبير عن تجربتهم الشّخصيّة، وتعبيرهم عن قضايا مجتمعيّة وثقافيّة مختلفة. يقول محمد الماغوط الشّاعر السّوريّ:
لن أنهض
حتى تجمع كل قضبان السّجون وإضبارات المشبوهين
في العالم
وتوضع أمامي
لألوكها كالجمل على قارعة الطريق..
حتى تفرَّ كلُّ هراواتِ الشرطة والمتظاهرين
من قبضات أصحابها
وتعود أغصانًا مزهرة (مرةً أخرى)
إذًا القصيدة لا تحتاج إلى كدّ ذهنيّ للوصول إلى مدلولاتها، فتركيبة معجمها دليل صريح على فرضيّات الواقع. ولم يحصل هذا التّحوّل التّعبيريّ لولا التّيارات الفكريّة التي اجتازت الحدود. والأدب هو اطّلاع على المشترك الأساسيّ، بما في ذلك الذي قدّمته مدارس الغرب، وتجاوز حدود أوروبا إلى العالم العربيّ بصورة خاصة، وإلى الشّرق بصورة عامة. فكانت نفحات شكسبير وأليوت، وكانت نفحات المدارس الفلسفيّة والاقتصاديّة واللّغويّة والاجتماعيّة أشدّ وقعًا على الحركات الفكريّة والأدبيّة في عالمنا العربيّ في طروحاتها وتجدّدها الإنسانيّ المطلق، ما جعلها مثار إعجاب الأدباء العرب في هذه البلاد التي يؤمّها ما يقارب عشرة ملايين سائح في السّنة، وهم في تواصل مستمر مع شعبها إلى مختلف العواصم.
ب- الشّحنة النّفسيّة للّغة: مثل الواقع البائس وصراع المقهور مع الحدّ الضّامن للسّلطة والرّقيب في إدارة المجتمعات البارزة التي تصدّرت التّعريف بالمجتمع وتحديد هويته. ومع تغير هوامش القيد والضّبط الاجتماعيّ بدت المواضيع التي تعيشها البلاد مواضيع مشتركة مع النّاس في مختلف القرى الكونيّة، وصار ما يمسّ المتواجدين هناك بشكل دائم أم مؤقت، كما يمسّ الذين يعيشون هنا بشكل مزر. وقد شكّل هذا الوضع نسيجًا جديدًا في العلاقات الإنسانيّة وفي المنظومة الثّقافيّة المعاشة. وهذا ما حمل شحنات نفسيّة تبلورت في صرخات الاحتجاج والحركات الانفعاليّة كونها جزءًا من التّعبير عن الرّفض والشّعور بالخطر المحدّق وبخاصة أنّ الغرب نفسه يعيش الآن عهد التّيه المتشظي وموت القيم في تمفصلات الغرب التّائه والمحتار أصلًا في حضارة التّيه هذه. ومن هنا تكوّن الشّعور بالمسؤولية الكونيّة لمواكبة التّغيرات والثّقافات الوافدة، والخروج من الدّوائر الثّقافيّة المحليّة الضّيقة التي رزحت فيها البلاد حينًا من الزّمن. لكنّ المشكلة التي أصابت المسيرة الأدبيّة في بداياتها هي تعميم المفاهيم التي اتّخذت صيغة قوية عند المغاربة، كما هي عند التّونسيّين؛ مع صالح القرماديّ وعثمان الكعّاك ونور الدّين بن بلقاسم وزهرة الرّياحي والبشير بن سلامة ومحمد مزالي… والملاحظ أنّ واحدًا من هؤلاء لم يفكر في تحديد الحقل الذي يعمل فيه أو يوجهه إلى وظيفة تقنيّة/بنيويّة/ أيديولوجيّة، إذ إنّ عاهة الحديث عن كلّ شيء مرّة واحدة يأخذ مجرى اللّهب عندهم… وحتّى في الجزائر، فإنّ محمد الميلي والطّاهر وطّار، ومصطفى الأشرف يتحدّثون عن الرّواية، لا عن النّوع أو الإشكاليّة التي تعانيها داخل الإطار الإبداعيّ.”[5] والهُويّة عند الكتّاب في تونس لم تخرج عن الأطر المعروفة سياسيًّا في حقبة ما بعد الاستقلال مباشرة، سواء من حيث تكريس النّزعة الوطنيّة وإبراز السّمة المحليّة والعمل على تقديم لهجاتها كونه البديل اللّغويّ المرتقب لهويّة الكيانات الجديدة، وبعثها من جديد، ودعم توجّهات دعائها. وهذا ما زعزع الاستقرار وزاد من دوائر الخوف والتّوتر، وكل ذلك بعد أخطار المؤشرات على هشاشة الدّول النّاشئة حديثًا.
في حين بدا الاتّجاه الواقعيّ الذي راج آنذاك محل إعجاب لمجموعة من الشّبان، بل هو تعبير عن لحظة اجتماعيّة معيّنة ترجمها قلة من الشّباب، وأوجدوا لأوّل مرة في العربيّة أدبًا قصصيًّا جادًا ذا شكل متطوّر، واستطاعوا أن يؤثّروا في الأشكال القصصيّة الرّائجة التي أصبحت تعنى بتصوير البيئة”[6]، ما يمنحها ذلك التّمييز المتعلّق بالهُويّة.
ثالثًا – الهُويّة والمكان بين الوطن والإقليم.
قديمًا نظر ابن سلام الجمحي (676-846) في الخبر إلى أثر البيئة وما يجري فيها؛ “من كثرة الشّعر وقلته في جودته…، والفرق بين البيئات المختلفة، اعتمادًا على ذلك”[7]. ووافقه ابن قتيبة (828-889)، فقال:”نازلة الوبر في الحلول والظّعن على خلاف ما عليه نازلة الحضر”[8]، ثم أرجع ابن طباطبا ذلك إلى استلهام الشّاعر القديم لبيئته، ووصفه ما فيها من أشياء، واتخاذها مادة ألف منها صورة فنية قائلاً:” اعلم أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتها وأدركه عيانها، ومرت به تجاربها… فليس تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفيها،”[9] وقد تطوّرت هذه النّظرة إلى المكان بعد هذه الحقبة وحسب الجنس الأدبيّ.
فالوطن مفهوم جديد حاله حال الهُويّة لذلك كان التّركيز على المكان أحد معالم البناء الرّوائيّ، وكونه جنسًا أدبيًّا جديدًا هو الآخر. فالرّواية تهدينا إلى المكان بقدر ما يمنحنا هويتنا، وهي بقدر ما تكتشفه بقدر ما تكتشف نفسها. إذ ينبهنا عرضها له وحضوره فيبلغ مقامه منها وأثره الفعال فيها ومساهمته الجليلة في بناء علمها. بل إنّ المكان لفاعل فعله حتّى في لغة الأثر. والرّواية تصدر في مزاولتها هذه عن رؤية أيديولوجيّة عامة.”[10] فصار المكان يحدّد بخصوصيته، وصار تصنيفه لا يخضع لمعايير الجهات فحسب، بل ينطلق من زوايا متعدّدة. وقد تكلّم النّقاد عن المكان المتخيّل والمكان الحقيقيّ، كما تكلّموا عن مكان خارجيّ وآخر داخليّ، وجعلوا الأحداث مناسبة لكل تصنيف ملائم للفعل الرّوائيّ انطلاقًا من مكوّناته وفضائه والمتغيّرات التي طرأت عليه. كما صار الحديث عن الأمكنة في أبعادها الزّمنيّة والاجتماعيّة من الأمور التي يحتاط الرّوائيّ في توظيفها ليكسب السّارد أو الرّاوي ذلك العالم الرّوائيّ الذي نسجه. رغم كونه يقدّم عالمًا مزدوج الجوانب، فتارة تراه عالمًا واقعيًّا حقيقيًّا، وأخرى تراه يتّسم بسمات أسطوريّة أو خياليّة تجعل له وجودًا مستقلًا يحاور وجوده الشّخصيّات ويخضعها أحيانًا لنفوذه”[11]، ويفرض عليها تلك السّلطة التي ركبتها مخيلة الشّعوب. أو تفرضها قوى تمثل الحدث الاستعماريّ، سواء كان هذا الحدث عسكريًّا أم اقتصاديًّا ممتدًا الى السّياسة والاجتماع والثّقافة، محدثًا التّميز المرسوم أو محافظًا على سرّ الاحداث بشكل طبيعيّ. وفي مختلف هذه المسافات تكتسب الهُويّة ماهيّتها من تلك السّمة الحدوديّة الفارقة، وربما التّجانس المغاير. إذ لا بد للإنسان من تحديد منزلته بالانطلاق من المكان”[12]، وحتى يتم ذلك، لا بدّ أن يعقد علاقة شخصيّة من المكان، ويعدّه أداة أو موضوعًا أو طرفًا مخاطبًا، ويفهم أنّه ليس كائنًا نكرة. عندئذ يصبح المكان موضوع رغبة ومحل فعل وجدوى”[13] ؛ ومن هنا، تتولّد المشاعر كونها جزءًا من ثقافة المكان نفسه.
وبما أنّ الهُويّة سمة حدوديّة فارقة اتّخذت تصنيفها من مجموع التّفاصيل التي شكّلت معالمها، فإنّ المكان هو أكثرها تمثيلًا لهذه الخصوصية التي يمكن من خلالها أن نطلق عليه” هوية الثّوابت المرجعيّة”. فالأمكنة والأزمنة ليست في سائر الحالات سوى أطر مجردة لها الدّلالة نفسها في بلورة الهُويّة؛ إذ” تقع الإشارة إليها، لأنّها من لوازم الفعل ومتمماته. بل إنّ المكان والزّمان في كثير من الأحيان يسهمان في توجيه الخطاب لما يمكن أن يقترن بهما من شحن عاطفية”[14]، وغالبًا ما يقدّم الكاتب حسب حركة الفعل، وعلى أساسه يصبح المكان أمكنة “ليظهر المعنى الرمزيّ لها”[15]، وقد يولي اهتمامًا أكبر، فيقدّم المكان الدّاخليّ والخارجيّ على حد سواء، باحثًا في تلك الخصوصيّات والعناصر التي تشكّل في مجملها عالم الرّواية، فتؤثّر وتتأثر، وتبني ويبنى عليها ذلك العالم. وتكون تلك الصّور مشاهد روائيّة ترتسم من خلالها عوالم الرّواية وهويتها، ابتداءً من أناس المكان وشوارعه وأبنيته والوسائل الموجودة فيه، مرورًا بكشف ذلك الفضاء الدّاخليّ، وما وجد فيه من أثاث، وهندسة غرف وخبايا لنفوذه”، ويفرض عليها تلك السّلطة التي ركبتها مخيلة الشّعوب، أو تفرضها قوى تمثّل الحدث الاستعماريّ، سواء أكان هذا الحدث عسكريًّا أم اقتصاديًّا ممتدًا إلى السّياسة والاجتماع والثّقافة، محدثًا التّغير المرسوم أو محافظًا على سير الأحداث بشكل طبيعيّ، وفي مختلف هذه المسافات تكتسب الهُويّة ماهيتها من تلك السّمة الحدوديّة الفارقة، وربما التّجانس المغاير. إذ “لابد للإنسان من تحديد منزلته بالانطلاق من المكان،”[16] وحتى يتمّ ذلك، لا بدّ أنّ يعقد علاقة شخصيّة مع المكان، ويعدّه أداة أو موضوعًا أو طرفًا مخاطبًا، ويفهم أنّه ليس كائنا نكرة. عندئذٍ يصبح المكان موضوع رغبة ومحل فعل وجدوى.” ومن هنا، تتولّد المشاعر كونها جزءًا من ثقافة المكان نفسه.
المبحث الثاني: الهُويّة والتّشكّل الحضاريّ
أوّلا- التّشكّل الحضاريّ
الحضارة مصدر لغويّ سماعيّ، والجذر حضر وهو فعل متعلّق بالزّمن والحركة على حد سواء فالحضور الزّمنيّ مرتسم بالفعل البشريّ، والحضاريّ مدلول التّجمع البشريّ يمكن أن يشمل جميع جوانب المجتمع، بما في ذلك الاقتصاد والسّياسة والثّقافة. ويمكن أن يشمل التّطوّر في معدّات العمل واللّباس والبناء وغيره.
أ- التّطوّر البنائيّ: التّطوّر سنة كونيّة في المجتمعات البشريّة، بحيث تتراكم التّجارب والمعارف والإنجازات الماديّة ، وتمنح آفاق جديدة لمقتضيات التجديد فيها ومن ثم تكتسب استمراريتها، لأنّ وقوفها هو الفناء بعينه، وبما أنّ الهُويّة سمة حدوديّة فارقة اتّخذت تصنيفها من مجموع التّفاصيل التي شكّلت معالمها، فإنّ المكان أكثر تمثيلًا لهذه الخصوصيّة التي يمكن من خلاله أن نطلق عليه “هوية الثّوابت المرجعيّة”. فالأمكنة والأزمنة ليست في سائر الحالات سوى أطر مجردة لها الدّلالة نفسها في بلورة الهُويّة؛ إذ “تقع الإشارة إليها، لأنّها من لوازم الفعل ومتمّماته، بل إنّ الزّمان والمكان في كثير من الأحيان يسهمان في توجيه الخطاب لما يمكن أن يقترن بهما من شحن عاطفي[17]، وغالبًا ما يقدم الكاتب حسب حركة الفعل، وعلى أساسه يصبح المكان أمكنة ” ليظهر المعنى الرّمزي لها”، وقد يولي اهتمامًا أكثر، فيقدّم المكان الخارجيّ والدّاخليّ على حد سواء، باحثًا في تلك الخصوصيّات والعناصر التي تشكّل في مجملها عالم الرّواية، فتؤثر وتتأثر، وتبني ويبنى عليها ذلك العالم. وتكون تلك الصور مشاهد روائية ترتسم من خلالها عوالم الرّواية وهيئتها، ابتداء من أناس المكان وشوارعه وأبنيته والوسائل الموجودة فيه، مرورا بكشف ذلك الفضاء الدّاخليّ، وما وجد فيه من أثاث، وهندسة غرف وخبايا وأسرار. هذه العناصر المشكلة في مجملها الهُويّة المكانية هي التي يقع عليها ذلك التأثير العولمي، وبالتالي التغيير المندرج ضمن منظومة معينة. ولعل رصد أثر العولمة على المكان نفسه؛ هو ذلك المكان الافتراضي الذي اقتحم الحدود، وهدم الحواجز وأسقط السواتر التي كانت في يوم ما عائقا أمام الناس ودرعًا تتمترس به السلطات المتعددة. هذا المكان الافتراضي وحده حط رحاله أمام الناس، فصاروا ينظرون إلى العالم على أنه مجرد قرية صغيرة تحتاج إلى تظافر الجهود للمحافظة عليها من الاختلال والعبث والفوضى المستجدة التي فرضها التقدم التقني والتقلبات المالية والأزمات الاقتصادية.
ب- التّشكّل في إطار التحول: في ظلّ التّغيرات المتلاحقة والمعارف المتراكمة والمتسارعة بدأ الفهم الجديد للحضارة يتشكّل في ظل كونيّة العالم أو تحوّل الدّولة القطريّة إلى قرية عولميّة، وهنا بدأت مفاهيم الحدود تفقد تلك السّطوة، وأصبحت قضايا الوطن متماهية في قضايا الإقليم والمحيط والعالم أجمع. وهنا تجاوزت الهُويّة تلك الخصوصية الضّيقة التي تقوقعت فيها لسنين طويلة، وصارت هوية انتماء إنسانيّ وليس انتماء تتحكّم فيه خصوصيّات اللّون والعرق. وفي هذا الإطار، ولتقويم الانزياح الذي يفرضه بعض المنتفعين بالعولمة نحو الأمركة، يصبح الحديث الشريف ” كلكم لآدم وآدم من تراب،” إذ لا فرق بين عربيّ على أعجميّ، ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى، مخرجًا مهمًّا في عملية التّصويب، وكأنّ العمل وحده هو الآلية المثلى للتّواصل مع العالم الآخر. فالتّشكّل لا يتم إلا في إطار مواكبة التّحوّل العلميّ الهائل.
إنّ تأشيرة العبور إلى المجتمع العالميّ لا يجب أن تكون ضحلة، بل يجب أن تحمل معها هي الأخرى ما يمكن أن يكون مؤشر انتماء سواء أكان باللّغة التّعبيريّة أو المساهمة الماديّة لأنّ الأمر لم يعد يخص مجتمعًا دون آخر. بهذه المعطيات انفتح المكان الضّيق على أفق أكثر رحابة، اختلط فيه الواقعيّ بالخيال.
ثانيًا: الأدب والتّشكّل الحضاريّ: لم يكن الأدب بعيدًا من الواقع الحاضر بل مواكبًا إلى حدّ ما، وربما كانت تعبيراته لا تصرح بذلك مباشرة لكنّها يلمح أو يلوي عنق الواقع بالتّأويل كما هو الحال عند درويش في رواية الدّراويش يعودون من المنفى” فالتّحوّل في إطار المكان على صعيد القرية، تحكمه رؤية غير عقليّة هي مزيج من الرّؤية الدّينيّة والخيال الأسطوريّ، لذلك فالقرية الفلانيّة تتجاوز الـ”هنا” كونها قريّة من قرى الرّيف التّونسيّ أو منطقة من المناطق التّونسيّة إلى كونها فضاء مأنوسًا منذ ما قبل التّاريخ، منفتح على الحاضر، لذلك لم يجد فرنسوا مارتال ذلك العناء الشّديد في العمل وفق معطيات المكان، يصلي…يحضر الجنائز…يقابل الناس…يقيم السّهرات لكنّه في الآن نفسه يتابع درويش في كل تفاصيل حركاته ويحمّله أكل الخليقة منذ البدء.
المبحث الثالث: المقاربات المكانية عند الأدباء الجدد
تبدو مقاربة الأمكنة فيها الكثير من التّعنّت في قراءة النّصوص لأنّ كلّ نصّ له خصوصيته، بحيث تتشظّى مميزات الهُويّة في تلك المقاربات المكانيّة.
أولا: المقاربة في الرّوايات الحديثة
تبدو المقاربة من خلال اللّغة والمحتوى أمرًا دلاليًّا في تعرية الواقع من خلال الشّخصيّات والفعل والأمكنة والتّطلعات والقضايا. ففي رواية “حفر دافئة”، يصبح فعل الرّحيل مكاشفة صريحة لنواقص المكان. فحمودة يرحل لأنّه لم ينجب أولادًا في ذلك المكان الذي يعيش فيه في ضيعته في تونس. وعادل الطّالبي يغادر المكان، لأنّه لم يقبل في الاختصاص الذي يريده في جامعة بلده. حتى سعادة تلك الممرضة الجميلة ضاق بها المكان فغادرته، وتعيش عيشة الغربة، فتشرّع جسدها لمن يشتهيه، ويتساوى في ذلك الإيطاليّ والفرنسيّ والعربيّ لتتحوّل إلى ناشطة في جمعية نسائيّة في باريس وتقضي العمر تسكّعًا في شوارعها.
أمّاعند أمل مختار، فقد كفّ “المكان عن أن يكون مادة ليصبح حركة علاقات بالأشياء والناس معا؛ “لكن المشكلة أن الأشخاص أنفسهم تاهوا؛ فمن يختار المكان إنما السرب الذي ضلوه فضاعوا، وضاعت عنهم الجماعة وأمن الانتماء إلى السّرب الذي يحفظون به اختلافهم[18] عن الآخرين، ولم يعد أمامهم سوى العودة من جديد.
ولا شكّ أنّ الرّواية تصدر في مزاولتها هذه للمكان عن رؤية أيديولوجيّة عامة تجد فيها شتى مظاهر الفضاء؛ وإن تعددت وتباينت مناط تجانسها وترابطها”[19]، كما أنّ حصر التّاريخ في معانيه القديمة وعدم الانتباه إلى حركة التّغيير والالتزام بقواعد سننه كفيل بإلغاء فهم للمستقبل وما يتطلبه من آليات تتماشى مع الواقع المستجد بكل تعقيداته.
ولا يلبث المكان نفسه أن يتحول إلى مختبر للتجارب وتعريات تلك الممارسات التي لم تعد فاعلة في مجتمع صار الكثير منه متأثرا بما يأتيه عبر الشاشات، ووسائل الإعلام. ففي رواية” صحري بحري” لعمر بن سالم، تنقلب الصور ويصبح كل شيء في تغير مستمر إذ أنك لا تدرك أن الهفوف شيخ في الصباح يعلم الفقه في جامع وعلانية في ظل وضع يصعب حتّى على غير المتزوجين ادراك إذا كان هو نفسه متزوج وله أبناء”[20]. ولعل هذا الأمر هو السمة المشتركة في الروايات التّونسيّة، من حيث اختلاف الموضوع والانتماء السياسيّ. فمعظم الروايات اتخذ صيغة الحكاية الرّوائيّة المندرجة في سياق السرد العربيّ القديم الجامع بين التراث الشعبي وفن المقامات. لكن الاختلاف كامن في ذلك الانغماس الهائل في مواضيع كانت سابقا من المحرمات؛ إذ يمثل الجنس والشذوذ عصب النص المكاني والعنصر المحرك للنص نفسه في إطار عملية نقد الواقع من بابه الخلفي المغرق في العقم والأزمات. وفي الحقيقة إنّ هذه النّصوص جاءت كشفا لمرحلة اعتبرها البعض حداثة المجتمع، وعدها آخرون مرحلة السقوط والانهيار الخلقي. لأنّ المكان في الأساس هو رمز ومرجعية لذلك التجذر المتعلق ” بلارض، أرض الأجداد، والإخلاص لها وفاء لهم وأمانة على وجاهة السّلالة وجدارتها،”[21] والسكوت عن ذلك هو الخيانة التي لا تغتفر. فالتغير الذي أولي هذه العناية هو بمثابة إعادة رسم معالم الهُويّة في ظل المتغيرات، وكل المسألة هي بالتّحديد رصد عملية الإفلات من ملامح الهُويّة في أطوار متعددة. ونظرًا لذلك التّشابه الزّاحف، فإنّ التّأكيد على السّمة الخاصة الّتي تتّسم بها كل قرية في أي بلد آخر من بلدان العالم هو نتيجة طبيعية للعمل الرّوائيّ وتمايزاته، إذ لكل مكان سمة ما، وإن تشابهت أو طغت عليها الجوانب الماديّة التي كرّستها العولمة المندرجة ضمن ثقافة المكان، ضمن إنتاج الحدث من المرجعية التّاريخيّة التي غالبا ما يكون التراث أحد أهم معالمها. ويبقى التجاذب السياسيّ هو المحرك الأساس للتعبير، وصبغه بألوان تتماشى مع سطوته.
إلاّ أنّ انعكاس هذا الأمر يتّضح بجلاء في فضاءات المكان نفسه، إذ أنّه يعد المؤشّر الأساس في تبيان ذلك المؤثّر في إحداث التّغيرات التي تشكّل تلك المقاربة بين هوية سابقة وهوية في طور التّشكّل؛ سواء على مستوى جماليّة المكان أو على مستوى الأماكن المغلقة (العمران) في ثنائية مقارنة بين مكانين وحضارتين وثقافتين. ففي ” وردة السّراب: تقوم المقابلة بين الشّرق والغرب، من خلال المقارنة بين مدينة عربيّة في السّعودية و مدينة أوروبية، فالأولى لم ترقَ إلى مستوى القرية الحديثة ، في حين أنّ الثانية تقدّمت مكتملة المعالم والمرافق والبنى. فالحديث عن باريس وضواحيها التي تمدّنت منذ مئات السّنين، و”انتصبت…شامخة بنهرها وتاريخها الحافل، معارك ثورات والكومونة وماي… وقصورها ومتاحفها وورودها وحدائق العشق.”[22] هو حديث الفوارق السّحيقة بين باريس نفسها ومدننا التي عشعش فيها الخراب، وكأن المسألة في هذه الرّواية لم تخرج من ثنائية البداوة والمدنية، فمقابل أم الدّوم القرية السعودية النائية تنتصب باريس عاصمة الثّقافة الأوروبية، ثم تواصل الرّواية الوصف لأم الدوم التي تنقلب بين حرّ الهاجرة وقر الشتاء، قرية صامتة تشبه المنفى إلى حدّ ما.
وتستمر لعبة المكان في السّرد الرّوائيّ التّونسيّ في توصيف محمل بالكثير من الدلالات، ففي رواية “ارتباك الحواس”، لم يكن المكان سوى محطّات ومسرح لفعل عابر في حياة كل من أمين الزّحلاوي وشامة دباس الكراولي وماتيوس، وجورج ورضوان الجربي صاحب السّفن. فإذا نظرنا إلى كلّ منهم نجد أن طبيعة العمل والحياة الشّخصيّة هي في واقع الأمر غير مستقرة، لذلك جاء الجميع غير متجذّر في المكان، منقطع عن الأولاد والهويّات والانتماء؛ إنّهم باختصار أناس تائهون. تقطّعت بهم السّبل والارتباطات وأجبرتهم الظّروف على ترك المقرّات الأساس لهم، “جاء إلى المدينة أناس كثيرون هربًا من الموت والنّار، عرب وإفرنج ويهود وغيرهم”[23]. وبهذه النّقلة في تحديد المكان يمكن القول إن الهُويّة والمكان مسألتان على غاية من الأهمية في توضيح الانتماء ومعالجة المشكلات التي تدور حولها الرّواية نفسها. وفي رواية “توقيت البنكا”، تتعدّد الأمكنة بتعدد الحراك السّلوكيّ للشّخصيّات وبآليات تعبيراتها عن مواقفها. فالمكان في هذه الرّواية هو مكانان بحيث يقوم في الأوّل عالم المظالم والفساد، في حين يقوم الثّاني على العدميّة كسابقة وهوية في طور التّشكّل، سواء ظهر ذلك على مستوى جمالية المكان أو على مستوى الأماكن المغلقة (العمران) في ثنائية مقارنة بين مكانين وحضارتين وثقافتين.
فالمكان في هذه الرّواية هو مكانان، بحيث يقوم في الأول عالم المظالم والفساد، في حين يقوم الثّاني على العدميّة والتّيه هو ما عبر عنه الأب المسافر” الحياة لا تطاق… المختار طلب الرّشوة واضحة وصريحة كي يسلمني ورقة تقول لمن يهمه الأمر إنّني ولدت هنا.. شرطي البصمات صديق الطفولة…قال لي عد غدًا…بعد أسبوع قال ماكش مش تشربنا قهوة.. ماكش ماش تشربنا قازوزة… موظف الجوازات يريد نومرو حتى يبني بيتًا… بعد شهرين تمكنت من تجديد جواز السفر”[24]، إلا أن معاناة المكان في الغرب تظهر من جانب آخر؛ وكما قال الأب” عرفت باريس من بوابتها الخلفية… كان ما بدأت به عالمًا سفليًا فعلا بقايا يسار تطن في الشوارع… عرفت الطالب… عرفت العامل الذي طنّ حوله اليسار”، ليصدح في النهاية بالنتيجة المرة التي ربما يعانيها آلاف العمال والمهاجرون في تلك الديار ” اللي ضيع بلاده… تضيعه بلاد الناس… رخيص دمك في بلادك… ورخيص في بلاد الناس،” هكذا هي الصّورة المختلفة التي لم تر في المكان سوى المعاناة أو منزلة بين نارين عند روائيّ عاش مدّة غير قصيرة متنقلًا بين البلاد العربيّة والغربيّة، لتكون هذه الرّواية أقرب إلى السّيرة منها إلى الرّواية.
أمّا في رواية “تماس” فالأمر يعالج مسألة أخرى لا تقلّ أهمية عن ذلك الفضاء الذي أثار الكثير من بؤر التّوتر لبلورة فعل الشّخصيّات نفسها، وقد جاء المكان هنا محليًّا بامتياز، حيث تتجلّى من خلاله تلك الطّقوس والعواطف والانفعالات “وحركات تتنافى وتتوالد من بعضها البعض لا تستقر ولا تهدأ ولا تستكين”[25]، وغيرها من الكواشف التي تعدّ بحق سمة الهُويّة وأحد أهم مؤشراتها.
إلاّ أن السّمة العامة تظهر الجانب الذي يمكن أن يكون موضحًا لتلك الهوة، لأنّ الفضاء المكانيّ يتسّم مكانه بأنّه معاد، تبدو علاقة الشّخصيّات به علاقة قدرية يصعب الفكاك منها.”[26]
وإذا كان المكان الغربيّ في بعض الرّوايات يثير الدّهشة والإعجاب، ويستحوذ على الكثير من الاهتمام، فإنّه في “زهرة الصّبار” لعلياء التّابعي يفقد هذه الهالة، ويتقدّم هو الآخر مخاوٍ من ذلك البريق وخاليًا من الحيوية والحياة، ماذا بقي لي في لندن؟ ضباب كثيف… جو من الخراب والحزن القابض.. وتاكسيات سوداء تنزلق على الثّلج الملوث بالوحل.”[27]
في هذه النّقلة يتراءى الوجه الآخر للمكان عند الكتاب اليساريين في تونس، حيث يصبح هذا الحفر جزءًا من البحث عن التموقع في خيبة المثقفين في هذا البلد الذي لم يستطع أحد ان يتموقع فيه بشكل مثمر دون أن تلفظه تربته، وكأن الكتابة هنا، هي إعادة حفظ لتلك المسيرة التي مرت بها النخب في بلد هو اقرب الى العناية الفائقة منه الى الانطلاق في الاتّجاه الصحيح، وعلى حد تعبير أحدهم الإقلاع عكس الزمن، اذ لا تنبت جذور في سماء لا هويّة لها.
ثانيا– الصّراع بين الأنا والآخر في علاقة المستعمَر بالمستعمِر
مثّل الأنا الشّرقي معضلة للآخر الغربيّ في العديد من المراحل سواء في مرحلة قوته أو ضعفه، وفي مختلف الحالتين كان تعبير المستعمِر والمستعمَر دليلًا على اختلال التّوازنات بين الأنا والآخر من حيث القوّة والقدرة.
أ- صراع الإرادات: تجلّى الصّراع بين المستعمر والمستعمر بوضوح في حقبة الاحتلال المباشر، ثم ما لبث أن توارى وراءه بين شعوب أخرى؛ منها الثّقافيّة، ومنها الاقتصاديّة، ومنها التّقنيّة. وتحوّل الصّراع إلى حال من التّوتر النّفسيّ بعدما خفّت حدّة المواجهات العسكريّة، وعجزت فرنسا عن تحقيق مشروعها الاستيطانيّ في الجزائر، كما عجزت بريطانيا ودول أخرى في المشرق العربيّ.
لكن هذا الأمر سرعان ما عاد الى الواجهة في تلاوين خطوط التّماس بين الأنا والآخر في عملية التّدافع المستمر منذ عقود، اذ شكّلت القوة العلميّة الغربيّة غلبة المستعمِر (بكسر الميم) وفتحت أمامه آفاق السّيطرة شبه المطلقة على كثير من بقاع العالم، ما جعله لم يقتصر على جغرافيا معينة منذ خروجه من أوروبا وانتشاره في شمال آسيا والأمريكيتين وأستراليا ليحيط بالعالم القديم من كل الجهات، وليحول سيرورة التاريخ الحديث كله إلى ما يشبه مشروع غربنة للعالم”[28]، بهذا التّوجه، وبهذه الأفكار كان دعاة الامتياز الاستثنائيّ للثّقافة الغربيّة يؤكدون أنّ الحداثة اليوم شيئان مترابطان: اقتصاد السّوق والدّيمقراطيّة، وإنّه ما كان لهما أن يكونا ممكنين خارج الثّقافة الغربيّة”[29]. وقد كان “ماكس فيبر” ومن بعده “فوكاياما” من بين اولئك الذين مازالوا يدافعون عن حضارة الغرب بشكل استعلائيّ، ويستثني حضارات المجتمعات الأخرى.
إنّ تعدّد مظاهر التّدافع الغربيّ العربيّ على مستويات مختلفة لا يمثل سباقًا تاريخيًّا وحسب، بل يجعل من تلك العلاقة توترًا مستمرًا. فنحن نعيش على ما استقر في الأذهان من الخطابات السّائدة في المجال التّداوليّ العربيّ منذ بدايات القرن الماضي الى اليوم بخصوص هذا الآخر الحضاريّ الذي يمثّل التّقدّم والحداثة والتّقنيّة مثلما يجسّد القوّة والغلبة والسّيطرة. إذ يحاول فرض لغاته وأفكاره وقيمه ومصالحه على الذّات العربيّة الإسلاميّة، وعلى غيرها من الذّوات الحضاريّة على نطاق أرضيّ وربما قضائيّ في ظلّ هذا التّوهج العلميّ المتزايد. إذ كان خير الدّين التّونسيّ وجيله من روّاد عصر النّهضة الشّوام والمصريين، اكتشفوا أن صورة الغرب البعيدة والخارجيّة غير دقيقة بل وقد تكون خدّاعة، ربما لا! فالأمر يتعلّق بحضارة تنتشر كالطّوفان الذي لا منجاة من خطر الماحق إلا بالسّير في تياره،”[30] كما عبّر عن ذلك “التّونسيّ” محاولًا بهذه الصّورة الواقعيّة في أن واحد تنبيه ذوي العقد من أولي الأمر والعامة لإرشادهم إلى أقوم المسالك للنّجاة من هذا الخطر. إلاّ أنّ المعضلة في هذه الحقبة برزت في إدارة الصّراع، فأخذت من خلاله مفهومًا آخر، وطالت مظاهر أخرى، لأنّ هناك من يعاين الغرب كعدو وخصم حضاريّ لا بد من رفضه ومقاومته بكل الوسائل. في قربه وحضوره، في بعده وغيابه”[31]، وبخاصة ان هناك من ينظر الى التّغيرات الجديدة، أو ما اصطلح عليه بالعولمة فهي انقلاب خطير على هويات الشّعوب،لأنها جعلت العالم خاضعا لمنطق القوة والواحدة عبر تعميم ثقافة الخوف وسيادة الرّعب، أما مرتكزاتها فهي القوة العسكريّة المتفوقة، والفكر الاستراتيجيّ الهادف الى الهيمنة والسّيطرة والغلبة”[32]، ضمن أحادية قطبيّة كرست مفاهيم الرفض وخلقت قوى ممانعة شديدة، رغم تبرير هذه الهيمنة على انها غير خطيرة… وأن أمريكا القوة العظمى غير استعماريّة”[33]. ولعلّ أنموذج القاعدة هو بداية هذا التّوجه الذي عرّى كل الأقنعة، ووسّع تلك التّناقضات عند المحافظين الجدد، رغم وجود فريق آخر ينتهج الاعتدال والوسطيّة، مطوّرًا خطاب الموافقات العريق في نصوصه يقيس حاضرها على ماضيها المثالي باستمرار”[34]. في المقابل نجد الغرب نفسه يعتمد على مسائل تقوي من شوكته وفي مقدمتها المسألة القومية بشكل لافت. وهذا ما لفت إليه محمد علي اليوسفي في روايته، حيث أرجعها إلى العمق التّاريخيّ. إذ جاء على لسان أحد أبطاله في تعبيره عن هذا التّغير المتغلغل الذي طال معظم هويتنا بعدما امتد “من أدينكيز” إلى السّاحل اللازورجي” الكوت دازور”. “قوميتهم، يا ولد نفيسة، امتدت اليد منا ولغتنا وعمودنا الفقري”[35]، بعدما استطاع هذا الآخر أن يحطّم النّظام الاقتصاديّ الدّاخليّ للمجتمع الرّيفيّ الذي كان يتم دورته من دون أن يستفيد الأجنبيّ من حركته الاقتصاديّة، فضلًا عن حركته الثّقافيّة واللّغويّة التي كانت تمثّل دورًا فولاذيًّا يصعب تحطيمه أو إذابته. ووجدت القوى الاستعماريّة الغربيّة صعوبات جمّة في إدخال المناطق ذات البنيّة القبائليّة والعائليّة والمغلقة إلى نسيجها الاقتصاديّ والثّقافيّ”[36]، في حين استطاعت أن تفرض على المجتمع المدنيّ ذلك الإيقاع التّغييريّ المباشر.
وهنا تظهر القيمة الفعليّة لتلك العلاقة ومدى خطورتها في بلورة المشروع القادم في مجموع التّحوّلات الاندماجيّة، وان كانت بوادره الاقتصاديّة هي أوّل الغيث. إن مسألة العلاقة بين الأنا والآخر غير محدّدة؛ بل غير ثابتة؛ وهي في الأساس تخضع لكثير من المعايير، ورواسب الصّراع في جوانب كثيرة منه، تحوّلت إلى خوف مستمر من اللّقاء نفسه بين أبناء العرب من جهة وأبناء أوروبا والدّول المستعمرة خاصة من جهة أخرى. إذ إنّ نظرة استعلاء التي بثّها الاحتلال اللاتينيّ مازالت تتربّع على تلك الرّؤية الدّونيّة بعدما انتقلت من الفعل الاحتلاليّ العسكريّ إلى الفعل الثّقافيّ والتّصوّرات الفكريّة. وبقدر ما جسّد خطاب “مرزاق” العامل الجزائريّ هذا المنحى بقدر ما بيّن هذه الهوة بين عقليتين ومزاجين، كما هو واضح في هذا المسرد النّصيّ” خاطبه رئيس الحضيرة في تعال هذه بلادنا إن لم يعجبكم الحال، فاقصدوا أبناء عمومتكم لتروا طيب المعالمة”[37]. وبهذه الإشارة يتعرّى الجانب المسكوت عنه في استمرار التعامل الدوني، وذلك أن مرزاق نفسه يكشف الهوة التّاريخيّة في علاقة تحكمها صراعات المصالح والاستغلال؛ “كنتم سبب خرابنا باستعماركم لبلادنا، مدعين أنّكم جئتم لتمديننا، فنهبتم منابع الخير عندنا ، تحمّلوا وزر استعماركم لنا ثم لا تنسوا دورنا في بناء اقتصادكم بعد الحرب.. كلما مررتم بأزمة حمّلتمونا مسؤوليتها”[38] ، ولا تشفع وجهة المغاربة نحو الغرب حتى عند أشقائهم العرب أنفسهم، فهم بالنسبة اليهم”فرنكفونيين لا يحذقون العربيّة بسبب الاستعمار”[39]. وإذا كانت الشواهد الأولى تعبّر عن تلك الأزمة في العلاقة بين العرب والأوروبيين، فإنّ المسألة الثانية تكشف عن الأزمة التي يعيشها العرب في شقي الوطن العربيّ.
ولا شك أنّ مسألة الصّراع في الرّواية التّونسيّة وبخاصة المكتوبة بالفرنسيّة تأخذ أبعادًا أخرى تجاوزت مسألة الاستعمار إلى مسائل أخرى باتت اليوم مصدر قلق للأوروبيين أنفسهم. ولقد انبثق عن هذه الحال ذلك الشّعور العنصريّ البغيض الذي راح يقض مضاجع أوروبا طولًا وعرضًا ناهيك عن العديد من المسائل التي استعملها الآخر الغربيّ لاستمراره في استنفاذ هذا العربيّ القادم إلى أوروبا في مهمّات لا يمكن لأوروبيّ أن يقوم بها. ولعلّ هذا التّعامل لم يكن من السّهولة الاستغناء عنه عند الفرنسيّ نفسه. ف “فرنسوا مارتان “في الدّراويش يعودون إلى المنفى؛ يعود إلى تلك الأرض التي غادرها أباؤه المستعمرون ليعيد صياغة احتلال جديد وبلورة نزاعات ظنّ بعض العرب أنّها رحلت منذ زمن.
ثالثًا– الصّراع في عالم الرّواية
لم تكن الرّواية بعيدة عن تلك العلاقة بين الأنا والآخر في إطار ذلك الكم الهائل من الثّنائيات المشكلة لحال الصّراع أحيانًا وحال التّناقض أحيانًا أخرى، وربما حال اللّقاء الّنفعيّ والبراغماتيّ حينًا ثالثًا. فالإمساك بطرفي المعادلة شكّل محور الفكرة الّتي طرحت منذ بداية القرن العشرين، ومازالت مستمرة الى يومنا هذا؛ لكن بصورة الواقع المغاير لما كانت عليه في أوّل لقاء ثقافيّ أو ما يمكن أن يسمّى (اقتباس المعرفة) جعلت إمكانية اللّقاء مريبة.
فمنذ البداية شكل الدّخول الغربيّ العنيف إلى الشّرق صدمة قويّة في الذّهن الشّرقيّ، وجعله يعيد حساباته حول ذاته من جهة، وحول إمكانياته من جهة أخرى؛ إنّ هذا الوجود ذاته هو الذي كان عامل التحام فيه الكثير من العنف، فرفع من خلاله الغشاوة عن تلك الصورة الضبابية عن كلا الطرفين، والتي تشكلت عبر حقبة طويلة من الصراع، كما نسجته مخيلة كل من الغربيّ والعربيّ على حد سواء. إذ شكلت الصور المتخيلة مرجعية الكتاب في الغرب قبل نظرائهم من العرب. وكان عامل التحام، فرفع من خلاله الغشاوة عن تلك الصورة الضبابية عن كلا الطرفين، والتي تشكلت عبر حقبة طويلة من الصراع وما نسجته مخيلة كل من الغربيّ والعربيّ على حد سواء.
إذ شكّلت الصور المتخيلة مرجعية الكتّاب في الغرب قبل نظرائهم من العرب؛ إلاّ أنّ هذا الأمر صار مختلفا في النّصف الثّاني من القرن العشرين، ذلك أنّ الاحتلال الفعليّ الغربيّ وما أنتجه من أفكار وتركه من آثار ولّد رغبة من نوع آخر للإنسان العربيّ في القدوم إلى الغرب لنسج الصورة الحقيقية له من جانب، ولوصول الأرض الغربيّة بشكل فردي وشخصي مختلف عما سبقه جانب آخر. فالجماعة العربيّة عجزت في مشروعها العسكري سواء بالتصدي للآخر أو غزوه، وبقي هاجس الماضي مجرد الحلم يراود بعض الأشخاص، وبقي تداعي الذّكريات لإعادة الاعتبار للفتح العربيّ الذي قاده موسى ابن نصير، وطارق بن زياد كانت فعليًا نافذة شوق لذلك الحلم.
أمام ماضٍ عتيد وواقعٍ مأزوم، قاد محسن في “عصفور من الشّرق”، ومصطفى سعيد في (موسم الهجرة الى الشمال) غزوًا معنويًّا عبر العمل الرّوائيّ. وقد كان لهذا الالتباس في التّصوّر نشوء تيه في بوتقة العمل غير المستند إلى الوعي الحضاريّ، ثُمّ ما لبث أن أتمّه حبيب السّالمي ومحمود طرشونة، والعروسي المطوي وصلاح الدين بوجاه وأمل مختار وآخرون في كثير من إنتاجاتهم الإبداعية. وبدا الانتقال من المفعوليّة إلى الفاعليّة العامل المهم في ردّ الاعتبارات الشّخصيّة لأبطال الرّوايات عبر ردود أفعال مستهجنة لا تنمّ سوى عن مركّب النّقص عندهم، في ظلّ تلك الانهيارات التي ترنح فيها الشّرق أمام سطوة الغرب وجبروته.
وإذا كان اللّقاء بالغرب قد اصبح أكثر يسرًا، وتخطى الكثير من الصّعوبات والخوف في هذا الاحتكاك المتواصل بين الشّرق والغرب، إلا أنّ هذا التّواصل لم يصل إلى درجة الطمأنينة التي حلم بها الكثير من الشّخصيّات الرّوائيّة. ففي زهرة الصّبا، قدمت علياء التّابعي مسألة الصّراع في بعده النّفسيّ والتّاريخيّ الذي وقف عائقًا أمام هذا اللّقاء؛ فأحمد، رغم ذلك الإغراء الذي وجده في فرنسا وارتقائه إلى منصب كاتب دولة في حركة الاشتراكيين الذي أمّن له مقامًا اجتماعيًا رفيعًا ودخلًا كبيرًا وعلاقات مهنية وأسرية لها وزنها ورأيها في أي قرار من هذا النوع”[40]، بل إنّ هذه المغريات والارتباطات التي لم يحصل عليها لو بقي في بلاده لم تمنعه من ذلك الامتلاء إلى حدّ العدوانية والكفر بالكآبة والوحدة وشعور التفاهة[41]، رغم زواجه وإنجابه. وتزداد الصورة تجليًا لاستحالة التواصل عندما ننظر إلى زوجته (آنّا)؛ تلك المرأة الفرنسيّة، فهي كما قال: تحدث الشّرخ ولا تتحدث عنه.. ورفضت العودة ثانية إلى تونس، وجاء كريم فرفضت أن يتعلم العربيّة[42]. وما لا شك فيه أن الصورة تزداد وضوحًا في سبر الأعماق عندما ندرك أَن “آنّا” كانت تخشى الفرنسية التي تتقنها في المقابل كان أحمد يخشى الدارجة التي تفضلها وتفرقع على لسانها[43].
إنّ التّركيز على هذه العلاقة المتوترة لم يكن عفويًا بقدر ما هو إبراز لمسألة الصّراع الجديد،
رغم تلك الارتباطات المتعددة المآرب والغايات. فالبريطاني العجوز يتحدّث منتفخ الصّدر والأوداج. مازال يتحدث عن البنغال والسودان بخوذة بيضاء وتبان كاكي، ليكون الاستحضار نفسه في الضفة الشّرقية، إذ يقول البطل نفسه :”كنت قد تركت في وطني ملايين مثله ما زالوا يحلمون بليالي اشبيلية وقرطبة ويربتون على كتف التاريخ يسترضونه”[44]، هكذا كانت رواسب الماضي وشوائب الحاضر تدفع الجميع للاستمرار في ذلك التّنافر المبالغ فيه لذلك فبناء العلاقة في الأساس لم يكن ينذر إلا بمثل هذا البتر، لأنّه بُنيَ في الأساس على فتور تجسّد في بدايات حالة قسريّة من الهجرات، حتّم هذا الرّباط أو ذلك، بحيث تقدّمت المصالح في غياب القناعات وبدا الجميع يتصرف آنيا حتى إذا ما فتر الأوان عاد الوضع الى نصابه وعادت ترسبات الثّقافة والتاريخ والمزاج وخلفيات القوة والضعف لتفرض نفسها وتهدم ما كان قد حصل في لحظة الكمون. وهذا ما قاله أحمد عندما تحدث عنها: “لم أكن أحبها.. ولم أكن أكرهها.. كنت محطم الاعصاب، متعبًا فوافقت عندما عرضت علي الزواج بعدها دخلت مكتب المحاماة”[45]. في ظل هذه الاجواء قدّم الأدباء صورة التواصل مع الغرب ليكون اللّقاء جزءًا من تتمّة الصراع الذي عجز أبطاله عن إنهائه حتى لو كان الزواج والإنجاب.
رابعًا: التماس الحضاريّ
ارتبط التّماس الحضاريّ بين الغرب والعرب بهواجس الخوف وبحالة صراع وتدافع مريب، ولم يستطع إلى يومنا هذا أن يفسح في المجال لحال أخرى من التلاقي. فرغم أن هذا التّماس الحضاريّ يواكبه تماس لغويّ وتماس تاريخيّ، فإن المرجيعة التّاريخيّة تستعيد في كل حدث زمام المبادرة في رسم العلاقة بين الشّرق والغرب، ويمثل الإطار الزّمانيّ الذي دارت فيه الأحداث، خلفية ظريفة مؤقتة، كما هو شأن حرب الخليج وما تركته من شعور بالعجز في نفوس العديد من الشّخصيّات الرّوائيّة التي تتّصف هي الأخرى بالعجز واليأس من تغيير حالتها الذّاتيّة ولعلّ هذا التّشابه هو الخيط الرّابط بين أحداث الرّواية وخلفيتها التّاريخيّة”[46] ، وكان بالإمكان اعتبار كلّ ذلك استعارة كبرى موازية للدّمار النّفسيّ الذي أحدثته الموجبات الهجوميّة الغربيّة على بلاد العرب من الخليج الى المحيط، والواقع الذي تفرضه هذه القوى على أمتنا واستغلالها خيراتنا مقابل عجز الأمّة عن التّصدّي لهذا العدوان وفهم دوافعه، إلاّ أنّ الرّبط لا يخلو من تصنع وقلب وتغيير المعادلات الّتي فرضها المحافظون الجدد؛ إذ أنّهم يرون أنّ الحرب ليست نتيجة سوء تفاهم أو عيب في التّواصل، أو قصر في النّظر، بل هي مترسخة في الطّبيعة البشريّة والمصلحة الخاصة والحرب من أجل الثّروة والأمن والسّلطة”[47].
وما لا شكّ فيه أن هذه الصّورة نفسها نقلت بأسلوب آخر عند الصّافي سعيد الذي أبرزها من خلال الحوار الذي دار بين “سميرة نوف” الفرنسيّة “جوليانو” التّاجر اليهوديّ. وهنا تتّسع الهوة؛ فرغم اختلاف طرائق التّعبير والانفعال، فإن البعد الدّلاليّ يوحي برفض الآخر. ففي ردّ واضح على مسألة اليهود، يقول الأبّ جوليانو:”فنحن نبارك أعمالهم المجيدة والقذرة على حد سواء.. وبرأيي، فإذا كان اليهود يبيعون التّوابيت، فنحن نبيع الموت منذ قرون.”[48] في هذا السياق تتكشف الحال من خلال رؤية نقدية تعرّي تفاعل مشاعر النّفور؛ اذ ليس من المقنع ان تدخل دول أخرى لتحررها كما حدث في العراق، وإنما المسألة أعمق وأدق. ولعلّ روائيًا مثل الصّافي سعيد لم يكلّ عن متابعة هذه التفاصيل من خلال حركة المد والجزر بين الشّرق والغرب وحركة الموت هنا وهناك، فهو بملاحقته التّجار والشركات والأموال والأشخاص يكشف رحلة الصّراع الحاد بين نماذج مختلفة هي في الأساس نماذج واقعية تجسّد مجريات الأحداث في الواقع العالمي المعاش. ومع ذلك، هناك جوانب أخرى مهمة في الرّواية التّونسيّة، حين تصدرت المرأة العمل الاجتماعيّ، وأسهمت في العمل الوظيفيّ بشكل فاعل داخل مؤسّسات الدّولة نفسها، بعد ذلك الجهد في التّحصيل العلميّ وفرض وجودها على مقاعد الدّراسة في مختلف المؤسّسات التّعليميّة.
وقد أفردت حركة المرأة التّونسيّة حيزًا مُهمًّا في بلورة مشروع التّعبير الّذي طرأ على حياتها، والرّواية التّونسيّة في هذا السّياق انتقلت بأنثاها من حال المحافظة على كينونتها وتملكها إلى تلك الحال من الضّياع على مستوى الذّات نفسها، لتمحو ذلك النّيّة الفرديّة أو البحث عن الذّات – كما يحلو للبعض تسميته- نوعًا آخر من التّموقع والوجود على مستوى الذّات مقابل الضّلال والتّيه على مستوى الجماعة، وهنا تكمن قيمة الرّواية نفسها؛ ذلك أنّ النّجاة هي نجاة فرديّة في ظلّ وهن الجماعة، دون أن يخرج الرّوائيّون في تونس عن هذا المنحى. فالسّالمي في “حفر دافئة” يطلق الحبل على الغارب لشخصيّاته لتقرر مصيرها بيدها في لمحة وجوديّة خالصة؛ فسعاد تطلق لجسدها العنان دون قيد أو شرط: “كسرني على ضوء القمر في عربة من الدرجة الثانية لقطار سريع يعبر مقاطعة “كاتالونيا” … كسرني شاب أندلسي أسمر كافر غير مطهّر… لم انتبه إلى ذلك.. كنت سكرانة.. الشّاب لم أعد اذكر اسمه.”[49] وفي المقابل، نجد أن عادل هو الآخر تاه في أوروبا دون أن ينجح في الطب الذي ظلّ فيه سنتين. ولا يخرج الحاح حمودة عن هذا المنحى بعدما كان يسعى بكل ما يملك لإنجاب ولد، حتّى إذا ما جاء الولد وكبر تاه، ولم يلتفت إلى أبيه. ولا تخلو “نخب الحياة” لأمل مختار من هذا المنحى، فسوسن تبرز حالتها بقولها: “استسلمت للتسكع تحت رذاذ المطر لم أكن أفكر ولم أكن واعية…”[50]، أمّا عند مسعود بو بكر، فالبحث والانفعال مستمرّان: “بشكل متوتر أقلعت الطائرة من مطار تونس صوب أثينا، وخيّل إلي أن مضخة الدم في داخلي قد اقلعت هي الأخرى فسكنت، كل حركة فيّ توقّفت، كدت أنسى وجهتي ومأرب سفري؛ وأنا معلقة بين الأرض والسّماء.”[51] وتتضّح الصّورة أكثر في “إذ يعود “حيث يعود المغترب بابن هذه المرة، لا يتكلّم العربيّة ولا يفهمها… ومع كثير من التّعب والفواتير والأسئلة”[52]، والنّتيجة ذاتها نجدها في الرّوايات التي كتبها أصحابها في غربتهم نحو المشرق العربيّ، إذ كانت الغربة هي العنصر الملتهب في نفوس هذه الشّخصيّات للتّعبير عن ذلك الحنين الذي يؤجج البحث عن دفء الوطن والعشيرة والأهل.
المبحث الرابع– الهُويّة الأدبيّة ووضع المجتمع:
لا شك أنّ الأدب والمجتمع صنوان متلازمان، وقد عبّر عن ذلك الشّعراء، ثم الرّوائيّون ليؤكدوا هذا التّلازم. لكن الأمر هذه المرة مختلف، لأنّ الهُويّة الأدبيّة في حدّ ذاتها أصبحت مموّهة في ظل تعدّد الألسن واللغات التي تحمل هذه الهُويّة. وبات من الواضح انها مترامية الأطراف؛ فهي بقدر ما تستثمر التراث، تسعى في الوقت نفسه الى الاستفادة من تراث الآخرين. وفي نماذج من الرّوايات الحديثة، مثل “الدّراويش يعودون من المنفى”، يستند ابراهيم الدرغوثي إلى التّراث السّرديّ، لكنّه يسعى الى الجديد العالميّ ويحاوره، وبوظفه بمنتهى الدّقة. في حين تقدم الرّواية مكتوبة باللّغة الفرنسيّة عالمها من خلال نبش التّراث وتوظيفه على صعيد الفنّ الرّوائيّ نفسه، كما فعل عبد الوهاب المدب. لكن الملاحظ أنّ النّمطين يسيران في اتّجاه واحد بأشرعة مختلفة: والمسألة كما يؤكد صلاح الدين بوجاه تتصف بأمرين: أوّلهما: تلازم البعيدين الزّماني والمكانيّ في المصنفات العربيّة والفرنسيّة. وثانيهما: التّناسب بين المدونتين العربيّة والفرنسيّة في باب التّعامل مع الفضاءات الزمانيّة والمكانيّة”[53].
وفي هذا الإطار تصبح الهُويّة الأدبيّة متغيرة بتغير المجتمع نفسه، وبخاصة اذا نظرنا الى العمل الرّوائيّ في رصده لتغيرات المجتمع نفسه؛ سواء أكان على مستوى الفرد أو الأسرة أو الوعي الذي بات يتمتع به الجانبان. غير أنّ الصّورة في “وردة السّراب”، تبرز تلك حال التي يعيشها المجتمع مثل الهجرات القسريّة من جراء ذلك الفقر الّذي يمثل كابوسًا مرعبًا، ويزيده ثلج الشتاء قتامة حين ينزل غزيرًا بالدّهمانيّ ذات شتاء، نعاني من برد الشّتاء. نعاني ما نعاني.. فكيف بالثّلج… نمنا ليلتنا حالمين، والبرد يزحف الى المفاصل لاسعًا”[54].
وبهذا التّحديد تكون أحوال المجتمع هي مادة الأدب الأساس في تناوله قضايا النّاس وتحديد أطرها. ولا شكّ أنّ بين أزمات المجتمع ورخائه صورةً أدبيّةً عاكسةً لاحتضان التّوجهات الرّوائيّة؛ فإذا طغت الحال الأولي، أصبح المجتمع مرتبطًا بعلاقات متأزمة تبحث لها عن مستقر فلا تظفر به، إذ سرعان ما يفرّق الطّرف بينهما ولو طال الأمد[55]. أمّا إذا كان العكس ونعم المجتمع بشيء من الرّفاهية، ارتقى الأدب إلى تتبع هذا التّطوّر. ولعل العائد إلى الكتابات التّونسيّة يسترعي انتباهه ذلك التّركيز على بينة السّرد المركّزة على بعض الأشخاص. فشخصية المختار في “نخب الحياة” هي شخصية محورية في عدم إنتاجيته، لكنه يتحول إلى مختار الجمعية. “ففي الماضي كان له جدة وصديق وشعب. والجدّة تروي له الأساطير فتنير سبيله. والصديق يغدق عليه من حكمته فيعقده. والشعب يعيش حياة الطمأنينة ويواجه الواقع بسخريته البائسة، فيدفعه الى الهجرة. وفي الحاضر صار له صديق ورفيقة وجمع من الباحثين مثله عن حلول لقضايا الزمن الراهن والمستقبل.”[56] هذا الانتقال من حال إلى أخرى كشف غوص الجماعة في مشكلاتهم الجزئية واهمالهم المبادئ العامة التي كان البطل يؤمن بها، لذلك انفصل عنهم جميعًا. فكان الحضور الثّقافيّ والحضاريّ والسياسيّ والذاتي قائما على الجدلية بين مختلف هذه الجوانب. وما طغيان الذاتي إلا نتيجة طبيعية للمحيط العام بكامل تناقضاته وصراعاته وهزائمه لما انتشر في الغرب والشّرق الأقصى من أفكار كان لها اصداء قوية في نفوس الكثير من الطلبة والمثقفين في مطلع السبعينات.”[57]
وباختصار، فإنّ الأديب لم يكن معزولًا عن الأحداث التي تمرّ بها البلاد، فهؤلاء لا يكادون يختلفون عن الثّعالبيّ، إذ لا يكاد يخرج من السّياسة وأحداثها في تونس حتى ينغمس في أخبار الدّنيا كلّها، متنقَلاً من ألمانيا إلى فرنسا، إلى بلد العجم وبر الشّام، ثمّ خارجًا من الهند وعجائب المعتقدات… هذا الرّجل الذي زعزع الدنيا بإرادته في مقاومة الجمود الذي يرزح تحته العالم الإسلامي.”[58] والحقيقة أنّ الهُويّة الأدبيّة قد اتّخذت من القضايا الاجتماعيّة موضوعاتها، ومنحتها ذلك الاهتمام الخاص في عملية الكشف عن خصوصياتها المحلية وسبر أغوارها، لتبيان عملية التّأثير العالميّ على نطاق واسع في وضعية المجتمعات الصّغيرة أو تلك التي بدأت تتشكل، كما هو الحال في مختلف البلدان العربيّة وبلدان العالم الثّالث عامة.
الخاتمة
إنّ موضوع الهويّة والمكان متشعّب، لأنّه يجمع بين أبعاد مختلفة تتعلّق بالجذور والانفتاح، وبينما استحضر بشير بن سلامة الهويّة انطلاقًا من الخصوصيّة الوطنيّة، ذهب آخرون في اتّجاهات أخروى فبعضهم أكّد الهويّة العربيّة، وبعضهم ذهب إلى الجغرافيّة فعد الهويّة المتوسطيّة مرجعية ونسج لها خيوط لبوسها، في حين نرى الهويّة الفرديّة الذّاتيّة تطرح من التّجربة الشّخصيّة وخاصة عند كتاب المهاجر والاغتراب على غرار ما قدّمه الحبيب السّالمي في مدوناته.
وقد تقدّم المكان في المدونتين الفرنسيّة والعربيّة من خلال تشكّل الهويّة السّرديّة، فالمكان هو عامل مكوّن للشّخصيّة التّونسيّة وللسّرد في مقتضى البناء الرّوائيّ. كما تقدّم المكان بوصفه موطن الجماعة التّونسيّة، وبهذا يكون مرآة للهويّة. عند فئة كبيرة من الكتّاب التّونسيّين.
إلّا أنّ المسألة التي تطفو مباشرة هي الصّراع بين الموروث والثّقافة الوافدة والأيديولوجيّات الوافدة لينطرح السّؤال الآتي: أي هُويّة نريد؟ وإلى أيّ مدى تعكس الاتّجاهات الرّوائيّة حقيقة المجتمع التّونسيّ؟
أمام هذا الواقع كان من المفترض أن يتوحّد الرّوائيون في إطار بلورة المكان كونه مشروع وطن لابدّ أن ينتمي وفق مزاج شعبه و دينه.
إنّ مرتكزات الهويّة الدّينيّة قائمة في مجتمع مسلم وشرقيّ في غالبيته، لذلك فإنّ العمل على جانب تغذية روح الانتماء يبقى منقوصًا ما لم نعر الاعتبار اللازم للدّين.
ويبقى الحاضر المأزوم ماثلًا للعيان ما لم تستثمر منجزات العصر التّقنيّة، والخروج من دوائر الاستبداد والحكم المطلق غير القابل للمحاسبة وإطلاق الحريّات المسؤولة وفق ميثاق جديد يكفل تشكّل الهويّة على المرحلة السّوية.
وإلى أن يتم ذلك يبقى المكان أشبه بسجن كل مواطن يتمنى الخروج منه، وتبقى الهويّة هاجسًا لحالم بوجود وطن كريم.
فهرست المراجع والمصادر
ابن خليفة محيي الدين: الشّجرة، المطبعة العصريّة، تونس، 1972م.
ابن رشيق الحسن بن علي: العمدة في صناعة الشّعر ونقده، دار الجيل، ج:1، بيروت، 1972م
ابن سلطان، إبراهيم: وردة السراب ، دار صامد للنشر ، صفاقس، ط:1، عام 2002م
ابن منظور: لسان العرب، المجلد الخامس عشر، دار صادر بيروت، ط:3، سنة 199
أبو الحسن، بن محمد بن أحمد بن طباطبا: عيار الشّعر تحقيق وتعليق طه الحاجري، ومحمد زغلول سلام، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 1956م.
التابعي، علياء: زهرة الصبّار ، دار الجنوب للنشر تونس، ط:1، سنة 1991م.
حماد، كمال: العولمة الأمريكية من أفغانستان إلى العراق، مجلة شؤون الأوسط، مركز الدراساات الاستراتيجية، العدد: 120، خريف 2005م.
الزّبيدي، مرتضى : تاج العروس، تحقيق علي شيري، المجلد العشرين، دار الفكر للطباعة للنشر والتّوزيع، بيروت لبنان 1994.
زايد، عبد الصمد: المكان في الرّواية العربيّة، الصورة والدلالة، دار محمد علي للنشر، تونس، 2003.
علوش، سعيد: الرواية والأيديولوجيا في المغرب العربي، دار الكلمة للنشر، بيروت، 1981م.
عياد، شكري: المذاهب الأدبيّة والنقدية عتد العرب والغربيّين، عالم المعرفة،الكويت ، العدد177، ربيع أول 1414هـ/1993م.
الكثيري، الفاضل: المرأة والهُويّة بين الأنا والآخر في الرّواية العربيّة ، دار الفنون للطباعة الإلكترونية، تونس. 2023.
النالوتي، عروسية: تماس، دار الجنوب للنشر ، تونس، 1995م.
نكسون، ريتشارد: الفرصة السانحة، ترجمة: أحمد صدقي مراد، عمان ، 1992م.
نصار، حسين وآخرون: الأدب العربيّ تعبيره عن الوحدة والتنوع، مركز الوحدة العربيّة، بيروت 1997م.
اليوسفي محمد علي توقيت البنكا، دار رياض النشر للطباعة والنشر، بيروت ، 1992م.
Reference
- Annie Armandies : (1938 ) Ie nouveau roman. Gallimard. Paris.
- A cogny: (1958 ) Réalisme et naturalisme . Hachette. paris.
- Bourga,francois : (1995) islamisme en face , Edition la découverte , paris.
- A cogny: (1958 ) Réalisme et naturalisme . Hachette. paris.
-Georges .Matore:1988 l espace humain .Publisher colombe .Paris
[1] أستاذ منهجية البحث العلميّ والنّقد الحديث باحث وأديب تونسيّ.
[2] ابن منظور: لسان العرب، المجلد الخامس عشر، دار صادر بيروت، ط:3، سنة 1994، ص: 374.
[3] الزّبيدي، مرتضى : تاج العروس، تحقيق علي شيري، المجلد العشرين، دار الفكر للطباعة للنشر والتوزيع، بيروت لبنان 1994، ص” 349.
[4] الفاضل الكثيري : المرأة والهوية بين الأنا والآخر في الرّواية العربيّة ، ص: 15.
[5] علوش، سعيد: ص: 123.
[6] عياد،شكري:المذاهب الأدبيةوالنقدية عتد العرب والغربيين، عالم المعرفة،الكويت، العدد177، ربيع أول 1414هـ/1993م،ص:134.
[7] نصار، حسين وآخرون: الأدب العربي تعبيره عن الوحدة والتنوع، مركز الوحدة العربية، بيروت 1997م، ص:219.
[8] ابن رشيق الحسن بن علي: العمدة في صناعة الشعر ونقده، دار الجيل، ج:1، بيروت، 1972م، ص: 226.
[9] أبو الحسن، بن محمد بن أحمد بن طباطبا: عيار الشعر تحقيق وتعليق طه الحاجري، ومحمد زغلول سلام، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 1956م، ص: 10.
[10] زايد، عبد الصمد: المكان في الرواية العربية، الصورة والدلالة، دار محمد علي تونس، 2003، ص: 9.
[11] خالد، حسين: نظريّة المكان في الرّواية الجديدة، ص:396.
[12] J.Matore: l espace humain,P :17.
[13] J.Matore: l espace humain,P :110.
[14] حاتم، عبيد: من الخطابة إلى تحليل الخطاب، ص:51.
[15] حاج، معتوق محبة : ص: 58.
[16] J.Matore: l espace humain,P :17
[17] حاتم ، عبيد: ص: 51.
[18] عبد الصّمد، زايد : ص: 37.
[19] عبد الصّمد، زايد: ص: 9.
[20] بن سالم، عمر: صحري بحري، ص: 25.
[21] عبد الصمد، زايدص:68.
[22] بن سلطان إبراهيم: وردة السراب، ص: 58.
[23] ارتباك الحواس، ص: 48.
[24] اليوسفي محمد علي توقيت البنكا، ص: 176.
[25] النالوتي ، عروسية: تماس، دار الجنوب للنشر ، تونس، 1995م، ص: 37.
[26] صويلح، خليل: ص: 12.
[27] التابعي، علياء: ص: 107.
[28] الزهراني، معجب: ص: 56.
[29] أومليل ، علي: ص:29.
[30] الزهراني، معجب: ص: 60.
[31] الزهراني، معجب: ص: 60.
الزهراني، معجب: ص: 60.
[32] حماد، كمال: العولمة الأمريكية من أفغانستان إلى العراق، مجلة شؤون الأوسط، مركز الدراساات الاستراتيجية، العدد: 120، خريف 2005م، ص:45.
[33] نكسون، ريتشارد: الفرصة السانحة، ترجمة: أحمد صدقي مراد، عمان ، 1992م، ص:54.
[34] الزهراني، معجب: ص: 61.
[35] اليوسفي، محمد علي:توقيت البنكا ، ص: 191.
[36] الإدريسي، الحسين: ص: 74.
[37] ابن سلطان، إبراهيم: ص:22.
[38] ابن سلطان، إبراهيم: ص:22.
[39] ابن سلطان، إبراهيم: ص:36.
[40] التّابعي، علياء: زهرة الصبّار ، دار الجنوب للنشر تونس، ط:1، سنة 1991م، ص: 39.
[41] التّابعي، علياء: ص: 39.
[42] التّابعي، علياء: ص: 151.
[43] التّابعي، علياء: ص: 152.
[44] التّابعي علياء: ص: 108.
[45] التابعي، علياء: ص: 150.
[46] طرشزنة، محمود: ص: 56.
[47] الربيعو، تركي علي: ص:19.
[48] الصافي، سعيد:كازينو، ص:55.
[49] السالمي، حفر دافئة، ص: 34.
[50] أمل مختار: نخب الحياة، ص:9.
[51] أبوبكر، مسعودة: ليلة الغياب، ص:8.
[52] زهرة الصبار، ص: 31.
[53] بوجاه ، صلاح الدين : ص: 208.
[54] زهرة الصبار، ص: 154-155.
[55] الزهراني، معجب: ص:55.
[56] طرشونة، محمود: ص: 41.
[57] طرشونة محمود: ص: 63.
[58] بن خليفة محيي الدين: الشجرة، المطبعة العصرية ، تونس ، 1972م، ص: 35.