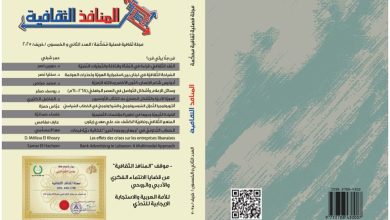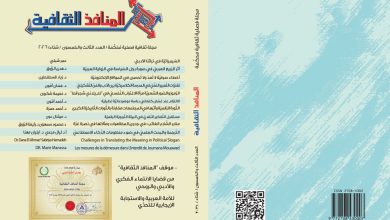دلالات الأمثال الشّعبيّة عند سلام الرّاسي (شيح بريح أنموذجًا)
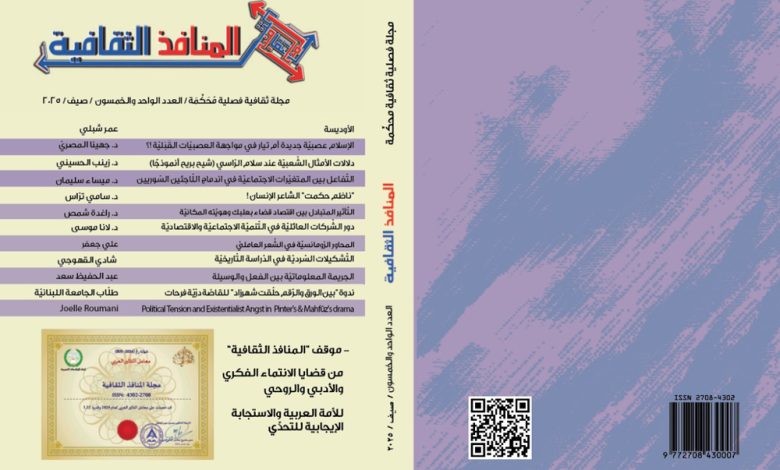
دلالات الأمثال الشّعبيّة عند سلام الرّاسي (شيح بريح أنموذجًا)
The Meanings of Popular Proverbs in Salam Al-Rassi’s “Sheeh B’reih” – Selected Models
د.زينب حبيب الحسيني
Zeinab habib housseini
تاريخ الاستلام 20/1/ 2025 تاريخ القبول 3/2/2025
المستخلص
تسعى هذه الدّراسة إلى تسليط الضّوء على دلالات الأمثال الشعبية عند سلام الراسي “شيح بريح” أنموذجًا، وهي تقوم على رصد السّلوك الإنسانيّ في حالات ومواقف متغيرة، وتحمل في طياتها دلالات غايتها الطابع التعليمي، والطابع الشّعبي، والطابع الأخلاقي، وتنوّع التراكيب، والاستخدام الفنّي للألفاظ.
تهدف الدّراسة إلى الكشف عن أهمية هذه الظّاهرة وأثرها الدّلالي، والإفادة من مخرجاتهما كأساس ينطلق منه البحث من خلال مدوّنة “شيح بريح”، كما تهدف إلى تقديم رؤية جديدة ومتكاملة في الأمثال الشعبيّة، ونظرة رؤيويّة واعية للمستقبل والأدب المتكامل مع الحياة، يميّزها التفاؤل والنظرة الثاقبة للحياة وللوجود، وبرز ذلك من خلال الإشكالية المحوريّة: هل الأمثال الشعبيّة نتاج أدبي يستحقّ الدراسة وله دلالاته، أم أنّه كلام عامّة لا ينطوي على قيمة تداولية؟
قد اعتمدتُ في الدراسة على المنهج الاجتماعيّ والمنهج الاستقرائيّ التّحليليّ، وقد اتّبعت هذين المنهجين لأهميّتهما في تبيان مكامن البحث، واستعنت بالأدوات الإجرائية كالاستقراء، ونظرية الحقول الدلاليّة، والنظريّة السّياقيّة عند التعامل مع الأمثال بمراعاة السّياقات المنتمية إليها، وقد قسّمت هذه الدّراسة إلى ثلاثة حقول:
أوّلاً: الحقل الاجتماعيّ
ثانيًا: الحقل الأخلاقي
ثالثًا: الحقل الديني
ومن أهمّ الاستنتاجات التي تمّ التّوصّل إليها
- المثل الشعبي هو جنس أدبيّ حيّ يعبّر عن مختلف تجارب الشعوب ومرآة عاكسة لحياتهم.
- تتميّز الأمثال الشعبيّة بسمات متنوّعة أهمّها الدقة في التعبير وإصابة المعنى وإيجاز اللفظ.
عبّرت الأمثال الشعبية عن مختلف العلاقات داخل المجتمع الواحد، وحاولت بيان العلاقة الصحيحة التي يجب اتّباعها.
الكلمات المفتاح: الأمثال الشعبيّة- الأخلاق- القيم- التعليم- الاجتماعيّ- تجارب- العلاقات- نظرة رؤيوية.
Abstract
This study aims to shed light on the meanings of popular proverbs in Salam Al-Rassi’s work *Sheeh B’reih* as a model. These proverbs reflect human behavior in changing situations and carry connotations that serve educational, popular, and moral purposes. They also showcase diverse structures and artistic use of language.
The study seeks to reveal the significance of this phenomenon and its semantic impact, utilizing the findings as a foundation for research based on *Sheeh B’reih*. Additionally, it aims to present a new and comprehensive vision of popular proverbs, offering an insightful perspective on the future and a literary outlook integrated with life—characterized by optimism and a deep understanding of existence. This emerges through the central research question: *Are popular proverbs a literary product worthy of study with meaningful implications, or are they merely common speech with no real pragmatic value?*
The study adopts the social and inductive-analytical approaches, given their importance in exploring the research dimensions. It also employs procedural tools such as induction, the theory of semantic fields, and contextual theory to analyze proverbs within their relevant contexts. The study is divided into three main fields:
- The Social Field.
- The Moral Field.
- The Religious Field.
Key Findings:
– Popular proverbs represent a dynamic literary genre that reflects the diverse experiences of societies and serves as a mirror of their lives.
– These proverbs are characterized by precision in expression, accuracy in meaning, and brevity in wording.
– They articulate various social relationships within a community and attempt to define the correct patterns of interaction.
Keywords: Popular Proverbs – Ethics – Values – Education – Social – Experiences Relationships – Visionary Perspective.
المقدّمة
تعدّ الأمثال الشعبيّة الأكثر انتشارًا وشيوعًا بين الأنواع الأدبيّة، كونها مرآة لمشاعر الشّعوب وتجاربها على اختلاف سبلها وطبقاتها وانتماءاتها، وهي تجسيد لمختلف تصوّراتها وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها في صور حيّة ودلالات إنسانية شاملة؛ فهي بذلك تعدّ الذاكرة الحيّة للشعوب؛ لأنّها سريعة التّوسّع، وتحفظ من جيل إلى آخر وتنقل بالتّواتر من لغة إلى أخرى عبر مختلف الأزمنة والأمكنة، وتتّسم بالإيجاز وجمال اللّفظ وكثافة المعاني، وهي وسيلة من وسائل حفظ التجارب والحكم.
“والمثل لا يعبّر عن الوقائع بشكل مباشر، وإنّما يمثل لها تمثيلًا عبر صورة أو قصّة ما، ولذلك كان المثل في جملته إشارة تحيل إلى معنى أبعد”([1]). “فالأمثال الشعبيّة تتماشى ومنطلقات الأمثال في التعبير ذلك أنّ المثل رصد للسّلوك الإنسانيّ في حالات ومواقف متغيّرة، وليس رصدًا لقضية ذات موضوع ووضع اجتماعيّ محدّد”([2])، ومن سمات المثل، كما لخّصها بعض الدارسين: الطابع التعليمي، والطابع الشّعبي، تنوّع التراكيب، والاستخدام الفنّي للألفاظ.
كما أنّ الأمثال الشعبية تتميّز بسمات الإيقاع والتناغم الموسيقي في ألفاظها، ممّا جعلها سهلة التداول والانتشار وحقّق لها الاستمرارية: “والحقيقة أنّ السبب في بقاء الأمثال متداولة إلى يومنا هذا، هو إيقاعها الناتج عن قصرها وإيجازها، فسَهُل الحفظ وبقيت الأفواه تناقل الأمثال([3])، “مش رمّانة قلوب مليانة“[4]
انطلاقًا من هذه الأرضية، أردت من هذه الدراسة التي تتناول الأمثال الشعبيّة عند سلام الراسي كشكل من أشكال التعبير الشعبي الأكثر تداولًا في الأوساط الشعبية، وأن تكون في شكل الموضوعات الّتي تنتظم في صورة مجالات مختلفة بحسب المعنى أو المضمون الظاهر للمثل.
لذا يحاول هذا البحث تصنيف الأمثال في شكل حقول دلالية، حيث ستعالج الحقل الاجتماعيّ، والحقل الدينيّ، والحقل الأخلاقيّ.
وبما أنّ الأمثال الشعبيّة جاءت لتعبّر عن مختلف العلاقات والفئات داخل المجتمع وداخل الأسرة، وانطلاقًا من أنّ التمسّك بالتراث ظاهرة اجتماعيّة ولها دلالاتها المعنويّة؛ جاء هذا البحث ليطرح سؤالًا محوريًا هو:
هل الأمثال الشعبيّة نتاج أدبي يستحقّ الدراسة وله دلالاته، أم أنّه كلام عامّة لا ينطوي على قيمة تداولية؟
ومن هذه الإشكالية تتولّد عدّة تساؤلات:
- كيف عبّر المثل الشعبي عن مختلف العلاقات الاجتماعيّة القائمة بين الفرد ومجتمعه؟
- هل استطاع المثل الشعبي أن يضع قوانين للفرد يسير عليها وتوجّهه نحو الأفضل؟
- ما الدلالات التي تقف خلف الأمثال الشعبيّة التي طرحها سلام الراسي كثقافة شعبية قروية؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية اخترت موضوع البحث وعنونته بـ: دلالات الأمثال الشّعبيّة عند سلام الرّاسي[5] “شيح بريح” نماذج مختارة.
واستندت في دراسة الأمثال الشعبيّة عند “سلام الراسي” إلى المنهج الاجتماعيّ والمنهج الاستقرائيّ التّحليليّ، وقد اتّبعت هذين المنهجين لأهميّتهما في تبيان مكامن البحث، واستعنت بالأدوات الإجرائية كالاستقراء، ونظرية الحقول الدّلاليّة، والنّظريّة السّياقيّة عند التّعامل مع الأمثال بمراعاة السّياقات المنتمية إليها، إلى جانب الوصف والتّحليل في مراحل البحث المختلفة.
فالمنهج الاجتماعيّ يُعنى بكشف الخصائص الفنّية الاجتماعيّة دلالاتها، وتبيان المقوّمات الجماليّة التّحليليّة التي تتّسم بها الظواهر الأدبيّة، ومن أسسه ربط الأدب بالمجتمع والنظر إليه على أنّه لسان المجتمع، فالأدب صورة العصر والمجتمع والأعمال الأدبية وثائق تاريخية واجتماعية، والأديب يؤثر في مجتمعه ويتأثر به، ورؤيته تتبلور بتأثير المجتمع والمحيط والتربية.
أمّا المنهج الاستقرائيّ التّحليليّ فهو عبارة عن عملية دقيقة تهدف إلى تحليل البيانات، وملاحظة الظواهر المرتبطة بها من أجل الربط بينها بمجموعة من العلاقات الكلية العامّة، كما يُعرفُ المنهج الاستقرائيّ التّحليليّ بأنّه الأسلوب البحثيّ الذي يستخدمه الباحث في تعميم دراسته الخاصّة على الدراسة العامّة المرتبطة بالموضوع الذي يبحث فيه، أي يربط بين الدّراسة التي عمل على تنفيذها بصفتها جُزءًا من كلّ، فيعتمد هذا المنهج على استخدام مجموعة من الاستنتاجات القائمة على الملاحظات، والتقديرات، والتجارب.
نقد المدوّنة: كتاب شيح بريح
هذا الكتاب صادر عن نوفل، هاشيت أنطوان، مع “شيخ الأدب الشعبي” سلام الراسي على مدى عقود من الزمن، عيون التراث الشعبي اللّبناني من أمثال وحِكَم، فوثّق التجربة الشعبيّة اللّبنانيّة، والريفيّة الجنوبيّة منها بشكل خاصّ، بأسلوبه الفذّ الذي امتاز بالسلاسة وبمزاوجةٍ بارعة بين اللهجتَيْن الفصحى والمحكيّة.
مفهوم المثل الشعبيّ
اهتمّ العديد من الباحثين بدراسة المثل الشّعبي وإعطاء تعاريف مختلفة له، ومنها: “المثل عبارة عن جملة أو أكثر تعتمد السجع وتستهدف الحكمة والموعظة… المثل الشعبي تقطير لقصة أو حكاية، ولا يمكن معرفته إلا بعد معرفة القصة أو الحكاية التي يعبّر المثل عن مضمونها”([6])، ويمكن القول إنّ الأمثال الشعبية جزء من الأدب وضرب من ضروب الإبداعية، وهو قول وجيز يعبّر عن خلاصة تجربة، مصدره کامل الطبقات الشعبية، يتميز بحسن الكتابة وجودة التشبيه، له دلالات متنوّعة ووظائف مختلفة”([7]).
وهناك العديد من الباحثين من اتّفق على أنّ الحكمة والمثل الشعبي يحملان المعنى نفسه، وهناك من أكّد على استقلالية كلّ منها عن الآخر، فالدارسون اتّفقوا على أنّ المثل يقوم على أساس التشبيه: “المثل أساسه التشبيه وما يقع في حكمه من وجوه بلاغية، أمّا الحكمة فهدفها إصابة المعنى وترمي إلى التّعليم، ويكون إنتاجها وشيوعها بين الخاصَّة، تقوم على التجريد، وتستدعي التأمل، وهي أكثر قابلية للتعميم”([8]).
أوّلًا: الحقل الاجتماعيّ
الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، إذ لا يمكنه العيش إلّا ضمن الجماعة التي تحكمها مجموعة من الضوابط، مثل الدين، والأعراف، والتقاليد، والتي بدورها توجه العلاقات داخل الجماعة البشرية، كالزواج والجوار والصداقات والتّعاون والتّبادل التجاري، والمعاملات المالية كالأسواق والحرف، وغير المالية القائمة على الإكراميات كالأعراس والمآدب ونحوها.
- العلاقة بين الأقارب (صلة القرابة)
تبرز علاقة وطيدة بين الأقارب فيما بينهم سواء أكانت من جهة الأب (أعمام وعمات)، أم من جهة الأم (أخوال وخالات)؛ فالقرابة هي: “ذات جانبين يستخدم هذا المصطلح بطرق متعدّدة، فكلّ أنساق القرابة توحي بأنّها ذات جانبين إذ ما تحقّقت للفرد روابط قرابة بأهل الأب والأم معًا، ومعنى ذلك أنّ صلات القرابة ليست أحادية، ولكنّها تنطوي على قيمة اجتماعية بالنسبة إلى أكثر من اتّجاه واحد لخط القرابة”([9]).
ولعظم هذه العلاقة تناولتها الأمثال الشعبيّة بكلّ جوانبها؛ لأنّ من اهتماماتها الإحاطة بكلّ ما يتعلّق بحياة الفرد، وتناولتها بالتفصيل سواء بالنقد أو المدح، ومن الأمثال التي تدعو إلى ذلك المثل الشعبي القائل: “ما يحك جلدك غير ظفرك”([10])؛ فهذه حكمة فصيحة يتداولها العامّة والخاصّة، وهذا ما يدلّ على عمق هذا الموروث، ومعناه: لا تنتظر العون من غير الأهل والأقارب.
فالمثل تشبيه بليغ يصوّر حالة اجتماعيّة وهي لؤم القريب ويحذر منه؛ لأنه قد يلسعك بشره وتكون ضربته القاضية، ففي المثل دلالة كبيرة ودعوة غير مباشرة إلى الابتعاد عن الأقارب وعدم مخالطتهم، وفي نوع آخر من الأمثال الّتي تدلّ على أهميّة الانجاب، وتبيان صفات الأولاد الحسنة “اللي خلف ما مات”([11]). فالمثل يدعو بطريقة مباشرة إلى الإنجاب؛ لأنّ الإنسان الذي ينجب الأولاد، ويعمل على تربيتهم أحسن التربية سيكونون له عونًا عندما يكبرون، ويكونون سببًا في تخليد اسمه في الحياة، إذًا الأولاد هم مصدر السعادة للوالدين في الصغر، وعونٌ لهم في الكبر، لذلك لا بدّ من علاقة تربط بعضهم مع البعض الآخر. هذه العلاقة تتحكّم فيها جملة من العادات والتقاليد الّتي توجّه مسارها، فتقوم على إحسان النّاس إليهم والبحث عن الحنان، وبفقدان الأم يفقد الولد والبنت على حدّ سواء مصدر الحنان والعطف والحبّ، فلا يجدان من يدافع عنهما ويحضنهما، وهذا ما يبين لنا عمق العلاقة بين الأم وأبنائها.
- الأسرة ( المرأة- الحبّ- الزواج)
الأسرة نتاج الزواج الذي يعدّ رابطة مقدّسة، وهو السبيل الأول لتأسيس أسرة هي النواة الأولى لتكوين المجتمع الذي تنجم عنه العلاقات الاجتماعيّة المختلفة، وتسري بين أفراده، وتظهر الأمثال الشعبية أهميّة الرابطة الزوجية، بل تجعل منها شيئًا يستدعي التفكير والانتباه من الزواج فقيل: “المرا خزانة والزّلم بلا أمانة“[12]، والزواج الحقيقي هو العقد الّذي يقع بين الزّوجين، ولا يكون مقرونًا بمدّة معينة، ففي المثل دعوة للتدبر والتعمق قبل الإقبال على الأمور المصيرية في حياة الإنسان؛ ولأنّ الفرد الشعبي يرى أنّ استمرارية الرابطة الزوجية أهمّ حتّى من الزواج ذاته، وهذا دليل على عمق الفكر الجمعي الشّعبي؛ لأنّ مسألة التوافق بين الزوجين أمر لا يستطيع أن يضمنه أحد مهما كانت قرابته بهما، وكذلك مهما كان الشخص متخصّصًا في الشأن الأسري والاجتماعيّ عمومًا، لأنّ الإنسان ليس كالآلة التي يعرف المتخصّص فيها طريقة عملها، والزواج يظهر بعد المعاشرة نحو المثال القائل: “ما بتنقفر البضاعة إلا بعد الحيل والرضاعة”[13].
كما يشكّل هاجس الخوف من عدم استمرار العلاقة الزوجية شيئًا من التردّد قبل إتمام الزواج خوفًا من الندم بعد فوات الأوان. فقالوا: “قعاد السلامة، ولا زواج الندامة“[14]، حيث يفضّلون العنوسة على الزواج الذي يجرُّ النّدامة، إمّا لكثرة المشاكل الزوجية، أو خوفًا من حدوث الطلاق خصوصًا بعد إنجاب الأولاد، كما تظهر الأمثال مدى الاهتمام الشعبي باختيار الزوجة؛ لأنّه بداية الطريق للزواج فقالوا: “اللي يتزوجها على مالها يموت فقير، واللي يتزوّجها على رجالها يموت ذليل، واللي يتزوجّها على زِينها يحبُّو ربي والنّبي البشير“[15]، فهم في هذا المثل يرون بأنّ الجمال من المقاييس الأساس، كما نجدهم يؤخّرون مقياس الجمال عندما يتعلّق الأمر بطيب الخصال، ويجعلون منه أمرًا ثانويًّا، خوفًا من أن يخفي جمال المرأة قبيح أفعالها، أو شيئًا ممّا يذمّ في النساء.
- المرأة:
تتردد كثيرًا عبارة “المرأة نصف المجتمع، ومربية النّصف الثاني منه”، وهي فعلًا كذلك، وهذا كلام لا يحتاج إلى دليل، هذا من حيث التشكيل العددي والكمي في المجتمع، وكذلك الشأن بالنسبة إلى فاعليه النساء ودورهنّ في المجتمع، وحتّى في تحريك عجلة التاريخ التي لا تتوقّف، ومهما يكن فإنّ حضور المرأة في الحياة الاجتماعيّة شيءٌ حتميٌّ، بل محوريّ، وهذا ما جعل الأمثال الشعبية تتناولها بمساحة شاسعة، فمرَّة تصفها بالذكاء، وأخرى بالمكر، وثالثة بالكيد، ورابعة بالحنان، ويصعب العدُّ والحصر. وعن أهمّية المرأة في الأسرة والمجتمع، وعند الرجل في المجتمع الشعبي الذكوريّ قالوا: “النِّسا إذا حَبّو يدبّرو، إذا كِرهو يخَبّرو“[16]، أي أنّ النساء هنّ محور الحياة في المجتمع، فإذا أحببن شخصًا كنّ له عونًا في تدبير أموره وسيرها سيرًا حسنا، وإذا حدث العكس فلا تجد منهنّ إلّا نقل الأخبار وتداولها، وإفساد الأمور بطرقهنّ وكيدهنّ.
لعلّ النظرة السلبية تطارد المرأة في كثير من الأمثال الشعبية التي ترد على سبيل التحذير منها، والخوف من مكرها وكيدها، فقد قيل: “إذا دخلت للبير طَوِّل حبالك، وإذا دخلت للتّجارة طوِّل بالك“[17]، وكلمة سوق في هذا المثل لا تعني البيع والشراء، وإنّما تعني عموم أمور النّساء، فنصّ المثل بحذر من كيد النساء من أجل أخذ الحيطة والحذر؛ لأنّ جانبهنّ لا يؤتمن. وموضوع المرأة هو موضوع واسع المجال لكونها محور الحياة الاجتماعيّة، وما زالت الأمثال ترسم صورة المرأة من خلال التركيز على ما تتميّز به من خصال خُلُقية وخَلْقية، ومن خلال ما تتميّز به على مستوى وضعيّتها الاجتماعيّة والثقافيّة وغيرها، وعلى مستوى أدوارها وأنشطتها داخل البيت وخارجه”([18]).
كما تُعدّ البنت أكثر التصاقًا بوالديها منذ ولادتها حتّى تصبح شابةً، فنجدها أحنّ من الابن على والديه، ترعاهم وتلبّي طلباتهم وتتولّى شؤون البيت مع أمّها، على عكس الابن الذي نجده دائمًا معتمدًا على نفسه من دون الرجوع إلى والديه وإشراكهما في حياته، ومن الأمثال التي قيلت حول البنت ودعت إلى إدراك أهمّيتها والدعوة إلى محبّتها المثل الشعبي القائل: “المرا بالبيت رحمة ولو كانت فحمة“[19]
- الحبّ:
الحبّ هو ذلك الشعور الرائع الذي يكنُّه الإنسان لأخيه، سواء أكان هذا الحبّ متعلقًا بمحبّة الأبناء أم الوالدين أم محبّة الأقارب أم الجيران أم محبّة الزوج لزوجته، فإنّه يبقي ذلك الشعور الصادق المنبعث من القلب بكلّ صدق ومودّة وعطف وحنان، فهو عکس الکره، لما تحمله هذه الكلمة من دلالات وصفات منبوذة من حقد وبغض وحسد؛ فالمحبة الصادقة تحقّق أشياء كثيرة، ويصل المجتمع إلى مراتب كبيرة من التماسك والانسجام، والأمثال الشعبية تطرّقت بدورها إلى هذه العاطفة بكثرة، وخاصة فيما يتعلّق بحبّ رجل لامرأة، أو العكس، يجعل الطرفين لا يريان أمامهما سوى صورة المحبوب، فهو عبارة عن مشاعر تحقّق التقارب والتجاذب والارتياح([20]).
وهذه العاطفة، عاطفة الحبّ، نجدها عند جميع الثقافات؛ فهي سمة من السمات البشرية، وتاريخنا العربيّ مليء بالقصص الخالدة عن الحبّ الحقيقي، وعن وفاء الشخص المحبّ لمحبوبه، فالحبّ يجعل صاحبه لا يرى أمامه سوى محاسن محبوبه ولا يرى عيوبه، ومن الأمثال الشعبية التي عبرت عن ذلك المثل الشعبي القائل:
“الحبّ أعمى”([21])؛ فبالرغم من أنّ المثل يتكوّن من لفظتين فقط، إلّا أنّه أدّى المعنى کاملاً، وحاول نقل كلّ مشاعر المحبّ في سبيل محبوبه، وهذه الجمالية في المثل، الإيجاز في اللفظ وقوة التعبير، والمثل يضرب في الشخص الذي لا يرى شيئًا من المخاطر التي تحيط به، لذلك شبه الحكيم الشعبيّ المحبّ بالأعمى، فعندما يُحبّ شخصٌ لا يعبأ بالمخاطر، ولا يبالي بسلوكيّاته وتصرّفاته، ولا يرى عيوب محبوبه، بل يرى كلّ شيء فيه جميلاً.
والأمثال الشعبيّة تطرّقت بدورها إلى هذه العاطفة؛ عاطفة الحبّ التي تنشأ بين الناس، وبين الرجل والمرأة خاصّة، وذكرت لنا ما يتعرّض إليه المحبّ من أشياء جرّاء وفائه لمحبوبه. “لبنات عمّارة الدار”([22]). فمن طبع الفتاة الاحتكاك بوالديها والاهتمام بهما، ولأنّهما مصدرا الحبّ والحنان فهي تحدث صدى في المنزل. وثمّة أمثال شعبية أخرى تفتخر برأي الفتاة الصائب في الغالب، وفي رأي آخر عدّ المرأة مرارة في الحياة، وهذا نقيض الرّاحة والسّعادة التي يدّعون وجود المرأة فيها وبسببها، ويعتقدون براحة المرأة وقداستها، فنجد المثل الشعبيّ القائل:” المرا مرارة: يا غشيمة يا قهّارة“[23].
وعليه فمن واجب الوالدَين أن يهتمّا باختيار الزوج لابنتهما طلبا لراحتها لأنّها مغلوبة على أمرها، ومن خلال هذا المثل يتّضح لنا حرص الوالدين على مصلحة ابنتهما وعلى مكانتها، كما يتّضح لنا جانب مهمّ، وهو الاهتمام بمصلحة البنت والدعوة إلى اختيار الزوج المناسب لها، إضافة إلى أنّه دعوة لتزويج البنت وحفظ عرضها وكرامتها وحمايتها من ألسنة الناس.
ولو أخذنا الأمثال الشعبية التي قيلت في المرأة سواء بالمدح أو الذم لتبيّن التناقض الواضح بين دلالة بعض الأمثال، وهذا التناقض لم يأت هكذا من فراغ، وإنّما جاء من رحِم المجتمع: “كما أنّ بروز التناقض في دلالة بعض الأمثال، إذا ما تمّت الموازنة فيما بينها، يكشف عن التّناقضات الاجتماعيّة التي يمكن أن توجد في نطاق مجتمع ما، إذ يصبح من غير المعقول اتفاق جميع الأمثال في دلالتها في مجتمع يعرف صراعًا حول القيم والتوجّهات المستقبليّة للجماعة، واختلافًا في المواقف وفي المصالح وفي القضايا المطروحة”([24]) .
وهذه الصفات التي تقلّل من قيمة المرأة وتحقّرها، هي ظلم وتعسف واضطهاد للمرأة؛ لأنّ المرأة لها مكانة كبيرة في المجتمع، كما أنّ الإسلام وتعاليمه منحها مكانة مشرّفة ولم يفرّق بينها وبين الرجل؛ لأنّها هي كل شيء في هذه الحياة، وفيها قال المثال:”المرأة ريحانة وليست قهرمانة“[25]، والأمثال تبقى تجارب شخصية المرأة الّتي عايشت هذه التجارب، فلا يمكن أن نعمّمها على جميع النّساء، وهذه الأمثال هي مرآة عاكسة للمجتمع بما فيه من خير وشر، وطريقة تفكير المجتمع، ورصد سلوكات الأفراد، وفهم طبيعة العلاقة بينهم ونظرتهم للحياة؛ لأنّ الأمثال الشعبيّة لو اقتصرت على جانب الخير فقط لما عكست الصورة الحقيقية التي نريد کشفها، بل هي صورة عامّة للحياة الاجتماعيّة المختلفة بكل تنوّعاتها واختلافاتها لمجتمع ما.
- الزواج:
الزواج “هو نصف الدين” كما يقال دائمًا في هذا المثل الشعبي المتداول بكثرة، فالزواج أو العلاقة الزوجية، وإنّما هي العلاقة الدائمة والمتواصلة بين الزوجين، وهي أساس تكوين أسرة وإنجاب الأولاد وتحقيق السعادة في المجتمع، فالزواج هو: “تلك الرغبة النفسية المشتركة بين الرجل والمرأة في هذا الموضوع”([26])، والأمثال الشعبية بدورها لم تغفل عن هذا الموضوع المهم، بل تطرّقت إليه، وتتبّعت مختلف مراحله انطلاقًا من الخطبة واختيار الزوجة، وصولًا إلى الزفاف وإلى تكاليفه وما ينتج عنه، مرورًا بعلاقة المرأة بمحيطها الجديد، وتناولت كلّ ذلك سواء بالنصح والإرشاد والتوجيه أو بالنقد والسخرية.
فالعلاقة التي تنشأ بين المرأة والرجل، وإنّما هي علاقة دائمة وثابتة تعود بالفائدة على المجتمع، وهو رباط مقدس به يجتمع الذكر والأنثى، ويكونان أسرة ينجبان فيها الأولاد. ولأهمية هذا الموضوع تناولته الأمثال بكلّ مراحله وتفاصيله، ومن الأمثال التي تدعو إلى ذلك المثل القائل: “الزواج سترة”[27]. فهذا المثل رغم أنّه يتكوّن من لفظتين فقط فإنّه يؤدّي المعنى كاملًا في بيان أهميّة الزواج في حياة الفرد، وهي ميزة في المثل الشعبيّ الّذي يتميّز بإيجاز اللّفظ وقوّة المعنى، ممّا يعطي المثل جمالية في الأداء وروعة في التأثير على المتلقي. فكلمة سترة تعني الطهارة والابتعاد عن الفاحشة، وإنشاء أسرة مثالية قائمة على المودة والرحمة، والأمثال تتبّعت جميع مراحل الزواج من البداية، في وجوب مراعاة عنصر الاختيار لكلا الطرفين حتى تكون أسرة سعيدة ومستقرة، وبالتالي يتحقّق الاستقرار للمجتمع، وأول خطوة في الزواج هي اختيار الزوجة، وهو ما يطلق عليه اسم “الخطبة” وهي تعني أن يبادر رجل أو أهله لخطبة امرأة وطلب الزواج منها، فنجد من يختار زوجة الابن بنت الأصل، أو على أساس والديها وخاصة الأم، وهناك من يختارها على أساس الجمال، وهناك من يختارها لمالها. ومن الأمثال التي تدعو إلى الزواج من بنات الأصول المثل الشعبي القائل: “طب الجرّة على تمها بتطلع البنت لأمّها”([28]). بعدما تنتهي تحضيرات الزواج، وتنتقل الفتاة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، وتعيش مع عائلة الزوج، فهي بذلك تنتقل من وسط عائلة وعادات إلى وسط آخر وعادات أخرى، فهي تنتقل إلى مجتمع الرجل، فهذا المجتمع هو الذي يقرّر مصيرها وفق مزاجه وعاداته وتقاليده، لذلك لا بدّ عليها أن تحاول التأقلم مع الحياة الجديدة وتقبلها بما فيها، وأوّل ما تواجهه هو “أم الزوج (حماتها)”؛ لأنّ أم الزوج دائمًا تراقب تصرفاتها وسلوكياتها، وتنقدها تارة وتمدحها طورًا، وتحاول إرشادها وتوجيهها إلى ما يجب فعله، من ذلك نجد المثل الشعبي القائل: “إذا تفاهمت العجوز والكنّة يدخل إبليس الجنة”([29]).
فالعلاقة هنا تبدو سيّئة بين الزوجة وأم زوجها: “وربما يكون سبب ذلك الأنانية، وحبّ التملك الذي تمتاز بهما المرأة، فالأم تعدّ نفسها أولى بحبّ ابنها من كلّ إنسان، لأنّها هي التي حملته وولدته وأرضعته وربّته حتّى صار رجلًا، وسوف تبقى تحبّه حتّى آخر يوم في حياتها”([30])، وأمّ الزوج عندما تأتي زوجة ابنها تنتابها الغيرة منها بحكم العلاقة بين الزوجين، أمّا الزوجة فترى من حقّها الطبيعي اهتمام زوجها بها، وأن يقتصر هذا الاهتمام عليها وحدها، من دون غيرها حتّى وإنْ كانت أمّه، كما لا تسمح لها بالتدخل في شؤونها وفي حياتها، وهذا ربما سبب النزاع.
وعليه فالأمثال الشعبيّة حبّبت لنا خُلق الصبر وحثّت عليه، كما أنّها وقفت مع الإنسان الذي يصبر، لأنّ بهذا الخلق وبأخلاق أخرى يستقيم سلوكه، ويكون عنصرًا صالحًا، وبصلاحه يكون مجتمعًا متفهّمًا، كما وضعته أمام حالات سلوكية يجب أن يستفيد منها ويتعظ بها.
ثانيًا: الحقل الدينيّ
إنّ تمسّك المجتمع اللّبنانيّ بالقيم الروحيّة أمر ظاهر في ارتباطه بالشعائر الدينية، ويعدّ اللبناني أنّ المحافظة على لغته امتداد للمحافظة على دينه، ومن هنا استطاع أن يحافظ على شخصيته، وقوميته، وثقافته، لذا نجد أنّ الأمثال الشعبية تتبع تمظهرات هذه المسحة الدينية في الأمثال الشعبية اللّبنانيّة في محاور عدّة ومنها:
- العقيدة
للعقيدة حضور في تعاملات الفرد، وهي التي تطلَق على التصريف الناشئ عن إدراك شعوري أو لا شعوري يجبر صاحبه على الإذعان إلى قضية ما من غير برهان”([31]). فمظاهر العقيدة الايمانيّة بادية من خلال الأمثال الشّعبية التي يتداولها أفراد المجتمع الشعبي من دون تفكير أو تصنع؛ ومن ذلك قولهم: “الضعيف فاق واللقمة معاه من ربي“، إيمانًا وتسليمًا بأنّ الله لا يترك عبده، ولا يتخلّى عنه خصوصًا إذا كان ضعيفًا.
وفي تعبيرهم عن عاقبة المتجبّر، قالوا: ” كلّ فرعون يجيبلو ربي موسى“، اعتقادًا لا ريب فيه بأن الله هو المدبّر لشؤون الكون، وتصديقًا لما جاء في القرآن الكريم حول قصة سيدنا موسى(ع)، ولأنّهم يدركون أنّ الّذي لا يخاف الله قد يصدر منه المكروه في أي لحظة. قالوا: “خاف من ربي، ومن اللي ما يخافش ربي“؛ ولأنّ الطبقة الشعبية تؤمن إيمانًا راسخًا بأنّ مسألة الرزق بيد الله تعالى، فقد قيل: “يموت القاق، ويبقى الرزّاق“[32]، يقولون هذا في حال وفاة عائل الأسرة، لأنّهم على يقين بأنّ الرزّاق هو الله عزّ وجلّ.
- ثنائية الخير والشر
تقوم الحياة في عمومها على مبدأ الثنائية، ولعلّ ثنائية الخير والشر تبرز مظاهرها في حياة المجتمع الشعبيّ بشكل واضح؛ ولأنّ عالم البشر غير عالم الملائكة الخيِّر، ولا هو عالم الشياطين الشرّير، وإنّما هو عالم يتجاذبه الطرفان، مع انتصار العالم الشعبيّ للخير دائمًا، رغم وجود مظاهر الشرّ في كلّ طبقات المجتمع، ومن الأمثال الشعبية التي ينفرون بها بعضهم من الشرّ قولهم: “كف شرّك عنّي، وما عليك منّي“[33]، دلالة على البعد عن الشرّ وكفّ الأذى، ويبقى عندئذ الإنسان سليمًا، ومثاله “بَعّد عن الشرّ وغَنيلُه“[34].
كما تبدو ثنائية الخير والشر في قولهم: “الشرّ يديروه النقاص، ويتحملوه العواقلة (العقلاء)“[35]، ففي المثل إشارة إلى الخصومات والمشاكل التي يثيرها خفاف العقول، ويتحمّل حلولها أو أعباءها العقلاء.
ج- القضاء والقدر
الإيمان بقضاء الله خيره وشرّه من عقيدة المسلم، والفرد اللبنانيّ عجنت معه مسألة الإيمان بالقضاء والقدر كما يعجن الماء والدقيق، فصارت على لسانه في كلّ أحواله، وكان أحسن مظهر تتمظهر فيه هو الأمثال الشعبية، فقالوا: اللّي ما إلو نصيب بتوقع اللقمة من تمّو“، أي أنّ اللّقمة التي لم تكتب للإنسان تسقط ولو وصلت إلى فمه، لأنّ الكتاب قد سبق عليها، وهذا من قمّة الإيمان والتسليم بقضاء الله وقدره.
وفي السّياق ذاته قولهم: “المكتوب ما منّو مهروب([36])“، أي لا داعي للتسرّع في الكسب ونحوه، لأنّ الإنسان لن يأخذ من الدنيا إلا ما كتبه الله له، كما يسعى الناس ويخططون لأمور حياتهم، لكنّ أمر الله هو الذي يكون في النهاية، ومن الأمثال الشعبيّة التي يبدو فيها الإذعان المطلق لمسألة القضاء والقدر في المجتمع الشعبيّ اللّبنانيّ قولهم: “المكتوب على الجبين ما بتمحُّوه يدين“، ففي ضرب هذا المثل استسلام لمشيئة الله، وهذا من سمات الفرد المسلم، كما يصلح المثل للسّلوان عمّن حلّت به حادثة غير مرغوبة في أهله أو ماله.
- الدنيا والآخرة
يشغل موضوع الدنيا والآخرة الفرد الشعبيّ كثيرًا، لذا أعطاه الحكماء مساحة غير يسيرة في أمثالهم وأقوالهم واهتمامهم، وقالوا فيه أمثالًا تتوافق في مجملها مع ما جاء به هدي الإسلام، وقد قال ابن قيم الجوزيّة عن الدنيا: “السير في طلبها سير في أرض مسبعة، والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح، المفروح به منها عين المحزون عليه، آلامها متولّدة من لذاتها، وأحزانها من أفراحها…” ([37]).
فالدّنيا في نظر الحكيم الشعبيّ قصيرة زائلة، أمّا الآخرة فهي المستقرّ. فقالوا: “الدنيا سقيفة والآخرة دار“[38]، بمعنى أنّ البناء الحقيقي يكون في الآخرة، أمّا الدنيا فهي كالبنيان المؤقّت الّذي لا داعٍ لإتقانه. وصدق قول المعرّي:
تعبٌ كلُّها الحياةُ فما أَعْـ جَبُ إلاّ من راغِبٍ في ازْدِيادِ[39]
ومن الصور الإيمانية التي تحملها الأمثال الشعبية قولهم: “الدنيا بالوجوه والآخرة بالفعايل“[40]، أي يمكن للإنسان أن ينتفع بالوساطات في الحياة الدنيا، أمّا في الآخرة فلا ينفعه إلا عمله الصالح. ومن الأمثال التي تذمّ الدنيا قولهم: “الدنيا جيفة وطلابها كلاب“، ولمّا كانت الأمثال الشعبية ليست كلّها حكمًا، فإنها تصدر في كثير من الأحيان عن عامّة الناس، فتحمل مضامين قد تكون إلى السلبية أقرب، ومن ذلك قولهم: “الدنيا يعيشو فيها أهل الصنايع ولا أهل البدايع“[41]، وقد يحمل معنى هذا المثل من جهة الإيجابية إذا كانت البدعة حسنة من أجل العيش، أي بإنشاء طرق للعيش والكسب لكنها تراعي المشروعية والحلال، وقد تعتري الفرد الشعبيّ لحظات يركن فيها إلى الدنيا ويأنس بها فتأتي الأمثال بما يخدم تلك اللّحظات. فقالوا: “لا تُبدّل الدنيا بالشّقا“[42].
ثالثًا: الحقل الأخلاقي
يعدّ مجال الأمثال الشعبية من المجالات التي تبدو أخلاق الشّعوب من خلالها بوضوح؛ لأنّ الأمثال تنتج في لحظات من الصفاء الروحي، فتكون تلخيصًا لقصّة، أو تبريرًا لموقف، أو حثًّا على فضيلة من الفضائل، أو نهيًا أو أمرًا. وقول المثل: “اللي ما عندو كبير ما إلو تدبير”[43]
وغالبًا ما يطلق هذا المثل على الأب، فالأب يمثل الدعامة والركيزة التي تبنى عليها الأسرة، وله أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأولاد، والإنسان الّذي يفقد والديه لا يجد من يعينه أو يرشده في حياته، وهذا ما يبين لنا قيمة الوالدين وأهميّتهما بالنسبة إلى الإنسان، فبفقدانهما يفقد الإنسان أهمّ شيء في الحياة، والمثل يحثّ على طاعة الوالدين والإحسان إليهما؛ لأنّه مَنْ يبرَّ والديه ينَلِ الأجر العظيم.
- الوفاء والخيانة: وهما صفتان متعاكستان، وخُلقان متعاكسان، وقد جاء في الأمثال الشعبية ما يرغِّب في الأوّل، وينفِّر من الثاني، فقد قيل: “خير الناس ردو، لا عدو“، وهذه قمة الوفاء والاعتراف بالجميل، فعلى الإنسان أن يكافئ الخير بالخير، فإن لم يستطع، فعليه أن يعترف بالجميل. ومن صور الوفاء بالوعد قولهم: اللّي عطى كلمتو، عطى رقبتو“[44]، بمعنى أنّ الّذي أعطى عهدًا لغيره فلا بدّ من الوفاء به، وإن أدّى ذلك إلى قطع العنق، وهذا أقصى ما يمكن أن يقع للإنسان من مكروه.
على نحو هذا المعنى قال المثل الشعبي: “الولد العاطل بيجيب المسبّه لأهله“[45]، فالأولاد العاطلون الذين لا عهد لهم ولا وفاء فهم منبوذون في مجتمعهم، ويلحقون الشتائم بأهلهم بسبب سوء خلقهم.
ومن الأخلاق الذميمة في المجتمع صاحب الوجهين الذي عنوه بقولهم: “يقول للكلب هش، ويقول للخاين خش“[46]، فمن الأخلاق الذميمة أن يتّصف الإنسان بعدم ائتمان الجانب، فلا يكاد القوم يعرفون موقعه، أعدو هو أم صديق؟! ومن الأشياء التي يجب على الإنسان أن يحافظ عليها الكلمة الصادقة والالتزام بها والوفاء بالعهود؛ فالإنسان مسؤول عن كلامه؛ لذلك يجب عليه أن يتجنّب الكلام السّيء، والوفاء بالكلمة والالتزام بها يكون أمرًا ضروريًا، لذلك تناولتها الأمثال الشعبية بكثرة، ودعت إليها ونوّهت بها، والوفاء كلمة مقترنة بالرجولة، وتعدّ دينًا يجب قضاؤه؛ يقال في ذلك: “كلمتو عند قطع رقبتو”([47]).
وهذا ما يبيّن لنا أهميّة الأمانة عندنا وقيمتها، وعليه فالأمانات عند الإنسان عديدة ومتعدّدة، سواء ما تعلقت بجوارحه أو بأمانات النّاس عنده أو بأولاده، فكلهم أمانات عنده يجب الحفاظ عليها، لأنّ الالتزام بأداء الأمانات والوفاء بالعهود تحقّق للإنسان السعادة والخير، وتنشر المحبّة والاستقرار والثقة بين النّاس، وهذا ما سعت إلى تحقيقه الأمثال الشعبية من خلال عباراتها الموجزة، وألفاظها المعبرة والمشخّصة للمعاني والدلالات.
- التعاون والتكافل: من محامد الجماعة الشعبية، التعاون والتكافل، وتقاسم الأعمال لا سيّما في مواسم الحرث، والبذر، وجزّ صوف الأغنام، وحفر الآبار، ونحوها من الأعمال الفلاحية، والرعَويّة، وغيرها من النشاطات، وهذا ما يعزّز أواصر التقارب بين أفراد المجتمع.
قد حملت الأمثال الشعبية كثيرًا من صور الحثّ والترغيب في هذه الأخلاق الحميدة، كما حملت نقيضها للتحذير منه، وتنفير النّاس من الإقبال عليه. ومن صور الحثّ على التكافل والتعاون قولهم: “النّمل إذا اجتمع انتصر على السبع“[48]، وفي هذا دعوة إلى العمل الجماعي، فمهما كان العمل شاقًّا، فعندما يوزع يصبح سهلًا، وكذلك قولهم: “الحمية تلهب السبع“[49]، في إشارة إلى أنّ الخصم مهما كان قويًّا فإنّ الجماعة تتغلب عليه، وقد أشاروا إلى القوة بالسبع، وهو في عرف العامّة الأسد؛ دلالة على أهميّة التعاون فيما بين الناس لتحقيق مبتغاهم في هذا الدنيا، وإذا تجنّد القوم إلى أيّ عمل، حتّى وإن كان صعبًا، فإنّ النتيجة مضمونة بأدائه على أتمّ وجه.
والتعاون هو صفة فطر الله عليها جميع مخلوقاته، وبها يمكننا إنجاز الأشياء في وقت قصير وتحدي كلّ الصعاب، والمثل الشعبي تطرق إلى هذا وبإسهاب كبير نظرًا إلى أهمّيته في حياتنا، فبفضله يستطيع أفراد المجتمع أن يصلوا إلى أعلى المراتب والرقي والازدهار، ويحافظ على العلاقات بينهم. ومن الأمثال التي تدعو إلى التعاون المثل الشعبي القائل: “نحلة واحدة لا تجني العسل”([50])، هذا يدلّ على أهميّة التّعاون، وهو ضروري في جميع مناحي الحياة، كما أنّ النّحلة لا يمكن وحدها أن تجني العسل، فكذلك الإنسان فهو دائمًا بحاجة إلى الآخرين لمساعدته والوقوف معه في السّراء والضّراء، “فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضًا، فبالتعاون تتحقّق الأهداف الكبرى للأفراد والجماعات وتقوى العلاقات، كما يقال:”باتحاده يشتعل الفحم وبتفريقه ينطفئ“[51]، دلالة على أهميّة الاتّحاد ومساوئ التفريق بين الشّعوب.
ومن الأمانات التي يمتلكها الإنسان”السر” الذي يحفظه ولا يستودعه أحد، لأنّ الإنسان الذي يستودعه أخوه سرَّه يعدّ أمانة أودعها إياه، فيجب المحافظة عليه وصونه. من ذلك نجد المثل الشعبي القائل: “سرك في بير”.
فكلمة “بير” تدلّ على المكان العميق الذي تسقط فيه الأشياء ولا يمكننا إخراجها منه، فالسرّ هنا بمثابة أمانة يحملها الإنسان، فيجب الحفاظ عليها وألّا يخبر بها أحدًا من الناس؛ والراوي الشعبيّ عبَّر لنا بكلمة “بير” لخطورة هذا الشيء وهو السرّ، ورمز به للتستّر على أخبار الناس وحفظها ورميها في البئر، والمثل فيه تشخيص الخفيّ من المواقف والمعاني والسلوكات، والتستّر على عيوب الناس ورميها في بئر، والحكيم الشعبيّ مزج بين العالمين الطبيعيّ والإنسانيّ بهدف تشكيل الجانب الدلالي للنّصّ ولبلوغ الهدف منه: “التداخل بين عالمي الإنسان والطبيعة؛ الأمر الذي كان له أثره الفاعل في التشكّل الدلاليّ للنّص”([52]). والمثل يضرب في وجوب حفظ السرّ جيدا وعدم إفشائه للناس، كما يقال أيضًا: “السرّ بين زوج“[53]. ففي المثل دعوة لعدم تداول السرّ بين أكثر من اثنين، فيؤدي إلى تناقل الخبر ويصبح منتشراً بين الناس، كما أنّ المثل يعبّر بصدق عن الواقع المعاش لأنّ السّرّ إذا عرفه أكثر من شخصين أصبح متداولاً عند كلّ النّاس.
- الصداقة (حسن الصحبة): الإنسان بطبعه كائن اجتماعيّ يحبّ التلاحم والتلاؤم مع الآخرين، فيشكل علاقات وروابط معهم خارج نطاق العائلة. وهذه الروابط والعلاقات إمّا أن تكون مبنية على مصالحه وخدماته، أو علاقات خارجة عن هذا المجال؛ أي المصالح، وهي ما يمكن تسميتها باسم “الصداقة”؛ والصداقة “هي العلاقة التي تربط بين شخصين أو أكثر وتتّسم بالجاذبية المصحوبة بمشاعر وجدانية، فهي علاقة اجتماعيّة وثيقة ودائمة تقوم على تماثل الاتّجاهات بصفة خاصّة، وتحمل دلالات بالغة الأهميّة، تمسّ توافق الفرد واستقرار الجماعة”([54])، ومن تلك المحبّة تكون الصداقة القوية الأخويّة، والأمثال الشعبيّة بدورها تناولت هذا الموضوع بكثرة، ووقفت جنبًا إلى جنب في انتقاء الصديق سواء بالنصح والإرشاد والنهي والابتعاد عن الصداقات القائمة على المصالح، ومن الأمثال التي تحدّثت عن هذه العلاقة الأخوية التي تربط بين صديقين فيصبحان أكثر من إخوة المثل الشعبي القائل: “الصديق عند الضيق”([55]). فالمثل يتحدّث عن الأصدقاء والصداقة والإنسان لا يدرك صديقه الحقيقي إلا إذا حلّت به مشكلة، فيجد صديقه الحقيقيّ في وقت الحاجة إليه للمساندة ومدّ يد العون سواء ماديًا أو معنويًا، فهو يسعد لسعادته ويحزن لحزنه، والمثل كناية عن صفة الإخلاص التي يجب أن يتّصف بها الصديق الحقيقي في جميع الحالات، والأمثال الشعبيّة شجّعت الصداقة النقيّة المبنية على المحبّة والتعاون والأخلاق الرّفيعة؛ لذلك يجب على الإنسان اختيار الأصدقاء بحسب ما يراه مناسبًا له من جانب الأخلاق والتوافق في السنّ والسّمات العقلية والقدرات الذاتية.
- حسن الجوار “الجار”: علاقة الجيران من أهمّ العلاقات في حياة الفرد لأنّ الجار يعرف الكثير من الأشياء والأسرار والسلوكيات عن جيرانه، والأمثال الشعبيّة المتداولة تطرّقت إلى هذا الموضوع وأولته عناية كبيرة، وتناولته بكلّ جهاته، ودعت إلى الحفاظ على هذه العلاقة، وعلى ضرورة الإحسان إلى الجار، وتجنّب كلّ ما يؤدّي إلى زعزعة هذه العلاقة تارة، وتارة أخرى إلى الابتعاد عن الجيران وعدم التقرّب منهم، ومن الأمثال التي تدعو إلى حسن الجيرة المثل الشّعبي القائل: “الجار وصّی عليه النبي”([56]). المثل كناية عن أهمية الجار كما أنّه يحمل دلالة عميقة، وهي الجانب الديني، فالمجتمع له وازع ديني يسترشد به، ومن خلال هذا نفهم بأنّ الجار في مجتمعنا له مكانة مهمة فهم يعملون بوصية الرسول(ص)، ويجعلون أمر الجار ليس بالأمر السهل، فهو من الأمور العظيمة والخطيرة التي يجب أن لا يغفل عنها المؤمن الحقيقي، لأنّ الإحسان إلى الجار من الأخلاق الرفيعة التي يجب أن يتحلّى بها المسلم، والمؤمن الحقيقيّ هو من يعتني بجاره لا من يعتدي عليه ويؤذيه ويسلب منه حقوقه وأشياءه، ومن الضروريات التي يحتاجها الإنسان وتحفظه من الضياع والتّشرد البيت؛ فالبيت هو الذي يستقرُّ فيه الفرد ويحميه من كلّ الظروف والمشاكل الخارجية، كما يحمي ويحافظ به على أسرته. يقال في ذلك: “اشري الجار قبل الدار”([57]).
فاختيار الجار يضمن الراحة والاستقرار، ولأنّ الجار السيئ يؤدّي بالضرورة إلى تحوّله إلى مصدر إزعاج وعدم الاستقرار، لأنّ علاقة الجوار هي علاقة مهمّة تدعو إلى التكافل الاجتماعيّ بين أفراد المجتمع، وهذا التكافل يكون بحسب قدرة واستطاعة كلّ شخص، فهذه العلاقة تحقق الراحة والهدوء. فالجار الذي لا يتعاون مع جاره ويتضامن معه لا فائدة من جواره، لكن في وقتنا الحالي أصبح الواقع الذي نعيشه واقعاً مليئاً بالبغض والحقد والكراهية، وتحوّل الجار إلى عدو ولم يعد الإنسان يأمن على نفسه، وعلى سمعته ولا على ماله وعلى حقوقه؛ لأنّ الناس أصبحت مادية أكثر ممّا هي قضايا إيمانية.
خاتمة واستنتاجات
إنّ المثل الشعبيّ من خلال انتشاره الواسع الكبير بين أوساط النّاس أصبحت له أهمّية فاعلة، ودور كبير في حياتنا لما يحتويه من دلالات اجتماعيّة وسياسيّة وتربويّة وعقائديّة، فهو بذلك يعدّ وسيلة يعبّر بها الإنسان عن مختلف تجاربه، ويمثّل عراقة الشعوب وجذورها، وأصولها تحمل الإرث الحضاري الذي جاء لنا بمجموعة من القيم والقواعد والأخلاق والمبادئ التي يجب أن يسير عليها الفرد.
وهو عند سلام الراسي مزيج ما بين الشعور والتفكير الذهني، ما بين الأدب الاجتماعيّ والواقعية، وإن رجحت كفّة أحدهما على الآخر، إلاّ أنّه أبدع في تصويرهما للواقع، ولا تخفى التجربة الفكرية التي مرّ بها، وخصوصًا التعمّق بالقراءات الاجتماعيّة والتاريخيّة والأدبيّة والسياسيّة والرمزيّة، وقد انعكس ذلك عبر سبكه لنتاجه الأدبي، فخرج بوحدة الرؤية الأدبيّة ووضوح الفكرة وتماسك الأسلوب؛ كلّ هذا لا يغيب الحضور الذاتي في نصّه، ما يسهم في صبغه بلون جنوبيّ متميّز يعود إلى جذوره.
وقد استطاع سلام الرّاسي أن يقدّم رؤية جديدة ومتكاملة في الأمثال الشعبيّة، ونظرة رؤيويّة واعية للمستقبل والأدب المتكامل مع الحياة، يميّزها التفاؤل والنظرة الثاقبة للحياة وللوجود، فانطلق من تجربة شخصيّة عُجنت بالمعاناة الفرديّة من مأساة شخصيّة لتصبح مأساة شعب وأمّة وقضيّة كليّة، وقد تجسّد ذلك من خلال القضايا والموضوعات الاجتماعيّة والصور الفنيّة والرموز.
ومن أبرز النتائج التي توصّل إليها البحث:
- التوافق بين مختلف الشعوب لأنّ المثل الشعبي جنس أدبيّ حيّ متداول عند سكان العالم أجمع، وبالتالي يعبّر عن مختلف تجاربهم ومرآة عاكسة لحياتهم.
- تميّزُ الأمثال الشعبيّة كغيرها من الأشكال الأدبية التعبيريّة الأخرى بخصائص متنوّعة أهمّها: الدقة في التعبير، وإصابة المعنى، وإيجاز اللفظ، وتميّزها بأدائها وظائف في حياة الإنسان بحسب الموقف الذي يتعرّض له، وهذا ما جعل العديد من الأدباء والكتّاب يوظّفونها في أعمالهم الأدبيّة، ويولونها عناية خاصّة.
- الأمثال الشعبية استطاعت من خلال عباراتها الموجزة أن تعبّر عن مختلف العلاقات داخل المجتمع الواحد، و عن العلاقات داخل الأسرة الواحدة، وحاولت بيان العلاقة الصحيحة التي يجب اّتباعها.
- الأمثال الشعبيّة كلّها علاقات قائمة على مواضيع منها: المحبّة والمودة والنزاع والشقاق والتلاحم والتّماسك داخل الأسرة الواحدة وداخل المجتمع.
- نشوء العديد من الأمثال الشعبية التي تهدف إلى تقويم سلوك الفرد داخل الوسط الذي يعيش فيه، وتدعوه إلى الاتصاف بالسلوكيات الحسنة.
فهرست المصادر والمراجع
أوّلاً: المدوّنة
- الرّاسي، سلام: شيح بريح، الأدب الشعبي، مؤسسة نوفل، لبنان، 2014م.
ثانيًا: المصادر والمراجع
- ابن منظور، لسان العرب، ج 11، دار صادر، لبنان، بیروت، د.ط، .1968
- أمين، احمد: فجر الإسلام، يبحث عن الحياة العقلية في صدر الإسلام إلى آخر الدولة الأموية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط 10، 1969
- بورايو، عبد الحميد، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2007.
- التلي بن الشيخ: منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،1990
- الجوزية، ابن قيم، الفرائد، تح: محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، صیدا، بیروت، ط2، 1999
- الجوهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد العطار، مجلد2، ط4، دار العلم للملايين، 1990
- حسام الدين، کریم زكي، أصول تراثية في علم اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط2، 1985.
- حليتيم، لخضر، صورة المرأة في الأمثال الشعبية الجزائرية.
- زغبي، أحمد، الأدب الشعبي بين الدرس والتطبيق، مطبعة مزاور،الوادي، ط 1، 2008
- عبد الحميد بورايو: البعد النفسي والاجتماعيّ في الأدب الشعبي الجزائري، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر، ط 1، ديسمبر 2008.
- عبد الحميد، علي عبد المنعم، المجتمع والحياة (دراسة على ضوء الكلم الطيب)، ج2، دار القلم، الكويت، ط1، 1981 م.
- عدلاوي، علي بن عبد العزيز، الأمثال الشعبية ضوابط وأصول منطقة الجلفة نمودجا، دار الأوراسية، ط 1
- عشتار داود محمد: الإشارة الجمالية في المثل القرآني – دراسة -، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق، 2005.
- فالق، سمية، البنية والإيقاع في الأمثال الشعبية، المعنى بحلة أدبية محكمة، المركز الجامعي خنشلة، العدد الأول، جوان، 2008،
- فندريس، جوزف، اللغة، تر. عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، 1950.
- كهينة، قاسمي، الأمثار الشعبية في منطقة لمهير – دراسة تاريخية وصفية، بحث مقدم لنيل لهادة الماجستير، جامعة المسيلة 2008/2009.
- کهينة، قاسمي، الأمثال الشعبية في منطقة المهير، دراسة وصفية تحليلية .
- المبارك، محمد، فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط7، 1981
- محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، 1998م.
[1]-عدلاوي، علي بن عبد العزيز، الأمثال الشعبية ضوابط وأصول منطقة الجلفة نمودجا، دار الأوراسية، ط 1، 2010، ص 45.
[2]-م.س. التلي بن الشيخ، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري، ص 157 – 158.
[3]-فالق، سمية، البنية والإيقاع في الأمثال الشعبية، المعنى بحلة أدبية محكمة، المركز الجامعي خنشلة، العدد الأول، جوان، 2008، ص 130.
[4]– م. س. الراسي، سلام، حكي قرايا وحكي سرايا، ص113
[5] – سلام الراسي، شيخ الأدب الشعبيّ، ولد عام 1911 في بلدة إبل السقي، جنوب لبنان. تنقّل بين وظائف عامّة متنوّعة، وبقي على هذا المنوال حوالى عشرين عامًا لحين تقاعده. نشر أوّل كتبه سنة 1971 عن عمر يناهز الستّين. كتب الراسي الشعر والزجل شابًّا، ثمّ تحوّل إلى جمع المأثور الشعبيّ ومجمل أصناف الأدب القرويّ. نال عن مؤلّفاته عددًا من الأوسمة والتكريمات، كما حصد برنامجه «الأدب الشعبيّ في لبنان» شهرة واسعة. توفّي عام 2003 عن 92 عامًا.
[6]– التلي بن الشيخ: منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د. ط،1990، ص 155.
[7]– زغبي، أحمد، الأدب الشعبي بين الدرس والتطبيق، مطبعة مزاور،الوادي، ط 1، 2008، ص 88.
[8]– بورايو، عبد الحميد، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2007، د. ط،، ص 67 – 68.
[9]– محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، ص 36.
[10]– م. س. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 56.
[11]– م. ن. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 86.
[12] – م.س. الراسي، سلام، حكي قرايا وحكي سرايا، ص63.
[13] – م.ن. الراسي، سلام، حكي قرايا وحكي سرايا، ص 65.
[14] – الراسي، سلام، شيح بريح، ص 128.
[15] – م. س. الراسي، سلام، شيح بريح، ص27.
[16] – م.ن. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 77.
[17] – م.ن. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 163.
[18]– حليتيم، لخضر، صورة المرأة في الأمثال الشعبية الجزائرية، ص 121.
[19]– م. س. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 193.
[20]– كهينة، قاسمي، الأمثار الشعبية في منطقة لمهير – دراسة تاريخية وصفية، بحث مقدم لنيل لهادة الماجستير، جامعة المسيلة 2008/2009، ص 103.
[21]– م. س. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 43..
[22]– م. س. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 123.
[23]– م.س. الراسي، سلام، حكي قرايا وحكي سرايا، ص 51.
[24]– عبد الحميد بورايو: البعد النفسي والاجتماعي في الأدب الشعبي الجزائري، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر، ط 1، ذي الحجة 1429 – ديسمبر 2008، ص 120.
[25] – م.ن. الراسي، سلام، حكي قرايا وحكي سرايا، ص 179.
[26]– التلي بن الشيخ، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري، ص 161.
[27]– م.س. الراسي، سلام، حكي قرايا وحكي سرايا، ص 96.
[28]– م.س. الراسي، سلام، حكي قرايا وحكي سرايا، ص 26.
[29]-م.س. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 139.
[30]-حليتيم، لخضر، صورة المرأة في الأمثال الشعبية، ص 142.
[31]-عبد الحميد، علي عبد المنعم، المجتمع والحياة (دراسة على ضوء الكلم الطيب)، ج 2، دار القلم، الكويت، ط1، 1981 م، ص107.
[32]– الراسي، سلام، شيح بريح، ص 181.
[33]– م.ن. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 181.
[34]– م.ن. الراسي، سلام، حكي قرايا وحكي سرايا، ص 51.
[35]– م.س. الراسي، سلام، حكي قرايا وحكي سرايا، ص148.
[36]– م.ن. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 159.
[37]– الجوزية، ابن قيم، الفرائد، تح: محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط2، 1999، ص58.
[38]– م. س. الراسي، سلام، حكي قرايا وحكي سرايا، ص 76.
[39] – المعري، أبو العلاء، قصيدة غير مجد، الديوان، ص 138.
[40] – م. س. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 123.
[41] – م. ن. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 80
[42]– م. س. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 111.
[43]– م. س. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 122.
[44]– م.س. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 111.
[45]– م. ن. الراسي، سلام، شيح بريح، ص .29
[46]– م .ن. الراسي، سلام، الناس بالناس، ص 164.
[47]– م .س. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 111.
[48]– م . س. الراسي، سلام، حكي قرايا وحكي سرايا، ص 114.
[49]– م . س. الراسي، سلام، شيح بريح، ص87.
[50]- م.س. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 139..
[51]– م.س. الراسي، شيح بريح، ص 69.
[52]– عشتار داود محمد: الإشارة الجمالية في المثل القرآني – دراسة -، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق، 2005، ص 76.
[53]– م.س. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 268.
[54]– کهينة، قاسمي، الأمثال الشعبية في منطقة المهير، دراسة وصفية تحليلية -، ص 123.
[55]– م.س. الراسي، سلام، شيح بريح، ص 129..