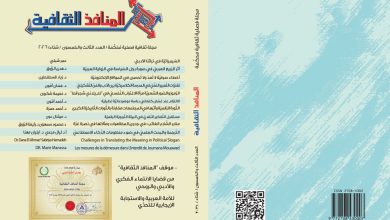القانون الرّومانيّ تطوّره التّاريخيّ وإسهاماته في تشكيل النّظم القانونيّة الحديثة
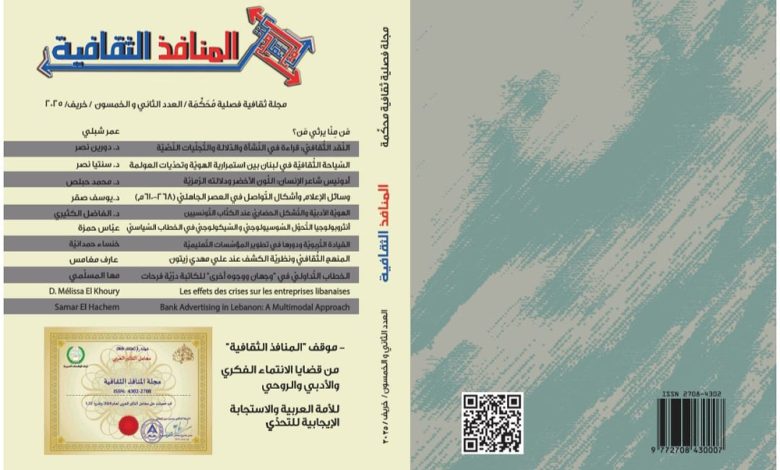
القانون الرّومانيّ تطوّره التّاريخيّ وإسهاماته في تشكيل النّظم القانونيّة الحديثة
The Roman Law Its Historical Development and Contributions to the Formation of Modern Legal Systems
د. هاني حسن حوماني(*)
Dr. Hani Hassan Houmani
تاريخ الاستلام 5/ 6/ 2025 تاريخ القبول 24/ 6/2025
ملخص
هذا الموضوع يتناول المقدمة ثم يبحث في التّعرف على القانون الرّومانيّ ويبين إسهاماته في تشكيل النّظم القانونيّة، ثم يستعرض مراحل تطوّره التّاريخيّ وانتشاره عالميًّا، كما يتناول عدة مواضيع منها مفهوم القانون وأهميته التّاريخيّة التي يشرحها البحت من عدة أوجه وهي الأسباب التي جعلت من القانون الرّومانيّ ذا أهمية دوليّة، ثم يشرح البحث التطوّر التّاريخيّ للقانون الرّومانيّ الذي يتناول أيضًا المراحل في العصور المختلفة، منها العصر الملكيّ والجمهوريّ والإمبراطوريّ، كما يتناول ذلك التطوّر بتعمّق أكبر، وكيف يتميّز من مرحلة إلى أخرى في القانون القديم وفي العصر العلميّ وكذلك في مرحلة تجميع القانون الرّومانيّ، كما يتناول البحث مصادر القانون الرّومانيّ لمختلف العصور والذي يشرح العرف والتّشريع وقانون الشّعوب والقانون البريتوريّ والفقه الرّومانيّ، ثم يتناول البحث بعض أنظمة القانون الرّومانيّ التي تشرح قانون الألواح الإثنى عشر ومجموعة جستنيان القانونيّة وبعض أنظمة القانون الرّومانيّ.
كلمات مفتاحة: القانون الرّومانيّ، التطوّر التّاريخيّ، النّظم القانونيّة الحديثة والمقارنة، التّأثير الرّومانيّ.
Abstract
This study begins with an introduction, followed by an exploration of Roman law and an explanation of its significance. It then presents the historical stages of its development and its global dissemination. The study addresses several topics, including the concept of law and its historical importance, explained from various perspectives that clarify the reasons behind Roman law’s international relevance.
The research also examines the historical evolution of Roman law, covering different periods such as the Monarchical, Republican, and Imperial eras. It delves deeper into how each phase is distinguished, from the archaic period to the classical age, and finally to the phase of legal codification.
Furthermore, the study discusses the sources of Roman law across different historical eras, elaborating on custom, legislation, the Law of Nations, praetorian law, and Roman jurisprudence. It also highlights specific legal systems within Roman law, including the Law of the Twelve Tables, the Justinian Code, and other Roman legal systems.
The research concludes with a summary of findings, recommendations, and a list of references.
Keywords: Roman Law, Historical Development, Modern and Comparative Legal Systems, Roman Influence.
المقدمة
إنّ تاريخ القانون بصفته علمًا يعدّ جزءًا لا يتجزأ من المنظومة القانونيّة وأحد المصادر الأخرى للقانون المدنيّ، حيث أظهر ابن خلدون آراءه في الأحداث التّاريخيّة المتتابعة والواقعات المتتالية على مر الأجيال، أنّ الجانب الفلسفيّ في فكره يتمحور من خلال الشّكل والمضمون، أي من حيث الذّات والموضوع والجوهر والظّاهر والصّيرورة والتطوّر في إطار واقعيّ وعقلانيّ في تطوّر المجتمعات(1)، لذلك نجد أنّ نشأة القانون الرّومانيّ كغيره من القوانين القديمة مرّت بعّدة مراحل متأثّرًا بالبيئة الاجتماعيّة في مدينة روما ثم انتشر إلى ايطاليا ثم إلى معظم الإمبراطوريّة الرّومانيّة حتى أصبح مصدرًا لكثير من القوانين العالميّة في العصر الحديث ومنها في اسكتلندا وإفريقيا الجنوبيّة، وعليه سوف نتناول البحث على النّحو الآتي:
الإشكالية
ما مدى تأثير تطوّر القانون الرّومانيّ عبر العصور في تشكيل وتأسيس المبادئ الجوهريّة للنّظم القانونيّة الحديثة، وما أوجه التّشابه والاختلاف بينه وبين تلك النّظم؟
أهمية الدّراسة
تظهر الأهمية للقانون الرّومانيّ في اهتمام الجامعات في مختلف البلدان، فالقانون الرّومانيّ تميّز عن غيره من القوانين المعاصرة بطبيعته القانونيّة التي طبقت في العصور القديمة.
ثالثًا: أسباب اختيار موضوع الدّراسة
إنّ الحاجة لمعرفة القانون الرّومانيّ تكمن في الآتي:
إعطاء مفهوم وتعريف للقانون وتبيان مراحل تطوّره التّاريخيّ.
- إسهاماته في تشكيل النّظم القانونيّة
- أسباب انتشاره السّريع عالميًا.
- إظهاره كمصدر لكثير من القوانين الغربيّة.
أهداف الدّراسة
- دراسة أحد أهم القوانين القديمة ومعرفة مراحل تطوّره الحضاريّ.
- التّعرّف على مدى تأثّره وتأثيره في القوانين وعلى الأفراد والشّعوب لتلك الحضارات القديمة.
- استعراض القواعد القانونيّة المختلفة وما يميّزها عن القوانين خلال مراحل التّاريخ الحضاريّ
- الأخذ به كمرجعية للقوانين القديمة ومصدر للقوانين الغربيّة.
- عرض الأسباب العمليّة والعلميّة التي جعلته أكثر ازدهارًا و قابلية بين الشّعوب.
منهج الدّراسة
اعتمدتُ على المنهجيّة المتبعة للبحث العلميّ والأكاديميّ وخاصة المنهج التّاريخيّ البحثيّ والاستنباطيّ.
خطة الدّراسة
يتألّف هذا البحث من مقدمة وأربعة عناوين رئيسة وخاتمة وتوصيات وقائمة بالمراجع، ولأجل التّوصل إلى معرفة القانون الرّومانيّ لابد لنا أن نحدد تعريفه وأهميته وتطوّره ومصادره وأنظمته وذلك على النّحو الآتي:
أولًا : تعريف القانون الرّومانيّ وأهمية إسهاماته.
ثانيًا: التطوّر التّاريخيّ للقانون الرّومانيّ.
ثالثًا: مصادر القانون الرّومانيّ.
رابعًا: أنظمة القانون الرّومانيّ.
أولا: تعريف القانون الرّومانيّ
يعرف بأنّه مجموعة من القواعد القانونيّة التي تحكم سلوك الإفراد في الجماعة التي يتعيّن عليهم الخضوع لها ولو بالقوّة إذا لزم الأمر، ومنذ إنشاء روما العام ٧٥٤ ق.م حتى القرن السّادس الميلاديّ حيث توفي الإمبراطور جستنيان العام ٥٦٥ق م .
- إسهامات القانون الرّومانيّ
إنّ دراسة القانون الرّومانيّ في الجامعات في العالم دليل على تلك الأهمية التي تكمن في قواعده القانونيّة، وهذه الأهمية تبرز المكان والمصدر القانونيّ لكثير من قوانين العالم مثل قوانين فرنسا وألمانيا، وهناك دول أخرى أخذت بالقانون الرّومانيّ، خاصة القوانين المدنيّة التي تأثّرت بعض الدّول العربيّة وخاصة في الحقّبة الاستعماريّة والتي أخذت به إلى جانب إحكام الشّريعة الإسلاميّة بالدّرجة الأساسيّة، فإذا نظرنا إلى المجموعة القانونيّة المدنيّة المصريّة الصّادرة في سنة ١٩٤٨م يظهر أنّها أخذت بالقانون الفرنسيّ المستمد من القانون الرّومانيّ، وكذلك أيضًا بالقوانين الجرمانيّة كالقانون المدنيّ الألمانيّ والقانون السّويسريّ اللذين تأثّرا بالقانون الرّومانيّ(1).
- أسباب أهمية القانون الرّومانيّ
تكمن الأسباب على النّحو الآتي:
- القانون الرّومانيّ أسباب علميّة
تمكّن الفقهاء الرّومان أن يضعوا علمًا يختلف عن بقية العلوم الاجتماعيّة، كالدّين والفلسفة والأخلاق حيث عدّوا القانون علمًا مستقلًا وذلك من خلال الأسس العلميّة التي تقوم عليها دراسة القانون، وما زالت هذه الدّراسات هي العماد التي تقوم عليه الدّراسات القانونيّة الحديثة(2).
- أسباب عمليّة
ما زالت كثير من الدّول الأوربيّة المعاصرة تطبق القانون الرّومانيّ سواء من حيث المدلول والصياغة والمصطلحات، وإنّ المبادئ الجرمانيّة والانجلوسكسونيّة أو نظم العصور الوسطى إلى القانون الرّومانيّ، وظلّ إلى إن ظهرت متغيّرات أدّت إلى وجود تعديلات، وخاصة في القرن الثّاني عشر ظهرت مجموعة جستنيان والتي تأثّرت بها أوروبا واقتبست منها قوانينها(1).
وتعرّض للسّقوط وخاصة في الدّول الرّومانيّة الشّرقية عندما سقطت معظم أجزائها في أيدي المسلمين في القرن السّابع الميلادي حتى وصول المسلمين إلى كلّ الدّول التي كانت خاضعة للرّومان مثل أسيا الصّغرى وغيرها(2)
ثانيًا: التّطوّر التّاريخيّ للقانون الرّومانيّ
تختلف كل مرحلة من مراحل تطوّر القانون الرّومانيّ عن المرحلة الأخرى بمميزات عديدة، وفي الغالب يسود كل مرحلة جديدة أسلوب الأفضليّة عن سابقتها وذلك بوجود صبغة جديدة ومميزة، وهذا ما عكس على المجتمع تطوّرا في القاعدة القانونيّة الجديدة، ولو نظرنا إلى نظام الحكم الملكيّ كيف تحوّل إلى جمهوريّ ثم إلى نظام حكم مطلق وهذا يكفي كدليل للتطوّر القانون الذي لامس الواقع الاجتماعيّ، وقد خصّص هذا لدراسة تطوّر القانون الرّومانيّ، وذلك على النّحو الآتي:
- لمحة تاريخيّة لتطوّر القانون الرّومانيّ
يبدأ هذا العصر بنشأة روما وقيام النّظام الجمهوريّ العام 509 ق.م وهذا ما سوف نتناوله على النّحو الآتي:
- العصر الملكيّ
تعدّ العشيرة هي الوحدة الاجتماعيّة والسّياسيّة الأولى، فالشّعب الرّومانيّ يتكوّن من عدّة عشائر وذلك قبل الغزو الاتروسكي لهم وتأسيس المدينة، وكلّ عشيرة تتكوّن من عدد من الأسر ويسمون بأفراد العشيرة وتحت اسم واحد هو مؤسس العشيرة ولكل فرد اسم آخر يحمل صفاتهم التي تميزه عن غيره من الناس، وعدّت العشيرة الرّومانيّة الأفراد الذين تم الاستيلاء عليهم سواء بحرب أو بغيره، والذين يعدّون عبيد وموال وأجانب وغرباء أعداء ومهزومين وتابعين للعشائر طالما هم في أوساط المجتمع الرّومانيّ، حيث أدى ذلك إلى ظهور نظام المدينة الذي ظهر عندما استولى الاتروسك الرّومان جعلوا من روما وحدة سياسية ومكانا للسلطان ومجمع لجميع العشائر، ومن ثم ظهر نظام العصر الملكيّ، وظهرت فيه ثلاث هيئات تحكم روما وهي: الملك، ومجلس الشّيوخ، ومجلس الشّعب، نتناولها على النّحو الآتي:
- الملك
يعدّ الملك رأس السّلطة في المدينة، وصاحب السّلطة العامة فيها ويتولّاها مدى الحياة وإن اتّفق أنّ المُلك ليس بالوراثة بل كان الملك يعين بواسطة سلطة، فإذا لم يقم الملك بتعين من يخلفه في الحكم، يتم هذا التّعين بواسطة مجلس الشّيوخ ويسمّى بالوسيط بحيث يقوم مجلس الشّيوخ بانتخابه لهذه المهمة وكان الملك يعيّن أحد أعضاء مجلس الشّيوخ ملكًا بعد وفاته(1).
- صلاحيات الملك
يعدّ الملك هو الرّئيس الأعلى وله الرّئاسة الدّينيّة والقضائيّة ويقود الجيش والسّلطات الإداريّة ويدعو المجلسين إلى الانعقاد وهو من يقوم بدور المرشد للعبادة الدّينيّة للمدينة وهو الوحيد الذي يستلم الأشياء المقدسة ويعدّ أيضًا الرّئيس القضائيّ الذي يعاقب على الجرائم العامة أما المنازعات المدنيّة فلها هيئة خاصة تختص بالحكم في المنازعات المدنيّة تسمى هيئة التّحكيم الخاص(2)
- مجلس الشّيوخ
كان أعضاء هذا المجلس على الأرجح من بين رؤوسا العشائر ويزداد أعضاؤه بنفس عدد العشائر وقد وصل عدد الأعضاء إلى ۳۰۰ عضوًا وهذا المجلس يتولّى التّصديق على قرار مجلس الشّعب الذي لم تكن قرارته ملزمة إلا بعد مصادقة مجلس الشّيوخ عليها، ويعدّ هذا من أهم اختصاصات مجلس الشّيوخ في العهد الملكيّ حتى فقد كثيرًا من هذه الاختصاصات تدريجيًّا منذ بداية العصر الجمهوريّ(3).
- مجلس الشّعب
يتكوّن هذا المجلس من سكان المدينة الأحرار والقادرين على حمل السّلاح للدّفاع عن الوطن، وكان يطلق عليهم الشّعب الرّومانيّ الأصيل أي الذي يتكوّن من القبائل الثّلاث التي تكوّنت منها المدينة وقد انقسم الشّعب إلى ثلاثين وحدة وكان لكل قبيلة وحدات اجتماعيّة، وهذه الوحدات كانت أساس النّظام السّياسيّ والإداريّ والعسكريّ، والرّاجح بين شارح القانون الرّومانيّ انّه لم يكن لتلك المجالس اختصاص في تعين الملك كما لم يكن لها اختصاص تشريعيّ، ولكن موافقة مجلس الشّعب كانت واجبة، وهذا المجلس في الإشراف للعامة وبعد أن تطوّرت المدينة بدأ يحصل تعديل حتى أصبح العامة لهم الحقّ في العضويّة(1).
- العصر الجمهوريّ
يتحدّد هذا العصر في المدة الواقعة بين العام 509 ق.م 27م حيث تشير الدّراسات إلى أن تسمية هذا العصر لا تتوافق مع العمر الزّمنيّ لان مصطلح الجمهوريّ من المصطلحات الحديثة إلا أنّها قد تعود إلى اسم شخص يدعى (جمهور) الذي أحدث ثورة شعبيّة وخلال هذه الحقّبة تحوّل النّظام من ملكي إلى جمهوريّ، ما أدى إلى انكماش سلطة الملك وسلطة الحكام المختارين من الشّعب حتى ظهرت أجهزته التي تدير النّظام السّياسيّ في هذا العصر وهي على النّحو الآتي:
- القنصلان
يتم اختيار القنصلين من مجلس الشّعب ومدة ولايتهما سنة واحدة فقط ويتساوى القنصلان في المهام إلا أنّ الحاجة إلى وجود حكام آخرين كانت مسألة ضرورية، وذلك بسبب اتساع الدّولة بالسكان أدى إلى توسعة المجالس الشّعبية وتكليفهم اختصاصات تتعلق بالشؤون الإداريّة والقضائيّة والسّياسيّة والعسكريّة وأولئك الحكام يتم اختيارهم من المجالس الشّعبية وهم على النّحو الآتي :
- حكام الإحصاء
يتم انتخاب اثنين فقط من مجلس الشّعب لهذه الوظيفة لمدة خمس سنوات وتحدّد اختصاصاتهم بإحصاء كل المدن والقرى والهدف من ذلك رصد الضّرائب ومعرفة العمر لأجل الاستفادة من الشّباب في الخدمة العسكريّة التي تعدّ شرفًا كبيرًا للرّوماني ولا يسمح لغيرهم في هذا الشّرف كما يعملون على إحصاء كل من ارتكب الجرائم العديدة من الرّومان، ويحرم من هذا الشّرف والأداء الوطنيّ المقدس (الخدمة العسكريّة)(2).
- الحاكم المدقّق
يتم انتخاب الحكّام عن طريق المجالس الشّعبيّة على أن يكون عددهم أربعة يعملون في هذه الوظيفة حتى تطوّر العدد إلى عشرين موظف، ويتم لمدة سنة فقط وتتحدّد وظائفهم في التّحقيق الجنائيّ والمسائل الجنائيّة.
- الحاكم القضائيّ (البريتور)
يختصّ هذا الحاكم في النّظر في القضايا المدنيّة حيث كانت هذه الوظيفة محدّدة لحاكم واحد فقط يسمى بريتور المدينة إلا أنّه تم تعين بريتور آخر يختصّ لقضايا الأجانب وتستمر مدة الوظيفة ثمانية عشر شهرًا كما يعد بريتور المدينة حاكم قضائي للولاية.
- حكام الأسواق
أنشئت هذه الوظيفة لأجل إدارة أعمال الشّرطة في المدينة والإشراف على الأسواق والملاعب العامة ومراقبة بيع العبيد والمواشي، كما يحقّ لهم فرض العقوبات وخاصة الغرامة المالية لمخالفي القانون.
- حكام آخرون
يتم اختيارهم من المجالس الشّعبية حكاما آخرين بوظائف الحماية الأمنية لمدنيين ومراقبة الغش وجباية الضرائب والغرامات والحفاظ على خزينة الدّولة وتنظيم النفقات(1)
- العصر الإمبراطوريّ
إنّ التّطوّرات التي حصلت في الأنظمة الرّومانيّة قد أظهرت نموًا جديدًا في المصطلحات القانونيّة مثل الإمبراطور، وهذه الكلمة تعني العظيم، وجا الإمبراطور بديلًا عن القنصلين اللذين يحكمان الدّولة حتى صارت السّلطة لشخص واحد هو الإمبراطور الذي ينفرد بالمهام السّياسيّة والاجتماعيّة والدّينيّة كافة وفرض سلطاته على الناس جميعهم، إلا أنّ مجلس الشّيوخ مازال كما هو لم يتغيّر، ويعدّ الشّريك في الحكم، ولكن أصبحت صلاحياته أقلّ مما كانت عليهم من مهام، أي أنّ الإمبراطور وضع قانونًا حدّد الاختصاصات التّشريعيّة والإداريّة والماليّة، وظهر في هذا العهد تطوّر جديد على نطاق قانون العقوبات وخاصة على الزّاني والملحد، وطبق قانون الوصية وجعل من طبقة الملاك بالمرتبة الأولى في المجتمع(2).
ب. مراحل تطوّر القانون الرّومانيّ
المراحل التي مرّ بها تاريخ تطوّر القانون الرّومانيّ نستعرضها من خلال تقسيم هذه المراحل إلى ثلاثة تقسيمات وهي على النّحو الآتي:
- المرحلة الأولى: القانون القديم
تشمل هذه المرحلة مدّة العصر الملكيّ والعصر الجمهوريّ فقد كان القانون ينسب إلى الملوك ويظهر بصورة بدائيّة، حيث اعتمد في بادئ الأمر على الرّعي والزّراعة واتّسم بالقوّة ومن ثم ظهر قانون الألواح الإثنى عشر الذي يتضمّن مائة مادة قانونيّة وسوف نستعرض هذا القانون بالتّفصيل لاحقا.
- المرحلة الثّانية: العصر العلميّ
سمي هذا العصر بالعلميّ نسبة إلى ظهور كثرة العلماء فيه، وهذا لم يأت إلا بعد تطوّر سمي ملحوظ في كافة المجالات من ازدهار وغيره ومن القوانين التي ظهرت في هذه المدّة قانون إيبوتا وانتهت بحكم الإمبراطور (دقلديانوس) العام 284م، والذي أدخل نظام الدّعوى الكتابيّة والتّخلّص من الشّكليّات التي وجدت على القانون الرّومانيّ وخاصة في تقسيم القوانين وبيان الحلول للمشكلات.
- المرحلة الثّالثة: تجميع القانون الرّومانيّ
تبدأ هذه المرحلة من العام ٥٦٥م بوفاة الإمبراطور جستنيان حيث تدهور الوضع الثّقافيّ والقانونيّ وابتعد رجال القانون عن الاجتهاد وسادت الروح العسكريّة وساد مبدأ الديكتاتورية (مركز السّلطة) وأصبحت إرادة الأباطرة هي القانون، حيث ظهرت الصورة الديكتاتورية على نمط الحكم مما أدى إلى انهيار المجتمع من الداخل والخارج وبالتالي ظهرت مجموعة لإنقاذ القانون والعمل على تجميعه ومن بين القوانين التي تم تجميعها هي مجموعة جستنيان القانونيّة(1)
ثالثًا: مصادر القانون الرّومانى لمختلف العصور
من أهم المصادر الأساسية للقانون الرّومانيّ المعاصر قانون الألواح الإثنى عشر ومجموعة الإمبراطور جستنيان القانونيّة وسوف نشير عنها لاحقا حيث تشير الدّراسات القانونيّة أنّ مصادر القانون الرّومانيّ كانت متعدّدة ويمكن حصرها على العصر الملكيّ والجمهوريّ والإمبراطوريّ(2) وسوف نتناول النّقاط التّالية:
- العرف
كان العرف لدى الرّومان مثل بقية الشّعوب القديمة وهو أقدم وأهم مصادر القاعدة القانونيّة حيث ظل العرف يحتفظ بهذه المكانة العالية حتى بداية عصر الإمبراطوريّة السّفلى حينما أصبح للتّشريع المقام الأول بين مصادر القانون وعليه فإننا سوف نتناول النقاط التالية:
- العرف في العصر الملكيّ
تكوّن العرف من مزيج من العادات والتّقاليد القبليّة التي استوطنت روما وخاصة التّقاليد التي تأتى من طبقة الأشراف الرّومانيّة دون تقاليد العامة على أن تكون وثيقة بالدّين كحاصل لها، حيث كان الجزاء على من يخالف العرف وتطبق عليه العقوبة المتعارف عليها في العرف وتكون الأحكام في سريّة من قبل رجال الدّين فقط، ومن ثمّ أخذ العرف يتطوّر بسبب كثرة المساحة السكانيّة ومن ثم تطوّر في طبيعة الصيغة القانونيّة التي أسبغ عليها الكهنة صفات سريّة ودينيّة إلى أن ظهر هناك تطوّر في المجتمع أدّى إلى تعديل العرف.
- العرف في العصر الجمهوريّ
بظهور قانون الألواح الإثنى عشر في منتصف القرن الخامس ق. م أدى تطوّر القانونيّ إلى تغير طبيعة الالتزام في القاعدة العرفيّة فلم تكن القاعدة العرفيّة تستمدّ قوّتها الإلزاميّة من أصلها الدّينيّ بل من رضا النّاس عنها وأصبح الجزاء الذي كانت تفرضه بواسطة أصلها الدّينيّ إلى الطابع المدنيّ، ومن يخالف ذلك يترتب عليه الجزاء، وأيضًا لم تعد تخصّ طبقة الإشراف بل العامة أيضًا، وفي هذا العصر أسهم الفقهاء في تطوير الصّيغ القانونيّة وأسلوب الدّعاوي، ومن أشهر هذه المجموعات مجموعة (فلافيوس) العام 304 ق . م ثم شملت القواعد التّشريعيّة أيضًا وهذا بدوره أدّى إلى تطوير القاعدة العرفيّة(1).
- العرف في عصر الإمبراطوريّة العليا
ظلّ العرف كما هو في العصر الجمهوريّ أيضًا في عصر الإمبراطوريّة العلياء، إذ ظهر فيه من استطاع أن يعمل على التعديل، ففي هذا العصر تم استحداث وتعديل وإلغاء كثير من القواعد ومثال على ذلك ظهور الأعراف المحليّة بجانب الأعراف العامة.
- العرف في عصر الإمبراطوريّة السفلى
لم يكن هناك مصادر أخرى غير إرادة الإمبراطوريّة التي استطاعت بقوّتها عدم إعطاء الحقّ للأقاليم في التّعديل أو الإلغاء أو ما إلى ذلك، ويطبّق العرف إذا لم يتعارض مع إرادة الإمبراطور وقراراته.
ب. التّشريع
يفهم التّشريع بأنّه: قاعدة قانونيّة محددة وصادرة من سلطة مختصّة بالتّشريع والتي أدّت دورًا بارزًا في تطوير القانون الرّومانيّ حتى عصر الإمبراطوريّة السفلى ، وحينئذ أصبح التّشريع المصدر الوحيد للقانون والعرف لا يعدّ مصدرًا إلا عند العودة إليه في حالة خلو التّشريع من القاعدة القانونيّة(1) وسوف نتناول التّشريع في العصرين الملكيّ والجمهوريّ وذلك النّحو التالي:
- التّشريع في العصر الملكى
لم تشر الدّراسات إلى التّشريع القديم وإنما إلى التّشريع الجديد الذي أدّى دورًا في تطوّر القانون حيث أشارت الدّراسات إلى أن صدور تشريعات ملكيّة كانت غير مألوفة، ولكن صدورها على أرض الواقع شكّل لها أهمية اجتماعيّة وإن كان في طابعها الشّكل الدّينيّ، وهي عبارة عن أوامر ملكيّة صدرت من الملك بصفته يعد رأس الكهنة وهي أعلى مرتبة دينية لا يتقلدها غير الملك(2)
- التّشريع في العصر الجمهوريّ
اتّخذ مجلس الشّعب التّشريع كمصدر أساسي للقانون حيث قدّم هذا كمقترح إلى مجلس الشّيوخ وطالبهم بالمصادقة عليه على أن يصدر باسم الحاكم، وينقش ذلك على ألواح خشبيّة أو الأحجار أو البرونز ويعلّق في ساحة الإعدام، حيث عرف في ذلك العصر شكل القانون حيث اشتمل كل قانون على ثلاثة أجزاء وهي المقدمة والنّص المقدم وهو التّعريف بالقانون ثم الجزاء، ففي المقدمة ديباجة متعارف عليها عند أهل القانون والعرف القانونيّ ومن ثم اسم الملك والحكام من مجلس الشّيوخ والشّعب وأيضًا يضعون تاريخ الإصدار وعدّ ذلك نموذجًا في الأحكام التي تصدر في المحاكم(3) وفي ذلك العصر ظهرت كثير من القوانين وهي على النّحو الآتي:
- قانون كانوليا : صدر هذا القانون العام 245 ق م وأباح حرية الزّواج بين طبقة الزّواج وطبقة الإشراف وطبقوه العامة.
- قانون بركيليا : الذي صدر العام 204 ق م وقيد هذا القانون من حالات إلقاء اليد والتنفيذ على جسم المدين.
- قانون اكوبيليا: صدر العام 286 ق.م ونظم هذا القانون جريمة الاعتداء على مال الغير أي فيما يتعلق بالمسئولية التقصيرية.
- قانون ايبوتياء: وهو من أهم القوانين التي صدرت في العصر القنصليّ فقد أدخل هذا النّظام المرافعات الكتابيّة القائم على نظام البرنامج وهو عبارة عن محور يحرّره الحاكم القضائيّ ويحدّد فيه موضوع النّزاع ومهمة القاضي بناء على طلب الطّرفين وكان لهذا القانون أثر كبير على تقدم القانون الخاص.
ذكر المؤرخون في عصر الإمبراطوريّة بعض القواعد المنظمة للعلاقات الفرديّة في هذا العصر، حيث كانت تصدر من مجلس الشّعب أو مجلس الشّيوخ إلى جانب القرارات التي تصدر عن القناصل، وكانت تلك القرارات تأخذ شكل إعلان يرجع إليه إفراد الشّعب ويعملون به، وهذه القرارات لا تعدّ إلزامية لأنها لا تتضمن أي جزاء للشخص الذي يخالفها، والفتاوى في ذلك يصدرها الحكام والملوك هي صدر من صدور الدساتير الإمبراطوريّة وهي تتضمن الآراء الفقهية وهذه الآراء تكون فقط ملزمة للقاضي. وفي هذا العصر بدأ التّشريع يتراجع عن أهميته حيث فقدت المجالس العامة اختصاصاتها بالتّشريع منذ أواخر القرن الميلادي الأول وانتقل هذا الاختصاص إلى مجلس الشّيوخ ثم انتقل في أوائل القرن الثّالث الميلادي إلى الإمبراطوريّة ثم فقد التّشريع صلاحياته تماما عندما أصبح المصدر الأساسي هو إرادة الإمبراطور(1).
- قانون الشّعوب
كان ثمة اعتقاد خاطئ لدى الرّومان من ناحية الأجانب ولذلك كان الأجانب لا يتمتعون بأي حماية قانونيّة ولا قيمة لهم في نظر الرّومانيّ ولا يطبق عليهم القانون الرّومانيّ لأنه مقصور على المواطنين الرّومان فقط، وبعد تطوّر العلاقات ذات الطّابع الدّبلوماسيّ أصبح للأجانب بعض الحماية ثم تطوّرت الحماية الأجنبيّة بعد عصور عديدة، حيث كان الأجنبي يعقد اتفاق مع الرّومانيّ ويظل تحت حمايته.
خلال العصر الجمهوريّ عقدت روما بعض المعاهدات مع الدّول المجاورة حيث اعترفت فيها برعاية الأجانب في روما وتشمل هذه الرعاية مثل حق التقاضي وحق الزّواج من الرّومان ، وفي العام 242 ق . م تم تعيين بريتور خاص للأجانب وقضاياهم وعلاقتهم مع الرّومان ، وأخذت الأمور في هذا المنحى حتى أواخر القرن الميلادي الأول اكتسب كل أبناء ايطاليا الجنسية الرّومانيّة وافتقر مدلول الأجنبي على سكان الإمبراطوريّة خارج ايطاليا حتى العام 212 ق .م ومنح الجميع الجنسية الرّومانيّة ولم تكن هناك تفرقة بين الأجنبي والرّومانيّ، أما الأشخاص الذين لا ينتمون إلى الإمبراطوريّة الرّومانيّة فكان يطلق عليهم البرابرة أي الأعاجم مثل الجرمان وسكان شمال إفريقيا وأولئك لا يستحقون أية حماية قانونية داخل الإمبراطوريّة الرّومانيّة(2) .
- القانون البريتوريّ
كانت السّلطة الخاصة بالبريتور هي السّلطة الإداريّة والأوامر إلى الأفراد بحكم أنه الحاكم العام للسلطة القضائيّة التي تتمثل بإحالة النزاع إلى القاضي المختص لغرض الفصل فيها دون أن يكون للبريتور الحقّ في منع أو رفض دعوى لا يقرها نظام الدّعاوي غير أنه بصدور قانون ايبوتيا العام ۱۳۰ ق . م ازدادت سلطات البريتور القضائيّة بفضل وجود نظام المرافعات الكتابيّة والذي أجاز فيه للأفراد اللجؤ إلى هذا القانون أو إلى نظام الدّعاوي، ثم تم تعديل هذا القانون عندما استطاع البريتور أن يدخل بعض المبادئ الجديدة بواسطة منشوره الذي عد من أهم المصادر للقانون الرّومانيّ خلال المدّة التي تلت صدور قانون ايبوتيا حتى أوساط عهد الإمبراطوريّة العليا(1)
- الفقه الرّومانيّ
احتكر رجال الدّين الفقه في العصور الأولى القانون الرّومانيّ حتى لا يعلمه أحد من العامة، واستشعارهم أنّ هذا القانون من المقدسات الإلهية التي لا يجوز معرفتها إلا من المقربين من الإله وبقي هذا الاعتقاد سائدًا حتى القرن الرابع ق. م إذ بدأ الفقه المدنيّ يحل محل الفقه الدّينيّ وكان ذلك بنشر صفة الدّعاوي الرّسميّة التي كان يحتكرها رجال الدّين، وكانت مهمّة الفقهاء تنحصر في الوظائف الأساسية آلاتية:
الإفتاء: هي الإجابة عن الاستشارات التي يقوم بها الأفراد أو الفقهاء أو الحكام أنفسهم، ولم تكن الفتاوى ملزمة للبريتور ولكنه كان من النّاحية العملية يتبعها إذا صدرت من فقيه له مكانته(2)
التّوثيق: هو إرشاد المتقاضيين إلى كيفية تحرير العقود وجميع التصرفات القانونيّة التي كانت تستلزم استعمال عبارات معينة(3) .
المقاضاة: لم يقصد بها الدّفاع عن الإفراد أمام القضاء إنّما يقصد بها مساعدة الإفراد في صنع الدّعاوي التي تحمي حقوقهم عن طريق تدعيم الفقيه لرأيه الاستشاريّ الذي أبداه لصاحب المصلحة. وقد استطاع خلق قانون جديد يقوم كالقانون القديم على العرف، لكنّه يتميز عنه بقابليته للتّطوّر والتّطبيق في حالات وظروف جديدة وأطلق عليه بقانون الفقهاء لأنّه كان يقوم خاصة على الإفتاء. ظهر فقهاء القانون القديم ومن بينهم الفقيه باتيس والفقيه كاتو الذي نال شهرة واسعة في المجال السّياسيّ والخطب السّياسيّة وترك مؤلفات كثيرة في التفسير الفقهي والقانون المدنيّ(4)
ازدهر العصر العلميّ بنشاط الفقهاء وخاصة من ناحية الإفتاء والتّأليف وانقسم الفقهاء منذ عهد الإمبراطور أغسطس إلى مدرستين متنافستين هما مدرسة السّابينين ومدرسة الروكوليين، واستمر هذا الانقسام أكثر من مائتي عام ولم تخف حدته إلا عندما جمع الإمبراطور هادريان زعماء المدرستين في مجلسه الاستشاري، ومؤسّس المدرسة السّابينيه هو كابيتور ولكنّها سميت باسم تلميذه سابينوس ومؤسّس المدرسة البروكوليه هو الفقيه لابيو وسميت باسم تلميذه بروكلوس ويرجع سبب الخلاف بين المدرستين إلى العقيدة السّياسيّة لمؤسّسي هاتين المدرستين فالأوّل يؤيد النّظام الإمبراطوريّ الجديد والحفاظ على التّقاليد وحرفية النصوص، أما الثّاني فكان مؤيدًا للنّظام الجمهوريّ القديم وهو من دعاة التّجديد من الناحية القانونيّة(5)
رابعًا: أنظمة القانون الرّومانيّ
تعدّ دراسة الأنظمة الرّومانيّة مرجعًا لابد منه لمعرفة المصادر القانونيّة -ليس للقانون الرّومانيّ بصفة عامة – بل لكل قانون على حدّة حيث نجد أنّ الأنظمة التي سادت المجتمع الرّومانيّ تجدها تارة متطوّرة في قانون ومتخلفة في الآخر إلى أن تطوّرت بمراحل زمنيّة مختلفة مثل مرحلة القانون القديم ومرحلة العصر العلميّ ومرحلة تجميع القانون الرّومانيّ، وعليه فإننا سوف نتناول فيه أبرز النقاط التالية:
- قانون الألواح الاثنى عشر
إذا كان العرف في العصر الملكيّ قد لا يعدّ المصدر الأول للقانون الرّومانيّ إلا أنّه لم يعد يثق بأحكامه وذلك لعدم تدوينه ولما أحاط بتطبيقه دعا إلى المطالبة بتدوين القواعد العرفيّة في قانون مكتوب ومن ثم توصلوا إلى إصدار قانون الألواح الإثنى عشر والذي عد أول قانون إلا أنه كان هناك كثير من الشك والغموض في قواعده العرفيّة، حيث أظهر القانون التقسيم الاجتماعيّ فرجال الدّين لهم طبقه وكذلك طبقة الإشراف طبقة مستقلة عن طبقة العامة(1)
عدّ قانون الاثنى عشر كأول قانون دون العادات والأعراف الرّومانيّة شأنه شأن القوانين المدونة القديمة إلى أن داسته أقدام الغزاة فلم يتبق من أصوله شيئ في حينه وذلك بسبب الحريق الذي حدث سنة 390 ق م على يد قبائل الغال وهذا الحريق التهم كل شيئ من ذلك القانون، إلا أن نصوص القانون أعيدت من جديد وتم صياغتها بصيغة أكثر عصرية عما كانت عليه دون المساس بأحكامه الموضوعية ومبادئه الجوهرية وخلال العصر العلميّ تم اخذ آراء المؤرخين والخطباء الرّومان الذين كان لديهم نصيب ملحوظ في دنيا القانون وعلى رأسهم الفيلسوف شيشرون وقد جمعت نصوص هذا القانون المتناثرة تحليلات فذة من جانب الفقهاء الرّومان المحدثين.
في مجال إبراز فكرة الرّبط ما بين القوانين المدونة القديمة حيث إنّ واضعي قانون الألواح الإثنى عشر ذهبوا إلى أثينا وأطلقوا قانون صولون وضمنوا قانونه كثيرا من أحكامه وقد ذكرنا من قبل أن صولون استلهم كثيرا من أحكام قانونه من قانون بوكخريس وأنّ هذا القانون استمد بعض قواعد من قانون حمو رابي، هذا من جهة ومن جهة أخرى رأي يقول بأن الرّومان سمعوا عن القانون المصري وخاصة قانون بوكخريس حيث أشادوا به كثيرا من قبل الفيلسوف هيرودوت الإغريقي الذي نشر ذلك في احتفالات الاولمبية فقاموا بالتّعرف على القانون ومن ثم اقتبسوا كثيرا من نصوصه وقواعده إلا أنهم عدوه أول قانون مدون لديهم هو قانون الألواح الاثنى عشر(2) وسوف نتناول هذا القانون على النّحو الآتي:
ب. الأحكام الخاصة في قانون الألواح الاثنى عشر
يعد قانون الألواح الاثنى عشر أساس القانون الخاص والعام عند الرّومان وقد استمر كذلك حتى وضع مجموعة جستنيان القانونيّة حيث اتخذ أساسا لتلك المجموعة. وفي هذه الأثناء كان للعرف أيضًا دور ظهر في أحكام القانون الاثنى عشر وبصفة أساسية في القانون الخاص وإذا استثنينا بعض النصوص المتعلقة بالقانون العام والأحكام الدّينيّة (الجرائم العامة والمراسيم الواجبة الخاصة بالجنائز). ركز القانون على المرافعات والنّظام والقضايا والدّعوى المدنيّة أما بشأن نظام الأسرة هناك نصوص قليلة وكذلك اهتم القانون بالحقّوق والذمة الماليّة وكيفية انتقالها من المتوفى إلى الآخرين عن طريق الوصية والميراث والأموال التي تنتقل عن طريق الخلافة، وكذلك ركّز القانون على تنظيم الملكيّة الزّراعيّة(1).
ج. نظام الدّعاوي لقانون الاثنى عشر
يقوم نظام الدّعاوي على الرّسميّة إذا كان يتعين على الخصوم التّفوه ببعض العبارات الرّسميّة وتأدية أشارات شكليّة بحيث إنّه إذا اخطأ أحدهم في أدائها تترتب على ذلك ضياع حقوقه التي يطالب بها ومن ثمّ كان الناس يلجأون إلى أولئك قبل القضاء لمعرفة ماذا يترتب على نوعية الدّعوى المطالب بها، وفي هذا يقوم القاضي بسماع الادعاءات الرّسميّة التي يقررها الطّرفان مع مراقبة الإشارات التي حصل عليها من قبل رجال الدّين مسبقا ومن ثم القاضي يفصل في النّزاع بين الطّرفين ومن ثم تنتهي للحكم للقاضي النّهائي للبث فيها والنّطق الرّسمي وبذلك ظهر نوعان من الدّعاوي في قانون الألواح الاثنى عشر وهي على النّحو الأتي :
- الدّعوى التقّريريّة
هي دعوى القسم أو الرّهان أو دعوى طلب تعيين قاضٍ أو حاكم ثم أضيف إليها فيما بعد دعوى الإعلان وسوف نشرح ذلك بالتفّصيل على النّحو الآتي :
- دعوى القسم أو الرّهان
هي دعوى عامة بمعنى أنها تعدّ الوسيلة العامة للدّفاع عن الحقّ وإجبار الخصم على الاعتراف به في كل حالة لا يوجد فيها نص قانونيّ يوجب إتباع طريقة أخرى، وسميت بدعوى القسم لأنّ كل من الطّرفين يلزم إن يقسم على صحة ادعائه ثم يقدّم برهان كل منهما على إن يقدّم كل منهما مبلغ من المال ويتحوّل إلى الخزانة العامة كإيداع عند الحكم تمنح عند مطالبة بالحقّ الشّخصيّ أو العيني ويترتب على هذه الدّعوى الدّعاوي التالية:
- دعوى الرّهان العينية
يستلزم النّزاع إحضار شيء أمام الحاكم القاضي إذا حضر الطّرفان ومعهما الشّيء المتنازع عليه والشّهود ثم يقف كل منهما أمام الأخر ويتلفظ بألفاظ رسميّة ويقوموا بحركات وإشارات خاصة فإذا أخطأ أحدهم في لفظ منها سقطت دعواه حتى ولو كان الحقّ في جانبه، ومن ثم يتحوّل القاضي إلى اليمين لكلّ من المدعي بالحقّ حيث يقول كل منهما للأخر بما أنّك ادّعيت بغير حق فأتي دعواك إلى تقديم النّذر وهو عبارة عن مبلغ أصبح يدفع للخزانة العامة بمثابة حكم ضده، ثم يعهد بأشياء مؤقتًا للطرف الذي كسب الحكم مع تقديم كفيل فإذا انتهت المراسيم السابقة اتفق الطرفين على القاضي الذي ينظر إلى النزاع ويقوم الحاكم بإقرار ذلك رسميا وبعد تعين القاضي يشهد الحاضرون على خلاصة الجلسة التي تم فيها تثبيت وهو ما يسمى بالإشهاد أمام الحاكم حيث يعد الأمر عادي بدون إي شكليات أو رسمية بحيث يسمع القاضي وعليه يتأكد من خلال الاستجواب ويحكم بالقضية ويحسم الأمر(1) .
- دعوى الرّهان الشّخصيّة
هذه الدّعوى تختص بالمطالبة بالحقّوق الشّخصيّة الغير ثابتة مقابل الجريمة التي وقعت أثناء السرقة أو قطع الأشجار، وهنا يطلب من المدعي الإثبات فقط أمام القاضي فإذا لم ينجح خسر الرّهان ودعواه أم إذا نجح في الإثبات فإنّ المدعي عليه ملزم بأن يخسر الرّهان، ويصبح ملتزمًا بتنفيذ الحكم الذي حكم به القاضي وإذا لم يقيم بالتّنفيذ في حينه، فإنّ الأمر سيكون منتهيًا تمامًا ومنفذًا خلال ثلاثين يوم من بدأ الحكم سميت بدعوى القسم أو الرّهان لأنّ الطّرفين يقسّمان على صحة دعواهم بيمين ثم استعيض عنها برهان كان يدفعه من خسر دعواه إلى الخزينة العامة(2) .
- دعوى طلب تعيين قاضٍ أو حكم
تختلف هذه الدّعوى عن دعوى الرّهان أو القسم في أنّها دعوى خاصة على بعض الحالات التي حدّدها القانون كما أنّها أبسط وأقلّ كلفة، إذ ليس هناك رهان ولا أموال تضيع لصالح الخزانة إذا خسر الشّخص دعواه وتتمثّل هذه الدّعوى في الطلب شفويًا إلى الحاكم لتعيين قاضٍ أو حكم وذلك بعد أن يكون الطّرف الأوّل قد أعلن ما يدعي عليه ويدخل في هذا النوع من الدّعاوي نوعان وهي على النّحو التالي:
- الخصومات على أساس الحقّ
يتعلّق هذا الأمر بوجود أو عدم وجود، الحقّ في هذه الحالة يستلزم الأمر بتعيين قاضٍ للفصل في أصل الحقّ على أن تتم الإجراءات الجوهريّة بأن يطلب إلى الحاكم شفهيًّا تعيين قاضٍ ثم يقوم الحاكم بنفسه باختيار القاضي وتعينه وبهذا يعد القاضي مفوضًا من قبل الحاكم ومن الحالات التي تستعجل فيها هذه الدّعوى حالة الديون الناشئة من الاشتراط الشفهي.
- حدود الحقّ
هي تلك الحقّوق التي يستعمل فيها الحقّ مثل الحدود بين الجيران والأراضي والبيوع والأقارب عند النّزاع في مسائل الميراث والتركات والأموال الشائعة ومن ثمّ لا يظهر هناك نزاع بسبب لا يوجد فيما يتعلّق بالحدود، وأيضًا يوجد نصوص قانونيّة تعالج مثل هذه القضايا(1) .
- دعوى الإعلان
تمتاز هذه الدّعوى بأنها أكثر دقة وحداثة من الطّرق المستعملة سابقا لما لها من البساطة وعدم التّعقيد، وإنّها لا رهان فيها وتتم إجراءاتها بادعاء المدعي مثل وجود دين على المدعي عليه فإذا أنكر المدعي عليه يلزم المدعي بالحقّ إن ينذره بالحضور إلى مجلس الحاكم القضائيّ وبعد ثلاثين يوما يتم تعيين قاضٍ للفصل في النّزاع .
- الدّعوى التّنفيذيّة
متى كان المدين معترفًا بالحقّ أو كان الحقّ ثابتًا ثبوتًا رسميًّا، أمكن الالتجاء إلى الدّعاوي التّنفيذيّة وطبقًا للإجراءات التي نظمها قانون الألواح الاثنى عشر يتم التنفيذ على المدين، و بعض الأحيان يتم التنفيذ باستيلاء الدّائن على مال المدين كرهينة، وهذا هي الطّرق التي يلجأ فيها الشّخص إذ ما نوزع في حقّه إلى أخذ من خصمه دون تدخّل من السّلطة العامة ، فهي دعاوي تحمل معنى الانتقام الفرديّ وتتميزان على النّحو الأتي:
- خصائص الدّعوى التّنفيذيّة ولها خاصيتان وهما على النّحو الأتي :
الحالة الأولى: بعد الوصول إلى موضوع الدّعوي يأتي تقيم الإجراءات الأخرى خارج مجلس الحاكم ولا مسوّغ في ظل هذا العدد للتّفرقة بين دعوى أخذ رهينة ودعاوي إلقاء اليد، ومن ثمّ تنتهي إلى صدور الحكم.
الحالة الثّانية: يحقّ للدّائن أن يقوم باجراء معين في المنازعة والإكراة و بهذه الطّريقة يحصل المدين على الحكم ويبرؤه ويقضي على عدم مديونيته(2)
- أنواع الدّعاوى التّنفيذيّة
تكمن على النّحو الأتي
- دعوى إلقاء اليد
هي دعوى إلقاء اليد ووضع اليد على الشّخص بدعوى تنفيذية وقد قرّرها قانون الألواح الإثنى عشر في حالتين هما :
- إذا كان هناك حكم سابق بالدّين ولم يقم المدين المحكوم عليه بالتّنفيذ ما عليه من ديون للدّائن.
- يقر أو يعترض أمام الحاكم بادعاء خصمه، كما أنا لدائن يقبض على المدين ويحبسه في بيته لمدة ستين يوما ويأخذه كل ثلاث أيام مكبل في الأغلال إلى الأسواق العامة ويعلن أمام الناس أنّ هذا الرجل عليه ديون لي ومحكوم عليه بالتّنفيذ، والهدف من ذلك لعل هناك من ينقذه من ديونه من أهله وأقربائه وعند اكتمال المدّة السّتين يومًا) ولم يظهر أحد ينقذه يتحوّل المحكوم ضده ومملوكا للدّائن يفعل به ما يشاء، كما يحقّ لأي شخص آخر الاعتراض على هذا التّصرف وخاصة إذا رأى الدّائن يعذبه بدنيا) الإكراه المدنيّ (وهذا الشّخص يسمّى بالمحرر إي من تحريره من سيده فيتحوّل الدّين عليه وترسى الإجراءات نفسها عليه عند تحرّر الآخر.
- دعوى أخذ رهينة
هذه وسيلة ثانية من وسائل التّنفيذ ويقصد من وراء ذلك حمل المدين على القيام بما التزم به وذلك عن طريق أخذ الدّائن مالًا أو بعضًا من الأموال المملوكة للمدين وحجزها عنده كرهينة حتى يقوم المدين بالوفاء بالدّين ولم يكن للدّائن الذي يضع يده على المال أن يبيعه أو أن يتملكه، وإنّما كان له فقط الاحتفاظ به حتى يقوم المدين بالوفاء، فإذا لم يتم الوفاء خلال مدة معينة كان للدّائن أن يقوم بالشّيء وقد كان للدّائن أن يقوم بنفسه دون حاجة إلى إتمامه أمام الحاكم القضائيّ بل ودون حاجة إلى أن يكون قد صدر حكم بالدّين وان كان على الدّائن أن يتلفظ بعبارات رسميّة لجعل فعله مشروعًا كما في حالة إلقاء اليد على المدين على نحو ما سلف، إلا أنّه كان من المحتمل أن يؤدّي هذا إلى اتّخاذ إجراءات لاحقة في صحة الإجراء(1).
- مجموعة جستنيان القانونيّة
إنّ أعظم أثر قانونيّ يذكر في تاريخ الإمبراطوريّة هي مجموعة جستنيان قانونية التي شملت القوانين الرّومانيّة بشرطيها وهي الدّساتير والأحكام الإمبراطوريّة من جهة والقانون القديم، من جهة ثانية أي منذ أن تم تطوّر الحقّوق في العصر الثّاني ومطلع العصر الثّالث حيث كان لهذه المجموعة من الأهمية والأثر الكبير حيث أراد الإمبراطور جستنيان بهذه المجموعة التي تحمل اسمه إلى تحقيق أمرين هي في غاية الأهمية وهي على النّحو الآتي:
- تمكين وتيسير الإطلاع على قواعد القانون الرّومانيّ دونما جهد أو تعب ودون حاجة إلى البحث في الكتب القديمة .
- حفظ هذا القانون كونه تراثًا عالميًّا ينطق بعظمة وعبقرية أولئك الذين اشتغلوا بعلم القانون ووضع أصوله التي لا زالت موجودة.
- بدأ العمل في وضع المجموعة الرّومانيّة العام (528 ق م) وانتهى العام (534 ق م) ويعود الفضل الأكبر الى الوزير (تريبفيان)
- شكّل الإمبراطور جستنيان العام 529 ق م المجموعة الأولى، ثم بدأ الوزير تريبفيان بتجميع القانون من كتابات شارح العصر العلميّ خلال مدّة ثلاث سنوات، وفي عام 533 ق م بدئ بتشكيل الموسوعة وسميت ب digesta.
- نشر جستنيان قبل الموسوعة موجز الكتاب ، النّظم الفقهية غايوس ليسهل على الطلاب والاطلاع عليها وليحل محل كتاب النّظم القديمة ويدعي هذا الكتاب الموجز المنظم(1)، وتكمن مجموعات جستنيان القانونيّة في المضامين الاتية :
- مجموعة دساتير الإمبراطوريّة توفيق
تتضمّن هذه المجموعة دساتير يرجع أقدمها إلى القرن الثّاني الميلاديّ على أن أكثر الدّساتير التي وردت في هذه المجموعة ترجع إلى الإمبراطور ديو كليسيان ومن تلاه من الأباطرة حتى الإمبراطور جستنيان نفسه، وتضم هذه المجموعة اثنى عشر كتابًا وقد رتبت الدّساتير فيها زمنيًّا مع ذكر اسم الإمبراطور الذي أصدره ومن وجه إليه وتاريخ صدور الدّستور ومكان صدوره.
- الموسوعة
عدّت الموسوعة العمل التّشريعي الثّاني الذي أمر بوضعه الإمبراطور جستنيان، وهي أهم كتاب قانوني للنّظم القديمة وقد دون فيها الفقه في العصر العلميّ وتتكوّن مجموعة الموسوعة من خمسين كتابًا، وينقسم كل كتاب على أبواب وفقرات وكل ما يلزم الكتاب.
- النّظم
في اثناء قيام لجنة الموسوعة بعملها قرر الإمبراطور جستنيان وضع كتاب لتدريس الحقّوق على أن يكون في الوقت نفسه يعدّ قوة القانون الذي ينظر إليه ويحلّ محل كتاب جايوس الذي يدرس للطّلاب(2)
إن هذه المجموعة التي وضعها جستنيان تسمى في العصر الحديث القانون المدنيّ Droit civil وهي آخر الأعمال العلميّة في العصر الرّومانيّ .
- بعض أنظمة القانون الرّومانيّ
حدّد القانون الرّومانيّ الموت المدنيّ بإن الأصل في شخصية الإنسان تبدأ وتنتهي بالوفاة، غير أن بعضًا من الحالات التي قد تترادى في حياة الشّخص الذي يحرم من بعض الحقّوق دون أن يفقد أهليته أو شخصيته القانونيّة. وهناك حالات تتغيّر فيها أهليّة الشّخص وتظلّ الشّخصيّة قائمة رغم حرمانه من بعض الحقّوق العادية ومن هذه الحالات :
الحالة الأولى: عدم الجدارة بالشهادة وسببها نكول الشّخص عن الشهادة أو قذف الغير بالكتابة(1)
الحالة الثّانية: الحكم بجريمة مخلة بالشّرف.
الحالة الثّالثة: ضياع السّمعة كالاحتراف لمهنة مخلة بالشرف ومنها السّرقة والغش. وفي الموت المدنيّ تتمثّل في فقدان الحريّة أو الوطنيّة أي يصير من الأجانب أو يفقد صفته كرب أسرة حالات تقابل الموت المدنيّ(2) و بالتالي تميز القانون الرّومانيّ بخصائص قانونيّة معينة ارتبطت بالقانون السّياسيّ التي عكست نفسها على بقية الأنظمة الأخرى وسوف نتناول فيه النّظام التالي.
- نظام الأسرة
يظهر أنّ نظام الأسرة في المجتمع الرّومانيّ كان بارزًا من بين القوانين الأخرى وسوف نتعرّف على ذلك من خلال الفروع الآتية:
- نظام الزّواج
للزّواج الرّومانيّ شروط معينة نجملها في الآتي
الرضا: يلزم رضا الوالدي العروسين لصحة زواجهما وإذا كان العروس مستقلًا أي بدون أبّ يعد ولي نفسه أمّا المرأة فلا يجوز لها ذلك وإن كانت مستقلة وإذا مات والدها قبل أن تتزوّج فهناك الأقرب إليها كالوصي، ثم تطوّر الأمر إلى أن أصبح رضا الخاطب والمخطوبة كافيين لصحة الزّواج.
بلوغ سن الزّواج: لم يحدّد القانون الرّومانيّ في بادئ الأمر سنا للزّواج وكان ينظر للأمر من الناحية الشّكليّة للجسد ثم تطوّر الأمر إلى أن تم تحديد سن بلوغ الفتاة باثنى عشر عامًا والشّاب بأربعة عشر عامًا وهذا كان في مدّة الإمبراطور جستنيان.
أهلية الزّواج: أوجب القانون ضرورة الأهلية لإبرام الزّواج وأن لا يكون هناك مانع، والقصد هنا أن يكون مماثلًا من حيث المستوى الطّبقي فالرّقيق والمحكوم عليهم لا يملكون الحقّ في الزّواج إلا بموافقة السّيد وللرّقيق من رقيقة. وكذلك هناك مانع يأتي من القرابة والمصاهرة حيث يحرم الزّواج بين الأصول والفروع إلى ما لا نهاية ويحرم الزّواج بين أقارب الزّوج والزّوجة ومثال على ذلك لا يجوز أن يتزوّج بأمّ زوجه ولا هي تتزوّج بوالد زوجها أو بابنه وإذا طلقها فلا يجوز أن يتزوّج بأخوات الزّوجة .
- موانع الزّواج
يمكن لنا أن نجمل الموانع للأسباب التالية :
- منع الزّواج بسبب الظروف الاجتماعيّة
كان الزّواج يتم وفق المستوى الطّبقي ثم منع هذا التّقليد فأصبح من الممكن أن يتم الزّواج بين الإشراف والعامة ثم صار مباحًا واقتصر المنع على طبقة مجلس الشّيوخ و كذلك منع الزّواج بين الرّقيق وسيدته.
- مانع الزّواج السّابق
أشار القانون الرّومانيّ بعدم السّماح من تطبيق الزّواج (تعدد الزّوجات) ومع ذلك فإنّ في عهد الإمبراطوريّة السّفلى اكتشف أن هناك زواج ثانٍ ولكن يشترط فيه إبطال الزّواج الأول.
- الزّواج في مدّة العدة
أوجب القانون المرأة التي مات زوجها بإكمال مدّة العدة وهي عشرة أشهر ثم جعلت سنة في عهد الأباطرة المسيحيين حيث كانت الفكرة السابقة دينية والأخرى تهدف لمنع الاختلاط بين الأنساب وارتبط الأمر بالحامل حتى تضع والمطلقة طبق عليها هذا المبدأ.
- بطلان الزّواج
إذا ثبت أنّ المرأة قد أنجبت من الشّخص قبل زواجها منه بطل الزّواج ويعد الأولاد غير شرعيين ويتم معاقبة أبو أم الأولاد الغير شرعيين بعقوبات جنائية(1)
حدد القانون الأحكام عن سلطة رب الأسرة وعن انتقال أموال الأسرة بالميراث أو الوصية وفقا للنّظام الأبويّ الذي كان سائدًا في حياة الأسرة الرّومانيّة، حيث كان رئيس الأسرة هو المالك الوحيد لأموالها ويخضع لسلطته زوجه وولده ورفيقه في مستوى قانوني واحد. وكانت القرابة قائمة على أساس التّفرع من الذكور، فهي قرابة العصبة(2). نظّم قانون الألواح الإثنى عشر أحكام الوصايا على القصر والنّساء بعد وفاة رب الأسرة، كما نظم أيضًا أحكام القوامة والسّفهاء إلا أنّ هذا التّنظيم كان مقررًا لمصلحة الوصي أو الأسرة أكثر منه لمصلحة المشمول بالوصاية أو القوامة، وقد شرحنا بعض المسائل في نظام الأسرة في مطلب نظام السّلطة الأبوية إلا أننا تركنا بعض من تلك المسائل المتعلقة بالزّواج الرّومانيّ و أنواعه وهي نوعين زواج مع السّيادة وتنتقل الزّوجة تحت سلطة الزّوج صاحب السّلطة، وزواج من دون سيادة تنتقل الزّوجة إلى بيت زوجها ولكنّها تظل تحت سيادة والدها ومستقلة بحقوقها، لذا فإنّ مفهوم الزّواج الرّومانيّ هو: ارتباط بين الرّجل والمرأة بمقتضاه يعيش الزّوجان معا. وسوف نتناول ذلك بأيضًاح أكثر من خلال الآتي:
- الزّواج بالسّيادة يمكنا أن نشرح هذا النّوع من الزّواج على النّحو الآتي :
- أنواع الزّواج بالسّيادة ويكمن ذلك على النّحو الآتي:
المعاشرة الزوجيّة: هي وضع اليد على الزوجة لمدة سنة كاملة وبهذا تصبح الزوجة تحت سيطرة زوجها مالم فإن الزوجة تكون بمقام إحدى بناتها وذلك إذا خرجت من البيت لمدة ثلاثة أيام في بيت والدها تظلّ تحت سلطة أسرتها.
الزّواج الدّينيّ يتم في المعبد على أن يقرّبا قربانا للإله وعشرة شهود، ويقوما بترتيل بعض الأناشيد وهذا يتم دائما مع طبقة الإشراف.
الزّواج بالشّراء وهذا يتم عن طريق شراء الرّجل المرأة من والدها وبموافقتها وتتم فيه عبارات معينة تهدف إلى تحقيق الغرض.
آثار زواج السّيادة حيث حدّد القانون الرّومانيّ المركز القانونيّ من حقوق المرأة وفقًا للخيار الذي تم اختياره وهو إذا كانت قد اختارت أن تكون تحت سلطة زوجها، فتكون حقوقها مثل ابن من أبنائه وإذا ظلّت تحت سلطة أسرتها فتترتب حقوقها من قبل رب أسرتها فقط(1).
- انحلال الزّواج بالسّيادة، ينحل الزّواج بالسيادة بالأسباب الآتية:
- بموت الزّوج والموت المدنيّ لأحد الزّوجين .
- ينحلّ بالإرادة وهذا كان نادرًا إلا أنّه يتم في حالة إذا ارتكبت الزّوجة خطأ جسيمًا يترتّب على ذلك أخذ السّيادة منها وكذلك من الأسرة وتطرد.
- الطّلاق بيد الزّوج
- اختفاء الزّواج مع السيادة وهنا يتعلّق الأمر بظهور الكراهية بعد الزّواج بالسيادة فإنّ الأمر ينتهي بعد التّأكد من صحة الأسباب التي نتجت عن ذلك.
الزّواج من دون سيادة: الأمر يتعلّق بزواج المرأة في ظلّ احتفاظها بسيادة أسرتها عليها لا أن تكون تحت سلطة الزّوج ومن هنا نتعرّف على ما يتعلّق في هذا النّوع من الزّواج من دون سيادة على النّحو الآتي:
- انعقاد الزّواج من دون سيادة حيث أوجب القانون الاتفاق بين الرّجل والمرأة على الحياة المشتركة وأنّ التّراضي بين الطّرفين كان يكفي لانعقاد الزّواج إلا أنّ هذا النّوع من الزّواج يخلو من الرّسميات التي تظهر على النّوع الآخر وخاصة أمور الفرح والزّفة التي لا يتحصل عليها النوّع الثّاني، وأي شروط للزّوجة من مقتنيات ويكتفي الأمران تأخذ بصورة عادية إلى بيت الرّجل الذي اختارها بعد موافقة ربّ أسرتها وبعضًا من الشّهود(1).
– آثار الزّواج من دون سيادة ومن الآثار التي تظهر على الزّواج من دون سيادة الآتي:
- لا تكون للزّوج أي سلطة على الزّوجة ولكن يحقّ له حمايتها مقابل احترامها له
- حقّ للزّوج قتلها إذا زنت أو تعاقب بالقانون… بالمؤبد وهذا ظهر في عهد جستنيان
- لا حقوق لها من تركة زوجها، إلى أنّ تطوّر القانون ووضع لها حقوق من قبل الأولاد
- ينحلّ الزّواج بالوفاة لكلّ منهما أو فقدان الحريّة.
- ينحل بالطّلاق بالاتفاق بين الطرفين.
طلاق مباح وهو الطّلاق الذي يقع تحت إرادة الطّرفين لأسباب مشروعه ومنها إذا ظهر مرض لكل منهما أو عقم أو عجز أو ما شابه ذلك .
- الطّلاق بسبب مشروع، حيث أخذ القانون الرّومانيّ بالأسباب المشروعة للطّلاق وركّز عليها مثل زنا الزّوجة أو اعتدائها على حياة الزّوج أو هجرها بيت زوجها أو ذهبت للتّنزه مع رجل آخر والأمر ينعكس أيضًا على الرّجل إذا زنا أو اعتدى عليها.
- الطّلاق من دون سبب شرعىّ، وهو يعود لرغبة الطّرفين بالانفصال ولكنّه يتعرّض لعقوبات ماليّة وبدنيّة.
- أثار انحلال الزّواج أي لا يحقّ للزّوجة المطلقة أو المتوفي عنها زوجها الزّواج إلا بعد مضي عشرة أشهر الخاصة وبعد سنه يحقّ لها أن تتزوج(2) .
ز. نظام الميراث في القانون الرّومانيّ
تشكّل الإرادة اللبنة الأولى في نظام الميراث في القانون الرّومانيّ فربّ الأسرة هو الوحيد الذي يمتلك الحقّ في تعين من يخلفه من بعده في تولي رئاسة العائلة وللقيام بما عليه من الحقّوق القومية والحربيّة، ولا يشترط في من يختاره ربّ الأسر لتولي منصب الخلافة أن يكون من الأبناء أو الأقارب فقد يختار شخصًا أجنبيًّا بشرط موافقة القبيلة لأنّ رب الأسرة كان يملك الأموال بوصفه وكيلًا للقبيلة ووليًّا للأسرة وقبول من يختاره لتولي الخلافة من بعده.
عرف القانون الرّومانيّ الوارث، بأنّه الشّخص الذي يحصل على ميراث لحظة الوفاة أو الموت المدنيّ ومن قبل الموروث له وأن يكون متمتعًا بالشّخصيّة القانونيّة الرّومانيّة وأن لا يكون جنينًا لم ير والده أو أمه(1) وهناك بعض المسائل التي تتعلّق في الميراث وهي على النّحو الآتي:
- مفهوم التركة
هو كلّ ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق والتزامات فالتّركة تعدّ امتداد لشخصيّة المورث.
- مفهوم الولاء وهي قرابة حكميّة نشأت بين المعتق والمعتق له بسبب العتق والاعتراف بالقرابة له وذريته ولاعتبار الولاء المورث وخضوعه لسلطان رب الأسرة(2).
- حرمان الإرث يقوم الميراث في القانون الرّومانيّ على الأسس التالية:
- اعتمد القانون الرّومانيّ في تقسيم الإرث وفقًا لما يتطلّبه العرف حيث لا تصرف لإفراد الأسرة في ظل حياة ربّ الأسرة موجود ويمتلك الشّخصيّة والحريّة والجنسيّة الرّومانيّة.
- استبقاء الثّروة بيد العائلة الرّومانيّة وحفظها من التّفتيت لذا فهم يورثون أبناء الظّهور دون أبناء البطون، وفيما يلي يتعلّق بميراث البنت من أبيها ويعد إلا عبارة عن حق الانتفاع فقط في التّركة التي آلت إليها من بعد أبيها ثم تعود بعد موتها على عصبتها الذّكور وهم أصل وفروع أبيها ولا يحقّ لأبنائها أن يورثوا من تركتها(3).
- منح القانون ربّ الأسرة بأن يكون الخليفة وهذا يتم عن طريق عقد البيع وبواسطة هذه الطّريقة تنتقل السّلطة من رب البيت إلى الشّخص الذي يرغب فيه خليفته في المال والأبناء والزّوجة وكل ما يخضع لسلطته الأبويّة فإذا ما أنجز العقد.
- الخليفة ومن هذا الوقت يصبح هو المالك لهذه الأسرة وأموالها فله الحقّ في التّصرف قبل ما نقل إليه بعقد البيع في ظل وجود رب الأسرة إلا أنّ أرباب الأسر وجدوا أنّ في هذه الطّريقة حرجًا ومشقة لهم ولأسرهم فعدلوا عن هذه الطريقة(3).
- نظام الملكيّة
وردت بعض الإحكام المتعلّقة بالملكيّة ومصادر الالتزام وعلاقات الجوار في اللوحين السّادس والسّابع، وقد كانت الملكيّة جائزة على الأموال المنقولة والأموال الثّابتة وكانت الأموال مقسمة إلى أموال نفيسة وأموال غير نفيسة، والأموال النّفيسة هي الأموال التي تخصّ الأراضي الزّراعيّة والأموال اللّازمة للزّراعة كالأرقاء وحيوانات الجر والحمل، وما عدا ذلك فهي أموال غير نفيسة بحيث تنتقل الأموال النّفيسة عن طريق الإشهاد أو الدّعوي الصّورية ويقوم الانتقال بإجراءات شكلية، ورسميّة بحضور الطّرفين المتصرّف والمتصرّف إليه، والشّيء المراد التّصرف فيه إذا كان منقولًا أو ما يرمز إليه إذا كان عقارًا، لذلك كان يتوجّب حضور خمسة من الشّهود الرّومان البالغين وحامل الميزان ويزن النّحاس أما الدّعوى الصّوريّة فهي من الطّرق الرّسميّة لنقل الملكيّة الرّومانيّة بحضور الطّرفين أمام الحاكم القضائيّ، كان يدعي المتصرّف إليه (المشتري) بملكية المال المراد نقل ملكيته فيسلم المتصرّف (البائع) بطلب المتصرّف إليه ويصادق البريتور على هذا الأمر الذي يترتب عليه انتقال الملكيّة.
- طرق اكتساب الملكيّة في القانون الرّومانيّ(1)
يمكن تعريف اكتساب طرق الملكيّة، بأنّها تلك الأعمال القانونيّة أو الوقائع الماديّة التي يترتّب عليها دخول حق الملكيّة في ذمة شخص ما، وسوف نستعرض طرق اكتساب الملكيّة على النّحو الآتي :
- الطرق المنشئة للملكية
يعدّ الاستيلاء من أهم الطّرق لاكتساب الملكيّة وهي طريقة من طرق قانون الشّعوب ومفهوم الاستيلاء هو الحصول على المال المباح الغير مملوك بنية تملكه ولذلك له ثلاثة شروط هي:
- أن يكون هناك وضع يد.
- وجود نية للتملك.
- توفر المال المحدد في وضع اليد ومباحا.
وللاستيلاء صور عديدة مثل الاستيلاء على الأراضي والأحجار الكريمة والحيوانات الطّليقة والغنائم التي تأتي من الحرب والأملاك المهملة، كإحياء الأرض المملوك والمرفوضة من صاحبها، وينطبق ذلك على الدّار التي لا يسكنها أحد والدّار التي آلت إلى السّقوط وقد تحدث ضررًا، فالقاضي يحكم هنا اما بهدمها من قبل مالكها الأساسي أو تتحوّل ضمن أملاك الجار وهناك طرق اختياريّة وإجباريّة تكمن في الآتي :
- الطّرق الاختياريّة لها ثلاثة أوجه هي: الإشهاد والدّعوى الصّوريّة والتّسليم، على أن تشترط فيها وجود الشّخصيّة القانونيّة الرّومانيّة الكاملة(2).
- مفهوم الإشهاد:
هي طريقة عقديّة من القانون المدنيّ والمقصورة على الرّومان وهذه الطّريقة تتم على شكل بيع صوري ومن شروطها حضور شهود لا يقلون عن خمسة رومانيين، ومنذ نهاية العصر العلميّ بدأ الإشهاد يفقد أهميته تدريجيا حتى انتهى به الأمر في عصر الإمبراطوريّة العليا.
- الدّعوى الصّوريّة أو التّنازل القضائيّ
هي دعوى صوريّة، أي هي طريقة من طرق القانون المدنيّ في كيفية نقل الملكيّة التي نصّ عليها قانون الألواح الإثنى عشر، وتتم إجراءاته عندما يتفق النّاقل والمنقول إليه على أن يكون من المواطنين الرّومان والحضور بصفتهم الشّخصيّة أمام القاضي ومعهم المال المراد نقل ملكيته أو ما يرمز به إن كان عقارا أو غير ذلك، فيقبض المكتسب المال المراد نقل ملكيته إليه على أن يقر ذلك بعبارة رسمية تهدف إلى أنه أصبح مالك للشي طبقا للقانون الرّومانيّ. ولا يترتب على هذه الدّعوى التزام المتصرف بالضمان كما في الإشهاد فلم يكن المتصرف
يسأل إذا كان الشي مملوكا للغير.
- التسليم
هو طريقة نقل الملكيّة في إجراءات شكلية ورسمية كما هو الحال في الإشهاد والدّعوى الصورية بل أنه كان يتم في اضيق حدوده من الشكلية إذا لم يكن الأمر يستلزم…. الأمر وتسليم الشي ولا يعد التسليم ناقلا للملكية إلا إذا جمع فيه ركنان هما : الركن المادي والركن المعنوي ويتمثل الأول في نقل الحيازة بينما الثّاني يتمثل في الاتفاق على نقل الملكيّة ويجب أن يكون التسليم صادر من المالك، والتسليم نوعان هما : التسليم الطويل أي الذي يرتسم عليه حدود طبيعة الملك حتى لا تترتب عليه نزاعات مع أطراف أخرى ، والتسليم الرمزي وهو الذي يحمل الصورة الشكلية ومتعارف عليه من قبل كافة الأطراف أي لا يشترط التأكد من صحة حدوده، و هناك أنواع أخرى مثل التسليم القصير والتسليم الحكمي(1).
- الطّرق الإجباريّة لنقل الملكيّة : تظهر وسائل انتقال الملكيّة بصورة إجبارية لدى الرّومان على النّحو الآتي :
- نقل الملكيّة بناء على نص القانون
الشرط الأساسي في هذا النوع هو إن يكون النقل على شكل نص قانوني أي الشكل التّشريعي وهو عمل من أعمال السّلطة أو يأتي على شكل قاعدة عرفية وهذا ينطبق على الوصية أو نقل الملكيّة عن طريق المكافأة نظير اعمال قام بها المنقول إليه الملكيّة ، وهناك طرق أخرى لنقل الملكيّة من قبل السّلطة ومثال على ذلك تمنح أرض الموات التي قام شخص تصلاحها وحولها إلى ارض زراعية إن كان لم يظهر لها مالك ، فان الملكيّة تنتقل بهذا الإجراء وإذا ظهر لها مالك يكون بالاتفاق الذي ينتهي بالمعاوضة وهناك سوف نتناوله لاحقا وهو الملكيّة بالتّقادم.
وهناك ملكية البيت المهجور والذي لا صاحب له، تتخذ الشكل القانونيّ لنقل ملكيته للشخص الذي قام بالاستيلاء عليه(2).
- نقل الملكيّة بحكم القضاء أو بأمر من الحاكم القضائيّ
إذا اختلف الشركاء بالميراث وتقسيم التركة فان التصرف القانونيّ يتم عن طريق رفع دعوى قضائية وتسمى دعوى حصر ورثة شرعيين، وبعد التأكد من صحة الدّعوى يحكم القاضي في تقسيم التركة عن طريق حكم قضائي كما أن الأحكام القضائيّة تستطيع نقل الملكيّة ليس فحسب عن طريق انتقالها من الأصل إلى الفروع عن طريق الوفاة أو الموت المدنيّ من الأصول إلى الفروع ، ولكن هناك صور أخرى للانتقال مثال على ذلك إذا كان هناك بيت آيل للسقوط ويهدد الجار بالخطر فإن في مثل هذه الحالة يلزم الجار برفع دعوى إلى القاضي وبإشعار مالك المنزل بتهديم المنزل وإذا لم ينفذ أصبح البيت الأيل إلى السقوط من ممتلكات الجار(1).
- نقل الملكيّة بالتّقادم (مرور الزمن)
وهو حصول الشي المادي و المتروك من قبل شخص آخر ومنذ زمن لم ينتفع به، حيث ورد في قانون الألواح الإثنى عشر أن المزارع الذي ترك أرضه دون أن يحرثها وتحوّلت إلى أرض بوار وقام شخصا آخر باستصلاحها يصبح مالكا لها بعد مرور سنتين من تملكها و للتقادم الرّومانيّ أنواع كثيرة و هي على النّحو الاتي:
– التّقادم بمضي المدة القصيرة وهي سنتان
– التّقادم الطويل الذي تمتد مدّته عشر سنوات
– التّقادم الأطول الذي يمتدّ إلى أربعين سنة.
وفي عهد الإمبراطور جستنيان أصبح التّقادم ثلاثين سنه بمجرد وضع اليد على الشّيء الباسط عليه مالكا له(2).
- نظام الرّق في القانون الرّومانيّ
عدّ الرّقيق من الأشياء المملوكة حيث وجد الرّق في روما منذ البداية حتى نهاية الإمبراطوريّة الرّومانيّة، فالرّق في المجتمعات القديمة كان لا يتميز عن غيره من البشر بشيء أي إنَّه كان يماثل الحيوانات وظلّ هذا الحال حتى ظهور قانون الشّعوب الذي أعطى بعض الحقّوق لهم كما أنّ هناك الأجانب الذين تحوّلوا إلى عبيد نتيجة لعدم وجود معاهدات دوليّة مع بلدانهم والمرجح هم أولئك الهاربون من العقوبات في بلدائهم.
- مفهوم الرّق
الرّقيق هو ذلك الشّخص الذي لا يحقّ له أن يملك شي من الحريّة أو ما شابه ذلك طالما هو أحد ممتلكات سيده، حيث تسند إليه الأعمال كافة سواء كانت داخل البيت أو خارجه، كما أنّه يحقّ للسّيد أن يفعل بعبده ما يشاء حتى الإعدام وكل ما يتعلّق بالعبد من زوجه و أولاد يعدون مـلكًا للسّيد ولا يستحق أي ذمة مالية ، كما أن العبيد هم من صنع الاقتصاد الزراعي وتنمية المدن بالبناء والتشييد، حيث لا يتحمل العبد أي مسئولية قانونية أو يتقاضى في المحاكم إلا عن طريق سيده فإذا اعتدى أحدهم جسديّصا على العبد فكأنّما اعتدى على السّيد، ومن ثم فان السّيد يقاضي المعتدي في القضاء ويحقّ له المطالبة بالتّعويض، وهذا التّعويض ليس للعبد بل للسّيد أما إذا اعتدى العبد على الغير يختلف الأمر وذلك إما أن يدفع السّيد لهذا العبد التّعويض للطّرف المعتدى عليه بالمال، أو يتخلى عن عبده للطّرف الأخر يفعل به كما يشاء، وظلّ الرّقيق يعاني هذا الاضطهاد حتى تطوّر القانون الذي فيه أعطي للعبد بعض الحقّوق، ونتج عن ذلك تأسيس المركز القانونيّ للرقيق(1).
- أهمية المركز القانونيّ للرّقيق
اهتم هذا المركز بالدّفاع عن حقوق الرّقيق من السادة الرّومان حتى أصبح الرّقيق لا يماثل الحيوان كما عرف سابقًا وأصبح هناك عقوبة على من يعامل الرّقيق بوحشية من دون سبب ومن يعاقب رقيق بذلك يعاقب قانونًا بالعقوبة نفسها، وخاصة في العقوبة التي تصل إلى القتل، كما أنّ الملك يعطي الحريّة للرّقيق عند التّأكد من إساءة السّيد مع عبده ، كما أعطى المركز اهتمامًا كبيرًا للرّقيق وتعزيز ثقته في المطالبة بالحريّة، وهذا يتم عن طريق مطالبة الرّقيق من وكيل يدافع عنه أمام القاضي، وفي العصر العلميّ أصبح العتق منتشرًا بين الرّق وهذا يتم عن طريق التزام من قبل الرّقيق لسيده على أن يقدّم خدمات معينة يطلبها السّيد ومن ثم يعتق، أما الرّقيق الذي أصبح رقيقا عن طريق العقوبة الجنائية فلا يتحرّر من العبوديّة.
- أسباب الرّق: قد يولد الإنسان رقيقًا أو يصبح فيما بعد رقيق، ونذكر هنا بعض الأسباب التي أدّت إلى لصق صفة الرّق بالإنسان وهي على النّحو الآتي:
- الميلاد : ذلك أنّ الطّفل المولود من رقيقه يعد رقيقًا، حتى وإن كان والده يمتلك الحريّه، واذا كان العكس يمتلك الولد صف الحريّة.
- الأسر: وهو ما يقع بعد الحرب من غنائم من ضمنها الأسرى.
- الرّق بالعقوبة وهي نوع من أنواع العقوبة التي من خلالها يتحوّل الحرّ إلى عبد ومن ضمن مصنّفات هذه العقوبه هي عدم استطاعة المعسر في الدّين من الدّيون، فيصبح ملكًا لدائنه(2).
– العتق يتحرّر الرّقيق لسبب من الأسباب وقد يكون بحكم قضائيّ أو بإرادة السّيد وإذا لم يتحرّر فقد كان يتحصّل على بعض الحقّوق، وهناك طرق معينة لاكتساب العتق وهي على النّحو التالي:
- دعوى الحريّة الصّوريّة في هذه الدّعوى يتم الاتفاق بين السّيد وشخص آخري نوي عن الرّقيق في رفع دعوى الحريّة فيأتي هذا الآخر كمدافع للرّقيق مطالبًا القاضي بحريّة هذا الرّقيق فيأتي المالك ويمدّ عصاه بحركات كالمسّ على الرّقيق فيحكم القاضي بحريّته مع اعتراف السّيد في ذلك.
- القيد في قوائم التّعداد يقوم حاكم الإحصاء بتعداد كل خمس سنوات للرّومان دون العبيد فإذا وافق السّيد لحاكم الإحصاء في أن يحصي هذا الرّقيق أصبح حراء.
- الوصية: إذا أوصى السّيد قبل وفاته بعتق الرّقيق يصبح حرا بعد الوفاة مباشرة شريطة أن يوافق على الوصية مجلس الشّعب.
- تطوّر القوانين لمصلحة الرّق: أصبح العتق يأخذ الصورة البسيطة من العتق وذلك يتم بمجرد إقرار من السّيد أمام الحاكم دون أي رسميات ومن ثم أصبح من حقه الحصول على الجنسية الرّومانيّة.
الآثار المترتبة على العتق : تكمن الآثار على النّحو التالي:
كان يترتّب على العتق اكتساب المعتق صفة الحريّة والصّفة الوطنيّة، لكنّه لا يتمتّع بكلّ الحقّوق التي يمتلكها الحرّ الأصيل بل كان يعدّ أقل مرتبة.
يحرم المعتق وأبناؤه من المناصب السّياسيّة ومن عضوية مجلس الشّيوخ أو المجالس البلديّة والخدمة في الجيش ولا له الحقّ في التّصويت.
يحرم عليهم الزّواج من العامة والأصلى وظلّ هذا مستمر حتى زال في عهد الإمبراطور جستنيان فأصبح له الحقّ بالزّواج من العامة فقط.
يضلّ الولاء التّقليديّ للسّيد الذي اعتقه وهذا له شروط وهي على النّحو الآتي:
واجب الاحترام والإجلال للسّيد وأسرته وهذا الواجب أيضًا واجب أخلاقي كالاحترام وأن لا يسيى أي احد من أسرته أو يتجرأ رفع دعوى قضائية ضد سيده أو أسرته.
واجب أداء الخدمات متى طلب منه ذلك.
– الإنفاق للسّيد إذا كان معسرًا، وإذا مات الرّقيق دون أن يكون هناك من يرثه من أهله أو دون وصية، يتحوّل الورثة للسّيد الذي اعتقه، وفي عهد جستنيان اختفت تلك الشّروط تمامًا وظلّ الاحترام قائمًا من الرّقيق للسّيد فقط.
- مصادر الالتزام
الجرائم الخاصة والعقود هي مصدر الالتزام، ففي اغلب الجرائم الخاصة كان الجاني يعد مدينًا للمجني عليه فإذا لم يعاقب بالغرامة أو الدّية يصبح الجاني خاضعا لسلطة المجني عليه أي أن يتحمل الالتزام في جسمه أو أن يدفع المبلغ من أموالها ويتم تسلّم الجاني للمجني عليه(1).
وللمصادر شرطان على النّحو الآتي
عقد الشّرط الشّفوي: ويتم بسؤال الدّائن وموافقة المدين في صيغة رسمية.
عقد القرض القديم أو عقد الاستدانة:
يقصد به التزام يقع على جسم المدين أو أحد أفراد أسرته بحيث يبيع المدين نفسه بدلا من الشيىء بطريقة الإشهاد وأن يحتفظ الدّائن بالشّخص المباع كرقيق حتى العرض(1).
الخاتمة
في خاتمة بحثنا الذي تم التّعرف من خلاله على القانون الرّومانيّ وأهميته التّاريخيّة، والبحث المضني في المراجع المختلفة التي أظهرت كل ما كنا نسعى إليه من تحقيق الأهداف المرجوة التي يستفاد منها، أولا الطّالب الجامعيّ في كليّات القانون، وثانيًا بوصفه مرجعية قانونية ملهمة للقارئ القانونيّ والمهتم في التّاريخ القانونيّ وخاصة القانون الرّومانيّ، لذلك أقدم في هذا البحث أهم ما جاء به القانون الرّومانيّ على النّحو الآتي:
- صنّف القانون الرّومانيّ من القوانين المتطوّرة التى تأثر بها العديد من القوانين، وذلك أنّ تاريخ القانون الرّومانيّ هو عبارة عن مجموعة من الأعراف غير المكتوبة، أي هو عبارة عن تقاليد أسريّة بيد الأب (النّظام الأبوي) فظهرت عدة قوانين تنكر ذلك ومنظمة للحياة العامة.
- رأى الشّعب الرّومانيّ أنّ الأعراف والتّقاليد القديمة لا تلبّي غاياتهم الاجتماعيّة والسّياسيّة والقانونيّة، وعليه أصبح للنّظام أشكال جديدة تخدم المصلحة العامة.
- يعدّ المصدر الأساسي للتّشريعات الرّومانيّة هو الأسرة الرّومانيّة الأصيلة التي تمثّلت بوجود قواعد قانونيّة منظمة للمسائل كافة في المجتمع الرّومانيّ.
التوصيات
في نهاية هذا البحث و بناءً على ما سبق:
- من أراد التّعرف على القانون الرّومانيّ ومضمونه أن يلجأ إلى هذا البحث، أو يكتفي بقراءة مراحل تطوّر القانون الرّومانيّ وخصائصه وهذا يشتمل على العديد من المسائل التي تدرّس في كليات القانون عالميًا.
- أن المقارنة بين القانون الرّومانيّ والقوانين الأخرى التي ظهرت في المرحلة الزمنية نفسها، يشكّل رافدًا ومصدرًا لكثير من القوانين الغربيّة، ويظهر أيضًا بعض القواعد التي تأثّرت بقوانين الشّرق وخاصة القوانين الفرعونيّة في عهد الملك بوكخوريس والتي تأثرت بقوانين حمورابي.
- كلّ ما كتب عن القانون الرّومانيّ يعدّ مرجعيه قانونية للقوانين الغربية، وقانونًا معرفيًّا وملزمًا تدريسه في جامعات العالم.
- ضرورة الأخذ بهذا البحث الشّموليّ الذي يناسب المنهجيّة المتبعة في استعراض القانون.
- التّوصل إلى ماهو مناسب للجامعات العربيّة، واختصارها في دراسة مراحل تطوّر القانون الرّومانيّ والأهمية التّاريخيّة ومصادر القانون وخصائصة.
- أن الضّرورة تستدعي للمهتم بالتّزود بالمراجع التي تخدم توسعة أفق المعرفة في هذا القانون.
لائحة المصادر والمراجع
المصادر والمراجع باللغة العربيّة
- ابو الوفاء، أحمد، ١٩٩٠، تاريخ النّظم القانونيّة والاجتماعيّة، دار المطبوعات الجامعية، مصر.
- أبو طالب، صوفي، ١٩٧٥م، تاريخ النّظم القانونيّة والاجتماعيّة، دار النهضة العربيّة، القاهرة.
- ألعودي، عباس تاريخ القانون، 1998، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن.
- جعفر، محمد علي، 2002، نشأة القوانين وتطوّرها، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت.
- حسن فرج، توفيق، ١٩٨٥م، القانون الرّومانيّ ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت.
- الحفناوي، عبد المجيد ، و حسن،أحمد إبراهيم،۱۹۸۹م، تاريخ النّظم الاجتماعيّة والقانونيّة ، الدار الجامعية، بيروت.
- الديب، عبد العظيم، ۱۹۷۸م، فريضة الله في الميراث والوصية، الطبعة الأولى، دار الأنصار للطباعة والنشر، القاهرة.
- رباح، غسان، ١٩٥٦، تاريخ القوانين والنّظم الاجتماعيّة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقّوقية،
- السريتي، عبدالودود، ١٩٩٧، أحكام الوصايا والأوقاف والمواريث، دار النهضة العربيّة ، الطبعة الأولى بيروت.
- السقا، محمود، ۱۹۷۸م، فلسفة وتاريخ النّظم الاجتماعيّة، دار الفكر العربي، جامعة القاهرة
- السهل، يحي قاسم، ۲۰۰۰ م، السهل في تاريخ القانون ، جامعة عدن .
- شحاتة، محمد نور عبد الهادي، 1993، تاريخ النّظم القانونيّة والاجتماعيّة، دار النهضة العربيّة، القاهرة.
- عبيد الفتلاوي، صاحب، ۱۹۹۸، تاريخ القانون ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن.
- عيسى، إبراهيم عبدا لله ، ٢٠٠٦ م، المنهجية المعاصرة لابن خلدون ، الطبعة الأولى ، صنعاء.
- الفضل، منذر، ١٩٩٦، تاريخ القانون ، الطبعة الأولى ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان
- محمد جعفر، علي، ۱۹۸۲م، تاريخ القوانين والشرائع ، الطبعة الأولى، دار المسيرة للطباعة والنشر، بيروت
- المغربي، عبد الحكيم علي، ۱۹۸۱م، المعاملات في الفقه الإسلامي الجزء الأول الطبعة الأولى ، صنعاء.
- مغربي، محمود عبد المجيد،۱۹۷۹م، الوجيز في تاريخ القوانين ، الطبعة الأولى المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت.
المصادر والمراجع باللغة الأجنبية
- Alan Watson, 1995, the spirit of Roman Lou, University of Georgia Press.
- Borry Nicholos, 1962, An Introduction to Roman Law, Oxford University Press.
- Joseph A. C. Thomer, 1976, Textbook of Romon low, North Holland Fellishing Company.
- Reinhard Zimmermann, 1996, The law of Obligations: Remon Foundations of the Civiling Tradition, Oxford University Press.
- W. Buckland, 2007, A Textbook of Roman four from Augustus to Justinian, Cambridge University Press, Reprint edition.
(*) دكتور محاضر في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة الإسلامية.
(1) إبراهيم عبدا لله عيسى ، المنهجية المعاصرة لابن خلدون، الطبعة الأولى ، صنعاء ،٢٠٠٦م 6، ص ٥٦ .
(1) Reinhard Zimmermann, The law of Obligations: Remon Foundations of the Civiling Tradition, Oxford University Press, 1996, Page. (1004 – 1100).
(2) Alan Watson, the spirit of Roman Lou, University of Georgia Press, 1995, p.51.
(1) A. Watson, The Spirit of Roman Low, p) 101 – 150)
(2) صوفي أبو طالب ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975م، ص 298.
(1) Joseph A. C. Thomer, Textbook of Romon low, North Holland Fellishing Company, 1976, p 321 – 400.
(2) W.W. Buckland, A Textbook of Roman four from Augustus to Justinian, Cambridge University Press, Reprint edition, 2007, p. (121 – 200).
(3) توفيق حسن فرج : القانون الروماني، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت 1985م، ص 16.
(1) R. Zimmermann, The low of Obligations., p. (902-1003)
(2) A.Waston, The Spirit Roman Low, p 160.
(1) صاحب عبيد الفتلاوي ، تاريخ القانون ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص 115 – 116.
(2) غسان رباح ، تاريخ القوانين والنظم الاجتماعية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1956، ص 56.
(1) منذر الفضل، تاريخ القانون، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1996م، ص ١١٦.
(2) Borry Nicholos, An Introduction to Roman Law, Oxford University Press, 1962, P(1 – 30).
(1) B. Nicholer, An Intro to Remon Law ,P(61 – 120)
(1) R. Zimmerman, The law of Obligations, P. (1-25)
(2) صوفي أبو طالب، مرجع سابق، ص 326.
(3) صاحب عبيد الفتلاوي، تاريخ القانون، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 1998، ص 134.
(1) W.W. Buckland, A Textbook of Roman Law from Augustus to Justinian, p (120).
(2) علي محمد جعفر، تاريخ القوانين والشرائع، الطبعة الأولى، دار المسيرة للطباعة والنشر، بيروت 1982، ص 314
(1) R. Zimmermann, The Law of Obligations), P. (1- 25).
(2) A. Waston, The Spirit of Roman Law, P: 150.
(3) R. Zimmermann, The Law of Obligations: Remon Foundations of the Cinction Tradition, P, 17
(4) R. Zimmermann, The Law of Obligations. P. 999 – 1003.
(5) عباس العودي، تاريخ القانون ، دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن ، الطبعة الأولى 1998، ص 196.
(1) توفيق حسن فرج ، مرجع سابق، ص 26.
(2) محمود السقا، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية، دار الفكر العربي جامعة القاهرة،۱۹۷۸م، ص ١٣٥
(1) B. Nicholos, An Introduction to Romon Low, p. 160-220.
(1) R. Zimmermann, the tow of Obligations, p. 54-61.
(2) B. Nicholas An Introduction to Romon Law, p,61-65
(1) R. Zimmermann, the power of Obligations, p. 26-145
(2) w.w, Buckland, Atextbook of Romon Law from Augustus to Justinion, P, 191 – 200
(1) توفيق حسن فرج، مرجع سابق ص 208 وما بعده .
(1) محمود عبدالمجيد مغربي، الوجيز في تاريخ القوانين ، الطبعة الاولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت 1979 م
(2) منذر الفضل ، تاريخ القانون، الطبعة الأولى، عمان، 1996 م ، ص 134.
(1) غسان رياح ، مرجع سابق، ص 69 .
(2) J. Thomas, textbook of Roman Lam, p. 150
(1) محمد نور عبدا الهادي شحاتة، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ، دار النهضة العربية القاهرة، 1993، ص 517.
(2) J.T homas, Textbook of Roman Law, p. 401-480.
(1) Awatson, the Spirit of Romantic Law, (51-100).
(1) J. Thomas, Text book of Romon Lawr, p. 201-300
(2) محمد نور عبد الهادي شحاته، مرجع سابق، ص 526.
(1) J. Thomas, test book of roman 20 low, p321-330
(2) علي محمد جعفر، نشأة القوانين وتطورها، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت 2002، ص 282.
(3) عبد الودود السريتي، احكام الوصايا والأوقاف والمواريث، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 1997 م، بيروت، ص 7 .
(1) J. Thomas, test book of roman 21 low, p251-320
(2) ww.buckland, A textbook of roman law from Augustus to Justinian p 51-120
(1) منذر الفضل، مرجع سابق، ص 158
(2) عبد المجيد الحفناوي، احمد ابراهيم حسن، تاريخ النظم الإجتماعية والقانونية، الدار الجامعية بيروت 1989م ص 528.
(1) J. Thomas, test book of roman 23 low, p 325-400
(2) ww.buckland, A textbook of roman law from Augustus to Justinian p 115-120
(1) محمد نور عبد الهادي شحاته، مرجع سابق، ص 470
(2) أحمد ابو الوفاء، تاريخ النظم القانونية والإجتماعية، دار المطبوعات الجامعية ، مصر، 1990 ص 194
(1) B. Nicholas, an introduction to roman 20 low, p 160 -220