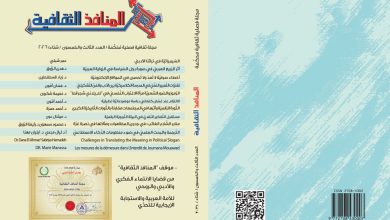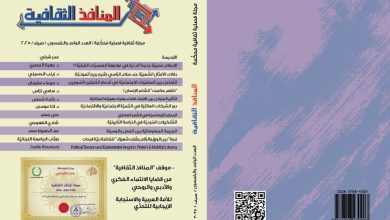وسائل الإعلام وأشكال التّواصل في العصر الجاهليّ (268-610م)
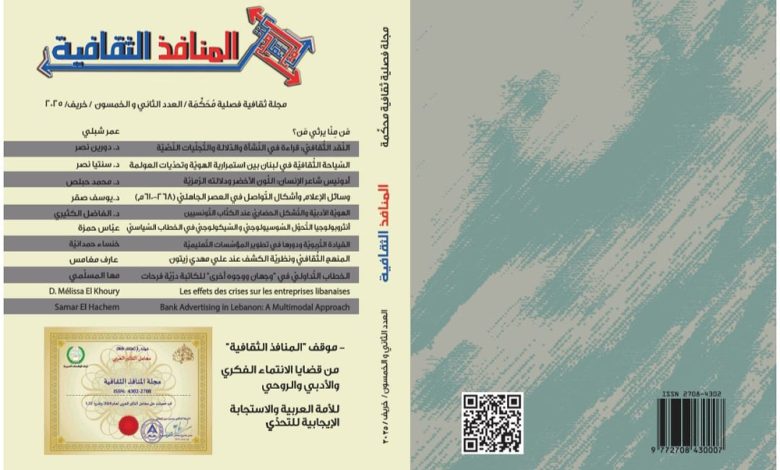
وسائل الإعلام وأشكال التّواصل في العصر الجاهليّ (268–610م)
Media and Forms of communication in the pre-Islamic Era
د.يوسف فيصل صقر[1]
Youssef Faysal Sskr
تاريخ الاستلام 29/ 6/ 2025 تاريخ القبول 13/ 7/2025
الملخّص
تعدّ وسائل الإعلام طريقة إنسانيّة مهمة لإظهار بطولات الأفراد، فهي ظاهرة حضارة استراتيجيّة عرفها الأفراد والقبائل والزّمالك العربيّة في شبه الجزيرة العربيّة قبل الإسلام، لذلك ابتكر العرب العديد من وسائل الاتّصال وأشكاله التي كان لها أحكام المقاصد، وكانت ميزة الإعلام الجاهليّ تتمثّل في سيطرة أجهزة السّلطة عليه إما مباشرة أو توجيهًا وتمويلًا، فوسائل الإعلام عديدة أهمها الشّعر، والشّاعر هو اللّسان الناطق باسم القبيلة والذائد عن حياضها، مثلما كانت الأسواق أماكن تجمعهم للحوار والنّقاش والقضاء والخطابة.
الكلمات المفتاحيّة: الإشارات – العلامات -الخطبة – الأمثال- القصص- الرّايات – نيران
Abstract
The media is an important human means of highlighting the heroism and exploits of individuals. It is a strategic civilizational phenomenon that was known among individuals, tribes, and Arab communities in the Arabian Peninsula before Islam. Thus, the Arabs developed many forms and methods of communication, each serving specific purposes. A defining feature of pre-Islamic media was the control exercised by ruling authorities—whether directly or through guidance and funding. Among the various media tools, poetry was the most prominent. The poet was the spokesperson of the tribe, defending its honor, just as marketplaces served as gathering spots for dialogue, debate, conflict resolution, and oratory.
Keywords :Signals- signs- Speech- Proverbs- Stories- Flags- Fires
توطئة
قامت العديد من الممالك في شبه الجزيرة العربيّة التي امتدت من بلاد اليمن جنوبًا إلى بلاد الشام والعراق شمالًا، ومن الخليج العربي شرقًا إلى البحر الأحمر غربًا، ويمكن اعتبار مملكة المناذرة (268 – 634 م) من أقدم الممالك الجاهليّة التي سبقت البعثة النبوية الشريفة. فالعصر الجاهليّ هو عصر الجهلاء بالدّين، وهي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجَهل بالله سبحانه ورسوله وشرائع الدّين، والمفاخرة بالأنساب والكِبَر والتّجَبُر[2]، فالجهل هو عكس الحُلم. وقد مارست الشّعوب والقبائل في ذلك العصر الإعلام وعرفته بشكل فطري ومتواتر، سواء كانت تدرك ماهية الإعلام وطبيعته أو لم تغُصْ في دهاليزه. فالإعلام وسيلة للتّواصل بين الأفراد والشّعوب، أو يأخذ شكلًا سياسيًا للتواصل بين الحاكم والرعية، والإنسان بطبيعته لديه القدرة على ممارسة التواصل الفريق” فهو الأساس الذي يقوم عليه البنيان الاجتماعيّ للأفراد باستخدام الرّموز المختلفة، كاللّغة والإشارات ونحو ذلك، ومن خلال علامات متبادلة ومفهومة، وبالتّالي فالاتّصال يمارس دورًا حيويًّا في تكوين وإعادة تكوين الآراء المختلفة” [3].
ومن واجبنا الفصل بين الإعلام ووسائله وأدواته، فكل ما أعلم فهو إعلام، وكل ما استخدم فهو وسيلة، وعليه، ما يوصل المعلومة هي وسيلة، وقد تأخذ الوسيلة شكل المظهر الإعلاميّ، كالأبنية والصّروح والإنجازات والألبسة الرّمزيّة أو التراثية التي ترمز لأمرٍ ما.
فالإعلام كان موجودًا في العصر الجاهليّ، ولكنّه لم يأخذ شكل ووسائل وأساليب إعلام اليوم، فهل ميّز العرب في العصر الجاهليّ بين الإعلام كمادةٍ، والوسائل التي تستخدم في الإعلام؟
- وسائل الإعلام
ابتكر العرب في العصر الجاهليّ العديد من وسائل الإعلام التي كان لها أحكام المقاصد ومن أهمها:
أ-الشّعر والشّعراء
الحقّ أنّ الشّعر في العصر الجاهليّ كاد يكون هو الوسيلة الوحيدة من وسائل الإعلام، فكان له المقام الأوّل في بيئة لا يعرف أفرادها القراءة والكتابة إلا ما ندر، يكادون يعدّون على الأصابع[4]، لقد ترك الشّعراء كمًّا كبيرًا من المواد الشّعريّة في أماكن أشبه بالمحطات الإعلاميّة، والإذاعات المتنقلة، وكانت المادة الإعلاميّة في زمانهم متمثلة بهجو، ومديح، وقدح، وذمّ، وتبيان، وذود، ورفع، ودحض، فأحدثت قصائدهم ضجيجًا إعلاميًّا كبيرًا ذا أثر متنقّل في عصرهم.
وممّا لا شكّ فيه أنّ لسلاح الشّعر الإعلاميّ أكبر الأثر وأبلغ التّأثير في المجتمع، فلم تكن هناك وسيلة أمضى، ولا أداة أكثر توثيقًا وتخليدًا للأحداثٍ، وأفعال الرجال، وتاريخ القبائل، وأمجاد العشائر أكثر في الشّعر والشّعراء.
وكانت القبائل، بشكل عام، “إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها بذلك وصنعت الأطعمة واجتمعت النّساء يلعبن بالمزاهر، كما يصنعن بالأعراس، وتباشر الرجال والولدان لأنّه حماية لأعراضهم، وذبٌّ عن أحسابهم، وتخليدٌ لمآثرهم وإشادة بذكرهم”[5]. “والسبب في ذلك أنّ الشّاعر في القبيلة كان يقوم مقام الصحيفة بالنسبة للأحزاب في الوقت الحاضر، فهو النّاطق بلسان هذه القبيلة، وهو المناضل عنها بشعره، وهو الحافز لهمَمها في أوقات الحروب، وهو المصوّر لأخلاقها، وعاداتها، ومكانتها بين القبائل”[6]، وقد اتخذت كلّ قبيلة وعشيرة شاعرًا لها ليقوم بعمل الوسائل الإعلاميّة في الدفاع عن القبيلة، وشرفها، وتقاليدها، وأمجادها، وينبري في الهجوم على أعدائها، بذمٍّ وقدح وأعمالها، وكان لزامًا على القبيلة أن يخرج من بينها شاعر، وإلا أضحت كاليتيمة، فنشر أخبار القيبلة، وتمجيد شرفها، والهجوم على الأعداء كانت من مهامّ الشّاعر.
وعمل الشّعر عمل الذاكرة الحافظة لمعظم الأحداث، فهو خلّد مآثرهم، وكان نوعًا من التحايل في التخليد من خلال اعتمادهم الشّعر الموزون[7].
وكانت قصائد الشّعراء، وهي لم تدوّن بقلم، تطير عابرة الصّحراء أسرع من الرياح، وتُحدِث أثرها العظيم في قلوب من يسمعونها، فصاغ عن قصد أو غير قصد بين القبائل، وحدة أهلية قائمة على أساس عاطفي[8]. فعّظم الملوك الشّعراء لرفعهم أقدارهم لما يبقون لهم من المدح والذكر[9]، وفي المقابل كانوا يرهبون الهجاء كلَّ الرهبة، لذلك كانت للشاعر مكانة اجتماعية سامية في كلّ مكان[10]، فالشّعر يعدّ من الوسائل المهمّة لإيصال المعلومات، فالويل لمن وقع تحت سيوف ألسنتهم، فلم يعفُ الدّهر عنه، وستظلّ لعنة أقوالهم تلاحقه أبد التّاريخ. وتعتبر المعلقات من أهمّ ما قاله الشّعراء الجاهليّون، ومن أعظم ما تمّ تدوينه، فهي من أكبر عمليات الإعلام المكتوب والمسموع آنذاك، سواء على صعيد طريقة اختيار المعلقة وفوزها، أو على أهمية المكان الذي علقت عليه، وهو جدران الكعبة، فيعدّ ذلك تعظيمًا للقصيدة وإكبارًا لقائلها، ولتعمّم الفائدة على زوار البيت العتيق، ثمّ لتحملها صدورهم إلى قبائلهم، وشعرائهم، ونواحيهم، وحاراتهم، وتنطق بها الألسنة، ويستشهد بها الحكماء والواعظون.
لقد أدّى الشّعر دور وسائل الإعلام الحديثة في يومنا هذا، كمحطات الرّاديو والتلفزة والصّحافة المكتوبة، لما تضمّنه من أسماء وأرقام وأحداث، وظروف، وتواريخ، وانتصارات، ومعاناة، ووصف، وتعظيم، وتمجيد، حتى العشق والوَلَه. فهو أهم وسائل الدعاية والإعلام في العصر الجاهليّ، لما له من تأثير مهمّ في النّفوس، إذ يتفاعل بسرعة مع المشاعر والأحاسيس، “فالشّاعر سمِّي شاعرًا، لأنّه يشعر بمالا يشعر به غيره”[11]
ومن اللافت بمكان، أنّ الإعلام السّياسيّ والاجتماعيّ، لم يكن آنذاك حكرًا على طبقة دون أخرى للجميع، ولم يكن للأقوياء دون الضّعفاء، ولا للأغنياء من دون الفقراء، بل كان الإعلام متاحًا للجميع. وها هم الصّعاليك يشرحون للنّاس أسباب تصعلكم، ولماذا التحقوا بمجتمع الصّعاليك؛ فهم قوم خرجوا على طاعة بيوتهم، وعشائرهم، وقبائلهم، لأسباب عديدة منها عدم إدراك أهلهم وعشيرتهم لمكنون أنفسهم، مما أدّى إلى نفورهم منهم، وخروجهم على طاعة مجتمعهم وهروبهم منه، والعيش عيشة اللّصوص[12].
وقد ثار هؤلاء الصّعاليك على البخلاء من الأغنياء، فوجدوا فيهم هدفهم المنشود، فحيِك حول حركة الصعلكة الكثير من الصفات منها البخل، وعدم إكرام الضيف، واللوم، والإلحاح في الطلب، والاستجداء، والمهم في أمر هذه الظاهرة الاجتماعيّة في المجتمع الجاهليّ، أنّه كان لها إعلامها وأدواتها الشّعريّة على وجه الخصوص، فالإعلام كان متاحًا حتّى للصعاليك.
ب- الأسواق
لم يقتصر دور الأسواق على العمل التّجاريّ، بل أدّت دورًا أساسيًّا في تبادل ونقل المعلومات، والأخبار، والأحداث، من خلال التّجار الذين قصدوا تلك الأسواق من كلّ حدب وصوب، حاملين في قوافلهم التّجاريّة الأخبار الوصفيّة للأحداث، وعادات وتقاليد وأعراف الشّعوب، وأخبار أفرادهم وأحداثها التي استعملها الشّعراء مادة دسمة في قرضِهم وقصائدهم. حيث خلّدت أعمالهم وإنجازاتهم مآثر كبار القوم وأمجادهم، فكانت تلك الأسواق أشبه بالمهرجانات الثّقافيّة السّنويّة للقبائل التي يتعاطون فيها التّجارة ومعظم الشّؤون، وعادات العرب، وتقاليدهم وأعرافهم، وتعاملاتها المختلفة فيما بينهم، فكانوا يتلاقون ويتعارفون، ويتصالحون، ويتقاضون.
وأسواق العرب كثيرة، ومنها: “دومة الجندل، وصحارى، والشّحر، وعدن، وصنعاء، والرّابية، وعكاظ، وذي المجاز”[13]، وسوق الحيرة الموسمي[14]، وسوق الخنافس[15] وسوق المشقر الذي قصده الفرس من البحر[16]، وسوق دبا بعُمان امتلاءً بأهل المشرق والمغرب[17]، واتخذت هذه الأسواق طابع المهرجانات الثّقافيّة، إذ كان لها تأثيرٌ على مجموعة الأسس الاجتماعيّة والأخلاقية بين الجماعات المختلفة، كما قامت بوظائف إعلانية، بحيث إنّه في السوق يتعلّم الإنسان الحيّل، السحر، والتنبّؤ، وعلم النجوم[18].
وإذا كان في القبيلة الشّاعر الماهر، المصيب المعاني، المخيّر الكلام، أحضروه في أسواقهم التي كانت تقوم لهم في السنة، ومواسمهم عند حجِّهم البيت، حتى تقف وتجتمع القبائل والعشائر، فتسمع شعره، ويجعلون ذلك فخرًا من فخرهم، وشرفًا من شرفهم، فالشّاعر كان إعلاميًّا مقدِّمًّا للخبر، والسوق هو المحطّة الإعلاميّة، المرئية والمسموعة.
وكانت لهم أسواق معلومة، أشهرها سوق عكاظ، فيه كانوا يجتمعون ومنه فيذهبون إلى الحج. قبل ارتحالهم إلى بلادهم ففي كل عام كانوا يجتمعون فيه للمفاخرة وإنشاد الأشعار، ومفاداة الأسرى، لأنّهم يأمنون بعضهم في هذه الأيام”[19]، ومن أحبّ أن يخلّد نصرًا لقومه، صنع ما صنعه عمرو بن كلثوم الثّعلبي، لمّا قام خطيبًا بعكاظ، فأعلن أنّ ملك الحيرة عمرو بن هند، تعمّد إلحاق الذلّ به وبأمّه فقتله[20]، وكانت عكاظ أشبه بإذاعة العرب، ومنبر أعلامهم، ومركزًا لنشر كلّ خبر، الغرض منه أن يكون عامًّا، أو سريع الانتشار، فمن أراد أن يمنح نسبه لأحد -أي هويته- قام بعكاظ، فأعلن ذلك في وجود أفراد قبائل العرب، فيعلمون بذلك، ومن أراد أن يجير أحدًا من غير قبيلة، أي يمنحه حقّ اللجوء إليها وحمايتها له، أو أراد أن يخلع أحدًا من القبيلة، أو من جوارها، فعليه أن يعلن ذلك في مجامع العرب
الكبرى. ولم يكن هنالك مجمع للعرب أكبر من مجمعهم في سوق عكاظ، وبشكل خاصّ في مواسم الجح، كما كانت معاهدات الأمن المعقودة بين قبائل العرب، لا تصير نافذة غالبًا، ما لم تعلن في سوق عكاظ[21].
تجد كلّ هذه الإرهاصات الاجتماعيّة طريقها ومنفذها في الأسواق، وقد يهدف فاعل الخير إلى تخليد صنيعه واسمه بين العرب، “ففي أسواق العرب يجتمع عرّاف، وعائف، وقائف (العيافة والقيافة)، وكاتب معه صحيفة الكتابة، وغنم وقرد، وما إلى ذلك، ومن له ثأرٌ بحث عن مُوتُورهِ ليتعرّف عليه أيضًا في أسواق العرب[22].
ولم تكن كلُّ بضاعة تَرِدُ على سوق عكاظ تُباع، إذا لم يعرَف أصلها ومنشأها، إن كان لها سمة خاصة بها، تؤكّد لنا هذا الأمر، لأنّ البضائع التي كانت مجهولة الأصل، لم تكن تجد من الناس من يشتريها، أو يُقبل عليها[23].
وكانت لكلّ قبيلة من قبائل العرب سمة خاصة، توسَمُ بها أنعامهم، ليعرف أصلها، فكان من عاداتهم أن يسألوا: ما نار هذه الناقة؟ أي سمتها، وسُمِّيت السمة نارًا، لأنّها بالنّار توسم، وكانوا يقولون عن الإبل: نجارها نارها، أي سمتها تدلّ على أصلها[24]، و كان يختمون أكياس البِّر، وزقاق الخمر، وغيرها من البضائع بخاتم خاصٍّ عليه كتابة منقوشة مميّزة، يسمّونه” الرَّوسَم”[25].
ومارست القوافل التّجاريّة دور المراسل الصحفي في نقل المعلومات، فقد كانت مصدرًا مهمًا موثوقًا في إعلام الآخرين بما جرى وسوف يجري، وما يدور من أحداث سواء بالمناطق التي دخلتها أو الأسواق والمدن والنقاط التي مرّت بها. وكان الناس يقبلون على هذه القوافل التّجاريّة، ليس طمعًا في الحصول على نفائسها فحسب، بل ليأخذوا خبرًا أو يسألونهم عن حدث، أو يسمعوا منهم عن عادات وتقاليد الأفراد والشّعوب التي تاجروا معهم. فكانت خطوط القوافل التّجاريّة محطات إرسال للمعلومات والأخبار والأحداث. وترافق كلّ قافلة تجارية رسل، وكانت مهمّتهم إيصال أخبار القافلة التّجاريّة، وما تتعرّض له من أحداث ومخاطر إلى صاحبها[26].
ج– الدّين
تباينت صورة الإعلام الدّيني بين قبيلة وأخرى، وبين منطقة وأخرى، فاتَّخذ العرب الأصنام والأوثان كأسلوب دعويّ دينيّ إعلامي، فكان لكلّ قبيلة صنم ووثن مختلف عن القبيلة الأخرى، وأعطتهم أسماء، وقدّمت لهم القرابين[27]، وتباركت بهم عند الحج، أو عند الحرب، أو في الشدائد.
وقد أنشد العرب ابتهالاتٍ ونداءاتٍ مختلفةً كانت تردَّد أثناء طوافهم بأصنامهم وأوثانهم، فكانت عبارة عن ما يشبه الأهزوجة[28]. وتتضمّن إظهار مشارب هذه القبيلة وأمجادها وانتصاراتها وما تشتهر به من حسب ونسب وجود وكرم، فكانت تروّج للإعلام الدّيني لمعتقد تلك القبيلة. ولزيادة التأثير الإعلاميّ، استخدموا الأغاني الموسيقية البدائية من تهليل وتلبية أثناء الحج[29]، لتشريع عملية النشر الإعلاميّ. وكانت طقوس وشعائر عبادة الأصنام والأوثان تشبه المهرجان الإعلاميّ الفلكلوري، فکلّ جماعة ترتدي أزياء مخصّصة لطقوسهم، ممتنعين عن بعض عاداتهم الحياتية الروتينية أثناء شعائرهم؛ وبالمقابل ممارسة بعض العادات المتعلقة بالديانة[30]، فكان لكلّ قبيلة الدور الإعلاميّ الدّيني لإظهار ما تعتقد أو ما تعظّم، وكذلك بالتفاخر بما امتازت به عن غيرها من القبائل، وإلى ما ترمز إليه أصنامهم وأوثانهم من مآثر.
وكان للكعبة المشرَّفة مكانة عند العرب حيث قصدوها من كلّ حدب وصوب، ونسبت أركان الكعبة الأربعة إلى الجهات التي تتّجه إليها، فسمّيت “الركن الشامي” بحيث يتّجه إلى الشمال الغربي، والركن اليماني “جنوب غربي”، والركن العراقي “شمال شرقي”، والركن الأسود، الذي به الحجر الأسود “جنوب شرقي”[31].
هذه البقعة الجغرافية أصبحت محجّةً لجميع الشّعوب من كلّ فجّ عميق، ممّا ساهم بتحويلها إلى خزّان إعلامي لجميع المعتقدات والعادات والتقاليد، لتنتشر في كلّ الأرجاء، فكانت تؤثر بالقادمين، وفي الوقت نفسه تتأثّر بهم.
د- الإشارات والعلامات
عرف عرب الجاهليّة عادة الخُلع، أو ما يُعرف في عصرنا هذا ( بالتبرُّؤ)، فهي من العادات الاجتماعيّة المعروفة، عنوانها تبرّؤ إنسان من آخر، أو أهل من ولد، أو عشيرة من أحد أفرادها، وذلك لجُرم أو فعل شائن، ما يجرّ عليه سمعة سيئة، أو عداوة أو ثأر، وكان لهذا الأمر أسلوب إعلامي، ليتبلغ بقرار الخلع كل من كان له علاقة بهذا الشخص، وليصل خبر ذلك لمن يهمّه الأمر. فكانوا يقولون: “إن خلعنا فلانا فلا نأخذ أحد بجناية تجنى عليه، ولا نؤاخذ بجناياته التي يجنيها”[32]، فنفي المرء عن قبيلته أو حرمانه من حماياتها له، وتضامنها معه، أو إسقاط جنسيتها عنه، كلّ ذلك كان يسمّى “الخلع” في الجاهليّة، وهو حرص منها على سمعتها وكرامتها. ووجب على القبيلة التبرّؤ من أفرادها بسبب سلوكهم المشين، يصبح سفيهًا سكّيرًا كثير الجرائم والجنايات[33].
فالمخلوع إمّا يكون من أسرى سجن أي من قبيلة أخرى، أو من بلاد أخرى[34] بحيث لا يُعرف لهم نسب، وأصل هؤلاء ليس من الرقيق، بل هم كانوا صرحاء فخلعوا، فأصبحوا منفيين، أو ربما كانوا هاربين من ثأر، أو باحثين عن الثروة[35].
ومن الإشارات الإعلاميّة في العصر الجاهليّ جزُّ الناصية، فكانت العرب تجزّ ناصية
الأسير ليعلم أن ناصيته مُلكت وجُزّت، ثم منّوا عليه وأطلقوه، وكان إذا ضلّ منهم الرّجل في الفلاة قلب ثيابه، وحبس ناقته، وصاح في أذنيها كأنّه يومئ إلى إنسان وصفّق بيديه[36]، فالتصفيق إشارة إعلامية تدلّ على الضياع في غياهب الصّحراء، وفقدان المعرفة بشعب المنطقة وممرّاتها.
وعرفت المرأة عادة شقّ الرداء والبرقع، وشقّ الجيب حزنًا على شخصٍ فقدته[37]، كما تعبّر بعض الأعمال عن شخصية المرأة الاجتماعيّة، وما تتميّز به من مواقف وفيّة مفعّمة بالمحبة والوفاء، فكانت تخمش وجهها، وتحلق شعرها إذا مات لها أحد أولادها، أو زوجها[38]. وأغرورقت عيناها بالبكاء على الحبيب، واصطحب ذلك النياحة والندب[39].
واتّخذ العرب بعض العلامات التي كانت جواز سفر في تنقّلاتهم، فقد كان شعار أهل مكة ومن في حِلفهم، عبارة عن لحاء شجر الحرم يجعلونه في أعناقهم، أو أعناق إبلهم فلا يعترضهم معترض[40]، “وذكروا أنّ سيماء أهل الحرم، إذا خرجوا إلى مناطق الحلّ في غير الأشهر الحرم، فإنّهم يتقلّدون القلائد، ويعلّقون العلائق”[41]، فهي من الإشارات التي تعطي صورة إعلامية واضحة عن أفراد القبيلة وأصلهم.
هـ- الخطبة والخطباء
الخطبة هي من مخاطبة الجمهور مشافهةً بأسلوب يعتمد على إثارة العواطف، وجذب الانتباه، انجذب إليها المستمع بشكل ضروري وفطري. ولا يمكن لأيّ نوع أو جنس أدبي أن يظهر أو يتطور إلا إذا توافرت له الدواعي والأسباب، والأمر نفسه ينطبق على الخطابة “فقد اقتضى النظام الاجتماعيّ والسّياسيّ في الجاهليّة أن يقيم العرب للخطابة وزنًا خاصًا في المفاوضات التي تكون في داخل القبيلة للنظر في أمورها وفي شؤونها الخاصة بها في أيام السلم وفي أوقات الغزو والغارات، وفي حالتي الهجوم والدفاع، وأقاموا لها وزنًا خاصًا بالمناسبة للمفاوضات التي جرت بين القبائل، أو بين القبائل والملوك، ثم في المحاضرات وفي المنافرات، فكلّ هذه الأمور وأسبابها استدعت ظهور أناسٍ بلغاء اعتمدوا على حسن تصرفهم في تنظيم التكلّم في تنسيق الجمل وفي التلاعب بالألفاظ للتأثير على القلوب”[42].
“وكان الشّاعر أرفع قدرًا من الخطيب، وهم إليه أحوج لردّه مآثرهم عليهم، وتذكيرهم بأيامهم، فلما كثر الشّعراء، وكثرُ الشّعر، صار الخطيب أعظم قدرًا من الشّاعر”[43]، وربما من بين أسباب تفوق الخطيب على الشّاعر في الجاهليّة هو اتساع وظيفته، فقد كان يفاخر وينافر عن قومه، فيشترك بذلك مع الشّاعر كما يشترك معه في الحضِّ على القتال، ولكنّه يتفرد بمواقف خاصة به كالوفادة على الملوك، والنصح والإرشاد، وخطبهم في الأملاك والزواج مشهورة، ومن أهم المواقف التي ينفرد بها أنّه كان يدعو إلى السلم، وأن تخبوا نيران الحرب. فقد تمّ إرسالهم إلى الملوك لتوضيح الأفكار بلغة شجعية قادرة على الإقناع[44].
وهناك مجموعة من التقاليد التي عكف الخطباء على اتباعها عند إلقائهم لخطبهم، ومن بينها اعتلاء رواحلهم عند إلقائهم لخطبهم من أجل أن يراهم القريب والبعيد، بالإضافة إلى أنّهم كانوا يتخذون العمائم على رؤوسهم لتزيدهم وقارًا ورفعة، كما كانوا يرفقون نطقتهم بالإشارة بالعصي والمخاطر فتبلغهم هذه الإشارات الموزونة مواطن التأثير في نفوس القوم[45].
وقد عاب على الخطباء حملهم للمخاصر التي يختصرها الإنسان فيمسكها بيده، والعصيّ هو العكاز أو القضيب، فبرر الجاحظ ذلك بقوله:” إنّ حمل العصاء والمخصرة دليل على التأهّب للخطبة، والتهيّؤ للإطناب والإطالة، وذلك شيء خاصّ في خطاء العرب ومقصور عليهم، ومنسوب إليهم، حتى إنّهم ليذهبون في حوائجهم والمخاصر في أيديهم إلفا لها، توقعا لبعض ما يوجب حملها، والإشارة بها”[46].
فالخطيب بوق إعلامي قام بوظائف اجتماعية وسياسية متنوعة[47]، اتخذ من الأسواق مكانا لخطبته في مختلف شؤون الحياة، فقس بن ساعد الإيادي كان يخطب بالناس في الأمور الكونية، ويدعوهم إلى التأمل في الموت وما بعد الموت[48]. وعلى الخطيب أن يسحر السامعين بالصوت قبل أن يقنعهم بالحُجَّة، فربما لجأ إلى اصطناع الجهارة في الصوت والتلاعب بالطبقات الصوتية تضخيمًا، وتفخيمًا، وتوقيعًا، وتنظيمًا، ممّا يساعد على تركيب الأفكار عند جماعة من الناس ليكون لديهم رأي، وتستطيع التأثير في الآخرين، “فالخطبة: الكلام المنشور المسجع”[49].
ونادم الخطباء الملوك والأمراء، فأتاح لهم ذلك الاطلاع على أسرار الدولة ومكنوناتها السّياسيّة؛ مثال عمر بن عمار الطائي خطيب قبيلة مذحج كلّها، الذي نادم الملك النعمان بن المنذر اللخمي ( 582-604 م)[50] بسبب حسن حديثة وجمال كلماته.
لا شكّ أبدًا في أنّ دور الخطابة في مسألة الإعلام هي من الأدوار الرئيسة، فسهولة التعامل والتخاطب بالمنثور، أهمّ وأسهل وأعمّ من التعامل بالمقفّى والموزون، وكذلك جاءت مختلف المعلومات والمواضيع الإعلاميّة، من علوم وإخبار، وإنباء، وتعليم و تعميم، بمعظمها منثورة، عدا بعض الأمور التى اختصّت بالشّعر، لأهمّية حفظها وتحفيظها ونشرها.
و- الأمثال
أبدع العرب في تقديم الأمثال في المواقف والأحداث المختلفة، فلا تكاد تخلو مواقف الحياة العامة من مثل ضُرب عليها، ولا نجد خطبة معروفة، ولا قصيدة سائرة إلا واحتوت مثلًا رائعًا مؤثّرًا في حياتنا، فالمثل: هو نوع فى الحِكم، يأتي في حدث لمناسبة ما، تطلّبت أن يَرِدَ فيها ثمّ يتناقلها الناس في غير واحد من الوقائع التي تشابهها[51]، دون أدنى تغيير لما فيه من إيجاز وغرابة ودقّة في التصوير.
والأمثال أقوال مختصرة، يُراعى في وضعها الإيجاز والبلاغة والتأثير، وقد يكون المثل كلمتين، وقد يكون أكثر من ذلك، ويُراعى أن يكون سجعًا أو طباقًا[52].
وقد ضرب المثل بشخصيات جاهلية تركت أثرًا في أيامها. فضُرِب بها المثل، مثل:” أبلغ
قسّ” و يراد به قسّ بن ساعدة الخطيب الشهير[53].
فالمثل العربى يأتي بعد الشّعر العربي مباشرة من حيث الحفظ وسرعة الانتشار، فقد عرف العربي المثل كمدرسة ومرجع توجيهي في حياته اليومية، فاتخذ الأمثال كشواهد على مختلف أعماله وتصرفاته، وضربت الأمثال لكلّ المسائل، لأنّها استُخرجت من التّجارب ومن خبرة الحياة، ولقد حفظت الأمثال العربيّة معظم ثقافات العرب وعاداتهم، وحكمهم وفهمهم للحياة، وطريقة تصريف أمورهم اليومية.
“والأمثال من حكمة العرب في الجاهليّة، فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتهم في المنطق بكناية غير تصريح. فيجتمع لها بذلك ثلاث من خلال: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحُسن التشبيه”[54]، فكم من خبرة، وثقافة، وتقليد، وحكمة، وموعظة، ومآثرة، حفظت في مثل، فتناقلته الألسن من جيل إلى آخر، ومن قبيلة إلى أخرى، وحتى من بلد إلى آخر، فحمل معه كلّ هذه القيم الإنسانية كنشرة إلكترونية أو مطبوعة، أو مُرسلة عبر الأثير، ولكن في قالب من الأنسنة، من خلال التلقين والتداول المباشر، من إنسان لآخر.
“ولا يزال بعضها حيًّا يتمثل الناس به، أو بعضًا منه يَرِدُ على لسان كلّ إنسان، أي أمثلة تنطبق على كلّ البشر، لأنّها صادرة من نفس إنسانية عامة، فلا تعدُّ من الأمثلة المحلية أو القومية، أي أمثلة نبعت من محيط أمَّة معينة، لذلك نجد لها شبهًا عند أمم أخرى، ولا نستطيع أن نقول إنَّ الأمّة أخذتها من تلك”[55].
فالأمثال عند الجاهليّين نوع فى أنواع الحكمة السائرة بين الناس، يقولها السيد، والمسود البارز والحاصل، وهي تحفظ بسهولة، ولا يحتاج المرء لتعلُّمها مهارةً وذكاء، فهى موروثٌ شعبيّ وثقافيّ، تمتاز بالحكمة والبساطة، بحيث كانت التّجارب التي مرّت بها الشّعوب سببًا أساسيًا ساهم في انتشار هذه الظاهرة.
ز- القصص
احتلّت القصص جزءًا كبيرًا من اهتمام العرب الجاهليّين، لأنّها مادة تاريخهم، ومنارةٌ لشعوب وأمم لا يعرفونها فتحفّز خيالهم، وتنقل ثقافتهم، ومعرفتهم، فالقصة فنُّ أدبيّ نثريّ يعطي الناس ويخبرهم بما مضى ليعتبروا[56]، تتناول بالسرد حدثًا واقعًا، أو يمكن أن يقع.
وعرب الجاهليّة كانوا يشغفون بالقصص شغفًا شديدًا، بسبب أوقات فراغهم الواسعة في متاهات الصّحراء، فكان لهذه القصص دورها في الإخبار والإعلام عن سالف الأيام والأمم التي عبرت خلالها، وعن أحداثها، لتكون دروسًا وعبرًا لمن بعدها من الأمم، وكانت أمثلة وإخبارًا. لا شكّ أنّ القصص كان لها تأثير هامّ في الناس لجهة التأثير بهم وبتوجيهاتهم. وكانت سلاحًا له وزنه بين الجماهير، إن للوعظ والتنبيه دورٌ إما لإظهار قدرة الله في خلقه ممن سبقه، وإما لشخذ الهمم ورفع المعنويات، أو لإظهار الصدق والفصل في الأمور المختلف عليها بين الناس وأخذ الدروس والعبر.
ومن أشهر قصص الجاهليّة، قصة عدي بن زيد العبادي الذي قتله النعمان بن المنذر أبا قابوس في سجنه[57] حوالي ٥٨٧م، والنابغة الذبياني زياد من معاوية (ت٦٠٤ م) الذي اصطنع القصص ليعظ بها قومه وممدوحه النعمان بن المنذر ملك الحيرة، فقصَّ عليه أسطورة زرقاء اليمامة[58]، وغيرها من القصص التي رواها وأبدع فيها بسبب حبّه لبلاط الملك المنذري[59].
وأدّت القصص دورًا مهمًا في الإعلام، وبخاصة عن أخبار الأمم الغابرة والغائرة القِدم في التّاريخ، ولقد اعتمد أهل التّاريخ في العصر الجاهليّ على القصص القديمة لمعرفة أخبار العرب، لأنها أحد أهم مصادر المؤرّخين، حيث لم يكن عصر التّدوين قد بدأ، وقد احتوت القصص على ما احتوته من معلومات رواها القصّاص والرواة كما وصلتهم، ولا يعلم أحد مقدار مصداقيتها، أو صحّتها، أو مدى دقّتها، فقصة الزباء بنت عمرو مع عمرو بن عدي اللخمي[60] التي تظهر الثأر في مغزاها.
ومن القصص، قصص الملوك والأبطال، وسادة القبائل والأيام، وتؤدّي قصص الأيام الدور الأوّل في هذا المقام، لما له من أثر في العصبية[61]، وكان من أحبّ القصص إلى نفوس العرب، تلك التي تدور حول المعارك العسكرية في الجاهليّة، بين القبائل والممالك العربيّة، کيوم حليمة بين المناذرة والغساسنة[62].
و أدّت القصة دورًا مهمًا في إدخال تاريخ الأقوام الغابرة. ولبعض القصص أصول أعجمية دخلت إلى المجتمع العربي من منابع خارجية يونانية، وفارسية، ونصرانية، مثل قصة يومي البؤس والنعيم للملك المنذريّ النعمان بن المنذر[63].
فالقَصّ هو من مخاطبة الجمهور والتأثير فيه، بالاعتماد على مضمون القصة والعظة التي تمثلها، ولأنّ العرب، وبطبع الناس عمومًا، حبّ المعرفة والاستماع للأمور الغريبة والغامضة مما خفي من أمور، فقد كانت القصة إعلاما متنقّلًا من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن جيل إلى جيل.
والقصص على نوعين: قصص للعامة، وقصص للخاصة. فأمّا الأولى، هي التي تجمع إليها نفوس أكثر الناس، وأمّا الثانية، فهي التي اعتمد عليها الملوك. “فقصص النوادر والنكات من القصص المعروفة عند أهل الجاهليّة، وقد اتخذ الملوك والأشراف لهم ندماء عرفوا بإغراقهم في قول المدح، والنوادر، والأمور الغريبة المضحكة”[64].
حـ- الرّايات
استخدم العرب في الجاهليّة الرّايات والألوية بألوانٍ مختلفة للدلالة الإعلاميّة، فاسم راية الحرب لواء، وهي عبارة عن شقّة ثوب تلوى وتشدّ إلى عود الرمح.
واتخذت كلّ مملكة وقبيلة راية خاصة بها من ناحية الشكل واللون، فبنو تغلب كانت رايتهم بيضاء ابن نحاس، المصدر السابق، جـ2، ص97 – 98، وقد حملت الراية عنوانًا إعلاميًّا مادّته الشجاعة والدفاع المستميت عن حياض القبيلة، أو المملكة.
ولم يقتصر حمل الرّايات للدلالة الإعلاميّة على اسم القبيلة أو المملكة، بل امتدّت حدودها الإعلاميّة إلى بيوت البغاء التي أختصّت برايات منصوبة على أبوابها لتُعرف به[65]. فكان لصواحب تلك الرّايات نصيبهنَّ من الإعلام، حيث كنّ يعرفن بهذا الإسم، وبتلك الرّايات، وكان لزامًا عليهنّ وضع تلك الرّايات ليتميّزن عن حرائر العرب من النّساء. وإذا غدر الرّجل رفعوا له في سوق عكاظ لواء ليعرفه الناس، ونصب اللواء في المواضع العامة وفي المواسم للإشارة إلى غدر شخص بشخص آخر. فلكلّ غادرٍ لواء، أي علامة يُشتهر بها في الناس[66].
وامتد استعمال الرّايات إلى الطرق التّجاريّة، فمن وسائل الاستدلال والاهتداء في الطرق الأصواء: وهي أعلام من الحجارة مرتفعة ومنصوبة يُستدلّ بها على الطريق[67]، والآرام: وهي الأعلام، أي حجارة تجمع وتنصب في المفازه يُهتدى بها[68]. فالرّايات بأنواعها القماشية، والطينية، والصخرية، مظهر من المظاهر الإعلاميّة عند العرب الجاهليّين.
ط- نيران العرب
استخدم عرب الجاهليّة النّار للعديد من المناسبات، فكانت وسيلة للإعلام عن بُعد توقد لأمور ومناسبات معينة، ولها دلالات لا يعرفها غيرهم، وقد بلغت ثلاثة عشر نوعًا من النّار، وقد اختصّت قريش دون العرب بنار المزدلفة التي استنَّها قصي بن كلاب، فهو أوّل من أوقدها ليظهر وهجها في ظلمة الليل، هديًا للحجيج عند دفعهم من عرفة إلى مزدلفة[69]. وكانوا إذا تحالفوا تصافقوا، وشبكوا الأيدي اليمنى، وكانوا يوقدون نارًا عند التحالف، ويقتربون منها حتى يشعروا بحرِّها، ثم يعدّوا منافعها ويحرم ناكث العهد منها، ويسمّون الرّجل المسؤول عن هذه النّار المهول فهي نار “المهّول”، التي توقد عند التّحالف، ويطرحون فيها ملحًا يفقع، ويهولون لذلك تأكيدًا للحلف[70]، فهي وسيلة إعلامية فطرية لا تكلّفهم شيئًا من الجهد والمشقة[71].
وللمغدور نار تسمّى نار العار، توقد أيام الحجّ على الجبل المطلّ على منى، ثم يصحيون هذه غدرة فلان، فيدعو عليه أهل الموسوم[72]، ويصحب هذه النّار تحذير ولعن، فهي رمز لنقضة العهد والغدر به[73].
وكان في عادة العرب الأجواد إيقاد النّار في اللّيل، ليراها الغريب والجائع من مسافة بعيدة، فينفذ إليها حيث يجد من يقريه، ويقدّم له ما يحتاج إليه من الطّعام، وأطلقوا على هذه النّار نار القرى، وكانوا يوقدونها في الأماكن المرتفعة لتكون واضحة للعيان[74]. وأوقدو للمسافر نارين: نار الطرد، ونار الأياب، فالأولى يوقدونها خلف المسافر والزائر الذي لا يحبّون رجوعه، والثانية توقد للقادم من السفر سالمًا غانمًا[75]. وللحرب نار تسمّى نار الأهبة والإنذار، فإذا أرادوا حربًا أو توقّعوا جيشًا أوقدوا نارًا على جبلهم يبلغ الخبر أصحابهم[76]. فنار الحرب يشعلونها إعلامًا لذويهم بالأهبة للحرب[77]. فهي في الليل نارٌ تسطع تضيء، وفي النهار دخان مرتفع، والواضح أنّها كانت توقد على مكان مرتفع لسهولة رؤيتها.
- أشكال التواصل الإعلاميّ
وهو انتقال وتبادل المعلومات، والعواطف، والاتجاهات من فرد لآخر، أو من مجموعة لمجموعة أخرى. من خلال الكتابة، أو الكلام، أو أي طريقة أخرى. ومن أشكاله:
أ- التواصل الشّخصيّ المباشر
وهو الجلوس إلى الشّخص وجهًا لوجه، أما غير المباشر فهو الاتّصال به من خلال الآخرين، أو عبر الوسائل كالمراسلة. وأدّى السفراء والمرسلون في العصر الجاهليّ دورًا جوهريًا في تطوير الاتّصال الشّخصيّ المباشر وغير المباشر[78].
وهي – أي المباشرة- الطريقة والأسلوب الأكثر فعالية على مدى الدهور، لأنّ في الاتّصال المباشر والجلوس للحوار وجهًا لوجه، يشعر المتلقي والمرسل بحقيقة الكلمات التي يسمعها من الآخر، فيحكم بما يحسسهُ من جليسه، فيؤثّر ويتأثّر، عكس أن يكون الحوار من خلال واسطة. وكانت وسيلة الاتّصال المباشر مهمّات جميع الرسل الذين يبعثهم الله إلى الأمم السالفة، وممّا لا شكّ فيه أنّ الاتّصال الشّخصيّ في ذاته أساس لجميع العمليات الإعلاميّة من حيث هي، ومن بينها العملية الإعلاميّة التي تعرف “بالعلاقات العامة” والعمليّة التي تعرف بالإعلان، ولكنّ الاتّصال الشّخصيّ أكثر ما يؤثّر في الحقيقة في ميدانين خطيرين، هما: ميدان الدّعوة، وميدان الدّعابة. والقدرة على ممارسة الاتّصال الذي من هذا النّوع شرط في نجاح العمليات الإعلاميّة، التي أشرنا إليها، ذلك أنّه يؤدّي دورًا خطيرًا في الإعلام على جميع المستويات، ومن الجدير بالذّكر أنّ اتّجاهات البحوث الحديثة تؤكّد أهمية الاتّصال الشّخصيّ، وتنسب إليه مقدرة عظيمة على التّأثير في الجماهير، أكثر بكثير من بقيّة وسائل الإعلام العامة[79].
فخبراء الإعلام اتفقوا على أنّ الإعلام: إنما هو رسالة ينطوي عليه هذا التعبير من شُعب مترابطة بين جهة البث، والتلقي، ومحتوى الرسالة، وحامل الرسالة. ومارس عرب الجاهليّة هذا النوع من الإعلام بشكل يخدم مصالحهم وأهواءهم[80]، ففي الاتّصال الشّخصيّ يسمع كلّ واحد رأي الآخر بالصوت والشكل، ويلتمس كلّ واحد منهم ما في وجه الآخر، ونبرة صوته، ويرى بعين قلبه مدى صدقه، وردّات فعله، فإمّا هو صادقٌ، أو هو كاذب.
وسرّ تفوق الاتّصال الشّخصيّ في التأثير بأنّه “إذا كان من السهل أن ينصرف الناس عن المواد الإعلاميّة التي لا تتّفق مع آرائهم وميولهم، فإنّه ليس من السهل أن يتجنّبوا الحديث مع زميل، أو قريب، أو صديق لهم، وخاصة إذا كان موضوع الحديث غير معروف لديهم سلفًا، كما يتيح النقاش المباشر مرونة أكبر في عرض وجهات النظر والتأثير في الناس”[81]، ومارس الناس طريقة المناداة[82] حيث ترتفع بها حناجر المنادين في القرى والمدن، فتطوّر النداء إلى الأذان في الإسلام. وإطلاق الأعيرة النّارية في الأفراح أو البشائر[83].
ولعلّ أبرز ما يميز الاتّصال الشّخصيّ المباشر عن الاتّصال الجمعيّ أو العامّ هو:
– توفير الحرّية أثناء الحديث والتحاور المباشر، واستعراض الأمور، والاستمتاع بحرّية، والسؤال بالأمور المستنتجة عن اللقاء.
– الوصول إلى تحقيق الإقناع بشكل أفضل أثناء الحوار المباشر والشّخصيّ، في استخدام وسائل الإعلام الأخرى.
– إمكانية الملاحظة الواضحة لردّات فعل المتحاورين، بما يساعد على تأكيد صدقية الحديث وإظهار روحيّته.
– العلم والإحاطة بما يلزم المتلقي، أو المحاور، أو ما قد يكون يحتاجه من علم أو معرفة أو استفسار.
ب- الاتّصال الجمعي أو الجماهيري
جسّدت مجالس رؤساء القبائل ولقاءات الوفود أكبر مظهر إعلاميّ للاتّصال الجمعيّ، ومن الأمثلة عليها دار النّدوة قرب الكعبة، وهي الدار التي اجتمع فيها رؤساء القبائل العربيّة، وأخذوا يتشاورون في الطّريقة المناسبة للتخلّص من النبي محمد (ص)[84] فهم يتباحثون في شتى المشكلات التي تعرض لهم، ويخرجون بحلّ للمشكلة يلتزم فيها الجميع، وللوصول إلى الحلّ يشتدّ الجدال وتعلو الأصوات، فدار الندوة أقوى طرق الاتّصال بين العرب في الجاهليّة من بعد الأسواق، فهي مكان يجتمع فيه أهل الرّأي في الأوقات التي تحتاج إلى تبادل الرأي[85] ولكن يجب أن لا يتبادر إلى أذهاننا أنّ جميع أفراد المجتمع كانوا على اطّلاع مباشر على مجريات الاجتماعات، والسبب في ذلك أنّه لا بدّ أن يجتمع الناس كلّهم في ساحة واحدة لكي يستمعوا إلى مقررات الاجتماع، أو رأي شيخ القبيلة، أو أقوال الزّعماء والقادة، وبدون ذلك لا يستطيع الشّعب الاطّلاع على مقرارات الاجتماع.
وهذا لم يكن متوفرًا في العصر الجاهليّ، ويُعزى السّبب في ذلك، أنّ المجتمعات الجاهليّة، أو نظمهم السّياسيّة في الحكم، لا تحفل كثيرًا بما يسمى بـ الرّأي العام[86].
جـ- اللّغة
تعدّ اللّغة أساس التّواصل فيما بين البشر رغم تنوّعها، واتّخاذها أنماطًا مختلفة، ولو أنّ هناك ما يشبه المصطلحات للتّواصل في بعض نواحي العلوم الحديثة، كالإشارات، والرسوم، والرّموز التي أصبحت عالمية المفهوم والمصطلح.
وكان العرب مختلفي الألسن بالبيان، متبايني المنطق والكلام، وإنّ بعضها كانت بعيدة بعدًا كبيرًا من عربيتنا، وبعضها مشتقٌّ من بعضها، فأوّل من كتب بالعربيّة هم أهل الأنبار، ومن الأخيرة انتشرت بين الناس، ووصلت إلى أهل الحيرة من قريش[87]. ولم يقتصر الأمر على نقل الكتابة العربيّة من الحيرة إلى شبه الجزيرة العربيّة، بل الكتابة الآرامية نُقلت بدورها إلى شبه الجزيرة من قبل سكان الحيرة[88]. وكان لسان أهل الجنوب، ومنها الحميرية، بعيدة كلّ البعد عن اللّغة العربيّة التي كُتب بها الشّعر العربي، “وأصبح اليوم من الأمور المعروفة أنّ أهل العربيّة الجنوبيّة كانوا يتكلّمون بلهجات تختلف عن لهجة القرآن الكريم، بدليل هذه النصوص الجاهليّة التي عثر عليها في تلك الأرضين، وهي بلسان مباين لعربيتنا، حيث تبيّن من دراستها وفحصها أنّها كتبت بعربية تختلف عن عربيّة الشّعر الجاهليّ، وبقواعد تختلف عن قواعد هذه اللّغة”[89].
د- التّدوين
استعان الجاهليّون بالموادّ الأولية البسيطة لتدوين كتاباتهم، ففي البدء استغلّوا الحجارة، كما ورد في النقوش، وقيل في وصف “الكتابات القديمة: فقد كانوا يجعلون الكتاب حفرًا في الصّخور، ونقشًا في الحجارة، وربما كان الكتاب هو النّاتئ، وربما كان الكتاب هو الحفر”[90]، وكتبوا على خشب الرحل[91]، واصطنعوا موادّ كصحيفة[92]، وربما كانت تتّخذ من جلود الحيوانات، واستعملوا القضيم للكتابة: وهو جلد الأبيض[93]، وكتبوا على القِطُّ الصكّ وهو الكتاب[94]، ووردت إشارة إلى استعمالهم المداد في كتبهم[95]، وكتبوا بالقلم، والمزبر، والدواة[96]. وكان التعليم يشمل القراءة والكتابة محصورًا بين الحضر وقريش، وفي المدينة ومكة، وعرفت رجالها الكتابة فقط دون نسائها[97].
ومن أدوات انتشار الكتابة والتّدوين استعمال الخاتم في مخاطبات الملوك، حيث تختم الرسائل، لأنّ الملوك لا يقرأون كتابًا غير مختوم[98].
الخاتمة
كان لدى العرب في العصر الجاهليّ علوم ومعارف تتناسب وحضارتهم داخل شبه الجزيرة العربيّة، فاستخدموا وسائل الكتابة والتّدوين، ولو بصورة بدائيّة، بعد أن وحّدوا جميع لهجاتهم بلهجة قريش، واستثمروا المناسبات الدّينية، والحركة التّجاريّة الناشطة، وأقاموا الأسواق الموسميّة والمتنقلّة في أرجاء الجزيرة العربيّة، بغية نشر أخبارهم، وعاداتهم، وتقاليدهم، وأعرافهم، وللحديث عن أمجادهم، وحسبهم، ونسبهم، تفنّنوا في ضروب الشّعر، ومذاهبه، وألوانه من مديح، وهجو، وغزل وحكم… إلخ. فكان الركيزة الأساسية في أي رأي أرادوا تعميمه أو تخليده، أو الرفع من شأنه، أو حتى ذمّه، فوصل الشّعر عندهم إلى حدّ القداسة، حيث علقت الأشعار على أستار الكعبة، وحفظ العرب مآثرهم، ومعارفهم وتجاربهم باستخدام الحكم، والأمثال، والقصص، التي حفظت معظم تلك التّجارب والمواقف، واستخدموا بعض اللوازم اليومية والموسمية من لباس، وشعار، وألوان فى إيصال مضامين إعلامية، بما يؤكّد أنّها كانت بمجملها وسائل وأدوات إعلامية، ماتزال تستعمل في الإعلام حتى الآن.
وكثيرًا ما تطوّرت وسائل الإعلام الجاهليّة لتوضع في قوالب تتناسب والحياة العصرية، ولكنّها في أساسها كانت جاهلية، واستمر العمل بها في عصرنا، فالمناداة تطوّرت إلى الأذان في الإسلام وما يزال يستعمل حتى الآن.
صحيح أنّ لكلّ عصر غاية للإعلام ووسائله، فإذا كان الإعلام الجاهليّ غاية إيصال الخبر، والعادات، والتقاليد، فإنّ الإعلام المعاصر استفاد من الإعلام الجاهليّ في أوجه كثيرة، لكنّه يختلف كلّ الاختلاف عنه بسبب تطور وسائل الإعلام الحديثة، واختلاف الغايات.
قائمة المصادر والمراجع
أولًا- المصادر العربيّة
- ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت 597 هـ/ 1200م)، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، 18 جزء، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط2، بيروت، 1995،
- ابن حبيب، أبو جعفر محمد بن أمية بن عمر و الهاشمي البغدادي (ت 245 هـ / 109م)، المحبّر، تحقيق سيد کسروی، نشر دار الغد العربي، القاهرة، 2000.
- ابن سعيد، أبو الحسن علي بن موسى بن عبد الملك (ت 485هـ/1286م)، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، جزآن، تحقيق نصرات عبد الرحمن، مكتبة الأقصى، عمان، (د.ط)، 1982.
- ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني (ت ٤٥٦ ه/ ١.٦٤م)، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه، جزآن، منشورات دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 2001.
- ابن قتيبة الدّينوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 276هـ / 889م )، الشّعر والشّعراء أو طبقات الشّعراء، تحقيق مفيد قميحة ونعيم زرزورة، دار الكتب العلمية، ط2، بيروت، 1985.
- ابن منظور، أبي الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم الأفريقي المصري، (ت 711 ه/ 1211 م )، لسان العرب، 15جزء، دار صادر، ط3، بيروت، 1994.
- ابن النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل(ت 338هـ / 949م)، شرح القصائد المشهورات، جزآن، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1985.
- أبو زيد، محمد بن أبي الخطاب (ت حوالي 170هـ / 786م )، جمهرة أشعار العرب، تحقيق علي فاعور، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1986.
- أبو الفرج الأصفهاني، بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد مناف ( ت 356هـ/ 967م)، الأغاني، 24 جزء، تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1992.
- الأنباري أبو بكر محمد القاسم (ت 328هـ/، 940م)، شرح القصائد السبع الطوال الى الجاهليّات، تحقيق محمد عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، ط5، القاهرة، (د.ت).
- البكري، عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (ت487 هـ / 1094م )، معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع، جزآن، تحقيق مصطفى سقا، نشر مكتبة الخانجى، ط3، القاهرة، 1996.
12- الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني (ت 255هـ/869م)، الحيوان، 6 أجزاء، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة البابي الحلبي وأولاده، ط1، مصر، 1938.
– البيان والتبين، 4 أجزاء، تحقيق عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط3، القاهرة، 1968.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدّين (911هـ/ 1505م)، المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، جزآن، تحقيق محمد جار المولى وآخرون، (د.ط)، المكتبة العصرية، بيروت، 1987.
- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير(ت 210هـ / 922م )، تاريخ الأمم والملوك، 6 أجزاء، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، 2001.
- العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت 382هـ / 992م)، كتاب الاوائل، تحقيق محمد السيد الوكيل، نشر أسعد طرابزوني الحسني، المدينة المنورة، (د.ط)، 1966.
- الميداني، أبو الفضل أحمد محمد بن أحمد بن ابراهيم (ت 518هـ/1124م )، مجمع الأمثال، جزآن، تحقيق نعيم حسين زرزور، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1988.
- ياقوت، شهاب الدّين أبي عبدالله بن عبدالله الحموي (ت 626هـ/ 1228م)، معجم البلدان، 5 أجزاء، نشر دار أحياء التراث العربي، بيروت،
- اليعقوبي، أحمد بن اسحق بن جعفر بن وهب بن واضح (ت 292 هـ / 950م )، تاريخ اليعقوبي، جزآن، تحقيق خليل منصور، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1999.
ثانيًا- المراجع العربيّة:
- الأفغاني، سعيد، أسواق العرب، مطابع دار الفكر، ط2، دمشق، 1960.
- التباني، محمد العربي، محادثة أهل الأدب بأخبار وأنساب جاهلية والعرب، مطبعة حجازي، القاهرة، 1951.
- حمزة، عبد اللطيف، الأعلام في صدر الإسلام، دار الفكر العربي، ط1، القاهرة،
- حمور، محمد عرفان، عكاظ و مواسم الحج، نشر مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر، ط1، بيروت، 2000
- سلامة، عواطف أديب، قريش قبل الإسلام دورها السّياسيّ والاقتصادية و الدّيني، دار المريخ للنشر، الرياض، 1994،
- علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب، 10 أجزاء، جامعة بغداد، ط2، بغداد، 1993.
ثالثًا- المراجع الأجنبية
- Farmers Henry George, A History of Arabia Music to the X111th Century, published by Good World, first edition: New Delhi, 2001.
- Klapper, Joseph; The Effects of Mass communication, New York, free press, 1967.
- R.A, A Literary History of the Arabs, Cambridge University press, second edition, London, 1930.
[1] الجامعة اللبنانيّة- كلية الآدب والعلوم الإنسانيّة الفرع الخامس قسم التّاريخ.
[2] ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري، (ت 711 ه/ 1211 م)، لسان العرب، 15 جزء، دار صادر، ط3، بيروت، 1994، جـ 11، ص130.
[3] Klapper, Joseph; The Effects of Mass communication, New York, free press, 1967. p. 60.
[4] حمزة، عبد اللطيف، الأعلام في صدر الإسلام، دار الفكر العربي، ط1، القاهرة، 1971، ص18 – 19.
[5] ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني (ت 456 ه/ 1064م)، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، جزآن، منشورات دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 2001. جـ1، ص70.
[6] حمزة عبداللطيف، المرجع السابق، ص20.
[7] الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني (ت 255ه/869م)، الحيوان، 6 أجزاء، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة البابي الحلبي وأولاده، ط1، مصر، 1938، جـ1، ص72.
[8] Nicholson. R.A, A Literary History of the Arabs, Cambridge University press, second edition, London, 1930. p. 72.
[9] اليعقوبي، أحمد بن اسحق بن جعفر بن وهب بن واضح (ت 292 هـ / 950م )، تاريخ اليعقوبي، جزآن، تحقيق خليل منصور، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1999، جـ1، ص180.
[10] Farmers Henry George, A History of Arabia Music to the X111th Century, published by Good World, first edition: New Delhi, 2001, p.9.
[11] ابن رشيق، المصدر السابق، جـ1، ص12.
[12] ابن منظور، المصدر السابق، جـ10، ص455 – 456.
[13] ابن حبيب، أبو جعفر محمد بن أمية بن عمر و الهاشمي البغدادي (ت 245هـ / 109م)، المحبّر، تحقيق سيد کسروی، نشر دار الغد العربي، القاهرة، 2000، ص270 – 272، اليعقوبي، المصدر السابق، جـ1، ص230 – 231.
[14] الأفغاني، سعيد، أسواق العرب، مطابع دار الفكر، ط2، دمشق، 1960، ص374.
[15] الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير(ت 210هـ/ 922م)، تاريخ الأمم والملوك، 6 أجزاء، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، 2001، جـ2، ص376، ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت 597 هـ/ 1200م)، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، 18 جزء، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط2، بيروت، 1995، جـ4، ص149.
[16] ابن جيب، المصدر نفسه، ص371، اليعقوبي، المصدر السابق، جـ1، ص231.
[17] ابن حبيب، المصدر نفسه، ص371، ياقوت، شهاب الدين أبي عبدالله بن عبدالله الحموي (ت 626هـ/ 1228م)، معجم البلدان، 5 أجزاء، نشر دار أحياء التراث العربي، بيروت، 1979، جـ2، ص435، البكري، عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (ت487 هـ/ 1094م)، معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع، جزآن، تحقيق مصطفى سقا، نشر مكتبة الخانجى، ط3، القاهرة، 1996، جـ2، ص529.
[18] الجاحظ، المصدر السابق، جـ4، ص369 – 370.
[19] التباني، محمد العربي، محادثة أهل الأدب بأخبار وأنساب جاهلية والعرب، مطبعة حجازي، القاهرة، 1951، ص126 – 127.
[20] أبو زيد، محمد بن أبي الخطاب (ت حوالي 170هـ / 786م )، جمهرة أشعار العرب، تحقيق علي فاعور، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1986، ص183، ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 276هـ / 889م )، الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء، تحقيق مفيد قميحة ونعيم زرزورة، دار الكتب العلمية، ط2، بيروت، 1985، ص138، الأنباري أبو بكر محمد القاسم (ت 328هـ/ 940م)، شرح القصائد السبع الطوال الى الجاهليات، تحقيق محمد عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، ط5، القاهرة، (د.ت)، ص371، ابن النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل(ت 338هـ / 949م)، شرح القصائد المشهورات، جزآن، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1985، جـ2، ص89، أبو الفرج الأصفهاني، بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد مناف( ت 356هـ/967م)، الأغاني، 24 جزء، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1992، جـ 11، ص50.
[21] حمور، محمد عرفان، عكاظ و مواسم الحج، نشر مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر، ط1، بيروت، 2000، ص 139-140.
[22] سلامة، عواطف أديب، قريش قبل الإسلام دورها السياسي والاقتصادية و الديني، دار المريخ للنشر، الرياض، 1994، ص227.
[23] الميداني، أبو الفضل أحمد محمد بن أحمد بن ابراهيم (ت 518هـ/1124م )، مجمع الأمثال، جزآن، تحقيق نعيم حسين زرزور، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1988، جـ2، ص114.
[24] ابن منظور، المصدر السابق، جـ5، ص243.
[25] علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب، 10 أجزاء، جامعة بغداد، ط2، بغداد، 1993، جـ7، ص551.
[26] سلامة، عواطف أديب، المرجع السابق، ص217.
[27] الجاحظ، المصدر السابق، جـ5، ص511.
[28] ابن حبيب، المصدر السابق، ص311-312، اليعقوبي، المصدر السابق، جـ1، ص218 – 219.
[29] Farmer. H. G, Ibid, p. 8.
[30] ابن قتيبة الدينوري، المصدر السابق، ص90، ابن رشيق، المصدر السابق، جـ2، ص124 – 125.
[31] سلامة، عواطف أديب، المرجع السابق، ص266.
[32] ابن منظور، المصدر السابق، جـ8، ص77.
[33] أبو زيد، المصدر السابق، ص203، الميداني، المصدر السابق، جـ2، ص87.
[34] الطبري، المصدر السابق، جـ1، ص461.
[35] Nicholson, A.R, Ibid, p. 39.
[36] ابن سعيد، أبو الحسن علي بن موسى بن عبد الملك (ت 485هـ/1286م)، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، جزآن، تحقيق نصرات عبد الرحمن، مكتبة الأقصى، عمان، (د.ط)، 1982، جـ2، ص791.
[37] أبو زيد، المصدر السابق، ص208.
[38] ياقوت، المصدر السابق، جـ4، ص69.
[39] أبو الفرج الأصفهاني، المصدر السابق، جـ22، ص90.
[40] علي، جواد، المفصل، جـ5، ص331.
[41] الجاحظ، البيان والتبين، 4 أجزاء، تحقيق عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط3، القاهرة، 1968، جـ2، ص95.
[42] علي، جواد، المرجع السابق، جـ8، ص774.
[43] الجاحظ، البيان والتبين، جـ1، ص241.
[44] ابن حبيب، المصدر السابق، ص158 – 159، اليعقوبي، المصدر السابق، جـ1، ص220.
[45] الجاحظ، المصدر نفسه، جـ3، ص6-7.
[46] الجاحظ، البيان والتبين، جـ1، ص371، و جـ3، ص117.
[47] حمزة، عبد اللطيف، المرجع السابق، ص21.
[48] الميداني، المصدر السابق، جـ1، ص155، العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت 382هـ / 992م)، كتاب الاوائل، تحقيق محمد السيد الوكيل، نشر أسعد طرابزوني الحسني، المدينة المنورة، (د.ط)، 1966، ص52 – 53.
[49] ابن منظور، المصدر السابق، جـ1، ص361.
[50] الجاحظ، المصدر نفسه، جـ1، ص349.
[51] ابن منظور، المصدر السابق، جـ11، ص611 – 612.
[52] علي، جواد، المرجع السابق، جـ 8، ص358.
[53] السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (911هـ/ 1505م)، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جزآن، تحقيق محمد جار المولى وآخرون، (د.ط)، المكتبة العصرية، بیروت، 1987، جـ1، ص503.
[54] السيوطي، المصدر السابق، جـ1، ص486.
[55] علي، جواد، المرجع السابق، جـ8، ص370
[56] ابن منظور، المصدر السابق، جـ7، ص74-75.
[57] أبو الفرج الأصفهاني، المصدر السابق، جـ2، ص118.
[58] أبو الفرج الأصفهاني، المصدر السابق، جـ11، ص13.
[59] Nicholson, R. A, Ibid, p. 122.
[60] اليعقوبي، المصدر السابق، جـ1، ص179، الطبري، المصدر السابق، جـ1، ص366 – 368، أبو الفرج الأصفهاني، المصدر السابق، جـ5، ص319 – 320، ابن سعيد، المصدر السابق، جـ1، ص63 – 66.
[61] علي، جواد، المرجع السابق، جـ1، ص373.
[62] ابن منظور، المصدر السابق، جـ2، ص149.
[63] ابن منظور، المصدر السابق، جـ13، ص312.
[64] علي، جواد، المرجع السابق، جـ8، ص374.
[65] ابن نحاس، المصدر السابق، جـ2، ص97 – 98.
[66] ابن منظور، المصدر السابق، جـ15، ص266.
[67] ابن رشيق، المصدر السابق، جـ1، ص63، ابن منظور، المصدر السابق، جـ1، ص472.
[68] ابن حبيب، المصدر السابق، ص328، ابن سعيد، المصدر السابق، جـ2، ص791.
[69] العسكري، المصدر السابق، ص28.
[70] قال أوس بن حجر: إذا استقبلته الشمس صد بوجهه كما ضد نار المهول حالف
[71] حمزة، عبد اللطيف، المرجع السابق، ص29.
[72] ابن سعيد، المصدر السابق، جـ2، ص800.
[73] حمور، عرفان، المرجع السابق، ص132.
[74] ابن منظور، المصدر السابق، جـ15، ص179.
[75] ابن سعيد، المصدر السابق، جـ2، ص800.
[76] العسكري، المصدر السابق، ص29.
[77] سلامة، عواطف، المرجع السابق، ص131 – 132.
[78] الطبري، المصدر السابق، جـ1، ص407 – 409.
[79] إمام، ابراهيم، المرجع السابق، ص12.
[80] أبو زيد، المصدر السابق، ص119، ابن قتيبة الدينوري، المصدر السابق، ص106، ابن رشيق، المصدر السابق، جـ1، ص203.
[81] حمزة، عبد اللطيف، المرجع السابق، ص75.
[82] ابن منظور، المرجع السابق، جـ15، ص315.
[83] حمزة، عبد اللطيف، المرجع السابق، ص75.
[84] الطبري، المصدر السابق، جـ1، ص566.
[85] حمزة، عبد اللطيف، المرجع السابق، ص28.
[86] حمزة، عبد اللطيف، المرجع السابق، ص14.
[87] ابن منظور، المصدر السابق، جـ15، ص171 – 172.
[88] Nicholson. R.A; Ibid, p. 138.
[89] علي، جواد، المرجع السابق، جـ8، ص563.
[90] الجاحظ، الحيوان، جـ1، ص68 – 69.
[91] ابن قتيبة الدنيوري، المصدر السابق، ص120، أبو الفرج الأصفهاني، المصدر السابق، جـ6، ص130، ابن منظور، المصدر السابق، جـ11، ص274
[92] أبو زيد، المصدر السابق، ص98، اليعقوبي، المصدر السابق، جـ1، ص181، الميداني، المصدر السابق، جـ1، ص504.
[93] ياقوت، المصدر السابق، جـ5، ص51، ابن منظور، المصدر السابق، جـ6، ص305، وجـ12، ص488.
[94] ابن منظور، المصدر السابق، جـ7، ص382.
[95] ابن منظور، المصدر السابق، جـ7، ص398.
[96] ابن رشيق، المصدر السابق، جـ1، ص293، ابن منظور، المصدر السابق، جـ4، ص315، و جـ14، ص279.
[97] سلامة، عواطف أديب، المرجع السابق، ص96 – 97.
[98] الأنباري، المصدر السابق، ص123.