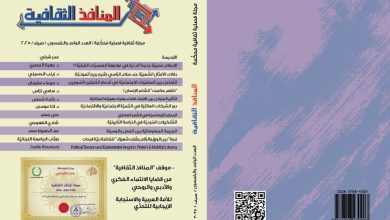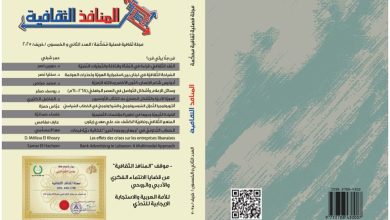قراءة في غلاف “يوميّات أُمّي” لجوزف لبُّس
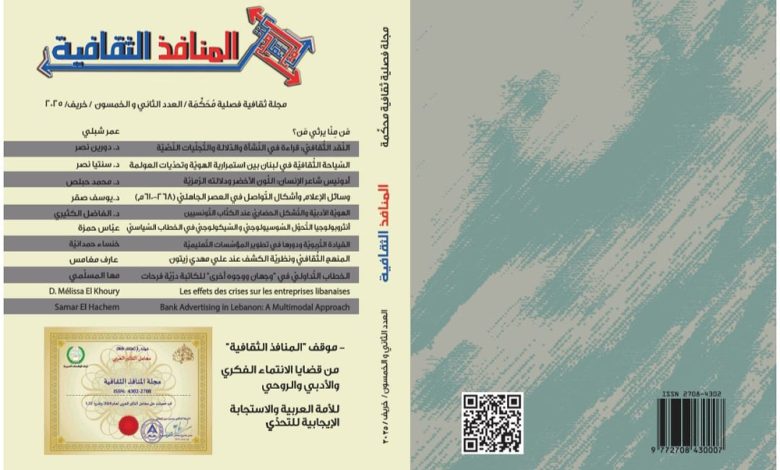
قراءة في غلاف “يوميّات أُمّي” لجوزف لبُّس[1]
A Reading into the Cover of “My Mother’s Diaries” by Joseph Lebbos
مريم محمود سرور[2]
Mariam Mahmoud Srour
تاريخ الاستلام 30/ 5/ 2025 تاريخ القبول 29/ 6/2025
الملخّص
هذا البحث قراءة في غلاف كتاب “يوميّات أمّي” لجوزف لبُّس، توقّفت عند مكوّنات الغلاف من صورة وألوان وعناصر بصريّة، بوصفها عتبة تأويليّة تسبق النصّ وتؤسّس لتلقّي محتواه. وتحاول القراءة أن تكشف عمق العلاقة بين الشّكل والمضمون، من خلال تحليل الرّموز اللونيّة ودلالات الصّورة، وربطها بسيرة الأمّ جاكلين – صاحبة صورة الغلاف – التي تشكّل محور الكتاب. كما يضيء البحث على كيفيّة تحويل الغلاف إلى مساحة بصريّة تعبّر عن الحضور العاطفيّ والفنّي للأمّ، وتجعل من الغياب مادّة للذّاكرة والاحتفال.
الكلمات المفتاحيّة: يوميّات- غلاف- تأويل- الرّموز- مساحة بصريّة
Abstract
This study is a reading of the cover of My Mother’s Diaries by. Joseph Lebbos, focusing on its visual elements image, colors, and design as an interpretive threshold that precedes the text and shapes the reader’s reception of its content. The reading aims to uncover the deep connection between form and meaning by analyzing color symbolism and the visual implications of the image, linking them to the life of Jacqueline—the woman depicted on the cover—who stands at the heart of the book as both its subject and inspiration. Furthermore, the study sheds light on how the cover transforms into a visual space that expresses the emotional and artistic presence of the mother, turning absence into a medium for memory and celebration.
Keywords: diary – cover – interpretation – symbols – visual space
المقدّمة – الكلمة حين تقاوم الغياب
في قلب الكتابة، كثيرًا ما تتجاور الحياة والموت، الذكرى والفقد. وبين دفّتي كتاب “يوميّات أمّي” للدكتور جوزف طانيوس لبُّس، الصادر عن الدار العربيّة للعلوم – بيروت في الأوّل من آب في العام 2024 أي في الذكرى الأولى لرحيل أمّ الكاتب، تلتقي هذه الأضداد في نسيجٍ ناعم، محكم، تنسجه يدٌ تسعى بالكتابة إلى تثبيت ملامح الغائبة، واستحضار حضورها في كلّ ما خطّته يده: في العبارة، في اللون، وفي التفاصيل الصغيرة. حيث تغدو جاكلين ماري أنطون الأشقر لبُّس، في هذا العمل، أكثر من أمّ، وأكثر من امرأة ارتبطت بعائلتها وفنّها. هي رمزٌ يتجاوز الخصوصيّة الفرديّة ليصبح نموذجًا للأمومة الخلّاقة، وللحبّ الصامت، وللنور الذي لا يخبو حتى بعد الغياب. تظهر الأمّ لا بوصفها موضوعًا للحنين، بل بوصفها مركزًا للمعنى، ينبثق منه النصّ ويتكوّن، وتتحرّك من خلاله لغة الابن، لا بوصفها لغة عاطفيّة فحسب، بل كفعل مقاوم للنّسيان، وكتابة في وجه العدم. وفي هذا الإطار، لا تقف اليوميّات عند حدّ التسجيل الزمنيّ، بل تتجاوزه إلى منطقة تأمّليّة عميقة، حيث تُصبح لحظات المرض والرحيل، محفّزًا على التأمّل في معنى الوجود، والعلاقة التي لا تنفصم بين الصّورة والكلمة، بين ما نرثه وما نكتبه. فالكتابة هنا ليست فعلًا توثيقيًّا بقدر ما هي إعادة خلقٍ لشخصٍ تحوّل من جسدٍ حيّ إلى طيفٍ خالد، يسكن الذاكرة واللغة واللون، بل ويُهيمن على الغلاف كما يهيمن على الروح. ويُضاف إلى قوّة هذه اليوميّات بُعدٌ بصريّ لافت، خُطّ بريشة الراحلة، حيث يتشابك الأصفر الذهبيّ – لون الشمس والدفء – مع الأبيض – رمز الصفاء والغياب النقيّ – ليكوّنا معًا مشهدًا لا يُقرأ بالعين فقط، بل يُستبطن بالقلب. إنّ اللون في هذا العمل لا يزيّن، بل يعبّر؛ لا يجمّل، بل يكشف، فيستحيل الغلاف لغة بحدّ ذاته، ويصبح اللون نصًّا موازيًا للكتابة.
أوّلًا: في اليوميّات – الكتابة في مهبّ الرحيل
من عنوان الكتاب نبدأ “يوميّات أُمّي”، فالعنوان أحد المفاتيح الرّئيسة لاكتشاف النّصّ وتفسير محمولاته الفنيّة والدّلاليّة (المناصرة، ٢٠١٥، ص١٠). يرى الباحث الفرنسيّ فيليب لوجون (Philippe Lejeune) أنّ اليوميّات «حكاية سرديّة بالضّرورة، لكنّها ليست حكايات، بل تتمثّل في تعاقب آثارٍ محدّدة زمنيًّا، قد تكون أفكارًا أو أوصافًا» (علي، ٢٠٢٠، فقرة ٢). والكتاب غير متعلّق بيوميّات الكاتب – كما يشير العنوان – إنّما بيوميّات أُمّه التي غادرت هذه الحياة في الأوّل من آب ٢٠٢٣، فيكون تاريخ نشر الغلاف على هذه الصفحة هو تاريخ الذّكرى السنويّة الأولى.
اشتهرت في العصر الحديث يوميّات عدد من الكتّاب والفنّانين، مثل “يوميّات تولستوي”، و”يوميّات كافكا”. وعلى الصّعيد العربيّ، “يوميّات نائب في الأرياف” لتوفيق الحكيم، و”يوميّات غسّان كنفاني” الّتي لم تُنشر في حياته (1936- 1972).
كتب القدّيس أوغسطينوس كتاب الاعترافات، وهو أوّل سيرة ذاتيّة غربيّة (400 م). وأوّل من شرع في كتابة اليوميّات هو المؤرّخ الإنكليزيّ وليم دو جديل (William Dugdale) (1686 -1605) الذي كتب في يوميّاته خمسًا وأربعين سنة من حياته، لكنّها لم تُنشر إلّا بعد وفاته (البغدادي، ٢٠١٦، ص٢٠٦).
تشبه اليوميّات فنّ السّيرة الذاتيّة من جهة، إذ تتعلّق بحياة كاتبها، وتختلف عنها في أوجهٍ أخرى. تمتاز اليوميّات بعدم تتبّع نمطٍ فنّيٍّ معيّن، ولا يفسح الكاتب في المجال لعمل الخيال، فاليوميّات مسوّدة تفتقر إلى البناء المنطقيّ، وشذرات مجزّأة كمراحل الحياة (لبُّس، 2009، ص59-60). إنّها آثار كاتبٍ يبدو وكأنّه يحيا بيوميّاته، ومثله مثل فنّان متفرّع يتمرّن يوميًّا كي يرتقي بفنّه أبدًا… ولعلّ أكثر ما يزيل الالتباس بين اليوميّات والسّيرة الذاتيّة أنّ كتّاب اليوميّات يدوّنون الأيّام ولا يسردون الحياة، وهم عوضًا عن أن يتحدّثوا إلى النّاس عن نفوسهم، يناجون نفوسهم في كثيرٍ من الرّفق والهدوء واليسر، مناجاةً عذبةً لكنّها عميقة دقيقة ساكنة، وحيّة خصبة (ص61).
بدأ المؤلّف بكتابة اليوميّات في الأوّل من أيلول، أي الشّهر التّالي على وفاة أمّه (١ أيلول ٢٠٢٣). وحين نقرأ هذه اليوميّات، لا سيّما فترة مرض الأمّ، والتّنقّل بين البيت والمستشفى، نشعر بتشابه الأمّهات وآلامهنّ ومعاناة العائلة، فكلّ ما في أمّه في أمّهاتنا، وكلّ ما في أمّهاتنا في جاكلين، أمِّه، وهذا ما عبّر عنه الكاتب نفسه في مقدّمة كتابه: «في أمّي شيءٌ من كلّ الأمّهات، وفي الأمّهات شيءٌ من أمّي» (٢٠٢٤، ص٧). عبارة تختصر حكاية إنسانيّة كبرى، تنقلنا من الخاصّ إلى العامّ، من حكاية أمّ واحدة إلى حكاية كلّ من تألم، وانتظر النبأ نفسه، وصلّى الصلاة ذاتها بصوتٍ خافت مرتجف.
النصّ لا يُقرأ، بل يُحسّ… كأنّه يضعنا في قلب لحظةٍ يعرفها كلّ من حمل الحبّ والخوف والدعاء في آنٍ واحد. ويرى المؤلّف أنّه لا يهدف في كتابه هذا إلى التّحليل أو السّرد، وإلّا لانتظر وقتًا أطول يتيح مجال التّفكير والتّخمير والبناء، بيد أنّه عاجزٌ في الوقت الرّاهن إلّا عن الكتابة الشّذريّة، من غير انتظام أو ترتيبٍ أو تأويل (ص١١).
ثانيًا: في صورة الغلاف – رمزيّة الغلاف وديناميّة التّلقّي
حينما نتلقّى الصّورة، فإنّ عدّة عمليّات سريعة تجري في ذهننا، قبل أن نتعرّف ما في الكتاب من موضوعات. في لحظة التلقّي البصريّ الأولى، تبدأ القراءة من دون أن تُفتح الصفحات، وتتسارع في الذهن عمليّات دقيقة، لا نعيها تمامًا، لكنّها ترسم انطباعًا أوّليًّا يسبق المعنى المكتوب؛ فالصّورة تستدعي ما اختزنّاه من صورٍ ذهنيّةٍ لا تنتمي إلى مربّعٍ خاصٍّ من حيث الزمان والمكان، بل تنبع من حصيلة ما قمنا بتجريده وتكوينه عبر ثقافتنا البصريّة وتجاربنا وذاكرتنا العاطفيّة. لذلك لا نتلقّى الصّورة بعينٍ حياديّة، بل بوعيٍ ملوّن بانفعالاتنا السابقة، وإيحاءاتٍ تتجاوز الظاهر إلى المخبوء. الصّورة ليست مجرّد شكلٍ أو إطارٍ فنّي، بل انعكاسٌ للذات المتلقّية، تمنح الغلاف سلطة استباقيّة في تشكيل توقّعاتنا، أو حتى تحيّزاتنا، تجاه مضمون الكتاب. فالصّورة لا تشرح بل تلمّح، لا تُخبر بل تُثير، وهذا ما عبّر عنه الناقد المغربيّ سعيد بنكراد (2012، ص131): «إنّ الإدراك لا يتمّ دفعةً واحدة من دون وسائط، فالصّورة لا تحضر في الذّهن باعتبار وجودها المخصوص، بل تأتي إلى العين من خلال خطاطة يطلق عليها البنية الإدراكيّة»؛ وهكذا فإنّنا نشعر ونحن ننظر إلى الصّورة، كأنّ الأنامل الماهرة التي رسمت هذه الشّمس في توهّجها وتوقّدها، ألهمت الأمّ الفنّانة السّيدة جاكلين الأشقر لبُّس، أو كما عبّر الدّكتور محمّد توفيق أبو علي في شهادة مثبتة في كتاب حدائق الألوان، وهو ألبوم ضمّ ستّين من لوحاتها: «كلّما اقتربْتَ إليها، أدركْت أنّ النّورفيها سجيّة وسليقة، وأنّه أقوى من ظلام التّراب، وهذا النّور عينه هو الّذي فتح الكُوى للإبداع الّلونيّ، وأفسح له في المجال كي يتماهى مع صاحبته، فينقلها لوحة متجدّدة الدّلالات» (الأشقر لبُّس، 2017، ص31)، فنسجت هذه اللوحة بدقّة التصوير ما بين «شروق وغروب»، أو ضوء «يتشعشع ألوانًا وورود» (ص٣٦). الشّعاع موسيقى هذه الّلوحة، ومبعث الحياة فيها، فكلّ ما فيه يتنفّس بلون: الحبُّ أحمر، والنّقاء أبيض، والتّوقّد أصفر، فما أروع العاشق حين يرى الكون متناغمًا في ألوانه، كذلك الأيّام تتلوّن؛ فاليوم الجميل نبدأه بالبياض وتشيع فيه تحيّة الصّباح، صباح الفلّ، لتشرق من رحم الألوان باقةُ شمسٍ أزهرت والتفّت ببرعمٍ انسلّ من خيوط الدّجى، وتفتّح وردًا وياسمين… وتصبح علامات الكون أحداثًا جديرةً بالتّأمّل، بقدر ما هي تدوينات يوميّة، فلا تخلو اليوميّات من الذّات ومن الآخرين، من الأحداث والأشياء، لتصل إلى عالم الإبداع الفنّيّ المتمثّل في حدائقِ ألوانٍ تتراقص سنابلها على أناملَ خُضرٍ ساحرة.
وللكتاب غلافان: أوّل ما يُطالعنا فيه تلك اللّوحة المتوهّجة التي تشعّ ألوانًا من النّور والحبّ، إنّها لوحة “الشّروق”، اللّوحة الخامسة والثلاثون من كتاب حدائق الألوان، الصّادر في العام 2017. هذه اللّوحة لم تكن مجرّد عمل فنّيّ عابر، بل بصمة من روح الأمّ، رسمتها بيدها في العام 2012، لتجسّد من خلالها شروق الشّمس، كأنّها زهرة من زهرات حدائق الحياة، تفتّحت من بين أصابعها، لتنثر الدفء والأمل على صفحات الزمن. في هذه اللّوحة، يتجلّى الشّروق لا كمشهد طبيعيّ فقط، بل كحالة وجدانيّة، كرمزٍ لبعث الحياة بعد العتمة، وكأنّها تكتب باللون ما تعجز الكلمات عن قوله.
أمّا صورة الغلاف الثانية، فهي صورة فوتوغرافيّة التُقطت للأمّ، السيّدة جاكلين الأشقر لبُّس، في حديقة النحّات الفرنسيّ الشهير أوغست رودان (Rodin) في بلدة ميدون (Meudon) الفرنسيّة، وذلك في العام 2008. تظهر الأمّ جالسة بوقارٍ هادئٍ، متّشحة بأناقة ناعمة، ونظرةٍ ثاقبة تُشبه تأمّلات النّحّات في منحوتاته الخالدة. في ملامحها ينعكس حضور عميق، وابتسامة بيضاء كقلب طفلة، تتّقد بنقاءٍ وطمأنينة، وكأنّها تقول الكثير بصمتها، وتهمس بما لا يُقال. وهكذا، فإنّ شمس الغلاف الأوّل ما هي إلّا طيف هذه الأمّ، تجلّيها النورانيّ، إشراقتها التي لا تغيب، وهي – في بُعدَيها الفنيّ والرّوحيّ – امتداد لصورتها الحيّة في الغلاف الثاني. الغلاف الأوّل مرآة للرّوح، والغلاف الثاني مرآة للجسد الحيّ الذي جسّد تلك الروح. الأوّل إشراق، والثاني حضور، الأوّل رمزٌ، والثّاني حقيقة، وبينهما يتجلّى المعنى الخفيّ الذي يجمع الحضور والغياب، الضوء والظلّ، الفنّ والحنين. وهكذا، يتحوّل الغلاف الثاني إلى مفتاح سرّ الغلاف الأوّل، وإلى المعنى الذي يُبرّر الشّعاع، إلى الجذر الذي أنبت الزهرة، وإلى الأمّ التي ما زالت، رغم الغياب، تُضيء الحياة بألوانها.
ثالثًا: في الألوان – وما بينها من ضوء وحنين
تُعَدُّ الألوان من الظواهر الطبيعيّة الّتي اكتسبت مع الأيّام دلالاتٍ ثقافيّة وفنّيّة ونفسيّة واجتماعيّة، يعبّر بواسطتها الفنّان عن انفعالاته وقيمه، وجعلها رموزًا متنوعةً تنوُّعَ آلامه وآماله: الحياة والموت، الأمل والخيبة، الحزن والفرح، النّور والظّلام (عبد الغني، ٢٠١٣، ص ٩- ١٠)؛ فالألوان، في يد الفنّان، لا تكتفي بأن تكون انعكاسًا للطبيعة، بل تتحوّل إلى لغةٍ صامتة، تُفصح عن الحياة والموت، عن الأمل والخيبة، عن الحزن والفرح، عن النور والظلام. هي مفاتيح سرّيّة لقراءة الحالات الوجدانيّة التي لا تُقال، تُعبّر عن كلّ ما يتجاوز قدرة الكلمات على البوح. وتختلف هذه الدلالات بحسب السياق الثقافيّ والزمنيّ، فتكتسب الألوانُ أدوارًا ومعانيَ تتعدّد بتعدّد نظرات الإنسان إلى العالم.
وهكذا، فإنّ اللون في العمل الفنّيّ لا يُقاس بجماليّته البصريّة فقط، بل بثقله الرمزيّ ودوره في بناء الرسالة الفنّيّة. وبذلك يصبح اللونُ شاهدًا على الداخل، مرآةً للمكنون، وجسرًا بين الفنّان والمتلقّي، يتبادلان عبره المشاعر والإيحاءات بلغةٍ تتخطّى المنطق لتلامس الروح.
يقول المؤلّف في كتاب اليوميّات (ص23): «أحبّت أمّي الطبيعة، فرسمتها ولوّنتها… لونها المفضّل؟ كلّ الألوان! يشهد على ذلك أزياؤها ولوحاتها». وبالنّظر إلى ألوان هذه الّلوحة المشرقة، واستنطاق دلالاتها، نرى عنوان الكتاب “يوميّات أمّي” كُتب بلون الذّهب، ذهب الشّمس الذي يمزّق الظلام، ليشعّ نورًا في السّماء الحالكة، فاليوميّات هو هذا الوهج الأصفر الّلامع الذي بدّد ظلمة السّماء، كما بدّد عتمة الّليالي، فكانت الأمّ في حياتها ومماتها الضّوء في حياة الكاتب، والأصفر هذا، هو الأكثر دفئًا، الأكثر بوحًا وتأجّجًا واتّقادًا بين الألوان، يصعب إخماده أو تخفّيه، يتجاوز الطّوق الّذي يتوخّى احتواءه. ولون نواة الشمس، هو الّلون الأبيض، كقلبِ نقيِّ ناصع البياض، لون الفجر والعبور، فهو كالسّكون المطلق يؤثّر في أرواحنا، هذا الصّمت ليس موتًا، إنّه يفيض بإمكاناتٍ حيّة، ويلفُّ الشّمس برعمًا أخضر، تفتّحت وروده البيض، كالياسمين العابق بألوان السّلام، ياسمين يفوح عطره في الأرجاء، يتراقص مع نور الشمس وظلالها. من نورها يكتسب لونه البهيّ، ومن دفئها يستمدّ حياته؛ فيمثّل شروقَ الشّمس هذه طيفُ الأمّ الذي يبعث النّور، ويكون الهداية في الأوقات المظلمة، إذ لا حياة للورود من دون الشمس، ولا معنى لحياة الأبناء من دون الأمّ. ما الشروق إذن إلّا صاحبة هذه اليوميّات، إنّه طيف الأمّ الحاضر الخالد، حتّى بعد الغياب. وبالأبيض أيضًا خُطّ اسم الكاتب، وهو ابنها البِكر “جوزف طانيوس لبُّس”، ليكون في منزلة قلبها، والّلون نفسه في النّقاط التّسع البيضاء أعلى الغلاف، فكأنّها نجوم لامعة، عددها لأمرٍ ما تسعة. كأنّ هذه اللوحة تنمّ عن روح الفنّانة، إذ رسمت حياتها العائليّة، فأطلّت علينا هذه الشمس بجمالها وبهائها، بعطائها ودورها، فالكلّ يستمدُ الحياة من وهجها، والأبناء ما هم إلّا فلذة من كبد هذه الأمّ النّقيّة، حبّات قلبها، فقدت بعضهم في حياتها، فأحيت حضورهم في سمائها، لتكون كالملاك الحارس. وهكذا أتت هذه الّلوحة نابضة بالحياة. وهيهات للأمّ أن ينطقئ حضورها في القلوب، وهيهات لهذا الإرث النابض بوهج الحياة والفنّ إلّا أن تدوم لحظاته وسكينته.
وتتداخل هنا الألوان لتشكّل أداة تبوح بالجمال، فيطغى على لوحة الشروق هذه الّلون الأحمر بدرجاته، ويُعَدّ الأحمربعامّةٍ الرّمز الأساس لمبدأ الحياة بقوّته وقدرته ولمعانه، فهو لون الدّم والنّار. والأحمر بتدرّجاته ينعكس في لوحة الغلاف: فالأحمر القاتم سرٌّ يمثّل غموض الحياة، وهو لون الرّوح والقلب، والمعرفة. والّلون البرتقاليّ، بين الذّهب السّماويّ، والأحمر الظلاميّ، يرمز إلى نقطة التّوازن في الروح (عبد الغني، 2013، ص129).
هذه هي جاكلين ماري أنطون الأشقر لبُّس (١٩٣٧- ٢٠٢٣) الأمّ الفنّانة التي خرجت من إطار التّاريخين، وانخرطت في زمن عابرٍ للتّاريخ (لبُّس، 2024، ص٦٤)، لتكون الملهمة لتدوين هذه اليوميّات، كتاب هو صفحات من حياة أمّ فنّانة بقلم ابنٍ فنّان. الفنّ دهشة وحيرة، والفنّان لا بدّ أن يكون رائعًا ونبيلًا لأنّ من يُعجب بالجمال، لن يفتقر إليه.
الخاتمة – الأمّ أفقُ لا يغيب
في يوميّات أمّي، لا نقرأ فقط سيرة أمّ، بل نواجه أثرًا إنسانيًا متجاوزًا، كتبه استاذنا الذي عاش التجربة بكلّ تفاصيلها: العطاء، المرض، الفقد، الذاكرة. من خلال هذه اليوميّات، تتحوّل جاكلين ماري أنطون الأشقر لبُّس الأمّ إلى مرآة للوجود: نقرأها فنّانة ترسم الحياة بصبر الأمومة، ونلمسها إنسانة تحفظ عائلتها بالحبّ، وتواجه المرض بكرامة وهدوء داخليّ يليق بالكبار. كلّ ما في النصّ يشهد على أنّ الفقد يُقاس بما يخلّفه الغياب من أثرٍ، ومن كتابةٍ تحاول أن تحتفظ بالحضور في وجه النسيان. لقد كتب جوزف لبُّس عن أمّه لا ليودّعها، بل ليُبقيها حيّة في الحروف، وفي الذاكرة، وفي القرّاء. حمل قلمَه كما تُحمل شمعة في العتمة، وسار في درب الكتابة لا ليوثّق الألم فحسب، بل ليُعيد تشكيل صورة الأمّ كما يراها: فاضلة، نبيلة، صلبة، فنّانة وإن كان لها معرضٌ يتيم (كاليري زمان للفنون – الحمرا، كانون الأوّل 2013)، قدّيسة وإن لم تُعلن. ليست هذه اليوميّات مجرّد تسجيل لحياةٍ عبرت، بل فعلٌ مقاوم للنسيان، وعمل وفاء نادر في زمن سريع التقلّب. وهي في الآن ذاته، دعوة مفتوحة إلى كلّ قارئ أن يرى في “جاكلين” شيئًا من أمّه، ومن ذاته، ومن المعنى الذي نبحث عنه حين نفقد مَن نحبّ. وهكذا، تختتم هذه الصفحات لا كمرثاة، بل كاحتفال هادئ بحياةٍ عميقة، وبأمّ لا تزال تُنير الدرب – لا من فوق المنبر، بل من بين السطور، وفي قلبٍ كتَبَ لئلّا تموت الأمّ مرّتين.
المصادر والمراجع
– الأشقر لبُّس، جاكلين (٢٠١٧). حدائق الألوان. بيروت: دار أوراق الزّمن.
– البغدادي، عبد المجيد (٢٠١٦). “فنّ السيرة الذاتيّة وأنواعها في الأدب العربيّ”. مجلّة القسم العربيّ (23)، 206.
– بنكراد، سعيد (2012). السّيميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها (ط3). الّلاذقيّة: دار الحوارللنّشر والتّوزيع.
– عبد الغني، خالد محمّد (2015). سيكولوجيّة الألوان. عمّان: مؤسّسة الورّاق للنّشر والتّوزيع.
– لبُّس، جوزف (2009). الحبّ والموت من منظور السّيرة الذّاتيّة بين مصر ولبنان. بيروت: دار المشرق.
– ______(2024). يوميّات أمّي. بيروت: الدّار العربيّة للعلوم ناشرون.
– المناصرة، حسين (٢٠١٥). القصّة القصيرة جدًّا: رؤى وجماليّات. إربد: عالم الكتب الحديث للنشر والتّوزيع.
[1] جوزف طانيوس لبُّس: كاتب وباحث وأُستاذ محاضر في الجامعة اللّبنانيّة وجامعة القدّيس يوسف. حائز على دكتوراه في اللغة العربيّة وآدابها من الجامعة اللّبنانيّة. له مؤلّفات في الجماليّة، وأدب الرّحلة، وأدب السّيرة، وتاريخ الأديان.
[2] مريم محمود سرور: أُستاذة لغة عربيّة، حائزة على ماستر في اللغة العربيّة وآدابها من الجامعة اللّبنانيّة.