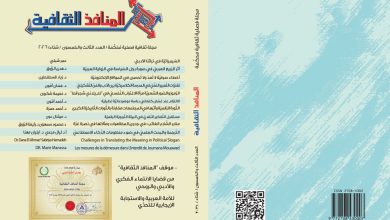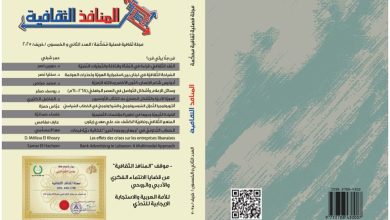أدونيس شاعر الإنسان: اللّون الأخضر ودلالته الرّمزيّة
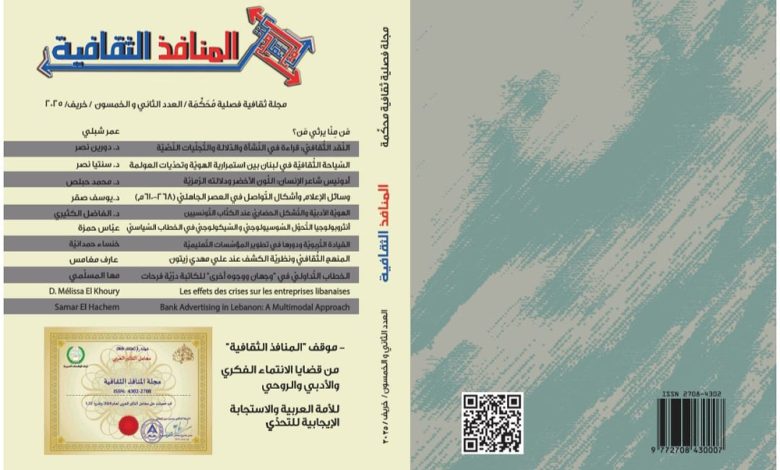
أدونيس شاعر الإنسان: اللّون الأخضر ودلالته الرّمزيّة
Adonis as the Poet of Humanity: The Symbolic Connotations of the Color Green
د. محمّد حبلص[1]
Dr. Mohammad Hoblos
تاريخ الاستلام 1/ 7/ 2025 تاريخ القبول 30/ 7/2025
الملخّص
يتناول هذا البحث رمزيّة اللّون الأخضر في شعر أدونيس، بوصفها مكوِّنًا جماليًّا وفكريًّا يعبّر عن رؤية حضاريّة شاملة. وقد انطلق من فرضيّة أنّ اللون الأخضر لا يُستخدم في الشّعر العربيّ الحديث لغايات تزيينيّة فحسب، بل يُستثمر بوصفه رمزًا مركّبًا يدلّ على الحياة والبعث والتّجدّد، ويشكّل مفتاحًا تأويليًّا لفهم البُنى العميقة في التّجربة الشّعريّة.
سعى البحث أوّلًا إلى تتبّع الجذور الثّقافيّة لهذا اللّون، مُبرزًا طاقته الإيحائيّة في التّراث الإنساني. ثمّ انتقل إلى دراسة تجليّات اللّون الأخضر في شعر أدونيس، متّخذًا من المنهج الموضوعاتيّ البنيويّ أداة لتحليل السّياقات النّصيّة واستكشاف المعاني الرّمزيّة في علاقتها بالشّكل والمضمون.
وقد أظهر التّحليل أنّ اللّون الأخضر يتجاوز في شعر أدونيس الوظيفة الوصفيّة أو الانفعاليّة، ليغدو حاملًا لرؤية وجوديّة، تعبّر عن توق الشّاعر إلى خلاصٍ ثقافيّ ولغويّ. فاللّغة في نصوصه تنبعث عبر هذا اللّون من رماد الجمود إلى آفاق التجدّد، وتتحوّل إلى كائن حيّ ينفتح على المستقبل والتّغيير.
بذلك، يُبرهن البحث على أنّ اللون الأخضر في التّجربة الأدونيسيّة جوهر فلسفيّ يستبطن علاقة الإنسان بالعالم، ووسيلة لمقاومة العقم الرّوحيّ والثّقافي، ورمزٌ للبديل الممكن في واقع مأزوم.
الكلمات المفتاحيّة: اللّون الأخضر – أدونيس – البعث – الرّمز – الرّمزيّة – الحداثة
Abstract
This study explores the symbolism of the color green in the poetry of Adonis, considering it an aesthetic and intellectual component that expresses a comprehensive cultural vision. It is based on the premise that the color green is not used in modern Arabic poetry merely for decorative purposes, but rather as a complex symbol that signifies life, rebirth, and renewal, serving as an interpretive key to understanding the deeper structures of the poetic experience.
The research first traces the cultural roots of this color, highlighting its suggestive power within human heritage. It then examines the manifestations of the color green in Adonis’s poetry, employing the thematic-structural approach as a tool to analyze textual contexts and explore symbolic meanings in relation to both form and content.
The analysis reveals that the color green in Adonis’s poetry goes beyond descriptive or emotional functions to become a bearer of an existential vision, reflecting the poet’s yearning for cultural and linguistic redemption. In his texts, language is revived through this color—from the ashes of stagnation to horizons of renewal—transforming into a living entity that opens toward the future and change.
Thus, the study demonstrates that the color green in Adonis’s poetic experience represents a philosophical essence that encapsulates the human relationship with the world. It serves as a means of resisting spiritual and cultural sterility, and as a symbol of a possible alternative in a crisis-ridden reality.
Keywords: Green Color – Adonis – Resurrection – Symbol – Symbolism – Modernity.
المقدّمة
تحتلّ الرّمزيّة مساحة واسعة في شعرنا العربيّ الحديث، فهي كانت في منتصف القرن العشرين، وما زالت إلى يومنا هذا نهجًا شعريًّا ثابتًا يتّبعه شعراء كثيرون، قد وجدوا في الرّمزيّة ما يعينهم على وصف قضايا الأمّة العربيّة خاصّة وقضايا الإنسان عامّة، وجدوا في الرمزيّة القوّة التي تمنحهم اللّغة الجديدة والتّعبير الذي يستطيع مواكبة أحداث العصر والاتّصال بالحياة، وجدوا فيها ما يجعلهم، في التّعبير الشّعريّ، يبتعدون عن المألوف والمبتذل، وقد استخدم الشّعراء العرب المحدثون أنواعًا كثيرة من الرّموز في كتاباتهم الشّعريّة، استخدموا الرّموز الواقعيّة، التّاريخية والجديدة، وكذلك الرّموز الأسطوريّة. ومن بين الرّموز التي حازت على حضور لافت في التّجربة الشّعريّة المعاصرة، رمز اللّون، بما يحمله من شحنة دلاليّة تُستثمر في تصوير الانفعالات والأفكار والرّؤى.
ويحتلّ اللّون الأخضر مكانة خاصّة في هذا السّياق، إذ يتجاوز وظيفته التّزيينيّة إلى بعد رمزيّ عميق يمسّ الوجود والحياة والموت والتّجدّد والطّبيعة والمقدّس، وقد انشغل به عدد من الشّعراء العرب، فحوّلوه إلى أداة تفكير شعريّ، لا مجرّد عنصر جماليّ. ويأتي الشّاعر أدونيس في طليعة هؤلاء، إذ يستثمر اللّون الأخضر بوصفه بنية رمزيّة مركّبة، تتعدّد معانيها وتتقاطع مع رؤاه الكونيّة والفكريّة. لذلك فإنّنا في هذا البحث لن ندرس رمزيّة اللّون الأخضر دراسة دلاليّة مضمونيّة وحسب، بل سندرسها دراسة سياقيّة أيضًا، لكي نظهر القوةّ الإبداعيّة لدى الشّعراء العرب من خلال أدونيس.
من هنا، تتجلّى أهمّيّة هذا البحث في كونه يحاول تفكيك حضور اللّون الأخضر في شعر أدونيس، بوصفه مفتاحًا تأويليًّا لقراءة البُنى العميقة في تجربته، والولوج إلى تمثّلاته للكون والطّبيعة والذّات والآخر. فاللّون الأخضر لا يظهر عرضًا في نصوصه، بل هو علامة مشحونة بمدلولات حضاريّة وروحيّة وفلسفيّة، تحتاج إلى قراءة تتجاوز الظّاهر اللّغويّ إلى الباطن الرّمزيّ.
وينبثق من هذا الطّرح الإشكاليّة المحوريّة للبحث: كيف تتجلّى رمزيّة اللّون الأخضر في شعر أدونيس؟ وما الدّلالات التي يكتسبها هذا اللّون في سياقات مختلفة من تجربته الشّعريّة؟ وهل تؤدّي هذه الرّمزيّة وظيفة جماليّة فقط، أم تتعدّاها إلى أبعاد فكريّة ووجوديّة؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية، اعتمدنا المنهج الموضوعاتي البنيوي، بوصفه منهجًا يُعنى بالكشف عن التّيمات المركزيّة في النّصوص الشّعريّة، وتتبّع بنيتها الدّاخليّة، ورصد كيفيّة تشكّل المعنى عبر العلاقة بين الرّمز والسّياق وبين الشّكل والمضمون. ويتيح هذا المنهج فهم اللّون الأخضر لا كمفردة معزولة، بل كبنية دلاليّة متشابكة تُسهم في بناء العالم الرّمزيّ والوجوديّ لدى أدونيس.
أوّلًا- رمزيّة اللّون الأخضر في الشّعر العربيّ الحديث
لا جرَم أنَّ رمزيّة اللّون الأخضر في الشّعر العربيّ الحديث، هي رمزيّة متنوّعة الدّلالات، متعدّدة الوظائف، مكثَّفة المعاني، وتؤدّي وظائفها في موضوعات كثيرة تتّصل بحياتنا وقضايانا، وقد لجأ إليها الشّعراء العرب المحدثون؛ ليعبّروا عن أفكارهم التي ترفض العُقم والجدب، وتؤمن بالحياة الخضراء التي تعني النّماء والتّجدّد والحيويّة والاستمرار.
لجأ الشّعراء العرب المحدثون إلى رمزيّة اللّون الأخضر؛ لأنّها تجعلهم يخرجون، بواسطة الكلمة الشّعريّة، من واقعهم السّياسيّ والاجتماعيّ الذي اعتراه اليُبْس؛ تجعلهم يعبّرون عن حلمهم بمجيء الزّمن الأخضر الذي تخضرّ فيه العروبة في مجالات الحياة كافّة؛ فالكلمة “هي وجود وحضور له كيان وجسم، وهي قطعة من الوجود أو وجه من وجوه التّجربة الإنسانيّة، ومن ثمّ فإنّ لكلّ كلمة طعمًا ومذاقًا خاصًّا”([2]).
ورمزيّة اللّون الأخضر تعبّر عن تفاؤل الشّعراء وإيمانهم القويّ بحتميّة اخضرار الحضارة، والعلم، والثّقافة في دنيا العرب، بعد زمن من الاصفرار والذّبول طال أمده. فكما اخضرار الشّجرة يشير إلى ثمرها وعطائها المتجدِّد، كذلك الاخضرار في القضايا الأخرى يحمل هذه المعاني؛ فاخضرار العلم يعني الانتشار والتّوسّع في ميادين متنوّعة، يعني التّقدّم المستمرّ في الاكتشاف والاختراع، ثمّ إنّ اخضرار الثّقافة يعني الزّيادة المستمرّة من الكتابة الإبداعيّة في الفكر والفلسفة والأدب.
إنّ الرمز، حتّى يحمل دلالات متنوّعة، لا بدّ أن يندرج في سياق شعريّ رمزيّ جديد، أمّا إذا اندرج في سياق تقليديّ، فلا يحمل حينئذ سوى معناه، فإذا وصف الشّاعر عيونًا خضرًا، أو جنّة خضراء بلغة تقليديّة مباشرة، فإنّ اللّون الأخضر يأتي في السّياق حاملًا معناه المباشر، مجرّدًا من أيّة دلالة رمزيّة، ويأتي الوصف تقليديًّا وعاديًّا يبيّن أنّ العيون لونها أخضر، وكذلك الجنّة من دون أن يحمل أيّة إشارات رمزيّة، أمّا إذا استخدم الشّاعر اللّون الأخضر واصفًا العيون والجنّة في سياق لغويّ جديد، فحينئذ يحمل اللّون الأخضر إشارات ودلالات رمزيّة، فيرمز إلى الخصبِ والنّماء والحياة، فتصبح العيون الخضر لدى المرأة التي يعشقها الشّاعر رمزًا إشاريًّا إلى الحياة والخصوبة. فالمرأة ذات العيون الخضراء هي خضراء ذات خصوبة بالحمل والإنجاب، وهي بعينيها الخضراوين ترمز إلى اخضرار حياة الشّاعر، ترمز إلى اخضرار كلماته وشعره وتجدّد عطائه ونتاجه، وتصبح الجنّة الخضراء رمزًا إشاريًّا إلى الخصب والنّماء في الأرض والمواسم ما يجعل الشّاعر مطمئنًّا في حياته على المستوى الفرديّ والوطنيّ والقوميّ والإنسانيّ. فاخضرار الجنّة يعني استمرار حياة الشّاعر والوطن والأمّة والإنسان عامّة؛ إذ إنّ الجنّة الخضراء تعطي الإنسان المواسم والثّمار، تعطيه مادّة الحياة والغذاء والاستمرار، وتجعله متفائلًا ذا أمل، لا يعرف اليأس ولا يخاف المستقبل، تجعله يشعر بأنّ الوجود كلّه ينبض حيًّا في قلبه، وروحه، وكلّ خليّة من خلايا جسده.
هكذا يتبيّن لنا الفرق الشّاسع بين معنى اللّون الأخضر في السّياق التّقليديّ ومعناه في السّياق الحديث، ويتبيّن لنا أنّ الكلمات، رموزًا كانت أو مفردات عاديّة، تستمدّ طاقتها الشّعريّة والإشاريّة من خلال اتّحادها وتواؤمها في سياقاتها النّصيّة والإبداعيّة. فطاقة الرّمز الشّعريّة والإشاريّة ليست موجودة فيه منفردًا، بل هي موجودةٌ فيه مندرجًا في سياقه النّصيّ الإبداعيّ، وما ينطبق على الرّمز ينطبق على الكلمة.
ثانيًا- رمزيّة اللّون الأخضر عند أدونيس
يعدّ أدونيس الشّاعر رائدًا بارزًا من روّاد الحداثة الشّعريّة، ومن الذين أسهموا إسهامًا كبيرًا في تفعيل حركتها، ومن الذين استخدموا الرّمز الشّعريّ- بنوعيه الواقعيّ والأسطوريّ- استخدامًا متنوّعًا، وفي موضوعات كثيرة، بغية الوصول إلى غايات شتّى.
- اللّون الأخضر درب الحياة والانبعاث
ومن بين الرموز التي استخدمها: اللّون الأخضر الذي رمز في شعره إلى الحياة والانبعاث؛ لأنّ هذا اللّون هو في حقيقته نقيض العقم والجدب ونقيض الموت، وأدونيس هو شاعرٌ بعثيّ في تعبيره الشّعريّ، وأعني بهذه العبارة أنّه يؤمن بفكرة البعث ويعبّر عنها، ويدعو إلى تحقيقها علميًّا وحضاريًّا ولغويًّا وإنسانيًّا، ولهذا شُغف باللّون الأخضر واتّخذه رمزًا للتّعبير عن فكرة البعث في قصائد كثيرة.
إنّه يرمز عنده إلى الأمل والتّفاؤل، يرمز إلى التّغلّب على قوّة الجدب والبوار والموت؛ فاللّون الأخضر يعطي أدونيس الثّقة القويّة بالذّات، يعطيه العزم الشّديد، ويجعله يمشي على درب الحياة متفائلًا ومؤمنًا بحتميّة النّصر على الجراح والألم؛ يقول: “أنا دربي خضراء لوّنها قلبي وغطّى جراحها تقبيلي”([3]).
إنّ اللّون الأخضر في هذا البيت الشّعريّ يرمز -كما أشرنا سابقًا- إلى التّفاؤل، يرمز إلى الخطوة الواثقة إلى الحياة الخضراء الزّاهية التي يمشي الشّاعر على دربها.
الدّرب الخضراء هنا ليست كأيّ درب أخرى من حيث الدّلالة الرّمزيّة، فهي تعني المسيرة المنتجة والمبدعة، مسيرة العطاء والعلم والنّجاح، مسيرة التّجدّد والتّطوّر؛ أمّا الدرب السّوداء، فهي تعني الجهل وفقدان الرّؤية، تعني الضّياع والقلق على المصير في قلب المسيرة، وبهذه المقابلة بين الدّرب الخضراء والدّرب السّوداء تتجلّى لنا الوظيفة الرّمزيّة التي أدّاها اللّون الأخضر في الشّاهد السّابق، فهي وظيفةٌ مكّنت الشّاعر من التّعبير عن تفاؤله بالمستقبل الذي يمشي إليه، فهو- لا ريب- مستقبلٌ أخضر زاهٍ، مستقبلٌ متجدّد ومتطوّر، مستقبلٌ حافلٌ بالإنتاج والعطاء؛ لأنّ الدرب التي تُفضي إليه هي دربٌ خضراء.
إنّ الدّرب الخضراء توصل من يمشيها إلى الغايات الخضر إلى المواسم والغلال، والدّرب السّوداء توصل من يمشيها إلى الفشل؛ لأنّ الرؤية تنعدم عليها، إنّها توصل إلى حيث الجهل والتّخلّف والضّياع والرّدى، فأدونيس حين أضفى على دربه صفة الاخضرار: “أنا دربي خضراء”، أراد أن يعبّر عن تفاؤله بمسيرته، وعن ثقته بخطوته التي يخطوها في سعيه إلى غاياته.
وكذلك أراد أن يُشير إلى ارتياحه وانبساط نفسه وسروره، فإذا كانت الدّرب خضراء، فإنّها حتمًا ستوصل من يمشيها إلى المواسم والغلال إلى الحصاد والجنى. فالاخضرار يعني الحياة والنّماء، يعني البراعم والتّفتّح؛ ولهذا السّبب المهم وجد الشّاعر نفسه في سرور وطمأنينة، وهو يمشي على الدّرب الخضراء، صار من دون أحزان ولا آلام: “وغطّى جراحها تقبيلي”.
كانت درب أدونيس من قبل مليئةً بالجراح التي تشير في هذه العبارة الشّعريّة إلى الصّعاب والعثرات والعذاب والألم، كانت دربًا مزروعةً شوكًا لكنّ قلبهُ المتفائل المليء حبًّا وخيرًا، قلبهُ الأخضر النّابض بالحياة والأمل جعلها خضراء، إذ أضفى عليها خضرته ولوّنها بلونه: “أنا دربي خضراءُ لوّنها قلبي وغطّى جراحها تقبيلي”([4]). فالقلب في هذا الشّاهد الشّعريّ الأدونيسيّ يملك قدرة بعثيّة، يملك قوّة الإخصاب، فهو كعشتار التي “تقوم بواجب آلهة الحبّ والخصب والرّفاهية والازدهار”([5]).
هو قلبٌ مفعمٌ حياةً وطموحًا، وليس غريبًا أن يمتاز بهذه المزايا، ويملك هذه القدرات؛ لأنه قلب شاعر استثنائيّ بعثيّ يؤمن بفكرة البعث، ويطلب تحقيقها في أفعال النّاس؛ وذلك “حينما غدت الرّؤيا الشّعريّة قفزة خارج المفهومات السّائدة”([6])، فأدونيس صحيح أنّه لم يستطع أن يحقّق هذه الفكرة في الحياة والمجتمع، بيد أنّه حقّقها في اللّغة والشّعر؛ والشاعر الذي يبعث اللّغة من موتها وحطامها، ويبث في الشّعر روح الحياة والتّجدّد والحداثة، هو شاعرٌ يملك قلبًا استثنائيًّا قادرًا على إخصاب الدّرب وجعلها خضراء.
- القلب الخصيب: مصدر الرّمزيّة والاخضرار في التّجربة الأدونيسيّة
إنّ قلب أدونيس، في البيت الشّعريّ السّابق، يبدو نبع الحياة ومصدر الاخضرار والإخصاب، إذ استطاع أن يلوّن درب صاحبه باللّون الأخضر، ويجعلها دربًا حيّةً بعد أن اعتراها العقم والجدب؛ فهي كانت من قبلُ درب الموت، فصارت بقوّة الإخصاب الكامنة في القلب الأخضر، (قلب الشاعر)، درب الحياة، صارت درب السّعادة والأمل بعد أن كانت درب الجراح والألم واليأس.
وفي سياق هذا التحليل الأدبيّ، تتبيّن لنا الوظيفة الرّمزيّة التي يؤدّيها اللّون الأخضر في التّعبير الشّعريّ الأدونيسيّ، فهي وظيفة إبداعيّة إخصابيّة قد أخصبت اللّغة الأدونيسيّة في البدء، ثمّ رمزت إلى إخصاب الدّرب وإخصاب مسيرة الشّاعر، وهذه القدرة الوظيفيّة الكامنة في اللّون الأخضر هي قدرة خارقة؛ لأنّها نابعة من القلب الذي يُعدّ السّبب المباشر لحياة الإنسان، فإذا مات القلب مات الإنسان.
الدّرب الخضراء، في البيت الشّعريّ السّابق، لم تكتسب اخضرارها من خيال الشاعر ومن إبداعه، بل اكتسبته من قلبه، وهنا نجد إشارة من أدونيس إلى أنّ الذي يريد أن يمشي دربه إلى أهدافه البعيدة والعظيمة من دون قلب يزوّده بالإيمان والثّقة والصّبر ينكفئ في بداية المسيرة؛ لأن الذي يسير ولديه قلب قانطٌ ومَيْتٌ، تموت لديه الإرادة، وتغدو الدّرب أمامه سوداء مزروعة بالأشواك والجراح.
إنّ قلب أدونيس ليس آلة تضخّ الدّمّ في شرايينه وحسب، بل هو طاقة فاعلة تمنحه الأمل والطّموح، وتحثّه على المضيّ إلى الحياة الكريمة، هو طاقة فاعلة خلّاقة تلوّن دربه باللّون الأخضر لون التّفاؤل والنّماء، مبشّرةً إيّاه بالمستقبل الأخضر المليء بالمواسم والثّمار بعد مسيرة جهاديّة طويلة على الدّرب الخضراء، درب الحياة؛ والدرب -هنا- لا تعبّر عن مسيرة الشّاعر الذّاتيّة وحسب، وإنّما تعبّر عن مسيرة الإنسان، هي تبشّرنا بمستقبل زاهر سوف تصل إليه الآدميّة جمعاء بعد حياة العقم والجدب التي لم تنتج سوى الحروب والقتل والخراب، تبشرّنا بالإنتاج العلميّ والازدهار الحضاريّ؛ ولهذا تُعدّ الصّورة الشّعريّة في هذا الشّاهد الأدونيسيّ حصرًا صورة تكمن فيها روح الحداثة؛ إذ لا تنحصر في إطار زمنيّ أو مكانيّ، بل هي مفتوحة على الزّمن والمكان معًا، وتعبّر عن تفاؤل الإنسان بالمستقبل أينما وُجد في أيّ زمن وعلى أيّة أرض.
الحداثة توجب على القصيدة ألّا ترتبط بصاحبها ارتباطًا ذاتيًّا؛ لأنّها تموت بموته، هي ترتبط بصاحبها فقط إذا كان يمثّل الإنسان معاناةً وتجربةً وشعورًا وألمًا، حينئذٍ تُكتب لها الحياة المستمرّة، فتخلّد في ذاكرة الأجيال المتعاقبة.
الحداثة توجب على القصيدة أيضًا ألّا ترتبط بزمن معيّن؛ لأنّها تموت بانقضائه؛ فإذا ارتبطت بزمن تتجرّد من روح الشّعر والإبداع، وتصير نصًّا يؤرّخ حقبةً وينفصل عن المستقبل، وتنقطع علاقته بحركة الزّمن الجديد؛ ولهذا رأينا أنّ الدّرب الخضراء في الشّاهد الشّعريّ الأدونيسيّ السّابق صورةٌ شعريّة تنبض فيها روح الحداثة وروح الإبداع؛ لأنّها ترمز إلى التّفاؤل والأمل، إلى الخصب والنّماء، إلى التّجدّد والحياة في أيّ زمن أو أيّ مكان؛ لأنّها تبشر الشّاعر خاصّة والإنسان عامّة بخصوبة الأيّام الآتية التي ستكون أيامًا مزهرة ومثمرة وغنيّة بالمواسم والغلال.
اخضرار الدّرب في العبارة السّابقة، هو اخضرارٌ في حركة الإنسان الحضاريّة، اخضرارٌ في سعيه وعمله وكفاحه، اخضرارٌ في مسيرته العلميّة والأدبيّة، اخضرار الدّرب هو اخضرار الكلمة الشّعرية؛ لأنّ الدّرب الخضراء هي درب الشّاعر: “أنا دربي خضراء لونها قلبي وغطّى جراحها تقبيلي”([7])؛ فالشّاعر الذي تكون دربه خضراء لا بدّ من أن تكون كلمته خضراء أيضًا، لا بدّ أن يكون لديه التّعبير الشّعريّ الأخضر الذي تُنتجه خصوبة اللّغة وخصوبة الخيال؛ إنّ الدّرب الخضراء هنا تأخذ دلالاتها من صاحبها الذي يمشي عليها، وهو الشّاعر، فلو كان من يمشي عليها فلاّحًا لكانت انتفت دلالتها الرّمزيّة، وصار اخضرارها تقليديًّا مألوفًا، يعني اخضرار الأرض والزّرع، يعني الحصاد الحقيقيّ والثّمار الحقيقيّة، فالعلاقة بين الأرض الخضراء والشّاعر لها دلالاتها الرّمزيّة، ولها وظيفة شعريّة واحدة في سياق النصّ؛ فالاخضرار في درب الشّاعر يعني الاخضرار في كلماته وقصائده.
وهكذا يحمل اللّون الأخضر في الدّرب الخضراء معاني خفيّة لا يمكن إدراكها إلّا بواسطة الفهم العميق للّغة الرّمزيّة الجديدة التي تُبنى عند الشّعراء المحدثين على أساس التّلميح والتّرميز؛ فالقارئ إذا أراد أن يفهم القصيدة الحديثة عليه ألّا يكتفي بأن يفهم الكلمات وحسب، بل عليه أن يفهم اللّغة فهمًا كليًّا، وهي تُؤدّى في عباراتها؛ ولهذا نجد الدّرب الخضراء في سياقها اللّغوي تجاوزت رمزيّتها ضمن حدودها، تجاوزت رمزيّتها الكامنة في لفظها وصارت على علاقة رمزيّة مع الشّاعر.
ج- الاخضرار الوجدانيّ والدّعوة إلى حبّ شموليّ
ننتقل إلى شاهد شعري جديد يبدو فيه حبّ أدونيس حبًّا شاملًا مشعًّا، حبًّا يهدي النّاس الحيارى كالمنارة الخضراء؛ يقول: “أنابيب الضوء الذي لا يُضاء: قلقي شعلة على جبل التّيه وحبّي منارةٌ خضراء”([8]).
رمزيّة اللّون الأخضر، في هذه العبارة، ترمز إلى الاخضرار العاطفيّ الوجدانيّ، إلى اخضرار الشّعور الإنسانيّ عند أدونيس، أمّا في الدّرب الخضراء فيرمز اللّون الأخضر إلى اخضرار الأمل والكلمات، وبالمقارنة بين الدّرب الخضراء والمنارة الخضراء عند أدونيس يتبيّن لنا الفرق بين الوظيفتين الرّمزيّتين اللّتين أدّاهما اللّون الأخضر في العبارتين؛ ففي العبارة الثّانية يبدو حبُّ أدونيس مفتوحًا على العالم لا تحدّه حدود، حبًّا يرفض أن يكون له وطنٌ أو قوميّة أو انتماء سوى الإنسان، حبًّا نوارنيًّا مسخّرًا لخدمة الحياة، هو يشبه المنارة الخضراء التي ترسل نورها الأخضر عبر الأفق والمدى المطلق، فتبدّد الظّلمات التي تمنع الضّائعين الحائرين من الهداية والرّؤية.
حبُّ أدونيس وفق هذا التّحليل حبٌّ مجّانيّ مجرّد من أيّة غاية، هو النّور الذي يصل إلى النّاس كافّة من دون أن تمنع وصوله حدود وحواجز، هو حبّ غايته الوحيدة أن يهدي الإنسان المتخبّط في مستنقعات الجهل والأحقاد والحروب سبل الخير والرّشاد، غايته جمع أبناء الآدميّة على النّور والهداية بعد أن فرّقهم الظّلام والضّلال.
وهكذا تبدو لنا هنا رمزيّة اللّون الأخضر رمزيّة تحمل معاني السّلام والحبّ والإخاء بين النّاس كافّة؛ فأدونيس في عبارته الشّعريّة السّابقة يدعو إلى الإخاء الإنسانيّ، هو يؤمن بأنّ كلّ الأمم والشّعوب هم إخوة في الأصل الآدميّ؛ ولهذا سخّر حبّه لهم جميعًا، سخّره لأجل جمعهم وتلاقيهم على الحبّ والأخوّة… إنّه لا يكره أحدًا، بل لا يعرف معنى الكره والعداء، من قلبه يتدفّق الحبُّ عميمًا، ينتشر في المدى المطلق كما ينتشر النّور من المنارة الخضراء؛ يقول: “وحبّي منارةٌ خضراء.
والنّور الأخضر، في هذه العبارة الشّعرية يرمز إلى الحبّ العميم المبثوث عبر المدى، إلى الحبّ الذي ينير درب الإنسان السّائر في ظلمات الجهل ومتاهات الصّراع العرقيّ والدّينيّ ولا يعرف إلى النّجاة سبيلًا، فمنارة الحبّ وحدها تمحو ظلمات الجهل وتجمع الناس كافّة على الإخاء بنورها العميم، وحدها تنشر نور الحبّ عبر المدى، فتبدّد البغضاء وتزيل أسباب العداء والصّراع. ومنارة الحبّ عند أدونيس هي الحلم والغاية في عصر يغشاه ليل العبوديّة والاستبداد والطّغيان، فهو يرى أنّ الشرّ لا يُقاوَم بالشّرّ، بل يُقاوَم بالخير، وكذلك الكره والحقد يقاومان بالحبّ فالشّرّ يصبح أكثر انتشارًا وأشدّ خطرًا إذا قاومناه بشرّ مثله، وكذلك مقاومة الحقد بالحقد تشعل الحروب وتدمّر الحياة؛ لهذا اختار أدونيس الوسيلة الفضلى النّاجعة لمقاومة الشّرّ والحقد المنتشرين بين النّاس، اختار الحبّ الذي يبني صرح السّلام، والمجتمع الإنساني البريء من علّة التقاتل والتّشرذم، اختار الحبّ الأخضر سلاحًا لمقاومة الشّرّ والحقد من أجل التّأسيس لمستقبل أخضر ينعم فيه النّاس بالازدهار والرّفاه والطّمأنينة والسّلام؛ فسلاح الحبّ عند أدونيس صونٌ للحياة وضمان للمستقبل، أمّا سلاح الشّرّ فيدمّر الحياة ويقتل كلّ أمل بالمستقبل. فالإنسان لا يمكنه أن يستمرّ في درب الرّقيّ والتّقدّم والحضارة إلّا بالحبّ؛ وهذا هو أسلوب أدونيس الشّعريّ بوصفه شاعرًا حداثيًّا رائدًا، هو أسلوبٌ تماهى مع معاني الفنّ والجمال والحبّ؛ لأنّ “الأسلوب هو النّصّ ذاته”[9].
وانطلاقًا من هذه المعاني الوجدانيّة الصّافية السّامية، نفهم لماذا جعل أدونيس حبّه منارة خضراء، فقد أراد أن يكون الحبّ منتشرًا بين النّاس كافّة، يجمعهم على الأخوّة، ويهديهم سبل الرّشاد والعلم. إنّ الشّاعر يبدو في الأبعاد الخفيّة الكامنة في الشّاهد الشّعريّ السّابق ساخطًا على الحياة الرّديئة التي يحياها النّاس في التّباغض والتقاتل، فاعتمد سلاح الحبّ كونه الوسيلة الوحيدة التي يدافع بها عن القيم الإنسانيّة والحضاريّة، قيم النّبل والأخوّة، قيم الحياة العظيمة.
الحبّ عند أدونيس هو الذي يشفي الإنسان من داء التّباغض والجشع، هو الدواء الفعّال النّاجع للعلل الاجتماعيّة والسّياسيّة التي تعرقل مسيرة الإنسان الحضاريّة في الحياة، من دون الحبّ لا يمكن أن تُبنى صروح الأخوّة والفكر والحضارة، وقد أدرك الشّاعر هذه القوّة الهائلة في الحبّ فأراد توظيفه في خدمة الإنسان والحياة فجعله حبًّا شموليًّا يعمّ الآدميّة جمعاء، إذ شبّهه بالمنارة الخضراء: “وحبّي منارةٌ خضراء”.
ونلاحظ هنا أنّ الدلالة الرّمزية الكامنة في اللّون الأخضر لا تنفصل عن السّياق النّصّيّ الذي وردت فيه، بل هي نتيجة بديهيّة لاتّحاد كلمة (الخضراء) مع الكلمات التي تجاورها؛ فصفة الاخضرار أعطت المنارة في السّياق النّصّيّ معنى الحياة والتّجدّد والخصوبة، فصار نورها الأخضر يحمل معنىً رمزيًّا جديدًا، إذ لم يعد يحمل معنى الهداية وحسب، بل صار يحمل معنى البشارة إلى الإنسان، معنى البشارة بالحياة الخضراء والمستقبل الأخضر. والنور بلونه الأصفر المألوف يبدّد الظّلام، أمّا النّور بلونه الأخضر فهو خروج عن التّقليد؛ لأنّه يعني انتشار الخصب والنّماء، ويرمز إلى المواسم الغنيّة بالعطاء الإنسانيّ في مجالات العلم والفكر والحضارة، وكذلك أعطت المنارة الخضراء الحبّ معنى الشّمول ومعنى الحياة والتّجدّد الكامن في صفة الاخضرار، فصار حبّ أدونيس شموليًّا إنسانيًّا لا يستثني أحدًا أو شعبًا أو أمّة، صار حبًّا أخضر يجعل الموت في المجتمع الآدميّ حياةً والعقم ولادة جديدة.
وهكذا يتبيّن لنا أنّ اللّغة “تكون كلًّا واحدًا، إنّها نظام، وقيمة كلّ عنصر لا تتعلّق به بسبب طبيعته أو شكله الخاصّ ولكن بسبب مكانه وعلاقاته ضمن المجموع”([10])، إنّ اللّون الأخضر في العبارة الشّعريّة السّابقة له علاقة وثيقة وموضوعيّة مع المنارة والنّور، وكذلك مع الحبّ. فالحبّ يعيد إلى المجتمع الآدميّ الخصب والنّماء بعد أن قتله العقم والجدب، فيصير مجتمعًا حيًّا منتجًا وذا عطاء مستمرّ، والنّور الأخضر المشعّ ينشر الحبّ بين الشّعوب ويجعله حبًّا عميقًا، خلّاقًا، يستطيع أن يجمع الشّعوب المتقاتلة والمتنافرة على معانيه السّامية، معانيه التي تدعو إلى نبذ الحقد والعداء والعمل بدأب وتفانٍ من أجل صناعة السّلام. فكما النّور الذي تنشره المنارة عبر الأفق، عبر المدى لا تحدّه حدود، فهو يصل إلى النّاس كافّة من دون تخصيص أو تمييز، كذلك الحبّ الأدونيسيّ يكتسب هذه الصفة، فهو يستطيع أن يتجاوز كلّ الحدود العرقيّة والدّينيّة والسّياسيّة، ويصل إلى الإنسان.
ثالثًا- اللّغة الخضراء عند أدونيس/ اخضرار اللّغة عند أدونيس
- اللّغة الخضراء بوصفها لغة الحياة والتّجدّد والبعث
أمرٌ بديهي من أدونيس الذي يؤمن بفكرة البعث، ويسعى إلى تحقيقها في الحياة والمجتمع أن يعبّر عن إيمانه باللّغة الخضراء، ويستخدمها في كتابته الشّعريّة، “انبثاقًا من نضجه الثّقافيّ المتحرّر المستقلّ، وهو المصرّح: “أُحبُّ هنا أن أعترف بأنّني كنت بين من أخذوا بثقافة الغرب، غير أنّني كنت كذلك بين الذين ما لبثوا أن تجاوزوا ذلك، وقد تسلّحوا بوعي ومفهومات تمكّنهم من أن يعيدوا قراءة موروثهم بنظرة جديدة، وأن يحقّقوا استقلالهم الثّقافيّ الذّاتيّ([11])؛ إذ لا يمكنه أبدًا أن يصل إلى أهدافه البعثيّة باللّغة الصّفراء، يقول أدونيس:
“ظلّ ملأت به أرضي يطول، يرى، يخضرّ، يحرق ماضيه ويحترقُ/ مثلي ونحيا معًا نمشي معًا وعلى شفاهنا لغةٌ خضراءُ واحدةٌ لكن أمام الضّحى والموت نفترق”([12]).
اللّغة الخضراء في هذا الشّاهد الشّعريّ ترمز إلى اللّغة الحيّة التي تمنح الشّاعر قدرة التّعبير عن الحياة والتّجدّد، عن الولادة والخصب والنّماء. فاللّون الأخضر في دلالته الرّمزيّة العامّة يعني الحياة فـ “الأخضر هو لون مملكة النّبات معيدًا إثبات ذاته من المياه المتجدّدة والطّاهرة التي تدين إليها المعموديّة بكلّ معناها الرّمزيّ. الأخضر هو صحوة المياه الأوّليّة، الأخضر هو يقظة الحياة”([13]).
وانطلاقًا من هذا التّعريف الذي يظهر الدّلالة الرّمزيّة التي يحملها اللّون الأخضر، يتبيّن لنا أن اللّغة الخضراء هي اللّغة الحيّة عند أدونيس، هي اللّغة التي تستطيع أن تصوّر الحياة وتخاطبها، وتعبّر بقوّة عن قضاياها ومشكلاتها وإلّا تكون لغة صفراء لغةً ميتة لا تستطيع أن تحمل رسالة الشّاعر البعثيّ، والبعث في حقيقته هو سرّ الحياة وروحها، وهكذا تظهر لنا العلاقة الوثيقة بين فكرة البعث التي طالما عبّر عنها أدونيس في شعره واللّغة الخضراء التي عدّها لغته الخاصّة.
فاللّغة الخضراء وفاقًا للدّلالة الرّمزيّة التي يحملها اللّون الأخضر، تستطيع أن تمنح الشّعر روح الحياة والقدرة على البقاء والخلود. فأدونيس لا يمكنه أن يكتب بلغة اعتراها اليباس، وهو يُعدّ من طليعة الشّعراء العرب البعثيّين، فحتّى يعبّر عن فكرة البعث التي يؤمن بها كان لا بدّ له من أن يكتب شعره بلغة حيّة جديدة تناسب نظرته إلى الوجود والحياة، تناسب أهدافه التي يسعى إليها، كان لا بدّ له من أن يرفض اللّغة السّلفيّة؛ لأنّها لا تملك القدرة على مخاطبة الحياة الجديدة، وتوافقًا مع هذا الرأي يقول أدونيس:
“ونمضي صدورنا إلى البحر، وفي كلماتنا يرقد نحيبُ عصرٍ آخر، وكلماتنا لا وريث لها”([14]).
الكلمات الموصوفة في هذا الشّاهد الشّعريّ لا يرثها أحدٌ؛ لأنّها كلمات بائدة تنتمي إلى لغة بائدة، تنتمي إلى لغة صفراء اعتراها اليباس، فماتت، ما جعل الشّاعر يبحث عن لغة أخرى تتّصف بصفة الدّيمومة والخلود، فاهتدى إلى اللّغة الخضراء.
إنّ اللغة الخضراء عند أدونيس هي لغة حيّة، ولديها القدرة على حمل معاني الحياة، ووصف مشكلاتها، وطرق قضاياها، وأمرٌ بديهيّ أن تحمل اللّغة الخضراء عند أدونيس هذه الدّلالة الرّمزيّة، لأنّ “الأخضر هو لون الماء”([15]).
والماء وفق التّحليل الموضوعاتيّ هو المادّة الأوّليّة التي تُصنع منها الحياة، هو السّبب المباشر والرّئيس للاخضرار والنّماء والتّجدّد، وهكذا تتجلّى لنا الأبعاد الرّمزيّة التي رمى إليها الشّاعر من خلال اللّغة الخضراء. إنّه أراد أن يلفت انتباه المتلقّي إلى أنّ اللّغة التي يستخدمها الشّعراء وأهل الكلمة غير مؤهّلة لمواكبة العصر ومخاطبة الحياة، غير قادرة على أن تحدث في الحياة الثّقافيّة أيّ تجدّد أو تحديث؛ لهذا أعرض عنها باحثًا عن لغته الخاصّة التي تمتاز بصفة الاخضرار. فاللّغة الخضراء تُنتج شعرًا أخضر وثقافةً خضراء؛ لأنّ اللّغة هي المادّة الأوّليّة التي يُصنع منها الشّعر والفكر والثّقافة، فهي الماء الذي تُخلق منه الحياة فانعدام اللّغة الخضراء يعني موت الشّعر والفكر والثّقافة، يعني بقاء اللّغة الصّفراء التي تعجز عن إنتاج الأدب الجميل، ونحن في هذا السّياق التّحليليّ نستطيع أن نقيم مشابهة بين اللّغة والشّجرة، إذ إنّ الثمر الطّيّب الشّهيّ تنتجه الشّجرة الخضراء، أمّا الثّمر الرديء الذي يفتقر إلى النّضارة واللّذّة، فتنتجه الشّجرة الصّفراء، وهذه النّتيجة تتوافق مع سُنّة الله في خلقه، مع سُنّة الله الذي جعل من الماء كلّ شيء حيّ، فلولا الماء لما كان هناك حياة، أو خضرة: ﴿أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَتُصۡبِحُ ٱلۡأَرۡضُ مُخۡضَرَّةًۚ ٞ٦٣﴾([16]).
إنّ الأرض الخضراء في هذه الآية القرآنيّة الكريمة ترمز إلى الحياة والتّجدّد، فالأرض الميتة تحيا وتتجدّد بالماء، فينظر الإنسان إلى خضرتها، فيولد في نفسه الأمل بالمواسم الوفيرة والغلال الكثيرة ما يؤدّي إلى شعوره بالطّمأنينة وعدم الخوف من الجدب والعقم واليباس؛ وأتيت هنا بهذا المثال القرآنيّ، لأبيّن أنّ اللّون الأخضر عند الله هو لون الحياة والتّجدّد والخيرات، وكما ورد ذكر اللّون الأخضر في القرآن الكريم، كذلك ورد ذكره في الكتاب المقدس: “في اليوم الثّالث بعد إخراج النّور من الظّلمة، بذر الرّبّ في الأرض بذور الأعشاب والنّباتات الخضراء”([17]).
إنّ الّلون الأخضر وفقًا لهذا النّصّ المأخوذ من الكتاب المقدّس يشير إلى أنّه أوّل ألوان الخلق، وهذا يؤكّد أهمّيّته الحياتيّة، أهمّيّته في خلق عناصر الحياة التي تتمثّل بنصّ الكتاب المقدّس بالنّباتات الخضراء.
وانطلاقًا من المعنى الذي يؤدّيه اللّون الأخضر في القرآن الكريم والكتاب المقدّس يتبيّن سبب ولع الشّعراء العرب المحدثين باستخدامه في شعرهم، فهو منحهم القدرة التّعبيريّة عن أملهم بولادة الحياة، بعد أن رأوا الموت قد أصاب كيانهم الاجتماعيّ والثّقافيّ والحضاريّ والإنسانيّ، فأحسّوا بالحزن والألم والقنوط. فاللّون الأخضر أعاد إليهم الأمل بولادة الحياة الجديدة التي تشمل قضايا كيانيّة كثيرة، ومن بينها قضيّة اللّغة.
فاللّغة هي شخصيّة المرء وهويّته، هي سمته القوميّة والحضاريّة، لهذا فإنّ عقمها يؤدّي – لا محالة- إلى شعوره بالعقم في كيانه العامّ، وهذا المعنى يفسّر لجوء أدونيس إلى إكساب لغته صفة الاخضرار، فهو يعاني معاناة شديدة من العقم الشّديد الذي أصاب رحم اللّغة العربيّة فما عادت قادرة على إنجاب المعاني الجديدة والجميلة، إنّ أدونيس يتوق إلى الخلق الجديد في اللّغة، لقد سئم من اللّغة الصّفراء البليدة التي لا تستطيع الحمل والإنجاب، إنّ مثال اللّغة كمثال الأرض، فالاخضرار في كليهما يحمل دلالة رمزيّة واحدة، فاللّون الأخضر “هو لون الرّبيع والتّجدّد والأمل، يرتبط- وخصوصًا النّاضر منه- بالنّماء، ويرمز للحياة والوفرة والخير”([18]).
وقد أراد أدونيس أن تحمل لغته كلّ هذه المعاني الرّائعة حين أكسبها صفة الاخضرار، أرادها لغةً تنبض فيها روح الخصب والحياة، فالتقى مع معنى الخضرة في القرآن الكريم والكتاب المقدّس، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ “اللّون الأخضر قد ارتبط بأساطير قديمة عدّة، تعكس محاولات بدائيّة للبحث عن علاقة الخضرة بالحياة والخصوبة والخلود، فعندما لاحظ البدائيّ ما تقدّمه الأشجار الخضراء له ولغيره من الكائنات، ورأى أنّها تمدّه- وتمدّ غيره- بأسباب الحياة، نظر إليها نظرة تقديس، قدّس فيها خصوبتها وخضرتها”([19]).
إنّ هذا القول الذي أورده إبراهيم محمّد علي في كتابه “اللّون في الشّعر العربيّ قبل الإسلام” يشير إشارة بالغة الأهمّيّة إلى أنّ رمزيّة الحياة والخصوبة في اللّون الأخضر رمزيّة ذات جذور أسطوريّة موغلة في التّاريخ القديم، وليست رمزيّة طارئة ومبتدعة؛ فالشّعراء العرب المحدثون وظّفوها في شعرهم توظيفًا جديدًا يرتبط بعصرهم، ويعبّر عن حياتهم ومشكلاتهم، وهذا الفعل ليس فعلًا سيِّئًا، بل إنّ الشّاعر المبدع الذي يريد أن يكتب شعرًا إبداعيًّا يُكتب له البقاء، لا بدّ له من أن يعود إلى التّاريخ الحقيقيّ والأسطوريّ، لكي يصير أكثر غنىً في المعرفة والثّقافة، وأكثر قدرةً على إعادة إنتاج التّاريخ في شعر جديد يعبّر عن الحياة الجديدة. إنّ الشاعر الذي لا يستلهم من التّاريخ معانيه التي تتّصل بالإنسان والحياة والثّقافة والحضارة هو في حقيقته يكون بلا جذور، وبلا إرث فكريّ يزوّده بالمادّة الأوّلية التي يُصنع منها الشّعر، يكون غير قادرٍ على مواكبة الحياة ومخاطبتها ووصف أحداثها، يكون غير قادر على الإنتاج الإبداعيّ، فمثله حينئذٍ كمثل الشّجرة التي تُقطع جذورها فتموت، وتصبح غير قادرة على إنتاج الثّمر، وأدونيس حين أضفى على لغته صفة الاخضرار أراد أن يمنحها صفة الخصوبة والتّجدّد والنماء، وأراد كذلك أن يربطها برمزيّة اللّون الأخضر ذات الجذور الموغلة في التّاريخ الميثولوجيّ، وكأنّ شاعرنا يريد أن يبيّن أنّ اللغة التي يجب أن تكتب لها الحياة لا بدّ من أن ترتبط بالجذور لكي تستمدّ خضرتها من التّاريخ وتجارب الشّعوب. فاللّغة التي ليس لها تاريخ تفتقر إلى الحيويّة، وتعاني من البلادة وعدم القدرة على التّجدّد؛ لأنّ اللّغة تستمدّ حيويّتها من تاريخها المثقل بالمعاني الإنسانية والحضاريّة، وهذا الرّأي يفسّر لجوء أدونيس (علي أحمد سعيد) وغيره من الشّعراء العرب المحدثين إلى التّاريخ القديم الواقعي والميثولوجيّ لاستخدام معانيه الرّمزيّة في كتاباتهم الشعرية.
وقد يظن بعضٌ من الشّعراء أنّ العودة إلى القديم لا تخدم الحياة الجديدة، وهي تتناقض مع التّطوّر والتّجدّد، ونحن نقبل هذا الظّنّ إذا كانت العودة إلى القديم تتمّ بأسلوب يتناقض مع روح الحداثة الشّعريّة وحقيقة الإبداع الشّعريّ، أمّا إذا كانت هذه العودة تتمّ بأسلوب جديد يناقض الحياة القديمة ويتوافق مع حياتنا وعصرنا ومجتمعنا، فحينئذ تكون عودة فاعلة ومنتجة وخلّاقة، ومثال هذا نجده في الشّعر العربيّ الحديث الذي يحوي الكثير من الأسماء القديمة الواقعيّة والقديمة الميثولوجيّة، ولكنّ هذه الأسماء تجدّدت في معانيها ودلالاتها؛ لأنّها وظفت في سياقات شعريّة جديدة فاسم (عشتار) مثلًا صار في الشّعر العربيّ الحديث يرمز إلى الخصب والازدهار في موضوعات وطنيّة وقوميّة وحضاريّة وإنسانية واسم (الفينيق) صار يرمز إلى انبعاث الوطن أو الأمّة أو الحضارة بعد الاحتراق، صار يرمز إلى انبعاث اللّغة من موتها، إلى انبعاث التّاريخ الحافل بالإبداع والعطاء.
فأدونيس يرفض اللّغة السّلفيّة في الشّعر بيد أنّه استخدم في كتابته الشّعريّة الكثير الكثير من الأسماء التي يعود زمانها إلى التّاريخ الميثولوجيّ، ولكنّ الأسماء القديمة في شعر أدونيس أُفرغت من معناها القديم وتجاوزت إطار زمانها الأسطوريّ، وصارت رموزًا شعريّة تحمل دلالات رمزيّة تتوافق وقضايا حياتنا وعصرنا؛ لأنّ أدونيس، بوصفه رائد الحداثة الشّعريّة ومن طليعة الشّعراء العرب المحدثين، يملك القدرة على تحوّل اللّغة، فهو يحوّل الاسم القديم الذي ينحصر ضمن إطار زمانيّ ومكانيّ اسمًا جديدًا متحرّرًا من قيود الزّمان والمكان، اسمًا جديدًا مثقلًا بالمعاني والدّلالات الرّمزيّة.
وبمعنى آخر، يمكننا القول: إنّ الشّاعر في هذا الفعل يبعث اللّغة من موتها يُخصبها ويبثّ فيها روح الحياة، ولأنّه يؤمن بضرورة إخصاب اللّغة وانبعاثها، فقد أضفى عليها صفة الاخضرار، وبديهيُّ أن تكون اللّغة الأدونيسيّة لغةً خضراء، مزهرة ومثمرة، فهي تستمد حياتها ونضارتها وطاقتها من الإرث الثّقافي والحضاريّ الذي خلّفته الشّعوب؛ إذ “إنّ الشّعر كان ضربًا من السّحر”[20].
وبالعودة إلى ما تقدّم يتبيّن لنا أنّ اللّون الأخضر في التّعبير الشّعريّ الأدونيسيّ قد حمل دلالات رمزيّة مختلفة، ووُظِّف في موضوعات متنوّعه. فالفرق واضح من حيث الدّلالة الرّمزيّة بين عبارة “وحبّي منارةٌ خضراء” وعبارة “وعلى شفاهنا لغةٌ خضراء واحدةٌ”.
إنّنا في العبارة الأولى نلحظ معنى شمول الحبّ النّاضر الذي به يحيا الإنسان وتُستمدّ الحياة، وشمول الحبّ في هذه العبارة، يتجاوز الحدود الاجتماعيّة والدّينيّة والعرقيّة، ويشمل كلَّ زوايا الأرض، حبٌّ ينشر بين النّاس الأمل والتّفاؤل، ويجعلهم أكثر ثقةً وتعلّقًا بالحياة، يجعلهم يعملون في ميادين الإنتاج، وفي نفوسهم زخم العطاء، وترتسم أمام أعينهم ملامح المستقبل الأخضر، فأدونيس يودّ أن يقول: إنّ الأرض والإنسان لا يصلحان إلاّ بالحبّ الأخضر العميق- الذي يؤّلف بين الشّعوب ويختصر المسافات بين البلدان، أمّا العبارة الثانيّة فإنّنا نلحظ فيها معنى اخضرار الأدب والفكر والثّقافة؛ لأنّ اللّغة الخضراء لغة حيّة قادرة على الإنتاج الصّحيح. فالخضرة تعني الصّحة، والصّفرة تعني المرض، ووِفْق هذا التّحليل يصير الحبّ الأخضر رمزًا للحبّ الصّحيح، رمزًا للإنسان الصّحيح والحياة الصّحيحة.
ب- اللّغة الخضراء كتجسيد للخصوبة الثّقافيّة والرّمزية التّاريخية والأسطوريّة
في سورة يوسف من القرآن الكريم يحمل اللّون الأخضر دلالة الحياة الصّحيحة التي يكثر فيها الخير والرّزق والنّماء، حيث ترمز السّنابل الخضراء السّبع في رؤيا ملك مصر إلى سنينَ سبعٍ يكثر فيهنّ الخير والرّزق والمواسم، وترمز السّنابل السّبع اليابسات إلى سنين سبع ينقطع فيهنّ المطر ويقلّ الرّزق ويعمّ اليباس.
إنّ هذه الدّلالة في السّنابل الخضر والسّنابل اليابسات مأخوذة من تأويل النّبيّ يوسف عليه السّلام لرؤيا الملك: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49) ([21])﴾.
إنّ هذه الآية القرآنية الكريمة تشير إلى أنّ اللّون الأخضر عند الله عزّ وجلّ هو لون الحياة.
فاللّه هو الذي أوحى إلى ملك مصر رؤيا السّنابل، وعلّم يوسف تأويل الرّؤيا. اللّون الأخضر هو لون الحياة، وبهذا قضت سنّة الله حين خلق الألوان، ونحن إذا ما تأمّلنا الطّبيعة، فإنّنا نجد كلّ شيءٍ أخضر حيًّا، وحتّى الأرض – كما مرّ معنا آنفًا- بالماء تصبح مخضرّة واخضرار الأرض يعني اخضرار النّباتات والأشجار الحيّة.
انطلاقًا من هذا المعنى الحياتيّ الكامن في اللّون الأخضر قد رأينا أنّ أدونيس أراد باللّغة الخضراء أن يرمز إلى اللّغة الحيّة، فهو يتوق إلى أن تنبعث اللّغة العربيّة من ذبولها ويُبسها خضراء زاهية، لتستطيع أن تعبّر عن الحياة وتواكب الزّمن، فهو شاعرٌ ثائرٌ على اللّغة السّلفيّة البليدة التي تعجز عن حمل أفكاره الجديدة الرّائدة، ولا تستطيع التّعبير عن همومه ومشكلاته الخاصّة والعامّة، من خلال “الرّؤيا الشّعريّة والحلم الواعي يرى متصوِّف عصرنا الواقع الكائن والواقع الممكن، وهو بذلك يخترق حجاب الزّمن المستقبل، فيؤدّي، بالنّسبة إلى عصره، دوره القديم دور النّبوّة”[22]، فأدونيس شاعرٌ تأبى يراعته أن تخطّ على القرطاس لغة بائدة؛ لأنّه يودّ أن يرى أسطورة الفينيق متجسّدة في كلِّ مجالات الحياة، يودّ أن يرى اللّغة تنبعث من حطامها قويّة وفاعلة، ورغبة أدونيس بالبعث لا تنحصر ضمن إطار اللّغة، بل هي رغبة تشمل الحياة، إنّه يرغب ببعث الفكر والحضارة وقيم الخير والعدالة؛ ليعيش الإنسان حياة أجمل وأفضل، ولكنّ هذه الرّغبة الأدونيسيّة البعثيّة الشّاملة لا تتحقّق إلاّ ببعث اللّغة من رمسها القديم، من ضعفها وبلادتها؛ وقد أدرك شاعرنا أدونيس هذه الحقيقة، فعمل على تخصيب اللّغة، واخضرارها لكي تنتج الثّقافة الخضراء النّاضرة الخصيبة، الثّقافة التي تتلاءم والحياة الجديدة وتتدفّق حداثةً وتجدّدًا عبر الماضي والحاضر والمستقبل.
ووِفْق هذا المعنى لا يُعدّ أدونيس رافضًا التّراث اللّغوي والثّقافيّ بوصفه مصدرًا أو ينبوعًا يمدّ الحاضر بالحياة ويجعله قادرًا على الاستمرار، بل هو يرفض تكرار الفكر القديم في لغة العصر الجديد، يرفض في لغتنا الفكر القديم الذي لا يتناسب مع حاضرنا ولا يبني أساسًا صلبًا لمستقبلنا المتقدّم المزدهر. إنّه حين يدعو إلى اللّغة الخضراء، يدعو إلى اخضرار المجتمع على الصّعيد الثّقافيّ والإنسانيّ والعلميّ والحضاريّ، فبمقدار تطوّر اللّغة يكون تطوّر المجتمع، وتطوّر الحاضر والمستقبل أيضًا، وبمقدار ضعفها وتردّيها يضعف المجتمع ويتردّى الحاضر والمستقبل، وتنعدم الثّقافة والعلم والحضارة.
اللّغة هي الكيان الذي ينتمي إليه الإنسان وبه يتأثّر؛ لهذا يجب أن تكون خضراء، خصيبة ثريّة بالمعاني والأفكار والإشارات والدّلالات الرّمزيّة، يجب أن تكون متجدّدة لكي تستطيع أن تجدّد الحياة وتجدّد الإنسان.
إنّ مَثَل اللّغة كمثل الماء، فإذا ركد في المستنقع أَسِنَ وفسد وصار غير صالح للحياة، أمّا إذا تدفّق من نبعه متجدّدًا عذبًا رقراقًا، فإنّه يكون ذا صلاح وفائدة، يكون ملائمًا لخلق الخصوبة والنّماء.
اللّغة ينبغي أن تتماشى وسنّة التّجدّد والحداثة، فإذا ما جمدت وتوقّفت عن الحركة، فحينئذٍ تقصّر عن مواكبة الزّمن ومجاراة الحياة، وفي تقصيرها عن مواكبة الزّمن ومجاراة الحياة تعجز عجزًا كبيرًا في التّعبير عن قضايا أمّتها وإنسانها؛ وليس هذا وحسب، بل إنّ عجز اللّغة يؤدّي إلى عجز الأمّة نفسها على الصّعد كافّة، فتتلاشى قواها وتضمحلّ حضارتها وتمّحي شخصيتُها. فاللّغة هي التي تصنع الأمّة وتُعطيها شخصيّتها، وتبني حضارتها وتنتج فكرها وثقافتها وتحدّد لها خواصّها ومزاياها بين سائر الأمم، فحين تموت اللّغة تموت الأمّة وتندثر حضارتها وثقافتها، والتّاريخ خير شاهد على صحّة هذا الرأي، فثمّة أمم كثيرة قد ماتت بموت لغتها، وأمم لم تجد لها سبيلًا للبقاء على قيد الحياة سوى اعتمادها لغة غيرها، ففقدت خواصّها الثّقافيّة والحضاريّة والقوميّة. فاللّغة هي الهويّة لكلّ هذه الخواصّ؛ ولأنّها تمتاز بهذه الوظيفة في الحياة، فقد أرادها أدونيس أن تبقى خضراء لا تذبل ولا تموت. فأدونيس يدرك كلّ الإدراك أهمّيّة دور اللّغة العربيّة الخضراء في جعل العروبة تزدهر في مجالات الخلق والإبداع كافّة، وهو في الحقيقة كان يدرك أيضًا أنّ لغة اللّون هي لغة إنسانيّة قديمة الجذور؛ لهذا عمد إلى توظيف اللّون في شعره بوصفه رمزًا تعبيريًّا يمنح الكتابة روحًا إبداعيّة متجدّدة.
إنّ اللّون لغةٌ عالميّة اعتمدتها الأمم والشّعوب في التّعبير منذ الأزل، وما زالت تعتمدها إلى يومنا، وستظل تعتمدها إلى نهاية الزّمان. ولغة اللّون متنوّعة الوظائف، فلا يقتصر دورها في التّعبير على الشّعراء فقط، بل هي لغة كلّ المبدعين والمعبرين. وهذا الرّأي تؤكّده الاكتشافات التي حقّقها علماء التّاريخ والآثار حيث “ثبت أنّ استخدام الألوان في الرّسم يمتدّ من مائة وخمسين ألف سنة إلى مائتي ألف سنة مضت، وقد عُثر في إسبانيا على رسوم في حوائط بعض الكهوف، تمثّل بعض الحيوانات في ألوان حمراء وسوداء وصفراء، ترجع إلى هذه الفترة السّحيقة”([23]).
إنّ هذا الشّاهد يؤكّد أنّ لغة اللّون ذات جذور موغلة في التّاريخ السّحيق، وذات تنوّع في الوظيفة التّعبيريّة. وقد يسأل سائل إذا كانت لغة اللّون لغةً مكتملة العناصر، وقد اعتمدتها الأمم والشّعوب في التّعبير خلال مراحل التاريخ المتعدّدة، فلماذا أضافها الشّعراء العرب المحدثون وغير العرب إلى لغة الحروف والكلمات؟
الجواب يكمن في أنّ شعراء الحداثة أرادوا في إضافة اللّون إلى الكلمة أن يقيموا مزجًا بين اللّغتين أو الوسيلتين التّعبيريّتين، أرادوا أن يُخصبوا اللّغة اللّسانيّة بتلقيحها أو (تطعيمها) من لغة اللّون الرّمزيّة الإشاريّة، وبواسطة عمليّة التّلقيح أو التّطعيم يتمّ إنتاج لغة جديدة فاعلة ومثمرة هي ذاتها عند أدونيس اللّغة الخضراء. فسرُّ الخصوبة في الشّعر العربيّ الحديث عمومًا وشعر أدونيس خصوصًا يكمن في عمليّة التّلقيح أو التّطعيم بواسطة رمزيّة اللّون ورمزيّة الأسماء الواقعيّة والأسطوريّة. إنّ رمزيّة اللّون في اللّغة الشّعريّة تمثّل- كما أسلفنا سابقًا- الطّاقة الإضافيّة الفاعلة؛ لأنّ اللّون على علاقة مع الحياة منذ بداية التّكوين على علاقة مع الطّبيعة بكلّ عناصرها والمخلوقات التي تعيش فيها، فإذا ما نظرنا إلى الشّجرة في فصل الرّبيع فإنّنا نرى أوراقها خضراء زاهيةً، ثمّ يتحوّل اللّون الأخضر في الأوراق تدريجيًّا إلى اللّون الأصفر في فصل الصّيف وصولًا إلى الذّبول والتّساقط في فصل الخريف، ومن ثمّ تعيش الشّجرة فترة التّعرّي في فصل الشّتاء متخلّية عن طبيعتها القديمة استعدادًا للتّجدّد في نظام موسميّ مستمرّ ومثمر، واللّون الأخضر في أوراق الشّجرة يرمز إلى الحياة والخصوبة والعطاء، أمّا اللون الأصفر فيها فيرمز إلى التّعب والرّكون إلى الارتياح حفاظًا على ديمومة الطّاقة المنتجة في دورة الحياة الموسميّة المثمرة.
ومثال الشّجرة الذي سقناه هنا ليس وحده يدلّ على العلاقة الوثيقة القائمة بين اللّون والحياة، بل ثمّة أمثلة كثيرة لا يمكن أن يحصيها أحد من الناس، فمنها ما هو في عالم الخفاء، ومنها ما هو في عالم الغيب. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ رمزيّة اللّون يختلف معناها الاجتماعيّ والحضاريّ عند أمّة عن معناها عند أمّة أخرى، وكذلك يختلف معناها في عصر عن معناها في عصر آخر، وقد ارتبطت رمزيّة اللّون بكلّ العصور السّابقة، وستظلّ مرتبطة بالعصور اللّاحقة؛ لأنّ اللّون هو في خلقه مرتبط بالحياة، وإذا ما عدنا إلى زمن الحضارة المصريّة القديمة، فإنّنا نجد اللّون قد حمل دلالة رمزيّة خاصّة في حقبة تاريخيّة حضاريّة خاصّة، حيث اعتاد المصريون على “تصوير النّساء بلون أصفر، والرّجال بلون أحمر”([24])، وكذلك نجد “مثل ذلك عند الكريتيين والفينيقيين”([25]).
خاتمة البحث
سعى هذا البحث إلى استكشاف اللّون الأخضر بوصفه رمزًا عميقًا في الثّقافة الإنسانيّة، ووسيلة تعبيريّة ذات طاقة إيحائيّة كثيفة في الحقول الدّينيّة، الأسطوريّة، الطّبيعيّة والفنّيّة، ثم انتقل ليستجلي تجلّيات هذا الرّمز في التّجربة الشّعرية الأدونيسيّة التي تمثّل نموذجًا للحداثة العربيّة الرّافضة للجمود والسّكون.
وقد تبيّن لنا أنّ اللّون الأخضر ليس مجرّد صفة بصريّة، بل هو علامة كونيّة كبرى تدلّ على الحياة والخصوبة والبعث والأمل، وقد ارتبط بالوجود الإنسانيّ منذ أقدم الحضارات، حتّى تجسّد في النّصوص المقدّسة كرمز لليقظة والنّماء. ومن هذا المعنى الرّمزي العميق انطلق البحث ليتتبّع كيف تمثّل أدونيس هذا اللّون بوصفه جوهرًا لرؤيته الشّعريّة، ووسيلة لتجديد اللّغة، وإعادة إحيائها من رماد البلادة والجمود؛ فاللّغة الخضراء في شعر أدونيس هي لغة البديل والممكن، اللغة التي تنبثق من رحم المعاناة والتّوق إلى الخلاص، وهي تجسيد لوعيه الجماليّ والحضاريّ، حيث تتحوّل الكلمة إلى كائن حيّ، يحمل قدرة التّغيير والتّأثير، وينبع من جذور التّاريخ والأسطورة؛ لينفتح على آفاق المستقبل والتّجدّد.
يمكن القول في ضوء ما سبق: إنّ اللّون الأخضر – بما يحمله من رمزيّة عميقة وقابليّة للتّحوّل الدّلاليّ – قد غدا عند أدونيس رؤية كاملة للعالم، لا تقتصر على الشّعر بوصفه فنًّا، بل تتجاوز ذلك إلى الفلسفة واللّغة والحضارة والثقافة.
من هنا، فإنّ دراسة اللّون الأخضر في شعر أدونيس ليست استقصاءً لعنصر جماليّ فحسب، بل هي أيضًا قراءة في بنية فكريّة متكاملة، تنشد الحياة في وجه الموت، والخصب في وجه العقم، والتّجدّد في وجه التّكرار.
هكذا، ينفتح البحث على إمكانات جديدة في تحليل الشّعر المعاصر من خلال رمزيّة اللّون، وعلى إمكانيّة إعادة قراءة الرّموز بوصفها أبوابًا لفهم أعمق للعلاقة بين الإنسان والعالم واللّغة.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم
- الكتاب المقدّس: سفر التكوين، (1: 11- 12)، الطبعات الألمانية والهولندية.
- أدونيس، الأعمال الشّعريّة الكاملة، دار السّاقي، بيروت، 1988م.
- أدونيس، الدّيوان، دار العودة، بيروت، ط 5، 1988.
- أدونيس، زمن الشّعر، دار العودة، بيروت، ط 3، 1983م.
- أدونيس، الشّعريّة العربيّة، دار الآداب، بيروت، ط 2، 1989م.
- إرمان، أدولف، مصر والحياة المصريّة في العصور القديمة، ترجمة عبد المنعم أبو بكر، محرم كمال، مكتبة النّهضة، القاهرة.
- إسماعيل، عزّ الدّين، الشّعر العربيّ المعاصر قضاياه وظواهره الفنّيّة والمعنويّة، دار الفكر العربي، ط 3، 2013م.
- برندات، ايفلين كلنيكل، رحلة إلى بابل القديمة، ترجمة: د. زهدي الداوودي، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، 2009.
- جيرو، بيير، علم الدّلالة، ترجمة: د. منذر عياشي، دار طلاس، دمشق، 1992.
- ديورانت، ول: قصّة الحضارة
- رد، هربرت، (Herbert Red) الفنّ والمجتمع، ترجمة فارس متري ضاهر، دار القلم، بيروت، ط 1، 1975م.
- عمر، أحمد مختار، اللّغة واللّون، عالم الكتب، القاهرة، ط 2، 1997م.
- محمد علي، إبراهيم، اللّون في الشّعر العربيّ قبل الإسلام، قراءة ميثولوجيّة، جروس برس، بيروت، ط 1، 2001.
المراجع الأجنبيّة
– Cheralier, Jean, Gheerbrant, Alain, Dictionnaire des Symboles, edition reuve et augmentatée, P 1002.
– Riffaterre, M, La production du texte, seuil, Paris, 1979.
[1] أستاذ مساعد في الجامعة اللّبنانيّة، كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة – الفرع الثّالث.
[2] إسماعيل، عزّ الدّين، الشّعر العربيّ المعاصر قضاياه وظواهره الفنّيّة والمعنويّة، دار الفكر العربي، ط 3، 2013م. ص 182.
[3] أدونيس: الديوان، قصيدة (قالت الأرض)، دار العودة، بيروت، ط 5، 1988. 1/ 26.
[4] أدونيس، الديوان، قصيدة (قالت الأرض)، 1/ 26.
[5] برندات، ايفلين كلنيكل، رحلة إلى بابل القديمة، ترجمة: د. زهدي الداوودي، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، 2009. ص 89.
[6] أدونيس، زمن الشّعر، دار العودة، بيروت، ط 3، 1983م. ص 9.
[7] أدونيس: الديوان، قصيدة (قالت الأرض)، 1/ 26.
[8] أدونيس: الديوان، قصيدة (أوراق في الريح)، 1/ 112.
[9] Riffaterre, M, La production du texte, seuil, Paris, 1979.
[10] جيرو، بيير، علم الدّلالة، ترجمة: د. منذر عياشي، دار طلاس، دمشق، 1992 م. ص 129.
[11] أدونيس، الشّعريّة العربيّة، دار الآداب، بيروت، ط 2، 1989م. ص 76.
[12] أدونيس: الديوان، قصيدة (فصل الدمع)، 1/
[13] Cheralier, Jean, Gheerbrant, Alain, Dictionnaire des Symboles, edition reuve et augmentatée, P 1002.
[14] أدونيس: الديوان، قصيدة (مرثيّة الأيّام الحاضرة)، 1/ 221.
[15]Cheralier, Jean, Gheerbrant, Alain, Dictionnaire des Symboles, P 1002.
[16] الحج : 63.
[17] الكتاب المقدّس: سفر التكوين، (1: 11- 12)، الطبعات الألمانية والهولندية.
[18] محمد علي، إبراهيم، اللّون في الشّعر العربيّ قبل الإسلام، قراءة ميثولوجيّة، جروس برس، بيروت، ط 1، 2001. ص 112.
[19] م. ن. ص 214.
[20] رد، هربرت، (Herbert Red) الفنّ والمجتمع، ترجمة فارس متري ضاهر، دار القلم، بيروت، ط 1، 1975م. ص 19.
[21] سورة يوسف: 46، 47، 48، 49.
[22] أدونيس، الأعمال الشّعريّة الكاملة، دار السّاقي، بيروت، 1988م. 1/ 369.
[23] عمر، أحمد مختار، اللّغة واللّون، عالم الكتب، القاهرة، ط 2، 1997م. ص 26-27.
[24] إرمان، أدولف، مصر والحياة المصريّة في العصور القديمة، ترجمة عبد المنعم أبو بكر، محرم كمال، مكتبة النّهضة، القاهرة. ص 22.
[25] ديورانت، ول، قصّة الحضارة، ترجمة زكي نجيب محمود، منشورات دار الجيل والمنظّمة العربيّة للتّربيّة والثّقافة والعلوم، لبنان – تونس، 1988م، 1/ 20