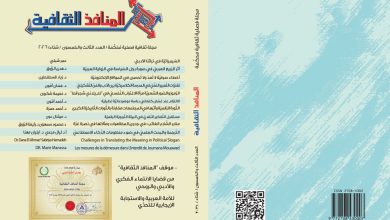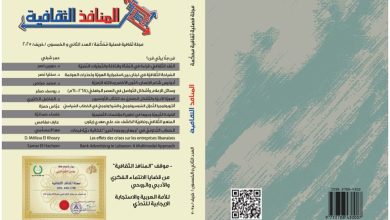المحاور الرّومانسيّة في الشّعر العامليّ
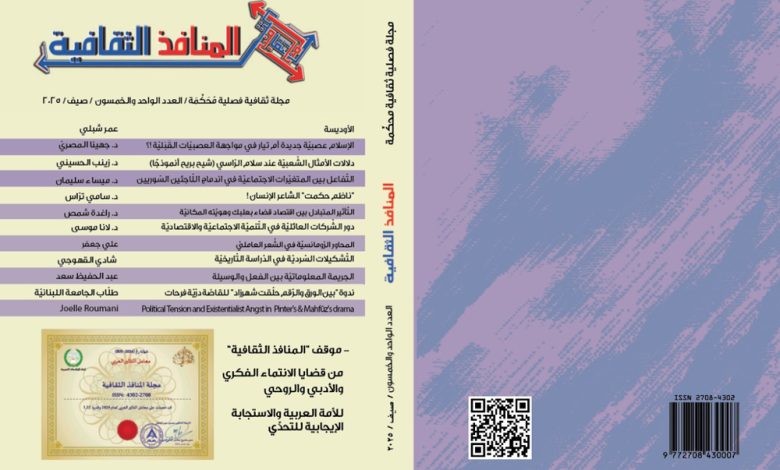
المحاور الرّومانسيّة في الشّعر العامليّ
Romantic themes in Amil poetry
علي خليل جعفر[1]
Ali Khalil Jaafar
تاريخ الاستلام 1/4/ 2025 تاريخ القبول 29/4/2025
الملخص
يتناول البحث أثر المدرسة الرّومانسيّة في الشّعر العامليّ بعد ظهورها في أوروبا، فكان الإنسان ضحيّتها، ما خلّف لدى الأدباء حالة من الضّيق بين ما تأمل النّفس وما تستطيع، ودور التّرجمة في نقل هذا الأثر عن الأدب الأوروبيّ، في حين كانت البيئة العربيّة والوطنيّة مهيأة للبعث والتّغيير. ومن ثَمَّ دراسة المحاور الرّومانسيّة في الشّعر العامليّ، والسّير نحو الحداثة والتّجدّد لدى بعض الشّعراء العامليّين في حقبة تاريخيّة معيّنة.
الكلمات المفتاحيّة: دور التّرجمة – الاغتراب والألم – الحبّ والمعاناة – الطّبيعة – الثّورة والحريّة – نحو الحداثة
Abstract
This research examines the impact of the Romantic school on Amil poetry after its emergence in Europe. Man was its victim, leaving writers feeling a sense of distress between what the soul hopes for and what it can achieve. It also examines the role of translation in conveying this influence from European literature, at a time when the Arab and national environment was ripe for revival and change. The research then examines the Romantic themes in Amil poetry and the path toward modernity and renewal among some Amil poets during a specific historical period.
Keywords:The Role of Translation – Philosophy of Pain – Love and Suffering – Nature – Revolution and Freedom – Towards Modernity
أولًا:
1- المقدمة
لكل أمّة أو مجموعة بشريّة خصوصيّة، لها فنونها وآدابها، لكنّها خصوصيّة مفتوحة على تجارب الآخرين حتى لا تجفّ أو تموت. وهذا لا يتحقّق عن طريق تصيّد الأشكال العالميّة أو الإبداع في إطارها. وإنّما هو وعي المحليّة نفسها وعيًا إنسانيًّا والنّفاذ إلى أعماق الواقع المحليّ. وعندما يكون الأدب قائمًا على الفكر، يجب أن يتضمّن الحرارة القادرة على أن تحرّك وجدان الإنسان[2]. فالأدب الصّادق مرتبط بهموم الإنسان وما يحيط به وما تقع عليه عيناه من مظاهر الألم والأمل[3].
وقد بدأت حركات التّحرّر والتّمرّد على النّظريّات الأدبيّة القديمة بالحركة الرّومانسيّة لدى الشّعراء اللّبنانيّين، وتأثر بها شعراء جبل عامل، وبدورها كان لها تأثير على أدبه وإنتاجه الشّعري والنّثري.
ترى الرّومانسيّة أنّ الأدب الحيّ هو أدب التّحرّر والانطلاق، وهذا ما كان المجتمع العامليّ يتطلّع إليه في حقبة نهاية الحكم العثمانيّ وبداية الانتداب الفرنسيّ. ففي هذه الحقبة كان هَمُّ الشّاعر العامليّ الالتفات إلى المجتمع لتحرّره وإصلاحه ومعالجة قضاياه الوطنيّة.
من هنا بدأ الاتّصال بين العامليّين والتّيّارات الأدبيّة الجديدة ومنها التّيّار الرّومانسيّ عن طريق التّرجمات التي كتبت عن هذه المدارس الأدبيّة وعن شعرائها بالإضافة إلى إقدام العديد من أدباء جبل لبنان، وأدباء المهجر الأميركيّ على تبنّي المذهب الرّومانسيّ، ما سهّل تأثر العامليّين بما يتوافق مع مقاييس هذه المدرسة، مع أذواقهم وأهوائهم، ودفعهم لهجر القوالب المحفوظة المبتذلة وأخذت تظهر فنون جديدة من التّعبير فيها الرّوعة والجدّة والطّرافة[4].
إشكالية البحث
وسأحاول من خلال هذا البحث الإجابة عن هذه الأسئلة:
- هل أثّرت المدرسة الرّومانسيّة في الشّعر العامليّ؟
- كيف نظر الشّعراء العامليّون إلى مبادئها في مجتمعهم؟ وفي التّعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم الذّاتيّة؟
- كيف تحقّقت المحاور الرّومانسيّة لدى الشّعراء العامليّين؟
منهجيّة البحث
لا بدَّ للباحث من الاستناد إلى منهج في دراسته، لذا، اخترت لهذا البحث المنهج النّفسيّ الأكثر ملاءمة في تحليل الموضوعات وتقصّي محاور الدّراسة.
2- دور التّرجمة
أدّت عملية التّرجمة والتّعريب دورًا مهمًّا في نقل التّراث الإنسانيّ العالميّ “فليس من فنّ يحيا من ذاته، بل على أصحابه أن يتغذّوا بروائع غيرهم إذ لا تجديد ولا إزدهار إلا من خلال رؤية الآخر. فالإبداع والخلق في أي مجال فنّي يلزمه دم جديد، هكذا شأن الأدب في شعره ونثره، إذا لم يتطعّم الأدب بآداب توازيه وتفوّقه تطوّرًا يبقى متكئًا على ذاته، منطويًا على نفسه وعلى شعبه”[5].
وقد جاءت القصيدة المترجمة نثرًا لتشكّل أحد أهم المداخل التي نفذت منها قصيدة النّثر إلى أذهان وعقول المثقفين العامليّين، وأوّل من قام بالتّرجمة عن اللّغات الأجنبيّة محمد علي حامد حشيشو، حيث قال في هامش التّرجمة: “هذه المقالة النّثريّة لها علاقة كبرى بباب النّفحات والنّسمات، إذ تضمّنت من الأسلوب الشّعريّ ما جعلنا نعتقد أنّها من قبيل الشّعر المنثور”[6].
وبدأ الشّعراء العامليّون يتحفون المثقفين بقصائد مترجمة عن اللّغات الأجنبيّة، ومنها ما ترجم بقصائد منظومة مقفاة كقصيدة “ليلة شاعر” لزهرة الحر وقد عرّبتها عن الفرنسيّة ومن أبياتها[7]:
غروب الشّمس يشجيني كصدّ في الهوى مرّ
ونور البدر يؤلمني ويفضح دائمًا سرّي
أحبّ لقلبي عاصفة من النّسمات في البرّ
تطهر أنفسًا فسدت وتردي زمرة الشرّ
وأحنو الرأس إجلالًا لربّ النّظم والنّثر
وينشد الشّعراء الحريّة بصوت عالٍ للإفلات من القيود الحاقدة والإنطلاق مع الريح والعواصف الثائرة. فمن قصيدة القيد المحطّم للشاعرة الإنكليزية فليسا دورثا هيمانز، ترجم مرتضى شرارة بعضًا منها[8].
إنّي حرّة، انفجرت من قيدي الحقود
وعادت لي حياة صغار النّسور من جديد
أستطيع أن أشقّ بزورقي الشّراعي البحر الطّروب
وأطوف حيثما تطوف الرّياح… إنّ طريقي حرّ
أيّها الأسير المستعبد ألا تحطم قيدك
أنت حرّ في الفلاة وفي لجج البحر؟
أجل هناك تحلق روحك في فخر؟
ثانيًا: المحاور الرّومانسيّة
1- اللّيل والألم
اللّيل أحد محاور القاعدة الرّئيسة للرومانسيّة عمومًا إلى جانب محور الألم النّفسيّ، وفي هذا السّياق يقول الكاتب العامليّ عبداللّطيف شرارة: “إنّ النّزعة الرّومنطقيّة تحمل صاحبها على التّغنّي بالألم والتّململ من الحياة، نعرفها لدى شعراء العربيّة، وقد عبّر عنها المتنبي مرّات عديدة بكل وضوح”[9]. وهذا ما قصدته زهرة الحر في غروب الشّمس من الشّجى والألم من نور البدر في دجى اللّيل.
وإن أضاءت “نجمة الغروب” لدى الشّاعر كامل سليمان، فهي مبعث للشّحوب والأسى. هذه القصيدة التي استوحاها من قصيدة الصّفصافة “لألفرد دي موسه”[10]:
يا نجمة في الأفق تبدو لنا كالعين تبدو في صورتها الشّاحبة
لا تنحري نفسك من ثورةٍ للحبّ مستأزمة غاضبة
وابتردي من الماء لألأة أو فارقُصي لاهية لاعبة
وقبل أن تمضي إلى قصره لتطفئ زفراتكِ اللاهبة
تلفتي نحوي فإنّي فتى يهجره الصّاحب والصّاحبة
ينادي الشّاعر نجمة الغروب من نفس قلقة مضطربة وصورة اللّيل الشّاحبة، فتزول لديه مساحة الأمل والنّور وتطغى عليه خيبات الهموم الذّاتيّة.
أمّا عبد المطلب الأمين فالألم لديه له فلسفة خاصة، من عمق ذاته المعانية في حكاية سفر وجرح إلى نظرة إنسانيّة شاملة، تتجاوز هموم الفرد إلى نوازع المشاعر الإنسانيّة:
جراحي جراح الكون لست بمفرد ولا أنا باللّحن النّشاز بمغرمِ
هكذا يعبِّر الشّاعر الأمين بلغة النّبل الإنسانيّ عن رؤيته لقضية الكائن الآدميّ، بكل زخم الصّراع مع الأشواق المتناقضة من ضجيج صراع الكائنات إلى قوافل المواسم العائدة والمهاجرة متمرّدًا على الألم السّطحيّ المتسكّع الغافي على نتن مستنقع[11].
ألم التّفاهة عفته ومللته وحننت للألم العميق الملهِمِ
ألم خمرة قلم أبي شبكة في “غلواء”[12]:
أجرح القلب واسق شعرك منه فدم القلب خمرة الأقلام
إنّه يرى الإبداع في ألم القلوب والأقلام، في سفر الجرح على مثلث الزّمن والألم والحبّ. في قضية الإنسان من منظورها الثّوريّ “أنّ الإنسان قدرة خالق وتجسيد إبداع”.
من هذه الرّؤية عاش الأمين معاناته بتوتر بالغ، مستغرقًا فيها إلى أقصى الحدود، مهاجرًا في ظلمات الوحدة والغربة، حتى الإنسحاق رمادًا في نزف الجرح[13]:
نجمة الصّبح يا حطام اللّيالي ورماد اللّفافة السّوداء
خلفتك الظّلماء عقبًا ذليلًا تحت أقدام كبرياء الضّياء
لم تكن الرّومانسيّة لدى الشّاعر الأمين خائبة سلبيّة من أجل الشّكوى والضّعف، بل دقّ من خلالها على جدار الوجود وحاول اكتناه الزّمن عن جدليّة العلاقة بين البداية والنّهاية هذا اللّغز المبهم منذ الأزل. إنّها رومانسيّة إعمال الفكر ومحاولة الاستكشاف. وهنا مكمن المعاناة وحقيقة الوجود في تناقضاته، فيراها مصدرًا لواقع متقلّب[14]:
أنت نايي يا كأس والنّغم الحلو عطاء من كفك الخرساء
أنت حطمتني وسقت حياتي في دياجير هذه الظّلماء
أنا لولاك جذوة من طموح لم تسعها مدارج العلياء
حكاية جرح الأمين هذه، امتدت ظلالها إلى علاقته بمسار حركة الشّعر العربيّ الجديدة، مسار يتقاطع معها حينًا ويتوازى حينًا آخر. هذه الظّلال كانت حاجزًا بينه وبين الحركة الشّعريّة في الإبداع والتّطوّر. حكاية القلق الوجوديّ بكل معانيها، غربة عن الذّات، عن الحياة، حتى يكون فناء[15].
يا غريب الدّيار إنّي غريب صمت الكون فالفناء المجيب
ما شممنا من الحياة عطرًا ولا خالج الأنوف طيوب
إنّه بوح دفين، نغم مرارة بلا ضفاف، نداء يتردّد في الأصداء، لقاء مع صلاح عبد الصّبور في حزنه الصّباحيّ[16]:
يا صاحبي، إني حزين
طلع الصّباح، فما ابتسمت، ولم يُنر وجهي الصّباح
ومن آهات اللّيل الطّويل يخاطب الشّاعر الأمين الألم[17]:
أأخي عمري كالسِّهام أجرّها من ساحق الأعماق في الجرح الظّمي
دفق الجراح سنِّي إن عددتها ودقائقي القطرات تقطر من دمي
أجترّ آهاتي وأعصر مهجتي أقتات من جود السّراب المعدم
لم يبقَ لي إلا الكؤوس نواصرًا وبلاسمًا في مهجتي في أعظمي
في ليلي القزِم الطويل ملالة وتفاهة، ونهاري المتهجّم
ويدخل الشّاعر في ليله الخاص، ليل رؤيته الكونيّة، المنطوية على الأشباح والأطياف، والكآبة السّارحة في فيافي العمر، فتغيب الألحان وتخرس الشّوادي عن التّغريد، فيصوغ اللّيل ألحانه في موكب يحدوه اللّظى[18]:
… وانطوى اللّيل على أشباحه يصطفيها من رؤى عربيده
… وهو لو أفصح عن أشجانه لم يُدَعْ شادٍ على تغريده
ولصاغ اللّيل لحنًا كامدًا يوحش الدنيا صدى ترديده
لقد ارتقى الشّاعر الأمين بالواقع المؤلم إلى يقين وَضَعَهُ في إطار معادلة فلسفيّة للحياة التي تأخذ الإنسان في مسيرتها إلى النّهاية من دون اختيار، وكأنّه يلمِّح إلى فكرة الجبريّة في الوجود[19].
… فلا الحياة ورود بعده صور ولا النّهاية تبرير لدنيانا
… تلك الكؤوس شربناها على مضض ومذ فَرَغْنَ سَلَوْنَ النّاس والحانا
ويبقى الأمين يدقّ على جدار الزّمن، الماضي، الحاضر، الآتي ويسأل عن المصير، البداية، النّهاية، وما بينهما من سعادة وشقاء، قلق وحيرة ونداء[20].
يا أمس، يا غد، يا يومي! بأيّكم أنمي وأرثي واستوحي وأبتسم
يومي وأمسي، وأخشى أن أقول غدي غرقت في الألم الساجي وما علموا!
كأنّ تلك الدّنى أشباح واهمة لا أكؤوس لمعت فيها ولا نغم
تبًا له الزمن الواهي فمرّ بها مرّ الكرام: عيون أوصدت وفم
ويبقى الجواب عن السّؤال الدّائم عن الوجود لغزًا في دائرة معجزة الخلق، فهذا الحدّ يبقى دونه عقل الإنسان عاجزًا عن الجواب مهما حاول السّؤال. وتبقى العِبرة للعاقل والتّائه معلّقة على جدار الأبد.
2- الحبّ والمعاناة
صحيح أن الشّاعر الامين عاش مأساة القلق الوجوديّ على حدّه المضني وما زاد من هذه القسوة معاناته العاطفيّة. ويبدو أن الشّاعر كان يعيش جنة بلذيذها فوقع في عذاب النّدم بخسرانها، يحاول إعادتها عبر الخيال وجمال الذّكرى، فكشف في هذه الأبيات[21] عن هذا الجانب من هواه العُمري[22].
محمومة الشّفتين لو نطق الدّم لم يعدُ ما تهذي به وتتمتم
… آمنت بالظّمأ الذي لا يرتوي وفتنت بالثّغر الذي لا يبسم
هو في لماك لبانة منهومة وعلى شفاهك شهوة تتكلّم
مرّت بها القبل الظَّماء كليلة لم ترتعش شفة ولم يخفق فم
… دنيا إذا شاء الشّباب رحيبة ريّانة صخابة تتبسم
خلقت بها شفتاك معجزة الهوى متعًا إذا سُئم الهوى لا تُسأم
قبلًا كألحان الجحيم مُرنّة هوجاء تعصف بالشّفاه وتهدم
واضح من هذه الأبيات أنّ الشّاعر فقد جنة في الهوى كان يمتلكها أو يسعى إلى امتلاكها عبر التّمنّي والشّوق، وأنّ قلبًا قهر الشّاعر وفلت من عقال حبّه، يحاول استرجاعه من سحيق النّدم، ولم تبقَ له إلا الذّكرى تناديه من بئر الحرمان، أو من قيم التّربيّة الأخلاقيّة والبيئة المحافظة.
ذكراك، يا ظمأ الهجير إلى النّدى وتطلع البأساء بالنّعماء
ذكراك، يا ماضٍ أفاض وكم سخا وكسا الحياة روائع اللألاء
من هذا المنحى السّوداوي يسأل الأمين عن الحبّ واللّقاء، والشّعر وفي التّكرار مأساة مضاعفة[23]:
ماذا أقول لماضيَّ الذي ذهبا ماذا أقول لأتيَّ الذي هربا
ماذا أقول لأشباحي وأخيلتي ماذا أقول لنبع الشّعر إن نضبا
ماذا أقول لهذا الحبّ والهفى هل نلتقي؟ يا لعهد الحبّ إن كذبا
من هذه الصّورة الحادة في تضادها، يبرز الوجه العاطفيّ والنّفسيّ للشّاعر، وتبقى الحسرة للحبّ الذي مضى، ونأى عن الصّبابة وتحوّلت واحة الهوى إلى صحراء[24]:
الحبّ واحة عمرنا كم حومت في فيئها وظلالها صحرائي
ما بلل الظمأ القديم صبابةً تهب الهجير طراوة الأنداء
كانت لذاذاتٍ وكانت صبوةً والحبّ عنها كالغريب النائي
صحراء الهوى هذه، أودت بالأمين إلى “دمية الماخور” بنزعة عبثيّة، هي ملجؤه في دنيا السّراب، يخاطبها بلغة الأمر المتكرر بإصرار وعناء، فلعل هذه الصّيغة اللّغويّة تكون صحوة للعابث، تعوّضه عن الفرح الذي تركه فريسة المأساة والمعاناة، وفي التّحليل النّفسيّ لهذا السّلوك قد يكون شفاء للذّات من المهاوي التي قادته إلى هذا المصير[25]:
صُبيِّ فلن يصحو الفتى المخمور ما شعّ في الدنيا طلا وثغور
… واسقيه حتى ترتوي بدمائه أحشاؤك الظمأى ضنى وتفور
واسقيه حتى يستفيق خياله ويعود يخفق جنحه المهصور
ويعود للهوى السبب في كل هذا الألم، وهذا الإنسحاق المتحكم به، هي “حواء” وعيونها المسؤولة عن هذا اللّيل الطويل الآسي[26]:
يا دمية الماخور أين عن الهوى هذا المجون الفاتر الممكور
… أين العيون يشع من أحداقها للنشوة الكبرى سنى وسعير
… أواه ما في ليلك الدامي سوى حُرق يداعبها الأسى وتثير
ورغم أن الشّاعر الأمين يبوح بمكنونات صدره يوزعها مآسي ولوعات على المسامع، فقد وصل به المطاف إلى النهاية، الأمل بعودة ربيع الحبّ، الضياء من عتمة الماضي، إلى الإرتواء من كأس الهوى، إلى تلك الآهات الحبّيسة في الجوارح، بلغة الاستعطاف التي أثبتت أنها أقوى من كبرياء الحبّ.
3- الطّبيعة
مهّدت مناداة الحبّيب للعودة إلى الميناء المنشود الذي وجده في أحضان الطّبيعة، بعد أن طالت المسيرة في هجير صحرائها، إلى الندى والربيع، إلى آمال النفس المتجددة بعد سفر شاق طويل.
وتأتي الطّبيعة ينبوعًا رئيسًا للشاعر الرّومانسيّ. وشاعر الطّبيعة شاعر الإنسان. كما قالوا: مواضيع الشّعر ثلاثة: الله والطّبيعة والإنسان[27]. ومع الطّبيعة نرى كيف تتغير من الوصف إلى جعلها مادة غنية بالأحاسيس تندمج مع الحالة النّفسيّة للشاعر وإن عودة شعراء المهجر إلى الطّبيعة كانت طريقة جديدة متميزة في إنشادها ووصفها وعشقها، حتى أصبحت مصدر “دلالات” في مواضيع الحنين والحبّ والذّكريات، وهي عناصر حيّة في المسار الرّومانسيّ. وأصبحت الطّبيعة إلهام الشّاعر الغني بالخيال والأحلام والأسرار، يختلط فيها بصورة حميمة تتغنّى “بالأنا”. وموضوع الطّبيعة لا يعني العزلة، بل يعتبر مصدر الإلهام والجمال وصور الحنين للشاعر الرّومانسيّ، تجمع في حناياها الأمانة والعزاء والصداقة، وكذلك الصدى الناعم والمخلص لكل الخلجات التي تعتري الإنسان[28].
وقد أثبت محمود باشو في حديثه عن ربيع صيدا أن الطّبيعة ليست لغربة الشّاعر الرّومانسيّ بل فيها الحياة والعيد وجنة الفردوس[29].
وأجمل ما صبت روحي إليه ربيعٌ كلٌّ ما فيه جميلُ
إذا وافى الربيعُ فذاك عيدي وفردوسِ الحدائقُ والحقولُ
أطيرُ إلى الغديرِ كعندليبِ يطيرُ به إلى الماءِ الغليلُ
وقد تكون الطّبيعة عنصرًا إيجابيًا مساعدًا لدى شعراء الرّومانسيّة لبث الشكوى فيرتاحون لها كأنها صدر الأم الحنون، وملجأ يحميهم من أذى الحياة والمجتمع حيث العدالة مفقودة[30]:
ألا يا نهر جئت إليك أشكو حياة لا تحيط بها العقولُ
حياةً كلنا يشكو أذاها وعنها لا يطيب لنا الرحيلُ
بنوها كالذّئاب أذىً وغدرًا حديث شرورهم شرح يطولُ
يصيب فقيرهم ذلّ وبؤس وحظّ غنيّهم مجدٌ أثيلُ
وهنا مكمن مفصل التّحوّل في مفهوم الرّومانسيّة، الحريّة والتّجدّد والبعث. والعودة بالحنين إلى الطّفولة والذّكريات، إلى وطن المولد والنّشأة[31]. فكانت مع الطّبيعة ثورة على الذّات والواقع[32]:
ذكراك، يا ظمأ الهجير إلى الندى وتطلع البأساء بالنعماء
ذكراك، يا ماضٍ أفاض وكم سخا وكسا الحياة روائع اللألاء
ويرى في الشام صورًا داعبت خياله إلى الماضي البريء، بل القديم من عمر أيامه الأولى[33]:
طيبي دمشق ثرىً وطيبي محتِدا عبق الجنان على ثراكِ تجسَّدا
وأشم تربك عابقًا، بل عابدًا طفلًا بأحضان الأمومة وُسِّد
طال الفراق وما سلوت ولا غفا ثمل بأنغام الوفا قد عربدا
بيتي القديم وحارتي ومدارسي والحبّ والذكرى السَّخية والصَّدا
في هذا الحنين الرقيق إلى دمشق وحاراتها ومدارسها يتجلّى الجانب الرّومانسيّ المضيء الحي لدى الشّاعر الأمين. فهو وإن قست عليه سطوة الألم والوحشة الذاتية، فإنّ لديه عاطفة رومانسيّة متجدّدة رغم أسى النوى، إلا أن دربه ما ضيعت بوصلتها مواكب المجد زمن الانتداب تحت راية الكبرياء والعروبة[34]:
كم في سمائك من خيالي موكب للمجد كم راضى النجوم وجندا[35]
ما اختار إلا الكبرياء منارة بشعاعه وسوى الكرامة مورد
عيناك نبراس العروبة قائدًا ثريّاك ينبوع الكرامة والندى
4- الثّورة والحريّة
تهتم الرّومانسيّة بالمجتمع من أجل عالم أفضل، تسوده العدالة والمساواة، والشّعراء الرّومانسيّون مولعون بالحريّة يشجعون على التّجدّد في الحياة، ويعملون على نشر الأفكار الفلسفية والأخلاقية والاجتماعية، ويقفون بوجه المناوئبين لحركات التّجدّد. وبرغم استغراق عبد المطلب الأمين في رومانسيّتة الذّاتية ورؤاه الكونيّة الفلسفيّة وإبحاره في متاهات الاغتراب وألم الهوى ومعاناته الطّويلة المتحولة بكلّ الاتّجاهات.
إلا أنّ القضية تبقى عنده في منطقها الثّوريّ، أن لا نكون أو أن نكون، في هذه الحدود كان يفهم الأحداث وقضايا المجتمع، فيضع خصوصية قضيته في منظور متقدم لثورة مسحوق، وعزة ثائر. فكان مصداقًا لقول بدوي الجبل في ذكرى أبي العلاء المعري[36]:
من راح يحمل في جوانحه الضحى هانت عليه أشعة المصباح
من هذا المنظور الثّوريّ كتب الشّعر عن أحداث الوطن والعالم والتّاريخ، واختلال الموازين في المجتمعات العربيّة[37]:
“… وروائح البترول تزكم أنف كل الأنبياء
تطغى على نتن الجريمة في دهاليز الثراء
… يا شعب جرحك في يديك، وبين كفّيك الدواء
“… قل للطّغاة السّادرين بغيهم حان القطاف: أُرغموا أم شاءوا
.. لا شيء إلا الشّعب حي خالد والباقيات سفاسف وفناء
كل الطغاة على تراب نعاله تهوي وتُسحق: رمّة شوهاء
لو يقرأ التّاريخ طاغية لما عصفت بتافه عقله الخيلاء[38]
أقام الشّاعر الأمين معادلة للصراع بين الطغاة والشعوب، حيث يتمادون في ظلمهم، لا بد من مفترق بين ما يشاؤون وبين ما يرغمون عليه، والشعب خالد في هذه المعادلة هو باقٍ وهم إلى زوال، لأنهم لم يقرأوا حكمة التّاريخ في الدوام والزوال.
وحين يكون الشّعر قيمة إنسانيّة عليا، والطغاة في سفاسف الألقاب الصّغيرة، يأبى الشّاعر أن يذكرهم في المعنى الكبير، حتى ولو في معرض الهجاء المرير، فيوجه خطابه لكل طاغية[39]:
أدعوك ماذا؟ بالرئيس أم الزّعيم أم المشير؟
إني رحمتك من عظيم اللّفظ في المعنى الصّغير
ورحمت نفسي أن أهين الشّعر في نخل القشور
وبمجد الشّاعر كامل مصباح فرحات شعارات الرّومانسيّة في الحق والحريّة والتصدي للظلم، والانتماء للإنسان فيقول[40]:
… حريتي مثل جنات تحف بها وجرأتي فوق النسور تأتلقُ
إني جعلت شعاري الحق اشهره سيفًا صدور رجال الظلم يخترق
… المرءُ من أي دين كان فهو أخي ارثي له إن عراه الحزن والقلق
ويرى الشّاعر فرحات وظيفة الشّعر، في ما يرى الرّومانسيّون في الشّعر والشّعراء[41]:
قلت شعري يا ملاكي ثروتي ولذا ما خفت فقرًا وانكسارا
أُسمِع الأمة أنغام العلى جاعلًا حرية الرأي شعارا
بنشيدي أُثمِل الأرواح يا دعد فالناس بأشعاري سكارى
5- نحو الحداثة
ثارت الرّومانسيّة على التّقاليد والقوالب الجامدة. فوقف الأدباء والشّعراء العامليّون بين معارض ومؤيّد للقديم بقدمه، ورابطٍ بين القديم والجديد، ومشجّع ومؤيّد ومدافع عن مقاييسها ونظريّاتها إن بالشّكل أو بالموضوعات فانطلقوا معها نحو الحريّة وكسر القيود، وحقّقوا أهدافها في الثّورة والتّمرّد على الواقع والتّحرّر والإبداع الخلاق ومخالفة الموروث[42].
أنا لا أبالي بالتقاليد التي قد قيدتكم إنني متمرد
من لم يكن في ذي الدنى متحررًا مثلي فلا يهنأ بها أو يسعد
… لا تعبدوا عاداتكم ناشدتكم بإلهكم بجلاله لا تعبدوا
… خالفتها وسحقتها ونبذتها فتهددوا ما شئتم وتوعدوا
وقال الشّاعر أحمد عارف الحر في الشعارات التي طرحتها الرّومانسيّة حول القديم والجديد[43]:
يقولون “بعث” قلت خلق مجدد حقيق ولكن هل تراه يروق
يقولون هل تهوى الجديد أجبتهم إذا كان نفع بالجديد حقيق
شعور صحيح لا جمود بروحه مسالك فضل بالأديب تليق
فكل جميل بالجديد يروق لي وكل جميل بالقديم يروق
وكل قديم كان قبل مجددًا وكل جديد في الغداة عتيق
وأحسن مازان الجديد انطلاقه من القيد والتقليد فهو طليق
لقد طرح الشّاعر الحر بهذه الأبيات إشكاليّة الحداثة التي تخرج من رحم القديم وأقام معادلة بين القديم والجديد جسرها التواصل والتوصيل.
وإذا كانت الغنائية أسلوب الرّومانسيّين في التّعبير عن المشاعر والأحاسيس المخنوقة، بلغة الكآبة والحزن والبؤس والتّعاسة. فإن هذه الغنائيّة تبقى صفة للذّهب الرّومنطيقيّ، “وهي الفرع وليست الأصل… وهي تؤدّي صفة الألحان والأنغام[44]. لكنّ شعراء جبل عامل استطاعوا أن يرتقوا بمبادئ المدرسة الرّومانسيّة إلى مستويات فكرية في النظرة إلى الوجود ومعالجة قضايا المجتمع، والنحو إلى التّمرّد والكفاح والإصلاح والتّجدّد والحداثة، كما صدى تاريخهم، دون أن ينسوا مشاعرهم الإنسانية ومشاعرهم الذاتية.
الخاتمة
لقد تحقّقت شعارات الرّومانسيّة في الشّعر العامليّ لدى بعض الشّعراء في حقبة ما قبل الحرب العالميّة الأولى وبين الحرب العالميّة الثّانية، هذه الحقبة التي شهدت تحولات في السياسة والاجتماع والأدب ومناحي الفكر والعلم عامة، وانعكس ذلك على مثقفي جبل عامل فارتقى بعضهم إلى مصافي شعراء الرّومانسيّة العربيّة بل العالميّة. وأثبت الشّعراء العامليّون من خلال ترجمات بعضهم أنّهم جديرون بالتّجدّد والحداثة والتّعامل مع مبادئ الرّومانسيّة الذّاتية وطرح الأسئلة المصيريّة الوجوديّة، ومكنتهم من مراكمة المواقف والمشاعر في نصّ واحد. حدا بهم نحو القوميّة العربيّة الواحدة.
لقد وضعت الرّومانسيّة المتلقي العامليّ على تخوم الواقع فبات مثقفًا بما قدَّمه له بعض شعرائه من ذخر فنّيّ رائع، جدير به أن يُجمع ويُنشر ليعبّر عن مكنونات وكنوز الإنتاج العامليّ. فيتكامل مع الآداب العربيّة والإنطلاق نحو الآداب العالميّة في حوارية إنسانيّة شاملة.
المصادر والمراجع
- أمين، أحمد، النّقد الأدبيّ، بيروت، دار الكاتب العربيّ، ط4، 1967، ص 328.
- الأمين، عبدالمطلب، ديوان شعر، شقراء، لبنان، المطبعة العامليّة، ط1، 1976، ص 7.
- البقاعي، شفيق، أدب عصر النّهضة، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1990، ص 229.
- عبد الصّبور، صلاح، الديوان، دار العودة، بيروت، ط1، 1976، ص 36.
- غريّب، فيكتور، الرومنطقية في الشّعر العربي المعاصر، شركة مطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ط1، 2013، ص 245.
- الفاضل، أحمد، تاريخ وعصور الأدب العربي، دار الفكر اللّبنانيّ، بيروت، ط1، 2003، ص 545.
- فرحات، كامل مصباح، ديوان الشّلال، بيروت، 1959، ص 43.
- المقالح، عبدالعزيز، ثرثرات في ثناء الأدب العربي، دار العودة، بيروت، ط1، 1983، ص 126-127.
- مندور، محمد، الأدب وفنونه، المطبوعات العربيّة، بيروت، لا.ط، لا.ت، ص 4.
- نوفل سايد، شعراء الطّبيعة في الأدب العربي، القاهرة، 1945، ص 11 و27.
الدّوريات:
- العرفان، مج2، 1910، ص 53.
- العرفان، مج 26، ص 48.
- العرفان، مج 34، 1927، ص 232.
- العرفان، مج 31، 1942، ص 217.
[1] – طالب مرحلة الدكتوراه النهائية، اللغة العربية وآدابها، الجامعة الإسلاميّة، خلدة – بيروت.
[2] – مندور، محمد، الأدب وفنونه، المطبوعات العربية، بيروت، لا.ط، لا.ت، ص 4.
[3] – المقالح، عبدالعزيز، ثرثرات في شتاء الأدب العربي، دار العودة، بيروت، ط1، 1983، ص 126-127.
[4] – أمين، أحمد، النقد الأدبيّ، بيروت، دار الكاتب العربي، ط4، 1967، ص 328.
[5] – البقاعي، شفيق، أدب عصر النهضة، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1990، ص 229.
[6] – العرفان، مج2، 1910، ص 53.
[7] – العرفان، مج 26، ص 48. لم تذكر المترجمة اسم الشاعرة التي أخذت عنها القصيدة.
[8] – العرفان، مج 34، 1946، ص 1104.
[9] – غريّب، فيكتور، الرومنطقية في الشعر العربي المعاصر، شركة مطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ط1، 2013، ص 245.
[10] – العرفان، مج 34، 1927، ص 232.
[11] – الأمين، عبدالمطلب، ديوان شعر، شقراء، لبنان، المطبعة العاملية، ط1، 1976، ص 7.
[12] – الفاضل، أحمد، تاريخ وعصور الأدب العربي، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط1، 2003، ص 545.
[13] – الأمين، عبدالمطلب، الديوان، م.س، ص 11.
[14] – م.ن، ص 12.
[15] – م.ن، ص 21.
[16] – عبد الصبور، صلاح، الديوان، دار العودة، بيروت، ط1، 1976، ص 36.
[17] – الأمين، عبدالمطلب، الديوان، م.س، ص 24.
[18] – م.ن، ص 25-26.
[19] – م.ن، ص 25.
[20] – م.ن، ص 29.
[21] – الأمين، عبدالمطلب، الديوان، م.س، ص 34.
[22] – نسبة إلى شعر عمر بن أبي ربيعة الإباحي.
[23] – م.ن، ص.ن.
[24] – م.ن، ص 42.
[25] – م.ن، ص 26-27.
[26] – م.ن، ص.ن.
[27] – نوفل، سايد، الطبيعة في الأدب العربي، القاهرة، 1945، ص 11 و27.
[28] – غريّب، فيكتور، الرومنطيقية في الشعر العربي المعاصر، م.س، ص 61.
[29] – العرفان، مج 13، ص 1137.
[30] – م.ن، ص.ن.
[31] – ولد ونشأ في حي كان يطلق عليه “حي الخراب”، وقد غيّرت اسمه الحكومة السورية بعد جلاء الفرنسيين إلى “حي الأمين” تكريماً لمواقف والده السيد محسن الأمين الوطنية والقومية.
[32] – الأمين، عبدالمطلب، الديوان، م.س، ص 29.
[33] – م.ن، ص 42.
[34] – م.ن، ص.ن.
[35]– م.ن، ص 42-43.
[36]– مغنية، منير، ديوان الأمين، م.س، ص 124-125.
[37]– الأمين، عبدالمطلب، الديوان، م.س، ص 46-47.
[38]– م.ن، ص 41.
[39]– م.ن، ص 48.
[40]– فرحات، كامل مصباح، ديوان الشلال، بيروت، 1959، ص 43.
[41]– م.ن، ص.ن.
[42]– فرحات، كامل مصباح، ديوان الشلال، م.س، ص 35.
[43]– العرفان، مج 31، 1942، ص 217.
[44] – غريّب، فيكتور، الرومانسية في الشعر العربي المعاصر، م.س، ص 1908.